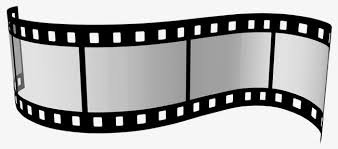قرأت في كتاب "الأغاني" لأبي الفرج الأصفهاني أن مصعب بن الزبير أخذ بالشعبي – وهو شاعر معروف في البصرة – إلى بيته، بل إلى حجلة رفع عنها الغطاء ليرى عائشة بنت طلحة، زوجته الجميلة، فقال له مصعب: "أَفتدري لمَ أدخلناك؟" فقال الشعبي: "لا"، فقال: "لتحدث بما رأيت". أكتب الشعبي جمال ما رأى؟ ولو كتب أكان للقصيدة أن تنقل، أن تحفظ جمالها؟ ألا يكون مصعب مثل الشعبي يستعيضان بالصورة الشعرية عن الصورة الفنية؟ ألا يتحقق القارئ في المتون القديمة من أن الصورة – العقلية، القلبية وغيرها – هي التي استحوذت على استثمارات المعاني والدلالات فيما ضمرت معاني الصورة البصرية ودلالاتها واقتصرت على القليل منها؟
وهي معان مختلفة أتحقق منها بمجرد إقبالي على الصورة الفنية، على تحققات كثيرة لها، هنا وهناك في العالم العربي، حيث يبدو التعامل مع الصورة، بل إنتاجها، مشكلة مستديمة، على الرغم من ذيوع الصورة بصيغها المختلفة، في البيت والشارع والمؤسسة وغيرها. أقبلنا الصور فعلاً، حتى في الفيلم أو المسلسل التلفزيوني؟ أتساءل ذلك أنني – لو أطفأت زر الضوء في الصورة التلفزيونية، وأبقيت على الصوت وحده - لما خفي علي الشيء الكثير منها، إذ أن المخرج يعول على "الحكاية"، ولا يمكن الصورة من عناصر لغتها، أي أن تكون بممكناتها التعبيرية والتمثيلية.
وهو ما لا أتوانى عن قوله، في ظني، أثناء تجولي في هذا المعرض أو ذاك، بين لوحات ورسوم هذا وغيره من الفنانين العرب، حيث أن أعمالهم الفنية تبدو لي، في عدد من الأحوال، أشبه بتدوين، أو خط، ولكن بأدوات اللون والصورة. أي أنه يتحكم بهذه الأعمال منطق كتابي، لا صوري. عدا أن هذه الأعمال لا تستثير من متعة العين التي ترى إليها سوى متعة القراءة، كمن يتابع سطراً أو جملة في كتاب.
عبد الرحيم شريف، الفنان البحريني، ليس من هؤلاء، بل من طينة أخرى من الفنانين، من طينة أقبلت على لغة الصورة مثل أبجدية. ولهذه حروف من لون وضوء، ولها أن تكفي، مثل حجر في عمارة ومثل عمارة بحد ذاتها. فهو قد أقبل على الأصباغ مثل من يتعلم العزف بوتر واحد، أو بجوقة، وفي الوقت عينه. أقبل من دون وخز ضمير، ومن دون رجع بعيد آثم، إذ أن بعض الفنانين العرب يقبلون على التصوير مثل من يقترف جريمة بالسر، ولا يتوانى عن إخفاء معالم الجريمة. مثل من يقترف فعلاً، من دون أن يتحمل عواقبه، أو عائده كذلك.
لهذا أقبل شريف على عدة التصوير بالتصميم الذي للأطفال عندما يشرعون في بناء العالم، أو صناعة الحياة نفسها؛ وهو التصميم الذي يرتعش فوق أصابع الأطفال الطرية. وهو تصميم يلهو بقدر ما يبني، ويخطط بقدر ما يبدد. وهو الخفة التي للأطفال إذ يلهون فيما يكدون، ويبسطون فوق صفحة العالم لوناً من فتنة: هو افتتانهم به قبل أن يكون تمكيناً لنا من هذه الفتنة. وهو إقبال فيه متعة وعمل، أو فيه عمل المتعة نفسها، أو متعة العمل نفسه. ذلك أن الناظر إلى هذه الأعمال يحار في النظر إليها: أهي حاصل جهد وفيها هذا القدر العالي من اللهو؟ أهي حاصل لهو وفيها هذا القدر العالي من الخبرة المتراكمة والمراس الشديد، بحيث لا يقوى اللون إذ يقع – مرتطماً بغيره، منداحاً، متفجراً وملتبساً بغيره – إلا أن يقع في ما يناسبه ويستقبله، إن جاز القول.
وهو ما يتأكد منه المتلقي مرة جديدة، سواء أنظر إلى أعمال الفنان السابقة، أو المتأخرة، وهي الحالية في نتاجه. ففي أعماله السابقة التي كانت تنتسب إلى التجريد اللوني الصرف، كانت التجربة تتعين في مفارقة لافتة تقع بين خط تصميم تحافظ عليه اللوحة وبين توزع لوني متفجر ومتفلت من كل ضبط وانضباط، بما يجعل اللوحة تقيم في منطقة من التوتر، من التنازع الداخلي، بين التصميم والضربة، بين الخط والتبعثر، بين الرسم المقصود واللطخة التي تفشي عن نفسها بعد حصولها. وهو ما للمتلقي أن يقوله إذ يرى إلى أعمال الفنان التي ترقى في بداياتها إلى مطالع التسعينات، وهي التي تتجمع حول الوجه، علامة وحيدة ونهائية للوحة. ذلك أن هذه الأعمال تنبني حول مفارقة بدورها، وهي التالية: لا يتوانى الفنان في كل لوحة عن تصوير وجه، في الوقت عينه الذي يحمل على إخفائه، على تحطيمه، على طمسه. ذلك أن الوجه ليس بوجه، بل هو وجه من لون، من ألوان، ينتسب إلى جبلة الألوان أو يصدر عنها أكثر مما يصدر عن "جلسة" أو "لقطة" أو صورة وجهية لوجه يعمل عليه الفنان وينطلق منه للتصوير. وفي هذا ما يكشف عن الصلات الخفية التي تمتد بين سابق أعماله وحاليها، إذ هي صلات تنشأ في التصوير، في أسبابه، في عدته، في خياراته، قبل أن تقيم في "موضوع" بعينه. وهو ما يشير إلى أن الفن هو ما يشغل عبد الرحيم، وهو صنعته وبناؤه وعدته. أي هو هذا الشاغل الذي يخفي، وراء لهوه الطفولي، ما يشغل عمل المبدعين في جديتهم التي لا تنكشف إلا في العمل. وهي الصورة التي نتحقق منها إذ نرى أحياناً صبياً، على سبيل المثال، يتقدم صوب البيانو بخفة وتعثر ولا يلبث، ما أن يعلو على مقعده للعزف، أن يتحول، بجهامة قادرة، إلى عازف لا يعتني بما يعزف وحسب، وإنما بالهواء الذي يتخلل أصابعه، حيث أن العازف يرتعش إذ يلامس جسد الوجود.
(3-3-2007).
وهي معان مختلفة أتحقق منها بمجرد إقبالي على الصورة الفنية، على تحققات كثيرة لها، هنا وهناك في العالم العربي، حيث يبدو التعامل مع الصورة، بل إنتاجها، مشكلة مستديمة، على الرغم من ذيوع الصورة بصيغها المختلفة، في البيت والشارع والمؤسسة وغيرها. أقبلنا الصور فعلاً، حتى في الفيلم أو المسلسل التلفزيوني؟ أتساءل ذلك أنني – لو أطفأت زر الضوء في الصورة التلفزيونية، وأبقيت على الصوت وحده - لما خفي علي الشيء الكثير منها، إذ أن المخرج يعول على "الحكاية"، ولا يمكن الصورة من عناصر لغتها، أي أن تكون بممكناتها التعبيرية والتمثيلية.
وهو ما لا أتوانى عن قوله، في ظني، أثناء تجولي في هذا المعرض أو ذاك، بين لوحات ورسوم هذا وغيره من الفنانين العرب، حيث أن أعمالهم الفنية تبدو لي، في عدد من الأحوال، أشبه بتدوين، أو خط، ولكن بأدوات اللون والصورة. أي أنه يتحكم بهذه الأعمال منطق كتابي، لا صوري. عدا أن هذه الأعمال لا تستثير من متعة العين التي ترى إليها سوى متعة القراءة، كمن يتابع سطراً أو جملة في كتاب.
عبد الرحيم شريف، الفنان البحريني، ليس من هؤلاء، بل من طينة أخرى من الفنانين، من طينة أقبلت على لغة الصورة مثل أبجدية. ولهذه حروف من لون وضوء، ولها أن تكفي، مثل حجر في عمارة ومثل عمارة بحد ذاتها. فهو قد أقبل على الأصباغ مثل من يتعلم العزف بوتر واحد، أو بجوقة، وفي الوقت عينه. أقبل من دون وخز ضمير، ومن دون رجع بعيد آثم، إذ أن بعض الفنانين العرب يقبلون على التصوير مثل من يقترف جريمة بالسر، ولا يتوانى عن إخفاء معالم الجريمة. مثل من يقترف فعلاً، من دون أن يتحمل عواقبه، أو عائده كذلك.
لهذا أقبل شريف على عدة التصوير بالتصميم الذي للأطفال عندما يشرعون في بناء العالم، أو صناعة الحياة نفسها؛ وهو التصميم الذي يرتعش فوق أصابع الأطفال الطرية. وهو تصميم يلهو بقدر ما يبني، ويخطط بقدر ما يبدد. وهو الخفة التي للأطفال إذ يلهون فيما يكدون، ويبسطون فوق صفحة العالم لوناً من فتنة: هو افتتانهم به قبل أن يكون تمكيناً لنا من هذه الفتنة. وهو إقبال فيه متعة وعمل، أو فيه عمل المتعة نفسها، أو متعة العمل نفسه. ذلك أن الناظر إلى هذه الأعمال يحار في النظر إليها: أهي حاصل جهد وفيها هذا القدر العالي من اللهو؟ أهي حاصل لهو وفيها هذا القدر العالي من الخبرة المتراكمة والمراس الشديد، بحيث لا يقوى اللون إذ يقع – مرتطماً بغيره، منداحاً، متفجراً وملتبساً بغيره – إلا أن يقع في ما يناسبه ويستقبله، إن جاز القول.
وهو ما يتأكد منه المتلقي مرة جديدة، سواء أنظر إلى أعمال الفنان السابقة، أو المتأخرة، وهي الحالية في نتاجه. ففي أعماله السابقة التي كانت تنتسب إلى التجريد اللوني الصرف، كانت التجربة تتعين في مفارقة لافتة تقع بين خط تصميم تحافظ عليه اللوحة وبين توزع لوني متفجر ومتفلت من كل ضبط وانضباط، بما يجعل اللوحة تقيم في منطقة من التوتر، من التنازع الداخلي، بين التصميم والضربة، بين الخط والتبعثر، بين الرسم المقصود واللطخة التي تفشي عن نفسها بعد حصولها. وهو ما للمتلقي أن يقوله إذ يرى إلى أعمال الفنان التي ترقى في بداياتها إلى مطالع التسعينات، وهي التي تتجمع حول الوجه، علامة وحيدة ونهائية للوحة. ذلك أن هذه الأعمال تنبني حول مفارقة بدورها، وهي التالية: لا يتوانى الفنان في كل لوحة عن تصوير وجه، في الوقت عينه الذي يحمل على إخفائه، على تحطيمه، على طمسه. ذلك أن الوجه ليس بوجه، بل هو وجه من لون، من ألوان، ينتسب إلى جبلة الألوان أو يصدر عنها أكثر مما يصدر عن "جلسة" أو "لقطة" أو صورة وجهية لوجه يعمل عليه الفنان وينطلق منه للتصوير. وفي هذا ما يكشف عن الصلات الخفية التي تمتد بين سابق أعماله وحاليها، إذ هي صلات تنشأ في التصوير، في أسبابه، في عدته، في خياراته، قبل أن تقيم في "موضوع" بعينه. وهو ما يشير إلى أن الفن هو ما يشغل عبد الرحيم، وهو صنعته وبناؤه وعدته. أي هو هذا الشاغل الذي يخفي، وراء لهوه الطفولي، ما يشغل عمل المبدعين في جديتهم التي لا تنكشف إلا في العمل. وهي الصورة التي نتحقق منها إذ نرى أحياناً صبياً، على سبيل المثال، يتقدم صوب البيانو بخفة وتعثر ولا يلبث، ما أن يعلو على مقعده للعزف، أن يتحول، بجهامة قادرة، إلى عازف لا يعتني بما يعزف وحسب، وإنما بالهواء الذي يتخلل أصابعه، حيث أن العازف يرتعش إذ يلامس جسد الوجود.
(3-3-2007).