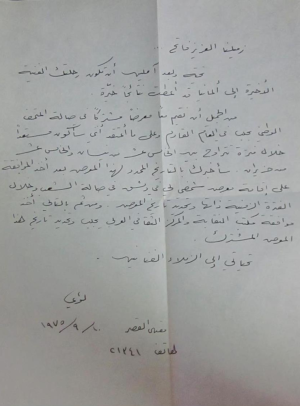لفّني الأسى، وشعرت بالحرج، وانتابني الأسف، وواعتراني الألم العميق وأنا أتابع واحدة من الحلقات المتتابعة عن السجون السورية، وكل تلك الصور التي تجوب فضاء العام من نيوزيلندا إلى ألاسكا. وتساءلت في سري بعيدا عن العسس والمخبرين الأشقياء، لا أدري ما الذي ستفعله المكاتب الإعلامية السورية في الخارج، ومدراؤها الفطاحل المتفوهون الشطار، والحالة هذه، وماذا سيردون على كل ذاك الكلام والاتهام الضمني القاسي، لا سيما أن هؤلاء السجناء هم من المثقفين والمبدعين وحملة الأقلام، وليسوا من القتلة، والمجرمين ودعاة الإرهاب.
فليس كل ذاك الدخان بلا نار، وليست كل تلك الأقاويل والدعاوي والأخبار محض تجنٍ وهراء، وليست كل تلك الصور المحزنة البغيضة هي من الخيال وتوليف المخرجين، وهذيان العقول وتركيب الأذهان. كما أنها ليست لتهديد الأمن القومي وتقويض البنيان السلطوي الذي شيد بالخوف وقهر اليتامى، ودموع الثكالى، وأحزان الفقراء، وحرمان البؤساء. فها هي الحقائق التي يرويها السجناء السابقون، وعلى الملأ في وسائل الإعلام التي تخطت المحلية، تصل إلى رابعة أطراف الأرض وتتخطى هذا المكان. ولن ننجر أيضاً وراء التعميم الضال، ولكن يمكن القول أن هناك بشراً مسالمون، وادعون، طيبون، مثقفون، وطنيون قضوا خلف القضبان عقودا وسنينا طويلة ثقيلة باردة نكداء، بدون محاكمة أو أية أسباب ظاهرة، اللهم سوى إشهار قانون الطوارئ سيء الذكر في وجه أي كان، والذي يخوّل أي "شاويش" أمي أرعن زج الأحرار بدون محاكمات، ووضعهم في "الكلبشات". لقد دخل هؤلاء المناضلون السجن، وخرجوا منه دون الرجوع للمحاكم أو الاستناد على أية قرارات قانونية واضحة. وهذا ما يدخلهم عمليا في عداد المختطفين والرهائن الذين سلبت حريتهم وتم التحفظ عليهم في أمكنة مجهولة. فأي قانون في العالم يستبيح حياة الناس بهذا الشكل، ويرخّص بها إلى هذا الحد الوضيع، ويجعل من المواطنين موضع مساومة، وأوراق لعب نكرة جرداء في حساب السياسات السوداء؟ لم يحملوا أسلحة ولا رشاشات، ولا قنابل ولم يقتلوا نفساً، ولم يزهقوا روحاً، ولم يفجروا أحداً وكان سلاحهم فكرا مختلفاً، وكلمة مختلفة، عما كان يحب أن يسمعه السادة الأجلاء ويردده البلهاء، والمأجورون، وثقلاء الدم في وسائل الإعلام. هل هذه جريمة في عالم يتغير بالثواني ، في فضاء الكلمة الصاروخ، والخبر السهم الذي يخترق الآفاق؟ والحقيقة الثابتة اليوم التي لا ترضي سادة المنع، والزجر، والإقصاء، أن لا سلطة لأحد بعد اليوم على الكلمة الحرة التي تنتقل بلا حواجز في أرجاء العالم، والفضاء.
نعم لقد كانت هناك مرحلة محزنة سوداء بكل أبعادها ذهب ضحيتها كثيرون، وخسر آخرون حياتهم، فيما دمرت حياة الكثير من الأسر والعائلات، في سبيل سلطان فانٍ لم يدم لقيصر، ولا لكسرى أنو شروان، ولا إمبراطور الغرب الأكبر شارلمان. قصص مؤلمة ومحزن تهز الخاطر، وتوقظ الضمير، وتكسر القلب، وتجرح الوجدان. قصص تبدأ، ولا تنتهي من ألف دهر ودهر من دموع القمع والإقصاء، ولكن بدون شهرزاد، أو شهريار هذه المرة، بل أجهزة متجبّرة متسلطة، بلا شفقة، ولا رحمة، ولا اعتبار لكرامة وروح الإنسان، فاقت كل سيّاف في بلاط الحجاج، وزرعت الويل، والرعب، والدموع والأحزان ربوع الوطن.
الإيجابية الوحيدة في هذا الموضوع الدامي هو أن هناك من خرج حيا وسالماً معافى، وبقي على قيد الحياة، وطبعا بدون ذكر ذاك التشويه النفسي الكامن الذي يحتاج ربما لدهر آخر للامساك ببعض من خيوطه الغامضة وحبيسة العقل والوجدان. هناك من ظهر للنور مرة أخرى ليتكلم ويؤرخ لهذه المرحلة الحزينة بكل أبعادها، وحيثياتها، ولحظاتها المرعية وتفاصيلها البأساء، وعن جنون ووحشية بعض الناس حين ينجر بعض موتور في دوامة من الشر والبغضاء.
ألم يحن الوقت لتفسير رسمي، واعتذار علني، وشفافية مطلقة، وتعويض لهؤلاء الأبرياء الذين أفنوا زهرة شبابهم، وحياتهم التي وهبتهم إياها الطبيعة والسماء، وسطا عليها بعض الأشرار ليحولوها إلى جحيم وعذاب. لم تهدد تلك الأشعار، وهذه الكلمات، و كل أدبيات هؤلاء السجناء الوحدة الوطنية، ولم تفجر حروباً أهلية ولا نزاعات، بل كان سجنهم جرحاً نازفاً في جسد الوطن، ووصمة عار على جبينه صارت تميزه من بين الأوطان. بذر بذور الفرقة بين الشعب والنظام، ووضع حاجزاً كبيراً، وسداً منيعاً من الخوف قضى على الوطنية والموهبة والإبداع، وأصاب الوطن في مقتل من الخوف والرعب والإيلام. لقد صور عتاة الأمن لأصحاب القرار أن هؤلاء المثقفين، وأصحاب الرأي الآخر هم خطر داهم على الوطن، وتجب محاربتهم، وتعاموا عن أهوال وويلات الفاسدين والمافيات، ليجد الوطن نفسه مهدداً ذات يوم من كل حدب وصوب، وأدرك الجميع حجم المأساة، ولكن، وللأسف، بعد فوات الأوان.
ألم يحن الوقت فعلا لتسوية هذا الملف الشائك وعودة ما تبقى من روح لجسد الوطن الذي أهلكه هذا الجموح، والانحراف والطغيان؟ ولِمَ يبق أصلا كل سجناء الرأي خلف القضبان إلى الآن؟ ألم يحن الوقت أيضا للتعويض على أولئك الذين دمرت حياتهم، بشكل ما وصاروا أشباحاً بلا أرواح، تدور في الفراغ بلا هدف ولا أي مستقبل على الإطلاق؟ ألم يحن الوقت لقرار سليم وشجعان أقوى من كل الصواريخ العابرة للقارات، ومن حاملات الطائرات، وفرق المدرعات، وأجهزة المخابرات، ويقضي بعودة جميع المهجرين إلى أوطانهم، وديارهم، وعائلاتهم، ومرابع الطفولة والصبا، والشباب بعد فرقة دهر، وطول غياب؟ هل في هذا تهديد للوحدة الوطنية، وتوهين لعزيمة الأمة، وفتٍ لعضدها، أم الحل الدائم في استمرار استهداف رواد الكلمة الحرة؟ لِمَ لا تفتح ملفات المجرمين، والمسيئين للوطن، ومرتكبي الجرائم، والملطخة أياديهم بدماء الأبرياء عبر محاكم عادلة ووفق القانون العام، وليأخذ كل جزاء ما عمل، وما اقترفت يداه، وليطلق فورا سبيل من لم تثبت إدانته أو يتورط في أعمال تمس أمن وسلامة الناس؟ ولِمَ لا يحول كل معتقل لمحكمة مدنية تبرئ البريء، وتجرّم المسيء صاحب السوابق والإجرام؟ وهل من الحكمة، بعد الآن، وفي عالم الأجواء المفتوحة، محاسبة الناس على التفكير، والكلمة، والأحلام؟
إن استمرار هذا الملف الشائك، وإبقائه في الثلاجة، وفي حالة من التسويف والمماطلة، يجعل الوضع في حالة من التوتير العام، كما أنه لن يساهم سوى في المزيد من ضعضعة الوضع العام، وجعل السبيل ممهدة أمام الطامعين والأعداء. وسيكون هناك، حتماً، المزيد، والمزيد من حلقات أدب السجون، بالانتظار، تتناقلها وسائل الإعلام، وتلوكها الألسن، وتبثه الفضائيات.

فليس كل ذاك الدخان بلا نار، وليست كل تلك الأقاويل والدعاوي والأخبار محض تجنٍ وهراء، وليست كل تلك الصور المحزنة البغيضة هي من الخيال وتوليف المخرجين، وهذيان العقول وتركيب الأذهان. كما أنها ليست لتهديد الأمن القومي وتقويض البنيان السلطوي الذي شيد بالخوف وقهر اليتامى، ودموع الثكالى، وأحزان الفقراء، وحرمان البؤساء. فها هي الحقائق التي يرويها السجناء السابقون، وعلى الملأ في وسائل الإعلام التي تخطت المحلية، تصل إلى رابعة أطراف الأرض وتتخطى هذا المكان. ولن ننجر أيضاً وراء التعميم الضال، ولكن يمكن القول أن هناك بشراً مسالمون، وادعون، طيبون، مثقفون، وطنيون قضوا خلف القضبان عقودا وسنينا طويلة ثقيلة باردة نكداء، بدون محاكمة أو أية أسباب ظاهرة، اللهم سوى إشهار قانون الطوارئ سيء الذكر في وجه أي كان، والذي يخوّل أي "شاويش" أمي أرعن زج الأحرار بدون محاكمات، ووضعهم في "الكلبشات". لقد دخل هؤلاء المناضلون السجن، وخرجوا منه دون الرجوع للمحاكم أو الاستناد على أية قرارات قانونية واضحة. وهذا ما يدخلهم عمليا في عداد المختطفين والرهائن الذين سلبت حريتهم وتم التحفظ عليهم في أمكنة مجهولة. فأي قانون في العالم يستبيح حياة الناس بهذا الشكل، ويرخّص بها إلى هذا الحد الوضيع، ويجعل من المواطنين موضع مساومة، وأوراق لعب نكرة جرداء في حساب السياسات السوداء؟ لم يحملوا أسلحة ولا رشاشات، ولا قنابل ولم يقتلوا نفساً، ولم يزهقوا روحاً، ولم يفجروا أحداً وكان سلاحهم فكرا مختلفاً، وكلمة مختلفة، عما كان يحب أن يسمعه السادة الأجلاء ويردده البلهاء، والمأجورون، وثقلاء الدم في وسائل الإعلام. هل هذه جريمة في عالم يتغير بالثواني ، في فضاء الكلمة الصاروخ، والخبر السهم الذي يخترق الآفاق؟ والحقيقة الثابتة اليوم التي لا ترضي سادة المنع، والزجر، والإقصاء، أن لا سلطة لأحد بعد اليوم على الكلمة الحرة التي تنتقل بلا حواجز في أرجاء العالم، والفضاء.
نعم لقد كانت هناك مرحلة محزنة سوداء بكل أبعادها ذهب ضحيتها كثيرون، وخسر آخرون حياتهم، فيما دمرت حياة الكثير من الأسر والعائلات، في سبيل سلطان فانٍ لم يدم لقيصر، ولا لكسرى أنو شروان، ولا إمبراطور الغرب الأكبر شارلمان. قصص مؤلمة ومحزن تهز الخاطر، وتوقظ الضمير، وتكسر القلب، وتجرح الوجدان. قصص تبدأ، ولا تنتهي من ألف دهر ودهر من دموع القمع والإقصاء، ولكن بدون شهرزاد، أو شهريار هذه المرة، بل أجهزة متجبّرة متسلطة، بلا شفقة، ولا رحمة، ولا اعتبار لكرامة وروح الإنسان، فاقت كل سيّاف في بلاط الحجاج، وزرعت الويل، والرعب، والدموع والأحزان ربوع الوطن.
الإيجابية الوحيدة في هذا الموضوع الدامي هو أن هناك من خرج حيا وسالماً معافى، وبقي على قيد الحياة، وطبعا بدون ذكر ذاك التشويه النفسي الكامن الذي يحتاج ربما لدهر آخر للامساك ببعض من خيوطه الغامضة وحبيسة العقل والوجدان. هناك من ظهر للنور مرة أخرى ليتكلم ويؤرخ لهذه المرحلة الحزينة بكل أبعادها، وحيثياتها، ولحظاتها المرعية وتفاصيلها البأساء، وعن جنون ووحشية بعض الناس حين ينجر بعض موتور في دوامة من الشر والبغضاء.
ألم يحن الوقت لتفسير رسمي، واعتذار علني، وشفافية مطلقة، وتعويض لهؤلاء الأبرياء الذين أفنوا زهرة شبابهم، وحياتهم التي وهبتهم إياها الطبيعة والسماء، وسطا عليها بعض الأشرار ليحولوها إلى جحيم وعذاب. لم تهدد تلك الأشعار، وهذه الكلمات، و كل أدبيات هؤلاء السجناء الوحدة الوطنية، ولم تفجر حروباً أهلية ولا نزاعات، بل كان سجنهم جرحاً نازفاً في جسد الوطن، ووصمة عار على جبينه صارت تميزه من بين الأوطان. بذر بذور الفرقة بين الشعب والنظام، ووضع حاجزاً كبيراً، وسداً منيعاً من الخوف قضى على الوطنية والموهبة والإبداع، وأصاب الوطن في مقتل من الخوف والرعب والإيلام. لقد صور عتاة الأمن لأصحاب القرار أن هؤلاء المثقفين، وأصحاب الرأي الآخر هم خطر داهم على الوطن، وتجب محاربتهم، وتعاموا عن أهوال وويلات الفاسدين والمافيات، ليجد الوطن نفسه مهدداً ذات يوم من كل حدب وصوب، وأدرك الجميع حجم المأساة، ولكن، وللأسف، بعد فوات الأوان.
ألم يحن الوقت فعلا لتسوية هذا الملف الشائك وعودة ما تبقى من روح لجسد الوطن الذي أهلكه هذا الجموح، والانحراف والطغيان؟ ولِمَ يبق أصلا كل سجناء الرأي خلف القضبان إلى الآن؟ ألم يحن الوقت أيضا للتعويض على أولئك الذين دمرت حياتهم، بشكل ما وصاروا أشباحاً بلا أرواح، تدور في الفراغ بلا هدف ولا أي مستقبل على الإطلاق؟ ألم يحن الوقت لقرار سليم وشجعان أقوى من كل الصواريخ العابرة للقارات، ومن حاملات الطائرات، وفرق المدرعات، وأجهزة المخابرات، ويقضي بعودة جميع المهجرين إلى أوطانهم، وديارهم، وعائلاتهم، ومرابع الطفولة والصبا، والشباب بعد فرقة دهر، وطول غياب؟ هل في هذا تهديد للوحدة الوطنية، وتوهين لعزيمة الأمة، وفتٍ لعضدها، أم الحل الدائم في استمرار استهداف رواد الكلمة الحرة؟ لِمَ لا تفتح ملفات المجرمين، والمسيئين للوطن، ومرتكبي الجرائم، والملطخة أياديهم بدماء الأبرياء عبر محاكم عادلة ووفق القانون العام، وليأخذ كل جزاء ما عمل، وما اقترفت يداه، وليطلق فورا سبيل من لم تثبت إدانته أو يتورط في أعمال تمس أمن وسلامة الناس؟ ولِمَ لا يحول كل معتقل لمحكمة مدنية تبرئ البريء، وتجرّم المسيء صاحب السوابق والإجرام؟ وهل من الحكمة، بعد الآن، وفي عالم الأجواء المفتوحة، محاسبة الناس على التفكير، والكلمة، والأحلام؟
إن استمرار هذا الملف الشائك، وإبقائه في الثلاجة، وفي حالة من التسويف والمماطلة، يجعل الوضع في حالة من التوتير العام، كما أنه لن يساهم سوى في المزيد من ضعضعة الوضع العام، وجعل السبيل ممهدة أمام الطامعين والأعداء. وسيكون هناك، حتماً، المزيد، والمزيد من حلقات أدب السجون، بالانتظار، تتناقلها وسائل الإعلام، وتلوكها الألسن، وتبثه الفضائيات.