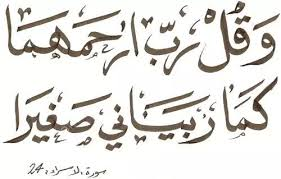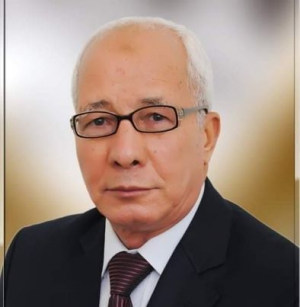# الذكرى_الأولى لرحيل أمي تغمدها الله بواسع رحمته، ورزقها الجنة.
لست أدري هل كان شوقي يعني نفسه أم كان يعنيني بقوله:
ماذا دهاني يوم بِنْتَ فعَقَّني = فيكَ القريضُ وخانني إمكاني؟!
فما أصدق قوله معبرًا عما مررت به من مشاعر حين رحلت والدتي رحمها الله؛ شعرت أن آخر حصوني قد هوت، ولم يعد لي ملاذ ألوذ إليه؛ رغم إيماني الراسخ أنها سُنّة الله في خلقه؛ فلا خلود لبشر، كلٌّ سيرحل ولا بقاء إلا لوجه الله جلت قدرته؛ بيد أن للفراق شعورًا لا يتحمله كل الناس.
عند رحيلها أحسستُ كما وصف عمرو بن العاص حاله حين وافته المنيَّة فلما رآه ابنه عبد الله بالرؤيا بعد موته قال له: " يا أبتِ، وأنت في الدنيا كنت تتمنى أن يصف أحدهم الموت، وقد ذقتَه ( أي الموت)؛ فصفه لي، قال: يا بني رأيتُني حين مِتُّ كأن السماء انطبقت على الأرض، وكأنني اتنفس من (خَرق) أي ثقب إبرة، وكأنني عصفور في مقلاة زيت لا الزيت يبرد فأستريح، ولا أنا أموت فأستريح.
للموت فلسفة وسرّ عظيم ليس في مظهره الضيق القريب، وليس هو ذلك الحادث المُكرَّر تختم به حياة كل فرد، إنما هو تلك الحقيقة الخالدة، هو حرب سرمدية كما بدا منذ القدم للحكماء بين قوتين خفيتين ميدانهما كل نفس حية، وكل ذرة في الأرضين وعوالم السماوات - هاتان القوتان هما الخير والشر، أو هما النور والظلام، أو الحق الباطل، أو هما البقاء والفناء؛ لكل منهما جنود لا تغفل، وأعوان لا تنِي تقبل وتدبر ولا تتمهل، والعوالم علويها وسفليها تشهد منذ كانت وقعات هذه الحرب ومساجلاتها، ولتشهدنها اليوم وغدا، ولتشهدنها إلى ختام الزمان .
إن المرء ليدرك تلك الفلسفة حقّ الإدراك؛ بيد أنه – وتلك طبيعة البشر – يحاول التحليق بعيدا عن عالم الحزن؛ لكنَّ ثمة قيودًا تكبِّله ويظل يرصف فيها، محاولًا التحليق فيقعي ولا يستطيع ويخلد إلى الأسى، ما زلت مستغرقًا متذكرًا تلك الطفولة التي عشتُها في كنفها ببلدتنا، فكانت – رحمها الله – لا تضج مني ومن شكوى الناس مني.
كنت صغيرًا لم أدخل - بعدُ - في حدود الشباب، وكان الوقت صيفًا، وأكثر ما أقضي النهار أمام البيت ألُاعب الصبيةَ من لِدَاتي، فمرَّة نكوِّن قطارًا بخاريٍّا مؤلفًا من بضع عشرة قاطرة، وأخرىٰ نكوِّن خيلًا تصهل وتتوثب وتضرب الأرض بحوافرها، وتزعج المارة وتصطدم بهم، وطورًا نتقاذف الكرة ونحطِّم بها زجاج النوافذ؛ فيثور السكان ويجلوننا عن الحارة، وتارة نقسِّم أنفسنا فريقين: عصابة من اللصوص وضباطًا، وأحيانًا نعصِب لواحد منا عينيه، ونتوارى عنه، وينطلق هو وراءنا باحثًا، فمَن لقي منا عصبْنا له عينيه بدلًا منه، وهكذا إلى آخر هذه الألعاب الصبيانية البريئة .
وكنت إذا ضاربَني أحد لم ُأبالِ أين وقعت يدي، ولم أتَّقِ أن أصُيب عينَه أو أنفَه أو أسنانَه، وقد أتناول الحفنة من التراب فأعفِّر به وجهه وأردُّه كالأعمى، ثم أنهال عليه لطمَا ولكمًا وركلًا. إذ كنتُ واسعَ الحيلة كما ترى، فعوَّضني ذلك من ضعفي، وصارت لي بفضله منزلةٌ بين هؤلاء الصبيان، وكانت – رحمها الله – تقول لي: لك من اسمك نصيب؛ فكلّ عمروٍ داهية، وكانت تعجب من موقفي مع إخوتي وخصوصًا مع من يصغرني منهم؛ فقد كانوا جميعًا دائمي الهجوم عليّ وضربي، وكنت أعلل ذلك بأنهم مني لا أستطيع أن أقسو عليهم، وكانت دومًا تدافع عني وتقول: إن عَمْرًا أرَقُّ أبنائي، وهو من يحنو عليّ؛ رغم أنني كنت أرىٰ في نفسي – ولا زلتُ – قسوةً وغلظةً لا يرونها جميعا.
برحيلها سقطت آخر حُصوني؛ فلم يعد هناك من يدافع عني، وصرت هذا الطفلَ الذي ما فتِئ يبكي بين يديها قسوةَ الألم ومرارةَ الحزن؛ بيد أنها رحلتْ ولم يعد هناك من يواسيني ويمسح على رأسي، أمسيتُ بلا حصون تتناوشني الحياة، لا أستطيع دفاعًا عن نفسي الذي هدَّها ألم الفراق. رحمة الله عليك وسلامه في جنات الخلد، ولعل لقاءً قريبًا يكون يا أُمَّاه.

 www.facebook.com
www.facebook.com
لست أدري هل كان شوقي يعني نفسه أم كان يعنيني بقوله:
ماذا دهاني يوم بِنْتَ فعَقَّني = فيكَ القريضُ وخانني إمكاني؟!
فما أصدق قوله معبرًا عما مررت به من مشاعر حين رحلت والدتي رحمها الله؛ شعرت أن آخر حصوني قد هوت، ولم يعد لي ملاذ ألوذ إليه؛ رغم إيماني الراسخ أنها سُنّة الله في خلقه؛ فلا خلود لبشر، كلٌّ سيرحل ولا بقاء إلا لوجه الله جلت قدرته؛ بيد أن للفراق شعورًا لا يتحمله كل الناس.
عند رحيلها أحسستُ كما وصف عمرو بن العاص حاله حين وافته المنيَّة فلما رآه ابنه عبد الله بالرؤيا بعد موته قال له: " يا أبتِ، وأنت في الدنيا كنت تتمنى أن يصف أحدهم الموت، وقد ذقتَه ( أي الموت)؛ فصفه لي، قال: يا بني رأيتُني حين مِتُّ كأن السماء انطبقت على الأرض، وكأنني اتنفس من (خَرق) أي ثقب إبرة، وكأنني عصفور في مقلاة زيت لا الزيت يبرد فأستريح، ولا أنا أموت فأستريح.
للموت فلسفة وسرّ عظيم ليس في مظهره الضيق القريب، وليس هو ذلك الحادث المُكرَّر تختم به حياة كل فرد، إنما هو تلك الحقيقة الخالدة، هو حرب سرمدية كما بدا منذ القدم للحكماء بين قوتين خفيتين ميدانهما كل نفس حية، وكل ذرة في الأرضين وعوالم السماوات - هاتان القوتان هما الخير والشر، أو هما النور والظلام، أو الحق الباطل، أو هما البقاء والفناء؛ لكل منهما جنود لا تغفل، وأعوان لا تنِي تقبل وتدبر ولا تتمهل، والعوالم علويها وسفليها تشهد منذ كانت وقعات هذه الحرب ومساجلاتها، ولتشهدنها اليوم وغدا، ولتشهدنها إلى ختام الزمان .
إن المرء ليدرك تلك الفلسفة حقّ الإدراك؛ بيد أنه – وتلك طبيعة البشر – يحاول التحليق بعيدا عن عالم الحزن؛ لكنَّ ثمة قيودًا تكبِّله ويظل يرصف فيها، محاولًا التحليق فيقعي ولا يستطيع ويخلد إلى الأسى، ما زلت مستغرقًا متذكرًا تلك الطفولة التي عشتُها في كنفها ببلدتنا، فكانت – رحمها الله – لا تضج مني ومن شكوى الناس مني.
كنت صغيرًا لم أدخل - بعدُ - في حدود الشباب، وكان الوقت صيفًا، وأكثر ما أقضي النهار أمام البيت ألُاعب الصبيةَ من لِدَاتي، فمرَّة نكوِّن قطارًا بخاريٍّا مؤلفًا من بضع عشرة قاطرة، وأخرىٰ نكوِّن خيلًا تصهل وتتوثب وتضرب الأرض بحوافرها، وتزعج المارة وتصطدم بهم، وطورًا نتقاذف الكرة ونحطِّم بها زجاج النوافذ؛ فيثور السكان ويجلوننا عن الحارة، وتارة نقسِّم أنفسنا فريقين: عصابة من اللصوص وضباطًا، وأحيانًا نعصِب لواحد منا عينيه، ونتوارى عنه، وينطلق هو وراءنا باحثًا، فمَن لقي منا عصبْنا له عينيه بدلًا منه، وهكذا إلى آخر هذه الألعاب الصبيانية البريئة .
وكنت إذا ضاربَني أحد لم ُأبالِ أين وقعت يدي، ولم أتَّقِ أن أصُيب عينَه أو أنفَه أو أسنانَه، وقد أتناول الحفنة من التراب فأعفِّر به وجهه وأردُّه كالأعمى، ثم أنهال عليه لطمَا ولكمًا وركلًا. إذ كنتُ واسعَ الحيلة كما ترى، فعوَّضني ذلك من ضعفي، وصارت لي بفضله منزلةٌ بين هؤلاء الصبيان، وكانت – رحمها الله – تقول لي: لك من اسمك نصيب؛ فكلّ عمروٍ داهية، وكانت تعجب من موقفي مع إخوتي وخصوصًا مع من يصغرني منهم؛ فقد كانوا جميعًا دائمي الهجوم عليّ وضربي، وكنت أعلل ذلك بأنهم مني لا أستطيع أن أقسو عليهم، وكانت دومًا تدافع عني وتقول: إن عَمْرًا أرَقُّ أبنائي، وهو من يحنو عليّ؛ رغم أنني كنت أرىٰ في نفسي – ولا زلتُ – قسوةً وغلظةً لا يرونها جميعا.
برحيلها سقطت آخر حُصوني؛ فلم يعد هناك من يدافع عني، وصرت هذا الطفلَ الذي ما فتِئ يبكي بين يديها قسوةَ الألم ومرارةَ الحزن؛ بيد أنها رحلتْ ولم يعد هناك من يواسيني ويمسح على رأسي، أمسيتُ بلا حصون تتناوشني الحياة، لا أستطيع دفاعًا عن نفسي الذي هدَّها ألم الفراق. رحمة الله عليك وسلامه في جنات الخلد، ولعل لقاءً قريبًا يكون يا أُمَّاه.

Amr Elzayat
Amr Elzayat is on Facebook. Join Facebook to connect with Amr Elzayat and others you may know. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected.
 www.facebook.com
www.facebook.com