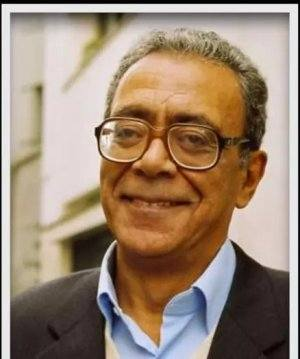1
لا أزال أتذكرها، حتى هذه اللحظة، بحنينٍ شجيّ ومتعةٍ طفولية لا تصدق. بساطة أقربُ إلى الفقر، وتفاصيلُ خضراء عصية على النسيان. ابتعدَ بها الزمن، أو ابتعدتْ به، حد الانخراط في نقطةٍ سديميةٍ لا عودة منها. لكنّ خيطاً خرافياً، دافئاً ونحيلاً، مازال يمتد بيني وبين تلك القرية وأكواخها الطينية الصابرة. تماماً كما كانت تمتد سدتها الترابية حتى تربطها بمدينة الكوت. مركز محافظة واسط :
واسطٌ كانتْ في دمي آنيةً
من مطَرٍ، مملكةً تركْتُها مبتلّةَ الخدّينْ ..
وفي صباحِ السفَرِ الشاحبِ جفّتْ وردةٌ
في طرَفِ الضِلْعِ
بكتْ قبيلةٌ في العينْ ..
لم يقترن تأسيس مدينة واسط القديمة بتفتح الحياة واتساعها. بل كان العكس هو الصحيح تماما. كان اقترانها بفائض الاستبداد وقهر الناس كبيراً، مدينة لم يؤسسها الحجاج بن يوسف الثقفي تلبية لنداء الحياة أوالرغبة في إنعاش مدياتها. بل لتجسد واحدة من أقسى فترات العذاب والقسوة في تاريخنا العربيّ والإسلامي. حتى يخيل لي أن حجارتها لا تزال، حتى الآن، زلقة الملمس بفعل ما علق بها من دم وأنين.
ويخيل إلي، أيضا، أن الحجّاج، ذلك الطاغية البليغ، حين هـمّ ببناء واسط إبّان حكمه، إنما كان يستجيب إلى لحظةٍ كابوسيةٍ من لحظات تشهّيه للظلم وإشاعة الفجيعة. كان لا بد له من أن يزيد من سعة الأرض التي يحكمها لكي تتسع لمزيدٍ من جبروته وبطشه. لقد بلغ ذلك الجبروت حداً دفع بالحسن البصري إلى إطلاق صرخته الشهيرة: عجبتُ من جرأتك على الله، وعجبتُ من صبر الله عليك.
2
حين فتحتُ عينيّ في قريتي الصغيرة تلك، كانت حواس الطفل الذي كنته، تمتلئ بالكثير من مفاتن البراري ونشوتها الفوّاحة. وكان فيه ميلٌ، لم يفارقه حتى الآن ربما، إلى مقدم الخريف، والبدايات الأولى للرعد والمطر وقطاف الكمأة.
كانت محافظة واسط، التي يعرفها الناس آنذاك، بلواء الكوت، تعيش نظاما إقطاعيا بالغ الشراسة. وكأنّ لعنة واسط القديمة لا تزال تتحكم في مقدّرات الناس ومصائرهم.أرض شاسعة ممتدةٌ، كالسماوات، يملكها شخصٌ واحد، وفلاحون يزرعون تلك الأرض، ويسهرون على ترابها حتى يخضر، وعلى حقولها حتى تموج بالذهب والثمار. وفي آخر الموسم قد لا يحصل هؤلاء الفلاحون إلا على حفنةٍ من القش، أوما يكفي لمنع هلاكهم جوعاً.
لم يكن والدي مالكا للأرض، في تلك القرية، ولم يكن فلاحا تماما. كان أكثر من فلاحٍ بقليل، وأقلَّ بكثير من مالكٍ للأرض. عبارة كررتها كثيراً. وكنت أحس، دون أن أعي بطبيعة الحال، أن ثمة تراتبا في مقامات الناس، ومنزلاتهم الاجتماعية والاقتصادية. مالك واحد للأرض وما عليها، وفلاحون لا يملكون إلاّ تعبهم وانتظارهم المرير. حالات من الفقر، تصل حد الإذلال أحيانا. وأتساءل الآن عما كنت أحسه آنذاك دون أن أعيه: أكان بقية من عنت الحجاج وقسوته الكبيرين؟
في تلك القرية التي ربطت لغتي إلى الماء، تعلمّتُ الإصغاء إلى الريح الشتوية وهي تردد نواحها الليليّ البارد في الحقول المجاورة، وأودعتُ ذاكرتي حشداً من المخلوقات الممعنة في ندرتها وصفائها. في تلك القرية الذائبة في فضاء من الحنين ألفْـتُ طيورَ الحصاد، والغجرَ القادمين من وراء الظنّ: يصنعون، في النهار، حليّ النساء وخناجرَ القتلة، ويبيعون الطربَ والملذات في الليل.
ومذ هاجرنا من قريتنا تلك، في منتصف الخمسينات، وحتى هذه اللحظة، وواسط كلها تتماوج في حناياي غائمة، شجية، محيرة. لا تبتعد تماماً ولا تقترب بما يكفي. لا غيابٌ يعينني على النسيان، ولا قربٌ يساعد شمل روحي على الالتئام :
ربمـا الوهـــُم يبتكـرُ امرأةً
من حنينِ الشجَـرْ..
ربمـا القَـشُّ، لا وابـلٌ من مطـرْ..
ربمـا واسطٌ تتمـوّجُ، فـيَّ، كما الأمّهـاتُ..
يغنّيـنَ للشـيبِ أو للـقـلوب الحجـَرْ..
3
مجموعة من الأكواخ الطينيّة ، والحقول الممتدّة ، والقلوب البيضاء . لا تقع بعيداً عن النهر، فالمسافة بينها وبين دجلة لا تتجاوز الكيلومترين أوالثلاثة . ولا يفصل بينها وبينه سوى سدّة ترابية تمتدّ من مدينة الكوت، مركز المحافظة، وحتى مدينة الشيخ سعد . وكم سمعنا في ليالي الفيضان صيحات الفلاحين وأهازيجهم وهم يعملون على تعلية السدّة وتمتين جوانبها خوفاً من جموح النهر أوجنونه الطينيّ المفاجئ .
كانت القرية تقع على الجانب الأيمن من ذلك الطريق الترابي المرتفع ، الذي يربط القرى المتناثرة بمدينة الكوت . ويفصل بين السدة والنهر شريط من الأرض الغرينية الخصبة التي كان الفلاحون يزرعونها عادة بالباقلاّء ، واللوبياء، واليقطين والقثاء، والشمام، والبطيخ، والرقّي . وهكذا كان هذا الشريط الخصب ، والذي نسمّيه ( الحاوي ) يعبق بروائحه الخاصة . ولم يكن ليلنا بمنأى عن ذلك العبق المنعش الذي تحمله إلينا ، في الليل ، أنسام النهر المبللة . بل كنا نحس ، أحياناً ، أن الليل نفسه كان مائياً الى حدّ كبير: وكأنه يأتينا من النهر مباشرة . ليل كنا نراه مختلفاً عن ليالي القرى الأخرى ، البعيدة تلك القرى التي تقع وراء الليل ، والمحرومة من ذلك الجوار المائي البهيج .
تشدّني إلى الماء ، منذ طفولتي ، رابطة خاصة : شيء ما، أوقوّة خفيّة لا تدخل دائرة الوعي أبداً ، بل تظلّ ، هناك : في الجذر ، أوفي قاع البئر ، أو ظلمة اللاوعي . شكلت جزءاً بيناً من شخصيتي واتجاهات سلوكي ربما، حتى أنني قلت ، في إحدى قصائدي:
يا مـاءُ ، يا أيهذا البهيُّ ، العصيُّ ، الحنونْ
لغةً كنتَ لي ، حينما اخشوشنَ
الآخرونْ ..
كان الماء، وما يزال، يحمل لي دلالات خاصة ، هي مزيج متدافع من عناصر عديدة، يلطم بعضها بعضاً : معجزة الخلق ، الغموض ، الحرية وقهر النهايات ، توق الجسد وعجزه ، جبروت المخيّلة ، الطبيعة وسحرها المترامي .
وللماء عليّ سطوة لا تخفى ؛ فهو يضعني دائماً في مناخات وجدانية بالغة القسوة والعذوبة ، تتمثل ،ربما، في الحزن المندفع كالغيوم الأولى . كان الماء ، وما يزال ، يرتبط لديّ بالموت كما يرتبط بالحياة . وكان من المعتاد أن يهرع القرويّون إلى النهر مفجوعين بغرق واحد من أبنائهم . وكثيراً ما كنت أرى مشاهد كهذه : ينتظر القرويّون ساعات طويلة ، وربّما أياماً ، في انتظار أن يطفو جسد الغريق على سطح الماء . يوزّعـون سهرهم المرّ على الضفاف، في استقبال الحبيب الذي خذله جسده ، أواختطفته دوّامة النهر منحدرة به إلى الأعماق المظلمة : حيث الموت الكامن هناك .
ولم تكن قريتي تلك ، تسلم من بطش النهر حين يفيض ويخرج عن طوره . ومع أنه كان ينساب على مقربة منها حنوناً في أغلب فصول العام . لكنه ، حين يطفح به الكيل ، يتحوّل إلى قوة سيّالة مهلكة تدمّر كل شيء : الأكواخ ، والأسرّة الطينية ، والذكريات . وطالما روت لي أمي ، أن الماء الهائج اقتحم عليهم نومهم فجأة ، ذات ليلة ، بعد انهيار جزء من السدة الترابية الفاصلة بين النهر والقرى المتناثرة قريباً منه. تدفق الماء والظلام على البيوت فعاث فساداً بكل شيء : بالجدران ، وقطعان الماشية ، ومهود الأطفال . كان المهد يُصنع من القماش ، ويُشدّ من طرفيه إلى عارضتين خشبيّتين ، ثم يُحرّك ، بعد أن يُوضع فيه الطفل ، كما تُحرّك الأرجوحة . حمل الفيضان بعض المهود، وغمر بعضها الآخر . وهكذا امتلأت أحلام الأطفال بالماء الطيني والصراخ ، وكنت أوشك أن أكون ، في تلك الليلة ، واحداً من أولئك الأطفال الغرقى . وبعد ذلك بسنوات طويلة اقتحم هذا المشهد عليَّ أحد نصوصي:
أنتَ، من قبل أن نلتقي، لم تكنْ غـيرَ فاصلةٍ
لا تشيرُ إلى أحدٍ، وأنا كنتُ كالحُلْم ِ، أو لا أحـــدْ ..
وكبرنا معـا ً، صافيـين ِ، كهـذي الفلاةِ النظيفةِ ..
ما زلت أذكـرُ، كادَ يطيرُ بنا الماءُ في مهرجانِ
تخبّـطهِ، ليلة الفيضانِ ..
تُـرى لو مضى النهرُ حتى يتـمَّ حماقتَهُ ..
أيّـنا كان يبـلغُ أقصى النهاياتِ
وأيٌّ سيبقى رهـينَ الـزبـدْ؟
مع ذلك كان لنهر دجلة مباهجه المائيّة الكبيرة : كان يوزّعها علينا ، نحن الأطفال ، طوال العام . ولا بد من القول إن الفيضان نفسه كنا نعتبره واحداً من المشاهد الآسرة . كان مشهداً لا يُنسى .كم استمتعنا به ونحن نراه يطفح بذلك الجمال المتوحّش ، تاركين للكبار، أعني آباءنا وأمهاتنا تحديداً ، معاناة ما يلحقه بأكواخهم وحقولهم وأحلامهم من هلاك . وكم كان يثيرني منظر الماء المحتدم وهو يُصارع ليحدث شرخاً ما في جسد السدّة الترابيّة . كان منظر النهر مثيراً، وقد تباعدت ضفّتاه بفعل ارتفاع مناسيب الماء في الربيع ، حتى بدا وكأنّه أفقٌ مائيٌّ عريضٌ لا نكاد نرى نهاياته البعيدة . ووسط ذلك كلّه ، لن أنسى تلك الكائنات الناعمة : السمك اللامع ، وأفاعي الماء ، والطيور ، التي تنقضّ ، بين لحظة وأخرى ، على فرائسها الطريّة .
4
تتيح حياة القرية للإنسان فرصة لا تُضاهى للامتزاج بالطبيعة والتشبّع بما تكتظّ به من براءة ، أوقسوة ، ومن دعوة للتأمّل ، أو إغراء للحواس . في القرية لم أكن أحسّ أنني أشاهد عالماً يقع بعيداً عني ؛ لم أكن متفرّجاً ، بل كنت أحد كائنات تلك الطبيعة ، وبعضاً من ضجّتها الخضراء التي لا تُملّ .
هكذا كنت أحسّ ، وهكذا كنت امتلئ بما يبثّه، فيّ وحواليّ ، ذلك العالم الممعن في بساطته وجماله، وكأنه سيمفونية مسكرة تخترق جوارحي كلّها . موسـم الكمأة ، توافـد الغجر، أيام الحصاد ، رائحـة التراب الرطب، منظراللقـالق البيضاء وهي تقف ، في ميأاه الغدران ، على قـدم واحـدة .
إن الالتصاق بالطبيعة كان يمثّل لنا ، نحن الأطفال ، جزءاً حيّاً من سلوكنا اليومي ، وعبثنا التلقائي البريء . كانت الطبيعة تقف عارية أمام عيوننا الشرهة دونما روادع أومصدات. كانت كنـزاً من المشاكسات ، المسرّات والمتاعب اللذيذة . هكذا كانت وهكذا كان إحساسنا العفوي بها ، وهي تفوح من ثيابنا المهلهلة ، وتعلق بقلوبنا الصغيرة الطافحة بالحياة .
في القرية أنت ، دائماً ، جزء من الأرض ، أما في المدينة فثمة ما يحرمك من إحساس كهذا ؛ لأن هناك ما يجعل تماسَّك، مع جسد الطبيعة، منقوصاً :المساحات العارية من الشجر، الطرق المعبدة، والأرصفة ، السيّارات ، والألبسة. أشيــاء ومعادن وكتل صمّـاء تجعل منك " شيئاً " منفصلاً عن " شيء" آخر منفصل عنك . القرية تهبك إحساساً مختلفاً تماماً، حين تحسّ أن قدميك نبتتان تنبعثان من التراب العاري مباشرة. وأن جسدك كله قد جُبل من طين القرية ومن مائها ، ثم نشف بعد أن تعرّض لهواء الليل أولفحة الظهيرة .
ولا يمكنني أن أنسى تلك المتعة العجيبة : الخوض في طين الحقل والقطف من ثماره النيّئة. كان عبث الطفولة يدفعنا إلى الركض بين النباتات الكثيفة ، والتراشق بالطين والماء ، ومطاردة الطيور ، أوالجراد ، أوالأرانب العابثة .
وكم يكون المنظر مغرياً حين يصبح الجوّ كلّه مشبعاً بتلك الرائحة الخضراء البهيجة . وما أجمل أن تمدّ يدك إلى هذه النبتة أو تلك فتحسّ ، بين أصابعك ، ملمس الثمار الناعمة المتراصّة : أصابع الباقلاء أوالسمسم ، أوجوز القطن . كان منظر نباتات الطماطم ، مثلاً ، مثيراً إلى أبعد الحدود : مصابيح مدوّرة ، شديدة الحمرة . نقوم ، أحياناً ، بقطفها قبل أن تنضج تماماً ، ونلتهمها بتلذّذ عجيب وكأنّنا نتركها تكمل نضجها هناك ، حيث تختلط بدمائنا التوّاقة إلى الضوء .
وكثيراً ما يحدث ، ونحن نتراكض في تلك الحقول المرويّة توّاً ، أن يتجاور احساسنا بالجمال ، وإحساسنا بالرعب : كم شعرنا ، تحت أقدامنا الحافية ، بملمس أفعى وهي تسيل ، مبتعدة ، بكامل جمالها الأملس المخيف . وكم تجرّحت أقدامنا أو أيدينا ونحن نطأ على شظيّة حادة من الزجاج أو الحديد المختلط بالطين . أو حين نتعرّض لضربة غصن شائك . وفي الغالب لا يعيدنا إلى بيوتنا إلا الإحساس بالتعب ، أوالخوف من الليل أومن عقاب الآباء . وغالباً ما نعود وقد ترك بعضنا قطرات من دمه ، عالقة هناك، بعظام شجرة أوحجارة مسننة.
هناك مناسبات للفرح ، مبعثرة ، بين أيام السنة. تأتي في انتقالات زمنية معلومة، مع البرد أوتجمع السحب ، أوعندما يتهيأ الناس للربيع أوالحصاد أوالعيد . الملابس الجديدة، مثلاً، لا تلامس جلودنا إلا مرتين في العام تقريباً، في العيد أوفي تحولات الفصول الكبرى. أما الباص فهو حامل البشائر اليومي، نودع من يذهب معه الى المدينة ونستقبل من يجيء. وغالباً ما نجد متعة غريبة في التعلق بذلك الباص أوبالسيارات المارة على السدة الترابية خلال النهار، على أمل النزول منها في القرية المقبلة. ويحدث أن تخذلنا أيدينا، أوأرجلنا، فلا نحتمل الركض مع السيارة مسافة طويلة ولا البقاء معلقين بها. ولا يبقى أحياناً ما يشدنا الى تلك السيارة إلا أملٌ مشكوكٌ فيه بمرتفع أوحفرة أوحيوان يعبر. عندها نسقط مبعثرين على الطريق بعد أن يبطىء السائق في سيره، ثم نعود الى قرانا وجلودنا مغطاةٌ بالتراب والكدمات .
5
ما أجمل مخيّلة الطفولة ، وما ألذّ تصوّراتها الشرسة والمحببة في آنٍ . إنّ لها قدرة هائلة على أن تجعل للتراب رائحة الحليب ، وللأفاعي قلوباً تعشق بحنان بالغ . خرافات وحكايات كثيرة كانت تهبّ على عقولنا فتدفعنا أمامها ، في دروب القرية ، لنمارس لهونا العجيب ، أونلتصق، أكثر فأكثر، بسحر الخرافة وأجوائها العذبة . كم اعتقدنا ، أنا وبعض أقراني ، أننا نشم رائحة الحليب وهو يندفع إلينا من تراب الأرض كلما مر ، بمحاذاة القرية، بعض البدو وهم على ظهور جمالهم العالية.
كان كل منا يختار واحداً من خفاف الإبل المرسومة على التراب ، وينحني عليه وكأنه يصلّي . يفتح راحة كفّه اليمنى عمودياً على سعتها غارساً خنصره في التراب وطرف إبهامه في فمه . وفجأة تتدفّق رائحة الخرافة صاعدة من تراب الطريق إلى أفواهنا الصغيرة . وما هي إلا لحظات حتى يمتلئ الجوّ برائحة الحليب : حليب النياق العالية كالشجر والرشيقة كالأباريق . كنا نحسّ ، فعلاً ، أن أنوفنا ملأى برائحته ، وكنّا نتلمّظ به بين أفواهنا . بل كنا ، أحياناً ، نسارع إلى أطراف أرداننا لنمسح بها ما علق منه بالشفاه ، أو ما تساقط على أسمالنا الكالحة .
وتذهب بنا الخرافة ، أو الواقع الذي يشبه الخرافة إلى أبعد من ذلك . كان نسمع أن لبعض الرجال قدرات عجيبة : كأن يكون ليديه لمسة سحريّة تشفى من لدغة الأفعى ومن لسعة العقارب السوداء كالليل .وكان أكثر ما يثير مخيّلتنا تلك الخرزة السحريّة المسمّاة ( عرق السواحل ) كانت، كما يقال، تمنح الرجل الذي يحملها حظوة لدى النساء ، وتأثيراً شافياً للدغة الأفاعي السامّة . هذا ما تقوله أحاديث القرية ، أو خرافاتها المثيرة للخيال . وكم كنا نحسد ذلك الرجل ، وكم تمنيّنا أن نكونه ذات يوم ، فنتمتّع مثله بما تمنحه تلك الخرزة العجيبة من تأثير ساحر على النساء خاصة .
تقول أحاديث القرية إن تلك الخرزة لا تجيء إلا هدية من ثعبان وأفعى يكونان في حالة عشق خاصة، فهما لا يهبانها إلا لمن يراهما في ذلك الوضع ثم يتركهما ينعمان بعناقهما أوالتفافهما الحميم . وبعد أن ينتهيا من اشتباكهما اللذيذ هذا ، ينسلان بين الأدغال الكثيفة تاركين ، وراءهما، في فراشهما الطري ، تلك الخرزة المذهلة.
كنا نستمتع كثيراً بتلك الخرافة ، وربّما ما يزال يصدقها الكثيرون من أبناء القرية ويستمتعون بها. ومع تحديقنا الدائم في الأدغال وضفاف الأنهار، إلا أننا لم نلمح ، ولا مرة واحدة، أفعواناً يحتضن أنثاه بطريقة عاطفية ملتهبة.
علي جعفر العلاق
.........................................................................................................................................
مجلة الأقلام في عددها لشهر آذار ، 2021 ، ص 142-147
لا أزال أتذكرها، حتى هذه اللحظة، بحنينٍ شجيّ ومتعةٍ طفولية لا تصدق. بساطة أقربُ إلى الفقر، وتفاصيلُ خضراء عصية على النسيان. ابتعدَ بها الزمن، أو ابتعدتْ به، حد الانخراط في نقطةٍ سديميةٍ لا عودة منها. لكنّ خيطاً خرافياً، دافئاً ونحيلاً، مازال يمتد بيني وبين تلك القرية وأكواخها الطينية الصابرة. تماماً كما كانت تمتد سدتها الترابية حتى تربطها بمدينة الكوت. مركز محافظة واسط :
واسطٌ كانتْ في دمي آنيةً
من مطَرٍ، مملكةً تركْتُها مبتلّةَ الخدّينْ ..
وفي صباحِ السفَرِ الشاحبِ جفّتْ وردةٌ
في طرَفِ الضِلْعِ
بكتْ قبيلةٌ في العينْ ..
لم يقترن تأسيس مدينة واسط القديمة بتفتح الحياة واتساعها. بل كان العكس هو الصحيح تماما. كان اقترانها بفائض الاستبداد وقهر الناس كبيراً، مدينة لم يؤسسها الحجاج بن يوسف الثقفي تلبية لنداء الحياة أوالرغبة في إنعاش مدياتها. بل لتجسد واحدة من أقسى فترات العذاب والقسوة في تاريخنا العربيّ والإسلامي. حتى يخيل لي أن حجارتها لا تزال، حتى الآن، زلقة الملمس بفعل ما علق بها من دم وأنين.
ويخيل إلي، أيضا، أن الحجّاج، ذلك الطاغية البليغ، حين هـمّ ببناء واسط إبّان حكمه، إنما كان يستجيب إلى لحظةٍ كابوسيةٍ من لحظات تشهّيه للظلم وإشاعة الفجيعة. كان لا بد له من أن يزيد من سعة الأرض التي يحكمها لكي تتسع لمزيدٍ من جبروته وبطشه. لقد بلغ ذلك الجبروت حداً دفع بالحسن البصري إلى إطلاق صرخته الشهيرة: عجبتُ من جرأتك على الله، وعجبتُ من صبر الله عليك.
2
حين فتحتُ عينيّ في قريتي الصغيرة تلك، كانت حواس الطفل الذي كنته، تمتلئ بالكثير من مفاتن البراري ونشوتها الفوّاحة. وكان فيه ميلٌ، لم يفارقه حتى الآن ربما، إلى مقدم الخريف، والبدايات الأولى للرعد والمطر وقطاف الكمأة.
كانت محافظة واسط، التي يعرفها الناس آنذاك، بلواء الكوت، تعيش نظاما إقطاعيا بالغ الشراسة. وكأنّ لعنة واسط القديمة لا تزال تتحكم في مقدّرات الناس ومصائرهم.أرض شاسعة ممتدةٌ، كالسماوات، يملكها شخصٌ واحد، وفلاحون يزرعون تلك الأرض، ويسهرون على ترابها حتى يخضر، وعلى حقولها حتى تموج بالذهب والثمار. وفي آخر الموسم قد لا يحصل هؤلاء الفلاحون إلا على حفنةٍ من القش، أوما يكفي لمنع هلاكهم جوعاً.
لم يكن والدي مالكا للأرض، في تلك القرية، ولم يكن فلاحا تماما. كان أكثر من فلاحٍ بقليل، وأقلَّ بكثير من مالكٍ للأرض. عبارة كررتها كثيراً. وكنت أحس، دون أن أعي بطبيعة الحال، أن ثمة تراتبا في مقامات الناس، ومنزلاتهم الاجتماعية والاقتصادية. مالك واحد للأرض وما عليها، وفلاحون لا يملكون إلاّ تعبهم وانتظارهم المرير. حالات من الفقر، تصل حد الإذلال أحيانا. وأتساءل الآن عما كنت أحسه آنذاك دون أن أعيه: أكان بقية من عنت الحجاج وقسوته الكبيرين؟
في تلك القرية التي ربطت لغتي إلى الماء، تعلمّتُ الإصغاء إلى الريح الشتوية وهي تردد نواحها الليليّ البارد في الحقول المجاورة، وأودعتُ ذاكرتي حشداً من المخلوقات الممعنة في ندرتها وصفائها. في تلك القرية الذائبة في فضاء من الحنين ألفْـتُ طيورَ الحصاد، والغجرَ القادمين من وراء الظنّ: يصنعون، في النهار، حليّ النساء وخناجرَ القتلة، ويبيعون الطربَ والملذات في الليل.
ومذ هاجرنا من قريتنا تلك، في منتصف الخمسينات، وحتى هذه اللحظة، وواسط كلها تتماوج في حناياي غائمة، شجية، محيرة. لا تبتعد تماماً ولا تقترب بما يكفي. لا غيابٌ يعينني على النسيان، ولا قربٌ يساعد شمل روحي على الالتئام :
ربمـا الوهـــُم يبتكـرُ امرأةً
من حنينِ الشجَـرْ..
ربمـا القَـشُّ، لا وابـلٌ من مطـرْ..
ربمـا واسطٌ تتمـوّجُ، فـيَّ، كما الأمّهـاتُ..
يغنّيـنَ للشـيبِ أو للـقـلوب الحجـَرْ..
3
مجموعة من الأكواخ الطينيّة ، والحقول الممتدّة ، والقلوب البيضاء . لا تقع بعيداً عن النهر، فالمسافة بينها وبين دجلة لا تتجاوز الكيلومترين أوالثلاثة . ولا يفصل بينها وبينه سوى سدّة ترابية تمتدّ من مدينة الكوت، مركز المحافظة، وحتى مدينة الشيخ سعد . وكم سمعنا في ليالي الفيضان صيحات الفلاحين وأهازيجهم وهم يعملون على تعلية السدّة وتمتين جوانبها خوفاً من جموح النهر أوجنونه الطينيّ المفاجئ .
كانت القرية تقع على الجانب الأيمن من ذلك الطريق الترابي المرتفع ، الذي يربط القرى المتناثرة بمدينة الكوت . ويفصل بين السدة والنهر شريط من الأرض الغرينية الخصبة التي كان الفلاحون يزرعونها عادة بالباقلاّء ، واللوبياء، واليقطين والقثاء، والشمام، والبطيخ، والرقّي . وهكذا كان هذا الشريط الخصب ، والذي نسمّيه ( الحاوي ) يعبق بروائحه الخاصة . ولم يكن ليلنا بمنأى عن ذلك العبق المنعش الذي تحمله إلينا ، في الليل ، أنسام النهر المبللة . بل كنا نحس ، أحياناً ، أن الليل نفسه كان مائياً الى حدّ كبير: وكأنه يأتينا من النهر مباشرة . ليل كنا نراه مختلفاً عن ليالي القرى الأخرى ، البعيدة تلك القرى التي تقع وراء الليل ، والمحرومة من ذلك الجوار المائي البهيج .
تشدّني إلى الماء ، منذ طفولتي ، رابطة خاصة : شيء ما، أوقوّة خفيّة لا تدخل دائرة الوعي أبداً ، بل تظلّ ، هناك : في الجذر ، أوفي قاع البئر ، أو ظلمة اللاوعي . شكلت جزءاً بيناً من شخصيتي واتجاهات سلوكي ربما، حتى أنني قلت ، في إحدى قصائدي:
يا مـاءُ ، يا أيهذا البهيُّ ، العصيُّ ، الحنونْ
لغةً كنتَ لي ، حينما اخشوشنَ
الآخرونْ ..
كان الماء، وما يزال، يحمل لي دلالات خاصة ، هي مزيج متدافع من عناصر عديدة، يلطم بعضها بعضاً : معجزة الخلق ، الغموض ، الحرية وقهر النهايات ، توق الجسد وعجزه ، جبروت المخيّلة ، الطبيعة وسحرها المترامي .
وللماء عليّ سطوة لا تخفى ؛ فهو يضعني دائماً في مناخات وجدانية بالغة القسوة والعذوبة ، تتمثل ،ربما، في الحزن المندفع كالغيوم الأولى . كان الماء ، وما يزال ، يرتبط لديّ بالموت كما يرتبط بالحياة . وكان من المعتاد أن يهرع القرويّون إلى النهر مفجوعين بغرق واحد من أبنائهم . وكثيراً ما كنت أرى مشاهد كهذه : ينتظر القرويّون ساعات طويلة ، وربّما أياماً ، في انتظار أن يطفو جسد الغريق على سطح الماء . يوزّعـون سهرهم المرّ على الضفاف، في استقبال الحبيب الذي خذله جسده ، أواختطفته دوّامة النهر منحدرة به إلى الأعماق المظلمة : حيث الموت الكامن هناك .
ولم تكن قريتي تلك ، تسلم من بطش النهر حين يفيض ويخرج عن طوره . ومع أنه كان ينساب على مقربة منها حنوناً في أغلب فصول العام . لكنه ، حين يطفح به الكيل ، يتحوّل إلى قوة سيّالة مهلكة تدمّر كل شيء : الأكواخ ، والأسرّة الطينية ، والذكريات . وطالما روت لي أمي ، أن الماء الهائج اقتحم عليهم نومهم فجأة ، ذات ليلة ، بعد انهيار جزء من السدة الترابية الفاصلة بين النهر والقرى المتناثرة قريباً منه. تدفق الماء والظلام على البيوت فعاث فساداً بكل شيء : بالجدران ، وقطعان الماشية ، ومهود الأطفال . كان المهد يُصنع من القماش ، ويُشدّ من طرفيه إلى عارضتين خشبيّتين ، ثم يُحرّك ، بعد أن يُوضع فيه الطفل ، كما تُحرّك الأرجوحة . حمل الفيضان بعض المهود، وغمر بعضها الآخر . وهكذا امتلأت أحلام الأطفال بالماء الطيني والصراخ ، وكنت أوشك أن أكون ، في تلك الليلة ، واحداً من أولئك الأطفال الغرقى . وبعد ذلك بسنوات طويلة اقتحم هذا المشهد عليَّ أحد نصوصي:
أنتَ، من قبل أن نلتقي، لم تكنْ غـيرَ فاصلةٍ
لا تشيرُ إلى أحدٍ، وأنا كنتُ كالحُلْم ِ، أو لا أحـــدْ ..
وكبرنا معـا ً، صافيـين ِ، كهـذي الفلاةِ النظيفةِ ..
ما زلت أذكـرُ، كادَ يطيرُ بنا الماءُ في مهرجانِ
تخبّـطهِ، ليلة الفيضانِ ..
تُـرى لو مضى النهرُ حتى يتـمَّ حماقتَهُ ..
أيّـنا كان يبـلغُ أقصى النهاياتِ
وأيٌّ سيبقى رهـينَ الـزبـدْ؟
مع ذلك كان لنهر دجلة مباهجه المائيّة الكبيرة : كان يوزّعها علينا ، نحن الأطفال ، طوال العام . ولا بد من القول إن الفيضان نفسه كنا نعتبره واحداً من المشاهد الآسرة . كان مشهداً لا يُنسى .كم استمتعنا به ونحن نراه يطفح بذلك الجمال المتوحّش ، تاركين للكبار، أعني آباءنا وأمهاتنا تحديداً ، معاناة ما يلحقه بأكواخهم وحقولهم وأحلامهم من هلاك . وكم كان يثيرني منظر الماء المحتدم وهو يُصارع ليحدث شرخاً ما في جسد السدّة الترابيّة . كان منظر النهر مثيراً، وقد تباعدت ضفّتاه بفعل ارتفاع مناسيب الماء في الربيع ، حتى بدا وكأنّه أفقٌ مائيٌّ عريضٌ لا نكاد نرى نهاياته البعيدة . ووسط ذلك كلّه ، لن أنسى تلك الكائنات الناعمة : السمك اللامع ، وأفاعي الماء ، والطيور ، التي تنقضّ ، بين لحظة وأخرى ، على فرائسها الطريّة .
4
تتيح حياة القرية للإنسان فرصة لا تُضاهى للامتزاج بالطبيعة والتشبّع بما تكتظّ به من براءة ، أوقسوة ، ومن دعوة للتأمّل ، أو إغراء للحواس . في القرية لم أكن أحسّ أنني أشاهد عالماً يقع بعيداً عني ؛ لم أكن متفرّجاً ، بل كنت أحد كائنات تلك الطبيعة ، وبعضاً من ضجّتها الخضراء التي لا تُملّ .
هكذا كنت أحسّ ، وهكذا كنت امتلئ بما يبثّه، فيّ وحواليّ ، ذلك العالم الممعن في بساطته وجماله، وكأنه سيمفونية مسكرة تخترق جوارحي كلّها . موسـم الكمأة ، توافـد الغجر، أيام الحصاد ، رائحـة التراب الرطب، منظراللقـالق البيضاء وهي تقف ، في ميأاه الغدران ، على قـدم واحـدة .
إن الالتصاق بالطبيعة كان يمثّل لنا ، نحن الأطفال ، جزءاً حيّاً من سلوكنا اليومي ، وعبثنا التلقائي البريء . كانت الطبيعة تقف عارية أمام عيوننا الشرهة دونما روادع أومصدات. كانت كنـزاً من المشاكسات ، المسرّات والمتاعب اللذيذة . هكذا كانت وهكذا كان إحساسنا العفوي بها ، وهي تفوح من ثيابنا المهلهلة ، وتعلق بقلوبنا الصغيرة الطافحة بالحياة .
في القرية أنت ، دائماً ، جزء من الأرض ، أما في المدينة فثمة ما يحرمك من إحساس كهذا ؛ لأن هناك ما يجعل تماسَّك، مع جسد الطبيعة، منقوصاً :المساحات العارية من الشجر، الطرق المعبدة، والأرصفة ، السيّارات ، والألبسة. أشيــاء ومعادن وكتل صمّـاء تجعل منك " شيئاً " منفصلاً عن " شيء" آخر منفصل عنك . القرية تهبك إحساساً مختلفاً تماماً، حين تحسّ أن قدميك نبتتان تنبعثان من التراب العاري مباشرة. وأن جسدك كله قد جُبل من طين القرية ومن مائها ، ثم نشف بعد أن تعرّض لهواء الليل أولفحة الظهيرة .
ولا يمكنني أن أنسى تلك المتعة العجيبة : الخوض في طين الحقل والقطف من ثماره النيّئة. كان عبث الطفولة يدفعنا إلى الركض بين النباتات الكثيفة ، والتراشق بالطين والماء ، ومطاردة الطيور ، أوالجراد ، أوالأرانب العابثة .
وكم يكون المنظر مغرياً حين يصبح الجوّ كلّه مشبعاً بتلك الرائحة الخضراء البهيجة . وما أجمل أن تمدّ يدك إلى هذه النبتة أو تلك فتحسّ ، بين أصابعك ، ملمس الثمار الناعمة المتراصّة : أصابع الباقلاء أوالسمسم ، أوجوز القطن . كان منظر نباتات الطماطم ، مثلاً ، مثيراً إلى أبعد الحدود : مصابيح مدوّرة ، شديدة الحمرة . نقوم ، أحياناً ، بقطفها قبل أن تنضج تماماً ، ونلتهمها بتلذّذ عجيب وكأنّنا نتركها تكمل نضجها هناك ، حيث تختلط بدمائنا التوّاقة إلى الضوء .
وكثيراً ما يحدث ، ونحن نتراكض في تلك الحقول المرويّة توّاً ، أن يتجاور احساسنا بالجمال ، وإحساسنا بالرعب : كم شعرنا ، تحت أقدامنا الحافية ، بملمس أفعى وهي تسيل ، مبتعدة ، بكامل جمالها الأملس المخيف . وكم تجرّحت أقدامنا أو أيدينا ونحن نطأ على شظيّة حادة من الزجاج أو الحديد المختلط بالطين . أو حين نتعرّض لضربة غصن شائك . وفي الغالب لا يعيدنا إلى بيوتنا إلا الإحساس بالتعب ، أوالخوف من الليل أومن عقاب الآباء . وغالباً ما نعود وقد ترك بعضنا قطرات من دمه ، عالقة هناك، بعظام شجرة أوحجارة مسننة.
هناك مناسبات للفرح ، مبعثرة ، بين أيام السنة. تأتي في انتقالات زمنية معلومة، مع البرد أوتجمع السحب ، أوعندما يتهيأ الناس للربيع أوالحصاد أوالعيد . الملابس الجديدة، مثلاً، لا تلامس جلودنا إلا مرتين في العام تقريباً، في العيد أوفي تحولات الفصول الكبرى. أما الباص فهو حامل البشائر اليومي، نودع من يذهب معه الى المدينة ونستقبل من يجيء. وغالباً ما نجد متعة غريبة في التعلق بذلك الباص أوبالسيارات المارة على السدة الترابية خلال النهار، على أمل النزول منها في القرية المقبلة. ويحدث أن تخذلنا أيدينا، أوأرجلنا، فلا نحتمل الركض مع السيارة مسافة طويلة ولا البقاء معلقين بها. ولا يبقى أحياناً ما يشدنا الى تلك السيارة إلا أملٌ مشكوكٌ فيه بمرتفع أوحفرة أوحيوان يعبر. عندها نسقط مبعثرين على الطريق بعد أن يبطىء السائق في سيره، ثم نعود الى قرانا وجلودنا مغطاةٌ بالتراب والكدمات .
5
ما أجمل مخيّلة الطفولة ، وما ألذّ تصوّراتها الشرسة والمحببة في آنٍ . إنّ لها قدرة هائلة على أن تجعل للتراب رائحة الحليب ، وللأفاعي قلوباً تعشق بحنان بالغ . خرافات وحكايات كثيرة كانت تهبّ على عقولنا فتدفعنا أمامها ، في دروب القرية ، لنمارس لهونا العجيب ، أونلتصق، أكثر فأكثر، بسحر الخرافة وأجوائها العذبة . كم اعتقدنا ، أنا وبعض أقراني ، أننا نشم رائحة الحليب وهو يندفع إلينا من تراب الأرض كلما مر ، بمحاذاة القرية، بعض البدو وهم على ظهور جمالهم العالية.
كان كل منا يختار واحداً من خفاف الإبل المرسومة على التراب ، وينحني عليه وكأنه يصلّي . يفتح راحة كفّه اليمنى عمودياً على سعتها غارساً خنصره في التراب وطرف إبهامه في فمه . وفجأة تتدفّق رائحة الخرافة صاعدة من تراب الطريق إلى أفواهنا الصغيرة . وما هي إلا لحظات حتى يمتلئ الجوّ برائحة الحليب : حليب النياق العالية كالشجر والرشيقة كالأباريق . كنا نحسّ ، فعلاً ، أن أنوفنا ملأى برائحته ، وكنّا نتلمّظ به بين أفواهنا . بل كنا ، أحياناً ، نسارع إلى أطراف أرداننا لنمسح بها ما علق منه بالشفاه ، أو ما تساقط على أسمالنا الكالحة .
وتذهب بنا الخرافة ، أو الواقع الذي يشبه الخرافة إلى أبعد من ذلك . كان نسمع أن لبعض الرجال قدرات عجيبة : كأن يكون ليديه لمسة سحريّة تشفى من لدغة الأفعى ومن لسعة العقارب السوداء كالليل .وكان أكثر ما يثير مخيّلتنا تلك الخرزة السحريّة المسمّاة ( عرق السواحل ) كانت، كما يقال، تمنح الرجل الذي يحملها حظوة لدى النساء ، وتأثيراً شافياً للدغة الأفاعي السامّة . هذا ما تقوله أحاديث القرية ، أو خرافاتها المثيرة للخيال . وكم كنا نحسد ذلك الرجل ، وكم تمنيّنا أن نكونه ذات يوم ، فنتمتّع مثله بما تمنحه تلك الخرزة العجيبة من تأثير ساحر على النساء خاصة .
تقول أحاديث القرية إن تلك الخرزة لا تجيء إلا هدية من ثعبان وأفعى يكونان في حالة عشق خاصة، فهما لا يهبانها إلا لمن يراهما في ذلك الوضع ثم يتركهما ينعمان بعناقهما أوالتفافهما الحميم . وبعد أن ينتهيا من اشتباكهما اللذيذ هذا ، ينسلان بين الأدغال الكثيفة تاركين ، وراءهما، في فراشهما الطري ، تلك الخرزة المذهلة.
كنا نستمتع كثيراً بتلك الخرافة ، وربّما ما يزال يصدقها الكثيرون من أبناء القرية ويستمتعون بها. ومع تحديقنا الدائم في الأدغال وضفاف الأنهار، إلا أننا لم نلمح ، ولا مرة واحدة، أفعواناً يحتضن أنثاه بطريقة عاطفية ملتهبة.
علي جعفر العلاق
.........................................................................................................................................
مجلة الأقلام في عددها لشهر آذار ، 2021 ، ص 142-147