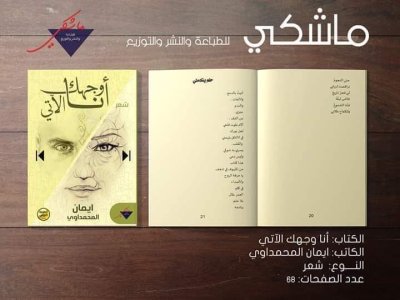المشهد كان داميا ومُركَّبا وتتصاعد فيه الأصوات والصرخات، وأسفل منصة المسرح؛ الذي كان منعزلا بفاصل من الزجاج، كان واقفا ضاما ذراعيه، محتضنا صدره وذاته، وقف صامتا وابتسامة لا تنم عن معنى محدد تفترش وجهه؛ ضمة الذراعين هذه لها من المعاني الكثير: هل كانت غضبا؟ هل كانت تأملا؟ أم كانت صبرا وانتظارا لرد فعل ما يتوقعه؟ أم كانت انبهارا وتأملا لجمال المشهد؟ ظل واقفا في صمت ومتابعة وليس ترقبا لجديد؛ فملامحه تكشف لنا أنه يتوقع الأحداث؛ فلا دهشة ولا تعبير على وجهه يشير إلى التفاجؤ.
كان أحد المشخصين متوسطا خشبة المسرح، يفرد ذراعه ملوحا ومهددا والجمل تخرج من فمه كما الرصاص متتالية وقوية، مرعبة ...
- أنا المنقذ ... يد الرب التي تبطش، وسبابته التي تشير إلى السماء لكي تنزل غيثها فتنبت الأرض فلا تجوعوا ولا تتعروا، أنا صوته الذي ترعد له السماء وتبرق فتنزل لعنته؛ لتصيب من يرفض ويعترض، أنا من إن تلاقت يداه حول رقبة أحدكم، فهي نهاية دوره على الأرض وموعد انتقاله إلى الثرى والنسيان ...
يستدير في كبر بكامل جسده وما زالت رقبته لا تحيد ولا تلف، بل ثابتة في شموخ وكأنه يرفض إلا أن يستدير الكون له ولا تستدير رقبته، كما الزرافة في شموخها وغرورها؛ ليصفع الشاب المكبل بالأصفاد، ثم يشير بإصبعه للسياف، ثم إلى المكبل بالأصفاد، فإذا بسيف جلاده ينزل على رقبة ذلك الشاب وتفصلها عن جسده والجموع تكبر للعظيم العادل ...
"اقتلوه، اذبحوه.".
يهمس رجل من بين الحشد: "ولكنه مظلوم؛ لقد كان يسأل ملككم الطعام لكم، يسأله الكف عن جمع الضرائب من الفقراء وعن أراضيكم التي أكلها القحط وعن بيوتكم التي تشققت عطشا من جفاف النهر".
يرد أحد التابعين، الذين يبررون دوما للملك: "لقد خلق الرب الناس درجات: منهم السيد ومنهم العبد، ولقد اختارنا لنكون عبيدا، إنه قدرنا ومشيئته، ولا راد لما خُطَّ في الكتاب، ونحن لنا في الحياة الأخرى الجنة ولهم العذاب، لا يجب أن نعصي الإله والملك".
- ولكنكم عاونتموه هو وشباب البلدة على العصيان ودفعتموهم للثورة على الملك، والآن تتهمونه وهم بالعقوق والكفر وتنادون بقتله؟! فلتخجلوا من أنفسكم ولتطلبوا لأنفسكم الموت؛ فأنتم حقا لا تستحقون الحياة؛ إنكم خونة.
تضع إحدى المواطنات كفها على فمه تمنعه من الكلام؛ تمنع عنه الموت، وتمنع الحضور -والذي بينهم الدسيس والخائن- أن يستمعوا إلى قوله الحق، وتسحبه إلى الخلف وكأنها تواريه عن الظهور أمام الكاميرا ودور البطولة، فالبطل غالبا ما ينتهي دوره مشنوقا أو محروقا أو مذبوحا؛ ليستكمل حياته سطرا في كتاب التاريخ، وبضع زفرات من عيون خاذليه ...
يخرج من بين الزحام طفل؛ يتجه نحو جثة من تم إعدامه بعد انصراف الملك وركبه، ويمسك برأسه؛ يتأملها مقبلا خده، محتضنا لها، ثم يأخذها وينصرف، في مشهد سكوت للعامة وقد ارتدوا الخفيف والممزق من الملابس وأقدامهم حافية، كانت خطواتهم كما الكنجاروا؛ يقفزون في حركة أشبه بحركة البهلوان، ليضحك المتفرجون، ولكنها كانت قفزات من سخونة الأرض ولسعات الشمس، خطواتهم كانت مضحكة مبكية، تعالت أصوات الجمهور من الضحك، وصاحبت ضحكاتهم قطرات من الماء المالح تساقطت من أعينهم لتترك خطوطا من الملح على الوجوه.
(تغلق الستار في انتظار الفصل الثاني.)
خلف الكواليس، كان هناك صراع بين الممثلين واتهام للمشخص؛ الذي يلعب دور الملك أنه قد تجاوز حدود الدور، وتعدى على الحوار، وارتجل الكثير من القسوة والسباب، بل وامتدت يده لتصفع زميله، وهذا خارج عن النص.
كانت هناك شاشات غير ملموسة، أحدث ما تم اختراعه، مسجل عليها حوار كل ممثل ولا يراها غيره؛ يشير إليها بإصبعه فيظهر الحوار ودور كل ممثل.
ومازال المخرج يقف خلف جدار زجاجي كبير يتابعهم من خلاله، يراهم ويسمعهم، أما هم فيرونه ولكن يتلقون التعليمات في شكل إشارات يحفظونها ...
يدافع المشخص عن نفسه، بأنه أتقن دوره وأجاد لعب دور الحاكم القوي كما يراه على الأرض، وكما درسه في كتب التاريخ، وأنه لا حاكم دون تعالٍ ورفض للنقاش مع العامة أو المستشارين؛ فلابد أن يكون الحاكم ديكتاتورا حتى يحمي العرش والأرض من العامة والغوغاء.
لتتوجه إحدى المشخصات، لتواجه الجدار الزجاجي؛ ملوحة للمخرج بإشارات يتلقاها ويفهمها؛ بسؤال عن رأيه لما قام به الملك أو المشخص؛ فلا ترى منه إلا ابتسامة وصمتا، ويشير بيده إليهم للصعود على خشبة المسرح، فلقد حان موعد الفصل الثاني.
يفتح الستار بني اللون عن مشهد آخر ويوم آخر؛ أحد بيوت العامة وصوت الأطباق وحركات الأسرة استعدادا لتناول وجبة الإفطار، وضحكات الأطفال وهم يجرون في لعبة المسّاكة ...
أحدهم يلعب دور البطل الثوري مهلهل الثياب، يمسك بعصاه، تشرق من عينيه الشجاعة والإصرار، يجري خلف رجل الأمن الذي يمسك سيفا من ورق ...
جلس الجميع حول مائدة الفطور والتي كانت كما الصحراء يتناثر عليها على مسافات متباعدة نباتات شوكية لا تسمن ولا تغني من جوع، نظر الأولاد إلى المائدة متسائلين:
"أين الخبز يا أماه؟ وأين الفول أو العدس؟
أجابت: "من أين لي الدقيق؟ فلقد جفت الأرض، ونفد مخزون الدقيق والقمح لدينا؛
لم يتبق لنا إلا تلك اللقيمات المتبقية من موائد سابقة، جمعتها لكم.
سأل أحد الأبناء أباه: لماذا هللت لذبح من ثار ضد الملك طلبا لرفع الضرائب عنكم وعن توفير القمح الذي يخزنه الملك لنفسه ولخاصته ويمنعه عنكم، بل خرجتم شامتين في قصل رقبته؟
ينهر الأب ابنه مهددا له بالضرب، قائلا: إياك أن تنطق بذلك أمام أحد، هل جننت؟ أخشى أن يحاكموك ويذبحوك مثله؛ فلقد عادت الحوائط بأذان، تتجسس وتتنصت لما نقول خشية التآمر ضد الملك والوطن.
قال ابن آخر: يا أبتي، نحن موتى، سواء بالشنق أو بالذبح أو بالجوع، ولقد سمعنا من رجل الدين أن الموت ما هو إلا جسر إلى عالم أفضل؛ حيث العدل ومائدة السماء التي لن نجوع معها ولا نتعرى، لقد رأيت وجه الثائر ضاحكا وكأنه لم يشعر بالسيف الذي ذبحه وكأنه رأى "المدينة العادلة".
سكت الأب وأحنى رأسه ناظرا إلى حجره الخاوي من المال والطعام بل والكرامة،
خرج الأولاد الصغار، وقد نسوا الجوع، وقد امتلأوا بما حفظوا من كلمات عن معلمهم وعن الثائر، عن الكرامة والعدل والمساواة، فلا حقيقة لقول العامة؛ أنهم خلقوا ليكونوا عبيدا وخدما للسادة؛ فلقد نظر الأطفال والصبية في مياه النهر التي أوشكت على الجفاف فرأوا ملامحهم هي نفسها ملامح الملك وخاصته، إلا أن الملك شحذ حنجرته ليكون صوته أعلى وأقوى من صوت الجميع، ليرهبهم ويثنيهم عن المطالبة بنصيبهم من الأرض التي وهبها لهم وله الرب، ولولا البطانة التي تلتف حوله ومعها سيوف ومفاتيح السجون؛ لما جرؤ أن يتعال عليهم ويهددهم بسلب حقهم في الحياة، وأنه هو من يحدد معنى الحق والحقيقة، ومن يحدد معاني كل مفردات اللغة التي ينطقها شعبه؛ لقد ساعده آباؤنا، بل هم من منحوه تلك الصلاحيات ومن سلم له ما ننتجه من حديد؛ ليصنع منها أصفادا وسلاسل؛ ليقيدنا بها. إنه قد خزّن لنفسه وحاشيته
كل ما أنتجته حقولنا من قمح وأرز بل وخزّن ما يكفيه من ماء؛ فقد أنشأ لنفسه مدينة تليق به بعيدا عن العامة ليتركهم في الجوع والقحط ويهرب بنفسه وعمالته حيث الرخاء.
يغلق الستار البني على مشهد الأطفال والصبايا وهم يتسيّدون المسرح ويقفون صفا في مواجهة الجمهور وقد تباعدت المسافة بين أرجلهم ضامين أذرعهم، ورفعوا رؤوسهم في شموخ وإصرار ...
وكانت نظراتهم تتجه إلى مخرج العرض وقد علت وجهه تلك الابتسامة، وعلت وجوهم تلك النظرة التي تنم عن اليأس وجملة أنطقتها وجوههم: إما العدل أو الموت.
صفّق الجمهور، ولكن تملكت الجميع نظرات الاستغراب والدهشة؛ فلم ينته النص ولم يكتمل، ولم تكن هناك جمل يقولها المشخصون الأطفال أو الصبية ليُفهَم منها باقي الأحداث، ولم يتحرك المخرج من مكانه، بل ظلَّ محتضنا نفسه بذراعيه وقد علت وجهه ابتسامة ذات تفسيرات عديدة، يختلف كل منا في فهم معناها أو مبررها؛ مخرج غامض.
ليغلق الستار دون أن يفتح لاستكمال المشهد الثالث، ليترك للجمهور حرية توقع أحداثه ...
مارا أحمد
كان أحد المشخصين متوسطا خشبة المسرح، يفرد ذراعه ملوحا ومهددا والجمل تخرج من فمه كما الرصاص متتالية وقوية، مرعبة ...
- أنا المنقذ ... يد الرب التي تبطش، وسبابته التي تشير إلى السماء لكي تنزل غيثها فتنبت الأرض فلا تجوعوا ولا تتعروا، أنا صوته الذي ترعد له السماء وتبرق فتنزل لعنته؛ لتصيب من يرفض ويعترض، أنا من إن تلاقت يداه حول رقبة أحدكم، فهي نهاية دوره على الأرض وموعد انتقاله إلى الثرى والنسيان ...
يستدير في كبر بكامل جسده وما زالت رقبته لا تحيد ولا تلف، بل ثابتة في شموخ وكأنه يرفض إلا أن يستدير الكون له ولا تستدير رقبته، كما الزرافة في شموخها وغرورها؛ ليصفع الشاب المكبل بالأصفاد، ثم يشير بإصبعه للسياف، ثم إلى المكبل بالأصفاد، فإذا بسيف جلاده ينزل على رقبة ذلك الشاب وتفصلها عن جسده والجموع تكبر للعظيم العادل ...
"اقتلوه، اذبحوه.".
يهمس رجل من بين الحشد: "ولكنه مظلوم؛ لقد كان يسأل ملككم الطعام لكم، يسأله الكف عن جمع الضرائب من الفقراء وعن أراضيكم التي أكلها القحط وعن بيوتكم التي تشققت عطشا من جفاف النهر".
يرد أحد التابعين، الذين يبررون دوما للملك: "لقد خلق الرب الناس درجات: منهم السيد ومنهم العبد، ولقد اختارنا لنكون عبيدا، إنه قدرنا ومشيئته، ولا راد لما خُطَّ في الكتاب، ونحن لنا في الحياة الأخرى الجنة ولهم العذاب، لا يجب أن نعصي الإله والملك".
- ولكنكم عاونتموه هو وشباب البلدة على العصيان ودفعتموهم للثورة على الملك، والآن تتهمونه وهم بالعقوق والكفر وتنادون بقتله؟! فلتخجلوا من أنفسكم ولتطلبوا لأنفسكم الموت؛ فأنتم حقا لا تستحقون الحياة؛ إنكم خونة.
تضع إحدى المواطنات كفها على فمه تمنعه من الكلام؛ تمنع عنه الموت، وتمنع الحضور -والذي بينهم الدسيس والخائن- أن يستمعوا إلى قوله الحق، وتسحبه إلى الخلف وكأنها تواريه عن الظهور أمام الكاميرا ودور البطولة، فالبطل غالبا ما ينتهي دوره مشنوقا أو محروقا أو مذبوحا؛ ليستكمل حياته سطرا في كتاب التاريخ، وبضع زفرات من عيون خاذليه ...
يخرج من بين الزحام طفل؛ يتجه نحو جثة من تم إعدامه بعد انصراف الملك وركبه، ويمسك برأسه؛ يتأملها مقبلا خده، محتضنا لها، ثم يأخذها وينصرف، في مشهد سكوت للعامة وقد ارتدوا الخفيف والممزق من الملابس وأقدامهم حافية، كانت خطواتهم كما الكنجاروا؛ يقفزون في حركة أشبه بحركة البهلوان، ليضحك المتفرجون، ولكنها كانت قفزات من سخونة الأرض ولسعات الشمس، خطواتهم كانت مضحكة مبكية، تعالت أصوات الجمهور من الضحك، وصاحبت ضحكاتهم قطرات من الماء المالح تساقطت من أعينهم لتترك خطوطا من الملح على الوجوه.
(تغلق الستار في انتظار الفصل الثاني.)
خلف الكواليس، كان هناك صراع بين الممثلين واتهام للمشخص؛ الذي يلعب دور الملك أنه قد تجاوز حدود الدور، وتعدى على الحوار، وارتجل الكثير من القسوة والسباب، بل وامتدت يده لتصفع زميله، وهذا خارج عن النص.
كانت هناك شاشات غير ملموسة، أحدث ما تم اختراعه، مسجل عليها حوار كل ممثل ولا يراها غيره؛ يشير إليها بإصبعه فيظهر الحوار ودور كل ممثل.
ومازال المخرج يقف خلف جدار زجاجي كبير يتابعهم من خلاله، يراهم ويسمعهم، أما هم فيرونه ولكن يتلقون التعليمات في شكل إشارات يحفظونها ...
يدافع المشخص عن نفسه، بأنه أتقن دوره وأجاد لعب دور الحاكم القوي كما يراه على الأرض، وكما درسه في كتب التاريخ، وأنه لا حاكم دون تعالٍ ورفض للنقاش مع العامة أو المستشارين؛ فلابد أن يكون الحاكم ديكتاتورا حتى يحمي العرش والأرض من العامة والغوغاء.
لتتوجه إحدى المشخصات، لتواجه الجدار الزجاجي؛ ملوحة للمخرج بإشارات يتلقاها ويفهمها؛ بسؤال عن رأيه لما قام به الملك أو المشخص؛ فلا ترى منه إلا ابتسامة وصمتا، ويشير بيده إليهم للصعود على خشبة المسرح، فلقد حان موعد الفصل الثاني.
يفتح الستار بني اللون عن مشهد آخر ويوم آخر؛ أحد بيوت العامة وصوت الأطباق وحركات الأسرة استعدادا لتناول وجبة الإفطار، وضحكات الأطفال وهم يجرون في لعبة المسّاكة ...
أحدهم يلعب دور البطل الثوري مهلهل الثياب، يمسك بعصاه، تشرق من عينيه الشجاعة والإصرار، يجري خلف رجل الأمن الذي يمسك سيفا من ورق ...
جلس الجميع حول مائدة الفطور والتي كانت كما الصحراء يتناثر عليها على مسافات متباعدة نباتات شوكية لا تسمن ولا تغني من جوع، نظر الأولاد إلى المائدة متسائلين:
"أين الخبز يا أماه؟ وأين الفول أو العدس؟
أجابت: "من أين لي الدقيق؟ فلقد جفت الأرض، ونفد مخزون الدقيق والقمح لدينا؛
لم يتبق لنا إلا تلك اللقيمات المتبقية من موائد سابقة، جمعتها لكم.
سأل أحد الأبناء أباه: لماذا هللت لذبح من ثار ضد الملك طلبا لرفع الضرائب عنكم وعن توفير القمح الذي يخزنه الملك لنفسه ولخاصته ويمنعه عنكم، بل خرجتم شامتين في قصل رقبته؟
ينهر الأب ابنه مهددا له بالضرب، قائلا: إياك أن تنطق بذلك أمام أحد، هل جننت؟ أخشى أن يحاكموك ويذبحوك مثله؛ فلقد عادت الحوائط بأذان، تتجسس وتتنصت لما نقول خشية التآمر ضد الملك والوطن.
قال ابن آخر: يا أبتي، نحن موتى، سواء بالشنق أو بالذبح أو بالجوع، ولقد سمعنا من رجل الدين أن الموت ما هو إلا جسر إلى عالم أفضل؛ حيث العدل ومائدة السماء التي لن نجوع معها ولا نتعرى، لقد رأيت وجه الثائر ضاحكا وكأنه لم يشعر بالسيف الذي ذبحه وكأنه رأى "المدينة العادلة".
سكت الأب وأحنى رأسه ناظرا إلى حجره الخاوي من المال والطعام بل والكرامة،
خرج الأولاد الصغار، وقد نسوا الجوع، وقد امتلأوا بما حفظوا من كلمات عن معلمهم وعن الثائر، عن الكرامة والعدل والمساواة، فلا حقيقة لقول العامة؛ أنهم خلقوا ليكونوا عبيدا وخدما للسادة؛ فلقد نظر الأطفال والصبية في مياه النهر التي أوشكت على الجفاف فرأوا ملامحهم هي نفسها ملامح الملك وخاصته، إلا أن الملك شحذ حنجرته ليكون صوته أعلى وأقوى من صوت الجميع، ليرهبهم ويثنيهم عن المطالبة بنصيبهم من الأرض التي وهبها لهم وله الرب، ولولا البطانة التي تلتف حوله ومعها سيوف ومفاتيح السجون؛ لما جرؤ أن يتعال عليهم ويهددهم بسلب حقهم في الحياة، وأنه هو من يحدد معنى الحق والحقيقة، ومن يحدد معاني كل مفردات اللغة التي ينطقها شعبه؛ لقد ساعده آباؤنا، بل هم من منحوه تلك الصلاحيات ومن سلم له ما ننتجه من حديد؛ ليصنع منها أصفادا وسلاسل؛ ليقيدنا بها. إنه قد خزّن لنفسه وحاشيته
كل ما أنتجته حقولنا من قمح وأرز بل وخزّن ما يكفيه من ماء؛ فقد أنشأ لنفسه مدينة تليق به بعيدا عن العامة ليتركهم في الجوع والقحط ويهرب بنفسه وعمالته حيث الرخاء.
يغلق الستار البني على مشهد الأطفال والصبايا وهم يتسيّدون المسرح ويقفون صفا في مواجهة الجمهور وقد تباعدت المسافة بين أرجلهم ضامين أذرعهم، ورفعوا رؤوسهم في شموخ وإصرار ...
وكانت نظراتهم تتجه إلى مخرج العرض وقد علت وجهه تلك الابتسامة، وعلت وجوهم تلك النظرة التي تنم عن اليأس وجملة أنطقتها وجوههم: إما العدل أو الموت.
صفّق الجمهور، ولكن تملكت الجميع نظرات الاستغراب والدهشة؛ فلم ينته النص ولم يكتمل، ولم تكن هناك جمل يقولها المشخصون الأطفال أو الصبية ليُفهَم منها باقي الأحداث، ولم يتحرك المخرج من مكانه، بل ظلَّ محتضنا نفسه بذراعيه وقد علت وجهه ابتسامة ذات تفسيرات عديدة، يختلف كل منا في فهم معناها أو مبررها؛ مخرج غامض.
ليغلق الستار دون أن يفتح لاستكمال المشهد الثالث، ليترك للجمهور حرية توقع أحداثه ...
مارا أحمد