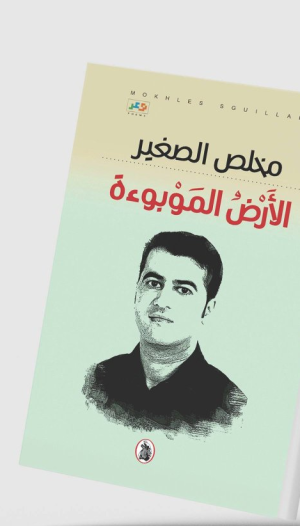ملحوظة:
يمكنك أن تقرأ هذا النص من أعلى لأسفل أو من أسفل لأعلى ولن يشكل ذلك فارقاً مهماً.
(1) الماركيزة ونهاية التاريخ:
ماذا كان حلمي؟
كان حلمي أن أكون راعياً طيباً.
نعم، ليس راعياً فقط، بل راعياً طيباً. لقد حدثتنا الأسطورة التوراتية عن الراعي الطيب. الراعي هابيل. جدنا الذي قُتل بسبب أول قصة حب في التاريخ. وفي ذات الوقت جعلت تلك الأسطورة من جدنا الفلاح قايين رجلاً متعصباً، ممترعاً بالأنا، مزاجياً، حاداً ومجرماً ومفزوعاً باستمرار، هارباً وقلقاً، باختصار غير مستقر نفسياً. لذلك لا يمكن لأحد أن يتمنى أن يكون مزارعاً أو فلاحاً عند مزارع. هما سيان بالنسبة لي. نعم كان حلمي أن أكون راعياً طيباً، ولكن ليس في أي مكان؛ بل في مكان واحد فقط في العالم؛ إنه سويسرا، انترلاكن في سويسرا. هناك حيث يمكنك أن تكون راعياً طيباً حين ترى الشلالات الهابطة من الجبال، والسحب التي يتدلى شعرها الأشيب على الخضرة كملكة بريطانيا العجوز. والسماء.. السماء داكنة الزرقة، والتي تمحو نفسها كلما تمددت على الأفق، والطيور والنهير، والأعشاب، والزهور، والأكواخ التي تتبعثر كبذر البطيخ. ظللت أتخيل دائماً، وأنا عموماً أعتقد بصدق أن من يعيش هناك، ومعه مجموعة متوسطة الكمية من الخراف، مع حظيرة دجاج صغيرة، سيصبح راعياً طيباً. ولا أحد يسألني عن معنى طيب. لأنني أدمج هذا الوصف بالعزلة. المكان الأصلح للعزلة، لتجنب جحيم الآخر كما وصفه سارتر. أن تتجنب البشر بقدر المستطاع ولكن ليس في أفريقيا وإنما في سويسرا، في انترلاكن. حتى وإن كنت في كل الأحوال أفريقياً. غير أنني متأكد بأنني لو قمت بتحليل حمضي النووي فسأكون أحد أحفاد رجل عاش في انترلاكن حتى لو كان الإنسان الأصلي لهذه المنطقة أوروبياً. من هو الإنسان الأصلي؟ هذا سؤال متعسف، لأنني أيضاً أصدق مقولة نيتشه وهي أن الشيء الوحيد الذي يمكن تعريفه هو ذلك الشيء الذي ليس له تاريخ. أي الشي الذي هو ابن الآن، ابن اللحظة، سواء كان جماداً أم كائناً حياً. وبما أنه لا شيء ليس له تاريخ حتى الآلهة؛ لذلك لا يوجد –في الحقيقة- شيء يمكن تعريفه. وبالتالي فما الأصالة إلا وهماً تاريخياً ضرورياً للتأسيس للمستقبل. نعم أن أكون الراعي الطيب، ليس هدفاً، بل روح. نعم روح. لأنها حالة تتشكل في عمق الذات وتتضافر مع الوعي والرغبة. ولذلك فليس بالضرورة أن يكون الراعي الطيب رجلاً لا يؤمن بالمقاومة أو الحرب. لكنه عندما يقاوم سيقاوم الظلم، وحين يحارب فسيحارب من أجل العدالة. وهو حتى حين يتجنب كل عنف ما بقدر ما يستطيع فهو يتجنب ما يمكن الالتفاف عليه عبر نشاط سلمي بلا خوف. إنها مسألة –بشكل كلي- تعتبر أسلوب حياة، أو منهجاً، ولكنه منهج غير شكلي فقط، بل منهج شكلي وموضوعي. فهذه الثنائية تبدو حمقاء جداً. أشعر بذلك وأنا أكتب هذا الكلام. نعم؛ كان حلمي أن أكون راعياً طيباً في انترلاكن، ولكن الحلم لم يتحقق، وربما لن يتحقق، لأسباب لن يكون بيانها هنا داعماً للنص الأدبي –إذا افترضنا أن هذا النص أدبي- ولكن في كل الأحوال كان ذلك الحلم – لو تحقق- أن يتماشى مع الخطاب المضاد للخطاب الشعبوي؛ الخطاب الشعبوي الذي أنتج ملايين الضحايا في أوروبا، ومليارات أخرى في باقي العالم منذ فجر التاريخ، وبما أن هذا الحلم بأن أكون راعياً طيباً يتفق والتوجه المضاد للخطاب الشعبوي، فإنه – في هذه الحالة- سيكون في مواجهة حاسمة مع الثقافة الجماهيرية، وسلاحاً حاسماً من أسلحة القمع الحداثوي الديموقراطي. لذلك كان من المفترض أن أجد الدعم المناسب لأكون راعياً طيباً، غير أنني في كل الأحوال، مجرد رجل أفريقي مُلقى في هامش الكون. ولكنه هامش مزروع بالسكاكين.
وفي الثامن والعشرين من شهر أكتوبر عام 1943 توفيت الماركيزة، سقطت دون أن تمرض ولو ليوم واحد. كانت بالفعل ماركيزة انتقل جدها الأرمني من إيطاليا إلى السلطنة العثمانية وعمل طبيباً في البلاط هناك؛ مغيراً اسمه إلى اسمٍ تركي، ومعلناً اسلامه لكي يتجنب الكثير من الويلات. وفي ذات العام وصل أبناء الرجل الصوفي المغربي إلى أواسط أفريقيا التي بدأ غزوها من الجيش التركي. انتقلت الماركيزة التي لم تعد ماركيزة إلى وسط أفريقيا. أما أولاد الشيخ العربي المغربي فاستوطنوا هناك في نفس الوقت. بشكل أو بآخر، تزوجت الماركيزة التي لم تعد ماركيزة من أحد أحفاد الشيخ المغربي، وتصاهر أبن المغاربة مع الترك. وحصل ما حصل. لقد تناسلوا بدون حساب؛ وحين ماتت الماركيزة في ذلك العام، كانت ابنتها قد بدأت رحلة الزواج لتنجب والدي. أما أختها فأنجبت والدتي. كانت رحلة غريبة تحتاج لمراجعات توثيقية صارمة. لكنها في الواقع لم تعد هامة، لا بالنسبة لأجدادي ولا بالنسبة لي. فيبدو أننا جميعاً قد توارثنا عدم إيماننا بالحدود السياسية والخصوصيات الثقافية. نحن في الواقع ولدنا بجين مناهض للشعبوية. إنني مُصر على هذه الكلمة لأنها عاطفية جداً، لصيقة بالأرض أكثر من التصاقها بالتأويل الميتافيزيقي.
في يوم ما سأرحل من هنا لأكون راعياً طيباً. يا للعنة الأمل.
وكان الراعي الطيب داخلي يتضاءل، إذ أنني في قلب الفقر الإفريقي؛ هنا حيث تعتاد الدسائسَ وأكل القدوقدو. نعم إن كنت لا تجيد الدسائس فستأكل القدوقدو، هذا إن كنت محظوظاً كفاية. ولذلك فإن ما حدث للماركيزة كان شيئاً طبيعياً، إذ تم إرهابها وطردها من ممتلكات زوجها، من منازله التي سكنوها بعد هروبها ببناتها الثلاث وابنها الوحيد. لقد قطعَت الفيافي، حتى حطت في مدينة أخرى تبعد مئات الكيلومترات، واستقرت لتعمل ماشطة لشعر من كُنَّ خدمها سابقاً.
أن تكون راعياً يعكس الرابط بين الحزن وموسيقى البلوز. في تلك المساحة يتوطن الرعاة الطيبون. ليس بالضرورة في انترلاكن، لأن هذه الأخيرة ليست سوى رمز أحياناً وقضية شخصية في غالب الأحيان بحيث ينضاف إلى كل شوق كتبتُ عنه. فمثلاً؛ كتبتُ عن ماريان كثيراً. ماريان الحب السحابي القديم الذي ينضاف إلى باقي الأوهام التي سقطت في هوة المنظومة الكونية الهزلية اللئيمة إلى جانب عزف الجيتار والغناء ورعي الخراف ذات الصوف المنفوش. وحوض السمك. حوض السمك هذا لا يمكن نسيانه إلا إذا كنتُ قد بلغت من القنوط مبلغاً، لأنه ظل حلم الشباب والكهولة، أما القطار الكهربائي فكان حلم الطفولة.
كانت الأزمة كلها تكمن في هوية لم تملكها الماركيزة ولا أنا. هوية مسحوقة في التاريخ. وكنا كتوأمين في زمنين مختلفين. لكنها كانت أكثر حباً للحياة ولذلك كانت أكثر مقاومة..
والأشياء ضبابية.. نعم إنها ضبابية، منذ أن ولدت وإلى اليوم.. إن الصور لا تكتمل أبداً، القصص -وهذا ما يجعلني أضحك حد التقيؤ- القصص لا تكتمل أبداً.. لم أر شيئاً حياً أو جامداً وقد اكتملت قصة انوجاده في الحياة.. إنها أغنية بلوز يمكن أن تسمعها لتومي كاسترو أو أي فنان آخر دون أن يحدث ذلك الكثير من الفرق، تماماً كما كانت البلوز لا تحدث فرقاً عند عبيد قصب السكر في الحقول المشمسة والمشبعة بالحشرات الطيارة الشقية. لا موسيقى البلوز ولا حتى تحريرهم. إنه لشيء يجعلني أنفجر من الضحك حقاً.
...
من المفترض أن ألتقي بالماركيزة في شبابها ونتحدث وبيننا برزخ شفاف. تحكي وأحكي. نعم هذا قد حدث بالفعل. وأنا مؤمن بذلك. إنني مؤمن بذلك لأن هناك قضايا يلوكها البشر منذ فجر التاريخ؛ لأن البشر –ويجب أن أكرر كلمة البشر مرة أخرى- يتماثلون داخل أنماط متنوعة ومع ذلك مكررة. ولهذا فإنهم يجترون ذات الأسئلة، أسئلة النفس وكأنها أسئلة جديدة في الكون. أنا متأكد أننا -أنا والماركيزة- حكينا لبعضنا البعض بلغة واحدة وبروحين مختلفتين في انكسارهما.
كانت تقول: العالم مقسوم منذ فجر التاريخ إلى أسياد وعبيد.. ولذلك سأظل ماركيزة حتى الموت فلا أملك ثقافة العبيد حتى وأنا أمشط شعرهن..
وكنت أرى من خلفها العالم يتنامى، الأبراج الشاهقة ترتفع من تحت الأرض، والصخور تتحول إلى سيارات، والسحب إلى طائرات، والهواء إلى بلورات وغير ذلك.. فأخبرها بأن الآن لا يوجد عبودية يضمن فيها العبد طعام يومه ومكان نومه.. إننا في عالم بلا أي ضمانات..
فتلمع عيناها العسليتان وتهفهف الريح خصلة صفراء من شعرها.. ثم تتبدد صورة الماركيزة كلها كقطع السحاب بعد هطول المطر.
نعم يجب أن أكرر كلمة البشر، وكلمة الماركيزة، وغير ذلك، لأن اللغة مصابة بعاهة الزمن؛ إنها مثلنا تحيا بلا أي ضمانات.
***
كما قلت، فليس من نهاية للقصص، لأن الرب فنان. وكما يقولون فإن الفن يُترك ولا يَكتمل. هكذا على الرسام أن يبعد فرشاته عن اللوحة في لحظة ما رغم أنه يستطيع الاستمرار في الرسم والإضافة، لكن الرابط الكوني سيمنعه من الاستمرار. الرابط الكوني الذي سيقول له بأن اكتمال القصص يعني انفصالها عن العالم، ويعني أنها ربما تتحول إلى إله هي نفسها أو أشخاصها أو أشيائها إن لم يكونوا بشراً. إن الفن كحديث العاشق لمعشوقته، إذ يجب أن تكون جمله غير مكتملة ليفتح لها مساحة للكلام، ليجعلها تتكلم وتتكلم، ويظل هو يتأمل وجهها من بين وسط غمام سيجارته. هكذا يتعايش الكون، بالنقص لا بالكمال، ليتمم بعضه بعضاً في شبكة معقدة من الترابطات غير القابلة للتعقب والحساب؛ فالربُّ لا يلعب النرد.
ولذلك؛ فوجئت هذا الصباح بشعور عام بالسلام النفسي، وهذا نادر جداً ولذلك أحتفي به بوجل. لأنني أخشى العواصف التي تلي الهدوء. على أي حال، فإن السلام النفسي يحدث مقاربة بيني وبين حلم الراعي الطيب؛ مقاربة نسبية. فهو يلقيني في أجواء انترلاكن على نحو ما. ولذلك يتوقف هذياني مع الذات. إنني أرى الأشياء تترتب. وفي الغالب تعمه الفوضى بعدها بسرعة.
قبل عام 1943 بعقود أحاطت جموع من المسلحين بالقصر، وقتلت الحاكم البريطاني العام، وتركت ابنتين للقائد تيران باشا، وعملت السلطنة العثمانية على انقاذهما لكن الماركيزة فضلت البقاء في وسط أفريقيا في حين هاجرت الأخرى إلى مصر. كانت الأولى صبية عشرينية جميلة، ذات شعر ذهبي وعينين عسليتين، وسيقان مكتنزة وظهر طويل، لذلك اختطفها الأغا الأفريقي على الفور، وتزوجها وأنجب منها. ثم حدث ما حدث بعد ذلك. كان السؤال الذي شغلني دائماً لماذا قبلت البقاء في قلب أفريقيا الفقير، ولماذا هاجر ولدا الشيخ الصوفي المنتمي للطريقة الشاذلية إلى قلب أفريقيا في حين أن العالم كله كان مفتوحاً أمامهما. كانت اسبانيا على مرمى حجر من المغرب. لكنههما فضلا البؤس الأفريقي. بدا لي ذلك هروباً ما، عزلة في انترلاكن الأفريقية، إذ أن انترلاكن هنا رمز كما قلت سابقاً، رمز قد يعني الجحيم دون أن يفقد رمزيته. إن الراعي الطيب ليس أكثر من مقاومة لعبثية التشوهات، مقاومة تأخذ في الغالب صور الهروب إلى الخارج أو الداخل، إلى الأدغال أو الصحاري أو البراري أو الحداثة أو البربرية. إنها شيء ما غريبٌ وشمولي، كمسطح المحايثة الدولوزي.
***
تقاسمت البراري الأفريقية وأشجار الصمغ العربي المساحات الشاسعة، التي يقطنها القليل من البشر الذين يسترزقون من أراضي الأغا عبر الزراعة الصغيرة وبيع القليل من الصمغ. وفي الجوانب الغربية تناثرت منازل الأغا، التي سكن أحدَها هو والماركيزة، وتناوب أبناء قبليته السكن في الأخرى على سبيل الرخصة. وتدفق الخير الوفير من اقطاعياته، والأراضي التي استأجرتها الحكومة البريطانية منه لمدد طويلة جداً لتنشئ فيها السينمات الصامتة والمحلات الترفيهية، وبعض الدواوين التي تحمي السجلات. كانت كل ثروته تنتج ريعاً ضخماً ما عدا الجبل الذي على مشارف المدينة. الجبل الذي كان يقف بشموخِ متسولٍ بملابس رثة وقبعة ممزقة، ناظراً إلى المجهول بثبات.
رغم كل ذلك عانت الماركيزة وبناتها وابنها من الفاقة والعوز بعد وفاته كما لو كانوا أبناء سفاح. وليس الطمع والفجاجة والتنمر فقط ما كان دافعاً لأهل الأغا لفعل ذلك – أي ضرب الماركيزة وتشريدها وسرقة أموال أولادها- بل كانت العنصرية أقوى تلك الأسباب، العنصرية المتخفية تحت القبيح الذي هو أقل قبحاً منها، فالشماعة التي يعلق عليها الإنسان جرائمه يجب أن تكون طاهرة وأخلاقية مهما كانت تلك الجرائم، إلا في العنصرية فإن كل تبريراتها تكون فاسدة وملوثة ولا أخلاقية، لأنها محاطة بالفزع.
وهكذا؛ وبعد أقل بقليل من مائة عام، تلقيت اتصالاً من أهالي الأغا يشكون فيها من احتلال قبيلة أخرى لأراضي جدي طالبين مني أن أتدخل، فسألتهم إن كانوا يفلحون تلك الأراضي ليجيبوا بالنفي، سألتهم إن كانت تلك القبيلة قد عمرت تلك الأراضي فأجابوني بالإيجاب؛ حينها قلت لهم: الأرض لمن يفلحها.
كانت تلك خاتمة ارتباطي بالتاريخ كما كنت أتصور، لأن نيتشه قال بأن الشيء الوحيد الذي يمكن تعريفه هو ما لا تاريخ له. وأردت أن أملك تعريفي الخاص.. "الراعي الطيب".
***
(2) السيارة رينو- أفق زمني متوتر:
السيارة رينو الفرنسية سيارة قديمة تشبه الفرنسيين. وتشبه أسلوب تفكيرهم، وهيجانهم الحماسي والكارثي أيضاً كما حدث لمُصَنِّعي تلك السيارة في فترة السبعينات والثمانينات فتعرضوا لخسائر فادحة تشبه ما لحق بالثورة الفرنسية تماماً. مع ذلك فقد مضت بكل هدوء وسكينة تقطع بنا الفيافي الأفريقية الحارة. كان الغسق مستلقٍ خلف الطريق الترابي المتعرج والممتد من قرية ساركيل ذات الأكواخ التي صُنعت سقوفها من القش المخروطي وحتى أمام الجبل وملتفاً بعدها إلى ما ورائه. الجبل الذي يقف كما –قلنا- كمتسول يحاول تجاهل نخسات كرامته العجوز.
يحاصرني أسد، فأهرب واستيقظ متضايقاً. وأرى سوقاً بدائياً تحت ظلال الأشجار يطل منه أشخاص متربو البشرة كالموتى، ولكنهم يصخبون كالأحياء. فأضع سماعة الأذن واستمع في قلب أفريقيا إلى "أنا فيدوفيتش" الكرواتية وهي تعزف مقطوعة استورياس الاسبانية. يبدو ذلك كاضطراب الهُوية الجنسية. ولكن ما الذي نعنيه بالهُوية؟ هذا سؤال كما قلت حسمه نيتشه معلناً زيفه. وهكذا يجب أن يتحلل الكون في كتلة واحدة وإن شُدت أطرافه في الزمكان. في المنتهى الذي بلا منتهى حيث لا تعريف.. أي السقوط في معضلة التاريخانية.
نتغلغل في السافنا الفقيرة، وتهرع بقع الأعشاب الصفراء نحونا، تتبعها أشجار شوكية شاحبة، وسقف أزرق بلا سحابة واحدة، فيغمرني حزن ما، حزن غير مُبرر، ربما لأن من صنع الرينو لم يكن ليتوقع أن تبلغ هذا المدى من الانفلات من نطاق المدنية والحداثة. هنا حيث يجب أن يعيد هبرماس فلسفته من جديد، ويحصل هايدجر على اثبات مختبري لكائنه الملقى هناك في العالم، ويغرق ابن عربي في وحدة الوجود الممحي داخل وحدته.. أليس ذلك كله مُحتوىً داخل الراعي الطيب؟ الراعي الطيب كفلسفة حياة أقل وأكثر عمقاً من كل تلك الفلسفات المتماهية مع العقل والعقلانية. تلك التي تنفي المجد عن العفوية، وعن الروح، منتقصة من التكامل للمعطيات الفيزيائية وغير الفيزيائية لما يسمى بالوجود. نعم ليست انترلاكن وحدها التي ترمز للراعي الطيب؛ ولكنها الأفضل دائماً من حيث إزاحة التأويل قليلاً من رسوخه، الجبل المتسول.
ولكن.. هل الراعي الطيب هو إنسان مسكويه؟ إنني أقول لا، وأؤجل التفاصيل لما بعد الرحلة. فهذه الرحلة تمنحني تأملات بوذية تستحق التضحية من أجلها. فمن بعد تلك الامتدادات في السافنا الفقيرة، سقطنا في الصحراء.. شاهدنا الإبل يقودها البدو بأسلحتهم، وشاهدنا الكثبان المتنهدة تقابل السماء المجدبة، وشاهدنا العظايا والثعالب الصحراوية، وحقول كريات روث خنافس الصحراء، والواحات، والنسوة الهزيلات البائسات وهن يبحثن عن الماء ويحملن فوق رؤوسهن القليل من الحطب، وحوصرنا أحياناً بجبال كلسية وردية اللون تتخللها أخاديد وكهوف انسيابية الحواف كلوحة سوريالية.. نعم كل ذلك بالرينو.. صدق أو لا تصدق.
***
إن مأساة مجتمعاتنا هذه ليست في فقرها بل كونها تقمع تحرك قلبك نحو الحب. فيجدر أن تهرب منها لتكون راعياً طيباً.. هكذا يفكر أكثر من فروا إلى أوروبا عبر زوارق الموت. غير أن هذا المفهوم الهلامي للراعي الطيب يصطدم بالمفاهيم الصلدة في مجتمعات الغرب.. في النظام الغربي القديم والأكثر صرامة وتحرراً في نفس الوقت. إنه نظام يقمع تحرك قلبك نحو الحب بدوره، ولكن كما تفعل الملاريا في الجسد. لأنه يتسلل بخفة من باطن قدميك، وحين يبلغ دماغك تكتشف أن انترلاكن ليست سوى أنت نفسك.. لأن الجنة حلم تاريخي للخائفين.
على أية حال؛ فإنني كلما سمعت وصفَ "غريب الأطوار" تذكرت نفسي، وهو وصف مخيف، عند غريبي الأطوار، لأنه يذكرهم بتشوهات عميقة داخل الكوكب الزجاجي الذي نضج كجنين في أعماقهم عبر سنوات أعمارهم. التشوهات التي تجعلهم يرون ضرورة أن يصبح العالم كله راعياً طيباً. وربما هذا كان بداية ما اختلقته الأسر المتمدينة في إيطاليا من دعم للفكر الحر والفنون والآداب، ليس فقط –كما يزعمون- من أجل مناهضة التقاليد الارستقراطية إيماناً باستحقاق البرجوازية الناهضة، ولكن لأن النظام العالمي الجديد الذي ستشكله المخرطة الماسونية خلال قرون سوف يوفر حماية جيدة لغريبي الأطوار أمثالي. نعم.. الحداثة مشروع لم يبدأ بعد.. ولن يكتمل أبداً؛ بل يجب ألا يكتمل أبداً. هذا ما أفكر فيه ومعي عشرات الآلاف من غريبي الأطوار. رغم ذلك فستظل الجنة حلم تاريخي، وللخائفين أيضاً.
وتمضي بنا الرينو في طرقٍ موحشة، وتصل إلى خضرة مستقطعة من المخيال العام الذي تحفزه المشاهد السابقة. خضرة أفريقية موحية بالعصر الجوراسي وأفلام الديناصورات. لكن لا توجد ديناصورات بل بشر، بشر سعداء جداً لأنهم لا يعرفون كلمة "المستقبل".
وتصيح المرأة لتبعد قطعان الثيران المقدسة التي تعبر الممر الرملي ببطء الآلهة. وبين كل مجموعة من الأبقار يظهر ولد شبه عارٍ يجلس فوق ظهر ثور أو يسير وسط القطيع، ويرتفع الغبار الكثيف، وأصوات أقدام الثيران فتحدث هزة خفيفة في الأرض. يطلق السائق صفيراً ليهدئ من روعه قليلاً، وهو صفير لم أكد أتبين انتماءه. كان شيئاً والسلام.
- لديها قرون أثقل من جسدها الهزيل.
يقطع صفيره ليدلي بهذه المعلومة المشوقة. إنها مشوقة حقاً ليس لأنها تضيف شيئاً، ولكن لأنها تفتح مجالاً للمسامرة حول هذا العالم الذي لم أشاهده إلا في القنوات الفضائية الوثائقية.
- كان من المفترض أن نسير في اتجاه الشرق، ولكن هناك حرب أهلية بين قبيلتين.
سألته عن السبب فلاك شفتيه وأجاب إجابة مقتضبة، كأنها مسألة طبيعية.
- يكرهون بعضهم.
وأدركت أن المسألة لا ترتبط بأسباب جوهرية، بل بعداء تاريخي أصبحت علته الأولى مجهولة الآن.
***
كيف تكوَّن الوجود الآني للمجتمعات. الوجود الذي يفتعل قطيعة مع الماضي، قطيعة جزئية. إنه يتم بالغزو وطرد الشعوب الأخرى التي تنزح وتنزح أو تتشتت وتتشتت. كانت قبيلة الأغا ضحية لذلك النمط التاريخي، حيث بدأت القبائل الأخرى تتسرب إلى حواف أرضهم، ثم تتمدد، ثم بدأت تقتل القليل ممن يحاولون الدخول إلى أراضيهم، ثم بعد ذلك بدأت تشن غارات حقيقية، أزهقت فيها أرواح الرجال والنساء والأطفال، ومن لم يمت فرَّ إلى الخارج، إلى الأقاليم المجاورة ليعيش فقيراً، أو إلى العاصمة ليعيش فقيراً وغريباً. كان ذلك انتقاماً جعلني استعيد إيماني بالعدالة السماوية. الإيمان الذي فقدته بعد معارك خاسرة كثيرة، ها أنا استرده بلا معارك مباشرة. وقد سمعت تلك الأخبار السارة وأنا داخل الرينو، حين بدأت الشبكة تضعف فانقطع الاتصال.
- ستسترد الانترنت عندما نصل إلى الفندق.
قال السائق، ومضى يقطع المعبر الرملي الذي يقسم الأحراش إلى نصفين.
كان الفندق ليس أكثر من بضعة غرف لا يحيط بها سور. لكنها مؤثثة أثاثاً لا بأس به. استقبلتنا فتاتان سوداوتان جميلتان. كانت إحداهما بلا شعر تقريباً، لكنها كانت بضة الجسد، تحتشد ثورة من الجنس في قسمات وجهها. أدركت أنها تملك ما لا تملكه أنثى أخرى، وأدرك السائق ما أفكر فيه فشعر بالغيرة حين تبادلنا أنا وهي نظرات حميمة أو فلنقل شبقة.
***
هنا حيث تحلو العزلة وليس في انترلاكن. لكن ما الذي يعنيه ذلك. يعني البقاء مع تريزا الصلعاء الجميلة، لإدارة النُّزل وبيع الكحول المستوردة للغربيين الذين يعملون في المنظمات الإنسانية الدولية التي توزع السلاح سراً على القبائل المتحاربة. يعني أن تصنع النبيذ من فاكهة الأدغال الأفريقية، وتدفن براميلها تحت الطين لتتعتق. يعني أن تربي بضع دجاجات، وتزرع القليل من السمسم الأحمر والورود الوحشية صباحاً وتأكل شفتي تريزا مساءً، وتستخدم الواقي الذكري كي لا تنجب. كانت تريزا أقل النساء تساؤلاً في العالم. لم ألتقِ بامرأة شديدة الرومانسية مثلها. إنها صامتة ولكن عينيها الواسعتين تثرثران كثيراً، تثرثران بالحب والجنس. ولم تكن تضحك بل تبتسم فقط. كانت تنظر إليَّ بهيام يخترق قلبي مباشرة، تحدق في عيني وتتأملهما، وتظل كذلك كملك الموت، كانت في الواقع تأكلني بنظراتها كما لو كنت أنا الأنثى وهي الذكر، وهذا شيء لم أعتده من قبل ولم أرغب في الاعتياد عليه، لأنه سيمنحني ثقة الأسود الطليقة في البرية. سيجعلني ألفظ حلم الراعي الطيب إلى الأبد، إذ ربما أتحرر من الرغبة في العزلة.
***
في شهر نوفمبر تمرض السماء فتداوي نفسها بالإمطار المستمر. تسقط حبات المطر الاستوائي كبالونات صغيرة، وتنفجر على كل مسطح. تنتشي الخضرة، الأعشاب البرية، الضفادع تحت الطين، تنظف الثعالب فروها، وتبتل جلود الفيلة الرمادية الجافة. يتوقف المولد الكهربائي عن العمل لانقطاع امدادات البنزين. وتنتشر الحشرات والبعوض في الفراغ. تزداد الحياة صعوبة، وتحتاج تريزا لمزيد من الوقت كي تتحرك من مكان إلى آخر ببطنها المنتفخ. غير أن أفضل ما يحدث هو أن القتال بين القبائل يتوقف حتى انجلاء الخريف.
وبعد عشرين عاماً ستردد تريزا على ابنها ما ظلت تردده عليه لسنوات: لقد استيقظت على آلام المخاض.. لكن أباك لم يكن موجوداً.. لقد هرب.. هرب الراعي الطيب ولم يعد أبداً..
***
نعم.. لم تكتمل قصة للإنسان، ومن السذاجة أن نجعلها نحن تكتمل. حتى بحيرات البط المصقولة بالصفو تظل حبيسة التعريف الناقص. ولذلك كان عليَّ أن أمشي إلى الأبد.. أن أمشي بعقلي نحو اللانهائية.. وعادت بنا الرينو إلى مكان مجهول آخر؛ وأنا لا أعرف اسم من يفترض أنه ابني. لكنه في النهاية سيكبر، سيحيا متألماً وهذا ما سيجعله إنساناً ومن ثم سيبحث لحياته عن معنى مُشتت في أفق الزمن المتوتر؛ ثم سيموت كما سيحدث لي.. لذلك لم أجد خطأً فيما فعلت بقدر ما اعتقدته صناعة لحدث فلسفي. ذلك أن الرتابة الكونية تجعلنا نحاول انتحال وظيفة الآلهة التي اكتفت ببناء المنظومة القانونية ثم نأت بنفسها عن كل شيء.
(3) العالم ما بعد المجتمعات
لازمني الخوف من السلطة. ولذلك ظللت خائفاً باستمرار؛ فالسلطة في كل مكان. وربما كان موقف فوكو، وربما كل الأناركيين من باكونيين وحتى أنا وباقي الشعوب المضطهدة بشكل مباشر أو خفي هو معاناتنا من هذه المتلازمة السلطوية. فهناك من يخدعنا ويجعلنا متأكدين بأنه يستحيل وجود دولة بلا سلطة. وقد تؤدي أغنية "تخيل" لجون لينون إلى تأكيد هذا الزعم لتجعل العالم اللا سلطوي عالماً أسطورياً. نعم لا عالم بلا سلطة –رغم أنني أؤكد أن هذه خدعة- ولذلك على هذه السلطة أن تظل محدودة جداً. هكذا يقول باستيا وغيره من الليبراليين. إنها دعوة طيبة من كل الحالمين بأن يكونوا رعاة طيبين.
لذلك حين التقيت بالسيد مغونو في حانة صغيرة ملقاة داخل زقاق صغير يدعى الحرية، كان ذلك نقطة تحول في تفكيري، إذ بث بقعة ضوء في وعيي تجاه احتمالية بناء مجتمع بلا سلطة بالاستفادة من التقنيات الحديثة. ورغم أن كلمة مجتمع نفسها تحيل إلى السلطة، لكن حديثه هذا جعلني أتخيل فكرة الفقاعات التقنية، التي سينتهي الإنسان بداخلها واعتياده على العزلة. الفقاعة الشاملة، التي تمثل دولة الفرد بعَلَمِها. وإذا تتبعنا كل منهج الماسونية العالمية اليوم فسنجدها تدفع ببطء نحو ذلك العالم، العالم ما بعد المجتمعات. كان السيد مغونو رجلاً أفريقياً أسوداً وطويل القامة، وأطرافه مليئة بالعروق والعصب كملاكم من الوزن المتوسط ولكنه كان كذلك ممتع الصحبة، غزير المعرفة لولا قصصه البائسة مع زوجته المتنمرة التي تحيل حياته إلى جحيم فيهرب من المنزل إلى حانة "الحقل المتميز" بزقاق الحرية، ليحتسي الشراب حتى يفقد السيطرة على حركته ثم يؤوب مترنحاً بقدميه ذاتا الساقين الطويلتين والنحيلتين بعد أن يحكي قصصاً مكررة عن لقاءاته برئيس زمبابوي أيام الشباب في إحدى الجامعات الأوروبية مؤكداً أنه كان مثلياً.
وبعد أن نخرج من الحانة؛ يترنح فاقداً السيطرة على لسانه. وهذا ما هددنا -باستمرار- بالتعرض للضرب.
- كم عمرك؟
- لا أعرف.
- يجب ألا تعرف..
ويمضي مغونو إلى أبعد من ذلك عبر أفكاره المتعالية على الواقع، ولكنها لا تشي بجنون بقدر ما تشي بعبقرية ما. وهي عبقرية قاصرة على ما هو خارج سلطته؛ أو ما يفترض أن يكون ضمن سلطته؛ أي منزله، وأسرته التي لا يملك أقل عبقرية لإدارتها. فابنته غادرت إلى نيجيريا لتلتحق ببوكو حرام، وقد عاد يوماً ليخبرني بأنها حُبلى. قالها بعينين جاحظتين ومحمرتين. وشرب بعدها أربعة كؤوس من الخمر البلدي القوي جداً والذي يُسمى "بوزو".
وفي تيكيتا، المدينة التي تطل على الجبال، وراسينيا وأوبالو وغيرها من مدن أفريقية متوحشة، بحيث لا يمكنك الخروج للمشي بعد هبوط الظلام، في كل تلك المدن الخطرة، كان مغونو يحاول الانتحار وهو يقود شاحنته لنقل البضائع متنقلاً من مكان إلى مكان لكي يهرب من واقعه، مرتحلاً في خيالات التأملات اليونانية العبثية وهو يمخر الطرق السريعة النائية. لقد أخبرته بأن ذلك لا يعد سوى محاولة لبلوغ درجة الراعي الطيب. وقد أدهشه هذا التعبير وفهمه بسرعة –دون أن أتوقع ذلك- لقد نظر إلى أفق مجهول وهمس:
- تخيل أن أفلاطون لم يحاول أبداً أن يفكر في جمهورية السلام. لقد كان عنصرياً وطبقياً وفجاً ومدعياً ونبياً مزيفاً. إن بوذا أفضل منه. أدركت حين قال ذلك بأن هذه الفكرة ستلتصق بعقله، وسيبدأ في التعمق فيها، ولكنني لم أتوقع أبداً أن يبيع شاحنته ويهجر أسرته ويهاجر إلى حيث مدارس التبت البوذية. لقد اختار الموت بعد أن سئم من الحياة كما فعلت ابنته تماماً. ولم أرَ في الموت "حقيقةً" يوماً ما؛ كانت الحياة هي الحقيقة الأصيلة. وهي الأجدر بأن ترتكز عليها الفلسفات وليس العكس. غير أن عالم المُثل الأفلاطوني –كما قال مغونو- قد خدع العالم وغيَّر مسارات الركض الفكري إن لم يكن قد شتته عن موطئ قدمه الحقيقي.
- تعبر شاحنتي الصحو ويخفق الهواء البارد فوق وجهي، تتمدد أشعة الشمس الزرقاء على حواف جسدي. وأشعر بأنني بوذي.. بل أنا.. بوذا نفسه (تشرق عيناه وتظهر تجاعيد وجهه حين تتهدل من القشعريرة). أهرب من ذاتي وأتحلل في الكون.. من ذا الذي يعطني إحساساً مثل هذا؟ هل تستطيع أنت؟
فانفي ذلك بصمتي المطبق. لأنني رأيته حينئذٍ جسداً ميتاً. وشعرت بسوء عظيم يجتاحني.
***
في بدايات الصباح، وأقول الصباح لأنني أعني ما بعد الفجر، أي في تلك اللحظة التي تتماس فيها أصابع الشمس بأصابع الزمهرير الرمادي، أسترجع حياتي، استرجعها وتبدو لي كذكريات شاحبة. أو كأنها حلم متعاقب فقط؛ وليست اللحظة الآنية إلا وعي مؤقت بالحضور والغياب. وأتذكر أيضاً ذلك الشاب الذي يحيا على أمل احتكار التفكُّر حتى أصيب بجنون العظمة الكذوب. ومن هنا كانت النتيجة العكسية هي أنني بت أحيا على تبسيط الأشياء بنفي الأصالة عنها. إنها أصيلة ولكن منقطعة تاريخياً، إنها أصيلة الآن فقط كزهرة تتفتح عند الفجر على حافة جُرفٍ نهري. والنهر بدوره يتجدد، بحيث لا يمكن أن ننزل فيه هو نفسه مرتين كما قال هيراقليطس. ومع ذلك فتظل هناك عقبة واحدة وهي عقم هذه الحياة. إنها عقيمة مهما حاولتَ إثراءها، أو فكرتَ في إثرائها. إذ أن الإثراء إن لم تُعرف ماهيته صادر نفسه ولم يعد إلا مفردة مجردة.
لقد سرق خادم المكتب قنينة تعطير الجو وأنكر معرفته بها، وكان من الممكن أن أتخذ إجراءات عقابية ضده، ولكنني فكرت في المسألة من ناحية أخرى أو لم أفكر فيها ولكن حدسي قادني لتجاهل السرقة. في الواقع هناك اختلاطات تقود الحدْس، وأنا أؤمن بالحدس. طار مغونو إلى التبت؛ ولا يمكننا أن نتجاهل حدسه هنا. الحدس الذي يتخذ القرارات، وهذا ما يفتقر إليه الذكاء الاصطناعي. الحدس والملاحظة كلمتان تحتاجان إلى عمق يتجاوز أطروحات بيرغسون. يحتاج إلى دراسة علمية بيولوجية أكثر من فلسفية؛ ففهم الحدس هو ما سيفضي لإحداث ثورة في عالم التكنولوجيا، وسيمنح العالم الرأسمالي أداة أخرى لجمع المال.
***
كان هناك هرج ومرج. الشوارع امتلأت بالجثث والقاذورات. وكانت هناك ملامح ثورة.
***
لقد فكرت في صيغة العقد. العقد كرابط لعلاقة بن شيئين. بينها وبيني. نحن الشيئان. الشيئان المزدهران بالحب وتورد الخدود. حتى لو كانت خارج حصني الهش تمارس الدعارة مع الرجال الآخرين. كان ذلك تسيباً مني على الأقل. كنت ابتلع الأيام ابتلاعاً. حتى أن كل شيء -حتى هي- يبدو ثانوياً. أن تبتلع الأيام. يوماً وراء يوم، وأنت محاصر بهزالة القدرات وحدود مؤسسة الجسد. لا يبدو العالم مفتوحاً أبداً. إنه يزيف انفتاحه بشكل أو بآخر. وتتراص السيناريوهات المخاتلة فوق بعضها البعض كما تتراص الأصوات الموسيقية لتمنح قطعة موسيقية تشير إلى معنى هائم في دخان السماء.
لا أحد خلفي
لا أحد أمامي
لا أحد ينتظرني
لا أنتظر أحداً
ولا حتى قاعدة نحوية.
***
ذلك الفتى المهيب
المهيب بصوته الرنان..
الذي ينحني وينعطف
يتلوى ويستقيم
يصدح بضباب الحقول في الصباح
بالشمس فاترة الضياء
وبالحب المنتصر في عمق الهزيمة
وكنت أبادله الوله بحياة لم أعشها..
بالهدف المفقود..
وقد قال في إحدى أغنياته أن الهدف من الحياة هو تجنب الموت.. وبدا لي ذلك عوداً على بدء.. لكنه حقيقي على نحو ما.. وكنت أرافقه لأفتح صفحة جديدة مع ذاتي. وإن كان ذلك مستحيل إلى حد كبير لكن لا ضير من المحاولة. فالناس ينتشون بهطول المطر. يملؤون الدنيا صياحاً في أعياد الاستقلال وهم لا زالوا عبيداً. وتتكاثر الأعشاب والورود حول المستنقعات الآسنة. وتبدو الحياة محاولات مزمنة للنجاة.
لذلك كان يجب أن ألتقي به. أن ألتقي بذلك الفتى لكي أتعلم منه، أتعلم منه كيف يكتب كلمات أغنياته، وكيف يلحن كلماته. وكيف يغنيها. كان يغني:
"العيش مجاز.. هذا هو السر"
وتذكرت قصائد نيرودا ومحمود درويش.
العيش مجاز، مقولة أشعرتني بالتفاؤل والتشاؤم في نفس الوقت.
قرأت الورقة، واتبعت العنوان بدقة، وعبرت الأزقة، ووجدت الرقم. ووجدت معه الباب مفتوحاً. ومجموعة من رجال الشرطة في الداخل ومعهم طبيب شرعي يحدقون في جثة الفتى المتدلية. فتراجعت بسرعة.
وفي مقهى فالنتينو التقيت بها.
"لم تنتظرينني أبداً"
وكعادتها كانت تدخن بعصبية.
"السوق نائم هذا الموسم"
سألتها:
- ألا يوجد زبائن؟
- لا..
- إنه موت عاصف..
قالت:
- أنت لا تصلح للحب.. أنت جبان
أطفأتْ سيجارتها بضغطات قاسية متعددة.
كانت السماء زرقاء تتناثر فيها الغمامات كالقطن وكأنها لوحة من لوحات عصر النهضة، فقلت:
- لقد حاولت أن أجد السبيل إلى العيش كراعٍ طيب.. ولا زلت أحاول.. المسألة لا تتعلق بالحب..
قالت وهي تغادر:
- فقط كن بلا رسالة وستحيا كراعٍ طيب..
***
في فيلم لروبرت دي نيرو، كان البطل – وهو شخص أخلاقي- يحيا حياة فراغ شامل، وقد فشل في إيجاد بديل ليفعله، شيء حقيقي، وحتى محاولته لبناء علاقة عاطفية مع إحدى الفتيات فشلت. لقد انتهى به الأمر إلى التفكير في القتل. وقد فعل ذلك. ولكنني ظللت أتساءل عن معنى كلمة "حقيقي". لقد بدا لي أن ما هو حقيقي هو ما يحدد هوية الإنسان الفرد. وما يحدد هويته، هو ما يحدد تميزه عن غيره من البشر. لقد حصل بطل الفيلم على بطولة غير متوقعة جراء قتله لمجموعة من القوادين وإنقاذ إحدى الفتيات وانتهى الفيلم بأن المرأة التي أحبها ولكنها هجرته حاولت العودة إليه، ولكنه لم يهتم، بل واصل حياته كسائق تاكسي، مكتفياً بتلك البطولة التي كانت بديلاً عن كل شيء بما في ذلك الحب القديم.
***
اليوم هو الرابع عشر من شهر نوفمبر، حيث لم تسقط الأمطار منذ وقت طويل. غير أن السماء تتهيأ لذلك. تتهيأ لتستقبل مظهراً من مظاهر العود الأبدي، حيث لا جديد منذ آلاف السنين.
الرعاة الطيبون في البراري يسرحون مع خرافهم، وأبقارهم. والدجاج يهرول نحو علفه في الحظائر، والبط يتلاعب ويتغنج في مشيته قرب جدران المنزل الخشبي الصغير، وهناك بحيرات تشبه الموسيقى الاسبانية الرومانسية، أما الأشجار فأخشابها قاسية ورحيمة كالحوارات الذكورية اللاتينية، متجمعة في مكان واحد كالقبائل الأفريقية الخائفة دائماً. والزمن يتدفق بسلاسة، بطعم اللافندر. وتغيب المدن الكبرى بضجيجها وألوانها وأضوائها وزحامها ومطاعمها الفاخرة، وكؤوس النبيذ المعتق، وعاهرات الليل.
إنه اليوم الرابع عشر من نوفمبر، اليوم الذي سطعت فيه الشمس ببرود الموتى، وبنعومة زغب الشقراوات وهمسهن.
إنه يوم يتمنى المرء ألا ينتهي أبداً وألا يقسو فيه القدر، إنه يوم لاعتزال البشر.. يوم يعبِّر بدون أدنى شك عن كيف تكون "راعياً طيباً".
لكنني رغم ذلك أرى وجهه يحدق فيَّ، ينتظر اللحظة المناسبة لينقض عليَّ، محاولاً تنغيص حياتي، إنه يتوتر بشدة، ويعتبرني عدواً له، ولكن هل هذا سيغير من الأمر شيئاً؟ لا أعلم. لقد عشت حياة فيها من القصص ما كفاني استجداء الدهشة في عيون الآخرين، هنا، حيث تصبح اللحظة دائرة مفرغة من الماضي والمستقبل، وبحيث أغرق فيها بالكامل منزهاً نفسي عن التوقعات. هنا؛ حيث تصبح تلك هوية مستلقية في عمق الذات.
البراري المُرّة. الشفق، والفجر، ومرور كلب لاهث تحت قدميَّ.
(4) المال مقابل الغناء
نوفمبر؛ الشهر المخنث، الذي يمتلك جهازين تناسليين؛ لذلك تنفعل فيه كل الأرض بتناقضاتها المختلفة، وتتطاحن فيه المناخات كآلهة الأوليمب. وهو الشهر الرومانسي والقاتم في السوداوية، وتعلق على أطرافه الأحلام والطموحات وجثث الأمنيات القديمة. في هذا الشهر ستعبر الشوارع والأزقة وتدخل إلى الملهى الليلي، لتلتقي بحب بارد يتدفأ بحرارة الجعة في الجوف، ومع ذلك ستظل خائفاً من شيء مجهول، كعادة الإنسان القلِق. وفي هذا الشهر تحديداً ستطرح ذلك السؤال الذي لا إجابة له: "ماذا أريد؟"، إنه سؤال غير مكتمل، إذ "ماذا أريد من ماذا؟" من الحياة؟ من الوجود، من المرأة التي رقصت وغادرت تاركة عطرها في المكان؟ ماذا أريد من الانهماك في العمل؟ ماذا أريد من اليقظة والنوم الروتينيين؟
لذلك في شهر نوفمبر يمكنك أن تدفع المال لتشاهدها وهي تغني. تلك الحلوى المصنوعة من الفراولة واللبن والفانيليا. فالهرمونات المتصارعة داخلك -ككل شيء في هذا الشهر- ستجعل تصرفاتك أقل عقلانية مما كنت عليه. وبمشاهدتها ستنزاح التساؤلات الناقصة، وتحيا في الفانتازيا الكلاسيكية كمدينة السحاب الأرستوفانيسية، ومذابح جلجامش، وغير ذلك من ذلك البكاء المرُّ على الواقع المقفر. سينتهي الماضي كله في شهر نوفمبر.. وهذا أهم شيء.
كانت تغني لبوني إم ككل مطرب مبتدئ يبدأ بمزاحمة الماضي عبر أحاسيسه غير المصقولة بعناية. عادت بنا إلى الثمانينيات، حيث كان العالم محصوراً داخل غيتو. وكان عليَّ أن ألتقي بها، وأن أنتزعها من بقية رجال العالم وأحصرها في الغيتو الخاص بي. كان ذلك يشبه حرب المخابرات. حرباً يُمارس فيها الحزق والسياسية والمعلومات وتحليل المعلومات ورسم المربعات والمثلثات والدوائر وعمل حسابات دقيقة لكل خطوة بكافة المعادلات الرياضية. وكان ذلك هو المدخل إلى بهوها. قلت لها ذلك، فأظهرت دهشة لعوباً وقالت: "لم أكن أعرف أنني خطِرة إلى هذه الدرجة". وكانت تلك إجابة جيدة. ففي شهر نوفمبر تتخلص من وهم أن تكون "راعياً طيباً".
***
- ماذا تعمل؟
كان ذلك سؤالاً محرجاً، لأن كلمة "كاتب" ليست مقنعة إلى حد كبير، مهنة كاتب غير مقنعة حتى بالنسبة لي؛ إنها تشبه أفريقيا حين تحيا فيها الماركيزة. ولما حرت جواباً قالت:
- يبدو أنك عاطل؟
قلت: ليس تماماً فأنا كاتب؟
قالت وعيناها تشعان: لديك كتب؟
قلت: كتابان أو ثلاثة..
قالت: روايات؟
قلت: ليس تماماً..
ثم أضفت بعد أن شعرت بضيقها:
- إنها نصوص فقط.. إذ أن عهد التجنيس قد انتهى.. النص فقط.. لكن دعينا من كتبي التافهة.. هل تؤمنين بوجود إله؟
قالت بثقة: بالتأكيد؟
ولما ران صمتي سألتني كما توقعت:
- يبدو أنك لا تؤمن بوجود إله؟
قلت: كنت.. ولكنني أعدت النظر في الأمر منذ أن شاهدتك على المسرح إذ لا يمكن أن تكون هاتان العينان الجميلتان قد خلقتهما الصدفة.
قالت: تحسن الغزل..
وتبخرت الكواليس، واندمج ديكور غرفة المطربين في بعضه البعض.. كان لا بد من خطوة أكبر لتجاوز خسارة العمر.. خطوة شقية..
***
في العشرين من نوفمبر، اليوم المنحوس، ليس فقط لأن آنيا اعتذرت عن إحياء الحفل الغنائي واختفت تماماً، ولكن لأسباب أخرى عديدة، لقد تورطت شخصياً في العمل، معنى تورطت في العمل غريب؛ إذ يعني أنني بت أشعر بأنني تورطت في ضياع حياتي في العمل، العمل تحول إلى عبودية، حيث يجب أن أعمل لكي أحصل كل شهر على راتب. لكنني تأملت الحياة من حولي، وتأملت الفرص، في الواقع لا توجد فرص. لا توجد فرص البتة للفرار. وقال مغونو أننا في النظام العالمي الجديد لن نعمل، "سيأتون إليك بطعامك شرابك كالكلب.. سيتم تعليفك إلى آخر يوم في حياتك". ورأيت الأبقار حينها في خيالي، الأبقار التي ترعى وترعى قبل الذبح. ولكن أين الله من كل هذا يا مغونو؟ نظر نحوي كما لو كان ينظر لجريمة قتل ثم انفجر ضاحكاً.
- إنني أتألم يا مغونو؟
- شيء عادي..
أجابني دون أي رغبة في استفزازي، والأشخاص إما يختفون أو أختفي منهم، لكن الوضع بات لا يطاق. ولكنني رغم كل شيء لن أسعى وراء بوذا.
قال بأنني سأسعى وراء بوذا، لأن تعاطي هذه المخدرات هو الحل الوحيد لتجاهل حقيقة الواقع. قلت له بأنني استرجع كل كلامه باستمرار، حتى بعد اختفائه، فالحوارات بيننا لم تتوقف. فأخبرني بأن معركة دارت بين الجيش الصيني ومجموعة من الكهنة، وقد قتل سبعة منهم واختفى عشرون آخرون، وبقي هو وحده في المدرسة. ولما لم أفهم المغزى ضَحِك. كان هناك رابط شفاف، هو يراه وهذا جزء من طبيعته. أما أناْ فلا.
وفي اليوم التالي بعت كل ما أملك، بعت الثلاجة والبوتاجاز، والدواليب وحتى ملابسي الداخلية، والسيارة القديمة، والأحذية المستعملة، والفرن، والمايكرويف، وكل شيء. ثم جمعت المال كله وربطته في حزمة واحدة قبل أن ألفه بصحيفة، وبدأت البحث عن آنيا.
***
ايزاك ألبينيز يحدد لنا ملامح الصباح، الكآبة المشرقة، توهج الحزن في الدروب المغسولة بماء المطر، الأتربة التي تتنفس عندما تَرشُد طيناً. والغمامات التي تحتوي القلوب وهي عالقة بين السماء والأرض. والنجمة الأخيرة التي تقاوم جحافل الشمس باستبسال. وهذا الانغماس المرير في اللا معنى الذي يتعاقب مقيداً ظهره إلى الشمس والقمر. وهذا الانحطاط الكلي في الغمر والشتات لا يبرح منطقة التمرد على الإنوجاد القسري. وهو تمرد مهزوم قبل أن يعلن عن نفسه، إنه خجل حتى من الإعلان عن نفسه.
ولكن حتى لا يكون النص سيرة ذاتية، فيجب الغلو في التخييل، كما يرى جيرار جينيت، وزملائه في التنظير للنصوص المغلقة على نفسها كعذراء، والواقع أن النص يجب أن يكون قرباناً يلقى في النهر كي يغرق ويتبعثر مندمجاً مع كل مُركَّب ماء. وهنا يموت ليحيا في كل شيء. فليست آنيا إلا معنىً متوقعاً، يصبح البحث عنه إثارة بالغة، نشاطاً كثيفاً للروح، وارتفاعاً للأدرينالين.
وأيا كان السبب فقد كانت آنيا تهرب من الحب باستمرار. وكنت أهرب منه باستمرار، لأن كلينا كنا نراه قيداً على الحرية. لكن الحرية نفسها ليست سوى فرار يقفو المعنى. وقد نلمح في الحب معنى، وقد يخدعنا ذلك المظهر الثاوي في باطن المجهول، لنتبين بأن الحب ليس معنى ولا أي شيء سوى انجذاب أعمى يحفزه جوعٌ للمغامرات التي تأخذ حيزاً أكبر من حجمها في تصوراتنا. وهكذا كان الأمر بيني وبين آنيا.
- إنها المرة الأولى التي أقاوم فيها الكسل.
- بالبحث عني؟
- نعم.. كنت دائماً أهرب من الحب
- هل تحبني؟
كانت آنيا مباشِرة جداً، وكان ذلك يدفعني للتأمل، لذلك صَمَتُّ.
والتقينا في القديس أونلياز، تحت جسر صغير شُيِّد بعد الحرب والانفتاح على النظام العالمي الجديد. كان كل شيء قد اختلف بالفعل وعمَّق الغربة في أرواحنا؛ نحن مواليد العهد القديم. لقد ارتدينا البدل وربطات العنق وغزونا ريادة الأعمال ولكن بروح الفقراء.
وحكت آنيا عن عشاقها السابقين والحاليين، ربما لتمنحني خيار الرحيل المبكر، وربما بكل براءة، فلا تستطيع اكتشاف أهداف النساء بسهولة. فوضعت أمامها المال:
- هذا كل ما أملك..
- لأي شيء؟
- لتكوني لي.. ولو ليوم واحد..
كان ذلك مذلاً لها، ولكنني لم أتوقع أن تمد يدها وتسحب المال وتجرني إلى غرفة الممثلين.
وخسرت كل ما أملك لليلة سحرية واحدة. وهي الليلة التي ستشكل ذاكرة للمستقبل، وما الحياة إلا ذاكرة مما مضى وانقضى.
باختصار؛ كان ذلك يناسبها ويناسبني تماماً كهاربين من الحب.
ويقول مغونو بشفافيته المعهودة:
- إن شخصياتك سحابية.. بما فيهم أنت..
قلت:
- وبما فيهم أنت.. ذلك أن هذه هي الحقيقة التي ترد على سائر حيوات البشر.
ثم عبر ببصره محيطات من التأمل وهو يقول:
- وما نهاية هذا النص؟
- كما هو معتاد.. مصائر غير مكتملة..
- لقد انتهت هذه النوعية من الأسئلة القديمة.. لقد اقتنع البشر بواقعهم وتعاملوا معه بشكل جيد.. وهذا أسلوب صحي..
- نحن الأجيال القديمة التي تطرفت في دفاعها عن عقلها..
- ثم انهزمت..
ولاحت صورة تريزا واختلطت بصورة الماركيزة ثم بصورة آنيا.
***
من ذا الذي يفهم النص؟ غير أن السؤال الحقيقي هو: من ذا الذي يستطيع كتابة النص ليُفهم؟ النص المثالي، المكتمل، والمحكم؟
لا أحد
كان من المفترض أن يكون ذلك هو السؤال؟ وليس فهم النص ولا تأويله، ولا دور القارئ في خلق النص؛ ذلك أن أسئلة ما بعد النص ليست سوى خزعبلات.
ولقد تناهى الفشل كله في لحظة واحدة.. في صباح ما، بحيث جرد النص من كل معانيه، وأطلقه في أفق الآلام الشعثة والوسوسة الداخلية التي تُبئِّر الأزمنة والحقب في حضور الكينونة الكئيب.
لم تكن ليلة سحرية، وكان عليَّ أن أعترف بالخسارة.
لم تكن سحرية أبداً..
كانت أقل من عادية، مع ذلك فإن الأموال التي أنفقتها لم تك تمثل خسارة؛ إذ أن التجربة تعتبر مكسباً دائماً. التجربة هي أعظم ما يُلحقنا باللحظة ويثبت فعاليتنا الآنية. التجربة ضد الموت باستمرار، مقاوِمة باستمرار، مشبعة بأمل ما. إذاً؛ فالتجربة حياة.
أقول بأنها لم تكن سحرية، لقد عادت آنيا لتكون امرأة عادية لا تختلف كثيراً عن باقي البشر وليس عن النساء فحسب. يسقط الرجل بالكلام، وتسقط المرأة بالتذوق.
***
سأعود دائماً لأتجاهل الليالي، لأتجاهل الأمسيات، لأتجاهل الظلام. ولأبدأ من الصباح، وأنتهي من الصباح.
***
هل تشعر بالعبثية؟
نعم وبشدة..
إنها حالة نفسية وليست عقلية.. أليست كذلك؟
في الغالب..
موت بطيء؟
بل حياة مُرَّة
وينحني مكباً على وجهه وهو يدوِّن كلماتٍ ما على دفتر صغير. فأدور ببصري على زوايا مكتب عيادته، مجرد صندوق مدهون باللون الزيتي الكئيب. وطاولة صدئة، ومقعد، وستارة جانبية تغطي شيئاً ما، لا يوجد ما يغري بالفضول لمشاهدته. أما هو ففي العقد السادس، له نظارة ذات عدسات غليظة في منتصفها دائرة أصغر، تظهر حدقة العينين بحجم أكبر. وعلى جابني رأسه شعيرات ساقطة إلى الخلف. يرتدي تي شيرت طويل العنق وجاكيت بنيين. كان يشبه صمويل بيكيت إلى حد ما أو قناص روسي أو أيهما الأكثر قساوة. كان ذلك يمنحني ثقة غامضة في حكمه على الأشياء.
ما الذي يبقيك حياً؟
ولما رفعت رأسي لأفهم السؤال؛ أضاف بسرعة:
لماذا لم تنتحر؟
شعرت بالضيق وأجبته بهمهمات متلعثمة:
لا أريد الانتحار..
فجأة أخرج مسدساً من درج مكتبه ثم وضعه تحت ذقنه وأطلق النار.
تجمدت قليلاً في مكاني، ثم بدأت أقهقه..
قلت بأنفاس لاهثة برافو برافو
كان ذلك أفضل عرض مسرحي أشاهده في حياتي.. أفضل عرض.. أقسم على ذلك..
***
والرجل العجوز يرتدي المعطف الثخين، معطفٌ من الصوف القديم ذو الياقة العالية والذي يشبه معطف الجنرالات الروس. يستيقظ قبل الفجر بدقائق، إذ أن العجائز لا ينامون كثيراً. ومع ذلك فهم لا يحكون أحلامهم، ربما لأنهم فقدوا الاستمتاع بالحكي، أو ربما لأنهم يخجلون من ماضيهم، أو ربما لأنهم باتوا لا يأبهون بالتكرار الممل؛ والأقرب إلى الحقيقة هو أنهم لا يكترثون. يجلس الرجل أمام باب منزله وبين أصابع يده اليمنى سيجارة وعلى اليسرى كوب شاي. ثم ينظر إلى اللا شيء سارحاً مع تأملاته التي لا يمكننا أن نعرفها؛ إذ يصبح الكون كله كوميدياً. فهو يستيقظ ويتناول عشرين قرص دواء، إنه لا يعرف ماذا تُعالج هذه الأدوية ولا أسماءَها، ولم يعد يهتم بقراءة التعليمات الطبية، إنها تسعة عشر قرصاً في الواقع؛ لقد بات ينسى كثيراً. الكون الكوميدي، الذي يلهو بالأدمغة البشرية؛ والذي كان في أيام الشباب يتجنبه، بات اليوم جزِلاً بحضوره فيه. وقد سأله الفتى حفيد زميله في العمل الذي توفى قبل سنتين فقط، سأله إن كان يصدق إذا ما كانت الأرض مستديرة كما تقول ناسا أم أنها تكذب؟. فضحك بفمه الخالي من الأسنان. ضحك بشدة. ثم أجاب: المهم ألا نسقط منها. حار الفتى من جواب العجوز ومضى في حال سبيله.
لم تكن هناك طرق بل أزقة بين الأكواخ البائسة. أزقة خاملة في الطين والقذارة. وسيقان الأطفال السود تلمع بفضل اللعب في المياه القذرة. وهم في الواقع لا يذهبون إلى المدرسة لأن وظائفهم جاهزة: النشل في مرحلة التدريب الأولى، ثم السرقة، ثم القتل، ثم رئاسة الجمهورية في مرحلة الاحتراف.
ينظر العجوز إليهم، ولا يراهم، فقد أضحوا جزءً من المشهد، جزءً من الأكواخ والأزقة المتعفنة، السماء والسحب الرمادية، والأشجار الكسولة. كان الألم قد تبدد، ذلك الذي كان متجذراً في عمقه، وكان الحذَر أيضاً قد تبدد، وتبدد مع الماضي برمته، بكل قصصه الشاحبة غير المكتملة، تبدد كل شيء... ولكن لا شيء مُهم.. لا شيء مُهم.. فقد أضحى اليوم راعياً طيباً.. راعياً بلا خِراف.
(تمت)