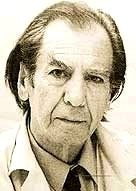1
فى صحوات النفس أنسى كل شئ عنها ولا يبقى لى منها إلا ما يبقى للمغتسل فى بحر ضاحك من أمل تهب عليه زوابع الحياة فتذويه حتى قطرات الذكرى تفر وتشرد، وحين تأخذنى تلك النوبة التى تعتاد أصحاب الفن، تطيف بى حواشى الذكرى، وما آلمها وتهبط على من مناحى عقلى شوائب سوداء تحيل النفس إلى فن خالص لا غش فيه ولا حيوانية فترتاد النفس أقطاب الحياة.. وما بعد الحياة! فنكون مزاجا من فن باكٍ كئيب ومن فلسفات هى للفن أيضا وللحياة، وماذا فى الفن والحياة، حب وبكاء، وشئ من اللذة .. لعلها باكية أيضا.. وأما تلك الضحكات التى تخترق الصموت الواجم وذلك التعابث وذاك الهذر فما هو من الحياة.
حين تساورنى أطياف الذكرى تموج برأسى أشياء هى من الحياة.. أعنى سادرة باكية ، وفى تلك الشملة التى تلفنى كأنها رداء الأزل تهزنى ذكريات أخرى.. ولكنها ليست من الحياة، ذكريات هى تضحك أو تكاد، فتضحكنى معها، فتنتهبنى الحياة وما هو ليس من الحياة، ولكن تلك البارقة التى تشع فى جنوب النفس تبدد ظلمة الصدر، فأعود بفضلها هى أمرح الناس.
كان لى من الأنامل ما لزوزو الصغير أو لميمى الصغيرة.. (وسكينا) فى استرخاء، أو أنوثة إن شئت.. وأما هى فقد كانت، لا أدرى ما هى الأن، غادة لا أنضح منها، وكيف كنت أفهم النضوح فى هذه السن، ما كان بيننا لم يكن ما بين الولد وأمه.. كان يغرينى منها أشياء، وأنا مرهف الإحساس لكل نأتئ منها أو غائر.
كانت تأتى فتلقينى راقدا فى شرودى فتلقى على نظرة لا أفهمها، لعلها تهتف، انت صغير، أنت صغير.. أما أنا فكنت استنيم إلى خيال لذيد.. أه لو فهمت ما برأسى.. تعالى إلىّ ، هنا ، هنا إلى جانبى ، تعالى أدفن نفسى بين أطوالك، أه ثديك هذا يغيظنى ، لو كان لى .. لى وحدى، ثم تسرى ببدنى سعادة سيالة فأتمطى وأقوم وقد نفضت عنى كل شئ، حتى تلك الصورة الناضجة
وتنادينى فأقبل نحوها فى هجمة وتعاودنى حمى الرقاد فأصرخ فى نار
– أين أقبلك
فيقول والدى فى يدها
وتقول أختى فى جبينها
ويقول أخى مداعبا بل فى شفتيها”
أما أنا فيهزنى شئ، لا أدرى ماذا، أندفع إلى ناحية وأطبع على ثديها قبلة كلها نار فتتراجع فى غنج.
– اختش يا واد
أما والدتى فقد كانت تكسوها زرقة باهتة حتى يخيل إلىّ أنها تخرج من قبر! لا أدرى لماذا. هل يفعت حتى يغضبها هذا؟ أما اخى فكانت تأخذه هزة لعلها عنيفة ، ماذا؟ ألم أجد سوى الثدى أطبع عليه قبلتى، ما أفسح جسمها، هناك العنق، هناك الشعر، هناك اليد، هناك الفم، وهناك الخدان لمن يشاء! وتنصرم سويعات تنصرم معها أمال ، تبلى كأوراق الخريف.
كانت تأتى فتلقينى منكفئا على فراشى تطيف بعقلى الذى لا يفكر، إرادات يرسلها ذلك السيال الذى يطوف ببدنى فيورثه اللذة الخالدة، كانت تنادينى ولكن لا كما تنادى أخى، كانت تضم شفتيها فى استدقاق وترسل من بينهما صوتا مستطيلا، لا أدرى ماذا تعنى بذلك، لعلها كانت تحاكينى حين أنادى كلبتى “فيبى” . إذاً أنا كلب! ثم هى ذى تنادينى باسمى مرة أخرى ، اثنتين ، ثلاثا، وانا مازلت منكفئا على فراشى فى حرارة كلها لذة! أنت ، أنت تناديننى؟ تعالى هنا فى هذا الفراش الصغير فإنه يكفينا ، تعالى هنا، أرتوى منك وترتوين منى، أوه منك هذا الشباب يجرى ويتدافع ، كلى حرارة واحتراق وقد تبدر منى صيحات فى زيغ العقل وأنا منكفئ فى لذتى أكاد لا أبصر، وقد تنطلق كلمة تصبغ منها الوجنتين وتعيد تلك الزرقة الباهتة إلى والدتى ، وتلك الهزة التى أحسبها عنيفة إلى أخى .
كانت تأتى فتلقينى مستلقيا فى تأملى المحدود فأنفض عنى حتى ذلك الغبار وأقفز، لا إليها بل إلى خصرها!، ما كان أعذبه، لو كان لى وحدى، وتجلس ثم تجلسنى على ركبتيها ثم تقول فى غنجها.
– ماذا يعجبك فىّ
فأصمت ، فتهزنى لا أدرى فى عنف وتهديد
– ألا يعجبك هذا الشعر؟
فأصمت.
– ولا هاتان العينان.
فأصمت.
– ولا هذا الفم.
فأصمت
– إذاً ما يعجبك فى؟
فتأخذنى حمى ولهيب لعله كلهيب الشباب وتسرى فى بدنى تلك اللذة الهازة فأنتفض.
– هذا الثدى. آه . لو كان لى . لى وحدى، و تحتثنى إليها حمى، فأنقض على ثديها ألصق به جسدى، فتحتجزنى غلالة كأوراق الورد، فانكص كالمخبول وأقف فى شدهة ذاهلة، منعطفا نحو ثديها تراودنى شتى الأحاسيس، وإذا بهمسة واجفة ” خذه” هو لك، لك وحدك، فينبجس من الأعماق هاتف يائس “نعم ولكن ماذا أصنع به”
2
كنت إذ ذاك جميلا لا كما أنا الأن، كانت تعلونى نعومة كاسية وطراوة تكسب الجسد تلك النضارة الفائضة، فكان وجهى يطالع من يطالعه فى إشراف وإشراق كأنه صفحة خالصة من بهاء، كنت استعرض نفسى فى المرآة، كما كانت تفعل تاييس، وأرفع منى الذراعين ثم أخفضهما أو أشيح بجانب منى إشاحة المستكبر أو اطأطئ منى الرأس فى خفر المستورة فضحها الزمان أو اصطنع نظرة من نظرات العابد الجاثى لربة فاجرة، أما شعرى فقد كان كدجوج الليل يتراخى ويتهدل، ما كان احلاه حين كانت ترف عليه النسمة فيبدو كأنه حلم طائرا.
كنت أغمض منى العين وأرخى منى الرأس على جانب من جوانب الكتف ثم اخلع عنى عذار الحياة، فإذا نحن فى جنة ورقاء الصور يحوطنا لحن تبعثه أطياف ما بعد الحياة، وسلسال من النغم تزجيه خالصا أفواه وعيون وقلوب خرساء لا تنطق ولا ترى ولا تعى، ولكنه ملكوت السحر العجيب وهى بروحها الخاتلة وجسدها الحامى راقدة لا على ظهرها بل على جانبها فى أثير المكان.
وأنا بهذا الوجه عينه، هذا الوجه الطافر والمشرئب وهذا الفم عينه، هذا الفم الذى ما خامرته بسمة ساخرة، وهذا الجبين المضئ تلفه تلك الكومة من ذلك الشعر، وأخيرا هذا القلب عينه، هذا القلب المدفون الذى ماجت به شتى الإرادات وطافت به شتى الأحاسيس والشهوات الماردة، كنت بهذا كله أتمدد لا إلى جانبها بل فيها، تحتوينى أعطافها، فمى إلى خدها ، وصدرى إلى ثدييها، تطوينى فى شملتها وتناد على ثم تتأطر، ثم تقبض بأناملها الهشة على شفتى وتدعونى أن أهتصر وتطالعنى بصفحة طاهرة، بكم تبيعنى هذه الشفة.. فأضحك فى سرى ما أحمقها، لتأخذ ما تشاء، فشفة واحدة لا تُقبل، ولكنى أعود فأتزن ثم يعلونى مبسم الهازئ وأهوى على شفتيها بقبلة متقطعة وأصرخ بهذا الفم كله.. فترتد كالميئوس وتكاد تطفر العبرة من مدمعها، ما أهون الثمن إلى.. ثم يعود إليها دمها الشارد وتعود إليها النضرة وتزدهى ثم تقبض على خصلة حماء من ذؤاباتى المتهدلة، وتدنى فمها من أذنى وتهتف فى إسرار وبكم تبيعنى هذه الغديرة.. فيعود إلىّ شعورى الهازئ وأنقض على رأسها الصغير فأغمر منه المفرق بفيض من قبل متهالكة وأتناول أذنها بهذا الشعر كله فتطوى عنى طلعة مكفهرة وتنحل غدائرها على منكبى وتهب لفحة من الريح ثم تسكن، أما هى فتهز رأسها، كأنما تنفض عنها ذلك الشعور القانط، ولا ألبث أن أبصر على شفتيها ابتسامة فيها خبث وزيف، وفى عينيها التماعات عجيبة كأنما اهتدت إلى سرالحياة ، ثم تأخذها ارتعاشة عنيفة ويرتد منها الجسد، وتهتف فى حشرجة غانجة، وقد كشفت عن ثديها، وهذا الثدى بكم تشتريه، أما انا فأتحسس موضع الثدى منى فلا أجده، وينتابنى ما اعتاد أن ينتابنى وتعاودنى حماى فتسرى ببدنى انتفاضة كانتفاضة الموت.. وأصرخ بالحياة.
وتهب لفحة أخرى من الريح هى أعتى، أفتح منى العين وأُقوّم منى وألبس دثار الحياة، فإذا نحن، بل أنا وحدى، منكفئ إلى كتابى الملعون، وهى قد طارت منى.. ولكن لا إلى الأبد بل فرت من مروج الأحلام المخصبة التى فيها حيينا بل حييت وحدى آمادا.
كانت تأتى فى خلوات من البيت وتخلع عنها كل شئ إلا سترا هو للحياء المحتضر، وكانت تراودنى الظنون أنها كانت تعنى ذلك، وماذا كان بينى وبينها حتى كانت تعنيه؟ بضع التفاتات واهتصارات وضغطات، لعلها كانت برئية أو لثمات تتراوح بين الثديين لا تعدوهما أو ارتعاشات متبادلة كأنما يبعثها سيال لا يبارح أو قبلات خرساء بين فمى المشتهى وثناياها العذاب أو دفئات لجسدى الناعم بين مطاوى جسدها الناعم مما كان يرسل فى بدنها غير الطهر. وهل – بعد كل هذا شئ، فقد كان هذا كل الحياة، ولم تكن الحياة إلا هذا. كانت ترقد وتنادينى فأندفع نحوها ولكن فى برود عجيب ليتها لم تخلع وتخامرنى ثورة طاحنة بين التقاليد والاشتهاء، ولكن ليكن ما تريد الشهوة، وأنام إلى جانبها أو استنيم وتمضى هنيئة أو التصاقة متهالكة يتدافع فيها الدم الحامى. ولكنها لا تلبث أن تغمرنى بنظرة ميئوسة لو كنت كبيرا ثم تلقينى كأننى خرقة بالية وتتخاذل منى الجوارح! كأنها تغترف.
وتشب بين أعطافى ثورة أجرف وأعتى وتنتابنى حسرات القانط فأغمض منى العين فى لهفة وأرسلها زفرة خائرة، ثم أفتح عينى فلا أراها إلى جانبى ، لقد فرت منى إلى من يشبع منها الإحساس والعقل والعاطفة، لعلها فرت إلى أخى فهو فى ذلك أكفأ منى، ثم تعرونى نوبة ساخرة صامتة: لن تجده، لن تجده، ستعود إلى – ثم لا ألبث أن أراها وافدة تعض شفتيها وأشملها بنظرة قاسية منتقمة، فتجيب فى نظرة مستغفرة: لو كنت كبيرا، فيتراخى منى كل عطف وجارحة ويغفينى ستران من يأس ورجاء .
وبعد ذلك لا أذكرها إلا فى ليلتين، ليلة قمراء زاهية الكون حافلة بالذكرى، تلاشت فيها أشباح ما بعد الحياة وبددتها خيوط هزيلة وانية يرسلها قمر أبتر غير كالح، ولكنها كموجات السحر مبثوثة تبعث حولها طرفا من أطراف الأبد وتكشف ناحية من حقاقيه، وهى متكئة على ظهرها لا راقدة فى شرفة البيت تكسوها تلك الموجات فتغمرها بلون القمر ويتبدد ذلك اللون الخمرى الرقيق من خديها ولا يبقى لها سوى صفحة رائعة من فضة القمر، فتبدو كأنها مُلكٌ به كل شئ حتى الطهر وإن كانت غير ذلك. وكأنها طرحت عنها ثوب العالم وكأنها فى يوم غير أيام الدنيا الفاجرة، وأما عيناها فقد تكسوهما ظلال شافة وأنية فتتبديان كأنهما ظلمة تخامر النور أو جريمة لوثاء تمازج الطهر.
وأما أنا بطلعتى المفكهرة عينها فقد كنت آجثو على قدميها فى صورة المستغفر من جريمة الحياة تحوطنى أجواء الغفران والتكفير بتضحية الموت. موت النفس لا موت الجسد. وهى فى موقف الغافر النادم. لا لغفرانه بل لتوبتى، هى لا تريدنى فى صورة النقى الصفحة، بل تريد منى صورة الفاجر الباذل. كل شئ لإحساسى وإحساسها، وكذا كنت أريدها ، لست أطيق أن اراها فى هذا الثوب طاهرة مغتسلة بالتوبة، بل أريدها للمتعة والشهوة، فلتكن هى بغياً، ولأكن أنا فاجراً.
وأما ليلتها الثانية، وهى آخر ما لها عندى فقد كانت ليلة ضريرة النجم ساقطة النواحى، تتراقص فيها أطياف الأزل والأبد وأشباح الحياة وما بعد الحياة وأرواح الليل والنهار على موسيقى حاكتها الطبيعة لنا وحدنا ولهذا اليوم وحده لا لغيره، بل ولتلك الساعة وحدها لا لغيرها.
هى تحتى تردد أنشودة الغرام الفاسق وكل ما فيها يلتهب. عيناها تلتمعان التماعات الشهوة الزائغة وشفتاها تنضحان جمرا وثدياها فائران كأنهما أتون شائط يرسلان فى بدنها أفاريق اللذة المتهالكة. أنا افترشها كما أفترش الآن البغايا وأعتصرها بين ذراعى الراعشتين وأكاد أتخلع شهوة كالذئب على الشاه جثم، كأن الدنيا ما خلقت إلا لتشهدنا وكأنه ما فى الدنيا سوانا، وهى فى تكالبها تدنينى ولا تنأى وتستفز منى كل إحساس وتئن طوراً فى ألم اللذة وتتراخى طورا فى فيضها، أما ألمها فلعله مفتعل كما تألم العاهر المتجرة، وأما تراخيها فى فيض اللذة فهو انتشاء فى غمرة الانعطاف نحو الجنس ، أما قبلاتنا الرانة فقد تقضى عهدها وصوحت تلك اللثمات الرائحة الغادية بين أثدائها وبادت تلك القبلات المتهالكة على مفرقها وراحت تلك السويعات المتألمة الشاغرة وسادت سويعات مستيقظة وتبدل الموقف فإذا بكلينا شئ غير المشتهى المكبوت وذى الغرائز الباكرة التمرد، بل أمسينا شبابا يتبادل مال الشباب كلانا فى جوف هذا الليل المتراكب الظلمة نؤدى واجب الشباب او جزءا من واجب الشباب، وهى فائضة الأنوثة، وأنا من ذلك اليوم أكاد أكتمل فى فتوتى أخذ منها حقى وأعطيها حقها وتهب علينا لفحات نسمات الصيف فتذكى نارنا والليل أيضا يخفى ما عليه أن يخفى وفى كل هذا تأخذنا الظلمة المستيقظة فتعمى عنا كل شئ وتعمينا عن كل شئ، فنثبت فى بحور اللذة ثم نهتز كأنما نعتصر ماء الحياة وأنتفض كأنما استنزف دم الشباب.
مجلة القاهرة – يوليو 1996 العدد 164

 sadazakera.wordpress.com
sadazakera.wordpress.com
فى صحوات النفس أنسى كل شئ عنها ولا يبقى لى منها إلا ما يبقى للمغتسل فى بحر ضاحك من أمل تهب عليه زوابع الحياة فتذويه حتى قطرات الذكرى تفر وتشرد، وحين تأخذنى تلك النوبة التى تعتاد أصحاب الفن، تطيف بى حواشى الذكرى، وما آلمها وتهبط على من مناحى عقلى شوائب سوداء تحيل النفس إلى فن خالص لا غش فيه ولا حيوانية فترتاد النفس أقطاب الحياة.. وما بعد الحياة! فنكون مزاجا من فن باكٍ كئيب ومن فلسفات هى للفن أيضا وللحياة، وماذا فى الفن والحياة، حب وبكاء، وشئ من اللذة .. لعلها باكية أيضا.. وأما تلك الضحكات التى تخترق الصموت الواجم وذلك التعابث وذاك الهذر فما هو من الحياة.
حين تساورنى أطياف الذكرى تموج برأسى أشياء هى من الحياة.. أعنى سادرة باكية ، وفى تلك الشملة التى تلفنى كأنها رداء الأزل تهزنى ذكريات أخرى.. ولكنها ليست من الحياة، ذكريات هى تضحك أو تكاد، فتضحكنى معها، فتنتهبنى الحياة وما هو ليس من الحياة، ولكن تلك البارقة التى تشع فى جنوب النفس تبدد ظلمة الصدر، فأعود بفضلها هى أمرح الناس.
كان لى من الأنامل ما لزوزو الصغير أو لميمى الصغيرة.. (وسكينا) فى استرخاء، أو أنوثة إن شئت.. وأما هى فقد كانت، لا أدرى ما هى الأن، غادة لا أنضح منها، وكيف كنت أفهم النضوح فى هذه السن، ما كان بيننا لم يكن ما بين الولد وأمه.. كان يغرينى منها أشياء، وأنا مرهف الإحساس لكل نأتئ منها أو غائر.
كانت تأتى فتلقينى راقدا فى شرودى فتلقى على نظرة لا أفهمها، لعلها تهتف، انت صغير، أنت صغير.. أما أنا فكنت استنيم إلى خيال لذيد.. أه لو فهمت ما برأسى.. تعالى إلىّ ، هنا ، هنا إلى جانبى ، تعالى أدفن نفسى بين أطوالك، أه ثديك هذا يغيظنى ، لو كان لى .. لى وحدى، ثم تسرى ببدنى سعادة سيالة فأتمطى وأقوم وقد نفضت عنى كل شئ، حتى تلك الصورة الناضجة
وتنادينى فأقبل نحوها فى هجمة وتعاودنى حمى الرقاد فأصرخ فى نار
– أين أقبلك
فيقول والدى فى يدها
وتقول أختى فى جبينها
ويقول أخى مداعبا بل فى شفتيها”
أما أنا فيهزنى شئ، لا أدرى ماذا، أندفع إلى ناحية وأطبع على ثديها قبلة كلها نار فتتراجع فى غنج.
– اختش يا واد
أما والدتى فقد كانت تكسوها زرقة باهتة حتى يخيل إلىّ أنها تخرج من قبر! لا أدرى لماذا. هل يفعت حتى يغضبها هذا؟ أما اخى فكانت تأخذه هزة لعلها عنيفة ، ماذا؟ ألم أجد سوى الثدى أطبع عليه قبلتى، ما أفسح جسمها، هناك العنق، هناك الشعر، هناك اليد، هناك الفم، وهناك الخدان لمن يشاء! وتنصرم سويعات تنصرم معها أمال ، تبلى كأوراق الخريف.
كانت تأتى فتلقينى منكفئا على فراشى تطيف بعقلى الذى لا يفكر، إرادات يرسلها ذلك السيال الذى يطوف ببدنى فيورثه اللذة الخالدة، كانت تنادينى ولكن لا كما تنادى أخى، كانت تضم شفتيها فى استدقاق وترسل من بينهما صوتا مستطيلا، لا أدرى ماذا تعنى بذلك، لعلها كانت تحاكينى حين أنادى كلبتى “فيبى” . إذاً أنا كلب! ثم هى ذى تنادينى باسمى مرة أخرى ، اثنتين ، ثلاثا، وانا مازلت منكفئا على فراشى فى حرارة كلها لذة! أنت ، أنت تناديننى؟ تعالى هنا فى هذا الفراش الصغير فإنه يكفينا ، تعالى هنا، أرتوى منك وترتوين منى، أوه منك هذا الشباب يجرى ويتدافع ، كلى حرارة واحتراق وقد تبدر منى صيحات فى زيغ العقل وأنا منكفئ فى لذتى أكاد لا أبصر، وقد تنطلق كلمة تصبغ منها الوجنتين وتعيد تلك الزرقة الباهتة إلى والدتى ، وتلك الهزة التى أحسبها عنيفة إلى أخى .
كانت تأتى فتلقينى مستلقيا فى تأملى المحدود فأنفض عنى حتى ذلك الغبار وأقفز، لا إليها بل إلى خصرها!، ما كان أعذبه، لو كان لى وحدى، وتجلس ثم تجلسنى على ركبتيها ثم تقول فى غنجها.
– ماذا يعجبك فىّ
فأصمت ، فتهزنى لا أدرى فى عنف وتهديد
– ألا يعجبك هذا الشعر؟
فأصمت.
– ولا هاتان العينان.
فأصمت.
– ولا هذا الفم.
فأصمت
– إذاً ما يعجبك فى؟
فتأخذنى حمى ولهيب لعله كلهيب الشباب وتسرى فى بدنى تلك اللذة الهازة فأنتفض.
– هذا الثدى. آه . لو كان لى . لى وحدى، و تحتثنى إليها حمى، فأنقض على ثديها ألصق به جسدى، فتحتجزنى غلالة كأوراق الورد، فانكص كالمخبول وأقف فى شدهة ذاهلة، منعطفا نحو ثديها تراودنى شتى الأحاسيس، وإذا بهمسة واجفة ” خذه” هو لك، لك وحدك، فينبجس من الأعماق هاتف يائس “نعم ولكن ماذا أصنع به”
2
كنت إذ ذاك جميلا لا كما أنا الأن، كانت تعلونى نعومة كاسية وطراوة تكسب الجسد تلك النضارة الفائضة، فكان وجهى يطالع من يطالعه فى إشراف وإشراق كأنه صفحة خالصة من بهاء، كنت استعرض نفسى فى المرآة، كما كانت تفعل تاييس، وأرفع منى الذراعين ثم أخفضهما أو أشيح بجانب منى إشاحة المستكبر أو اطأطئ منى الرأس فى خفر المستورة فضحها الزمان أو اصطنع نظرة من نظرات العابد الجاثى لربة فاجرة، أما شعرى فقد كان كدجوج الليل يتراخى ويتهدل، ما كان احلاه حين كانت ترف عليه النسمة فيبدو كأنه حلم طائرا.
كنت أغمض منى العين وأرخى منى الرأس على جانب من جوانب الكتف ثم اخلع عنى عذار الحياة، فإذا نحن فى جنة ورقاء الصور يحوطنا لحن تبعثه أطياف ما بعد الحياة، وسلسال من النغم تزجيه خالصا أفواه وعيون وقلوب خرساء لا تنطق ولا ترى ولا تعى، ولكنه ملكوت السحر العجيب وهى بروحها الخاتلة وجسدها الحامى راقدة لا على ظهرها بل على جانبها فى أثير المكان.
وأنا بهذا الوجه عينه، هذا الوجه الطافر والمشرئب وهذا الفم عينه، هذا الفم الذى ما خامرته بسمة ساخرة، وهذا الجبين المضئ تلفه تلك الكومة من ذلك الشعر، وأخيرا هذا القلب عينه، هذا القلب المدفون الذى ماجت به شتى الإرادات وطافت به شتى الأحاسيس والشهوات الماردة، كنت بهذا كله أتمدد لا إلى جانبها بل فيها، تحتوينى أعطافها، فمى إلى خدها ، وصدرى إلى ثدييها، تطوينى فى شملتها وتناد على ثم تتأطر، ثم تقبض بأناملها الهشة على شفتى وتدعونى أن أهتصر وتطالعنى بصفحة طاهرة، بكم تبيعنى هذه الشفة.. فأضحك فى سرى ما أحمقها، لتأخذ ما تشاء، فشفة واحدة لا تُقبل، ولكنى أعود فأتزن ثم يعلونى مبسم الهازئ وأهوى على شفتيها بقبلة متقطعة وأصرخ بهذا الفم كله.. فترتد كالميئوس وتكاد تطفر العبرة من مدمعها، ما أهون الثمن إلى.. ثم يعود إليها دمها الشارد وتعود إليها النضرة وتزدهى ثم تقبض على خصلة حماء من ذؤاباتى المتهدلة، وتدنى فمها من أذنى وتهتف فى إسرار وبكم تبيعنى هذه الغديرة.. فيعود إلىّ شعورى الهازئ وأنقض على رأسها الصغير فأغمر منه المفرق بفيض من قبل متهالكة وأتناول أذنها بهذا الشعر كله فتطوى عنى طلعة مكفهرة وتنحل غدائرها على منكبى وتهب لفحة من الريح ثم تسكن، أما هى فتهز رأسها، كأنما تنفض عنها ذلك الشعور القانط، ولا ألبث أن أبصر على شفتيها ابتسامة فيها خبث وزيف، وفى عينيها التماعات عجيبة كأنما اهتدت إلى سرالحياة ، ثم تأخذها ارتعاشة عنيفة ويرتد منها الجسد، وتهتف فى حشرجة غانجة، وقد كشفت عن ثديها، وهذا الثدى بكم تشتريه، أما انا فأتحسس موضع الثدى منى فلا أجده، وينتابنى ما اعتاد أن ينتابنى وتعاودنى حماى فتسرى ببدنى انتفاضة كانتفاضة الموت.. وأصرخ بالحياة.
وتهب لفحة أخرى من الريح هى أعتى، أفتح منى العين وأُقوّم منى وألبس دثار الحياة، فإذا نحن، بل أنا وحدى، منكفئ إلى كتابى الملعون، وهى قد طارت منى.. ولكن لا إلى الأبد بل فرت من مروج الأحلام المخصبة التى فيها حيينا بل حييت وحدى آمادا.
كانت تأتى فى خلوات من البيت وتخلع عنها كل شئ إلا سترا هو للحياء المحتضر، وكانت تراودنى الظنون أنها كانت تعنى ذلك، وماذا كان بينى وبينها حتى كانت تعنيه؟ بضع التفاتات واهتصارات وضغطات، لعلها كانت برئية أو لثمات تتراوح بين الثديين لا تعدوهما أو ارتعاشات متبادلة كأنما يبعثها سيال لا يبارح أو قبلات خرساء بين فمى المشتهى وثناياها العذاب أو دفئات لجسدى الناعم بين مطاوى جسدها الناعم مما كان يرسل فى بدنها غير الطهر. وهل – بعد كل هذا شئ، فقد كان هذا كل الحياة، ولم تكن الحياة إلا هذا. كانت ترقد وتنادينى فأندفع نحوها ولكن فى برود عجيب ليتها لم تخلع وتخامرنى ثورة طاحنة بين التقاليد والاشتهاء، ولكن ليكن ما تريد الشهوة، وأنام إلى جانبها أو استنيم وتمضى هنيئة أو التصاقة متهالكة يتدافع فيها الدم الحامى. ولكنها لا تلبث أن تغمرنى بنظرة ميئوسة لو كنت كبيرا ثم تلقينى كأننى خرقة بالية وتتخاذل منى الجوارح! كأنها تغترف.
وتشب بين أعطافى ثورة أجرف وأعتى وتنتابنى حسرات القانط فأغمض منى العين فى لهفة وأرسلها زفرة خائرة، ثم أفتح عينى فلا أراها إلى جانبى ، لقد فرت منى إلى من يشبع منها الإحساس والعقل والعاطفة، لعلها فرت إلى أخى فهو فى ذلك أكفأ منى، ثم تعرونى نوبة ساخرة صامتة: لن تجده، لن تجده، ستعود إلى – ثم لا ألبث أن أراها وافدة تعض شفتيها وأشملها بنظرة قاسية منتقمة، فتجيب فى نظرة مستغفرة: لو كنت كبيرا، فيتراخى منى كل عطف وجارحة ويغفينى ستران من يأس ورجاء .
وبعد ذلك لا أذكرها إلا فى ليلتين، ليلة قمراء زاهية الكون حافلة بالذكرى، تلاشت فيها أشباح ما بعد الحياة وبددتها خيوط هزيلة وانية يرسلها قمر أبتر غير كالح، ولكنها كموجات السحر مبثوثة تبعث حولها طرفا من أطراف الأبد وتكشف ناحية من حقاقيه، وهى متكئة على ظهرها لا راقدة فى شرفة البيت تكسوها تلك الموجات فتغمرها بلون القمر ويتبدد ذلك اللون الخمرى الرقيق من خديها ولا يبقى لها سوى صفحة رائعة من فضة القمر، فتبدو كأنها مُلكٌ به كل شئ حتى الطهر وإن كانت غير ذلك. وكأنها طرحت عنها ثوب العالم وكأنها فى يوم غير أيام الدنيا الفاجرة، وأما عيناها فقد تكسوهما ظلال شافة وأنية فتتبديان كأنهما ظلمة تخامر النور أو جريمة لوثاء تمازج الطهر.
وأما أنا بطلعتى المفكهرة عينها فقد كنت آجثو على قدميها فى صورة المستغفر من جريمة الحياة تحوطنى أجواء الغفران والتكفير بتضحية الموت. موت النفس لا موت الجسد. وهى فى موقف الغافر النادم. لا لغفرانه بل لتوبتى، هى لا تريدنى فى صورة النقى الصفحة، بل تريد منى صورة الفاجر الباذل. كل شئ لإحساسى وإحساسها، وكذا كنت أريدها ، لست أطيق أن اراها فى هذا الثوب طاهرة مغتسلة بالتوبة، بل أريدها للمتعة والشهوة، فلتكن هى بغياً، ولأكن أنا فاجراً.
وأما ليلتها الثانية، وهى آخر ما لها عندى فقد كانت ليلة ضريرة النجم ساقطة النواحى، تتراقص فيها أطياف الأزل والأبد وأشباح الحياة وما بعد الحياة وأرواح الليل والنهار على موسيقى حاكتها الطبيعة لنا وحدنا ولهذا اليوم وحده لا لغيره، بل ولتلك الساعة وحدها لا لغيرها.
هى تحتى تردد أنشودة الغرام الفاسق وكل ما فيها يلتهب. عيناها تلتمعان التماعات الشهوة الزائغة وشفتاها تنضحان جمرا وثدياها فائران كأنهما أتون شائط يرسلان فى بدنها أفاريق اللذة المتهالكة. أنا افترشها كما أفترش الآن البغايا وأعتصرها بين ذراعى الراعشتين وأكاد أتخلع شهوة كالذئب على الشاه جثم، كأن الدنيا ما خلقت إلا لتشهدنا وكأنه ما فى الدنيا سوانا، وهى فى تكالبها تدنينى ولا تنأى وتستفز منى كل إحساس وتئن طوراً فى ألم اللذة وتتراخى طورا فى فيضها، أما ألمها فلعله مفتعل كما تألم العاهر المتجرة، وأما تراخيها فى فيض اللذة فهو انتشاء فى غمرة الانعطاف نحو الجنس ، أما قبلاتنا الرانة فقد تقضى عهدها وصوحت تلك اللثمات الرائحة الغادية بين أثدائها وبادت تلك القبلات المتهالكة على مفرقها وراحت تلك السويعات المتألمة الشاغرة وسادت سويعات مستيقظة وتبدل الموقف فإذا بكلينا شئ غير المشتهى المكبوت وذى الغرائز الباكرة التمرد، بل أمسينا شبابا يتبادل مال الشباب كلانا فى جوف هذا الليل المتراكب الظلمة نؤدى واجب الشباب او جزءا من واجب الشباب، وهى فائضة الأنوثة، وأنا من ذلك اليوم أكاد أكتمل فى فتوتى أخذ منها حقى وأعطيها حقها وتهب علينا لفحات نسمات الصيف فتذكى نارنا والليل أيضا يخفى ما عليه أن يخفى وفى كل هذا تأخذنا الظلمة المستيقظة فتعمى عنا كل شئ وتعمينا عن كل شئ، فنثبت فى بحور اللذة ثم نهتز كأنما نعتصر ماء الحياة وأنتفض كأنما استنزف دم الشباب.
مجلة القاهرة – يوليو 1996 العدد 164

لويس عوض في ذكراه “ملف خاص” إعداد ماهر طلبة
مفتتح للقصة القصيرة شغف خاص تركت أثرها على الكثيرين ، منهم الكاتب لويس عوض الذي عرفناه مفكرًا وناقدًا …لكنه كتب رواية وحيدة هي العنقاء أو تاريخ. حسن مفتاح”التي كانت دليلا عل…