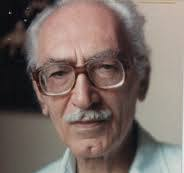نظرة تاريخية:
انشغل الأدب العالمي بأدب الطفل، وعلى الرغم من مرور هذا الأدب بالعديد من المراحل التاريخية، إلاّ أن الاهتمام به جاء في ثلاثة القرون الماضية؛ بمعنى ابتدائه منذ عصر النهضة في أوربا.. ناقلاً مرحلةً كان يسيطر فيها سابقاً أدب الشفاهية، على شكل حكايات وأساطير تناقلتها الألسن جيلاً بعد جيل.. وفي وطننا العربي تشير المراجع التاريخية إلى أن أدب الطفل قد تأخر كثيراً جداً مقارنةً مع انتشاره وتطوره في أوربا.
لقد لاقى هذا الجنس الأدبي قبولاً غريباً لدى الناس في الغرب والشرق كافة، ويروي تاريخ الأدب أن قصةً واحدةً "كتبتها زوجة كاهن بروتستانتي" عن "جزيرة البرنس إدوارد" حيث كانت تعيش في فقر وعزلة موحشة، قبل مئة عام، في مزرعة كافنديش شمال الجزيرة على ساحل كندا الأطلسي، قد فعلت هذه القصة فعل السحر في العالم. مع أنها قصة للأطفال تتحدث عن جزيرة تربتُها فقيرةٌ حمراءُ اللون، لا تُنتج غير البطاطا، ولا تكفي لإطعام سكانها البالغ عددهم 140 ألفاً. وبسبب هذه القصة البسيطة أخذ السياح يتوافدون على الجزيرة كل عام، بمعدل مليون وخمسمائة ألف شخص. وهذا يشهد على عظمة الأدب وشدة تأثيره في وجدان البشر. فما الذي يدفع مئات الألوف لعبور القارات والبلدان (مئة ألف زائر من اليابان فقط) إلى جزيرة صغيرة مناظرُها الطبيعية لا تختلف عن مناظر الأماكن الأخرى في كندا، وفنادُقها أغلى سعراً؟!.
لقد بدأ العالم الغربي بإحياء فن رواية القصة، وما يتبعه من حكايات شعبية من أجل مجابهة الواقع المادي، بكل صراعاته وآلامه، بزرع أمل رومانسي، وحلم عاطفي، بنقاء الأرواح الإنسانية لتجاوز الصراعات والآلام، متفائلة بغد مشرق.
يعدّ كتاب "حكايات أمّي الإوزّة" الذي صدر في فرنسا عام 1697 لمؤلّفه "تشارلز بيرو" (1628 ـ 1703) أوّل كتاب أدبي خاص بالأطفال، يحتوي على مجموعة من الحكايات الشعبيّة تشكّل بداية مرحلة جديدة في تاريخ تطوّر أدب الأطفال، إذ ظهر مستقلاً عن الآداب الشّعبيّة. ومنذ ذلك الزمن بدأ أدب الأطفال في استقطاب أجناس متعدّدة من التراث، وظلّت الحكاية الشعبيّة في ألمانيا موجّهة للكبار حتّى أصدر "الأخوان جريم" (يعقوب 1785 ـ 1863، وفلهلم ـ أو ـ وليم 1786 ـ 1859) الجزء الأوّل من كتابهما "حكايات الأطفال والبيوت" عام 1812 وفي نهاية عام 1914 ظهر الجزء الثاني. ولم يجد أيّ صعوبة في تقديم الحكايات الشعبيّة للأطفال، ثم كانت النقلة النوعية بظهور كتاب "أليس في بلاد العجائب" عام 1846 الذي عدّه النقاد (البركان الروحي) لأدب الأطفال، جاء بعده الكاتب الدانمركي "هانس كريستيان أندرسن" (1805 ـ 1873) بأقاصيصه التي عُدّت بداية العصر الرومانتيكي، والتي لا يزال الأطفال يتداولونها حتى اليوم، بعد أن ترجمت إلى لغات العالم.
في عام 1930 بدأ الحديثُ عن "أدبيات الطفل" يتردد على ألسنة المربين العرب والكتّاب في الدوريات العربية، وظهرت إلى الوجود ملامح تأصيل جنس أدبي للطفل، وقبل هذا التاريخ، كانت كتب الأطفال تقتصر اقتصاراً ـ يكاد يكون تامَّاً ـ على الأغراض التعليمية "مادةً للقراءة المدرسية" تهتمّ بالمحصول اللغوي، وتدعو إلى القيم والآداب الحميدة، والتمسك بالدين، ثم وُجدت أصوات تدعو إلى ضرورة الاهتمام بالتأليف للأطفال بعيداً عن التعليم، وبدأت تستحوذ على اهتمام المختصين في مصر الشروطُ الواجب توافرها في الكتب الموجهة للصغار، سواء من حيث الشكل، أو من حيث المضمون، محاولةً منهم لحثّ كُتَّاب الطفل على تقديم الأفضل، وقد أشاد "د. زكي مبارك" برائدين، فقال: "أشهر المؤلفين في هذا الباب رجلان: محمّد الهراوي، وكامل الكيلاني، وهما بعيدان عن التدريس". (1)
لقد نجحت القصة الطفلية ـ في مصر، خاصة ـ في الاستفادة من التراث، ولعل سبب نجاحها في هذا التوّجه، عائدٌ إلى طبيعة الجنس الأدبي القصصي، الذي رأى في التراث جانباً درامياً بتسليط الضوء على ثنائية التضاد، أو المفارقة الفنية في الخير والشرّ، والحق والباطل، والعدل والظلم، والجمال والقبح، مستغلةً ما استوحته في ذلك من التراث الشعبي الموروث. كسِيَر "عنترة، وذات الهمة، والملك الظاهر بيبرس، وسيف بن ذي يزن، وعلي الزيبق، وشهرزاد، والسندباد..." وسواها من السِيَر التي اجتمعت في شخصيات أبطالها، إلى جانب الصفات الإنسانية، جوانبُ سحرية خارقة، مما جعل "السيرة الشعبية تمثّل ذخيرةً عربية لا تنفذ مهما قُدّمت في أشكالها، وزاداً لا ينتهي، حينما تغدو مصدراً جيداً من مصادر ثقافة الطفل، لا تقلّ أهمية ـ إن لم تكن تتفوّق ـ على هؤلاء الأبطال المعاصرين، الذين يتفوّقون بالحاسوب وغيره من الأدوات العصرية" التي يمكن الاستفادة منها في تشكيل وجدان الطفل. (2)
في المصطلح والهدف:
إن مصطلح "أدب الأطفال" يعني الأدب الموجه إلى الصغار بالتعبير الاصطلاحي، لأن مُجمل عملية إنتاج أدب الأطفال تحمل في مراحلها المختلفة خصوصية عناصره ومجمل أهدافه أيضاً، ومن ثم، فإن القنوات والوسائط التي يمر منها هذا الأدب على عالم الصغار تؤدي إلى تلقيه وانتشاره. لذلك فهو يتوجّه بصورة عامة إلى مرحلة الطفولة المحددة، التي يُكتب لها، من دون أيّ اختلاف في روح الأدب ذاته. فحين نتحدّث عن "أدب الراشدين" أو الموجه إلى الكبار، فإننا لا نستعمل هذا المصطلح، بل نكتفي بلفظ "الأدب" من دون إضافة كلمة الكبار. ومن جهة أخرى، فليس هناك أيّ تمديد لأجيال الكبار وملاءمة الأدب لها. إذ يُكتب الأدب للكبار من جيل الثامنة عشرة، وما فوق، من دون أيّ فصل بين مراحل هذا الجيل. وهنا تبدو خصوصية أدب الأطفال الذي يعدّ الأدب الوحيد الذي يلتصق اسمُ نوعِه باسم متلقّيه، ويراعي فيه الكاتب المستويات الفكرية والمعرفية لجمهوره، ولا يكون ذلك من خلال مستوياته الفكرية والمعرفية هو ككاتب مبدع، وإنما من خلال جمهوره، لأنه يدرك من البداية أن المتلقي الذي ينتظره في نهاية بحر الإبداع هو طفل، وأن عليه أن يحدد قاموسه المعرفي واللغوي وتركيبه الفسيولوجي والبيولوجي، لتحديد ميوله الفكرية، والانطباعية للفكر الذي يتلقاه، فيستعيد ذاكرته وغرائزه الطفولية بفكر واع لكاتب مبدع.
إن مصطلح أدب الأطفال، يطلق على "الأدب المكتوب للأطفال بصورة خاصة، ويتميز بملاءمته لمراحل الطفولة المتعددة والمختلفة" (3) وهذا من شأنه التمييز في المصطلح، بين الأدب، وروح الأدب، والتي يصعب تساويهما عند طفل وكهل. تماماً كما هي روح الإنسان؛ الروح واحدة، وإن كانت في جسد طفل، أو في شخص رجل كبير.
إن أهم ما يميز أدب الأطفال من أدب الكبار، هي فكرة التناسلية؛ أي مراعاة المرحلة العمرية التي يمر بها الطفل. كما أن الطفولة نفسها ليست مرحلة واحدة، فما يُضحك طفلَ العاشرة قد يثير رعباً أو خوفاً لطفل الخامسة، ولهذا يراعي الأديب ذلك في مضموناته، وفي لغته، وفي كل تفاصيل الجنس الأدبي الذي يقدمه للطفل.
لو تتبعنا بدايات أدب الأطفال في سورية سنجد أن ميلاد الشعر كان سبّاقاً للقصة، وذلك لأن الشعر الطفلي نشأ في ظل التربية والتعليم، وكانت المدارس ـ ولا تزال ـ تثبت القصيدة في كتبها بين مواد القراءة والإنشاء والمحادثة، وهي تغري الطفل بإيقاعها الغنائي، وبالحفظ والاستظهار الحرفي أكثر من أيّ مادة تعليمية أخرى، فضلاً عن أن المطبوعات الخاصة بالطفل التي تُنشر بجهود خاصة، أو في دور نشر تجارية، تؤكد على أن الشعر فنياً سبق القصة في هذا الاتجاه، فقد نشرت المكتبة الهاشمية بدمشق عام 1937 كتاب "الاستظهار المصور في أدب البنين والبنات" في حلقتين، لـ "جميل سلطان".
إن جميع الذين كتبوا للصغار انطلقوا من المدارس، وكان غرضهم رفد مناهج التعليم التي تسعى إلى ترسيخ قيمٍ تربوية مرتبطةٍ بالقيم الروحية، ولكنها غالباً ما تقدَّمُ بأسلوب الوعظِ، وإزجاء النصح، ثم خفتت هذه النزعة مع تقدّم الزمن، وازديادِ الزخم القومي، بسبب توالي الأحداث التي عصفت بالوطن. فاتسعت القيمُ الخلقيةُ إلى جانب القيم القومية، وهذا من شأنه الإخلال بتوازن المنظومة. نظراً لعدم التكامل في العطاء والتوجّه. وقد لعبت التناقضات السياسية دوراً بارزاً في دفع الشاعر للتطلّع إلى الأفق القومي. في حين تأخّرت القصة كثيراً عن هذا التاريخ، إذا اعتبرنا القصص الدينية، وغيرها من القصص الشعبية، واللوحات الحكائية المدرسية الأخرى التي تشبه موضوعات التعبير، ذات الأسلوب الإنشائي العالي، خارج إطار القصة الفنية، والتي تخلو من معايير التربية الحديثة بأهدافها القيمية.
يدرك الأدباء، ويؤكد النقاد، على أن القصة شيء من غذاء العقل والخيال والذوق عند الأطفال، وهي تتيح للأطفال أن يطوفوا على أجنحة الخيال في عوالم شتى العوالم، ويلتقوا بأشخاص قد يشبهونهم أو قد يسعدهم التشبّه بهم، ويتجاوز الأطفال في قصصهم أبعاد الزمان والمكان، فيجدون أنفسهم في يومهم هذا، أو يجدونها في عصور غابرة، أو عصور لم تأت بعدُ، ويقفون عند حوادث حصلت بالأمس، أو قد لا تحدث مطلقاً، ويتعرّفون على قيم وأفكار وحقائق جديدة. وهم شديدو التعلّق بالقصص، يحبون أن يستمعوا إليها، أو يقرؤوها بشغف، يحلقون في أجوائها، ويتشبّعون بما فيها من أخيله، فيتجاوزون من خلالها أجواءهم الاعتيادية، ويندمجون بأحداثها، يتعايشون مع أفكارها، خصوصاً وأنها تقودهم بلطف ورقة وسحر إلى الاتجاه الجمالي الذي تحمله، إضافة إلى أنها توفر لهم فرصاً للترفيه وتزجية أوقات الفراغ في نشاط ترويحي، وتشبع ميولهم إلى اللعب، وهي بذلك ترضي مختلف المشاعر والأمزجة والمدارك والأخيلة، بوصفها عمليةَ مسرحةٍ للحياة والأفكار والقيم.
والقصص بفضل مسرحتها وما فيها من معان أصبحت وعاءَ تجسيدٍ للثقافة، ما دامت الثقافة أسلوباً للحياة إذ إنها تجعل للحياة أبعاداً جديدة، فتبدو معقدة أو مشوقة أو غريبة أو قريبة إلى حياة الطفل (4) ومن ثم لا يمكن إغفال الدور الثقافي للقصة في الطفل فهي تحمل مضموناً ثقافياً من خلال ما تتضمنه من أفكار ومعلومات علمية وتاريخية وجغرافية وفنية وأدبية ونفسية واجتماعية.
أنموذج من قصص البدايات:
لم تكن القصة معروفة كجنس أدبي في الكتاب المدرسي، فقد كانت تتغلغل كنص للقراءة الصامتة والجهرية في كتاب القراءة، وعلى سبيل المثال فقد ورد نص شبيه بالقصة في كتاب الصف الخامس الابتدائي المقرر عام 1954 ص 105 بعنوان "لا سحر في الكلمات" بالصيغة الآتية:
1 ـ كان سعيد طفلاً مهملاً، ففي يوم واحد ترجّح على غصن شجرة التفاح فكسره وتسلّق شجرةً ومعه دميةُ أخته، فمزق ضفائرها حتى صارت خيوطاً، واصطدم بطبقٍ جديد فكسره، وبعد كل حادث كان يبادر فيقول: "إني آسف" وكان سعيد يعتقد أن تمنحه هذه الجملة العفو والغفران.
2 ـ وفي اليوم التالي، وكانت الأسرة تتناول عشاءها، أسقط سعيد قشدة اللبن على غطاء المائدة غافلاً فقال: "إني آسف" فما كان من والدته إلاّ أن خلعت مئزرها الأبيض، وجعلته عمامة على رأسه بدل تأنيبه، وناولته عصا من زجاج انتزعتها من حامل المناشف، وقالت لـه: "أنت الآن ساحر وهذه عصاك السحرية فردد الكلمة السحرية "إني آسف" عشر مرات على بقعة القشدة هذه "فأطاع أمرها، وظل سائر أفراد العائلة يكتمون ضحكهم، فلما انتهى، قالت لـه "هل زالت البقعة؟" فقال سعيد وقد خنقته العبرات: "لا. إنها لن تزول حتى إذا قلت "إني آسف" مليوناً من المرات"، فقالت له أمه: "هذا ما أردت أن تعرفه، فإن كلمة "إني آسف" لا تمحو بقعةً كان من الممكن أن نتجنبها بشيء من الحذر والانتباه".
ولم تعد والدة سعيد تذكر له الإهمال، لأن عصا الزجاج كانت تنتظره.
تعليق:
أُدرجت القصة بين دروس القراءة، من دون أن تكون فيها إشارة تميّزها من غيرها، ولا شيء يدل على أنها قصة، ويمكن أن نلاحظ أن:
1 ـ جملها طويلة.
2 ـ لغتها عالية جداً. وصيغة العنوان ليست سهلةً
3 ـ قسمت القصة إلى مقطعين. وبرزت فيها شخصيتان، في حدث أسري منزلي، ولكنها لم تراعِ أسلوب كتابة القصة، من حيث التنسيق الكتابي، فامتزج الحوار بالسرد.
4 ـ حرصت القصة على خصوصية العنوان، فجعلته في ثنايا السرد بين هلالين صغيرين.
5 ـ اعتمدت القصة على الأسلوب المباشر في العرض، فقررت: "كان سعيد طفلاً مهملاً" ولم تترك للطفل المتلقي أن يستنتج تلك القيمة/الإهمال، بنفسه، ثم ابتعدت القصة عن المباشرة حين اعتمدت على الاستنتاج، وطرح قيمة ضمنية، تجلّت في وقوف سعيد بنفسه على خطئه، لكن المباشرة ما لبثت أن تدخلت، حين أكّدت الأم على العبرة والمغزى في النهاية بقولها: "هذا ما أردتُ أن تعرفَه، فإن كلمة "إني آسف" لا تمحو بقعة كان من الممكن أن تتجنبها بشيء من الحذر والانتباه".
6 ـ حافظت القصة على وظيفتها التعليمية التربوية، بما تضمنته من قيم تندرج في إطار العلاقات الاجتماعية كالحفاظ على الأثاث المنزلي، وحب النظافة، واحترام رأي الأم، ومراعاة السلوك الأمثل في آداب المائدة، وتصّورٍ عام لما يجب أن يكون عليه الإنسان في حياته، وعلاقاته مع الآخرين. كما رسمت لـ ( الساحر) سمتاً ذا خصوصية معينة، يقوم على الإضحاك.
7 ـ حافظت القصة بحساسية مرهفة على خصوصية دور الأم الذي ارتبط بالتدبير المنزلي وجعلته الغاية المثلى، والهدف الأول.
شهادات:
تنبّهت وزارة التربية إلى الصورة الجديدة التي يجب أن يكون عليها الطفل العربي، فخرجت بمنهاج جديد للمرحلة الابتدائية، نظمه القرار 1285 تاريخ 17/9/1967 تتلخص بنوده بـ: "خلقِ فردٍ ذي شخصية متكاملة منفتح على الحياة والعلم.." وراعى أن تكون القصة من صميم المطالعة، وخصّ كلاً من الصفين الخامس والسادس بكتاب ذي موضوع (شبه قصصي) لكل صف، الأول أعدّه "منير الخير" بعنوان "قصص قصيرة" طبع وضم ست قصص يبدو أنها مترجمة، باستثناء قصة "شجرة الليمون الصغيرة" والثاني "قصص مختارة" طبع عام 1970 وهو من إعداد "يوسف بنا وعادل زريق" وقد استقيا مادته من كتابات عربية سورية لـ "أديب نحوي، وعبد الرحمن الباشا، وعبد الله عبد" ومن مادةً للمستشرقة الألمانية "زيغريد هونكه" وجزءاً من مذكرات "فالنتينا" رائدة الفضاء السوفياتية، ومسرحية "قطرة الماء" لـ "سليمان العيسى" وترجمة لـ "أبي بكر الرازي".
وقد وجد المربون أن القصة تحقق الصورة المأمولة التي رسمها المنهاج المدرسي، فجعلوها تتغلغل في كتب المرحلة الابتدائية، وجعلوا من بين أهدافها الاستمتاعَ والترفيه، الذي لا يخلو من قيم خلقية وتوجيه تربوي، وهذا اللون من القصص المدرسية يختلف عن القصص التي بدأ الكتّاب ينشرونها مجموعات خاصةٍ، تراعي الاعتبارات الفنية العامة لأدب القصة، وتستفيد من خبرات الأمم الأخرى، في ما أنتجه هذا الفن الجديد والصعب. وقد كان كتاب "فن الكتابة للأطفال" للباحث المصري "أحمد نجيب" (دار الكاتب العربي. القاهرة 1969) مرجعاً للعديد من كتّاب أدب الأطفال ونقاده في سورية.
إن البدايات القصصية تحمل سمات الكتابة العفوية التي قد لا تقترب من مقومات القصة الفنية، وهذا ما جعل بعضها يغرق في المباشرة. لأنها لم تنطلق من رؤية إبداعية مستندة إلى مرجعية تراثية، بقدر ما كانت تراعي النظرات التربوية، لأن جل كتابها كانوا من المعلمين وليسوا من الأدباء المبدعين، وحتى الكتاب المتمرسون لم يكونوا على بيّنة من أمرهم، وما اصطادوه من حكايات منثورة في كتب التراث وقصص العرب، وأخبار التاريخ فيبسّطونها، أو ينقلونها بعفوية ويضفون عليها شيئاً من أفانين العصر.
ولكن على الرغم من بساطة البدايات وعفويتها، وعدم مراعاتها السمات الفنية للقصة الطفلية، فإنها شكلت جذوراً تاريخية على الصعيد الأدبي، ساعدت الكتاب على تطويرها شيئاً فشيئاً. حتى بدأت تقف على رجليها، وتحديداً إثر نكسة حزيران عام 1967 التي كانت أشبه ببوق الخطر الذي نبه عقول المثقفين إلى ما يحلّ بالأمة، وأدخل في روعهم أنه لم يبق لها أمل إلاَّ في جيلها الناشئ.
إن من أسباب تأخّر القصة الطفلية عن الشعر في سورية، أن شعر الأطفال كان بصورة من الصور امتداداً لديون الشعر العربي، بينما دخلت القصة في المنهاج المدرسي من دون جذور تاريخية واضحة، وما جاء مستحدثاً منها، ليس سوى لوحات قصصية، وأنها لم تولد ولادة حقيقية في المكتبة السورية إلاَّ بعد أن التفتَ للاشتغال بها ثلاثةُ كتاب، كان لهم باعهم الطويل في الكتابة القصصية والروائية، هم "زكريا تامر وعادل أبو شنب وعبد الله عبد" وربما كان لـ "تامر وأبو شنب" دورٌ كبير في إغناء التجربة الطفلية بصورة عامة، فقد ساعدا ـ بحكم موقعهما الإداري والأدبي في مؤسسات الدولة الثقافية ـ على إصدار مجلات وصفحات في الصحف اليومية، فكان لذلك أبعد الأثر في تنبيه الرأي العام الثقافي إلى هذا الجنس الأدبي الوليد، وقد توالى الاثنان على رئاسة تحرير مجلة أسامة.
لقد كانت هزيمة عام 1967 مؤشراً هاماً على تحوّل الكتابة بصورة عامة وأدب الأطفال بصورة خاصة، يقول "سليمان العيسى": (5)
"وذات يوم أفاقت أمتنا العربية على كارثة من كوارثها المتلاحقة على نكسة حزيران.. في هذه الزوبعة السوداء الخانقة، التفتُّ إلى الأطفال، رأيت في عيونهم غد الأمة العربية ومستقبلها، فتساءلت: لمَ لا أتجه إليهم؟ لمَ لا أكتب لهم؟ لمَ لا أنقل إليهم همومي كلها؟. الشهيدُ الذي يسقط على أرض المعركة وهو يقاتل الغزو الأسود، لا أستطيع أن أنتقم لـه بأحسن من أغنية تحمل قطرة من دمه، وتتردد حارةً على شفاه الأطفال.. نتوارى نحن. نيبس. نجف. ويأتي أطفالنا أمواجاً متلاحقة ترفد المد العظيم.. من إيماني بهذه الحقيقة الصغيرة الكبيرة المتواضعة الشامخة بدأت رحلتي مع الصغار، أخذت أكتب لهم. أغني معهم. أنفق الساعات الطويلة بينهم أختار لهم الكلمة المشرقة، والموسيقا المعبرة".
وينطلق "زكريا تامر" من التوجه الوطني والقومي نفسه، فيعبر عن عجز الكبار من خلال الأمل في الصغار، قائلاً: "عندما جاءت حرب حزيران ونتائجها ازداد ارتباطي بالواقع، وصار أكثر حدةً وصرامة، وابتدأت أنظر إلى الصغار نظرة مختلفة. إنهم الجيل الذي سيُطلب منه في المستقبل أن يجابه عدواً شرساً، ولذا فلا بد من منحه الوعي وإرادة التحدي، والرغبة العميقة في التغيّر والحفاظ عليه.. لابد من أن يكون جيلاً قادراً على التضحية في سبيل العدالة والحرية والفرح". (6)
لكن تجربتي كل من "دلال حاتم، ولينا كيلاني" تبدوان مخالفتين للشهادتين السابقتين، فقد اعترفت الكاتبتان بأنهما لم تستطيعا الكتابة للأطفال إلاَّ بعد محاولتيهما في ترجمة القصص الأجنبية، تقول "لينا كيلاني": "لم يكن يفصلني عن عالم الطفولة زمن طويل، وأنا طالبة جامعية في السنة الأولى، عندما وجدت لديّ الحماسة الكافية لأن أغامر بالكتابة للأطفال، وقد كنت لا أزال مشبعة بروح الكتب الكثيرة التي قرأتها، والأفلام، والمسرحيات، وباختصار، عالم الطفولة الكامل.
وكان لاتصالي بالطبيعة، وأنا في كلية الزراعة أثرٌ كبير في أن أكتشف الصلة بين الأشياء وبين الحياة، فكأن الشجرة كانت تتكلم، والطير يلبس شخصية طفل منطلق، وهكذا..
وتدريجياً بدأتْ تنضج لديّ فكرةٌ كلما تدرجت في دراستي العلمية، بأن أحوّل هذه المعلومات إلى قصص جذابة ومشوّقة للأطفال تمنحهم المتعة والمعرفة معاً، وبدأت أتجرأ على الكتابة بعد أن ترجمت من الإنكليزية بعض القصص للأطفال، فوجدت أن أفكاري أيضاً يمكن أن تصبّ بقالبٍ قصصي، شبيه بما ترجمت، فكانت نقطة البداية، وكم كانت فرحتي كبيرةً عندما نُشرت لي قصتي الأولى عام 1976 وكان هذا أكبر تشجيع لي". (7)
وتعترف "دلال حاتم" بعدم اطّلاعها على أدب الأطفال، عندما دخلت رحابه، وأنها لم تبدع قصةً إلاَّ بعد أن اطّلعت على هذا الفن في لغة أخرى فترجمت منها، تقول: "عندما طلبت مني مجلة "الموقف الأدبي" أن أتحدّث عن تجربتي في الكتابة للأطفال، تملكتني رهبةٌ، أحسست أنني ما أزال بحاجة إلى سنوات كثيرة كي أتابع خلالها الكتابة، لأتمكن من التحدّث عن تجربتي. أما الآن، فتجربتي ما تزال طفلاً يحبو، وككاتبة للأطفال لا أجد ضيراً في الاعتراف بأنني ما أزال أقف على شاطئ هذا الجنس الأدبي، وأنني أخشى اقتحام مياهه العميقة.
لم يكن لي أيّ تجربة سابقة قبل عام 1970 فجأة وجدت نفسي أُندب للعمل في مجلة "أسامة" ومعنى هذا أن أساهم في تقديم مادة يقرأها الأطفال على صفحات المجلة.
كانت هنالك مجلات كثيرة ترد إلى إدارة المجلة، فبدأت بالمطالعة المركزة، ووضعِ الملاحظات في محاولة مني للإمساك بطرف الخيط. كانت لديّ الرغبة في الكتابة، ولكن الخوف يلجمني، كنت كمن أُلقي به في فراغٍ يحاول التمّسك بأيّ شيء ليتخلّص من حالة انعدام الوزن.
بدأت الترجمة عن اللغة الفرنسية ـ قد تكون هذه البداية خطأ ـ ولكن هذا ما فعلته. وضع زميلي الأستاذ سعد الله ونوس ـ وكان رئيس تحرير وقتذاك ـ أصابعي في الشق. اعتذرت أنني لا أملك تجربة سابقة، فقال لي: وأنا أيضاً لا أملك تجربة سابقة، ولكن هنالك حجم عمل علينا أن نقوم به.
مع متابعتي لمطالعة مجلات وكتب الأطفال التي ترد إلى إدارة المجلة، بدأت بمطالعة كتب أخرى في علم النفس وتربية الطفل لأفهم القارئ الذي أتوجّه إليه.
كانت نكسة حزيران ما تزال جاثمة على صدورنا، ومرارتها كالعلقم في فمنا، فتوجهت إلى القصص الوطنية، وكانت أول قصة من تأليفي نشرت على ثلاث حلقات في مجلة أسامة، بعنوان (الغريب).." (8)
دور النشر الخاصة:
على الرغم من الدور الاستباقي الذي اتجهت إليه دور النشر الخاصة في مرحلة مبكرة نحو الطفولة، إلاَّ أنها لم تلعب الدور المنشود في إيجاد قصة طفلية ذات ملامح فنية، فكثيرٌ من منشوراتها كان معتمداً على القصص الدينية التي تبسّط السيرة النبوية للصغار، إلى جانب القصص المستمدة من ألف ليلة وليلة، والسِيَر الشعبية، كرحلات السندباد وعلاء الدين والمصباح السحري وعلي بابا والأربعين لصاً وجحا وقراقوش.. وقد كان لدور النشر هذه أن تلعب دوراً بارزاً في الحياة الأدبية والثقافية لولا نزعتُها التجارية البحتة، التي تجلّت في إهمال تاريخ النشر وعدم ذكر اسم المؤلف، والمترجم، ومكان الطباعة، فضلاً عن أنها لم يُهيأ لها كاتب أديب جادٌّ كالذي تهيأ لدور النشر المصرية، من أمثال كامل كيلاني، الذي قام باستلهام حكايات ألف ليلة وليلة، وبسّطها وقدّمها للأطفال، وكان أوّلها السندباد البحري عام 1927.
ومع ذلك فإن قلةً من دور النشر السورية عمدت إلى تبسيط الروائع العالمية، كقصة مدينتين، لـ "تشارلز ديكنز" ومسرحيات "شكسبير" التي بُسّطت بقالبٍ قصصي، وحول العالم في ثمانين يوماً، إضافةً إلى تبسيط المؤلفات العربية، كقصص ألف ليلة وليلة، وسِيَر الأبطال وعظماء العرب والمسلمين، وكان لدار الشرق بحلب الدورُ البارز والرائد في هذا المجال، إذ ابتدأت مشروعها الجديد في نشر كتب الأطفال العربية والعالمية، في عهد الوحدة السورية المصرية، وقد حرص صاحبها "عبد السميع عفش" على ذلك، بعد أن كان يغذّي مكتبته بقصص الأطفال المصرية واللبنانية.
وكانت السمة العامة لقصص الأطفال في مرحلة البدايات، أنها كانت تراعي الثقافة السائدة، وتعبّر عن المزاج العام في الستينيات وما قبل، فقد التفتت التفاتة تاريخية إلى أبطال العرب بصورة خاصة، نقلت من خلالها الجانب الذهبي من الحضارة العربية، وكان لمكتبات حلب الدور الأول في بعث هذا اللون، وعلى رأسها مكتبة ربيع، ومكتبة الشرق، ومكتبة البلاغة، وأكملت مكتبات دمشق الدور، كدار الفكر، ودار كرم، ومكتبة الزهراء، ودار الجليل، ومكتبة أسامة، كما كان لمكتبة التراث في دير الزور دورها اللاحق، وكذلك مكتبة الغزالي بحماة.
الكتابات الجادة:
في مرحلة ما بعد نكسة حزيران، بدأت الدراسات النقدية تقف على الملامح العامة والخاصة لأدب الطفل، والقصة منه على وجه التحديد، فرأت ضرورة تعرّف الكاتب على جمهور الأطفال الذي يكتب له، والمعرفة تعني الاطّلاع على جوانب النمو المختلفة (الذهنية، والنفسية، والاجتماعية، واللغوية) التي يمر بها الطفل، وذلك لأن كثيراً من الأخطاء التي يقع فيها الأدباء، سواء في المضمون أو في البناء الفني، مرّدها عدمُ اطّلاع الكتاب والرسامين عما يناسب الأطفال، وما يحتاجون إليه.
لقد حظيت القصةُ الطفلية في سورية باهتمام النقاد أكثر مما حظي به الشعر، فقد توفّر على دراستها عددٌ من النقّاد من أمثال "د. سمر روحي الفيصل" و"د. عبد الله أبو هيف" و"د. عبد الرزاق جعفر" ثم " علي حمد الله" و"نزار نجار" و"د. عيسى الشماس" وسواهم، ممن تركّزت دراساتهم حول ضرورة الاطّلاع على ما كُتب من دراسات وبحوث حول أدب الطفل، ومراعاة الخصائص الموضوعية والفنية له، التي توصّل إليها أولئك الدارسون.
لقد ابتدأ الكتّاب كتابة القصة من دون أن تكون في أذهانهم رؤيةٌ واضحة لمقومات هذا الفن، الذي قد يلتقي مع فن الراشدين، وقد يختلف عنه في الموضوع والمعالجة، فلم يكن بين أيدي الكتّاب آنئذ تعريف واضح، ولم يصدر مثل هذا التعريف على الصعيد المحلي إلاَّ بعد أكثر من عشر سنوات على البدايات الجادة، فنقرأ على سبيل المثال لـ "سمر روحي الفيصل" قولَه: القصة "جنس أدبي نثري قصصي موجّه إلى الطفل، ملائم لعالمه، يضم حكاية شائقة ليس لها موضوع محدّد أو طول معين، شخصياتها واضحة الأفعال، ولغتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح قيمة ضمنية، وتعبّر عن مغزىً ذي أساس تربوي مستمد من علم نفس الطفل". (9)
وسادت لدى النقاد والكتّاب رؤية فنية ترى أن قصص الأطفال عبارة عن موضوع، أو فكرة لها هدف، تمثل صورة الإبداع الفني التعبيري، تصاغ بأسلوب لغوي محبّب، لأن الأطفال بطبيعتهم يميلون إلى سماع القصة، وينامون في هدوء عند سماعهم لحكايات أمهاتهم وجداتهم. وأن أكثر أنواع القصص الطفلية فائدةً للصغيرة ما كان مستوحىً من البيئة القريبة، ونقصد بذلك بيئة الطفل المنزلية الصغيرة التي يتفاعل معها، والتي تشارك في تنشئة عناصر شخصيته وتكوينها من خلال النماذج المختلفة، فتكسبه العديد من المهارات التي تشارك في بناء هذه الشخصية الغضة.
وقد تعدّدت موضوعات القصة في أدب الأطفال، وتنوعت شخصياتها العفوية منها والمدروسة بعناية، في المطبوعات التي صدرت عن المؤسسات الحكومية، فوُجدت القصص الاجتماعية، وقصص الحيوان، وقصص البطولة والمغامرة، وقصص الخوارق والأساطير والحكايات الشعبية، والقصص التاريخية، وقصص الفكاهة، وقصص الخيال العلمي. وقد راعت معظمها العناصرَ المطلوبة في الأسلوب المعتمد على الوضوح في كتاب القصة، ودقة التعبير، والبساطة في تناول الموضوع، وجمال العبارة. ولكن ما يلاحظ هنا أن معظم هذه القصص لم تحدّد الشريحة الطفلية، أو المرحلة العمرية التي تتوجّه إليها، تبعاً لمراحل النمو اللغوي عند الطفل.
وقد كانت وزارة الثقافة والإرشاد القومي الجهة الرسمية الأولى التي أخذت زمام المبادرة، في طباعة الكتب ونشرها وتوزيعها، ولكن ما يلفت الانتباه أن خطة الوزارة في بداياتها كانت غايتها إيجاد كتاب للطفل فحسب، لذلك كان اللون الطاغي على مطبوعاتها في السنوات الأولى الكتابَ المترجم. وهذا لا يعني عدم الاعتراف بالدور الرسمي الرائد الذي قامت به على صعيد نشر الكتاب الطفلي أولاً، وإصدار مجلة أسامة ثانياً، ثم إجراء مسابقة لكتابة القصة الطفلية ثالثاً، ورابعاً إصدار كتاب أسامة الشهري. ومن ثم إصدار أعدادٍ ممتازة وخاصة من مجلة المعرفة، غدت مع الزمن من المراجع التي لابد منها للمتخصصين.
2 ـ القصة في مجلة أسامة:
يعدّ صدور مجلة أسامة مطلع شهر شباط عام 1969 الخطوة الجادة الأولى نحو تأصيل فن أدبي للأطفال على الساحة السورية بصورة خاصة، والعربية بصورة عامة. وقد غدت وسيلة اتصال هامة من الوسائل الضرورية لثقافة الأطفال، وحققت أول لقاء للطفل مع الثقافة والعلم والأدب والفن، لأنها لعبت دوراً هاماً في تقديم خدمات معرفية جليلة.
لقد كان من أولى مهمات مجلة أسامة مراعاة اختيار الموضوعات والمواد التي تقدّمها لقرّائها الصغار، ومحاولة معرفة الشرائح العمرية التي تتوجّه إليها، بغية تحقيق الحاجات الأساسية للنمو، والتوافق مع الميول، ومستوى التطوّر العقلي واللغوي والاجتماعي، الذي يضع الطفل في عصره، وإعداد الجيل لعالم الغد، والتعامل مع تكنولوجيا العصر بروح علمية وعقل منفتح، إضافة إلى الحرص على تحقيق الانتماء للوطن والحضارة العربية والتراث، وتمثّلِ قيم الدين الحنيف.
إن كلمة "أسامة" التي حملت عنوان المجلة، هي اسم علم جنس الأسد، والأسد ملك الغابة، ورمزٌ للقوة والشجاعة، وهذا ما يؤهله لكي يكون أنموذجاً للبطولة والمغامرة التي يحبها الأطفال، وهي تحيل إلى فن القصّ، فثمة أكثر من إشارة وردت في العدد الأول توحي أن التسمية، لشخصية إسلامية، هي "أسامة بن زيد" حب رسول الله (، وكان فتى شجاعاً، عُرف بالحكمة والأمانة والإخلاص، وهو أصغر قائد في الدولة العربية يقود جيشاً باتجاه بلاد الروم، ويهزمهم شر هزيمة، والذي يُرجّح هذا الرمز، وجود قصة تاريخية في العدد الأول، كتبها "محيي الدين صبحي" بعنوان "بطولة أسامة بن زيد" كما نشرت في العدد الأول أيضاً قصة ثانية مسلسلة، بإسقاطٍ معاصر، تحمل عنوان "أسامة مع الفدائيين" لـ "عادل أبو شنب".
أفسحت المجلة حيّزاً من صفحاتها لقصص الأطفال، وذلك إدراكاً من القائمين عليها، أن الطفل بفطرته ميالٌ للقص والحكي، وقد تشدّد رؤساء التحرير في عدم نشر القصة التي لا تحقق فنيةً عاليةً، وركّزوا اهتمامهم على أن قيمة القصة تتأتّى من آثارها الإيجابية أو السلبية اللذين يتحدّدان من مدى جودة القصة أو رداءتها "ومقاييسُ الجودة أو الرداءة هي قبل كل شيء مقاييس فنية، فالقصة المفيدة للطفل هي القصة الجميلة التي تتحقق فيها شروط الفن القصصي المناسب لأذهان الصغار وأذواقهم، والتي تصدر عن مبدعين حقيقيين".
أخذت القصة مكانها على صفحات المجلة بين مجموعةِ المواد المتنوعة، وقد جاء في قرار إنشاء المجلة (10) إنها تضمّ (32) صفحةً، منها (24) صفحة بالألوان و(8) صفحات غير ملونة، توزّع فيها المواد حسب الحصص الآتية:
صفحتان للغلاف خارجي.
صفحتان لنتاج الأطفال.
صفحتان لصور الأصدقاء، والذين يرغبون في التعارف مع غيرهم.
صفحتان للقصة المؤلفة (محلية ـ عربية).
صفحتان للقصيدة الشعرية.
صفحتان للقصة المترجمة.
صفحتان للتسليات وأوقات الفراغ.
أربع صفحات للمادة العلمية.
صفحتان للريبورتاج المصور.
ثماني صفحات للمسلسلات المصورة (تاريخية ـ مغامرات).
صفحتان متفرقتان.
ومن هذا المخطط، يتضح أن القصة الإبداعية العربية لم تأخذ سوى ما أخذته الصفحات المتنوعة الأخرى، ولم تميّز بشيءٍ من غيرها، وكان نصيبها نسبة 1/16 وهذا مؤشر متواضع على النظرة الرسمية لمكانة القصة. لكنّ ما حدث في الواقع أن أعداداً كثيرة من المجلة لم تلتزم بهذا التوزيع، فطغت القصص في بعض الأعداد على غيرها من المواد الأخرى، واحتلّت عدّةَ صفحاتٍ، وصلت في بعض الأعداد إلى ثلث عدد صفحات المجلة.
ومع ذلك، فإن تخصيص مجلة أسامة صفحتين للقصة، يبدو جيداً إذ ما قيست بغيرها من المجلات المماثلة، التي تصدر في باقي أقطار الوطن العربي. ويبدو أن المجلة تمردّت على مخططها، منذ العدد الأول، فنشرت ست قصص، هي:
بطولة أسامة بن زيد. قصة تاريخية، لـ "محيي الدين صبحي".
أسامة مع الفدائيين. قصة مسلسلة، لـ "عادل أبو شنب".
لماذا سكت النهر. قصة رمزية، لـ "زكريا تامر".
آلة الزمن. قصة مصورة اقتبسها "نجاة قصاب حسن" من رواية لـ "هـ. ج. ويلز".
قصة من دون كلام، قريبة الشبه من الكاريكاتير، لعلها مأخوذة من مجلة أجنبية، ولم يذكر اسم ناقلها.
قصة الطيران، وهي مادة علمية حملت عنوان (قصة) تتحدث عن تجربة (عباس بن فرناس) ذُكر اسم رسامها "حسان أبو عياش" ولم يُذكر اسم كاتبها.
وقد حملت القصص سمات فنية وعلمية، ضمنية ومباشرة، لا يضاهيها في المستوى الفني الرفيع إلاَّ القصص التي بدأت تنشرها ـ بعد ذلك ـ مجلتا "المزمار" و"مجلتي" اللتان صدرتا عن دائرة ثقافة الأطفال العراقية ببغداد، ومع ذلك فإن تعامل مجلة أسامة مع القصة بدا جيداً، نظراً لتوالي عددٍ من رؤساء التحرير والمحررين من كتاب القصة والمسرحية المرموقين على رئاسة تحريرها، وهم "سعد الله ونوس، وزكريا تامر، وعادل أبو شنب، ودلال حاتم، ثم بيان الصفدي" ولكن الدخول إلى صميم العمل الإداري الفني في المجلة يُظهر مدى معاناة رئيس التحرير في إخراج القصة للنور، وقد بيّنت "دلال حاتم" كثيراً مما كانت تعانيه في التعامل مع القصة قبل نشرها، لأن بعض القصص ـ كما تقول ـ يجب أن تكون "عجينة لينة كي يستطيع العاملون في المجلة قولبتها بالشكل الذي يرونه مناسباً" (11) من تنقيح لغوي، وتشذيب فني، ورسوم، وحجم خط، وقد تضطر إعادتها إلى كاتبها، وتطلب إليه تعديل بعض فقراتها وإعادة كتابتها من جديد.
ومع ذلك، وعلى الرغم من خبرة رؤساء التحرير وتشددهم، فإن عدداً من السلبيات اعتور المادة القصصية في المجلة، فعلى سبيل المثال، ضمّ العدد (220) من المجلة قصةً تفتقر إلى مقومات التربية، حيث يروي طفل لرفاقه أن أباه عندما كان صغيراً رمى "بالوناً" تحت عجلات سيارة عامداً، وقصةً أخرى مترجمة لـ "أندرسون" تقوم على السحر والاغتيال والموت، وقصةً ثالثة تحكي عن أخ يذبح أخاه الأصغر، ويشق بطنه، ليرى ماذا أكل في غيابه، وهي صورة رهيبة، لا يجوز أن تعرض على طفل، وفي العدد قصةٌ مسلسلة أخرى، توشك أن تتحوّل إلى قصة "بوليسية" عن القتل والخيانة، ودورُ الخائن فيها أكثر بروزاً من دور غير الخائنين". (12)
ولكن ـ على الرغم من ذلك ـ فإن الكتّاب منذ أن بدأوا التوجه الجدي للطفل، برزت طاقة من الإبداع، موشاة بملامح إنسانية جديدة في قصص عدد من الكتّاب من أمثال نزار نجار، وأيوب منصور، عزيز نصار، لينا كيلاني وسواهم، كما توشّى عدد منها بالبعد الاجتماعي التربوي الذي يعبّر عن تآلف الأسرة، وذلك بسبب التقاليد المألوفة في المجتمع العربي من جهة، وفي رغبة الكتّاب الانطلاق من الرؤية التربوية من جهة أخرى، فكانت القصص الاجتماعية الهادفة، كما تجلت في قصص دلال حاتم، وليلى صايا، وجمانة نعمان.
.../...
انشغل الأدب العالمي بأدب الطفل، وعلى الرغم من مرور هذا الأدب بالعديد من المراحل التاريخية، إلاّ أن الاهتمام به جاء في ثلاثة القرون الماضية؛ بمعنى ابتدائه منذ عصر النهضة في أوربا.. ناقلاً مرحلةً كان يسيطر فيها سابقاً أدب الشفاهية، على شكل حكايات وأساطير تناقلتها الألسن جيلاً بعد جيل.. وفي وطننا العربي تشير المراجع التاريخية إلى أن أدب الطفل قد تأخر كثيراً جداً مقارنةً مع انتشاره وتطوره في أوربا.
لقد لاقى هذا الجنس الأدبي قبولاً غريباً لدى الناس في الغرب والشرق كافة، ويروي تاريخ الأدب أن قصةً واحدةً "كتبتها زوجة كاهن بروتستانتي" عن "جزيرة البرنس إدوارد" حيث كانت تعيش في فقر وعزلة موحشة، قبل مئة عام، في مزرعة كافنديش شمال الجزيرة على ساحل كندا الأطلسي، قد فعلت هذه القصة فعل السحر في العالم. مع أنها قصة للأطفال تتحدث عن جزيرة تربتُها فقيرةٌ حمراءُ اللون، لا تُنتج غير البطاطا، ولا تكفي لإطعام سكانها البالغ عددهم 140 ألفاً. وبسبب هذه القصة البسيطة أخذ السياح يتوافدون على الجزيرة كل عام، بمعدل مليون وخمسمائة ألف شخص. وهذا يشهد على عظمة الأدب وشدة تأثيره في وجدان البشر. فما الذي يدفع مئات الألوف لعبور القارات والبلدان (مئة ألف زائر من اليابان فقط) إلى جزيرة صغيرة مناظرُها الطبيعية لا تختلف عن مناظر الأماكن الأخرى في كندا، وفنادُقها أغلى سعراً؟!.
لقد بدأ العالم الغربي بإحياء فن رواية القصة، وما يتبعه من حكايات شعبية من أجل مجابهة الواقع المادي، بكل صراعاته وآلامه، بزرع أمل رومانسي، وحلم عاطفي، بنقاء الأرواح الإنسانية لتجاوز الصراعات والآلام، متفائلة بغد مشرق.
يعدّ كتاب "حكايات أمّي الإوزّة" الذي صدر في فرنسا عام 1697 لمؤلّفه "تشارلز بيرو" (1628 ـ 1703) أوّل كتاب أدبي خاص بالأطفال، يحتوي على مجموعة من الحكايات الشعبيّة تشكّل بداية مرحلة جديدة في تاريخ تطوّر أدب الأطفال، إذ ظهر مستقلاً عن الآداب الشّعبيّة. ومنذ ذلك الزمن بدأ أدب الأطفال في استقطاب أجناس متعدّدة من التراث، وظلّت الحكاية الشعبيّة في ألمانيا موجّهة للكبار حتّى أصدر "الأخوان جريم" (يعقوب 1785 ـ 1863، وفلهلم ـ أو ـ وليم 1786 ـ 1859) الجزء الأوّل من كتابهما "حكايات الأطفال والبيوت" عام 1812 وفي نهاية عام 1914 ظهر الجزء الثاني. ولم يجد أيّ صعوبة في تقديم الحكايات الشعبيّة للأطفال، ثم كانت النقلة النوعية بظهور كتاب "أليس في بلاد العجائب" عام 1846 الذي عدّه النقاد (البركان الروحي) لأدب الأطفال، جاء بعده الكاتب الدانمركي "هانس كريستيان أندرسن" (1805 ـ 1873) بأقاصيصه التي عُدّت بداية العصر الرومانتيكي، والتي لا يزال الأطفال يتداولونها حتى اليوم، بعد أن ترجمت إلى لغات العالم.
في عام 1930 بدأ الحديثُ عن "أدبيات الطفل" يتردد على ألسنة المربين العرب والكتّاب في الدوريات العربية، وظهرت إلى الوجود ملامح تأصيل جنس أدبي للطفل، وقبل هذا التاريخ، كانت كتب الأطفال تقتصر اقتصاراً ـ يكاد يكون تامَّاً ـ على الأغراض التعليمية "مادةً للقراءة المدرسية" تهتمّ بالمحصول اللغوي، وتدعو إلى القيم والآداب الحميدة، والتمسك بالدين، ثم وُجدت أصوات تدعو إلى ضرورة الاهتمام بالتأليف للأطفال بعيداً عن التعليم، وبدأت تستحوذ على اهتمام المختصين في مصر الشروطُ الواجب توافرها في الكتب الموجهة للصغار، سواء من حيث الشكل، أو من حيث المضمون، محاولةً منهم لحثّ كُتَّاب الطفل على تقديم الأفضل، وقد أشاد "د. زكي مبارك" برائدين، فقال: "أشهر المؤلفين في هذا الباب رجلان: محمّد الهراوي، وكامل الكيلاني، وهما بعيدان عن التدريس". (1)
لقد نجحت القصة الطفلية ـ في مصر، خاصة ـ في الاستفادة من التراث، ولعل سبب نجاحها في هذا التوّجه، عائدٌ إلى طبيعة الجنس الأدبي القصصي، الذي رأى في التراث جانباً درامياً بتسليط الضوء على ثنائية التضاد، أو المفارقة الفنية في الخير والشرّ، والحق والباطل، والعدل والظلم، والجمال والقبح، مستغلةً ما استوحته في ذلك من التراث الشعبي الموروث. كسِيَر "عنترة، وذات الهمة، والملك الظاهر بيبرس، وسيف بن ذي يزن، وعلي الزيبق، وشهرزاد، والسندباد..." وسواها من السِيَر التي اجتمعت في شخصيات أبطالها، إلى جانب الصفات الإنسانية، جوانبُ سحرية خارقة، مما جعل "السيرة الشعبية تمثّل ذخيرةً عربية لا تنفذ مهما قُدّمت في أشكالها، وزاداً لا ينتهي، حينما تغدو مصدراً جيداً من مصادر ثقافة الطفل، لا تقلّ أهمية ـ إن لم تكن تتفوّق ـ على هؤلاء الأبطال المعاصرين، الذين يتفوّقون بالحاسوب وغيره من الأدوات العصرية" التي يمكن الاستفادة منها في تشكيل وجدان الطفل. (2)
في المصطلح والهدف:
إن مصطلح "أدب الأطفال" يعني الأدب الموجه إلى الصغار بالتعبير الاصطلاحي، لأن مُجمل عملية إنتاج أدب الأطفال تحمل في مراحلها المختلفة خصوصية عناصره ومجمل أهدافه أيضاً، ومن ثم، فإن القنوات والوسائط التي يمر منها هذا الأدب على عالم الصغار تؤدي إلى تلقيه وانتشاره. لذلك فهو يتوجّه بصورة عامة إلى مرحلة الطفولة المحددة، التي يُكتب لها، من دون أيّ اختلاف في روح الأدب ذاته. فحين نتحدّث عن "أدب الراشدين" أو الموجه إلى الكبار، فإننا لا نستعمل هذا المصطلح، بل نكتفي بلفظ "الأدب" من دون إضافة كلمة الكبار. ومن جهة أخرى، فليس هناك أيّ تمديد لأجيال الكبار وملاءمة الأدب لها. إذ يُكتب الأدب للكبار من جيل الثامنة عشرة، وما فوق، من دون أيّ فصل بين مراحل هذا الجيل. وهنا تبدو خصوصية أدب الأطفال الذي يعدّ الأدب الوحيد الذي يلتصق اسمُ نوعِه باسم متلقّيه، ويراعي فيه الكاتب المستويات الفكرية والمعرفية لجمهوره، ولا يكون ذلك من خلال مستوياته الفكرية والمعرفية هو ككاتب مبدع، وإنما من خلال جمهوره، لأنه يدرك من البداية أن المتلقي الذي ينتظره في نهاية بحر الإبداع هو طفل، وأن عليه أن يحدد قاموسه المعرفي واللغوي وتركيبه الفسيولوجي والبيولوجي، لتحديد ميوله الفكرية، والانطباعية للفكر الذي يتلقاه، فيستعيد ذاكرته وغرائزه الطفولية بفكر واع لكاتب مبدع.
إن مصطلح أدب الأطفال، يطلق على "الأدب المكتوب للأطفال بصورة خاصة، ويتميز بملاءمته لمراحل الطفولة المتعددة والمختلفة" (3) وهذا من شأنه التمييز في المصطلح، بين الأدب، وروح الأدب، والتي يصعب تساويهما عند طفل وكهل. تماماً كما هي روح الإنسان؛ الروح واحدة، وإن كانت في جسد طفل، أو في شخص رجل كبير.
إن أهم ما يميز أدب الأطفال من أدب الكبار، هي فكرة التناسلية؛ أي مراعاة المرحلة العمرية التي يمر بها الطفل. كما أن الطفولة نفسها ليست مرحلة واحدة، فما يُضحك طفلَ العاشرة قد يثير رعباً أو خوفاً لطفل الخامسة، ولهذا يراعي الأديب ذلك في مضموناته، وفي لغته، وفي كل تفاصيل الجنس الأدبي الذي يقدمه للطفل.
لو تتبعنا بدايات أدب الأطفال في سورية سنجد أن ميلاد الشعر كان سبّاقاً للقصة، وذلك لأن الشعر الطفلي نشأ في ظل التربية والتعليم، وكانت المدارس ـ ولا تزال ـ تثبت القصيدة في كتبها بين مواد القراءة والإنشاء والمحادثة، وهي تغري الطفل بإيقاعها الغنائي، وبالحفظ والاستظهار الحرفي أكثر من أيّ مادة تعليمية أخرى، فضلاً عن أن المطبوعات الخاصة بالطفل التي تُنشر بجهود خاصة، أو في دور نشر تجارية، تؤكد على أن الشعر فنياً سبق القصة في هذا الاتجاه، فقد نشرت المكتبة الهاشمية بدمشق عام 1937 كتاب "الاستظهار المصور في أدب البنين والبنات" في حلقتين، لـ "جميل سلطان".
إن جميع الذين كتبوا للصغار انطلقوا من المدارس، وكان غرضهم رفد مناهج التعليم التي تسعى إلى ترسيخ قيمٍ تربوية مرتبطةٍ بالقيم الروحية، ولكنها غالباً ما تقدَّمُ بأسلوب الوعظِ، وإزجاء النصح، ثم خفتت هذه النزعة مع تقدّم الزمن، وازديادِ الزخم القومي، بسبب توالي الأحداث التي عصفت بالوطن. فاتسعت القيمُ الخلقيةُ إلى جانب القيم القومية، وهذا من شأنه الإخلال بتوازن المنظومة. نظراً لعدم التكامل في العطاء والتوجّه. وقد لعبت التناقضات السياسية دوراً بارزاً في دفع الشاعر للتطلّع إلى الأفق القومي. في حين تأخّرت القصة كثيراً عن هذا التاريخ، إذا اعتبرنا القصص الدينية، وغيرها من القصص الشعبية، واللوحات الحكائية المدرسية الأخرى التي تشبه موضوعات التعبير، ذات الأسلوب الإنشائي العالي، خارج إطار القصة الفنية، والتي تخلو من معايير التربية الحديثة بأهدافها القيمية.
يدرك الأدباء، ويؤكد النقاد، على أن القصة شيء من غذاء العقل والخيال والذوق عند الأطفال، وهي تتيح للأطفال أن يطوفوا على أجنحة الخيال في عوالم شتى العوالم، ويلتقوا بأشخاص قد يشبهونهم أو قد يسعدهم التشبّه بهم، ويتجاوز الأطفال في قصصهم أبعاد الزمان والمكان، فيجدون أنفسهم في يومهم هذا، أو يجدونها في عصور غابرة، أو عصور لم تأت بعدُ، ويقفون عند حوادث حصلت بالأمس، أو قد لا تحدث مطلقاً، ويتعرّفون على قيم وأفكار وحقائق جديدة. وهم شديدو التعلّق بالقصص، يحبون أن يستمعوا إليها، أو يقرؤوها بشغف، يحلقون في أجوائها، ويتشبّعون بما فيها من أخيله، فيتجاوزون من خلالها أجواءهم الاعتيادية، ويندمجون بأحداثها، يتعايشون مع أفكارها، خصوصاً وأنها تقودهم بلطف ورقة وسحر إلى الاتجاه الجمالي الذي تحمله، إضافة إلى أنها توفر لهم فرصاً للترفيه وتزجية أوقات الفراغ في نشاط ترويحي، وتشبع ميولهم إلى اللعب، وهي بذلك ترضي مختلف المشاعر والأمزجة والمدارك والأخيلة، بوصفها عمليةَ مسرحةٍ للحياة والأفكار والقيم.
والقصص بفضل مسرحتها وما فيها من معان أصبحت وعاءَ تجسيدٍ للثقافة، ما دامت الثقافة أسلوباً للحياة إذ إنها تجعل للحياة أبعاداً جديدة، فتبدو معقدة أو مشوقة أو غريبة أو قريبة إلى حياة الطفل (4) ومن ثم لا يمكن إغفال الدور الثقافي للقصة في الطفل فهي تحمل مضموناً ثقافياً من خلال ما تتضمنه من أفكار ومعلومات علمية وتاريخية وجغرافية وفنية وأدبية ونفسية واجتماعية.
أنموذج من قصص البدايات:
لم تكن القصة معروفة كجنس أدبي في الكتاب المدرسي، فقد كانت تتغلغل كنص للقراءة الصامتة والجهرية في كتاب القراءة، وعلى سبيل المثال فقد ورد نص شبيه بالقصة في كتاب الصف الخامس الابتدائي المقرر عام 1954 ص 105 بعنوان "لا سحر في الكلمات" بالصيغة الآتية:
1 ـ كان سعيد طفلاً مهملاً، ففي يوم واحد ترجّح على غصن شجرة التفاح فكسره وتسلّق شجرةً ومعه دميةُ أخته، فمزق ضفائرها حتى صارت خيوطاً، واصطدم بطبقٍ جديد فكسره، وبعد كل حادث كان يبادر فيقول: "إني آسف" وكان سعيد يعتقد أن تمنحه هذه الجملة العفو والغفران.
2 ـ وفي اليوم التالي، وكانت الأسرة تتناول عشاءها، أسقط سعيد قشدة اللبن على غطاء المائدة غافلاً فقال: "إني آسف" فما كان من والدته إلاّ أن خلعت مئزرها الأبيض، وجعلته عمامة على رأسه بدل تأنيبه، وناولته عصا من زجاج انتزعتها من حامل المناشف، وقالت لـه: "أنت الآن ساحر وهذه عصاك السحرية فردد الكلمة السحرية "إني آسف" عشر مرات على بقعة القشدة هذه "فأطاع أمرها، وظل سائر أفراد العائلة يكتمون ضحكهم، فلما انتهى، قالت لـه "هل زالت البقعة؟" فقال سعيد وقد خنقته العبرات: "لا. إنها لن تزول حتى إذا قلت "إني آسف" مليوناً من المرات"، فقالت له أمه: "هذا ما أردت أن تعرفه، فإن كلمة "إني آسف" لا تمحو بقعةً كان من الممكن أن نتجنبها بشيء من الحذر والانتباه".
ولم تعد والدة سعيد تذكر له الإهمال، لأن عصا الزجاج كانت تنتظره.
تعليق:
أُدرجت القصة بين دروس القراءة، من دون أن تكون فيها إشارة تميّزها من غيرها، ولا شيء يدل على أنها قصة، ويمكن أن نلاحظ أن:
1 ـ جملها طويلة.
2 ـ لغتها عالية جداً. وصيغة العنوان ليست سهلةً
3 ـ قسمت القصة إلى مقطعين. وبرزت فيها شخصيتان، في حدث أسري منزلي، ولكنها لم تراعِ أسلوب كتابة القصة، من حيث التنسيق الكتابي، فامتزج الحوار بالسرد.
4 ـ حرصت القصة على خصوصية العنوان، فجعلته في ثنايا السرد بين هلالين صغيرين.
5 ـ اعتمدت القصة على الأسلوب المباشر في العرض، فقررت: "كان سعيد طفلاً مهملاً" ولم تترك للطفل المتلقي أن يستنتج تلك القيمة/الإهمال، بنفسه، ثم ابتعدت القصة عن المباشرة حين اعتمدت على الاستنتاج، وطرح قيمة ضمنية، تجلّت في وقوف سعيد بنفسه على خطئه، لكن المباشرة ما لبثت أن تدخلت، حين أكّدت الأم على العبرة والمغزى في النهاية بقولها: "هذا ما أردتُ أن تعرفَه، فإن كلمة "إني آسف" لا تمحو بقعة كان من الممكن أن تتجنبها بشيء من الحذر والانتباه".
6 ـ حافظت القصة على وظيفتها التعليمية التربوية، بما تضمنته من قيم تندرج في إطار العلاقات الاجتماعية كالحفاظ على الأثاث المنزلي، وحب النظافة، واحترام رأي الأم، ومراعاة السلوك الأمثل في آداب المائدة، وتصّورٍ عام لما يجب أن يكون عليه الإنسان في حياته، وعلاقاته مع الآخرين. كما رسمت لـ ( الساحر) سمتاً ذا خصوصية معينة، يقوم على الإضحاك.
7 ـ حافظت القصة بحساسية مرهفة على خصوصية دور الأم الذي ارتبط بالتدبير المنزلي وجعلته الغاية المثلى، والهدف الأول.
شهادات:
تنبّهت وزارة التربية إلى الصورة الجديدة التي يجب أن يكون عليها الطفل العربي، فخرجت بمنهاج جديد للمرحلة الابتدائية، نظمه القرار 1285 تاريخ 17/9/1967 تتلخص بنوده بـ: "خلقِ فردٍ ذي شخصية متكاملة منفتح على الحياة والعلم.." وراعى أن تكون القصة من صميم المطالعة، وخصّ كلاً من الصفين الخامس والسادس بكتاب ذي موضوع (شبه قصصي) لكل صف، الأول أعدّه "منير الخير" بعنوان "قصص قصيرة" طبع وضم ست قصص يبدو أنها مترجمة، باستثناء قصة "شجرة الليمون الصغيرة" والثاني "قصص مختارة" طبع عام 1970 وهو من إعداد "يوسف بنا وعادل زريق" وقد استقيا مادته من كتابات عربية سورية لـ "أديب نحوي، وعبد الرحمن الباشا، وعبد الله عبد" ومن مادةً للمستشرقة الألمانية "زيغريد هونكه" وجزءاً من مذكرات "فالنتينا" رائدة الفضاء السوفياتية، ومسرحية "قطرة الماء" لـ "سليمان العيسى" وترجمة لـ "أبي بكر الرازي".
وقد وجد المربون أن القصة تحقق الصورة المأمولة التي رسمها المنهاج المدرسي، فجعلوها تتغلغل في كتب المرحلة الابتدائية، وجعلوا من بين أهدافها الاستمتاعَ والترفيه، الذي لا يخلو من قيم خلقية وتوجيه تربوي، وهذا اللون من القصص المدرسية يختلف عن القصص التي بدأ الكتّاب ينشرونها مجموعات خاصةٍ، تراعي الاعتبارات الفنية العامة لأدب القصة، وتستفيد من خبرات الأمم الأخرى، في ما أنتجه هذا الفن الجديد والصعب. وقد كان كتاب "فن الكتابة للأطفال" للباحث المصري "أحمد نجيب" (دار الكاتب العربي. القاهرة 1969) مرجعاً للعديد من كتّاب أدب الأطفال ونقاده في سورية.
إن البدايات القصصية تحمل سمات الكتابة العفوية التي قد لا تقترب من مقومات القصة الفنية، وهذا ما جعل بعضها يغرق في المباشرة. لأنها لم تنطلق من رؤية إبداعية مستندة إلى مرجعية تراثية، بقدر ما كانت تراعي النظرات التربوية، لأن جل كتابها كانوا من المعلمين وليسوا من الأدباء المبدعين، وحتى الكتاب المتمرسون لم يكونوا على بيّنة من أمرهم، وما اصطادوه من حكايات منثورة في كتب التراث وقصص العرب، وأخبار التاريخ فيبسّطونها، أو ينقلونها بعفوية ويضفون عليها شيئاً من أفانين العصر.
ولكن على الرغم من بساطة البدايات وعفويتها، وعدم مراعاتها السمات الفنية للقصة الطفلية، فإنها شكلت جذوراً تاريخية على الصعيد الأدبي، ساعدت الكتاب على تطويرها شيئاً فشيئاً. حتى بدأت تقف على رجليها، وتحديداً إثر نكسة حزيران عام 1967 التي كانت أشبه ببوق الخطر الذي نبه عقول المثقفين إلى ما يحلّ بالأمة، وأدخل في روعهم أنه لم يبق لها أمل إلاَّ في جيلها الناشئ.
إن من أسباب تأخّر القصة الطفلية عن الشعر في سورية، أن شعر الأطفال كان بصورة من الصور امتداداً لديون الشعر العربي، بينما دخلت القصة في المنهاج المدرسي من دون جذور تاريخية واضحة، وما جاء مستحدثاً منها، ليس سوى لوحات قصصية، وأنها لم تولد ولادة حقيقية في المكتبة السورية إلاَّ بعد أن التفتَ للاشتغال بها ثلاثةُ كتاب، كان لهم باعهم الطويل في الكتابة القصصية والروائية، هم "زكريا تامر وعادل أبو شنب وعبد الله عبد" وربما كان لـ "تامر وأبو شنب" دورٌ كبير في إغناء التجربة الطفلية بصورة عامة، فقد ساعدا ـ بحكم موقعهما الإداري والأدبي في مؤسسات الدولة الثقافية ـ على إصدار مجلات وصفحات في الصحف اليومية، فكان لذلك أبعد الأثر في تنبيه الرأي العام الثقافي إلى هذا الجنس الأدبي الوليد، وقد توالى الاثنان على رئاسة تحرير مجلة أسامة.
لقد كانت هزيمة عام 1967 مؤشراً هاماً على تحوّل الكتابة بصورة عامة وأدب الأطفال بصورة خاصة، يقول "سليمان العيسى": (5)
"وذات يوم أفاقت أمتنا العربية على كارثة من كوارثها المتلاحقة على نكسة حزيران.. في هذه الزوبعة السوداء الخانقة، التفتُّ إلى الأطفال، رأيت في عيونهم غد الأمة العربية ومستقبلها، فتساءلت: لمَ لا أتجه إليهم؟ لمَ لا أكتب لهم؟ لمَ لا أنقل إليهم همومي كلها؟. الشهيدُ الذي يسقط على أرض المعركة وهو يقاتل الغزو الأسود، لا أستطيع أن أنتقم لـه بأحسن من أغنية تحمل قطرة من دمه، وتتردد حارةً على شفاه الأطفال.. نتوارى نحن. نيبس. نجف. ويأتي أطفالنا أمواجاً متلاحقة ترفد المد العظيم.. من إيماني بهذه الحقيقة الصغيرة الكبيرة المتواضعة الشامخة بدأت رحلتي مع الصغار، أخذت أكتب لهم. أغني معهم. أنفق الساعات الطويلة بينهم أختار لهم الكلمة المشرقة، والموسيقا المعبرة".
وينطلق "زكريا تامر" من التوجه الوطني والقومي نفسه، فيعبر عن عجز الكبار من خلال الأمل في الصغار، قائلاً: "عندما جاءت حرب حزيران ونتائجها ازداد ارتباطي بالواقع، وصار أكثر حدةً وصرامة، وابتدأت أنظر إلى الصغار نظرة مختلفة. إنهم الجيل الذي سيُطلب منه في المستقبل أن يجابه عدواً شرساً، ولذا فلا بد من منحه الوعي وإرادة التحدي، والرغبة العميقة في التغيّر والحفاظ عليه.. لابد من أن يكون جيلاً قادراً على التضحية في سبيل العدالة والحرية والفرح". (6)
لكن تجربتي كل من "دلال حاتم، ولينا كيلاني" تبدوان مخالفتين للشهادتين السابقتين، فقد اعترفت الكاتبتان بأنهما لم تستطيعا الكتابة للأطفال إلاَّ بعد محاولتيهما في ترجمة القصص الأجنبية، تقول "لينا كيلاني": "لم يكن يفصلني عن عالم الطفولة زمن طويل، وأنا طالبة جامعية في السنة الأولى، عندما وجدت لديّ الحماسة الكافية لأن أغامر بالكتابة للأطفال، وقد كنت لا أزال مشبعة بروح الكتب الكثيرة التي قرأتها، والأفلام، والمسرحيات، وباختصار، عالم الطفولة الكامل.
وكان لاتصالي بالطبيعة، وأنا في كلية الزراعة أثرٌ كبير في أن أكتشف الصلة بين الأشياء وبين الحياة، فكأن الشجرة كانت تتكلم، والطير يلبس شخصية طفل منطلق، وهكذا..
وتدريجياً بدأتْ تنضج لديّ فكرةٌ كلما تدرجت في دراستي العلمية، بأن أحوّل هذه المعلومات إلى قصص جذابة ومشوّقة للأطفال تمنحهم المتعة والمعرفة معاً، وبدأت أتجرأ على الكتابة بعد أن ترجمت من الإنكليزية بعض القصص للأطفال، فوجدت أن أفكاري أيضاً يمكن أن تصبّ بقالبٍ قصصي، شبيه بما ترجمت، فكانت نقطة البداية، وكم كانت فرحتي كبيرةً عندما نُشرت لي قصتي الأولى عام 1976 وكان هذا أكبر تشجيع لي". (7)
وتعترف "دلال حاتم" بعدم اطّلاعها على أدب الأطفال، عندما دخلت رحابه، وأنها لم تبدع قصةً إلاَّ بعد أن اطّلعت على هذا الفن في لغة أخرى فترجمت منها، تقول: "عندما طلبت مني مجلة "الموقف الأدبي" أن أتحدّث عن تجربتي في الكتابة للأطفال، تملكتني رهبةٌ، أحسست أنني ما أزال بحاجة إلى سنوات كثيرة كي أتابع خلالها الكتابة، لأتمكن من التحدّث عن تجربتي. أما الآن، فتجربتي ما تزال طفلاً يحبو، وككاتبة للأطفال لا أجد ضيراً في الاعتراف بأنني ما أزال أقف على شاطئ هذا الجنس الأدبي، وأنني أخشى اقتحام مياهه العميقة.
لم يكن لي أيّ تجربة سابقة قبل عام 1970 فجأة وجدت نفسي أُندب للعمل في مجلة "أسامة" ومعنى هذا أن أساهم في تقديم مادة يقرأها الأطفال على صفحات المجلة.
كانت هنالك مجلات كثيرة ترد إلى إدارة المجلة، فبدأت بالمطالعة المركزة، ووضعِ الملاحظات في محاولة مني للإمساك بطرف الخيط. كانت لديّ الرغبة في الكتابة، ولكن الخوف يلجمني، كنت كمن أُلقي به في فراغٍ يحاول التمّسك بأيّ شيء ليتخلّص من حالة انعدام الوزن.
بدأت الترجمة عن اللغة الفرنسية ـ قد تكون هذه البداية خطأ ـ ولكن هذا ما فعلته. وضع زميلي الأستاذ سعد الله ونوس ـ وكان رئيس تحرير وقتذاك ـ أصابعي في الشق. اعتذرت أنني لا أملك تجربة سابقة، فقال لي: وأنا أيضاً لا أملك تجربة سابقة، ولكن هنالك حجم عمل علينا أن نقوم به.
مع متابعتي لمطالعة مجلات وكتب الأطفال التي ترد إلى إدارة المجلة، بدأت بمطالعة كتب أخرى في علم النفس وتربية الطفل لأفهم القارئ الذي أتوجّه إليه.
كانت نكسة حزيران ما تزال جاثمة على صدورنا، ومرارتها كالعلقم في فمنا، فتوجهت إلى القصص الوطنية، وكانت أول قصة من تأليفي نشرت على ثلاث حلقات في مجلة أسامة، بعنوان (الغريب).." (8)
دور النشر الخاصة:
على الرغم من الدور الاستباقي الذي اتجهت إليه دور النشر الخاصة في مرحلة مبكرة نحو الطفولة، إلاَّ أنها لم تلعب الدور المنشود في إيجاد قصة طفلية ذات ملامح فنية، فكثيرٌ من منشوراتها كان معتمداً على القصص الدينية التي تبسّط السيرة النبوية للصغار، إلى جانب القصص المستمدة من ألف ليلة وليلة، والسِيَر الشعبية، كرحلات السندباد وعلاء الدين والمصباح السحري وعلي بابا والأربعين لصاً وجحا وقراقوش.. وقد كان لدور النشر هذه أن تلعب دوراً بارزاً في الحياة الأدبية والثقافية لولا نزعتُها التجارية البحتة، التي تجلّت في إهمال تاريخ النشر وعدم ذكر اسم المؤلف، والمترجم، ومكان الطباعة، فضلاً عن أنها لم يُهيأ لها كاتب أديب جادٌّ كالذي تهيأ لدور النشر المصرية، من أمثال كامل كيلاني، الذي قام باستلهام حكايات ألف ليلة وليلة، وبسّطها وقدّمها للأطفال، وكان أوّلها السندباد البحري عام 1927.
ومع ذلك فإن قلةً من دور النشر السورية عمدت إلى تبسيط الروائع العالمية، كقصة مدينتين، لـ "تشارلز ديكنز" ومسرحيات "شكسبير" التي بُسّطت بقالبٍ قصصي، وحول العالم في ثمانين يوماً، إضافةً إلى تبسيط المؤلفات العربية، كقصص ألف ليلة وليلة، وسِيَر الأبطال وعظماء العرب والمسلمين، وكان لدار الشرق بحلب الدورُ البارز والرائد في هذا المجال، إذ ابتدأت مشروعها الجديد في نشر كتب الأطفال العربية والعالمية، في عهد الوحدة السورية المصرية، وقد حرص صاحبها "عبد السميع عفش" على ذلك، بعد أن كان يغذّي مكتبته بقصص الأطفال المصرية واللبنانية.
وكانت السمة العامة لقصص الأطفال في مرحلة البدايات، أنها كانت تراعي الثقافة السائدة، وتعبّر عن المزاج العام في الستينيات وما قبل، فقد التفتت التفاتة تاريخية إلى أبطال العرب بصورة خاصة، نقلت من خلالها الجانب الذهبي من الحضارة العربية، وكان لمكتبات حلب الدور الأول في بعث هذا اللون، وعلى رأسها مكتبة ربيع، ومكتبة الشرق، ومكتبة البلاغة، وأكملت مكتبات دمشق الدور، كدار الفكر، ودار كرم، ومكتبة الزهراء، ودار الجليل، ومكتبة أسامة، كما كان لمكتبة التراث في دير الزور دورها اللاحق، وكذلك مكتبة الغزالي بحماة.
الكتابات الجادة:
في مرحلة ما بعد نكسة حزيران، بدأت الدراسات النقدية تقف على الملامح العامة والخاصة لأدب الطفل، والقصة منه على وجه التحديد، فرأت ضرورة تعرّف الكاتب على جمهور الأطفال الذي يكتب له، والمعرفة تعني الاطّلاع على جوانب النمو المختلفة (الذهنية، والنفسية، والاجتماعية، واللغوية) التي يمر بها الطفل، وذلك لأن كثيراً من الأخطاء التي يقع فيها الأدباء، سواء في المضمون أو في البناء الفني، مرّدها عدمُ اطّلاع الكتاب والرسامين عما يناسب الأطفال، وما يحتاجون إليه.
لقد حظيت القصةُ الطفلية في سورية باهتمام النقاد أكثر مما حظي به الشعر، فقد توفّر على دراستها عددٌ من النقّاد من أمثال "د. سمر روحي الفيصل" و"د. عبد الله أبو هيف" و"د. عبد الرزاق جعفر" ثم " علي حمد الله" و"نزار نجار" و"د. عيسى الشماس" وسواهم، ممن تركّزت دراساتهم حول ضرورة الاطّلاع على ما كُتب من دراسات وبحوث حول أدب الطفل، ومراعاة الخصائص الموضوعية والفنية له، التي توصّل إليها أولئك الدارسون.
لقد ابتدأ الكتّاب كتابة القصة من دون أن تكون في أذهانهم رؤيةٌ واضحة لمقومات هذا الفن، الذي قد يلتقي مع فن الراشدين، وقد يختلف عنه في الموضوع والمعالجة، فلم يكن بين أيدي الكتّاب آنئذ تعريف واضح، ولم يصدر مثل هذا التعريف على الصعيد المحلي إلاَّ بعد أكثر من عشر سنوات على البدايات الجادة، فنقرأ على سبيل المثال لـ "سمر روحي الفيصل" قولَه: القصة "جنس أدبي نثري قصصي موجّه إلى الطفل، ملائم لعالمه، يضم حكاية شائقة ليس لها موضوع محدّد أو طول معين، شخصياتها واضحة الأفعال، ولغتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح قيمة ضمنية، وتعبّر عن مغزىً ذي أساس تربوي مستمد من علم نفس الطفل". (9)
وسادت لدى النقاد والكتّاب رؤية فنية ترى أن قصص الأطفال عبارة عن موضوع، أو فكرة لها هدف، تمثل صورة الإبداع الفني التعبيري، تصاغ بأسلوب لغوي محبّب، لأن الأطفال بطبيعتهم يميلون إلى سماع القصة، وينامون في هدوء عند سماعهم لحكايات أمهاتهم وجداتهم. وأن أكثر أنواع القصص الطفلية فائدةً للصغيرة ما كان مستوحىً من البيئة القريبة، ونقصد بذلك بيئة الطفل المنزلية الصغيرة التي يتفاعل معها، والتي تشارك في تنشئة عناصر شخصيته وتكوينها من خلال النماذج المختلفة، فتكسبه العديد من المهارات التي تشارك في بناء هذه الشخصية الغضة.
وقد تعدّدت موضوعات القصة في أدب الأطفال، وتنوعت شخصياتها العفوية منها والمدروسة بعناية، في المطبوعات التي صدرت عن المؤسسات الحكومية، فوُجدت القصص الاجتماعية، وقصص الحيوان، وقصص البطولة والمغامرة، وقصص الخوارق والأساطير والحكايات الشعبية، والقصص التاريخية، وقصص الفكاهة، وقصص الخيال العلمي. وقد راعت معظمها العناصرَ المطلوبة في الأسلوب المعتمد على الوضوح في كتاب القصة، ودقة التعبير، والبساطة في تناول الموضوع، وجمال العبارة. ولكن ما يلاحظ هنا أن معظم هذه القصص لم تحدّد الشريحة الطفلية، أو المرحلة العمرية التي تتوجّه إليها، تبعاً لمراحل النمو اللغوي عند الطفل.
وقد كانت وزارة الثقافة والإرشاد القومي الجهة الرسمية الأولى التي أخذت زمام المبادرة، في طباعة الكتب ونشرها وتوزيعها، ولكن ما يلفت الانتباه أن خطة الوزارة في بداياتها كانت غايتها إيجاد كتاب للطفل فحسب، لذلك كان اللون الطاغي على مطبوعاتها في السنوات الأولى الكتابَ المترجم. وهذا لا يعني عدم الاعتراف بالدور الرسمي الرائد الذي قامت به على صعيد نشر الكتاب الطفلي أولاً، وإصدار مجلة أسامة ثانياً، ثم إجراء مسابقة لكتابة القصة الطفلية ثالثاً، ورابعاً إصدار كتاب أسامة الشهري. ومن ثم إصدار أعدادٍ ممتازة وخاصة من مجلة المعرفة، غدت مع الزمن من المراجع التي لابد منها للمتخصصين.
2 ـ القصة في مجلة أسامة:
يعدّ صدور مجلة أسامة مطلع شهر شباط عام 1969 الخطوة الجادة الأولى نحو تأصيل فن أدبي للأطفال على الساحة السورية بصورة خاصة، والعربية بصورة عامة. وقد غدت وسيلة اتصال هامة من الوسائل الضرورية لثقافة الأطفال، وحققت أول لقاء للطفل مع الثقافة والعلم والأدب والفن، لأنها لعبت دوراً هاماً في تقديم خدمات معرفية جليلة.
لقد كان من أولى مهمات مجلة أسامة مراعاة اختيار الموضوعات والمواد التي تقدّمها لقرّائها الصغار، ومحاولة معرفة الشرائح العمرية التي تتوجّه إليها، بغية تحقيق الحاجات الأساسية للنمو، والتوافق مع الميول، ومستوى التطوّر العقلي واللغوي والاجتماعي، الذي يضع الطفل في عصره، وإعداد الجيل لعالم الغد، والتعامل مع تكنولوجيا العصر بروح علمية وعقل منفتح، إضافة إلى الحرص على تحقيق الانتماء للوطن والحضارة العربية والتراث، وتمثّلِ قيم الدين الحنيف.
إن كلمة "أسامة" التي حملت عنوان المجلة، هي اسم علم جنس الأسد، والأسد ملك الغابة، ورمزٌ للقوة والشجاعة، وهذا ما يؤهله لكي يكون أنموذجاً للبطولة والمغامرة التي يحبها الأطفال، وهي تحيل إلى فن القصّ، فثمة أكثر من إشارة وردت في العدد الأول توحي أن التسمية، لشخصية إسلامية، هي "أسامة بن زيد" حب رسول الله (، وكان فتى شجاعاً، عُرف بالحكمة والأمانة والإخلاص، وهو أصغر قائد في الدولة العربية يقود جيشاً باتجاه بلاد الروم، ويهزمهم شر هزيمة، والذي يُرجّح هذا الرمز، وجود قصة تاريخية في العدد الأول، كتبها "محيي الدين صبحي" بعنوان "بطولة أسامة بن زيد" كما نشرت في العدد الأول أيضاً قصة ثانية مسلسلة، بإسقاطٍ معاصر، تحمل عنوان "أسامة مع الفدائيين" لـ "عادل أبو شنب".
أفسحت المجلة حيّزاً من صفحاتها لقصص الأطفال، وذلك إدراكاً من القائمين عليها، أن الطفل بفطرته ميالٌ للقص والحكي، وقد تشدّد رؤساء التحرير في عدم نشر القصة التي لا تحقق فنيةً عاليةً، وركّزوا اهتمامهم على أن قيمة القصة تتأتّى من آثارها الإيجابية أو السلبية اللذين يتحدّدان من مدى جودة القصة أو رداءتها "ومقاييسُ الجودة أو الرداءة هي قبل كل شيء مقاييس فنية، فالقصة المفيدة للطفل هي القصة الجميلة التي تتحقق فيها شروط الفن القصصي المناسب لأذهان الصغار وأذواقهم، والتي تصدر عن مبدعين حقيقيين".
أخذت القصة مكانها على صفحات المجلة بين مجموعةِ المواد المتنوعة، وقد جاء في قرار إنشاء المجلة (10) إنها تضمّ (32) صفحةً، منها (24) صفحة بالألوان و(8) صفحات غير ملونة، توزّع فيها المواد حسب الحصص الآتية:
صفحتان للغلاف خارجي.
صفحتان لنتاج الأطفال.
صفحتان لصور الأصدقاء، والذين يرغبون في التعارف مع غيرهم.
صفحتان للقصة المؤلفة (محلية ـ عربية).
صفحتان للقصيدة الشعرية.
صفحتان للقصة المترجمة.
صفحتان للتسليات وأوقات الفراغ.
أربع صفحات للمادة العلمية.
صفحتان للريبورتاج المصور.
ثماني صفحات للمسلسلات المصورة (تاريخية ـ مغامرات).
صفحتان متفرقتان.
ومن هذا المخطط، يتضح أن القصة الإبداعية العربية لم تأخذ سوى ما أخذته الصفحات المتنوعة الأخرى، ولم تميّز بشيءٍ من غيرها، وكان نصيبها نسبة 1/16 وهذا مؤشر متواضع على النظرة الرسمية لمكانة القصة. لكنّ ما حدث في الواقع أن أعداداً كثيرة من المجلة لم تلتزم بهذا التوزيع، فطغت القصص في بعض الأعداد على غيرها من المواد الأخرى، واحتلّت عدّةَ صفحاتٍ، وصلت في بعض الأعداد إلى ثلث عدد صفحات المجلة.
ومع ذلك، فإن تخصيص مجلة أسامة صفحتين للقصة، يبدو جيداً إذ ما قيست بغيرها من المجلات المماثلة، التي تصدر في باقي أقطار الوطن العربي. ويبدو أن المجلة تمردّت على مخططها، منذ العدد الأول، فنشرت ست قصص، هي:
بطولة أسامة بن زيد. قصة تاريخية، لـ "محيي الدين صبحي".
أسامة مع الفدائيين. قصة مسلسلة، لـ "عادل أبو شنب".
لماذا سكت النهر. قصة رمزية، لـ "زكريا تامر".
آلة الزمن. قصة مصورة اقتبسها "نجاة قصاب حسن" من رواية لـ "هـ. ج. ويلز".
قصة من دون كلام، قريبة الشبه من الكاريكاتير، لعلها مأخوذة من مجلة أجنبية، ولم يذكر اسم ناقلها.
قصة الطيران، وهي مادة علمية حملت عنوان (قصة) تتحدث عن تجربة (عباس بن فرناس) ذُكر اسم رسامها "حسان أبو عياش" ولم يُذكر اسم كاتبها.
وقد حملت القصص سمات فنية وعلمية، ضمنية ومباشرة، لا يضاهيها في المستوى الفني الرفيع إلاَّ القصص التي بدأت تنشرها ـ بعد ذلك ـ مجلتا "المزمار" و"مجلتي" اللتان صدرتا عن دائرة ثقافة الأطفال العراقية ببغداد، ومع ذلك فإن تعامل مجلة أسامة مع القصة بدا جيداً، نظراً لتوالي عددٍ من رؤساء التحرير والمحررين من كتاب القصة والمسرحية المرموقين على رئاسة تحريرها، وهم "سعد الله ونوس، وزكريا تامر، وعادل أبو شنب، ودلال حاتم، ثم بيان الصفدي" ولكن الدخول إلى صميم العمل الإداري الفني في المجلة يُظهر مدى معاناة رئيس التحرير في إخراج القصة للنور، وقد بيّنت "دلال حاتم" كثيراً مما كانت تعانيه في التعامل مع القصة قبل نشرها، لأن بعض القصص ـ كما تقول ـ يجب أن تكون "عجينة لينة كي يستطيع العاملون في المجلة قولبتها بالشكل الذي يرونه مناسباً" (11) من تنقيح لغوي، وتشذيب فني، ورسوم، وحجم خط، وقد تضطر إعادتها إلى كاتبها، وتطلب إليه تعديل بعض فقراتها وإعادة كتابتها من جديد.
ومع ذلك، وعلى الرغم من خبرة رؤساء التحرير وتشددهم، فإن عدداً من السلبيات اعتور المادة القصصية في المجلة، فعلى سبيل المثال، ضمّ العدد (220) من المجلة قصةً تفتقر إلى مقومات التربية، حيث يروي طفل لرفاقه أن أباه عندما كان صغيراً رمى "بالوناً" تحت عجلات سيارة عامداً، وقصةً أخرى مترجمة لـ "أندرسون" تقوم على السحر والاغتيال والموت، وقصةً ثالثة تحكي عن أخ يذبح أخاه الأصغر، ويشق بطنه، ليرى ماذا أكل في غيابه، وهي صورة رهيبة، لا يجوز أن تعرض على طفل، وفي العدد قصةٌ مسلسلة أخرى، توشك أن تتحوّل إلى قصة "بوليسية" عن القتل والخيانة، ودورُ الخائن فيها أكثر بروزاً من دور غير الخائنين". (12)
ولكن ـ على الرغم من ذلك ـ فإن الكتّاب منذ أن بدأوا التوجه الجدي للطفل، برزت طاقة من الإبداع، موشاة بملامح إنسانية جديدة في قصص عدد من الكتّاب من أمثال نزار نجار، وأيوب منصور، عزيز نصار، لينا كيلاني وسواهم، كما توشّى عدد منها بالبعد الاجتماعي التربوي الذي يعبّر عن تآلف الأسرة، وذلك بسبب التقاليد المألوفة في المجتمع العربي من جهة، وفي رغبة الكتّاب الانطلاق من الرؤية التربوية من جهة أخرى، فكانت القصص الاجتماعية الهادفة، كما تجلت في قصص دلال حاتم، وليلى صايا، وجمانة نعمان.
.../...