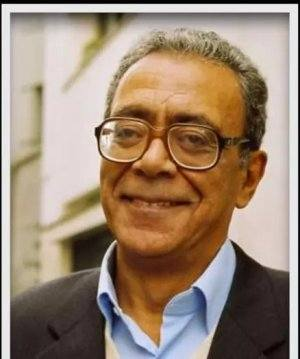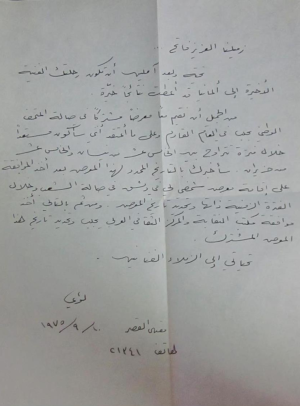الجزء الأول
تقدم قصص رحلات النساء الفرنسيات اللواتي جبن أنحاء المغرب خلال فترة الحماية 1912 -1956 تأرجحا في الكتابة بين الأدب والتاريخ. وتنوعا في المقاربات والتصورات لبلد لازال يعتبر في نظر الكثير من الفرنسيين منغلقا على ذاته، وعدائيا في تصرفاته ومعاملاته . كما أن نوعية الكتابات التي أنتجت خلال هذه الرحلات تعتبر غير متجانسة، ولم تنل حظها من الدراسة والتحليل، وبقي أغلبها منسيا على الرفوف حتى وقتنا الراهن. فبينما كانت كتابة البعض منهن عبارة عن انطباعات منبهرة بمناظر الطبيعية وظروف الحياة الاجتماعية، كانت كتابة أخريات منهن تأريخا فعليا يجمع بين الملاحظات والمعلومات الدقيقة عن الحياة السياسية والاجتماعية والدينية والفنية للمغرب. ولذلك يمكن القول بأنه كانت لهؤلاء النساء نظرتهن الخاصة لبلد لازال في طور التحول. وبأن كتاباتهن تعتبر مصدرا أصيلا حول تاريخ هاته الفترة. كما يمكننا أن نشير إلى أنه بالرغم من أن الكثيرات منهن كن مرتبطات بالمشروع الاستعماري لبلدهن الذي يقدم فرنسا كدولة متحضرة، تسعى لجلب التمدن والرخاء لباقي الشعوب التي ترسف في التخلف والهمجية ;فقدكانت للبعض منهن مواقف مشرفة تنتقد بشدة التوسع الاستعماري وتستنكره.
لم يهتم المؤرخون والدارسون في فرنسا برحلات النساء الفرنسيات بشكل أكثر عمقا وتطورا إلا في وقت قريب، في حين كانت الأبحاث والدراسات في العالم الأنجلوفوني متعددة ومتنوعة، واستدعت طرقا متنوعة للفكر من أجل فهمها ودراستها .زيادة على ذلك فإن دراسة تاريخ الرحالات الفرنسيات قد تمت في المقام الأول من خلال اليوميات والرسائل والقليل جدا من خلال كتب الرحلات المطبوعة.
لقد كانت الرحلات التي تقوم بها هؤلاء النسوة تعتبر مغامرة في ذلك الوقت، تقتضي الجرأة والشجاعة ومواجهة المجهول. كانت ترمي بالبعض منهن إلى مختلف المستعمرات الفرنسية في مختلف الأصقاع البعيدة، ليس في أفريقيا فحسب، بل حتى في مجاهل آسيا الوسطى وأدغال أمريكا الجنوبية. كما أنها كانت تقتضي الاعتماد على الحماية والمساعدة التي يمكن أن يقدمها لهن آباؤهن، أو أزواجهن بسبب المسؤوليات التي كانوا يتقلدونها كدبلوماسيين، أو إداريين أو عسكريين أو غير ذلك . وغالبا ما كان الدافع وراءها هو الرغبة الجامحة في الاطلاع على المستعمرات الفرنسية بغرض معرفتها وتقدير أهميتها بشكل أكبر.
وقد تم تحديد سبع عشرة امرأة قمن برحلات إلى المغرب خصوصا في الفترة الممتدة بين سنتي 1905 و 1935. وأنتجن كتابات تتعلق برحلاتهن إلى هذا البلد. كونت في مجموعها تشكيلة من الأعمال المتنوعة والفريدة، سواء من منظور تاريخي أو أدبي . ورغم محدودية هذه المؤلفات، فإنها تعتبر من المصادر التي تمكننا من فهم نموذج معين من الكتابات التاريخية حول المغرب، باعتبارها امتدادات للوجود والفعل الكولونيالي.
كانت أغلبية النساء اللواتي قمن برحلات إلى المغرب ينتمين إلى أوساط اجتماعية متعلمة وميسورة، منهن بنات أطباء مثل: Aline de Lens وهي فنانة تشكيلية، و بنات قضاة كالشاعرة Jane Guy ونساء من الإدارة الكولونيالية مثل: Mathilde Zeys، ودبلوماسيات كمثل Madeleine Saint-René Taillandier،وطبيبات كالسيدة .Marie Bugéjaأو كن هن أنفسهن طبيبات كالدكتورة Françoise Legey،أو ربانات طائرات مثل Magdeleine Wauthier. كما كانت من بينهن Reynolde Ladreit de Lacharrière المحاضرة لدى الجمعية الفرنسية للجغرافيا، وصاحبة كتاب«…على طول امتداد المسالك المُغربية ». وتعتبر هذه الأخيرة من الفرنسيات اللواتي زرن المغرب قبل الحماية، ومن طينة نساء أوربا الكولونيالية، ومن المستكشفات في القرن التاسع عشر، الباحثات عن روح المغامرة. بحيث لم تكن تعير أي اهتمام لظروف السفر ولا لشروط الإقامة، ولا لظروف العيش القاسية في المناطق الصعبة التي يمكن أن تنتقل إليها. وهكذا وصلت في رحلتيها إلى الجنوب المغربي مع زوجها بين سنتي 1910 و1911 حتى تارودانت، رغم أن الرحلتين كانتا محفوفتين بالمخاطر بسبب سيادة الفوضى وانعدام الأمن الذي كانت تعرفه المنطقة آنذاك.
وقد كانت هاتان الرحلتان لحساب هيآت فرنسية مختلفة منها: اللجنة المغربية والتي كانت Reynolde Ladreit de Lacharrière تقوم فيها بمهمة سكرتير، كما كانت أيضا لحساب وزارة التعليم العمومي ولحساب الجمعية الفرنسية للجغرافيا . وخلال رحلتها هاته كانت تدون كل ما تراه وما تسمعه، فجاء كتابها صنفا أدبيا رائعا يمزج بين الوصف والسرد والحكاية، ينم عن شخصية مرهفة الإحساس استطاعت أن تؤدي دورها فيه ببراعة كبيرة.
ولتقريب القارئ الكريم من هذا النوع من الكتابة، قمنا بترجمة بعض الفصول اليسيرة من كتابها ” … على طول امتداد المسالك المُغرببية” والذي دونت فيه رحلتيها إلى المغرب خلال سنتي 1910-1911.هذا الكتاب صدر سنة 1913 وقدم له السيد marquis de sėgonzac. وهو حاليا في الملك العام للخزانة الوطنية الفرنسية. ويورد مقدم هذا الكتاب كثيرا من المعلومات والمعطيات عن المغرب إبان هاته الفترة، من خلال تاريخه وعاداته وتقاليده، كما يشير إلى أن هذه الرحلة لم تكن للمتعة ومجرد تحقيق حلم لزيارة بلد يتميز بالعجائبية وبالغرابة، بل كانت رحلة محفوفة بالمخاطر إلى بلاد ” البارود ” حسب تعبيره.
وقد اخترت ترجمة هذه الفصول لأنها تناولت بالوصف الجغرافي، و الملاحظة الأنثروبولوجية الثقافية والاجتماعية المعاصرة لما يسمى بالبحث والمعاينة الميدانيين ﴿la recherche de domaine﴾لمنطقة لم تنل – حسب علمي – في هذه المرحلة، مرحلة ما قبل الحماية، كبير اهتمام من هذا النوع من البحث والدراسة، رغم أنها كانت معبرا هاما تربط بين شمال المغرب وجنوبه، وبين شرقه وغربه. إلا أن السيدةReynolde Ladreit de Lacharrièreأعطتنا في مؤلفها هذا وصفا دقيقا للأرض وللإنسان. الأرض التي كان يغمرها تيتوس زمن الكوندوانا ويحصرها النهران في زماننا. و الإنسان ابن القبائل القيسية، النازح من التغريبة الهلالية.والذي أدخله المنصور الموحدي إلى المغرب الأقصى ضمن قبائل عربية أخرى بعد انتصاره على ابن غانية في المغرب الأدنى.
ولقد اقتنعت بعد قراءة الكتاب عدة مرات، خصوصا الفصول المترجم عنها ، بأن عملية الترجمة هذه
لابد لها أن تعمل على إبراز وتثمين الجوانب الإبداعية للغة المصدر، وهذا يقتضي استشعار الحس الأدبي للنص، واستقصاء المهارة اللغوية في استعمال التراكيب لنقل ذلك الحس، مع الأخذ بمنهج يعطي للاتساق السياقي الأولوية على الاتساق المفرداتي، والأخذ بالمقابل المعنوي قبل المقابل الشكلي في الحالات التي تتطلبه. ذلك لأن الترجمة هي علم بأسسه ومناهجه، وفن لكونها ليست عملية نقل فحسب، وإنما هي إبداع يخص نشر معنى نصوص وخطابات معينة في مجتمع معين.بل هناك من علماء الترجمة من يعتبرها خطابا سياسيا بالمعنى الواسع للكلمة، تستخدم كمنظورلدراسة قضايا تاريخية أو سياسية أو إديولوجية متعلقة بالهوية خصوصا في مراحل ما بعد الاستعمار.
كما أنني انطلقت من اقتناعي بأن الترجمة لاتعرف بمقاييس مطلقة، ولكن بمعاييرشخصية، تأخذ بعين الاعتبارالمعايير السائدة في وسطنا الاجتماعي، كالعوامل الأخلاقية والسياسية وغيرها . هذا بطبيعة الحال مع النزوع إلى ما يقتضيه الأمر من الحرص على الأمانة جهد المستطاع.
وختاما أقول إنها تجربة. ليست لعالم ولا لدارس مختص، وإنما هي اهتمام وإثارة اهتمام، نابعة من محبتي وتقديري لهذه الأرض المعطاء، ولناسها الكرماء البسطاء الطيبين. فلنركب إذن رحلة الكلمات لنقتفي خطى هؤلاء الغرباء العابرين عبر هذا البلد الأمين … نشق غبار السنين … ونرى كيف كانت الأيام تشد التعب على صدور المتعبين … و تفرش ألوانها من بؤس البائسين …………. !
***
الرحلة الأولى نحو مراكش 1910
20 مارس 1910 جولة في سطات .
…أخذنا العقيد Jannerod في زيارة تفقدية إلى بعض المعالم الجميلة بمدينة سطات في شارع فسيح، ثم بعد ذلك إلى الحي اليهودي ” الملاح ” . كان يعج بكثير من التجار اليهود والتجار الإسبان الذين يمارسون شتى المهن والصنائع. وهناك خارج الأسوار قرب واد صغير، انتشرت الكثير من البساتين التي تكثر فيها أشجار السفرجل وأشجار اللوز والخروب. كثير من هذه البساتين بدأت أشجارها تقطع وتقلع من أجل فسح المجال للبناء، ورغم ذلك كنت ترى بعضها- خصوصا القديمة منها- لازال يخصص جزء فيها للبستنة لزراعة بعض الخضر وبعض الفواكه. وبعد طول انتظار، توصلنا أخيرا من الجهات الإدارية في نهاية ذلك اليوم بالترخيص الذي يسمح لنا بالسفر إلى مراكش ، فقررنا الرحيل في اليوم الموالي.
21 مارس 1910. مغادرة سطات.
انطلقنا على الساعة السابعة والنصف صباحا، يخفرنا فارس ومخزني، ولازال الرجل العجوز ذو اللحية البيضاء الذي كان يتبع ركبنا منذ أمس، والذي قضى ليلته قرب مخيمنا، ينتظر كي يسير على خطانا مرة أخرى، ربما للاحتماء بنا أو ربما لسبب آخر لم نكن نعرفه .عند خروجنا من سطات كنا نسير في أرض متربة ترتفع فيها الطريق شيئا فشيئا، إلى أن انحرفت نحو اليمين ، فاختفت معالم المدينة من ورائنا. عند « بئر مسورة » وعلى طول الطريق، كان بعض الأهالي يغسلون جلابيبهم وذلك بضربها بأخمص أقدامهم وهم يصدرون أصواتا رتيبة تتناغم مع إيقاع الضرب. كانت مناسبة ذلك، الاستعداد للاحتفال بعيد المولد النبوي الذي كان على الأبواب. على اليسار كانت تظهر لنا تموجات التلال، وفي الأفق يبدو « سيدي علي بن أحمد » وكانت رؤوس جبال صخور الرحامنة تظهر تارة وتختفي تارة أخرى .عند اقترابنا من قبة الولي سيدي بركة، انعطفنا نحو اليمين، كانت البلاد قليلة الزرع وسنابل الشعير لازالت مخضرة، طرقاتها ومسالكها خالية من البشر، لا تكاد تصادف راجلا أو راكبا، مناسبة عيد المولد جعلت الناس يلزمون أسرهم وعائلاتهم .
عند منتصف النهار تناولنا غذاءنا قرب قبة الولي سيدي محمد بن رحال، ثم استأنفنا مسيرنا في الواحدة والنصف بعد الزوال. كان الجو حارا، وكنا نسير سيرا حثيثا في أرض كالسهوب الجافة حيث لم يتبق من العشب إلا القليل، تحاول بعض القطعان من الغنم أن تقتات على ما تبقى منه، لا يقطع رتابة ووحشة هذا المكان إلا بعض النخيلات القصيرة المتناثرة هنا وهناك . بعد مدة بدأت تتغير معالم المكان، هذا الجبل الأخضر يمتد على اليمين، وتلك صخور الرحامنة تنتصب في الأفق، ومن وراءها تلوح قمم الأطلس مكللة بالثلوج، وهذه طريقنا بدأت تنخفض وتعلو تارة، تتلوى وتستقيم بين الوهاد والشعاب تارة أخرى، إلى أن أصبحنا نسير في منحدر من الأرض امتد لمسافة طويلة، لم ينته إلا بعد وصولنا عند الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال إلى مشرع بن عبو. آوينا إلى مكان يشرف على نهر أم الربيع، فأقمنا فيه مخيما يحيط به خندق صغير، وفي الأسفل على ضفة النهر، كان يترائى لنا بعض الجنود وهم يتجولون بين معدات موقع عسكري دفاعي كانوا قد أعدوه بين نخلتين كبيرتين. عند المساء كانت الحرارة قد انخفضت، وأمسى الجو أكثر رطوبة وانتعاشا وانتشرت في المخيم حركة من الحيوية والنشاط والحميمية، فدعانا الملازم de Féraudyلمقاسمته وجبة عشائه صحبة العقيد Godlewski تحت خيمة ميدانية.
*********
على الساعة السابعة والنصف صباحا كانت السماء تبدو صافية الأديم، وكنا نحس أن اليوم سيكون حارا كسابقه. غادرنا المخيم وعبرنا النهر، ومشينا صعودا في أرض رطبة محمرة إلى أن بلغ بنا المسير محاذاة “مولاي المجيب” وهو دوار أغلبية سكانه من أصول جزائرية. كنا قد تركنا الشاوية وراءنا وانفتح أمامنا فضاء من التضاريس المختلفة، تهيمن عليه كثير من التلال والأودية والهضاب، وانتابنا مزيج من الشعور بالفرح والرهبة أمام هذا الفضاء المجهول الذي ينفتح أمامنا، بحيث لم يكن يخفف من هذه المشاعر المختلطة إلا صورة هذا العجوز الوقور ذي اللحية البيضاء والذي لا زال يسير في أثر ركبنا دون كلل أو عياء، فكأنما بمثابرته وأناته منحنا القدرة على الصبر والمجاهدة.
دخلنا صخور الرحامنة وكان أول دوار نصادفه عن يميننا هو دوار أولاد بن علي« أولاد يعلى ». جرى الأطفال والنساء نحونا ليشاهدوا ” النصارى” حسب تعبيرهم يمرون بمحاذاة دوارهم. عند الساعة الحادية عشرة والنصف صادفنا في طريقنا ثلاثة أكوام من الحجر أو ما يسميه أهل البلد “كركور” وهم يضعونها عند المكان الذي يجب الولوج منه في المناطق الجبلية أو الوعرة خوفا من أن يتيه المسافرون الغرباء بين الشعاب والوديان . بعد تجاوز معبر صغير أصبح بإمكاننا أن نطل على سوق الأربعاء. على اليسار تبرز الصخور ناتئة مهيبة مكسوة بزرقة خفيفة تمتد طولا من الشمال إلى الجنوب، وتنوء بكلكلها على سهل صغير تبرز فيه ثلاث قباب بيضاء تحفها نخلتان. توقفنا من أجل تناول وجبة الغذاء على الساعة الثانية عشرة والربع زوالا قرب بئر. وكان الفضوليون من أهل البلد يحاولون الاقتراب منا شيئا فشيئا للتطلع إلى سحناتنا وألبستنا ومتاعنا. بعض النسوة كن منهمكات في جلب الماء من قاع بئر، وكن يستعملن لذلك دلاء من جلد الماعز.أما الأطفال فقد جلسوا القرفصاء حولنا دون أن يقتربوا منا كثيرا. كانوا يتحدثون بينهم بهمس وبعضهم كانوا يتنازعون علبة سردين فارغة. لم يطل بنا المقام كثيرا، وغادرنا المكان على الساعة الواحدة وعشر دقائق، نشق طريقنا عبر ساحة السوق وسط اندهاش أهل البلد، و صياح البعض منهم في وجوهنا. لم نكترث لذلك وتابعنا رحلتنا وسط حقول ضعيفة من الشعير التي ألهبتها حرارة الشمس طوال أيام عديدة من قساوة الجو وجفاف المناخ، إلى أن وجدنا في طريقنا قبة ضريح ولي. عندها أوقف صديقنا العجوز الذي ظل مرافقا لرحلتنا حماره، وجعل الضريح في قبلته ثم بدأ في التوسل والدعاء مطأطئا رأسه في خشوع، باسطا كفيه عند مستوى سرته في ضروع، يشكر ربه على تمكنه من الرجوع إلى بلده سالما رغم الرصاصات السبع التي أصابت جسده . وبينما نحن كذلك، إذ بفارس على صهوة جواده يندفع نحونا بتهور وهو يشيل بندقيته نحو السماء ويسألنا: هل وصل الفرنسيون؟ فارس آخر حيانا وتوجه نحو الشيخ يقبل طيلسانه ثم أقبل طفل يجري، وبدأ يقبل يدي جده فضمه هذا الأخير إليه وشرع يقبله على جبينه في شوق واشتياق…
************
…انفضت باقي النسوة وبقيت وحيدة مع الضرتين الجميلتين. كانت كبراهما تحدق في عقد الكهرمان الذي في عنقي كأنما تتمناه، لم أستطع أن أحرمها منه، وما كدت أهبه لها وأضعه في جيدها حتى انهالت علي بحركات شديدة تعبر عن حبها لي وامتنانها على حسن صنيعي معها. أما بالنسبة للصغرى فلم أجد بدا من وعدها بعقد آخر في مناسبة أخرى. ونزولا عند رغبتهما كان علي أن أكشف لهما عن لون و ملمس شعري، وكان علي أن أبين نوع المادة التي صنعت منها قبعة “الباناما” التي كنت أضعها على رأسي وعندما لم أكن أفهم معنى جملة مما تقولانه لي، كانتا تصرخان بها في أذني وتربتان بخفة على يدي.
انصرفت الكبرى لتهييء الطعام، ولمحت نصف خروف سيكون وجبة للعشاء. طلبت مني خدوج الطفلة الصغيرة أن أعطيها بسكويتا، فوجدتها فرصة سانحة لأقف وأنصرف لأريح ساقي مما أصابهما من خدر وتقلصات بسبب طول مدة جلوسي قرفصاء. ولم يمض ربع ساعة على التماسي قسطا من الراحة داخل الخيمة، حتى دخلت علي خدوج فأخذت بيدي وقادتني إلى” النوالة“ جلست على ركبتي، وألحت على عدم مفارقتي لها وهي تضحك ملء فمها.
عادت الكبرى من الضرتين وانضمت إلينا، وكان علي أن أنزل عند رغبتما في لمس شعري الأشقر وتأمل لون عيني الأزرق. ثم أرادتا أن تطلعا على سائر جسدي لكنني رفضت. ثم نزعت حذائي وشرعت اشرح لهن طريقة حزم خيوطه، وطريقة لبس سروال” الليجنس”. ولم يثر استغرابهن شيء آخر أكثر من حزام مطاطي كان مخيطا بمعطفي، كن يجذبنه الواحدة تلو الأخرى، ثم يطلقنه فيعلو صياحهن وضحكهن لذلك. بعد ذلك جاء دور الأزرار التي تغلق بالضغط، وتوالت أسئلتهن: ألا يمكن أن أتجمد من البرد ليلا بعد أن أخلع هذه الملابس وأنام بقميص خفيف؟ !. وهل أنا التي قمت بخياطتها …؟ كن معجبات بجودة الثوب، ولذلك رحن يقلبنه مرارا ويجربن متانته بجذبات قوية متتالية. لم يستوعبن أن لون بشرة وجهي كان بفعل الماكياج، وكان ظهور زرقة شرايين يدي تحت بشرتي البيضاء بالنسبة إليهن دليلا على أنني “صفراء” بفعل نقص الدم في جسدي، ولذلك كن يظهرن لي بكثير من الفخر والارتياح سيقانهن البنية المليئة بالدم حسب زعمهن…
*******
بعيدا عن باريس.. عشاء في سيدي البهيليل على ضوء قنديل .
… بدأ الليل يرخي سدوله حينما التحقت بنا امرأتان صديقتان للأسرة كانت إحداهما ذات سحنة باسكية، بشرة بيضاء وعينان متقدتان. اجتمعنا كلنا في « نوالة » مؤثثة بما هو ضروري من أفرشة بسيطة وحصر، وفي ركن منها أغطية بالية مطوية بعضها فوق بعض على صندوق خشبي، وقنديل تبعث ذبالته لهبا ضعيفا ينوس متثاقلا في فتور فلا يكاد ضوءه ينير أرجاء المكان. ناولنني وعاء حليب ثم طفن به تباعا على الجميع. وفي ركن عند المدخل، جثت إحدى النسوة على ركبتيها تمسك كيرا صغيرا ” رابوز” وتلهب النار بكل جهدها في مجمر من طين وضعت فوقه غلاية “مقراج ” فيه ماء ليغلي وبيض ليسلق. بادرت الأم العجوز ذات الشعر الأحمر بفعل التخضيب بالحناء تقرب إلي الكسكس ولحم الخروف في إناء من طين، وعلى ما يبدو كان الاهتمام بالنظافة قليلا إلا أن الضوء الخافت جنبني رؤية كثير من الأشياء التي كان من الممكن أن تثير اشمئزازي. أما خدوج فقد كانت تلعق أصابعها مما علق بها من طعام ثم تعيد مش ما فضل من عظم. بعد ذلك، تتابع أكلها بجمع الكسكس في إحدى كفيها وتضغطه ضغطا خفيفا لتشكله على هيأة كرة صغيرة تتلقفها بسرعة في فمها كما يفعل الرجال في العادة، وبعد أن تأكل كفايتها تتجشأ بارتياح كبير. كان هذا هو الطبق الأول، أما الطبق الثاني فكان من لحم عجل أظن أنه طبخ في الماء. قامت عائشة بإعداد شاي من نفس الغلاية التي سلق فيها البيض قبل قليل. فشربت منه خمسة كؤوس وكانت الأخريات يرشفنه بشفتين مزمومتين فيسمع لذلك صوت ممدود ينم عن استمتاعهن وتمتعهن بهذا االمشروب . لم يكن يقدمن لي الشاي في نفس الكأس الذي أشرب منه، بل كان ذلك يتم كيفما اتفق، لكن هذا لم يكن يهمني ما دام الشاي يدفئ جسدي في هاته الليلة الباردة. انزوت الأم العجوز في ركن معتم من « النوالة » افترشت زربية صغيرة، وجثت على ركبتيها، ثم بدأت تؤدي صلاتها وهي تتلو وتدعو بصوت خافت يتخلل ذلك ركوع وسجود. وما إن تنهي عددا من الركعات حتى تتوقف لتشرب الشاي أو تشارك في الحديث ثم تستأنف صلاة أخرى. دلف علينا محمد وشاركنا شرب الشاي، أخبرته النسوة في تعجب بأنني أتكلم بعض الجمل العربية، سمع مني بعضا منها، لكنه لم يعر ذلك اهتماما. قضيت أربع ساعات عند مضيفاتي وبدأت أحس بالتعب يهد جسمي وبالصداع ينتاب رأسي، وشعرت أنني في أشد الحاجة إلى الراحة والنوم، سيما وأنها التاسعة ليلا وقد بدأ جاك يقلق على طول غيابي، لقد حان وقت الانصراف… حملت بضع بيضات أصرت مضيفاتي على تقديمها إلي من أجل التزود بها في الطريق إكراما لي وعناية بي. شكرتهن، ثم ودعنني وذلك وبتقبيل أيديهن بعد مصافحتي. جاء السي محمد ليتناول عشاءه في الخيمة، وشرع يحكي لنا أشجانه ومآسيه، كمن يبحث عمن يشد عضده ويقوي سنده. وباتت الكلاب طول الليل تنبح وتتهارش تارة وتتسكع حول الخيمة تارة أخرى أو تسعى لتلغ من الماء القليل الذي نوفره في سطل لحاجتنا، كما بات بالقرب منا خمسة حراس جلسوا على حصير وأسندوا ظهورهم إلى الحائط ، يثرثون ويغنون ليغالبوا سيطرة النوم عليهم. وقضت الدواب المربوطة أمام خيامنا جزءا كبيرا من الليل تصهل وتضرب الأرض بحوافرها مثيرة بذلك جلبة وصخبا أفقدنا كثيرا من متعة النوم…
******
في الطريق إلى سيدي بوعثمان، ﻻطير يطير، وﻻ نبات ينمو، وﻻ مسافرين يعبرون السبيل…
23 مارس 1910
لم يكد ضوء الصبح يتسلل عبر خيوط قماش الخيمة، حتى قام أحد أهل البلد يؤذن للصلاة بأعلى ما أمكنه من جهد. راقني صوته الرخيم لكن حدته أذهبت عني النوم . أقبل السي محمد ليلقي علينا تحية الصباح، كان مرفوقا بخدوج التي أمسكتني من يدي، وتوجهت بي إلى «الحوش» حيث توجد النوايل، وحيث تحلقت حولي النساء يودعنني، ويطلبن مني أن أعود عبر سيدي البهيليل، لأزورهن مرة أخرى عند عودتي من مراكش. بعدها رجعت إلى المخيم في انتظار ساعة استئناف السفر. جلست أتأمل شاة كانت قد وضعت مولودها في تلك الليلة، كان الحمل ملتصقا بأمه ليأخذ بجانبها قسطا من دفء الشمس، وكان هناك كلب يحاول اﻻقتراب منه، لكن الشاة وبانحناءة من رأسها، كانت تتصدى له بالنطح، فيتراجع مدبرا خائفا.
عند الساعة السابعة والنصف غادرنا المكان، وكانت خدوج في منتهى اليأس؛ كانت تبكي، وكانت دموعها تبلل خديها ووجهها، فوعدتها بأنني سأعود لأراها. ومن أجل تخفيف حزنها حملها أبوها بين ذراعيه عله يهدئ من روعها. جلس الجميع ينظرون إلينا ونحن ننصرف، يرافقنا السي محمد أخ الشيخ في رحلتنا إلى مراكش، وبعض الصبية يتبعوننا مهرولين يلتمسون منا بعض النقود.
كانت السماء صافية، وحرارة الجو قد بدأت في الارتفاع، رغم أن برودة الليلة الماضية كانت متدنية وصلت حتى حدود الصفر . كانت حقول الشعير كالعادة جافة بفعل نذرة اﻷمطار. وكانت صخور ڴارة « وزرن » المسطحة تنتصب على يميننا، ونحن نسير في منطقة رملية من السهوب الجافة. أما في الجهة المقابلة لنا، فقد كانت ملامح اﻷطلس تخترق غبش الصباح، وتنجلي أمامنا بوضوح شيئا فشيئا . بعد أمد قصير أصبحت الطريق كثيرة الأحجار والحصى، بحيث كانت بعضها تدخل بين سنابك البغال وحوافرها. وعلى يميننا كانت تبرز هناك « نزالة » محاطة بالصبار، كما كان هناك قطيع من الغنم يبحث عن قليل من المرعى في أرض منبسطة حصباء، ينتشر فيها حجر صغير أبيض محمر يشبه الرخام. على يميننا يوجد دوار« أوﻻد نايل الشياظمة». كان أهل هذا الدوار يرتدون ثيابا زاهية اﻷلوان، ينهمكون في غسل ملا بسهم بضربها بأرجلهم وصب كثير من الماء عليها بين الفينة واﻷخرى، ويرددون في نفس الوقت أهزوجة تبث الشكوى بإيقاع رتيب. كانت جلاليبهم تجف تحت أشعة الشمس، وكانت الظفائر المتدلية من جوانب رؤوسهم تجعلهم يظهرون في شكل مخيف.
إنها الساعة التاسعة صباحا، الشمس حارة ،وحقول الحرث أكثر انتشارا في هذا البلد، بين الفينة واﻷخرى كانت المزاريب الجافة التي تحول عادة مياه اﻷمطار نحو الحقول تقطع الطريق. على اليمين «ابن جرير» وقطعان كثيرة من الغنم والماعز تتثير في وجوهنا كثيرا من الغبار وهي في طريقها نحو السوق . في الساعة الحادية عشرة كنا بمحاذاة « دوار الرڴيڴ »، بدأنا نقطع سهلا جافا، لاح لنا فيه عن بعد جملان يحملان الحطب، تخالهما ﻷول وهلة شجيرتين تمشيان الهوينى. من بعيد كانت ” نزالة العظم ” تبدو صغيرة كنقطة سوداء، وصلنا إليها عند الزوال، وتوقفنا لتناول وجبة الغذاء تحت الشجرة الوحيدة التي صادفناها خلال كل هذا الصباح، والتي لم تكن سوى سدرة قليلة اﻷوراق، كانت مصدر بهجة لنا بالرغم من شح ظلها. جاء بعض اﻷطفال والنساء يركضون نحونا يعرضون علينا البيض واللبن المنزوع الدسم في قلال صغيرة، لم أستطع أن أشرب منه شيئا لما علق به من أوساخ وشعر الدواب، أما جاك واﻵخرون فقد شربوا منه ما استطاعوا دون أن يهمهم ذلك. كانت النساء يلبسن « الخنت » وهو ثوب أزرق مربوط عند الكتفين بصفيحة معدنية، ويتمنطقن بحبل يشد وسطهن، ويغطين رؤوسهن بمنديل؛ كن يظفرن مع شعرهن خيوطا سوداء من الصوف تتدلى مع ظفائرهن، كما كن يزينن وجوههن بالوشم، فكن يظهرن على هيأة نساء البدو في جنوب الجزائر.
يمتد أمام أعيننا الآن سراب عجيب، يبدو كبحيرة زرقاء تحيط بها بعض الشجيرات، وحيثما وليت وجهك كان ذلك يوهمك بوجود برك عديدة تمتد الواحدة منها خمسين أو ستين مترا. كان الهواء حولنا حارا كأنه يغلي، فلم يجد السي محمد بدا في الجلوس تحت ظل جواده. عند الواحدة والربع حملنا أمتعتنا على الدواب واستأنفنا المسير. لم يعد لدينا ماء منذ هذا الصباح، ولن نحصل عليه إﻻ عند وصولنا إلى المحطة المقبلة خلال هذا المساء. كان السراب كمن يسخر منا، إذ كان يمنينا بالماء، و كلما دنونا منه كان يبتعد عنا، وكان هذا السراب وأعمدة الغبار التي يصعدها الهواء الحار واﻷرض العارية التي تمتد أمامنا توحي لنا بأننا في صحراء من اﻷرض مقفرة.
كان المكان الذي يحيط بنا يبعث اليأس والسأم؛ ﻻطير يطير، وﻻ نبات ينمو، وﻻ مارة يعبرون! لقد أخذ التعب من الرجال ومن الدواب كل مأخذ، وبدأ اﻻرتخاء والنوم يغالب أجسادهم. كان يترائى لنا أن رؤوس “الجبيلات ” تبتعد كلما اقتربنا منها، وأخيرا عند الساعة الخامسة مساء وصلنا «نزالة سيدي بوعثمان » وهي عبارة عن مجموعة من ” النوايل “، أقمنا خيامنا، ووجهنا مداخلها نحو ” الدوار “. تجمع بعض السكان أمامنا جالسين في صمت. بدأ الليل يزحف، وراحت قطعان اﻷغنام إلى حواظرها تثغو، وطلع البدر بهيا يكسو بضيائه قمم التلال فتبدو مهيبة في شموخ، و يظهر ” الدوار ” من تحتها متواضعا في سكون. وبات اثنان من رجال الحراسة مستندين إلى خيامنا، ملتفين في برنسيهما، وقضيا الليل كله وهما يثرثران بدون انقطاع…
*******************
استأنفنا رحلتنا على الساعة السابعة والنصف صباحا، وكانت الريح الباردة التي تهب من أعالي الأطلس تجمد أطرافنا، سرنا عبر ممر كثير اﻷحجار، عبرنا خلاله لمرتين متتاليتين بطن واد جاف، ثم مررنا بمحاذاة ركام كبير من الحجارة ” كركور” يدل المسافرين على المكان الذي ينبغي أن يسلكوه للخروج من بين مرتفعات الجبيلات. فجأة وبعد أن تجاوزنا « قبة سيدي بوكريشة » ، ظهر أمامنا منظرﻻ ينسى…مراكش !
كان ركبنا يتقدم متهاديا عبر واحة النخيل والتي كان علينا أن نقطعها في زهاء ساعة من الزمن قبل أن نصل إلى أسوار المدينة، ثم بدت أمام عيوننا حاضرة مراكش جلية بهية، تتسامى في وسطها صومعة الكتبية نحو السماء كما يتسامى دعاء ضارع متبتل لربه، وخلفها كانت ثلوج اﻷطلس العتيد تلمع تحت وهج شمس الظهيرة. لم أتمالك مشاعري وأحاسيسي أمام هذا المشهد الجليل، وبقيت أرنو إليه، ينتابني إحساس بالبهجة واﻻرتياح بعد أن قطعت من أجله طريقا جذباء تحت هذه الشمس الحارقة ! أصبح رجالنا فجأة كالمجانين، يصرخون ويصيحون: “مدام كتبية ” ويحفزون البغال التي يركبونها على العدو يفعلون ذلك كما لو أنهم يمتطون خيوﻻ في ميدان التبوريدة. كان لزاما علينا أن نطلب منهم أن يقللوا من حماستهم واندفاعهم، وكنا نعرف أن مراكش هي بالفعل جنة بالنسبة إليهم، فهي مدينة المتع والملذات والحسناوات الراقصات ! أصبح الركب اﻵن يمشي حثيثا في صمت والدواب تندفع أكثر فأكثر، وفوق المدينة كان الدخان الأبيض المتصاعد من فوهة المدافع يعلن حلول عيد المولد، عيد احتفال المسلمين بذكرى ميلاد الرسول. »
تقدم قصص رحلات النساء الفرنسيات اللواتي جبن أنحاء المغرب خلال فترة الحماية 1912 -1956 تأرجحا في الكتابة بين الأدب والتاريخ. وتنوعا في المقاربات والتصورات لبلد لازال يعتبر في نظر الكثير من الفرنسيين منغلقا على ذاته، وعدائيا في تصرفاته ومعاملاته . كما أن نوعية الكتابات التي أنتجت خلال هذه الرحلات تعتبر غير متجانسة، ولم تنل حظها من الدراسة والتحليل، وبقي أغلبها منسيا على الرفوف حتى وقتنا الراهن. فبينما كانت كتابة البعض منهن عبارة عن انطباعات منبهرة بمناظر الطبيعية وظروف الحياة الاجتماعية، كانت كتابة أخريات منهن تأريخا فعليا يجمع بين الملاحظات والمعلومات الدقيقة عن الحياة السياسية والاجتماعية والدينية والفنية للمغرب. ولذلك يمكن القول بأنه كانت لهؤلاء النساء نظرتهن الخاصة لبلد لازال في طور التحول. وبأن كتاباتهن تعتبر مصدرا أصيلا حول تاريخ هاته الفترة. كما يمكننا أن نشير إلى أنه بالرغم من أن الكثيرات منهن كن مرتبطات بالمشروع الاستعماري لبلدهن الذي يقدم فرنسا كدولة متحضرة، تسعى لجلب التمدن والرخاء لباقي الشعوب التي ترسف في التخلف والهمجية ;فقدكانت للبعض منهن مواقف مشرفة تنتقد بشدة التوسع الاستعماري وتستنكره.
لم يهتم المؤرخون والدارسون في فرنسا برحلات النساء الفرنسيات بشكل أكثر عمقا وتطورا إلا في وقت قريب، في حين كانت الأبحاث والدراسات في العالم الأنجلوفوني متعددة ومتنوعة، واستدعت طرقا متنوعة للفكر من أجل فهمها ودراستها .زيادة على ذلك فإن دراسة تاريخ الرحالات الفرنسيات قد تمت في المقام الأول من خلال اليوميات والرسائل والقليل جدا من خلال كتب الرحلات المطبوعة.
لقد كانت الرحلات التي تقوم بها هؤلاء النسوة تعتبر مغامرة في ذلك الوقت، تقتضي الجرأة والشجاعة ومواجهة المجهول. كانت ترمي بالبعض منهن إلى مختلف المستعمرات الفرنسية في مختلف الأصقاع البعيدة، ليس في أفريقيا فحسب، بل حتى في مجاهل آسيا الوسطى وأدغال أمريكا الجنوبية. كما أنها كانت تقتضي الاعتماد على الحماية والمساعدة التي يمكن أن يقدمها لهن آباؤهن، أو أزواجهن بسبب المسؤوليات التي كانوا يتقلدونها كدبلوماسيين، أو إداريين أو عسكريين أو غير ذلك . وغالبا ما كان الدافع وراءها هو الرغبة الجامحة في الاطلاع على المستعمرات الفرنسية بغرض معرفتها وتقدير أهميتها بشكل أكبر.
وقد تم تحديد سبع عشرة امرأة قمن برحلات إلى المغرب خصوصا في الفترة الممتدة بين سنتي 1905 و 1935. وأنتجن كتابات تتعلق برحلاتهن إلى هذا البلد. كونت في مجموعها تشكيلة من الأعمال المتنوعة والفريدة، سواء من منظور تاريخي أو أدبي . ورغم محدودية هذه المؤلفات، فإنها تعتبر من المصادر التي تمكننا من فهم نموذج معين من الكتابات التاريخية حول المغرب، باعتبارها امتدادات للوجود والفعل الكولونيالي.
كانت أغلبية النساء اللواتي قمن برحلات إلى المغرب ينتمين إلى أوساط اجتماعية متعلمة وميسورة، منهن بنات أطباء مثل: Aline de Lens وهي فنانة تشكيلية، و بنات قضاة كالشاعرة Jane Guy ونساء من الإدارة الكولونيالية مثل: Mathilde Zeys، ودبلوماسيات كمثل Madeleine Saint-René Taillandier،وطبيبات كالسيدة .Marie Bugéjaأو كن هن أنفسهن طبيبات كالدكتورة Françoise Legey،أو ربانات طائرات مثل Magdeleine Wauthier. كما كانت من بينهن Reynolde Ladreit de Lacharrière المحاضرة لدى الجمعية الفرنسية للجغرافيا، وصاحبة كتاب«…على طول امتداد المسالك المُغربية ». وتعتبر هذه الأخيرة من الفرنسيات اللواتي زرن المغرب قبل الحماية، ومن طينة نساء أوربا الكولونيالية، ومن المستكشفات في القرن التاسع عشر، الباحثات عن روح المغامرة. بحيث لم تكن تعير أي اهتمام لظروف السفر ولا لشروط الإقامة، ولا لظروف العيش القاسية في المناطق الصعبة التي يمكن أن تنتقل إليها. وهكذا وصلت في رحلتيها إلى الجنوب المغربي مع زوجها بين سنتي 1910 و1911 حتى تارودانت، رغم أن الرحلتين كانتا محفوفتين بالمخاطر بسبب سيادة الفوضى وانعدام الأمن الذي كانت تعرفه المنطقة آنذاك.
وقد كانت هاتان الرحلتان لحساب هيآت فرنسية مختلفة منها: اللجنة المغربية والتي كانت Reynolde Ladreit de Lacharrière تقوم فيها بمهمة سكرتير، كما كانت أيضا لحساب وزارة التعليم العمومي ولحساب الجمعية الفرنسية للجغرافيا . وخلال رحلتها هاته كانت تدون كل ما تراه وما تسمعه، فجاء كتابها صنفا أدبيا رائعا يمزج بين الوصف والسرد والحكاية، ينم عن شخصية مرهفة الإحساس استطاعت أن تؤدي دورها فيه ببراعة كبيرة.
ولتقريب القارئ الكريم من هذا النوع من الكتابة، قمنا بترجمة بعض الفصول اليسيرة من كتابها ” … على طول امتداد المسالك المُغرببية” والذي دونت فيه رحلتيها إلى المغرب خلال سنتي 1910-1911.هذا الكتاب صدر سنة 1913 وقدم له السيد marquis de sėgonzac. وهو حاليا في الملك العام للخزانة الوطنية الفرنسية. ويورد مقدم هذا الكتاب كثيرا من المعلومات والمعطيات عن المغرب إبان هاته الفترة، من خلال تاريخه وعاداته وتقاليده، كما يشير إلى أن هذه الرحلة لم تكن للمتعة ومجرد تحقيق حلم لزيارة بلد يتميز بالعجائبية وبالغرابة، بل كانت رحلة محفوفة بالمخاطر إلى بلاد ” البارود ” حسب تعبيره.
وقد اخترت ترجمة هذه الفصول لأنها تناولت بالوصف الجغرافي، و الملاحظة الأنثروبولوجية الثقافية والاجتماعية المعاصرة لما يسمى بالبحث والمعاينة الميدانيين ﴿la recherche de domaine﴾لمنطقة لم تنل – حسب علمي – في هذه المرحلة، مرحلة ما قبل الحماية، كبير اهتمام من هذا النوع من البحث والدراسة، رغم أنها كانت معبرا هاما تربط بين شمال المغرب وجنوبه، وبين شرقه وغربه. إلا أن السيدةReynolde Ladreit de Lacharrièreأعطتنا في مؤلفها هذا وصفا دقيقا للأرض وللإنسان. الأرض التي كان يغمرها تيتوس زمن الكوندوانا ويحصرها النهران في زماننا. و الإنسان ابن القبائل القيسية، النازح من التغريبة الهلالية.والذي أدخله المنصور الموحدي إلى المغرب الأقصى ضمن قبائل عربية أخرى بعد انتصاره على ابن غانية في المغرب الأدنى.
ولقد اقتنعت بعد قراءة الكتاب عدة مرات، خصوصا الفصول المترجم عنها ، بأن عملية الترجمة هذه
لابد لها أن تعمل على إبراز وتثمين الجوانب الإبداعية للغة المصدر، وهذا يقتضي استشعار الحس الأدبي للنص، واستقصاء المهارة اللغوية في استعمال التراكيب لنقل ذلك الحس، مع الأخذ بمنهج يعطي للاتساق السياقي الأولوية على الاتساق المفرداتي، والأخذ بالمقابل المعنوي قبل المقابل الشكلي في الحالات التي تتطلبه. ذلك لأن الترجمة هي علم بأسسه ومناهجه، وفن لكونها ليست عملية نقل فحسب، وإنما هي إبداع يخص نشر معنى نصوص وخطابات معينة في مجتمع معين.بل هناك من علماء الترجمة من يعتبرها خطابا سياسيا بالمعنى الواسع للكلمة، تستخدم كمنظورلدراسة قضايا تاريخية أو سياسية أو إديولوجية متعلقة بالهوية خصوصا في مراحل ما بعد الاستعمار.
كما أنني انطلقت من اقتناعي بأن الترجمة لاتعرف بمقاييس مطلقة، ولكن بمعاييرشخصية، تأخذ بعين الاعتبارالمعايير السائدة في وسطنا الاجتماعي، كالعوامل الأخلاقية والسياسية وغيرها . هذا بطبيعة الحال مع النزوع إلى ما يقتضيه الأمر من الحرص على الأمانة جهد المستطاع.
وختاما أقول إنها تجربة. ليست لعالم ولا لدارس مختص، وإنما هي اهتمام وإثارة اهتمام، نابعة من محبتي وتقديري لهذه الأرض المعطاء، ولناسها الكرماء البسطاء الطيبين. فلنركب إذن رحلة الكلمات لنقتفي خطى هؤلاء الغرباء العابرين عبر هذا البلد الأمين … نشق غبار السنين … ونرى كيف كانت الأيام تشد التعب على صدور المتعبين … و تفرش ألوانها من بؤس البائسين …………. !
***
الرحلة الأولى نحو مراكش 1910
20 مارس 1910 جولة في سطات .
…أخذنا العقيد Jannerod في زيارة تفقدية إلى بعض المعالم الجميلة بمدينة سطات في شارع فسيح، ثم بعد ذلك إلى الحي اليهودي ” الملاح ” . كان يعج بكثير من التجار اليهود والتجار الإسبان الذين يمارسون شتى المهن والصنائع. وهناك خارج الأسوار قرب واد صغير، انتشرت الكثير من البساتين التي تكثر فيها أشجار السفرجل وأشجار اللوز والخروب. كثير من هذه البساتين بدأت أشجارها تقطع وتقلع من أجل فسح المجال للبناء، ورغم ذلك كنت ترى بعضها- خصوصا القديمة منها- لازال يخصص جزء فيها للبستنة لزراعة بعض الخضر وبعض الفواكه. وبعد طول انتظار، توصلنا أخيرا من الجهات الإدارية في نهاية ذلك اليوم بالترخيص الذي يسمح لنا بالسفر إلى مراكش ، فقررنا الرحيل في اليوم الموالي.
21 مارس 1910. مغادرة سطات.
انطلقنا على الساعة السابعة والنصف صباحا، يخفرنا فارس ومخزني، ولازال الرجل العجوز ذو اللحية البيضاء الذي كان يتبع ركبنا منذ أمس، والذي قضى ليلته قرب مخيمنا، ينتظر كي يسير على خطانا مرة أخرى، ربما للاحتماء بنا أو ربما لسبب آخر لم نكن نعرفه .عند خروجنا من سطات كنا نسير في أرض متربة ترتفع فيها الطريق شيئا فشيئا، إلى أن انحرفت نحو اليمين ، فاختفت معالم المدينة من ورائنا. عند « بئر مسورة » وعلى طول الطريق، كان بعض الأهالي يغسلون جلابيبهم وذلك بضربها بأخمص أقدامهم وهم يصدرون أصواتا رتيبة تتناغم مع إيقاع الضرب. كانت مناسبة ذلك، الاستعداد للاحتفال بعيد المولد النبوي الذي كان على الأبواب. على اليسار كانت تظهر لنا تموجات التلال، وفي الأفق يبدو « سيدي علي بن أحمد » وكانت رؤوس جبال صخور الرحامنة تظهر تارة وتختفي تارة أخرى .عند اقترابنا من قبة الولي سيدي بركة، انعطفنا نحو اليمين، كانت البلاد قليلة الزرع وسنابل الشعير لازالت مخضرة، طرقاتها ومسالكها خالية من البشر، لا تكاد تصادف راجلا أو راكبا، مناسبة عيد المولد جعلت الناس يلزمون أسرهم وعائلاتهم .
عند منتصف النهار تناولنا غذاءنا قرب قبة الولي سيدي محمد بن رحال، ثم استأنفنا مسيرنا في الواحدة والنصف بعد الزوال. كان الجو حارا، وكنا نسير سيرا حثيثا في أرض كالسهوب الجافة حيث لم يتبق من العشب إلا القليل، تحاول بعض القطعان من الغنم أن تقتات على ما تبقى منه، لا يقطع رتابة ووحشة هذا المكان إلا بعض النخيلات القصيرة المتناثرة هنا وهناك . بعد مدة بدأت تتغير معالم المكان، هذا الجبل الأخضر يمتد على اليمين، وتلك صخور الرحامنة تنتصب في الأفق، ومن وراءها تلوح قمم الأطلس مكللة بالثلوج، وهذه طريقنا بدأت تنخفض وتعلو تارة، تتلوى وتستقيم بين الوهاد والشعاب تارة أخرى، إلى أن أصبحنا نسير في منحدر من الأرض امتد لمسافة طويلة، لم ينته إلا بعد وصولنا عند الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال إلى مشرع بن عبو. آوينا إلى مكان يشرف على نهر أم الربيع، فأقمنا فيه مخيما يحيط به خندق صغير، وفي الأسفل على ضفة النهر، كان يترائى لنا بعض الجنود وهم يتجولون بين معدات موقع عسكري دفاعي كانوا قد أعدوه بين نخلتين كبيرتين. عند المساء كانت الحرارة قد انخفضت، وأمسى الجو أكثر رطوبة وانتعاشا وانتشرت في المخيم حركة من الحيوية والنشاط والحميمية، فدعانا الملازم de Féraudyلمقاسمته وجبة عشائه صحبة العقيد Godlewski تحت خيمة ميدانية.
*********
على الساعة السابعة والنصف صباحا كانت السماء تبدو صافية الأديم، وكنا نحس أن اليوم سيكون حارا كسابقه. غادرنا المخيم وعبرنا النهر، ومشينا صعودا في أرض رطبة محمرة إلى أن بلغ بنا المسير محاذاة “مولاي المجيب” وهو دوار أغلبية سكانه من أصول جزائرية. كنا قد تركنا الشاوية وراءنا وانفتح أمامنا فضاء من التضاريس المختلفة، تهيمن عليه كثير من التلال والأودية والهضاب، وانتابنا مزيج من الشعور بالفرح والرهبة أمام هذا الفضاء المجهول الذي ينفتح أمامنا، بحيث لم يكن يخفف من هذه المشاعر المختلطة إلا صورة هذا العجوز الوقور ذي اللحية البيضاء والذي لا زال يسير في أثر ركبنا دون كلل أو عياء، فكأنما بمثابرته وأناته منحنا القدرة على الصبر والمجاهدة.
دخلنا صخور الرحامنة وكان أول دوار نصادفه عن يميننا هو دوار أولاد بن علي« أولاد يعلى ». جرى الأطفال والنساء نحونا ليشاهدوا ” النصارى” حسب تعبيرهم يمرون بمحاذاة دوارهم. عند الساعة الحادية عشرة والنصف صادفنا في طريقنا ثلاثة أكوام من الحجر أو ما يسميه أهل البلد “كركور” وهم يضعونها عند المكان الذي يجب الولوج منه في المناطق الجبلية أو الوعرة خوفا من أن يتيه المسافرون الغرباء بين الشعاب والوديان . بعد تجاوز معبر صغير أصبح بإمكاننا أن نطل على سوق الأربعاء. على اليسار تبرز الصخور ناتئة مهيبة مكسوة بزرقة خفيفة تمتد طولا من الشمال إلى الجنوب، وتنوء بكلكلها على سهل صغير تبرز فيه ثلاث قباب بيضاء تحفها نخلتان. توقفنا من أجل تناول وجبة الغذاء على الساعة الثانية عشرة والربع زوالا قرب بئر. وكان الفضوليون من أهل البلد يحاولون الاقتراب منا شيئا فشيئا للتطلع إلى سحناتنا وألبستنا ومتاعنا. بعض النسوة كن منهمكات في جلب الماء من قاع بئر، وكن يستعملن لذلك دلاء من جلد الماعز.أما الأطفال فقد جلسوا القرفصاء حولنا دون أن يقتربوا منا كثيرا. كانوا يتحدثون بينهم بهمس وبعضهم كانوا يتنازعون علبة سردين فارغة. لم يطل بنا المقام كثيرا، وغادرنا المكان على الساعة الواحدة وعشر دقائق، نشق طريقنا عبر ساحة السوق وسط اندهاش أهل البلد، و صياح البعض منهم في وجوهنا. لم نكترث لذلك وتابعنا رحلتنا وسط حقول ضعيفة من الشعير التي ألهبتها حرارة الشمس طوال أيام عديدة من قساوة الجو وجفاف المناخ، إلى أن وجدنا في طريقنا قبة ضريح ولي. عندها أوقف صديقنا العجوز الذي ظل مرافقا لرحلتنا حماره، وجعل الضريح في قبلته ثم بدأ في التوسل والدعاء مطأطئا رأسه في خشوع، باسطا كفيه عند مستوى سرته في ضروع، يشكر ربه على تمكنه من الرجوع إلى بلده سالما رغم الرصاصات السبع التي أصابت جسده . وبينما نحن كذلك، إذ بفارس على صهوة جواده يندفع نحونا بتهور وهو يشيل بندقيته نحو السماء ويسألنا: هل وصل الفرنسيون؟ فارس آخر حيانا وتوجه نحو الشيخ يقبل طيلسانه ثم أقبل طفل يجري، وبدأ يقبل يدي جده فضمه هذا الأخير إليه وشرع يقبله على جبينه في شوق واشتياق…
************
…انفضت باقي النسوة وبقيت وحيدة مع الضرتين الجميلتين. كانت كبراهما تحدق في عقد الكهرمان الذي في عنقي كأنما تتمناه، لم أستطع أن أحرمها منه، وما كدت أهبه لها وأضعه في جيدها حتى انهالت علي بحركات شديدة تعبر عن حبها لي وامتنانها على حسن صنيعي معها. أما بالنسبة للصغرى فلم أجد بدا من وعدها بعقد آخر في مناسبة أخرى. ونزولا عند رغبتهما كان علي أن أكشف لهما عن لون و ملمس شعري، وكان علي أن أبين نوع المادة التي صنعت منها قبعة “الباناما” التي كنت أضعها على رأسي وعندما لم أكن أفهم معنى جملة مما تقولانه لي، كانتا تصرخان بها في أذني وتربتان بخفة على يدي.
انصرفت الكبرى لتهييء الطعام، ولمحت نصف خروف سيكون وجبة للعشاء. طلبت مني خدوج الطفلة الصغيرة أن أعطيها بسكويتا، فوجدتها فرصة سانحة لأقف وأنصرف لأريح ساقي مما أصابهما من خدر وتقلصات بسبب طول مدة جلوسي قرفصاء. ولم يمض ربع ساعة على التماسي قسطا من الراحة داخل الخيمة، حتى دخلت علي خدوج فأخذت بيدي وقادتني إلى” النوالة“ جلست على ركبتي، وألحت على عدم مفارقتي لها وهي تضحك ملء فمها.
عادت الكبرى من الضرتين وانضمت إلينا، وكان علي أن أنزل عند رغبتما في لمس شعري الأشقر وتأمل لون عيني الأزرق. ثم أرادتا أن تطلعا على سائر جسدي لكنني رفضت. ثم نزعت حذائي وشرعت اشرح لهن طريقة حزم خيوطه، وطريقة لبس سروال” الليجنس”. ولم يثر استغرابهن شيء آخر أكثر من حزام مطاطي كان مخيطا بمعطفي، كن يجذبنه الواحدة تلو الأخرى، ثم يطلقنه فيعلو صياحهن وضحكهن لذلك. بعد ذلك جاء دور الأزرار التي تغلق بالضغط، وتوالت أسئلتهن: ألا يمكن أن أتجمد من البرد ليلا بعد أن أخلع هذه الملابس وأنام بقميص خفيف؟ !. وهل أنا التي قمت بخياطتها …؟ كن معجبات بجودة الثوب، ولذلك رحن يقلبنه مرارا ويجربن متانته بجذبات قوية متتالية. لم يستوعبن أن لون بشرة وجهي كان بفعل الماكياج، وكان ظهور زرقة شرايين يدي تحت بشرتي البيضاء بالنسبة إليهن دليلا على أنني “صفراء” بفعل نقص الدم في جسدي، ولذلك كن يظهرن لي بكثير من الفخر والارتياح سيقانهن البنية المليئة بالدم حسب زعمهن…
*******
بعيدا عن باريس.. عشاء في سيدي البهيليل على ضوء قنديل .
… بدأ الليل يرخي سدوله حينما التحقت بنا امرأتان صديقتان للأسرة كانت إحداهما ذات سحنة باسكية، بشرة بيضاء وعينان متقدتان. اجتمعنا كلنا في « نوالة » مؤثثة بما هو ضروري من أفرشة بسيطة وحصر، وفي ركن منها أغطية بالية مطوية بعضها فوق بعض على صندوق خشبي، وقنديل تبعث ذبالته لهبا ضعيفا ينوس متثاقلا في فتور فلا يكاد ضوءه ينير أرجاء المكان. ناولنني وعاء حليب ثم طفن به تباعا على الجميع. وفي ركن عند المدخل، جثت إحدى النسوة على ركبتيها تمسك كيرا صغيرا ” رابوز” وتلهب النار بكل جهدها في مجمر من طين وضعت فوقه غلاية “مقراج ” فيه ماء ليغلي وبيض ليسلق. بادرت الأم العجوز ذات الشعر الأحمر بفعل التخضيب بالحناء تقرب إلي الكسكس ولحم الخروف في إناء من طين، وعلى ما يبدو كان الاهتمام بالنظافة قليلا إلا أن الضوء الخافت جنبني رؤية كثير من الأشياء التي كان من الممكن أن تثير اشمئزازي. أما خدوج فقد كانت تلعق أصابعها مما علق بها من طعام ثم تعيد مش ما فضل من عظم. بعد ذلك، تتابع أكلها بجمع الكسكس في إحدى كفيها وتضغطه ضغطا خفيفا لتشكله على هيأة كرة صغيرة تتلقفها بسرعة في فمها كما يفعل الرجال في العادة، وبعد أن تأكل كفايتها تتجشأ بارتياح كبير. كان هذا هو الطبق الأول، أما الطبق الثاني فكان من لحم عجل أظن أنه طبخ في الماء. قامت عائشة بإعداد شاي من نفس الغلاية التي سلق فيها البيض قبل قليل. فشربت منه خمسة كؤوس وكانت الأخريات يرشفنه بشفتين مزمومتين فيسمع لذلك صوت ممدود ينم عن استمتاعهن وتمتعهن بهذا االمشروب . لم يكن يقدمن لي الشاي في نفس الكأس الذي أشرب منه، بل كان ذلك يتم كيفما اتفق، لكن هذا لم يكن يهمني ما دام الشاي يدفئ جسدي في هاته الليلة الباردة. انزوت الأم العجوز في ركن معتم من « النوالة » افترشت زربية صغيرة، وجثت على ركبتيها، ثم بدأت تؤدي صلاتها وهي تتلو وتدعو بصوت خافت يتخلل ذلك ركوع وسجود. وما إن تنهي عددا من الركعات حتى تتوقف لتشرب الشاي أو تشارك في الحديث ثم تستأنف صلاة أخرى. دلف علينا محمد وشاركنا شرب الشاي، أخبرته النسوة في تعجب بأنني أتكلم بعض الجمل العربية، سمع مني بعضا منها، لكنه لم يعر ذلك اهتماما. قضيت أربع ساعات عند مضيفاتي وبدأت أحس بالتعب يهد جسمي وبالصداع ينتاب رأسي، وشعرت أنني في أشد الحاجة إلى الراحة والنوم، سيما وأنها التاسعة ليلا وقد بدأ جاك يقلق على طول غيابي، لقد حان وقت الانصراف… حملت بضع بيضات أصرت مضيفاتي على تقديمها إلي من أجل التزود بها في الطريق إكراما لي وعناية بي. شكرتهن، ثم ودعنني وذلك وبتقبيل أيديهن بعد مصافحتي. جاء السي محمد ليتناول عشاءه في الخيمة، وشرع يحكي لنا أشجانه ومآسيه، كمن يبحث عمن يشد عضده ويقوي سنده. وباتت الكلاب طول الليل تنبح وتتهارش تارة وتتسكع حول الخيمة تارة أخرى أو تسعى لتلغ من الماء القليل الذي نوفره في سطل لحاجتنا، كما بات بالقرب منا خمسة حراس جلسوا على حصير وأسندوا ظهورهم إلى الحائط ، يثرثون ويغنون ليغالبوا سيطرة النوم عليهم. وقضت الدواب المربوطة أمام خيامنا جزءا كبيرا من الليل تصهل وتضرب الأرض بحوافرها مثيرة بذلك جلبة وصخبا أفقدنا كثيرا من متعة النوم…
******
في الطريق إلى سيدي بوعثمان، ﻻطير يطير، وﻻ نبات ينمو، وﻻ مسافرين يعبرون السبيل…
23 مارس 1910
لم يكد ضوء الصبح يتسلل عبر خيوط قماش الخيمة، حتى قام أحد أهل البلد يؤذن للصلاة بأعلى ما أمكنه من جهد. راقني صوته الرخيم لكن حدته أذهبت عني النوم . أقبل السي محمد ليلقي علينا تحية الصباح، كان مرفوقا بخدوج التي أمسكتني من يدي، وتوجهت بي إلى «الحوش» حيث توجد النوايل، وحيث تحلقت حولي النساء يودعنني، ويطلبن مني أن أعود عبر سيدي البهيليل، لأزورهن مرة أخرى عند عودتي من مراكش. بعدها رجعت إلى المخيم في انتظار ساعة استئناف السفر. جلست أتأمل شاة كانت قد وضعت مولودها في تلك الليلة، كان الحمل ملتصقا بأمه ليأخذ بجانبها قسطا من دفء الشمس، وكان هناك كلب يحاول اﻻقتراب منه، لكن الشاة وبانحناءة من رأسها، كانت تتصدى له بالنطح، فيتراجع مدبرا خائفا.
عند الساعة السابعة والنصف غادرنا المكان، وكانت خدوج في منتهى اليأس؛ كانت تبكي، وكانت دموعها تبلل خديها ووجهها، فوعدتها بأنني سأعود لأراها. ومن أجل تخفيف حزنها حملها أبوها بين ذراعيه عله يهدئ من روعها. جلس الجميع ينظرون إلينا ونحن ننصرف، يرافقنا السي محمد أخ الشيخ في رحلتنا إلى مراكش، وبعض الصبية يتبعوننا مهرولين يلتمسون منا بعض النقود.
كانت السماء صافية، وحرارة الجو قد بدأت في الارتفاع، رغم أن برودة الليلة الماضية كانت متدنية وصلت حتى حدود الصفر . كانت حقول الشعير كالعادة جافة بفعل نذرة اﻷمطار. وكانت صخور ڴارة « وزرن » المسطحة تنتصب على يميننا، ونحن نسير في منطقة رملية من السهوب الجافة. أما في الجهة المقابلة لنا، فقد كانت ملامح اﻷطلس تخترق غبش الصباح، وتنجلي أمامنا بوضوح شيئا فشيئا . بعد أمد قصير أصبحت الطريق كثيرة الأحجار والحصى، بحيث كانت بعضها تدخل بين سنابك البغال وحوافرها. وعلى يميننا كانت تبرز هناك « نزالة » محاطة بالصبار، كما كان هناك قطيع من الغنم يبحث عن قليل من المرعى في أرض منبسطة حصباء، ينتشر فيها حجر صغير أبيض محمر يشبه الرخام. على يميننا يوجد دوار« أوﻻد نايل الشياظمة». كان أهل هذا الدوار يرتدون ثيابا زاهية اﻷلوان، ينهمكون في غسل ملا بسهم بضربها بأرجلهم وصب كثير من الماء عليها بين الفينة واﻷخرى، ويرددون في نفس الوقت أهزوجة تبث الشكوى بإيقاع رتيب. كانت جلاليبهم تجف تحت أشعة الشمس، وكانت الظفائر المتدلية من جوانب رؤوسهم تجعلهم يظهرون في شكل مخيف.
إنها الساعة التاسعة صباحا، الشمس حارة ،وحقول الحرث أكثر انتشارا في هذا البلد، بين الفينة واﻷخرى كانت المزاريب الجافة التي تحول عادة مياه اﻷمطار نحو الحقول تقطع الطريق. على اليمين «ابن جرير» وقطعان كثيرة من الغنم والماعز تتثير في وجوهنا كثيرا من الغبار وهي في طريقها نحو السوق . في الساعة الحادية عشرة كنا بمحاذاة « دوار الرڴيڴ »، بدأنا نقطع سهلا جافا، لاح لنا فيه عن بعد جملان يحملان الحطب، تخالهما ﻷول وهلة شجيرتين تمشيان الهوينى. من بعيد كانت ” نزالة العظم ” تبدو صغيرة كنقطة سوداء، وصلنا إليها عند الزوال، وتوقفنا لتناول وجبة الغذاء تحت الشجرة الوحيدة التي صادفناها خلال كل هذا الصباح، والتي لم تكن سوى سدرة قليلة اﻷوراق، كانت مصدر بهجة لنا بالرغم من شح ظلها. جاء بعض اﻷطفال والنساء يركضون نحونا يعرضون علينا البيض واللبن المنزوع الدسم في قلال صغيرة، لم أستطع أن أشرب منه شيئا لما علق به من أوساخ وشعر الدواب، أما جاك واﻵخرون فقد شربوا منه ما استطاعوا دون أن يهمهم ذلك. كانت النساء يلبسن « الخنت » وهو ثوب أزرق مربوط عند الكتفين بصفيحة معدنية، ويتمنطقن بحبل يشد وسطهن، ويغطين رؤوسهن بمنديل؛ كن يظفرن مع شعرهن خيوطا سوداء من الصوف تتدلى مع ظفائرهن، كما كن يزينن وجوههن بالوشم، فكن يظهرن على هيأة نساء البدو في جنوب الجزائر.
يمتد أمام أعيننا الآن سراب عجيب، يبدو كبحيرة زرقاء تحيط بها بعض الشجيرات، وحيثما وليت وجهك كان ذلك يوهمك بوجود برك عديدة تمتد الواحدة منها خمسين أو ستين مترا. كان الهواء حولنا حارا كأنه يغلي، فلم يجد السي محمد بدا في الجلوس تحت ظل جواده. عند الواحدة والربع حملنا أمتعتنا على الدواب واستأنفنا المسير. لم يعد لدينا ماء منذ هذا الصباح، ولن نحصل عليه إﻻ عند وصولنا إلى المحطة المقبلة خلال هذا المساء. كان السراب كمن يسخر منا، إذ كان يمنينا بالماء، و كلما دنونا منه كان يبتعد عنا، وكان هذا السراب وأعمدة الغبار التي يصعدها الهواء الحار واﻷرض العارية التي تمتد أمامنا توحي لنا بأننا في صحراء من اﻷرض مقفرة.
كان المكان الذي يحيط بنا يبعث اليأس والسأم؛ ﻻطير يطير، وﻻ نبات ينمو، وﻻ مارة يعبرون! لقد أخذ التعب من الرجال ومن الدواب كل مأخذ، وبدأ اﻻرتخاء والنوم يغالب أجسادهم. كان يترائى لنا أن رؤوس “الجبيلات ” تبتعد كلما اقتربنا منها، وأخيرا عند الساعة الخامسة مساء وصلنا «نزالة سيدي بوعثمان » وهي عبارة عن مجموعة من ” النوايل “، أقمنا خيامنا، ووجهنا مداخلها نحو ” الدوار “. تجمع بعض السكان أمامنا جالسين في صمت. بدأ الليل يزحف، وراحت قطعان اﻷغنام إلى حواظرها تثغو، وطلع البدر بهيا يكسو بضيائه قمم التلال فتبدو مهيبة في شموخ، و يظهر ” الدوار ” من تحتها متواضعا في سكون. وبات اثنان من رجال الحراسة مستندين إلى خيامنا، ملتفين في برنسيهما، وقضيا الليل كله وهما يثرثران بدون انقطاع…
*******************
استأنفنا رحلتنا على الساعة السابعة والنصف صباحا، وكانت الريح الباردة التي تهب من أعالي الأطلس تجمد أطرافنا، سرنا عبر ممر كثير اﻷحجار، عبرنا خلاله لمرتين متتاليتين بطن واد جاف، ثم مررنا بمحاذاة ركام كبير من الحجارة ” كركور” يدل المسافرين على المكان الذي ينبغي أن يسلكوه للخروج من بين مرتفعات الجبيلات. فجأة وبعد أن تجاوزنا « قبة سيدي بوكريشة » ، ظهر أمامنا منظرﻻ ينسى…مراكش !
كان ركبنا يتقدم متهاديا عبر واحة النخيل والتي كان علينا أن نقطعها في زهاء ساعة من الزمن قبل أن نصل إلى أسوار المدينة، ثم بدت أمام عيوننا حاضرة مراكش جلية بهية، تتسامى في وسطها صومعة الكتبية نحو السماء كما يتسامى دعاء ضارع متبتل لربه، وخلفها كانت ثلوج اﻷطلس العتيد تلمع تحت وهج شمس الظهيرة. لم أتمالك مشاعري وأحاسيسي أمام هذا المشهد الجليل، وبقيت أرنو إليه، ينتابني إحساس بالبهجة واﻻرتياح بعد أن قطعت من أجله طريقا جذباء تحت هذه الشمس الحارقة ! أصبح رجالنا فجأة كالمجانين، يصرخون ويصيحون: “مدام كتبية ” ويحفزون البغال التي يركبونها على العدو يفعلون ذلك كما لو أنهم يمتطون خيوﻻ في ميدان التبوريدة. كان لزاما علينا أن نطلب منهم أن يقللوا من حماستهم واندفاعهم، وكنا نعرف أن مراكش هي بالفعل جنة بالنسبة إليهم، فهي مدينة المتع والملذات والحسناوات الراقصات ! أصبح الركب اﻵن يمشي حثيثا في صمت والدواب تندفع أكثر فأكثر، وفوق المدينة كان الدخان الأبيض المتصاعد من فوهة المدافع يعلن حلول عيد المولد، عيد احتفال المسلمين بذكرى ميلاد الرسول. »