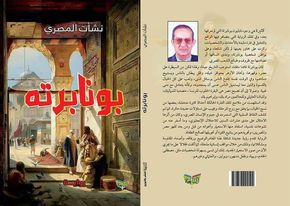تمهيد:
«شوكولاتة نيتشه»، للكاتب المصري المبدع صابر رشدي، نصّ سردي- حكائي يتضمن في جوهره مجموعة قصصٍ قصيرة عذبة مرحة وعميقة، تنحو في اتجاهها إلى استثمار عناصر الواقعية السحرية التي تنفصل طبعا عن واقعية ماركيز وخصائص عالمه الروائي الأمريكو- لاتيني، رغم أنها تتقاطع معها على نحو من الأنحاء، ما يحمل إشارة ما تؤكد على حضور شخصية الروائي ونفسه في أسلوب الكتابة القصصية لدى صابر رشدي، على الرغم من الفوارق الجوهرية القائمة بين فن القصة وفن الرواية، إلا أنهما يمكن أن يتحدا في قواسم مشتركة متينة جامعة بينهما مرئية ومدركة أحيانا، غير مدركة ولا مرئية في أحيان أخرى لدى القارئ. كما يحمل ذلك التقاطع نفسه انفصالا عن العالم المذكور، نظرا لكون بعض قصص المجموعة ترد من بيئة ذات خصوصية اجتماعية وثقافية وسمت جزءا من ملامحها أصوات الشخوص الفاعلة المتعددة الرئيسية منها والثانوية، وكذلك المساكن والحارات والفضاءت الشعبية المصرية البسيطة والهامشية منها خاصة، التي انعكست أصداؤها وأجواؤها الروحانية على بعض أحداث ووقائع القصص المتخيلة، لكن المحكوم منها بوجه أخص بأعراف وتقاليد محلية، يتأرجح فيها البعد الأسطوري بين الغرائبي والخرافي ويتداخل مع المكون الديني والطقس الجنائزي إضافة إلى الشعائري والاحتفالي أيضاً.
عن نزرٍ يسير من هذه الخصائص وغيرها، مما سيتمحور حديثنا حوله هنا انطلاقا من المجموعة بدءًا بتقديم إشارات قرائية فيها، وذلك بالتركيز على ملاحظات بعينها تخص محتوى بضع قصصها، وأخرى تتعلق بالتقنيات الموظفة من قِبل الكاتب في إطار السّعي إلى ملامسة أسلوبه في الكتابة والسّرد من خلال هذه القراءة عموماً، وتحديد موقعه كقاص وموقع السّارد منه روائيًّا، ومن خلال الكتابة السردية النموذجية مثلما انطبعت ذوقيًّا في تصوّرٍ متواضعٍ لكاتبِ هذه السطور وحاول التلميح إلى مُميّزاته واستكناه شيء من الأمارات الدالة عليه، في أحد مواطن هذه المقاربة غير المُحيطة بعالم المجموعة كاملة، لكنها تتوخى تسليط قليل من النور على إحدى زواياها كما نأمل في الآتي..
تداخل الواقعي بالمتخيل والحلم بالحقيقة
لعل أول ما سيتبادر إلى ذهن قارئ النصوص منذ الفاتحة الاِستهلالية لقصصها الأولى، هو ما تتميز به من تنويع في السرد جعلها تتسم بتداخل الزمن الماضي فيها بالحاضر، الواقعي بالمتخيل من الأحداث والشخوص، ثم تداخل الحلم بالحقيقة وذوبانه فيها.
وبالعودة إلى التمهيد، يتضّح أنّه قد كان هناك من بين تلك العوامل، المُساقة أعلاه، ما ساعد في ركنه، بالدفع بالقصص إلى الانفتاح على العبثي والمعقول وعلى الجاد والمبتذل في آن واحد، وجعلها تتصف بامتزج المقدس فيها بالمدنس، والأصيل من القيم الموروثة وحتى المُكتسبة، بالزائف من السلوكات الطارئة التي يفضح السارد على متنها ما تنطوي عليه ثقافة نوع محدد من الفئات البشرية من بلاهة وما يغمر تصرفاتها اليومية الفارغة من أي معنى، من قيم سلبية مرفوضة، ربما لغياب وعيها وشعورها بقيمة اللحظات التي تعيشها، أو لوجودها فيها صُدفة وقد ساقتها إليها أقدامها العمياء.
تنتقد القصص على لسان السارد، ضمن ما تنتقده، أو تعرّيه، أنواع بشرية سيئة السّجيّة والطوية والسّلوك؛ حيث يستحضرها الكاتب مُشخّصة بأدوائها، ليبيّن كيف تعمل من دون تبصّر وتقول من غير تفكير، من حيث قيامها في تلك اللحظات - المشار إليها- بتصرفات بليدة تفتقد للحس الإنساني ولا تتلاءمم معها وتتناقض على عكس ما تستوجبه من صواب وتعقل ومن سداد يسقط من حسابها دون أن تدري..!
لهذا السبب وغيره، يمكن للقارئ أن يدرك لماذا تبدو قصص المؤلّف في أجزاء منها محملة بحس السخرية ذي الطابع النقدي (التقويمي في إحدى غاياته ووظائف اشتغاله) الذي يحيل الكتابة إلى آلية دفاع واخزة بدلالة مّا، وكاشفة بالضرورة عن اتجاهات خطابها، المأخوذ في قسط منه، بأبعاد الخير والجمال والصلاح وبالرغبة الخفيّة في التسوية والتعديل والإصلاح للسلوكيات المعيبة.
تنتبه إلى التفاصيل الصغيرة حيناً، وتلتفت المجموعة في بعض نصوصها -دائماً-، إلى الحدث الطارئ كما تحاول التقاط العابر والاستثنائي والمنفلت الذي لا يُلقى له بالبال في أحيان كثيرة، بالإضافة إلى اهتمامها بالمرئي المُلتقط بعين الكاتب، لكنه في الوقت نفسه ذلك اللاّمرئي واللاّمفكر فيه أيضاً من جهة الآخر/ القارئ، الذي نعلم بواقعيته فقط حين نقرأ عنه فنتذكّره في الحين ثم نقول إذاك: "حقا هذه أشياء سمعنا عنها". مثلما نقول عن أخرى: "إنها موجودة فعلا ونعرفها". وكأننا بكاتبها يستدرج قُرّاءه هنا، ليُذكّرهم على طريقته الخاصة التي لا يلج مسالكها أحد غيره، بما عاشوه/ وعاشه الناس، واكتسبوه، ويعيشونه- من تجارب، ويعرفونه من معلومات، لكنهم ينسون أنهم عاشوها وعرفوها، ما يضع – متلقيه- إذا شئنا الدّقة، وهو يذكّرهم بها أو يدعوهم إلى اكتشاف ما في نصّه من جديد يريد إطلاعهم عليه، في مقام الجاهلين المُستكشفين سواء أحبوا ذلك أم كرهوه، ما دام الكتاب، أيًّا كانت هويّته، «مُعلّماً صامتاً»، في نهاية المطاف، كما قال بذلك قديماً الكاتب والطبيب الإغريقي "جالينوس". لكن هم كذلك أيضاً ما دام «التذكر هو المعرفة والجهل هو النسيان بعينه»، على حد تعبير الفيلسوف اليوناني "أفلاطون".
المقتفي لأثر النص من أوّله حيث جاء قول السارد: «كُنتُ أراه في منامي، صبيًّا جميلاً، مغمورًا بالضّياء...»- ص 3-، قد يدلف إلى صلبه ويصل إلى المُتاح من خلفياته وجذور انطلاقه، حيث تتوضّح له منذ البداية أنه بصدد مجموعة قصصية تحكمها الجملة السردية الروائية، وتتوفر على نُتفٍ من عناصر السيرة الذاتية الروائية، المستثمرة فيها إلى حدود ما، خصوصا أنّ اشتغال الذاكرة فيها متألّق في ظل اعتمادها على تقنية الاِسترجاع، رغم أن الأمر يتعلق بمجموعة قصصية أكثر من أي نوع أدبيّ آخر مُحتمل، وهذا في حد ذاته شيء جميل وكاسر للمألوف، مع هامشيته، لأنه يطرح - بشكل من الأشكال- مسألة تداخل الأجناس وتحاورها. واستناداً إلى المُعطى الأوّل ضمن هذا السياق، يأتي التساؤل: هل كان من المفروض فعلاً، أو من الممكن فقط، على الكاتب تسمية عمله "متتالية قصصية" أو "روائية"، بدل "مجموعة قصصية"؟
وفضلا عن ذلك، فإنّ الإمعان في إبداعيّة القصص شكلاً ومضموناً، يؤدي إلى رؤية مفادها أنّ هناك في كتابة المبدع صابر رشدي، رشاقة، وإيحاءً، وغِنىً، وإيجازاً عميقاً، وكثافة لا تخطئها العين، وغيرها من العلامات الدالة على الوعي بتقنيات وأساسيات تدوين القصّة القصيرة، فهي إلى جانب ذلك كتابة تحظى في تنويعاتها الأسلوبية في توصيل المراد من المعاني والدلالات المباشر منها والضّمني أيضاً بنصيب غير قليل من الشعرية، بل من السحرية الواقعية التي تسير على هدي المنوال المشار إليه في بداية الحديث عن اتجاه حكايات مجموعته "شكولاتة نيتشه" التي لا تخلو من السمات الأدبية الأصيلة المميزة لحكاياتها ذات النكهة الغرائبية والعجائبية؛ لاسيما إذا أمعنّا النّظر ولاحظنا استعانة المؤلف بالرائج في التراث والثقافة الشعبيين ويستحق الالتفات، من خرافة مُطعّمة بالموروث الشعبي الذي يمتحُ من عوالمه مواد مُحددة لصفات بعض شخصيات حكاياته وملامح مكوِّنة لهذه الأخيرة ولبنية بعضها وحبكتها، من قبيل: "الزار"، "العرافة"، "الجن والعفاريت"، "انتقام القطط".. وغيرها من الأمثلة كثير ومتعدد.
نوستالجيا الطفولة والاحتفال بالذاكرة
رغم أن القصص تشتمل على مفردات ترتبط بمناخها وبسياقها الشعبيين وثقافتها المحلية، بيد أنّ أغلب قصص شكولاتة نيتشه، ديدن ساردها الإتكاء على الذاكرة التي هي نبعها الذي تتدفق وتندلق منه كنهر سلس جارٍ بلا تعقيدات لفظية، نلمح فيها بساطة في التعبير الذي يكتسب قيمته والمجهود الذي بذله صاحبه حتى صاغه كما ارتأى، في سياقات توظيفه السليم لتلك الألفاظ.
هكذا إذن، يحتفل الكاتب بالذاكرة – بوعي منه أو بدونه- ويتكئ عليها (بموازاة المخيّلة) بوصفها خزّانا للتجارب بكل حمولتها التقنية في التوظيف والاستعمال لكي تؤدي دورها كما يستحثها ويتوسله منها، أن تعمل بجلاء كآلية جبّارة للتذكر أو الاستعادة أو الاستحضار للماضي من خلال العودة عبر الذاكرة إلى الطفولة البعيدة والسياحة الإبداعية/ الذاتية في الأزمنة والأمكنة والمشاعر والوجوه القديمة واستلهام السرد الآني من وحي أطلالها كما ارتسمت في روح مالكها وترسّخت في وجدانه وركنها في خزانة مِخياله حيث يمتح الصور والأحداث ويصوغ المعنى ويلوح بالمغزى المكنون والمُحتمل كيفما شاء.
وعسى الذاكرة بمفهومها المذكور هنا، أن تكون - كما تبدو- حاملة لسمات محضة تتعلق بجنس السيرة الذاتية ومتصلة بالذاكرة ذاتها، التي صيغت في النظرية السردية أداة نشِطة وصلها نقادها بهذا النوع السردي لكي يصير قائم الذات متصلا بشخصية صاحبه المؤلف وبسرد جزء من (أو/ جُلّ) وقائع تجاربه الحقيقية المستعادة على متن الذاكرة بوصفها مستودع المواقف والمشاهد والصور والأحداث وعنصرا قويا ومهيمنا في عملية السرد الذاتي، الذي يحضر هنا، ولو داخل نوع آخر يحمل مسمى "مجموعة قصصية" ما دامت آلية اشتغالها من لدن الكاتب تسير في هذا المنحى السيري/ المحكي الشخصي لأجزاء حياتية معيشة وتاريخية متقطعة ومتباينة، تنطلق من مرحلة الطفولة وذكرياتها المسترجعة، أو العالم الطفولي -بالأحرى-، ببراءته وشغبه ومرحه وحلمه ودهشة اكتشافه وفضوله وتلقائيته وخياله الحر.
إنّه ذلك العالم الذي يحتفي الكاتب بروحه أحيانا على لسان السارد الصبي/ الطفل الذي كانه وأحبه في داخله وصار يتسيعده بنوع من الغبطة ومن التكرار لشيئ من تجاربه السابقة كما تخيلها أو حدثت بالفعل، لكن من جديد كما لو أنه يريد امتلاكها هنا الآن وإلى الأبد.
وهو بهذا يذكرنا بما يطلق عليه الفيلسوف الألماني "نيتشه" مفهوم أو معنى "العود الأبدي"، للشيء الذي كان وأصبح ممكنا ظهوره مرة أخرى في طلعات متعددة بطرق مختلفة، الشيء الذي يذهب ويعود والذي يغيب ويحضر في دورة أبدية تتعاقب وتتجدد وتعيد نفسها مثل الليل والنهار والشمس والقمر والميلاد والموت، كالشيء الأشبه باللحن الموسيقي الذي نعزفه لمكتوب، أو لقدر يكرر ذاته، كالقوّة والضّعف، وكالغنى والفقر، كظاهرتي النجاح والفشل في العمل والزواج –مثلا- وفي غيرهما، بغض النظر عمّن انعكست عليه آثار تجربتهما إلا أنهما موجودان على الدوام كواقع يفرض نفسه ويتوزع كما يتجسّد في حالات شتى.. وما إن يتكرر في هذه، حتى لا يلبث من أن يتغير ليتكرر مرّة أخرى في غيرها، حتى يحس به الإنسان ويفهمه ويحبّه ويتقبّل فكرته ووجوده، ومن ثم- يعترف به ويوافق عليه كما يقول نعم لأمل يكرر ذاته، ولألم يكرر ذاته، لحالة استثنائية وللحظة غريبة معها سبق قولنا لهما نعم، ولذكرى سعيدة قلنا لها كذلك نعم.
هكذا تتكرر الحالات المختلفة، وتتردد كلها في ذاتها، مع الأحداث ومع الخبرات التي عقدنا معها صفقة إستطيقية تربطنا بها فنكررها بدورنا من جديد، مثل قطعة موسيقية مبهجة أو ناعمة أو شجية مؤثرة نحبها فنشدو بها بلا ملل ثم نعيدها ونرددها دائما على أسماعنا ونظل نحبّها إعلانا بسعادتنا بها إلى الأبد، ككل الأشياء الجديدة التي سنمتلكها وتكرر نفسها والقديمة التي عرفناها وكانت في ملكيتنا ومنها التجارب الماضية التي نحبها والتي لا نحبها، لكنها باتت جزءا منا، كالتي عشناها وتصالحنا معها أيضا ثم تقبلناها وأحببناها كما كانت بسعادتها وشقائها، بتفاصيلها المبهجة السعيدة ومآسيها الحزينة.. وتبعاً لهذا الفهم يستمر قياس القارئ العزيز.
هكذا بالتالي، وتبعا لهذا المعنى، يتجدد حضور ذلك الآخر/ الطفل/ الغائب المخبوء داخل كل إنسان/ فرد، ومن خلال الذاكرة يطلع بروحه التي هي بين الغريب والمألوف، و بين القريب والبعيد، تبدو بين- بين، كما كانت في الماضي أو غدت عليه في الحاضر بعدما تدرجت في منحنيات متفاوتة من النضج والوعي والتطور، واتخذت أشكالها هيئات جديدة تحدد منظر هذا الطفل الكبير، وتوضح كنه ذاك الرجل، وماهيته، التي يمكن لها أن تتجلى مرئية لكل الناس في ذات الفنان أو الأديب مثالاً.
وفق هذا النمط -إذاً- يحتفي القاص الأديب صابر رشدي بماضٍ يحنُّ إليه بالعودة التي تحققت في الزمن الراهن، باعتباره طريقا نقله إليه وأصبح يمتلكه فيه، لا يسير في اتجاه المستقبل فحسب، بل واستشرافه أيضًا زمناً يضمن خلود الماضي المحمول والمرتحل فيه على نحو أبدي.
بفضل الكتابة، هكذا يحتفل طوراً آخر مؤلف "شوكولاتة نيتشه" بعالم الطفولة الملازمة له وبحياة وجاذبية صورة ذاك الطفل الذي كانه وظل يستمتع بجماله ويحمله إلى الآن في وجدانه كاتباً ويحمله مبدعاً فوق كتفيه، كما يحتفل مجدّداً إلى جانبه، بنفسه الساردة، بهويته الروائية التي ما انفكت تختفي وتظهر، معجونة الطينة بهوية القاص، فتتجانس معها ثم تُفرغان معاً في قالب واحد. ولعل هذه واحدة من بين الحالات الاستثنائية النادرة التي قلّما نصادفها في الكتابة الإبداعية. حالة مهمة تشي بقدرة خلاّقة، وتنبئ بمهارة فنيّة في اللعبة السردية العاكسة لصورة السارد ونوعيته في مرآة القارئ، هي نفسها مهارة الكاتب التي كشفت عنها موهبتان يمتلكهما، لملم بينهما وضمّهما في نصّه حيث كشف عنهما بدوره من زاويته وألّف بين قلبيهما: موهبة الروائي وموهبة القاص.
الرؤية السردية والأسلوب وبعض آليات اشتغال النص
نجد أسلوب المجموعة أنه يغترف من تنويعات أخرى تتعلق أساسا بتوظيف السرد المختلف الذي ساهم في منح قصص المؤلف أوصاف عامة تشترك مع الخصائص نفسها التي قد نجدها في الرواية أو في السيرة الذاتية وغيرها من الأنواع السردية المتبانية في قواعد تدوينها والمختلفة في شروط تسميتها وتجنيسها النوعي؛ هذا من جهة.أما من جهة ثانية؛ وسعيا إلى توضيح ما تم الإيحاء إليه ووسمه بالتنويع السردي المميز للكتابة استكمالا لذكر بعض تجلياتها هنا من حيث الأسلوب، فجدير بالتأكيد على أن السارد يتجلى، أحيانا، مشاركا في الأحداث، كراصد أنثروبولوجي- ثقافي، كمن يكتب سيرته الذاتية في إطارها العام الأقرب إلى صنف المحكي الذاتي، وليس بمفهومها الدقيق والصارم، وأحيانا أخرى يبدو كمن يختفي خلف شخصياته، يراقبها تارة ويدفع بها إلى الفعل من خلال تحريكها كما يشاء بحرية تامة تارة أخرى؛ ما يعني تبنيه في السرد لرؤيتين معاً، واحدة من "الخلف" لأنه يظهر كالعارف والعليم بكل شيء متصل بشخصياته وعالمه برمته. أما الثانية فهي "مصاحبة".. وأحيانا أخرى، يتبنى "رؤية من الخارج"، تضاف إلى الاثنتين، ما يفسر بوضوح إعماله لجميع الرؤى الثلاث المقترحة نظريا والحاضرة عمليا في السرد الأدبي/ الحكائي. تطفو المصاحبة على سطح السرد عندما يظهر السارد لا أقل معرفة من الشخصيات ومسلك مضي أحداث حكاية ما، ولا أكثر معرفة منها في الوقت نفسه، وهكذا يبدوان متساويين في علمهما. في حين تتمظهر الرؤية من الخارج حينما يصور لنا السارد عينة من شخصيات المجموعة/ أو المتتالية القصصية، أكثر معرفة منه فيما هو أقل معرفة منها فيما ستؤول إليه مصائر أفعال شخصيات أخرى وما قامت به من أحداث نهايتها مفتوحة غير معروفة.. الشيء الذي يدعو إلى التفسير والفهم ويفتح باب التأويل على مستوى التلقي على مصراعيه عسى القارئ يتدخل أو يتفاعل أو يشارك في تأمل باقي الحكاية الناقص إذا أراد فعلا القبض على خيوط المعنى المنلفت والمغزى المُبطّن الخافي فيها أو الذي يسقطه السارد بمحض إرادته أو بدونها، بوعيه أو لاوعيه كذلك.
وبالإضافة إلى ما تقدم، هناك بالمقابل في هذه القصص/ الحكايات، استثمار لتقنية تيار الوعي في الكتابة، وللفلاش باك، وكذلك لأسلوب التداعي الحر بالمعنى الذي حددته صياغة العالم النفسي النمساوي "سيغموند فرويد" له كأداة تحليلية في سياق نظريته "اللاشعورية" التي أراد بوصلة الأدب أن تتوجه إلى منطقتها في النفس البشرية لاستكشاف شيء من غموضها وإضاءته؛ لاسيما إذا أخذنا في الحسبان أن السارد يستقرئ مكنونات الشخصيات وأعماقها من الناحية النفسية وما يجوس بداخلها ويجول في شق من باطنها ولاوعيها من أفكار وأحاسيس وصور قائمة بذاتها واقعيا/ تخييليا، ويترك لها العنان لتنساب وتتدفق بحرية وطلاقة. ما يؤدي بعمليات التفكير داخل النص وفي خارجه أيضاً، إلى أن تتحول وتتنوع وتتعدد، وتنتقل من عملية خاصة بالشخصية الواحدة إلى وجهة نظر فردية يتبناها السارد أو يقترحها فنيا على غيره/ القارئ، لتأخذ وجهات نظر مختلفة يتقاسمها قراء نصوصه جميعا فيما بينهم وبطرق شتى ومتفاوتة حسب تعدد مستويات القراءة واختلاف زوايا آفاق التلقي ومراتب الفهم والتأويل.
من البدهي والطبيعي القول إن الراوي/ السارد، في اللعبة الحكائية قد يكون هو الكاتب نفسه، وقد لا يكون هو حين يغدو مستقل الذات عنه. إلاّ أنّ الكاتب يتقمّص بحال من الأحوال ذات السارد وهو يحكي بضميره، كما يفعل مع باقي شخوصه، أو هكذا يجب عليه أن يفعل وهو ينشئ عالمه الواقعي أو المُتخيّل. أمّا السارد في المجموعة عنوان اشتغالنا، فيتجلى في أكثر حالاته عنصرا منتميا إلى هذا العالم في (الشكولاتة)، مشاركا فيه بحضور شبه كامل، وممارسا للحكي من الداخل (داخل عوالم القصص) وأقل قليلا من الخارج. ونتيجة لذلك، تعتبر الرؤية الخلفية هي الطاغية والمهيمنة مقارنة بالأخريين؛ بالنظر إلى كون الأحداث تأتي من الماضي السحيق الذي تستدعيه الذاكرة الطفولية البعيدة التي لا تخلو هي الأخرى من خصائص خاصة تميزها في نصوص المجموعة.
الكتابة استجابة لنداء خفيّ
عندي، وِفق تصوّر غير مشترك - بالضرورة -، أنّ الكاتب الناثر السارد الجيّد خاصة في مجالات القصّة والرواية وكتابات الرحلات واليوميات والمذكرات والسيرة الذاتية والأنواع الأخرى المجاورة والمشابهة لها، هو ذاك الذي تتهيّأ لي صورته في من يضع نصب عينيه وهو يكتب كما لو أنه يعيش آخر نزالاته وزفراته مع اللغة في حلبة المعاني والكلمات. لكن المقصود هنا بالإشارة أكثر على وجه التحديد والدقة ذلك الكاتب الماسك بالأخصّ على جمرة الكتابة الموضوعة على راحة كفه بالروح وبالدّم كأنها قدَره الذي لا مفر منه ويلح عليه إدراكه والوعي به والاستجابة السليمة لندائه الخفي.
كاتب تنعكس صورة أناه في مرآة ذاك الآخر الأديب متعدد الوجوه والأحوال والعوالم والحيل كأنه نابغة زمانه وساحره البارع (....)؛ كأنه السابق الذي لا يُسبق ولا يُشقّ له غبار، كالأشهر من كل شيء بطريقته الخاصة التي لم يستعرها ولا تقبل التقليد من أحد، كالمُتفرّد متفتّح القريحة، وكالأوّل في مجاله بلا ندّ ولا مثيل محتمل، الذي يتنكّب ما أمكنه - من جهة أولى-، فخ الوقوع في ظاهرة الإسهال الأدبي المنتشرة بكثرة رغم أنها لا تمثّل أدنى تهديد ولا خطر على حياة الإبداع الحقيقي، ويطمح -في الجهة المقابلة-، إلى تحبيب منتوجه إلى قارئه الجاد المُفترض وإيقاظ انتباهه وهمته وعنايته به عالياً.
أتصوّر هذا النوع من الحكّائين ومن اعتبر مثلهم وحذا حذوهم، متجلّيًا في صورة من يمتلك بالإضافة إلى كنه الفكرة ولب الموضوع وثراء المعنى وعمق الدلالة التي تتشكل منها النواة المركزية لمضمون عمله برمته، رؤية في التفكير، وشِعريّة في الأسلوب وفي الصياغة والتعبير، وأن يكون في كتابته خفيف ظِلٍّ يتسلل أثره لا شعوريا برشاقة تامة إلى الأفهام كما يحمل الفجر بسلاسة مع بداية كل صبح جديد نسائمه اللطيفة المنعشة إلى الخياشيم لتتنسمها بهدوء ونعومة.. معنى هذا أن يكون، مهما كانت أعماقه غارقة في الهموم والآلام حتى النخاع، ذا روح مرحة، وصاحب دعابة، ومثلٍ، وطُرفة من قولٍ ومن حكمة ونادرةٍ، وحِسٍّ بالضّحك أيضًا وبالفكاهة ولم لا روح السّخرية المُبدعة/ بمعناها الأدبي ودلالاتها النقدية الأصيلة، الجمالية والذهنية العميقة؟.. ومتى خلا إبداع الكاتب من أي واحدة من هذه المثيراتـ التي تُعدّ إحدى مقوّمات الفواكه اللغوية الأساسية، بل والركائز والجواهر التي تنبني عليها كل كتابة نثرية إبداعية حقيقية، تتوسّل في عمليتها الحيويّة، التواصل الإيجابي الفعّال عميق الأثر، بعيد الأمد والمدى، وتتغيا فضلا عن هذا كله الإفادة والبلاغة والمتعة والتأثير والصمود أملاً في البقاء؛ ومتى خلا إبداعه منها، فإنّه لا يُعَوّلُ عليه – يقيناً- أديباً لبيباً متمكّناً من تطويع اللغة والسيطرة على ناصية الحكي وعنانه، كما ينقاد الفرس الجموح للفارس الحاذق الماهر بأحكام الخيل والمتمكن من أسرار ركوبها، لأنّه بفقدانه لتلك الخصائص أو لإحداها، سوف لن يملك فيما كتب إلاَّ أن يترك المجال مفتوحاً أمام لعبة اللغة كي تنفلت بجلدها من بين يديه وتنقل سلطتها الطبيعية إليها ثم تلهو بذاتها كما يحلو لها أنّى رغبت وشاءت، كما لن يملك كذلك سوى أن يترك الشعور بالملل ليدُبّ إلى نفسية قارئه، فنفوره وهروبه منه - من ثمّ- كنتيجة أولى غير سارّة طبعاً.. هذا إن لم يكن لبعض متلقيه رأي مختلف وذوق آخر!
خاتمة:
هكذا بالمواصلة، نستشف في ارتباطنا الدائم ب"الشيكولاته"، بناء على ما سلف - وبلا أدنى إسقاط فج له على المجموعة مثار حديثنا-، أنّ صابر رشدي يحوم حول محيط ودائرة أولئك الحكّائين، إذ هو من عروضه لا يستسهل الكتابة بقدر ما هو ماسك على جمرة إبداعها، لذلك تنطبق عليه كاتبا وعلى نصه منتوجا سرديا/ إبداعيا جُملة من أهم الخصائص المذكورة التي ينبغي أن يتحلى بها أو ببعضها كل كاتب سارد جاد يستحضر ذكاء قارئه ويحترمه فيحاول تقديم الأفضل والأجمل له لعله يرتقي إلى مستوى تطلعاته أو يتجاوز ويخرق سقف أفق انتظاره. ورشدي كاتب أديب جاد يعرف كيف يخاطب قارئه ويحافظ عليه ويحقق تواصلا إيجابيا معه. ولعلّ هذا النوع هو المحمود والمنشود من أنواع التواصل الذي يبقى في الأخير غاية كل عملية سردية حقيقية تأمل تحقيق التاثير والحظوة بالاستحسان، فإثبات الوجود ثم البقاء هدفاً، لا النفور والفناء والعدم.
إلى هنا إذن، نستطيع القول – ختاماً-، بأن الكاتب يتجلى في مستوى معين داخل متتاليته القصصية/ الروائية- إن صح الوسم، حريصاً على الاِستعادة النوستالجيةً لأشواقه الذاتية، ومنح الحكي فتنةً تعبيرية على متن إسباغ حِلية لغوية عليه، تلك التي يُفصح عنها الإخلاص الجمالي المتمثل في تغليف الحكايات بشحنة شعرية ودفقة مجازية مُشبعة، إخلاصاً يتعدى صورية اللفظ إلى استهداف جوهر معنىً تُحرّض على إدراكه، عساها تصل الى مبتغاها بأمان وسلام. لكن على الرغم من ذلك كله، فالكاتب لم يكن مُنساقاً في هذه المجموعة وراء فتنة الحكي أو غواية النزوع النوستالجي فقط كما يمكن أن يتصوّر البعض؛ بل لقد كان الطموح الأدبي الجميل والمتميز الذي ركبه في هذا العمل الممتع والناجح بلا ريب، محكوماً بنزوع استطيقي أكثر قيمة وأهمية وجاذبية، وهو الالتزام الجادّ/ لكن والحادّ – بالكاد- بشروط القصة، ثم بحرفية السرد الفني التي تبرهن على مسعى صابر رشدي بوصفه أديباً مبدعاً يرمي إلى تجويد نصوصه وإنتاجها شيّقةً، ليس بغرض البحث عن استقطاب قرائي يشاركه فيه القارئ كي يمنحه لحظة تفاعلية مفيدة مع نصوصه، ولا ليبث في نفسيته حالاتٍ من الإثارة أو مشاعر من المتعة والتسلية فحسب، وإنّما ليقدّمها نصوصاً تخضع لأدوات النقد الحديث؛ رهانها الأسمى، بل هدفها النهائي- بالأحرى-، هو أن تكون عملا أدبيا صرفاً، يستفز خطاب النقد ويشاكسه ليصمد باستمرار أمام أدواته المتجددة.
عادل آيت أزكاغ
(كاتب وناقد مغربي)
مجلة"أبجديات" اليمنية
عدد نوفمبر 2020


 www.facebook.com
www.facebook.com
«شوكولاتة نيتشه»، للكاتب المصري المبدع صابر رشدي، نصّ سردي- حكائي يتضمن في جوهره مجموعة قصصٍ قصيرة عذبة مرحة وعميقة، تنحو في اتجاهها إلى استثمار عناصر الواقعية السحرية التي تنفصل طبعا عن واقعية ماركيز وخصائص عالمه الروائي الأمريكو- لاتيني، رغم أنها تتقاطع معها على نحو من الأنحاء، ما يحمل إشارة ما تؤكد على حضور شخصية الروائي ونفسه في أسلوب الكتابة القصصية لدى صابر رشدي، على الرغم من الفوارق الجوهرية القائمة بين فن القصة وفن الرواية، إلا أنهما يمكن أن يتحدا في قواسم مشتركة متينة جامعة بينهما مرئية ومدركة أحيانا، غير مدركة ولا مرئية في أحيان أخرى لدى القارئ. كما يحمل ذلك التقاطع نفسه انفصالا عن العالم المذكور، نظرا لكون بعض قصص المجموعة ترد من بيئة ذات خصوصية اجتماعية وثقافية وسمت جزءا من ملامحها أصوات الشخوص الفاعلة المتعددة الرئيسية منها والثانوية، وكذلك المساكن والحارات والفضاءت الشعبية المصرية البسيطة والهامشية منها خاصة، التي انعكست أصداؤها وأجواؤها الروحانية على بعض أحداث ووقائع القصص المتخيلة، لكن المحكوم منها بوجه أخص بأعراف وتقاليد محلية، يتأرجح فيها البعد الأسطوري بين الغرائبي والخرافي ويتداخل مع المكون الديني والطقس الجنائزي إضافة إلى الشعائري والاحتفالي أيضاً.
عن نزرٍ يسير من هذه الخصائص وغيرها، مما سيتمحور حديثنا حوله هنا انطلاقا من المجموعة بدءًا بتقديم إشارات قرائية فيها، وذلك بالتركيز على ملاحظات بعينها تخص محتوى بضع قصصها، وأخرى تتعلق بالتقنيات الموظفة من قِبل الكاتب في إطار السّعي إلى ملامسة أسلوبه في الكتابة والسّرد من خلال هذه القراءة عموماً، وتحديد موقعه كقاص وموقع السّارد منه روائيًّا، ومن خلال الكتابة السردية النموذجية مثلما انطبعت ذوقيًّا في تصوّرٍ متواضعٍ لكاتبِ هذه السطور وحاول التلميح إلى مُميّزاته واستكناه شيء من الأمارات الدالة عليه، في أحد مواطن هذه المقاربة غير المُحيطة بعالم المجموعة كاملة، لكنها تتوخى تسليط قليل من النور على إحدى زواياها كما نأمل في الآتي..
تداخل الواقعي بالمتخيل والحلم بالحقيقة
لعل أول ما سيتبادر إلى ذهن قارئ النصوص منذ الفاتحة الاِستهلالية لقصصها الأولى، هو ما تتميز به من تنويع في السرد جعلها تتسم بتداخل الزمن الماضي فيها بالحاضر، الواقعي بالمتخيل من الأحداث والشخوص، ثم تداخل الحلم بالحقيقة وذوبانه فيها.
وبالعودة إلى التمهيد، يتضّح أنّه قد كان هناك من بين تلك العوامل، المُساقة أعلاه، ما ساعد في ركنه، بالدفع بالقصص إلى الانفتاح على العبثي والمعقول وعلى الجاد والمبتذل في آن واحد، وجعلها تتصف بامتزج المقدس فيها بالمدنس، والأصيل من القيم الموروثة وحتى المُكتسبة، بالزائف من السلوكات الطارئة التي يفضح السارد على متنها ما تنطوي عليه ثقافة نوع محدد من الفئات البشرية من بلاهة وما يغمر تصرفاتها اليومية الفارغة من أي معنى، من قيم سلبية مرفوضة، ربما لغياب وعيها وشعورها بقيمة اللحظات التي تعيشها، أو لوجودها فيها صُدفة وقد ساقتها إليها أقدامها العمياء.
تنتقد القصص على لسان السارد، ضمن ما تنتقده، أو تعرّيه، أنواع بشرية سيئة السّجيّة والطوية والسّلوك؛ حيث يستحضرها الكاتب مُشخّصة بأدوائها، ليبيّن كيف تعمل من دون تبصّر وتقول من غير تفكير، من حيث قيامها في تلك اللحظات - المشار إليها- بتصرفات بليدة تفتقد للحس الإنساني ولا تتلاءمم معها وتتناقض على عكس ما تستوجبه من صواب وتعقل ومن سداد يسقط من حسابها دون أن تدري..!
لهذا السبب وغيره، يمكن للقارئ أن يدرك لماذا تبدو قصص المؤلّف في أجزاء منها محملة بحس السخرية ذي الطابع النقدي (التقويمي في إحدى غاياته ووظائف اشتغاله) الذي يحيل الكتابة إلى آلية دفاع واخزة بدلالة مّا، وكاشفة بالضرورة عن اتجاهات خطابها، المأخوذ في قسط منه، بأبعاد الخير والجمال والصلاح وبالرغبة الخفيّة في التسوية والتعديل والإصلاح للسلوكيات المعيبة.
تنتبه إلى التفاصيل الصغيرة حيناً، وتلتفت المجموعة في بعض نصوصها -دائماً-، إلى الحدث الطارئ كما تحاول التقاط العابر والاستثنائي والمنفلت الذي لا يُلقى له بالبال في أحيان كثيرة، بالإضافة إلى اهتمامها بالمرئي المُلتقط بعين الكاتب، لكنه في الوقت نفسه ذلك اللاّمرئي واللاّمفكر فيه أيضاً من جهة الآخر/ القارئ، الذي نعلم بواقعيته فقط حين نقرأ عنه فنتذكّره في الحين ثم نقول إذاك: "حقا هذه أشياء سمعنا عنها". مثلما نقول عن أخرى: "إنها موجودة فعلا ونعرفها". وكأننا بكاتبها يستدرج قُرّاءه هنا، ليُذكّرهم على طريقته الخاصة التي لا يلج مسالكها أحد غيره، بما عاشوه/ وعاشه الناس، واكتسبوه، ويعيشونه- من تجارب، ويعرفونه من معلومات، لكنهم ينسون أنهم عاشوها وعرفوها، ما يضع – متلقيه- إذا شئنا الدّقة، وهو يذكّرهم بها أو يدعوهم إلى اكتشاف ما في نصّه من جديد يريد إطلاعهم عليه، في مقام الجاهلين المُستكشفين سواء أحبوا ذلك أم كرهوه، ما دام الكتاب، أيًّا كانت هويّته، «مُعلّماً صامتاً»، في نهاية المطاف، كما قال بذلك قديماً الكاتب والطبيب الإغريقي "جالينوس". لكن هم كذلك أيضاً ما دام «التذكر هو المعرفة والجهل هو النسيان بعينه»، على حد تعبير الفيلسوف اليوناني "أفلاطون".
المقتفي لأثر النص من أوّله حيث جاء قول السارد: «كُنتُ أراه في منامي، صبيًّا جميلاً، مغمورًا بالضّياء...»- ص 3-، قد يدلف إلى صلبه ويصل إلى المُتاح من خلفياته وجذور انطلاقه، حيث تتوضّح له منذ البداية أنه بصدد مجموعة قصصية تحكمها الجملة السردية الروائية، وتتوفر على نُتفٍ من عناصر السيرة الذاتية الروائية، المستثمرة فيها إلى حدود ما، خصوصا أنّ اشتغال الذاكرة فيها متألّق في ظل اعتمادها على تقنية الاِسترجاع، رغم أن الأمر يتعلق بمجموعة قصصية أكثر من أي نوع أدبيّ آخر مُحتمل، وهذا في حد ذاته شيء جميل وكاسر للمألوف، مع هامشيته، لأنه يطرح - بشكل من الأشكال- مسألة تداخل الأجناس وتحاورها. واستناداً إلى المُعطى الأوّل ضمن هذا السياق، يأتي التساؤل: هل كان من المفروض فعلاً، أو من الممكن فقط، على الكاتب تسمية عمله "متتالية قصصية" أو "روائية"، بدل "مجموعة قصصية"؟
وفضلا عن ذلك، فإنّ الإمعان في إبداعيّة القصص شكلاً ومضموناً، يؤدي إلى رؤية مفادها أنّ هناك في كتابة المبدع صابر رشدي، رشاقة، وإيحاءً، وغِنىً، وإيجازاً عميقاً، وكثافة لا تخطئها العين، وغيرها من العلامات الدالة على الوعي بتقنيات وأساسيات تدوين القصّة القصيرة، فهي إلى جانب ذلك كتابة تحظى في تنويعاتها الأسلوبية في توصيل المراد من المعاني والدلالات المباشر منها والضّمني أيضاً بنصيب غير قليل من الشعرية، بل من السحرية الواقعية التي تسير على هدي المنوال المشار إليه في بداية الحديث عن اتجاه حكايات مجموعته "شكولاتة نيتشه" التي لا تخلو من السمات الأدبية الأصيلة المميزة لحكاياتها ذات النكهة الغرائبية والعجائبية؛ لاسيما إذا أمعنّا النّظر ولاحظنا استعانة المؤلف بالرائج في التراث والثقافة الشعبيين ويستحق الالتفات، من خرافة مُطعّمة بالموروث الشعبي الذي يمتحُ من عوالمه مواد مُحددة لصفات بعض شخصيات حكاياته وملامح مكوِّنة لهذه الأخيرة ولبنية بعضها وحبكتها، من قبيل: "الزار"، "العرافة"، "الجن والعفاريت"، "انتقام القطط".. وغيرها من الأمثلة كثير ومتعدد.
نوستالجيا الطفولة والاحتفال بالذاكرة
رغم أن القصص تشتمل على مفردات ترتبط بمناخها وبسياقها الشعبيين وثقافتها المحلية، بيد أنّ أغلب قصص شكولاتة نيتشه، ديدن ساردها الإتكاء على الذاكرة التي هي نبعها الذي تتدفق وتندلق منه كنهر سلس جارٍ بلا تعقيدات لفظية، نلمح فيها بساطة في التعبير الذي يكتسب قيمته والمجهود الذي بذله صاحبه حتى صاغه كما ارتأى، في سياقات توظيفه السليم لتلك الألفاظ.
هكذا إذن، يحتفل الكاتب بالذاكرة – بوعي منه أو بدونه- ويتكئ عليها (بموازاة المخيّلة) بوصفها خزّانا للتجارب بكل حمولتها التقنية في التوظيف والاستعمال لكي تؤدي دورها كما يستحثها ويتوسله منها، أن تعمل بجلاء كآلية جبّارة للتذكر أو الاستعادة أو الاستحضار للماضي من خلال العودة عبر الذاكرة إلى الطفولة البعيدة والسياحة الإبداعية/ الذاتية في الأزمنة والأمكنة والمشاعر والوجوه القديمة واستلهام السرد الآني من وحي أطلالها كما ارتسمت في روح مالكها وترسّخت في وجدانه وركنها في خزانة مِخياله حيث يمتح الصور والأحداث ويصوغ المعنى ويلوح بالمغزى المكنون والمُحتمل كيفما شاء.
وعسى الذاكرة بمفهومها المذكور هنا، أن تكون - كما تبدو- حاملة لسمات محضة تتعلق بجنس السيرة الذاتية ومتصلة بالذاكرة ذاتها، التي صيغت في النظرية السردية أداة نشِطة وصلها نقادها بهذا النوع السردي لكي يصير قائم الذات متصلا بشخصية صاحبه المؤلف وبسرد جزء من (أو/ جُلّ) وقائع تجاربه الحقيقية المستعادة على متن الذاكرة بوصفها مستودع المواقف والمشاهد والصور والأحداث وعنصرا قويا ومهيمنا في عملية السرد الذاتي، الذي يحضر هنا، ولو داخل نوع آخر يحمل مسمى "مجموعة قصصية" ما دامت آلية اشتغالها من لدن الكاتب تسير في هذا المنحى السيري/ المحكي الشخصي لأجزاء حياتية معيشة وتاريخية متقطعة ومتباينة، تنطلق من مرحلة الطفولة وذكرياتها المسترجعة، أو العالم الطفولي -بالأحرى-، ببراءته وشغبه ومرحه وحلمه ودهشة اكتشافه وفضوله وتلقائيته وخياله الحر.
إنّه ذلك العالم الذي يحتفي الكاتب بروحه أحيانا على لسان السارد الصبي/ الطفل الذي كانه وأحبه في داخله وصار يتسيعده بنوع من الغبطة ومن التكرار لشيئ من تجاربه السابقة كما تخيلها أو حدثت بالفعل، لكن من جديد كما لو أنه يريد امتلاكها هنا الآن وإلى الأبد.
وهو بهذا يذكرنا بما يطلق عليه الفيلسوف الألماني "نيتشه" مفهوم أو معنى "العود الأبدي"، للشيء الذي كان وأصبح ممكنا ظهوره مرة أخرى في طلعات متعددة بطرق مختلفة، الشيء الذي يذهب ويعود والذي يغيب ويحضر في دورة أبدية تتعاقب وتتجدد وتعيد نفسها مثل الليل والنهار والشمس والقمر والميلاد والموت، كالشيء الأشبه باللحن الموسيقي الذي نعزفه لمكتوب، أو لقدر يكرر ذاته، كالقوّة والضّعف، وكالغنى والفقر، كظاهرتي النجاح والفشل في العمل والزواج –مثلا- وفي غيرهما، بغض النظر عمّن انعكست عليه آثار تجربتهما إلا أنهما موجودان على الدوام كواقع يفرض نفسه ويتوزع كما يتجسّد في حالات شتى.. وما إن يتكرر في هذه، حتى لا يلبث من أن يتغير ليتكرر مرّة أخرى في غيرها، حتى يحس به الإنسان ويفهمه ويحبّه ويتقبّل فكرته ووجوده، ومن ثم- يعترف به ويوافق عليه كما يقول نعم لأمل يكرر ذاته، ولألم يكرر ذاته، لحالة استثنائية وللحظة غريبة معها سبق قولنا لهما نعم، ولذكرى سعيدة قلنا لها كذلك نعم.
هكذا تتكرر الحالات المختلفة، وتتردد كلها في ذاتها، مع الأحداث ومع الخبرات التي عقدنا معها صفقة إستطيقية تربطنا بها فنكررها بدورنا من جديد، مثل قطعة موسيقية مبهجة أو ناعمة أو شجية مؤثرة نحبها فنشدو بها بلا ملل ثم نعيدها ونرددها دائما على أسماعنا ونظل نحبّها إعلانا بسعادتنا بها إلى الأبد، ككل الأشياء الجديدة التي سنمتلكها وتكرر نفسها والقديمة التي عرفناها وكانت في ملكيتنا ومنها التجارب الماضية التي نحبها والتي لا نحبها، لكنها باتت جزءا منا، كالتي عشناها وتصالحنا معها أيضا ثم تقبلناها وأحببناها كما كانت بسعادتها وشقائها، بتفاصيلها المبهجة السعيدة ومآسيها الحزينة.. وتبعاً لهذا الفهم يستمر قياس القارئ العزيز.
هكذا بالتالي، وتبعا لهذا المعنى، يتجدد حضور ذلك الآخر/ الطفل/ الغائب المخبوء داخل كل إنسان/ فرد، ومن خلال الذاكرة يطلع بروحه التي هي بين الغريب والمألوف، و بين القريب والبعيد، تبدو بين- بين، كما كانت في الماضي أو غدت عليه في الحاضر بعدما تدرجت في منحنيات متفاوتة من النضج والوعي والتطور، واتخذت أشكالها هيئات جديدة تحدد منظر هذا الطفل الكبير، وتوضح كنه ذاك الرجل، وماهيته، التي يمكن لها أن تتجلى مرئية لكل الناس في ذات الفنان أو الأديب مثالاً.
وفق هذا النمط -إذاً- يحتفي القاص الأديب صابر رشدي بماضٍ يحنُّ إليه بالعودة التي تحققت في الزمن الراهن، باعتباره طريقا نقله إليه وأصبح يمتلكه فيه، لا يسير في اتجاه المستقبل فحسب، بل واستشرافه أيضًا زمناً يضمن خلود الماضي المحمول والمرتحل فيه على نحو أبدي.
بفضل الكتابة، هكذا يحتفل طوراً آخر مؤلف "شوكولاتة نيتشه" بعالم الطفولة الملازمة له وبحياة وجاذبية صورة ذاك الطفل الذي كانه وظل يستمتع بجماله ويحمله إلى الآن في وجدانه كاتباً ويحمله مبدعاً فوق كتفيه، كما يحتفل مجدّداً إلى جانبه، بنفسه الساردة، بهويته الروائية التي ما انفكت تختفي وتظهر، معجونة الطينة بهوية القاص، فتتجانس معها ثم تُفرغان معاً في قالب واحد. ولعل هذه واحدة من بين الحالات الاستثنائية النادرة التي قلّما نصادفها في الكتابة الإبداعية. حالة مهمة تشي بقدرة خلاّقة، وتنبئ بمهارة فنيّة في اللعبة السردية العاكسة لصورة السارد ونوعيته في مرآة القارئ، هي نفسها مهارة الكاتب التي كشفت عنها موهبتان يمتلكهما، لملم بينهما وضمّهما في نصّه حيث كشف عنهما بدوره من زاويته وألّف بين قلبيهما: موهبة الروائي وموهبة القاص.
الرؤية السردية والأسلوب وبعض آليات اشتغال النص
نجد أسلوب المجموعة أنه يغترف من تنويعات أخرى تتعلق أساسا بتوظيف السرد المختلف الذي ساهم في منح قصص المؤلف أوصاف عامة تشترك مع الخصائص نفسها التي قد نجدها في الرواية أو في السيرة الذاتية وغيرها من الأنواع السردية المتبانية في قواعد تدوينها والمختلفة في شروط تسميتها وتجنيسها النوعي؛ هذا من جهة.أما من جهة ثانية؛ وسعيا إلى توضيح ما تم الإيحاء إليه ووسمه بالتنويع السردي المميز للكتابة استكمالا لذكر بعض تجلياتها هنا من حيث الأسلوب، فجدير بالتأكيد على أن السارد يتجلى، أحيانا، مشاركا في الأحداث، كراصد أنثروبولوجي- ثقافي، كمن يكتب سيرته الذاتية في إطارها العام الأقرب إلى صنف المحكي الذاتي، وليس بمفهومها الدقيق والصارم، وأحيانا أخرى يبدو كمن يختفي خلف شخصياته، يراقبها تارة ويدفع بها إلى الفعل من خلال تحريكها كما يشاء بحرية تامة تارة أخرى؛ ما يعني تبنيه في السرد لرؤيتين معاً، واحدة من "الخلف" لأنه يظهر كالعارف والعليم بكل شيء متصل بشخصياته وعالمه برمته. أما الثانية فهي "مصاحبة".. وأحيانا أخرى، يتبنى "رؤية من الخارج"، تضاف إلى الاثنتين، ما يفسر بوضوح إعماله لجميع الرؤى الثلاث المقترحة نظريا والحاضرة عمليا في السرد الأدبي/ الحكائي. تطفو المصاحبة على سطح السرد عندما يظهر السارد لا أقل معرفة من الشخصيات ومسلك مضي أحداث حكاية ما، ولا أكثر معرفة منها في الوقت نفسه، وهكذا يبدوان متساويين في علمهما. في حين تتمظهر الرؤية من الخارج حينما يصور لنا السارد عينة من شخصيات المجموعة/ أو المتتالية القصصية، أكثر معرفة منه فيما هو أقل معرفة منها فيما ستؤول إليه مصائر أفعال شخصيات أخرى وما قامت به من أحداث نهايتها مفتوحة غير معروفة.. الشيء الذي يدعو إلى التفسير والفهم ويفتح باب التأويل على مستوى التلقي على مصراعيه عسى القارئ يتدخل أو يتفاعل أو يشارك في تأمل باقي الحكاية الناقص إذا أراد فعلا القبض على خيوط المعنى المنلفت والمغزى المُبطّن الخافي فيها أو الذي يسقطه السارد بمحض إرادته أو بدونها، بوعيه أو لاوعيه كذلك.
وبالإضافة إلى ما تقدم، هناك بالمقابل في هذه القصص/ الحكايات، استثمار لتقنية تيار الوعي في الكتابة، وللفلاش باك، وكذلك لأسلوب التداعي الحر بالمعنى الذي حددته صياغة العالم النفسي النمساوي "سيغموند فرويد" له كأداة تحليلية في سياق نظريته "اللاشعورية" التي أراد بوصلة الأدب أن تتوجه إلى منطقتها في النفس البشرية لاستكشاف شيء من غموضها وإضاءته؛ لاسيما إذا أخذنا في الحسبان أن السارد يستقرئ مكنونات الشخصيات وأعماقها من الناحية النفسية وما يجوس بداخلها ويجول في شق من باطنها ولاوعيها من أفكار وأحاسيس وصور قائمة بذاتها واقعيا/ تخييليا، ويترك لها العنان لتنساب وتتدفق بحرية وطلاقة. ما يؤدي بعمليات التفكير داخل النص وفي خارجه أيضاً، إلى أن تتحول وتتنوع وتتعدد، وتنتقل من عملية خاصة بالشخصية الواحدة إلى وجهة نظر فردية يتبناها السارد أو يقترحها فنيا على غيره/ القارئ، لتأخذ وجهات نظر مختلفة يتقاسمها قراء نصوصه جميعا فيما بينهم وبطرق شتى ومتفاوتة حسب تعدد مستويات القراءة واختلاف زوايا آفاق التلقي ومراتب الفهم والتأويل.
من البدهي والطبيعي القول إن الراوي/ السارد، في اللعبة الحكائية قد يكون هو الكاتب نفسه، وقد لا يكون هو حين يغدو مستقل الذات عنه. إلاّ أنّ الكاتب يتقمّص بحال من الأحوال ذات السارد وهو يحكي بضميره، كما يفعل مع باقي شخوصه، أو هكذا يجب عليه أن يفعل وهو ينشئ عالمه الواقعي أو المُتخيّل. أمّا السارد في المجموعة عنوان اشتغالنا، فيتجلى في أكثر حالاته عنصرا منتميا إلى هذا العالم في (الشكولاتة)، مشاركا فيه بحضور شبه كامل، وممارسا للحكي من الداخل (داخل عوالم القصص) وأقل قليلا من الخارج. ونتيجة لذلك، تعتبر الرؤية الخلفية هي الطاغية والمهيمنة مقارنة بالأخريين؛ بالنظر إلى كون الأحداث تأتي من الماضي السحيق الذي تستدعيه الذاكرة الطفولية البعيدة التي لا تخلو هي الأخرى من خصائص خاصة تميزها في نصوص المجموعة.
الكتابة استجابة لنداء خفيّ
عندي، وِفق تصوّر غير مشترك - بالضرورة -، أنّ الكاتب الناثر السارد الجيّد خاصة في مجالات القصّة والرواية وكتابات الرحلات واليوميات والمذكرات والسيرة الذاتية والأنواع الأخرى المجاورة والمشابهة لها، هو ذاك الذي تتهيّأ لي صورته في من يضع نصب عينيه وهو يكتب كما لو أنه يعيش آخر نزالاته وزفراته مع اللغة في حلبة المعاني والكلمات. لكن المقصود هنا بالإشارة أكثر على وجه التحديد والدقة ذلك الكاتب الماسك بالأخصّ على جمرة الكتابة الموضوعة على راحة كفه بالروح وبالدّم كأنها قدَره الذي لا مفر منه ويلح عليه إدراكه والوعي به والاستجابة السليمة لندائه الخفي.
كاتب تنعكس صورة أناه في مرآة ذاك الآخر الأديب متعدد الوجوه والأحوال والعوالم والحيل كأنه نابغة زمانه وساحره البارع (....)؛ كأنه السابق الذي لا يُسبق ولا يُشقّ له غبار، كالأشهر من كل شيء بطريقته الخاصة التي لم يستعرها ولا تقبل التقليد من أحد، كالمُتفرّد متفتّح القريحة، وكالأوّل في مجاله بلا ندّ ولا مثيل محتمل، الذي يتنكّب ما أمكنه - من جهة أولى-، فخ الوقوع في ظاهرة الإسهال الأدبي المنتشرة بكثرة رغم أنها لا تمثّل أدنى تهديد ولا خطر على حياة الإبداع الحقيقي، ويطمح -في الجهة المقابلة-، إلى تحبيب منتوجه إلى قارئه الجاد المُفترض وإيقاظ انتباهه وهمته وعنايته به عالياً.
أتصوّر هذا النوع من الحكّائين ومن اعتبر مثلهم وحذا حذوهم، متجلّيًا في صورة من يمتلك بالإضافة إلى كنه الفكرة ولب الموضوع وثراء المعنى وعمق الدلالة التي تتشكل منها النواة المركزية لمضمون عمله برمته، رؤية في التفكير، وشِعريّة في الأسلوب وفي الصياغة والتعبير، وأن يكون في كتابته خفيف ظِلٍّ يتسلل أثره لا شعوريا برشاقة تامة إلى الأفهام كما يحمل الفجر بسلاسة مع بداية كل صبح جديد نسائمه اللطيفة المنعشة إلى الخياشيم لتتنسمها بهدوء ونعومة.. معنى هذا أن يكون، مهما كانت أعماقه غارقة في الهموم والآلام حتى النخاع، ذا روح مرحة، وصاحب دعابة، ومثلٍ، وطُرفة من قولٍ ومن حكمة ونادرةٍ، وحِسٍّ بالضّحك أيضًا وبالفكاهة ولم لا روح السّخرية المُبدعة/ بمعناها الأدبي ودلالاتها النقدية الأصيلة، الجمالية والذهنية العميقة؟.. ومتى خلا إبداع الكاتب من أي واحدة من هذه المثيراتـ التي تُعدّ إحدى مقوّمات الفواكه اللغوية الأساسية، بل والركائز والجواهر التي تنبني عليها كل كتابة نثرية إبداعية حقيقية، تتوسّل في عمليتها الحيويّة، التواصل الإيجابي الفعّال عميق الأثر، بعيد الأمد والمدى، وتتغيا فضلا عن هذا كله الإفادة والبلاغة والمتعة والتأثير والصمود أملاً في البقاء؛ ومتى خلا إبداعه منها، فإنّه لا يُعَوّلُ عليه – يقيناً- أديباً لبيباً متمكّناً من تطويع اللغة والسيطرة على ناصية الحكي وعنانه، كما ينقاد الفرس الجموح للفارس الحاذق الماهر بأحكام الخيل والمتمكن من أسرار ركوبها، لأنّه بفقدانه لتلك الخصائص أو لإحداها، سوف لن يملك فيما كتب إلاَّ أن يترك المجال مفتوحاً أمام لعبة اللغة كي تنفلت بجلدها من بين يديه وتنقل سلطتها الطبيعية إليها ثم تلهو بذاتها كما يحلو لها أنّى رغبت وشاءت، كما لن يملك كذلك سوى أن يترك الشعور بالملل ليدُبّ إلى نفسية قارئه، فنفوره وهروبه منه - من ثمّ- كنتيجة أولى غير سارّة طبعاً.. هذا إن لم يكن لبعض متلقيه رأي مختلف وذوق آخر!
خاتمة:
هكذا بالمواصلة، نستشف في ارتباطنا الدائم ب"الشيكولاته"، بناء على ما سلف - وبلا أدنى إسقاط فج له على المجموعة مثار حديثنا-، أنّ صابر رشدي يحوم حول محيط ودائرة أولئك الحكّائين، إذ هو من عروضه لا يستسهل الكتابة بقدر ما هو ماسك على جمرة إبداعها، لذلك تنطبق عليه كاتبا وعلى نصه منتوجا سرديا/ إبداعيا جُملة من أهم الخصائص المذكورة التي ينبغي أن يتحلى بها أو ببعضها كل كاتب سارد جاد يستحضر ذكاء قارئه ويحترمه فيحاول تقديم الأفضل والأجمل له لعله يرتقي إلى مستوى تطلعاته أو يتجاوز ويخرق سقف أفق انتظاره. ورشدي كاتب أديب جاد يعرف كيف يخاطب قارئه ويحافظ عليه ويحقق تواصلا إيجابيا معه. ولعلّ هذا النوع هو المحمود والمنشود من أنواع التواصل الذي يبقى في الأخير غاية كل عملية سردية حقيقية تأمل تحقيق التاثير والحظوة بالاستحسان، فإثبات الوجود ثم البقاء هدفاً، لا النفور والفناء والعدم.
إلى هنا إذن، نستطيع القول – ختاماً-، بأن الكاتب يتجلى في مستوى معين داخل متتاليته القصصية/ الروائية- إن صح الوسم، حريصاً على الاِستعادة النوستالجيةً لأشواقه الذاتية، ومنح الحكي فتنةً تعبيرية على متن إسباغ حِلية لغوية عليه، تلك التي يُفصح عنها الإخلاص الجمالي المتمثل في تغليف الحكايات بشحنة شعرية ودفقة مجازية مُشبعة، إخلاصاً يتعدى صورية اللفظ إلى استهداف جوهر معنىً تُحرّض على إدراكه، عساها تصل الى مبتغاها بأمان وسلام. لكن على الرغم من ذلك كله، فالكاتب لم يكن مُنساقاً في هذه المجموعة وراء فتنة الحكي أو غواية النزوع النوستالجي فقط كما يمكن أن يتصوّر البعض؛ بل لقد كان الطموح الأدبي الجميل والمتميز الذي ركبه في هذا العمل الممتع والناجح بلا ريب، محكوماً بنزوع استطيقي أكثر قيمة وأهمية وجاذبية، وهو الالتزام الجادّ/ لكن والحادّ – بالكاد- بشروط القصة، ثم بحرفية السرد الفني التي تبرهن على مسعى صابر رشدي بوصفه أديباً مبدعاً يرمي إلى تجويد نصوصه وإنتاجها شيّقةً، ليس بغرض البحث عن استقطاب قرائي يشاركه فيه القارئ كي يمنحه لحظة تفاعلية مفيدة مع نصوصه، ولا ليبث في نفسيته حالاتٍ من الإثارة أو مشاعر من المتعة والتسلية فحسب، وإنّما ليقدّمها نصوصاً تخضع لأدوات النقد الحديث؛ رهانها الأسمى، بل هدفها النهائي- بالأحرى-، هو أن تكون عملا أدبيا صرفاً، يستفز خطاب النقد ويشاكسه ليصمد باستمرار أمام أدواته المتجددة.
عادل آيت أزكاغ
(كاتب وناقد مغربي)
مجلة"أبجديات" اليمنية
عدد نوفمبر 2020


صابر رشدي
صابر رشدي is on Facebook. Join Facebook to connect with صابر رشدي and others you may know. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected.
 www.facebook.com
www.facebook.com