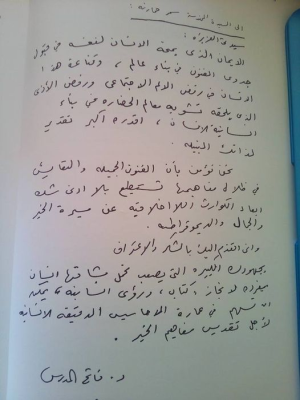أخبرتني الأستاذة سميحة خريس، منذ مدة، بأنها تعد لنشر ملفا خاص عن « الكرسي»، في الملحق الثقافي لـ «الرأي»، ودعتني للمشاركة في هذا الملف، بمقال، من دون أن تشير إلى محاور محددة للكتابة أو تحدد المغزى الذي تحاول الوصول إليه من خلال تناول هذا الموضوع. ولذلك تداعت إلى ذهني على الفور صورة الاختبارات النفسية الإسقاطية؛ ومنها، على سبيل المثال، اختبار « بقع الحبر»؛ حيث يقدم الأخصائي النفسي للشخص الذي يريد أن يفحصه ورقة طبعت عليها صور سوداء لما يبدو أنه بقع حبر منفلشة، ثم يطلب منه أن يتحدث عما يراه في هذه الصور. ومنها، أيضا، الاختبار المبني على كلمات معينة يذكرها الأخصائي أمام المفحوص ويطلب منه أن يعلق عليها بما يخطر في باله.. الخ. وعندما يستجيب الشخص المفحوص لطلب الفاحص فإنه في الواقع يستسلم لنوع من التداعي الحر الذي يجد لاوعيه عن طريقه متنفسا ملائما؛ الأمر الذي يساعد الأخصائي النفسي على دراسة حالة هذا الشخص بصورة معمقة. وحتى لو حاول المفحوص أن يضع قيودا على تدفق المعلومات من داخله وأن يتحكم بآلية التداعي الحر ويوجه عملها في الاتجاه الذي يريد، فإنه لن يخدع الفاحص، بل إن هذا الأخير سيجد من خلال النظر في أساليب تدخل المفحوص « الواعية» وفي التفافاته وخدعه وحيله، مادة إضافية تساعده في إلقاء المزيد من الأضواء الكاشفة على الأبعاد العميقة لشخصية المفحوص.
هذا ما خطر في بالي عندما تلقيت دعوة الأستاذة سميحة خريس للمشاركة في ملف الملحق الثقافي لـ" الرأي" عن « الكرسي»، ثم رحت أتساءل، بيني وبين نفسي: لماذا « الكرسي» بالذات؟! وأي نوع من الكراسي هو هذا الذي قصدته الأستاذة سميحة؟! ومع أنني خمنت عن خطأ أو عن صواب أنها قصدت نوعا محددا من الكراسي، إلا أنني امتنعت عامدا متعمدا عن البوح لها بذلك. والسبب هو أنني، كما قلت، تذكرت موضوع « الاختبارات النفسية الإسقاطية»، فاستهواني أن أخضع نفسي علنا لواحد منها عفوي؛ خصوصا وأن دراستي الجامعية كانت أصلا في مجال علم النفس. ومن هذه الزاوية بالذات فأنا أفترض أن هذا الملف يجب أن يكون فرصة ثمينة للدارسين والمختصين النفسيين بشكل خاص أنصار « مدرسة التحليل النفسي» لدراسة نماذج عديدة (ودفعة واحدة) من أنماط شخصية المثقفين والأدباء المحليين والتعرف على ملامحها وسماتها واختلالاتها. وما على هؤلاء المختصين إذا تمكنوا من الاستفادة من هذه المادة البحثية الدسمة إلا أن يشكروا الأستاذة سميحة التي جلبتنا جميعا للجلوس على كرسي الاختبار هذا.
أما الآن، وقد جلست على الكرسي، فسأبدأ فورا بالاستسلام لمنطق التداعي الحر:
لقد أعاد هذا الملف إلى ذاكرتي بعض المفارقات الكتابية التي حدثت لي سابقا، أكثر من مرة، مع موضوع «الكرسي». فذات مرة، قررت أن أواظب على الكتابة كل يوم في وقت محدد، وأن يكون الموضوع الذي أكتبه، في كل مرة، هو أول موضوع يخطر في بالي. وقد توصلت إلى ذلك القرار في سياق محاولة مني لاستنهاض همتي الكتابية بعدما ألم بها سبات طويل. قلت لنفسي بأنني يجب أن أتعامل مع الكتابة كحرفة، وأنني يجب أن أتصرف مثل أي حرفي آخر ينهض في الصباح ثم يشرع في وقت محدد بالاضطلاع بمهام حرفته. ولكي أثبت التزامي بما قلت وأؤكد جدية قراري، قررت أن أشرع بالتنفيذ فورا. كنت في تلك اللحظة أجلس على كرسيي أمام طاولة المكتب في العمل، ولذلك فقد كان أول شيء خطر في بالي هو «الكرسي». فإذا بي أكتب عن كرسي دوار.. يدور ويدور ويتحول إلى خازوق يخترق الجالس عليه، ويثبته فيه، وهو ذاهل عن نفسه، أو ربما وهو متواطئ عليها. وكان ما كتبته، ذاك، هو إحدى قصص كتابي «بعد خراب الحافلة» الذي صدر عام 2002. وفي مرة أخرى كتبت لإحدى الصحف المحلية نصا حاولت فيه أن أنساق بقدر استطاعتي مع منطق لاوعيي. ولشد ما كانت دهشتي في النهاية وأنا أنظر للحصيلة التي خرجت بها من الصور والتراكيب اللغوية والأفكار. كان عنوان النص، إذا لم تخن الذاكرة «غيمة في صدفة محكمة الإغلاق»، وأذكر أنني في سياقه تحدثت عن مقعدين أمام البحر! ولم أتوقف طويلا عند هذه الصورة في البداية، بيد أني حين عدت إلى قراءة الموضوع فيما بعد أدهشني الأمر كثيرا ورحت أتساءل: لماذا مقعدان أمام البحر؟! أنا أصلا لا أحب أن أجلس على مقعد أمام البحر، ولا أحب المقاعد بوجه عام، كما أنني لا أشعر بالراحة الحقيقية أثناء الجلوس عليها. ربما لأنني قروي، وتعودت ، عندما أريد أن أرتاح، أن أتمدد على فرشة على المصطبة أمام الدار؛ وربما لأنني تعودت أن أرى أناسا ينصبون المقاعد البلاستيكية على رمال الشواطئ العربية مثل الفخاخ ثم يختفون، فإذا ما جاء أحد وجلس على أحدها ظهروا له فجأة وطالبوه بدفع الثمن، أو أجبروه على ترك الكرسي الذي يجلس عليه والجلوس على الأرض، إن شاء، أو التمشي على رمال الشاطئ ما شاء. ولكن ما شأني أنا بهذا كله؟ فأنا، كما قلت، لا أحب الكراسي، وخصوصا إذا كانت منصوبة على الشاطئ.. الشاطئ المفتوح كنافذة واسعة على مشهد بعيد، مشهد غامض وفاتن. بيد أن أكثر ما يثير دهشتي دائما هو علاقة المثقفين بالكراسي. ليس كلهم بالطبع وإنما كثيرين منهم ممن يتهالكون بحماسة للجلوس على أول كرسي يصادفونه، مهما كانت سويته، وسواء أكان منصوبا على الشاطئ أم في أي مكان آخر، وسواء أكان من الخشب أم من البلاستيك (أنا في الأصل لا أتخيل الكرسي إلا من الخشب)، وسواء أكانت قوائمه ثابتة أم متداعية، وسواء أكان يتسع لهم أم أنهم سيضطرون لحشر أجسادهم فيه حشرا. وعندما يأتي الشخص الذي نصب لهم الكرسي ليقبض الثمن فإنهم لا يناقشونه ولا يعترضون، بل يدفعون له ما يطلبه منهم ممتنين شاكرين بينما هم يواصلون الجلوس على مقعدهم العزيز ذاك، بل إنبعضهم يكون قد دفع سلفا قبل أن يجلس وقبل أن يطلب منه أحد شيئا، كما أنه يواصل الدفع بعد ذلك أيضا بلا نهاية. يبدو لي أن سبب ذلك هو أنهم متعبون جدا ولا يستطيعون أن يفوتوا أول فرصة سانحة للجلوس. على أن أكثر المشاهد بؤسا في نظري هو عندما يكون عدد الكراسي المتوفر أقل من عدد الأشخاص الراغبين بالجلوس؛ إذ يأخذ هؤلاء عندها بالتدافع بشكل بهيمي، إلى أن يتمكن أحدهم في النهاية من الفوز بالكرسي المنشود، فيكوم نفسه عليه وهو ينظر حوله غير مصدق أنه هو من فاز في النهاية رغم كثرة المنافسين وشدة التنافس. ولشد ما تثير دهشتي وارتباكي التحولات التي تطرأ على الناس بعد جلوسهم على الكرسي، إلى حد أنني لا أعود قادرا على التعرف عليهم بعد ذلك.
ولكن، أعود لأتساءل مرة أخرى: ما شأني أنا المشاء القديم بكل ذلك؟ فأنا أحتاج إلى طرق جديدة دائما لكي أسير عليها وليس إلى مقاعد، وأحتاج إلى رفقاء درب أواظب على السير معهم، وعابرين أمر من بينهم، وليس إلى أشخاص بملامح بهيمية أتدافع معهم للفوز بمقعد (أو بكرسي، كما ترغب أن تسميه الأستاذة سميحة). والغريب أنني لا أمل من الطرق التي أطرقها مرارا وتكرارا، وفي الوقت نفسه فإنني أتحمس مثل طفل إذا ما عثرت فجأة على طريق جديد، ولا أتوقف عن السير فيه حتى أبلغ نهايته، ثم أتابع المشي في جميع تفرعاته حتى نهاياتها، محاولا تمهيده بخطواتي واستكشاف معالمه وأبعاده. ولكم هي مدهشة أحيانا الأماكن التي تقودني إليها بعض الطرق، وما أكثر ما بنيت من صداقات عميقة في نهاياتها. ولذلك فإنني حين أزور مدينة جديدة لا أرتاح ولا أنام، بل أظل أمشي وأنا أواصل النظر إلى الأماكن والأشخاص باندهاش. وقد لا يصدق أحد إذا ما حدثته عن حجم ونوع ما كنت أتمكن من رؤيته أو معرفته خلال زيارتي لمدينة ما ولو حتى لليلة واحدة فقط. بيد أنه حتى لو تكررت زياراتي لتلك المدينة نفسها مرارا، بعد ذلك، فإنني بدون شك سأعود للسير في الشوارع التي سبق وأن سرت فيها لأكتشف فيها دائما مشاهد جديدة، وفي الوقت نفسه سأبحث دائما عن شوارع جديدة لم تطأها قدماي من قبل. ولذلك فإنني في العادة لا أستفيد من ميزات الرفاهية التي توفرها الفنادق لزبائنها المقيمين، مهما كانت مغرية؛ لأنني في الواقع لا أستطيع أن أكون مقيما، وكل ما أحتاجه من الفندق هو القليل من الوقت لأضطجع أواخر الليل فأريح جسدي قليلا ثم أواصل المشي ما أن تدب الحياة في الصباح، وأحيانا أخرج باكرا لأرى على أي نحو تدب الحياة في هذه المدينة أو تلك.
ذاكرتي مليئة بالطرق التي سرت فيها، أو التي مهدتها، وكذلك فمخيلتي مليئة أيضا بالطرق التي أحلم بها وأتخيل كم هي جميلة ومدهشة وأنها بالتأكيد موجودة في هذا العالم وما علي إلا أن أسعى للوصول إليها. ولذلك فإنني في الواقع لا أحتاج إلى كرسي؛ فالكرسي غير مريح على الإطلاق في مثل حالتي كما أنه لا يشبع حاجتي للبحث والاكتشاف. كل ما أحتاج إليه بعد جولة طويلة هو فراش مريح أضع فوقه جسدي لبعض الوقت ثم أواصل المشي.
* قاص أردني
هذا ما خطر في بالي عندما تلقيت دعوة الأستاذة سميحة خريس للمشاركة في ملف الملحق الثقافي لـ" الرأي" عن « الكرسي»، ثم رحت أتساءل، بيني وبين نفسي: لماذا « الكرسي» بالذات؟! وأي نوع من الكراسي هو هذا الذي قصدته الأستاذة سميحة؟! ومع أنني خمنت عن خطأ أو عن صواب أنها قصدت نوعا محددا من الكراسي، إلا أنني امتنعت عامدا متعمدا عن البوح لها بذلك. والسبب هو أنني، كما قلت، تذكرت موضوع « الاختبارات النفسية الإسقاطية»، فاستهواني أن أخضع نفسي علنا لواحد منها عفوي؛ خصوصا وأن دراستي الجامعية كانت أصلا في مجال علم النفس. ومن هذه الزاوية بالذات فأنا أفترض أن هذا الملف يجب أن يكون فرصة ثمينة للدارسين والمختصين النفسيين بشكل خاص أنصار « مدرسة التحليل النفسي» لدراسة نماذج عديدة (ودفعة واحدة) من أنماط شخصية المثقفين والأدباء المحليين والتعرف على ملامحها وسماتها واختلالاتها. وما على هؤلاء المختصين إذا تمكنوا من الاستفادة من هذه المادة البحثية الدسمة إلا أن يشكروا الأستاذة سميحة التي جلبتنا جميعا للجلوس على كرسي الاختبار هذا.
أما الآن، وقد جلست على الكرسي، فسأبدأ فورا بالاستسلام لمنطق التداعي الحر:
لقد أعاد هذا الملف إلى ذاكرتي بعض المفارقات الكتابية التي حدثت لي سابقا، أكثر من مرة، مع موضوع «الكرسي». فذات مرة، قررت أن أواظب على الكتابة كل يوم في وقت محدد، وأن يكون الموضوع الذي أكتبه، في كل مرة، هو أول موضوع يخطر في بالي. وقد توصلت إلى ذلك القرار في سياق محاولة مني لاستنهاض همتي الكتابية بعدما ألم بها سبات طويل. قلت لنفسي بأنني يجب أن أتعامل مع الكتابة كحرفة، وأنني يجب أن أتصرف مثل أي حرفي آخر ينهض في الصباح ثم يشرع في وقت محدد بالاضطلاع بمهام حرفته. ولكي أثبت التزامي بما قلت وأؤكد جدية قراري، قررت أن أشرع بالتنفيذ فورا. كنت في تلك اللحظة أجلس على كرسيي أمام طاولة المكتب في العمل، ولذلك فقد كان أول شيء خطر في بالي هو «الكرسي». فإذا بي أكتب عن كرسي دوار.. يدور ويدور ويتحول إلى خازوق يخترق الجالس عليه، ويثبته فيه، وهو ذاهل عن نفسه، أو ربما وهو متواطئ عليها. وكان ما كتبته، ذاك، هو إحدى قصص كتابي «بعد خراب الحافلة» الذي صدر عام 2002. وفي مرة أخرى كتبت لإحدى الصحف المحلية نصا حاولت فيه أن أنساق بقدر استطاعتي مع منطق لاوعيي. ولشد ما كانت دهشتي في النهاية وأنا أنظر للحصيلة التي خرجت بها من الصور والتراكيب اللغوية والأفكار. كان عنوان النص، إذا لم تخن الذاكرة «غيمة في صدفة محكمة الإغلاق»، وأذكر أنني في سياقه تحدثت عن مقعدين أمام البحر! ولم أتوقف طويلا عند هذه الصورة في البداية، بيد أني حين عدت إلى قراءة الموضوع فيما بعد أدهشني الأمر كثيرا ورحت أتساءل: لماذا مقعدان أمام البحر؟! أنا أصلا لا أحب أن أجلس على مقعد أمام البحر، ولا أحب المقاعد بوجه عام، كما أنني لا أشعر بالراحة الحقيقية أثناء الجلوس عليها. ربما لأنني قروي، وتعودت ، عندما أريد أن أرتاح، أن أتمدد على فرشة على المصطبة أمام الدار؛ وربما لأنني تعودت أن أرى أناسا ينصبون المقاعد البلاستيكية على رمال الشواطئ العربية مثل الفخاخ ثم يختفون، فإذا ما جاء أحد وجلس على أحدها ظهروا له فجأة وطالبوه بدفع الثمن، أو أجبروه على ترك الكرسي الذي يجلس عليه والجلوس على الأرض، إن شاء، أو التمشي على رمال الشاطئ ما شاء. ولكن ما شأني أنا بهذا كله؟ فأنا، كما قلت، لا أحب الكراسي، وخصوصا إذا كانت منصوبة على الشاطئ.. الشاطئ المفتوح كنافذة واسعة على مشهد بعيد، مشهد غامض وفاتن. بيد أن أكثر ما يثير دهشتي دائما هو علاقة المثقفين بالكراسي. ليس كلهم بالطبع وإنما كثيرين منهم ممن يتهالكون بحماسة للجلوس على أول كرسي يصادفونه، مهما كانت سويته، وسواء أكان منصوبا على الشاطئ أم في أي مكان آخر، وسواء أكان من الخشب أم من البلاستيك (أنا في الأصل لا أتخيل الكرسي إلا من الخشب)، وسواء أكانت قوائمه ثابتة أم متداعية، وسواء أكان يتسع لهم أم أنهم سيضطرون لحشر أجسادهم فيه حشرا. وعندما يأتي الشخص الذي نصب لهم الكرسي ليقبض الثمن فإنهم لا يناقشونه ولا يعترضون، بل يدفعون له ما يطلبه منهم ممتنين شاكرين بينما هم يواصلون الجلوس على مقعدهم العزيز ذاك، بل إنبعضهم يكون قد دفع سلفا قبل أن يجلس وقبل أن يطلب منه أحد شيئا، كما أنه يواصل الدفع بعد ذلك أيضا بلا نهاية. يبدو لي أن سبب ذلك هو أنهم متعبون جدا ولا يستطيعون أن يفوتوا أول فرصة سانحة للجلوس. على أن أكثر المشاهد بؤسا في نظري هو عندما يكون عدد الكراسي المتوفر أقل من عدد الأشخاص الراغبين بالجلوس؛ إذ يأخذ هؤلاء عندها بالتدافع بشكل بهيمي، إلى أن يتمكن أحدهم في النهاية من الفوز بالكرسي المنشود، فيكوم نفسه عليه وهو ينظر حوله غير مصدق أنه هو من فاز في النهاية رغم كثرة المنافسين وشدة التنافس. ولشد ما تثير دهشتي وارتباكي التحولات التي تطرأ على الناس بعد جلوسهم على الكرسي، إلى حد أنني لا أعود قادرا على التعرف عليهم بعد ذلك.
ولكن، أعود لأتساءل مرة أخرى: ما شأني أنا المشاء القديم بكل ذلك؟ فأنا أحتاج إلى طرق جديدة دائما لكي أسير عليها وليس إلى مقاعد، وأحتاج إلى رفقاء درب أواظب على السير معهم، وعابرين أمر من بينهم، وليس إلى أشخاص بملامح بهيمية أتدافع معهم للفوز بمقعد (أو بكرسي، كما ترغب أن تسميه الأستاذة سميحة). والغريب أنني لا أمل من الطرق التي أطرقها مرارا وتكرارا، وفي الوقت نفسه فإنني أتحمس مثل طفل إذا ما عثرت فجأة على طريق جديد، ولا أتوقف عن السير فيه حتى أبلغ نهايته، ثم أتابع المشي في جميع تفرعاته حتى نهاياتها، محاولا تمهيده بخطواتي واستكشاف معالمه وأبعاده. ولكم هي مدهشة أحيانا الأماكن التي تقودني إليها بعض الطرق، وما أكثر ما بنيت من صداقات عميقة في نهاياتها. ولذلك فإنني حين أزور مدينة جديدة لا أرتاح ولا أنام، بل أظل أمشي وأنا أواصل النظر إلى الأماكن والأشخاص باندهاش. وقد لا يصدق أحد إذا ما حدثته عن حجم ونوع ما كنت أتمكن من رؤيته أو معرفته خلال زيارتي لمدينة ما ولو حتى لليلة واحدة فقط. بيد أنه حتى لو تكررت زياراتي لتلك المدينة نفسها مرارا، بعد ذلك، فإنني بدون شك سأعود للسير في الشوارع التي سبق وأن سرت فيها لأكتشف فيها دائما مشاهد جديدة، وفي الوقت نفسه سأبحث دائما عن شوارع جديدة لم تطأها قدماي من قبل. ولذلك فإنني في العادة لا أستفيد من ميزات الرفاهية التي توفرها الفنادق لزبائنها المقيمين، مهما كانت مغرية؛ لأنني في الواقع لا أستطيع أن أكون مقيما، وكل ما أحتاجه من الفندق هو القليل من الوقت لأضطجع أواخر الليل فأريح جسدي قليلا ثم أواصل المشي ما أن تدب الحياة في الصباح، وأحيانا أخرج باكرا لأرى على أي نحو تدب الحياة في هذه المدينة أو تلك.
ذاكرتي مليئة بالطرق التي سرت فيها، أو التي مهدتها، وكذلك فمخيلتي مليئة أيضا بالطرق التي أحلم بها وأتخيل كم هي جميلة ومدهشة وأنها بالتأكيد موجودة في هذا العالم وما علي إلا أن أسعى للوصول إليها. ولذلك فإنني في الواقع لا أحتاج إلى كرسي؛ فالكرسي غير مريح على الإطلاق في مثل حالتي كما أنه لا يشبع حاجتي للبحث والاكتشاف. كل ما أحتاج إليه بعد جولة طويلة هو فراش مريح أضع فوقه جسدي لبعض الوقت ثم أواصل المشي.
* قاص أردني