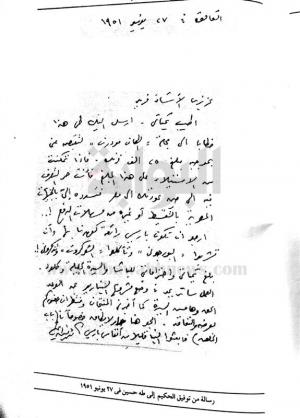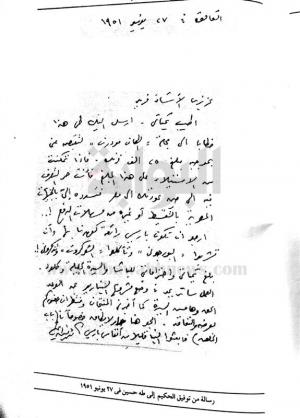01 - 06 - 1933
يا دكتور
يعنيك طبعاً أن تعلم كيف يرى الجيل الجديد عملك وعمل أصحابك، إن رسالتي إليك ليست حكماً يصدره الجيل الجديد، إنما هي تفسير لذلك العمل، لك أن تقره ولك أن تنكره. لا ريب إن العقلية المصرية قد تغيرت اليوم تحت عصاك السحرية، كيف تغيرت؟ هذا هو موضوع الكلام، إن شئون الفكر في مصر حتى قبل ظهور جيلك كانت قاصرة على المحاكاة والتقليد، محاكاة التفكير العربي وتقليده، كنا في شبه إغماء، لا شعور لنا بالذات، لا نرى أنفسنا ولكن نرى العرب الغابرين، لا نحس بوجودناولكن نحس بوجودهم هم، لم تكن كلمة (أنا) معروفة للعقل المصري. لم تكن فكرة الشخصية المصرية قد ولدت بعد. رجل واحد لمعت في نفسه تلك الفكرة فأضاء لكم الطريق: (لطفي بك السيد)، وسرتم ركضاً حتى بلغتم اليوم هذه الغاية، وإذا الجيل الجديد أمام روح جديدة وأمام عمل جديد. لم يعد الأدب مجرد تقليد أو مجرد استمرار للأدب العربي القديم في روحه وشكله، وإنما هو إبداع وخلق لم يعرفهما العرب. وبدت الذاتية المصرية واضحة لا في روح الكتابة وحدها بل في الأسلوب واللغة أيضاً، من ذا يستطيع أن يرد أسلوب طه حسين إلى أصل عربي قديم؟ بون شاسع بين الأمس واليوم. حتى أمس القريب كانت مقامات الحريري ورسائل عبد الحميد وبديع الزمان مثلاً تحتذي في كتابات حفني ناصف والمويلحي وغيرهما ممن رسفوا في أغلال التقليد راضين أو مرغمين. لقد بدأنا نعي ونحس بوجودنا، وأول مظاهر الوعي شخصية الأسلوب واستقلال طريقة التعبير وما يتبعها من ألفاظ وأخيلة، بهذا يبشر صاحبكم احمد أمين اليوم، ويصيح في هذا الجيل كي ينظر فيما حوله ويعبر عما يراه بخياله هو لا بخيال العرب. كل هذا جلي معروف، ولم أبعث برسالتي من أجله، حاجة مصر إلى الاستقلال الفكري أمر لا نزاع اليوم فيه، وعملك أنت وأصحابك لهذا الاستقلال أمر لا نزاع فيه أيضاً. ولقد مضى كلامكم في هذا، إنما الأمر الذي يحتاج إلى كلام هو معرفة مميزات الفكر المصري. معرفة أنفسنا: حتى تتبين لجيلنا مهمته. هذه هي المسألة، لقد فهمنا عنكم مميزات الأسلوب والشكل، وما فهمنا بعد جيداً مميزات النفس والروح، ما هي مميزات العقلية المصرية في الماضي والحاضر والمستقبل؟ ما روح مصر؟ ما مصر؟ إن اختلاطنا بالروح العربية هذا الاختلاط العجيب كاد ينسينا إن لنا روحاً خاصة تنبض نبضات ضعيفة تثقل تحت ثقل تلك الروح الأخرى الغالبة. وإن أول واجب عليكم لنا استخراج أحد العنصرين من الآخر. حتى إذا ما تم تمييز الروحين إحداهما من الأخرى كان لنا أن نأخذ أحسن ما عندهما، وكان لكم أن تقولوا لنا: (ها نحن أولاء أنرنا لكم الطريق إلى أنفسكم فسيروا) لا بد لنا إذن أن نعرف ما المصري وما العربي؟ هذا السؤال ألقيته على نفسي منذ ست سنوات إذ كنت ادرس الفنين المصري والإغريقي. وكانت المسالة عندي وقتئذ: ما المصري وما الإغريقي؟ وأذكر أني أثرت هذه المسألة أمام بعض أصدقائي في حي (مونبارناس)، أذكر أني لخصت لهم الفرق بين العقليتين بمثل واحد في فن النحت سائلاً: ما بال تماثيل الآدميين عند المصريين مستورة الأجساد وعند الإغريق عارية الأجساد؟ هذه الملاحظة الصغيرة تطوي تحتها الفرق كله، نعم كل شيء مستتر خفي عند المصريين، وعار جلي عند الإغريق، كل شيء في مصر خفي كالروح، وكل شيء عند الإغريق عار كالمادة. كل شيء عند المصريين مستتر كالنفس، وكل شيء عند الإغريق جلي كالمنطق. في مصر الروح والنفس، وفي اليونان المادة والعقل. نظرةٌ أخرى في أسلوب النحت تدعم هذا الكلام. أن المثّال المصري لا يعنيه جمال الجسد ولا جمال الطبيعة من حيث هي شكل ظاهر، إنما تعنيه الفكرة، انه يستنطق الحجر كلاماً وأفكاراً وعقائد. على انه يشعر مع ذلك بالتناسق الداخلي، يشعر بالقوانين المستترة التي تسيطر على الأشكال، يشعر بالهندسة غير المنظورة التي تربط كل شيء بكل شيء، يشعر بالكل في الجزء، وبالجزء في الكل، وتلك أولى علامات الوعي في الخلق والبناء؛ هذا كله يحسه الفنان المصري لأن له بصيرة غريزية أو مدبرة تنفذ إلى ما وراء الأشكال الظاهرة لتحيط بقوانينها المستترة، فنان عجيب لا يصرفه الجمال الظاهر للأشياء عن الجمال الباطن. إنه يريد أن يصور روح الأشكال لا أجسامها، وما روح الشكل إلا القانون العام الأعلى المستتر خلفه؛ إن ولع المصريين بالقوانين الخفية لشيء يبلغ حد المرض، مرض إلهي، لو أن الآلهة تمرض لكان هذا مرضها: فرط البحث عن القانون! كل شئ في مصر إلهي، لأن مصر التي منحتها الطبيعة الخير واليسر وسهولة العيش وكفتها مشقة الإجهاد في سبيل المادة استلقت منذ الأزل تتأمل ما وراء المادة. . حظها في هذا حظ الهند: أمة كثيرة الخير كذلك دانية القطوف لا حاجة بها إلى الكفاح ولا عمل لها إلا استمراء ترف الحكمة العليا، انقطعت هي أيضاً من قديم تحت أشجارها المقدسة تبحث عما وراء الحقيقة.
مصر والهند حضارتان قامتا على الروح لأنهما قد شبعتا من المادة، الإغريق على النقيض، أمة لم تشبع من المادة، أمة نشأت في العسر والفاقة، أرضها لا تدر من الخير إلا قليلا، كان لزاماً عليها الكفاح في سبيل العيش، وكان حتماً عليها الجري وراء المادة، حرب تلو حرب، وفتح بعد فتح، وضرب في مشارق الأرض ومغاربها، على هذا النحو لم يكن للإغريق ذلك الضمير المطمئن ولا ذلك الشعور بالاستقرار، ولا ذلك الإيمان بالأرض الذي يوحي بالتفكير فيما وراء الأرض والحياة، إن عاطفة الاستقرار والإيمان ممزوجة بالدم عند المصريين، لأن المصريين نزلوا من بطن الأزل إلى أرض مصر، لا يعرف لهم نسب آخر على وجه التحقيق، واختلاف العلماء في أمر أصلهم لم ينته بعد، وفي كل يوم يبدو دليل على أن العمران والاستقرار وجدا في مصر قبل التاريخ المعروف، ولقد ظهرت الحضارة المصرية في التاريخ تامة كاملة دفعة واحدة، كما يظهر قرص الشمس في الأفق عند الشروق، ولقد قال سولون: إن الكهنة المصريين يعنون العناية كلها بذكريات تلك القارة العظيمة ذات المدنية الزاهرة التي أبتلعها المحيط قبل مبدأ التواريخ: (قارة الأتلانتيد). أترى كانت الحضارة المصرية استمراراً لتلك المدنية المندثرة؟. . . لم يقم دليل، على كل فرض. مصر أمة مستقرة مؤمنة زهدها عمرها الطويل وخيرها الكثير في مباذل الحياة، وهذا الزهد والتفكير فيما وراء الحياة ظهر أثرهما على وجه الفن المصري، ولا شيءيدل على عواطف أمة وعلى عقليتها مثل فنها. فلقد طالع العالم الحديث على وجه الفن المصري الصرامة والجد والعمق ولا أكاد أفتح كتاباً في الفن المصري حتى أجد كلمة (الصرامة) نعتاً من نعوت هذا الفن، ولا أفتح كتاباً في الفن الإغريقي إلا وجدت كلمة (الحياة) وكلمة (الإنسانية) من نعوت هذا الفن، نعم. الحياة هي كل شيء عند الإغريق، قد يدفعهما حب البحث إلى لمس حدود الحياة الأخرى فيلمسونها بالعقل والمنطق لا بالقلب والروح. فلسفتهم فلسفة العقل والمنطق والحياة، فلسفة الحركة لا فلسفة السكون، عند مصر والهند السكون، عند الإغريق الحركة، قرأت حديثاً (المقبرة البحرية) لـ (بول فاليري) وهو المتصل اتصالاً مباشراً بالفلسفة اليونانية. فإذا هو يشير في القصيدة إلى الحركة والسكون، وإذا الحركة عنده من خصائص الكينونة الواعية الفانية، والسكون من خصائص العدم الخالد غير الواعي، وهو يعارض زينون الألياتي في إنكاره للحركة ويتغنى في آخر القصيدة بانتصار الحركة على قصرها وفنائها، فهو في ذلك لم يخرج عن يونانيته المكتسبة. ولم يفهم في رأيي روح مصر والهند، ولم يشرف على ذلك العالم الخالد غير الواعي، كان دون هذا الإشراف والاتصال والتجرد التام من كل عقل آدمي أو منطق بشري، هذه هي الصعوبة في فهم مصر والهند، وهذا ما جعل الفن المصري سراً مغلقاً حتى أوائل هذا القرن، وما صرف الناس إلى دراسة اليونان وحدها، فهي واضحة المعنى يسيرة المنال. لأنها لزمت شاطئ الحياة.
حظ الإغريق في كل هذا حظ العرب. العرب أيضاً أمة نشأت في فقر لم تعرفه أمة غيرها، صحراء قفراء، قليل من الماء يثير الحرب والدماء، جهاد وكفاح لا ينقطعان في سبيل العيش والحياة، أمة لاقت الحرمان وجهاً لوجه، وما عرفت طيب الثمار وجري الأنهار ورغد العيش ومعنى اللذة إلا في السير والأخبار، كان حتماً عليها ألا تحس المثل الأعلى في غير الحياة الهنيئة، والجنات الخضراء، والماء الجاري، وألوان النعيم واللذائذ التي لا تنضب ولا تنتهي، أمة بأسرها حلمت بلذة الحياة ولذة الشبع، فأعطاها ربها اللذة ومنحها الشبع. كل تفكير العرب وكل فن العرب في لذة الحس والمادة، لذة سريعة منهومة مختطفة اختطافاً، لأن كل شيْ عند العرب سرعة ونهب واختطاف، عند الإغريق الحركة، أي الحياة، وعند العرب السرعة، أي اللذة، لم تفتح أمة العالم بأسرع من العرب، ومر العرب بحضارات مختلفة فاختطفوا من أطايبها اختطافاً ركضاً على ظهور الجياد، كل شيء قد يحسونه إلا عاطفة الاستقرار. وكيف يعرفون الاستقرار وليس لهم أرض ولا ماضٍ ولا عمران! دولة أنشأتها الظروف ولم تنشئها الأرض، وحيث لا أرض فلا استقرار، وحيث لا أستقرار فلا تأمل، وحيث لا تأمل فلا ميثولوجيا ولا خيال واسع ولا تفكير عميق ولا إحساس بالبناء، لهذا السبب لم تعرف العرب البناء، سواء في العمارة أو الأدب أو النقد، الأسلوب العربي في العمارة من أوهى أساليب العمارة التي عرفها تاريخ الفن، وإذا عاش لليوم فإنما يعيش بالزخرف، فن الزخرف العربي أنقذ العمارة العربية، إن العمارة العربية ـ إلا في مصر ـ ما هي في رأيي سوى زخرف لا بناء، فلا أعمدة هائلة ولا جبهة عريضة ولا وقفة قوية ولا بساطة عظيمة ولا روعة عميقة، إنما هي وشي كثير وجمال كجمال الحلي المرصع يهز البصر ولا فكر خلفه. أما فن الزخرف العربي فهو في الحق أجمل وأعجب فن للزخرف خلده التاريخ. والزخرف عند العرب وليد ذلك الحلم باللذة والترف، كل شيء عند العرب زخرف. الأدب نثر وشعر لا يقوم على البناء، فلا ملاحم ولا قصص ولا تمثيل، إنما هو وشي مرصع جميل يلذ الحس، فسيفساء اللفظ والمعنى، و (آرابسك) العبارات والجمل. كل مقامة للحريري كأنها باب جامع المؤيد، تقطيع هندسي بديع. وتطعيم بالذهب والفضة لا يكاد الإنسان يقف عليه حتى يترنح مأخوذاً بالبهرج الخلاب، كذلك الغناء العربي (آرابسك) صوتي، فلا مجموعة أصوات متسقة البناء كما في (الديتيرامب) أو (الأوركسترا) الإغريقية أو كما في (الكورس) الجنائزي المصري، ولا حتى مجرد صوت ينطلق حراً بسيطاً مستقيما. إنما هو صوت محمل بألوان المحسنات من تعاريج وانحناءات والتواءات وتقاسيم كأنها (ستالاكتيتات) غرناطية، لا يكاد يسمعه (القاضي الفاضل) حتى يستخفه الطرب ويضع نعله فوق رأسه؛ كان هذا في العهد الأول للموسيقى إذ كانت عند جميع الشعوب بسيطة عارية تخرج من القلب تعبيراً عما في القلب، أو رمزاً لفكرة من الأفكار. والموسيقى كالعمارة من الفنون الرمزية لا الشكلية، ولكن العرب لا يحبون الرموز، ولا طاقة لهم بالفن الرمزي، ولا يردون إلّا التعبير المباشر بغير رموز، وإلا الصلة المباشرة بالحس، فجعلوا من الموسيقى لذة للأذن لا أكثر ولا أقل، ولقد حاول الفارابي فيما أذكر التقريب بين الموسيقى العربية والموسيقى الإغريقية، وكان لا بد له من الإخفاق لأسباب قد أذكرها بعد، كذلك التصوير العربي على جماله ودقته ليس إلا مجرد تزيين وزخرف للكتب والمخطوطات لم يؤَدِ لغير تلك الغاية (المنياتور) الفارسي. قد يكون للدين دخل في تأخر النحت والتصوير عند العرب، غير أني أعتقد براءة الدين. أن العرب كانوا دائماً ضد الدين كلما وقف الدين دون رغبات طبائعهم، لقد حرم الدين الشراب، فأحلوا هم الشراب في قصور الخلفاء، وما وصفت الخمر ولا مجالس الخمر في أدب أمة بأحسن مما وصفت في الأدب العربي، لا شيء في الأرض ولا في السماء يستطيع أن يحول بينهم وبين اللذة، أما النحت أو التصوير الكبير فليس في طبيعتهم، لأن تلك فنون تتطلب فيمن يزاولها إحساساً عميقاً بالتناسق العام مبناه التأمل الطويل والوعي الداخلي للكل في الجزء وللجزء في الكل، وليس هذا عند العرب، فهم لا يرون إلا الجزء المنفصل وهم يستمتعون بكل جزء على انفراد، لا حاجة لهم بالبناء الكامل المتسق في الأدب، لأنهم لا يحتاجون إلا للذة الجزء واللحظة، قليل من الكتب العربية في الأدب تقوم على موضوع واحد متصل، إنما أكثر الكتب كشاكيل في شتى الموضوعات تأخذ من كل شيء بطرف سريع: من حكمة وأخلاق ودين ولهو وشعر ونثر ومأكل ومشرب وفوائد طبية ولذة جسدية، وحتى إذ يترجمون عن غيرهم يسقطون كل أدب قائم على البناء، فلم ينقلوا ملحمة واحدة ولا تراجيديا واحدة ولا قصة واحدة، العقلية العربية لا تشعر بالوحدة الفنية في العمل الفني الكبير، لأنها تتعجل اللذة، يكفيها بيت شعر واحد أو حكمة واحدة أو نغم واحد أو زخرف واحد لتمتلئ طرباً وإعجاباً، لهذا كله قصر العرب وظيفة الفن على ما نرى من الترف الدنيوي وإشباع لذات الحس، حتى الحكمة، وشعراء الحكمة كانوا يؤدون عين الوظيفة: إشباع لذة المنطق، والمنطق جمال دنيوي ولا استغرب غضب نيتشه على إيروبيد لإسرافه في هذا المنطق على حساب الموسيقى، ومن المستحيل أن نرى في الحضارة العربية كلها أي ميل لشؤون الروح والفكر بالمعنى الذي تفهمه مصر والهند من كلمتي الروح والفكر. إن العرب أمة عجيبة، تحقق حلمها في هذه الحياة، فتتشبث به تشبث المحروم، وأبت إلا أن تروي ظمأها من الحياة وأن تعب من لذتها عباً قبل أن يزول الحلم وتعود إلى شقاوة الصحراء، وقد كان. إن موضع الحضارة العربية من (سانفونية) البشر كموضع الـ (سكِيْرتزو) من سانفونية بيتهوفن: نغم سريع مفرح لذيذ!!
لا ريب عندي أن مصر والعرب طرفا نقيض: مصر هي الروح، هي السكون، هي الاستقرار، هي البناء، والعرب هي المادة، هي السرعة، هي الظعن، هي الزخرف!
مقابلة عجيبة: مصر والعرب وجها الدرهم، وعنصرا الوجود، أي أدب عظيم يخرج من هذا التلقيح! إني أؤمن بما أقول يا دكتور. وأتمنى للأدب المصري الحديث هذا المصير: زواج الروح بالمادة، والسكون بالحركة، والاستقرار بالقلق، والبناء بالزخرف! تلك ينابيع فكر كامل ومدنية متزنة لم تعرف البشرية لها من نظير، إن أكثر المدنيات تميل إما إلى ناحية الروح وإما إلى ناحية المادة.
حضارة واحدة قيل أنها استطاعت في وقت ما هذا المزج بين الروح والمادة وهذا الاتزان بين عنصري الوجود، تلك حضارة الإغريق. نعم أعود فأرد إلى أمة الإغريق اعتبارها، وأعترف أني عندما وضعتها في كفة المادة كنت متأثراً بكلام (تين) فضللت السبيل. (تين) عقل خلاب لكنه عقل. والعقل وحده بعيد عن فهم الجانب الروحي للمدنيات. ما هداني إلى الحق إلا القلب. . . ألا طول تأملي في جبهة (البارتينون). من دماغ ذلك الجواد الذي خلقته يد (فيدياس) فوق هذا المعبد خرجت أفكار توحي إلي بأن أولئك القوم كانوا أعمق مما نظن، وكانوا يشعرون بشيء آخر غير مجرد المادة الظاهرة، وما لبثت (ميلبومين) أن جاءتني ببينة أخرى، وتأملت قليلاً فرأيت القناع قد كشف. ذكرت أن أصل الإغريق جنسان مختلفان: اليونان القادمون من آسيا المعروفون عند الهنود باسم (اليافاناس) أي عباد (يونا) والدوريون الحربيون البرابرة الهابطون من الشمال، اله اليونانيين: (ديونيزوس) إله الدوريين (أبولون). وهاهنا تفسير الإغريق: في هذا الصراع بين ديونيزوس رمز الروح والقوى الشائعة والنشوة. . . وبين أبولون رمز الفردية والشخصية الفارزة والوعي، الصراع بين الروح والمادة، وبين القلب والعقل، وبين النشوة والوعي، ديونيزوس إله آسيوي فيما يخيل إلي، جلب من الهند بالأمراء. فغدا في اليونان ينبوع الموسيقى، لهذا السبب قدرت إخفاق الفارابي، أن الموسيقى العربية وليدة عقل واع، لأن العرب أمة الفردية والوعي والمنطق العقلي والظاهر المحسوس، إن العرب من عباد أبولون وهم لا يشعرون. إن العرب لا يمكن أن يفهموا ديونيزوس ولا نشوة ديونيزوس. تلك النشوة الدينية الجارفة التي تخرج صاحبها من سيطرة العقل والوعي كي تصله مباشرة بالطبيعة. إن أغاني عباد (باكوس) الحماسية في الغابات ومزامير الـ (ساتير) لشيء بعيد إدراكه على العقلية الفردية، شعور الإنسان في لحظة أنه انقلب مخلوقا له جسم جواد ورأس رجل أو أرجل ماعز. هذا الاتحاد بين الحيوان والإنسان إحساس ليس له مثيل إلا عند المصريين القدماء، وهذا التلاقي بين الأنواع وبين القوى في مخلوق واحد لهو عند الأولين بقية ذكرى تلك المحلوقات الإلهية البائدة التي كانت تحكم الأرض قبل ظهور الإنسان. . . مخلوقات لا هي من الإناث ولا هي من الذكور، ولا هي من الحيوان، ولا هي من الإنسان، لأن الأجناس والفصائل لم تكن قد فرزت. كذلك (الساتير) في الميثولوجيا الإغريقية رمز الإنسان الأول، ذلك الإنسان الداني من الحيوان القريب من الآلهة، يدنو من الحيوان بغريزته الجنسية المتيقظة ينبوع القوة الخالقة عند الإغريق كما هي عند المصريين، ويقرب من الآلهة بغريزته الروحية المتصلة بقوى الطبيعة الإلهية، فهو ما زال يحتفظ بقبس من الحكمة العليا بدون أن يشعر، وببريق من ذلك النور الروحي والإلهام الذاتي يرى به كتلة الزمن من ماضي وحاضر ومستقبل في شبه لمحة واحدة.
تلك القدرة الخفية هي حاسة بائدة كانت للإنسان الأول، وفقدناها اليوم، نعم فقدنا كل القوى الروحية التي منحتنا إياها الطبيعة يوم كنا نحبها ونتصل بها، ولم يبقى لنا اليوم إلا العقل المحدود والمنطق القاصر. وها نحن اليوم في هذا الكون الهائل مخلوقات منفردة منبوذة! أين ذهب ديونيزوس؟ وهل يبعث من جديد؟ وإذا بعث فهل يجد من يعرفه في هذا العصر ذي الحضارة المادية الفردية؟!
رجل واحد ما زال يذكر هذا الإله ويستطيع أن يعرفه إذا ظهر كل عرف غالياس أصحاب الكهف!! وهو وحده كذلك الذي يستطيع أن يستقبله باسم هذا العصر، هذا الغالياس العصري هو: (تاجور) انه يتكلم كثيراً عن ذلك الاتحاد بين الإنسان والطبيعة. وعن ذلك الفاصل المرفوع بين الحياة الخاصة والحياة العظمى التي تخترق الكون. وعن ذلك الحب بين الإنسان والجماد. هذا كلام جميل. لكن هل تراه يشعر بحقيقته؟ يخيل إلي أن تلك الحقائق قد انطوت بانقضاء دولة الإغريق. بل لقد انقضت قبل أن تنقضي دولة الإغريق. انقضت بطغيان منطق سقراط على روح هوميروس. انقضت بطرد ديونيزوس من تراجيديات ايروبيد (غضبة نيتشه المعروفة) انقضت بظهور براكسيتيل على فيدياس، انقضت بغلبة الإحساس العقلي على الإحساس الروحي، انقضت بانتصار (أبولون) في النهاية على (ديونيزوس). وهكذا اختل التوازن، ورجحت كفة المادة، وانطفأت الحضارة الإغريقية إلى الأبد. ولم ترث أوربا منها غير كنوز العقل والمنطق، وبقيت في الظلام كنوز ديونيزوس الخفية.
لم تنجح اليونان إذن النجاح المطلوب في تطعيم الروح بالمادة، فهل تأمل مصر بلوغ هذه الغاية يوماً؟ أرجو من الدكتور أن يجيب، أنت وأصحابك ومدرستك قد فرغتم من تصوير وجه الأدب المصري، ولم يبقى إلا صبغه باللون الخاص، وطبعه بالروح الخاصة، فما هو هذا اللون؟ وما هي هذه الروح؟ إن ردك على هذا السؤال نور يلقي على طريق الجيل الجديد.
******
رسالة من طه حسين إلى توفيق الحكيم
15- 06 - 1933
سيدي الأستاذ
لست أدري أيعنيني حقا ويعني أصحابي، أن نعرف رأي الجيل الجديد في جهدنا الأدبي وما أحدثنا من أثر في حياتنا الأدبية الجديدة. لأن العلم الصحيح برأي المعاصرين لا سبيل له، أو لا تكاد توجد السبيل التي توصل إليه. أو قل أن هذا الجيل الجديد نفسه قد يشق عليه جدا أن يصور لنفسه فينا رأياً صحيحاً مستقيماً بريئاً من هذه العواطف الحادة الجامحة التي تسيطر على نفوس الشباب، وتؤثر أشد التأثير فيما يكونون لأنفسهم من آراء في الكتاب والشعراء المعاصرين. فهم بين معجب يدفعه الإعجاب إلى الإغراق في الثناء، وبين ساخط يدفعه السخط إلى الإغراق في الذم. وأكاد أعتقد أن ليس من اليسير لكاتب أو شاعر أن يعرف رأي الناس فيه حقا، لأن هذا الرأي لا يظهرواضحا جليا بريئا من تأثير العواطف والأهواء والظروف، إلاحين يصبح الكاتب أو الشاعر وديعة في ذمة التاريخ. ومع ذلك فأنا أشكر لك أجمل الشكر رأيك في أصحابي وفيّ، وثناءك على أصحابي وعليّ ويسرهم كما يسرني أن يكون رأيك فينا صحيحاً، وأن يكون ثناؤك علينا خالصاً من الإسراف في الحب الذي يدعو إلى الإسراف في التقدير.
لقد قرأت كتابك الممتع فترك في نفسي آثارا مختلفة، ولكن أظهرها الإعجاب بهذا التفكير المستقيم العميق، وهذا الاطلاع الواسع الغني، وهذا الاتجاه الخصب إلى تعرف الروح الأدبي لمصر في حياتها الماضية والحاضرة والمستقبلة. وقد دفعني إعجابي بكتابك القيّم إلى ألاّ أختص به نفسي فآثرت به قرّاء الرسالة وأذعته فيهم. وأنا واثق بأنهم قد رأوا فيه مثل ما رأيت وحمدوا منه مثل ما حمدت، وأثنوا عليك بمثل ما أثنيت، وهموا أن يناقشوا بعض ما جاء فيه من الآراء كما أريد أنا الآن أن أناقشها. ولست أدري أيقف أمر كتابك هذا عند إذاعته في الرسالة وردي عليه، أو يتجاوزهما إلى مناقشة طويلة عريضة، يشترك فيها كتاب مختلفون ونقاد كثيرون. فكتابك خليق بهذه المناقشة لأن أسلوب التفكير فيه جديد قيّم، ومهما أفعل فلن أستطيع أن أتناول كل ما أشعر بالحاجة إلى تناوله بالنقد والتمحيص من آرائك الكثيرة المتباينة التي أفعمت بها كتابك إفعاماً. ولكني أقف عند طائفة قليلة من هذه الآراء، لا أستطيع أن أدعها تمضي من غير نقد ولا تعليق.
وأول ما أقف عنده من هذه الآراء رأيك فيما تسميه شؤون الفكر في مصر، قبل الجيل الذي نشأنا فيه، فقد ترى أن هذه الشؤون كانت كلها محاكاة وتقليداً وتأثراً للعرب، واحتذاءً خالصا لمثلهم الأدبية، حتى جاء الأستاذ لطفي السيد ففتح لنا طريق الاستقلال الأدبي. وفي رأيك هذا شيء من الحق، لكن فيه شيئا من الإسراف غير قليل، فلست أعتقد أن الشخصية المصرية محيت من الأدب المصري محواً تاماً في يوم من الأيام، ولست أعتقد أن كلمة أنا لم يكن لها مدلول في لغة المصريين، ولست أعتقد أن المصريين كانوا في شبه إغماء حتى أقبل هذا الجيل الذي تتحدث عنه، فرد عليهم الحياة والنشاط. كل ما يمكن أن يصح لك هو أن الشخصية المصرية في الأدب كانت ذاوية ذابلة إلى حد بعيد في وقت من الأوقات لعلّه يبتدئ بآخر عصر المماليك. ولكن هذه الشخصية على ذبولها وفتورها لم تمت ولم تمح، بل ظلت حية تتردد أشعتها الضئيلة في آثار الكتاب والشعراء والعلماء، إلى أن كان العصر الحديث. ويكفي أن تقرأ الأدب المصري في أيام المماليك وقبل أيام المماليك، لتعلم أنّ شخصيتنا الأدبية كانت قوية منتجة، وكانت جذابة خلاّبة في كل فرع من فروع حياتنا المعنوية. كانت في الشعر بنوع خاص أقوى منها في هذه الأيام، وأقرأ ديوان البهاء زهير فستجد صورتك فيه واضحة، وستجد نفسك فيه ظاهرة، وستجد عواطفك فيه ممثلة، وستجد هذا كله أشد جلاء وقوة عند هذا الشاعر القديم منه عند شعرائنا المعاصرين. والأمر ليس مقصورا على هذا الشاعر، بل هو شائع في شعرائنا جميعا قبل فتح الترك لمصر. وهو كذلك شائع في كتّابنا وعلمائنا، ولو قد كانت شخصيتنا ضعيفة فانية وفاترة واهية، لما أتيح لنا أن نؤدي الحضارة الإسلامية ونحفظها من الضياع حين أخذ التتار والأوروبيون عليها أقطار الشرق والغرب. ولم تكن هذه الشخصية في عصور الضعف والوهن خفية ولا غامضة، فأنت تجدها واضحة في شعر هؤلاء الشعراء المتأخرين الذين عاشوا في أول القرن الماضي وفي أثنائه، والذين لا نحب شعرهم ولا نطيل النظر فيه، والذين يخيل إلينا انهم كانوا يقلّدون فيسرفون في التقليد، ولكنهم برغم هذا التقليد الشديد لم يستطيعوا أن يمحوا مصريتهم ولا أن يخفوها. ولست أستطيع أن أضرب لك الأمثال هنا فذلك شيء لا ينتهي، ولكني أؤكد لك أن حكمك على هذه الشخصية المصرية في الأدب محتاج إلى التصحيح، وأنت قادر على هذا التصحيح، إن قرأت أدبنا المصري كما تقرأ الأدب الغربي وكما تقرأ الأدب العربي القديم، ستجد فيه تقليداً، وستجد فيه بديعاً كثيراً، ولكنك ستجد فيه نزعة مصرية واضحة تحسّها حيثما ذهبت، وأينما وجهت من أرض مصر، وتجدها عند المصريين المعاصرين الذين لم تخرّجهم الثقافة الأوروبية عن أطوارهم المألوفة، في الشعور والتفكير وفي النظر إلى الحياة والتأثر بها والحكم عليها. هذه النزعة صوفية بعض الشيء، فيها مزاج معتدل من الإذعان للقضاء والابتسام للحوادث، وفيها مزاج معتدل من حزن ليس شديد الظلمة، ولا مسرفاً في العمق، ومن سخرية ليست عنيفة ولا شديدة اللذع ولكنها على ذلك بالغة مقنعة، تمضي في كثير من الأحيان، ولعلك تجد هذه النزعة نفسها قريبا جداً منك. لعلك تجدها في أهل الكهف. فجيلنا إذن لم يحدث شخصية مصرية لم تكن، وإنما جلا هذه الشخصية وأزال عنها الحجب والأستار، وجيلنا لم يمنحها الحياة، وإنما منحها النشاط، وزاد حظها من الاستقلال وغيّر وجهتها، فلفتها إلى الأمام بعد أن كانت تصر على الالتفات إلى وراء، وليس هذا بالشيء القليل. وأنا معجب بآرائك في الفن المصري، وفي الفن الإغريقي، ولكني لا أحب لك هذا الإسراع إلى استخلاص الأحكام العامة، وإقامة القواعد التي لا تثبت للنقد والتمحيص. وآية ذلك أنك أنت نفسك قد أحسست بعض هذا الإسراع فأصلحته حين قضيت على اليونان في أول الكتاب ثم قضيت لهم في آخره. وستر أنك أسرعت في الأولى وأسرعت في الثانية، وكنت خليقا أن تصطنع الأناة فيهما جميعا. فليس من الحق أن اليونان كانوا أصحاب مادة ليس غير، وليس من الحق أن روحية اليونان هذه التي أنكرتها في أول الكتاب، وعرفتها في آخره قد جاءتهم من إلههم ديونيزوس وحده. فحظ اليونان من الروحية قديم تجده بيّنا في شعرهم القصصي في الإلياذة والأوديسا قبل أن تظهر فيهم الآثار العنيفة لدين ديونيزوس، وأنت تعلم أن ظهور هذا الإله عند اليونان متأخر العصر، وأنه في أكبر الظن اله أجنبي جاءهم من تراقيا، وأنه لم يعطهم هذه الحياة الروحية العليا، التي نجدها عند سقراط وعند تلاميذه، وعند أفلاطون بنوع خاص، وإنما أعطاهم حياة روحية أخرى كلّها تصوف وكلّها طموح إلى عالم مجهول مختلط تحيط به الأسرار والألغاز، وتعبّر عنه الرموز والكنايات. وكان هذا النوع من الروحية ذا مظهرين مختلفين، أحدهما شائع مشترك، يساهم فيه الشعب كله، وأهل الريف منهم خاصة، والآخر مقصور على طائفة معينة، هي هذه التي تتعلم الأسرار وتشترك في إقامتها وإحيائها. فكان دين ديونيزوس أشبه شيء بطرق الصوفية عندنا، علمها الصحيح مقصور على خاصة المتصوفة، ونشاطها العملي الغليظ شائع في أفراد الشعب جميعاً. وقد كان أثر ديونيزوس في الأدب اليوناني قوياً عميقاً. وحسبك إنه إله التمثيل، ولكن روحية اليونان الخصبة حقاً، الممتازة حقاً، التي أزعم معتذراً إليك إنك لا تستطيع أن تجد لها شبيهاً ولا مقارباً في مصر الروحية. هذه الروحية اليونانية تجدها واضحة جلية، عذبة ساحرة عند فلاسفة اليونان من تلاميذ سقراط، وعند أفلاطون بنوع خاص. ستقول كما قال كثيرون من قبل: إن أفلاطون قد زار مصر، وأخذ منها. ولست أنكر روحية مصر، ولكني لا أعرف عنها شيئاً كثيراً، ولعلي مدين لليونان بما أعرفه من الروحية المصرية. ومهما يكن من شئ فأنت توافقني على أن اليونان لم يكونوا أصحاب مادة فحسب، ولم تأتهم روحيتهم من ديونيزوس وحده، وإنما اليونان مزاج معتدل من المادة والروح. هم الذين يحققون مثلك الأعلى من المزاوجة بين المادة والروح، والملائمة بين الحركة والسكون، وبين القلق والاضطراب، ولذلك كان اليونان هم الذين أخرجوا للإنسانية في العصر القديم أرقى تراث في الأدب والفن والفلسفة.
قلت إني لا أنكر روحية المصريين. وأقول أيضا إني مؤمن بروحية الهنود، ومعترف بتأثير الروحية المصرية والهندية في حياة اليونان. ولكني لا أعرف من روحية المصريين شيئاً كثيراً لأننا لا نعرف للمصريين فناً ناطقاً، لا نعرف لهم أدباً بالمعنى الصحيح لهذه الكلمة. وأنت ترى معي أن الأدب هو أوضح مصور لحياة العقول والقلوب، لأنه يحقق مقداراً مشتركاً يمكن الاتفاق عليه، ويصعب الاختلاف فيه. فنحن إذا قرأنا الشعر أو النثر معاً، فهمنا فهماً واحداً أو فهمين متقاربين، ولكن الفن الصامت فن البحث والتصوير وما إليهما يثير في نفوس الناس معانٍ مهما تكن متقاربة متشابهة، فهي تختلف باختلاف الأشخاص والبيئات والعصور، ها أنت ذا تفهم من الفن المصري ما تفهم، ويشاركك فيه كثير من المثقفين ثقافة أوربية، ولكن أواثق أنت حقاً بأن قدماء المصريين كانوا يرون تماثيلهم وعماراتهم كما تراها، ويفهمونها كما تفهمها، ويستلهمونها كما تستلهمها؟ أرأيتك لو سألت مصرياً معاصراً لرمسيس عن رأيه في تمثال من التماثيل، أو عمارة من العمارات، أيقول فيهما مثل ما تقول؟ ومثل هذا يقال في الفن اليوناني، وفي كل الفنون الصامتة، فليس من الخير أن نعتمد عليها وحدها في تشخيص عقلية الأمم وروحيتها، إنما المشخص الصحيح للعقول والقلوب والأرواح هو الكلام، والكلام الجميل الذي نسميه الأدب ونقسمه شعراً ونثراً. فإلى أن يكشف لنا علماء الآثار المصرية عن أدب مصري قديم خليق بهذا الاسم أرجو أن تأذن لي في أن أشك في كثير جداً من هذه الأحكام التي يرسلها الأدباء والشعراء وأصحاب الفن على عقلية المصريين القدماء وروحيتهم، وبعدهم عن المادة، وقربهم من الروح.
كل هذه عندي أحكام يتعجل بها أصحابها، ويرسلونها على غير تحقيق، وإذن فقد يكون من الإسراف أن تتخذ هذه الروحية المصرية الغامضة التي يسرع إليها الشك، والتي تعجز عن أن تثبت للبحث، والتي توشك إن تكون خيالاً تخيلته أنت وتخيله أصحابك من الأدباء ورجال الفن أساساً لأدبنا المصري الحديث. فمن يدري لعل البحث عن آثار مصر أن يكشف لنا بعد زمن طويل أو قصير عن حياة مصرية قديمة تغاير كل المغايرةهذا الخيال الذي تحبونه تطمئنون إليه، ويخيل إليكم أن الفن المصري القديم يوحيه ويمليه وينطق به.
نحن إذاً أمام أمرين أحدهما عرضة للشك الشديد، لا نكاد نعرف منه شيئاً، والآخر لا سبيل إلى الشك فيه؛ أحدهما حياة مصر القديمة وحضارتها العقلية - إن صح هذا التعبير - والآخر حياة العرب وحضارتهم. فإلى أي الأمرين نفزع لنقيم عليه بناء أدبنا الجديد؟ أإلى الشك أم إلى اليقين؟ وهنا يظهر الخلاف بينك وبيني شديداً حقاً، فقد أصلحت أنت رأيك في اليونان، ولا أستطيع مناقشتك في أحكامك على المصريين لأنها أثر الإلهام الفني، ولكن رأيك في العرب وآثارهم في حاجة شديدة جداً إلى التقويم. فقد كنّا نرى أن ابن خلدون جار على العرب فإذا أنت أشد منه جوراً وأقل منه عذراً. فقد يسّر الله لك من أسباب العلم بالتاريخ القديم، وتاريخ القرون الوسطى وتاريخ الحياة الأدبية والفنية والعقلية لمختلف الأمم والشعوب ما لم ييسّره لابن خلدون. فإذا قبل من هذا المؤرخ الفيلسوف أن يتورّط في الخطأ لأن عقله الواسع لم يحط من أمور اليونان والرومان والهند والفرس والمصريين القدماء بما نستطيع نحن الآن أن نحيط به أو نمعن فيه. فليس يقبل منك أنت هذا الخطأ وليس يقبل من المعاصرين بوجه عام. وقد ذهب إلى مثل ما ذهبت إليه جماعة من المستشرقين منهم دوزي ورينان، وأحسبكم جميعاً تظلمون العرب ظلماً شديداً وتقضون في أمرهم بغير الحق. فلو أنكم ذهبتم تقارنون بين العرب وبين الهنود والفرس، والمصريين القدماء لما كان من حقكم أن تقدموا هذه الأمم في الأدب على الأمة العربية بحال من الأحوال، لأننا لا نكاد نعرف من آداب هذه الأمم في تاريخها القديم شيئاً يقاس إلى ما بين أيدينا من الأدب العربي. فإلى أن يستكشف أدب هذه الأمم إن كان لها أدب أكثر من هذا الذي نعرفه، يجب أن نؤمن للعرب بالتفوق عليها في الشعر والنثر جميعاً. للمصريين فنهم، وللهنود قصصهم وفلسفتهم، ولكن للعرب شعرهم ونثرهم ودينهم، ولهم قصصهم أيضاً. فإذا أردت أن تقارن بين العرب والرومان فأظنك توافقني على أن الأدب العربي الخالص أرقى جداً من الأدب الروماني الخالص، أيأن الأدب الروماني إنما ارتقى حقاً حين أثّر فيه الأدب اليوناني، فالرومان تلاميذ اليونان في الأدب والفن والفلسفة، والعرب يشبهونهم في ذلك. ولكن العرب كان لهم أدب ممتاز قبل أن يتأثّروا بالحضارة اليونانية، ولم يكن للرومان من هذا الأدب الروماني الممتاز الخالص حظ يذكر. وقد تفوق الرومان في الفقه، ولكنهم لم يسبقوا العرب في هذه الناحية من نواحي الإنتاج، ولعل الأمة الوحيدة التي يمكن أن تشبه بالرومان في الفقه إنما هي الأمة العربية.
لم يبق إذن إلاّ أدب اليونان، هو الذي يمكن أن يقال فيه انه متفوق على الأدب العربي حقا، ولكن من الذي يقيس رقي الأدب في أمة من الأمم برقي الأدب في أمة أخرى؟ فإذا كانت ظروف الحياة العربية مخالفة أشد المخالفة لظروف الحياة اليونانية، فطبيعي أن تختلف الآداب عند الأمتين. وليس من شك في أن الأدب العربي قد صوّر حياة العرب تصويرا صادقا فأدى واجبه أحسن الأداء، وكل ما يؤخذ به الأدب العربي القديم هو أنّه لا يصوّر حياتنا نحن الآن، ولكن أواثق أنت بأن الأدب اليوناني القديم قادر على أن يصور الحياة الحديثة تصويراً يرضي أهلها؟! أمّا أنا فلا أتردد في الجواب على مثل هذا السؤال، فالأدب اليوناني القديم خصب غني ممتع من غير شك، ولكنه كالأدب العربي قد صوّر حياة القدماء، وهو قادر على أن يلهم المحدثين لا أكثر ولا أقل.
وأراك تذكر الفن العربي فتعيبه وتغض منه، وقد تكون موفقا في ذلك، ولكن أليس من الظلم أن تحمل هذا الفن على العرب وإنّما هو فن إسلامي ساهمت فيه الأمم الإسلامية المختلفة واستمدت أكثره من البيزنطيين. فإذا كان لك أن تعيب هذا الفن أو تحمده، فأحب أن تقتصد في إضافته إلى العرب، والخير أن تضيفه إلى الأمم الإسلامية. وأمر العرب بالقياس إلى الفن والأدب والعلم والفلسفة بعد العصر العباسي الأول، كأمر اليونان بالقياس إلى هذه الأشياء كلها بعد غارة الاسكندر على الشرق. كانوا ملهمين باعثين للنشاط دافعين إلى الإنتاج، مقدمين لغتهم وعاء لما تنتجه العقول والملكات على اختلافها، وقد يكون من الحق أن كل مقامة من مقامات الحريري أشبه بباب من أبواب جامع المؤيد، ولكن من الحق أيضا أن الآثار الأدبية التي تشبه مقامات الحريري والآثار الفنية التي تشبه أبواب جامع المؤيد كثيرة جدا عند اليونان في العصر المتأخر، وعند البيزنطيين، ولعل هذه الآثار اليونانية البيزنطية هي التي أحدثت عند المسلمين مقامات الحريري وأبواب جامع المؤيد. وأنت تميز اليونان بالحركة، وتميز العرب بالسرعة، وتستنبط من هذه السرعة ظلماً كثيراً للعرب، كما فعل أبن خلدون من قبل، وليس من شك في أن العرب يشاركون اليونان في الحركة، ولكن ليس من شك أيضاً في انك تغلو غلواً شديداً في وصفهم بالسرعة. إنما أسرع العرب في الخروج من باديتهم، ولكنهم حين بلغوا الأمصار استقرّوا فيها، وطال بهم المقام، فأثروا في أهلها وتأثروا بهم، وكانوا في القرون الوسطى أشبهالأمم باليونان في العصر القديم. ورأيك في الموسيقى العربية واليونانية في حاجة إلى التصحيح أيضا، فنحن نعلم من الموسيقى اليونانية شيئاً يسيراً غير مضبوط، ولا نعلم من الموسيقى العربية شيئاً، ولست أدري إلى أي أمة أو إلى أي جيل نستطيع أن نرد هذه الموسيقى، وهذا الغناء اللذين نتحدث عنهما. ولكن الشيء الذي لا أشك فيه هو أن من العسير جداً أن نردهما إلى العرب القدماء. وكل شئ يدل على أن الموسيقى والغناء العربي كما كان يعرفهما العرب أيام الأمويين والعباسيين وفي الأندلس كانا متأثرين أشد التأثر بالموسيقى البيزنطية والغناء البيزنطي. فإذا أردت أن تعيبهما فلا تنس أن تعيب أصلهما اليوناني القديم.
وأريد الآن أن أدع هذه المناقشات التي تمس أموراً جزئية وأن أخلص إلى جوهر الموضوع الذي تريد أن تعرف رأيي فيه، وهو: الروح المصري الذي ينبغي أن يقوم عليه الأدب الحديث ما هو؟ وما العناصر التي تؤلفه؟ وأنا استأذنك في أن أكون يسيراً سهلاً، لا متعمقاً ولا متكلّفاً، ولا باحثاً عن الظهر في الساعة الرابعة عشرة (كما يقول الفرنسيون) فالأمر أيسر جداً من هذا كله. عناصر ثلاثة تكون منها الروح الأدبي المصري، منذ استعربت مصر، أولها العنصر المصري الخالص الذي ورثناه عن المصريين القدماء على اتصال الأزمان بهم، وعلى تأثرهم بالمؤثرات المختلفة التي خضعت لها حياتهم، والذي نستمده دائماً من أرض مصر وسمائها، ومن نيل مصر وصحرائها. وهذا العنصر موجود دائما في الأدب المصري الخالص، قد حاولت تشخيصه بعض الشيء في أول هذا الفصل، فيه شيء من التصوف، وفيه شيء من الحزن، وفيه شيء من السماحة، وفيه شيء من السخرية. والعنصر الآخر هو العنصر العربي الذي يأتينا من اللغة ومن الدين ومن الحضارة، والذي مهما نفعل فلن نستطيع أن نخلص منه، ولا أن نضعفه ولا أن نخفف تأثيره في حياتنا، لأنه قد امتزج بهذه الحياة امتزاجاً مكوناً لها مقوماً لشخصيتها، فكل إفساد له إفساد لهذه الحياة ومحو لهذه الشخصية، ولا تقل انه عنصر أجنبي، فليس أجنبياً هذا العنصر الذي تمصر منذ قرون وقرون، وتأثر بكل المؤثرات التي تتأثر بها الأشياء في مصر من خصائص الإقليم المصري، فليست اللغة العربية فينا لغة أجنبية، وإنما هي لغتنا وهي أقرب إلينا ألف مرّة ومرّة من لغة المصريين القدماء. وقل مثل ذلك في الدين، وقل مثله في الأدب.
أما العنصر الثالث، فهو هذا العنصر الأجنبي الذي اثّر في الحياة المصرية دائماً، والذي سيؤثّر فيها دائماً، والذي لا سبيل لمصر إلى أن تخلص منه، ولا خير لها في أن تخلص منه، لأن طبيعتها الجغرافية تقتضيه، وهو هذا الذي يأتيها من اتصالها بالأمم المتحضّرة في الشرق والغرب. جاءها من اليونان والرومان واليهود والفينيقيين في العصر القديم، وجاءها من العرب والترك والفرنجة في القرون الوسطى، ويجيئها من أوربا وأميركا في العصر الحديث. فخذ الآن أي أثر أدبي مصري فحلله إلى عناصره التي يتكون منها، فستجد فيه هذه العناصر الثلاثة دائما. ولكنك ستجد بعضها أقوى من بعض بمقدار حظ المؤلف أو المنشئ من هذه الثقافات الثلاث المختلفة. بعض هذه الآثار يغلب فيه العنصر العربي، وبعضها يغلب فيه العنصر الأوربي، وقليل جدا منها يظهر فيه العنصر المصري القديم. فإذا لم يكن بد من أن أصور المثل الأعلى لروحنا المصري في أدبنا الحديث، فأني أحب أن يقوم التعليم المصري على شيء واضح من الملاءمة بين هذه العناصر الثلاثة فتشتد عنايته جدا بالتاريخ المصري، والفن المصري، والأدب المصري على اختلاف العصور. وتشتد عنايته جداً بالأدب العربي، والتاريخ العربي، والدين الإسلامي. ثم تشتد عنايته بالثقافة الحديثة. وأخوف ما أخافه على هذا الروح المصري شيئان: أحدهما أن تلهينا الثقافة الأوربية عن الثقافة المصرية والعربية، وكل شيء يغرينا بها ويغريها بنا فهي ضرورة من ضرورات الحياة، فمن الحق علينا أن لا نضيع حظنا منها، ولكن من الحق علينا ألاّ نفني أنفسنا فيها. الثاني أن نؤثر ثقافة أوربية على ثقافة أوربية فنؤثر الثقافة الإنكليزية (كما يريد قوم وكما تريد سياسة الدولة) أو نؤثر الثقافة اللاتينية (كما يريد قوم آخرون، وكما كانت تريد سياسة الدولة من قبل) هذا خطر لأنه يجعل الروح المصري الناشئ وجها لوجه أمام روح أوربية أقوى منه وأشد بأسا. فيوشك أن يخضع له ويفنى فيه، فلو قد فتحنا أبوابنا للثقافات الأجنبية على اختلافها، لانتفعنا بها كلها ولأضعف بعضها بعضا، وحال بعضها دون بعض أن يفنينا أو يسيطر علينا. لذلك تمنيت وما زلت أتمنى لو لم تفرض على مصر لغة بعينها من لغات الأوربيين، بل جعلت اللغات الحية الراقية كلها مباحة للطلاب يأخذون منها ما يشاءون.
هذا الروح المصري الذي يتكون من هذه العناصر الثلاثة، هو الذي نشهده الآن عندك وعند كثير من أمثالك المثقفين، وهو الذي نجد في نشره وإذاعته بين المصريين جميعا، وهو الذي سيطبع أدبنا المصري الحديث بطابعه القوي سواء أردنا أم لم نرد. فشخصيتنا المصرية العربية أقوى بحمد الله من أن تمحى أو تزول، والحضارة الأوربية أقوى وألزم من أن نعرض عنها، أو نقصر في الأخذ بحظنا منها. ستسألني: ولكن الأديب؛ من أين يستمد خواطره، ويستلهم وحيه؟ فأجيبك: من هذه العناصر كلها، أو من أي من هذه العناصر شاء، سيكون منّا الأديب الذي يستلهم العنصر المصري القديم؛ أليس بين الفرنسيين من يستلهم اليونان؟ وسيكون منّا الأديب الذي يستلهم العنصر العربي؛ أليس من الفرنسيين من يستلهم الرومان؟ وسيكون منّا أن يستلهم العنصر الأوربي، أليس من الفرنسيين من يستلهم السكسونيين؟ بل من يستلهم الشرق الأقصى، أو الشرق الأوسط، أو الشرق القريب، بلى. والأمر كذلك عند الإنجليز وعند الألمان، وعند غيرهم من الأمم الحية. فأنت ترى أن أمر هذا الروح المصري أيسر من أن يدعو إلى الخوف أو يضطر إلى الحيرة وأكبر الظن أنّ مصدر هذه الحيرة وذلك الخوف إنّما هو اضطراب سياسة التعليم في مصر وقيامها على غير أساس، وسيرها في غير طريق، ولو قد وضحت هذه السياسة واستقامت منذ زمن بعيد لما تساءلنا الآن عن الروح المصري، ولا عن الأدب المصري من أين يستمد الحياة.
أمّا بعد؛ فقد كنت أريد أن أقتصد وأؤثر الإيجاز، ولكن الحديث معك أغراني بالإطالة وحببها إليّ، وأرجو أن لا أكون عليك ولا على غيرك من القرّاء، وأرجو أن تقبل تحيتي الخالصة.
****
رسالة من الأستاذ توفيق الحكيم إلى الدكتور طه حسين
عزيزي الدكتور
قرأت الرد، ومرة أخرى أتأمل ما بيمينك. هذه العصا عجيبة التركيب، إنك لا تلمس شيئاً حتى ينقلب إلى الحق، حق كبير يبتلع كل رأي، ويلقف كل حجة. تلك عصا الأستاذية. ما كنت اجهل أنك حاملها في هذا العصر. نحن متفقان. ولا خلاف بيننا في الغاية. وهو مطلبنا. هنالك تفاصيل افترق فيها عن الدكتور ولن أعود اليها. فأنا أفزع من النظر إلى الوراء، خشية أن أتحول إلى تمثال من الملح، أو حتى إلى تمثال من الذهب. نفسي تصدف أحيانا عن الفكرة الجامدة مهما تكن خالدة، ويحلو لي أحيانا أن انثر الأفكار عابثا من نافذة قطار. أن رسائلنا في حقيقتها لا تعني أكثر من إثارة الغبار في أرض ناعمة مفروشة بالحصى. لسنا نصدر أحكاما بهذه الكتب السريعة. إنما نحن نطرح مسائل ونلقى بفروض سوف يلتقطها ويجمعها الباحثون المنقطعون يوم تستيقظ الأجيال. اتفقنا إذن. أو ينبغي لنا أن نتفق على أي حال، حتى ننصرف إلى شيء جديد. أن البحث عن الجديد هو الخليق عندي بالمجهود. ولقد فتح لنا اليوم باب الجديد الأستاذ احمد أمين. قال لي ذات مساء أنه يضع كتابا في أصول النقد، ويود أن يوليني شرف المشاركة في البحث من بعض وجوهه. النقد؟ لفظ رن في أذني. وذكرت للفور أن رسالتي الأولى للدكتور كان موضوعها (الخلق). وقلت في نفسي ما يمنع من إتمام الكلام في رسالة ثانية يكون موضوعها (النقد) وإذا الأمر ينكشف لي عن قضية كبيرة: أنعد النقد كالخلق خاضعا لسلطان التيارات الفكرية الثلاثة التي ذكرها الدكتور: التيار المصري القديم، والتيار العربي، والتيار الأوربي؟ أم نعد النقد كالعلم لا يخضع لمثل هذه المؤثرات؟ أما أنا فلن أجيب عن فوري عن هذا السؤال. فأنا أكتب ولا أدري أين يحط بي القلم. دعني أولا أنشئ على هذا النغم بعض (تقاسيم) دون أن أعني الآن بالغاية. أن الغاية أحيانا رخيصة بجانب الوسيلة على الأقل في نظر الفن. لأن الغاية في الفن لا تبرر الوسيلة. الحياة كذلك، تلك القطعة الفنية التي أبدعها الخالق، أهي شيء غير وسيلة متينة التكوين؟ ألها معنى في غير ذلك الطريق المبين الذي أوله ضباب وآخره ضباب؟ خط هندسي رسم على لوح الوجود، كيف أبتدأ، كيف انتهى؟ لا يعنى ذلك علم الهندسة. انه خط بين نقطتين وكفى. ليس لنا أن نسأل عن غاية الحياة، ولا عن غاية الفن، ولا عن غاية العلم. أن الغاية لا تهم. إنما المعنى كله في الوسيلة. الحياة هي الطريق. العلم هو الطريقة. الفن هو الأسلوب. أما الغاية فلا غاية. وهل يترجى من العلم أو من الفن أو من الحياة غاية مطلقة يوما من الأيام؟ محال. ما نحن ألا أسلوب الخالق. ما الكون ألا أسلوب. الأسلوب كل شيء عند كل خالق وفي كل خلق. أن الخالق اعظم من أن يحبس إرادته الخالدة في حدود، غاية، لفظ يدل بذاته على معنى الانتهاء. في اعتقادي أن كلمة (غاية) هي من صنع العقل البشرى الصغير. هذا العقل المحدود الذي يضع كل شيء دائماً داخل حدود، ويأبى ألا أن يكون لكل شيء أول وآخر. إنما الخلود في الأسلوب. لأن الأسلوب لا أول له ولا آخر، فهو شيء كائن دائماً، لا علاقة له بالزمن. أن رجل الفن، وهو المقلد الأصغر للمبدع الأكبر، يدرك أن الفن لا يعيش بالغاية. لأن الغاية فانية كاسمها. وانما يعيش الفن بالأسلوب. لقد انقضت الغاية من تشييد الأهرام، وفنيت الغاية من بناء البارتينون. دفن الموتى أو عبادة الآلهة الغابرين غاية قد ماتت وبقى أسلوب الفن وحده خالداً في الأهرام والبارتينون. خدمة الإنسانية غاية العلم في نظر البسطاء. لو سئل عالم في ذلك لابتسم: (مالي وللإنسانية! إنما أنا أبحث عن سر أسلوب الصانع الأعظم. إنما هي لذة البحث وحدها. إنما هي طريقة البحث وأسلوبه. ولولا ذلك السرور الذي يملأ نفسي إذ ينكشف لعيني الباحثة عن جمال أسلوب الله لما تجشمت النصب في سبيل العلم، ولما كان للعلم هذا المعنى الرفيع.) المخترعات كذلك ليست غاية العلم. هي تطبيق للعلم. إنما العلم هو البحث الخالص المجرد عن كل غاية وعن كل استغلال. لقد كان الإغريق يبحثون ولا يطبقون. فيثاغورس مثل من أمثلة الأسلوب الخالد للعلم الخالص. الأسلوب إذن هو محور النقد كما هو عماد الخلق، وكلمة الأسلوب رحبة عميقة كالبحر، في جوفها كل كنوز المعرفة التي يصبوا اليها البشر. ولعل كل ما أوتيه الإنسان من سليقة سامية منذ أول الأزمان ليس ألا انعكاس أسلوب الخالق في نفس الإنسان. هذا المنطق الذي نشأنا عليه، ونرجع إليه في كل حياتنا، هذا الإحساس بالنتيجة والسبب، هذا الشعور بالتناسق والتناسب، هذا الإدراك للصلة التي تربط الشيء بالشيء، من أين جاءنا هذا نحن البشر؟ أهناك مصدر آخر غير أسلوب الخالق؟ فتحت البشرية عينيها فالفته حولها. فهو موجود قبلها وقبل الخليفة كما يوجد الرسم والتصميم قبل البناء. أن أسلوب المبدع في صنع الخليقة هو وحدة المنبع الأزلي لهذه الصفات كلها: المنطق، ارتباط السبب بالنتيجة والشيء بالشيء. والجزء بالكل، والتناسق والتناسب. صفات هي بعينها صفات الأسلوب السليم لكل عمل فني عظيم. أسلوب الله هو المعلم الأول والأخير. وما أول صورة رسمها الإنسان على الأحجار وعظام الحيوان سوى إعلان شعوره الخفي بتلك الصفات، أن رجل الفن الأول هو أول إنسان عرف (المنطق) صفة فنية بعد أن كان المنطق سليقة سامية تسبح في أنحاء نفسه ولا يعرف ما هي. أن المنطق الذي شيد الأهرام صورة محكمة لهو المنطق الذي شيد الكون. ما المنطق؟ ما معنى المنطق؟ سره في تلك المرآة العظيمة الصافية التي تحيط بنا كالجدران: الوجود، أجمل مثال للمنطق في الأسلوب ينبغي لرجل الفن والأدب والعلم أن يطيل فيه النظر. كل شيء في هذا الوجود مصنوع على طريقة واحدة وعلى قاعدة واحدة. ما القاعدة التي بني عليها الوجود؟ هي القاعدة التي بنيت عليها الأهرام. هي قاعدة كل بناء: التماسك بين الأجزاء في كل واحد متسق. هذا التماسك ما علته وكيف يكون؟ قانون أستطيع أن أفرغه كما يفعل الرياضيون في صيغة بسيطة من لفظين: (الأخذ والعطاء). كل شيء في هذا الوجود يحيا على نمط واحد. وكل حياة في هذا الوجود لها مظهر واحد: اخذ وعطاء في حركات متصلة متشابهة: زفير وشهيق عند الإنسان والأحياء، اكتساب وإشعاع عند النجوم والأشياء. الأخذ والعطاء قانون التماسك والاتصال في حياة الفرد والمجتمع والأمة والأمم. وفى حياة الأخلاق والسياسة والاقتصاد. وفي حياة المادة والروح. وفي حياة الأرض والأجرام والسدم. ليس في الوجود شيء لا يأخذ ولا يعطى. وليس في الوجود شيء يعطى ولا يأخذ. كل شيء يعتمد على كل شيء في هذا الكون. بنيان مرصوص يشد بعضه بعضا.
وكل خلق بنيان. ولا بنيان بغير وحدة شاملة، ولا وحدة شاملة بغير تضامن بين الحجر والحجر، وبين الجزء والجزء. هذا التضامن وليد ذلك القانون: (الأخذ والعطاء) وليس هذا كل المنطق في صنع الوجود وانما المنطق في تركيب ذلك القانون. ما قوام الأخذ والعطاء؟ هل يكون اخذ وعطاء إلا بين كائنات متشابهة؟ ما الحال لو أن الخالق أبدع في وجودا آخر على أسلوب آخر، فصنع أناسا يعيشون بالزفير ولا يعرفون الشهيق، ومخلوقات تأكل ولا تصرف، وأجراما تكتسب الحرارة والضوء ولا تشع؟ أي اتصال يمكن أن يقوم بين كائنات خلقت على غير أسلوب واحد؟ لا اتصال، وحيث لا اتصال لا بناء. لا خلق ولا بناء. أي اتصال بيني وبين أخي وابني لو أن الخالق صنعني من عناصر غير عناصرهما فجعلني من يابس ورطب وجعلهما من نور ونار وغاز وبخار؟ أي ارتباط لو انه جعل كل مخلوق منفردا بمادته وهيئته وعناصره عن كل مخلوق. وأي هرم يمكن أن يشيد بأحجار، أحدها من صخر، وآخر من عجين، والثالث من ورق، والرابع من طين؟ لا ارتباط من غير تشابه وتماثل. ولا تضامن بين أجزاء غير متجانسة في التركيب. إن كل ما نحس بوجوده يتحد معنا في بعض العناصر. بغير هذا ما كنا نعترف له بوجود. إنا نعرف الأجرام لأن أجسامنا تعرف الحرارة والضوء والحديد. التشابه شرط الأخذ والعطاء. الاختلاف كذلك شرط آخر. هل يقوم آخذ وعطاء إلا بين كائنات مختلفة؟ ما الحال لو أن الخالق صنع كل شئ ككل شئ، فجعل كل رجل ككل رجل، وكل جرم ككل جرم؟ طبع واحد، ومنظر واحد، وحجم واحد. أليس هذا التشابه المطلق ينفي الشخصية؟ وحيث لا شخصية فلا أخذ ولا عطاء، ولا تماسك ولا اتصال، وهل من صلة بيني وبين غيري إلا الاختلاف شخصه عن شخص وما عنده عما عندي؟ وهل رابطة الأجرام إلا اختلافها في الأحجام؟ الجاذبية، الحب، هل علتهما اختلاف النسب في القوى والأشكال؟ أن مثل هذا الكون المتماثل لا يمكن كذلك أن يشيد أو يوجد. مثله مثل قصة تمثيلية أشخاصهم لهم عين الاسم والجسم والطبع والحظ، يتكلمون عين الكلام، ويتحركون عين الحركات، ويتصرفون عين التصرفات! أي علاقة يمكن أن تنشأ بين هذه المخلوقات؟ وهل يشعر أحدهم بوجود الآخر؟ وهل يدرك أحد منهم معنى كلمة (أنا)؟ لا بد من بعض الاختلاف بين الكائنات حتى يتميز كل كائن من الآخر. ومتى تميزت الأشخاص والأشياء والأجزاء نشأ بينها الأخذ والعطاء، سر تماسك في كل بناء. . . ها هنا إذن قوام التناسق: (التشابه لا كل التشابه، الاختلاف لا كل الاختلاف!) بيتهوفن الذي كشف لي منذ ست سنوات عن سر التأليف بين صوتين في عين الوقت. لاحظت انه يجمع بين صوتين متشابهين لا كل التشابه مختلفين لا كل الاختلاف. وأدركت انه لا تناسق بغير هذا. فلو انه جعل الصوتين متشابهين كل التشابه لفنى أحدهما في الآخر. وما يميزنا شيئاً غير صوت واحد. ولو انه جعلهما مختلفين كل الاختلاف لاستحال على الأذن أن تصل بينهما وهما متباعدان متنافران. فأساس (التناسق) في الموسيقى والفن كأساس التناسق في الحياة والكون: ائتلاف بين الأجزاء لا كل الائتلاف واختلاف بينهما لا كل الاختلاف. ملاحظة أخرى داخل القوسين: كلامي عن المصرية والعربية في رسالتي الأولى ليس ألا رغبة مني في فرز خصائص أمم هذا العالم العربي الذي أخشى انحلال آدابه إنما الحب والتضامن في اختلاف ما عندنا عما عند إخواننا الجيران بعض الاختلاف. إن التشابه مضمون باللغة الواحدة والتراث الواحد. فليبحث كل منا عن شخصيته المميزة في ماضيه الطويل بأكمله. المصري في مصر القديمة وما بعدها من عصور. والسوري في فينيقيا وما بعدها. والعراقي في بابل وما بعدها وما قبلها من تواريخ الخ الخ. . . كل يستخرج من بطن الأرض التي يحيا عليها كل محاسن طبيعتها وكل كنوز ماضيها. أن الفن أبن الأرض. الولد للفراش والفن للأرض. أني أقول بالمصرية والعراقية والسورية الخ الخ لا للانفصال بل للاتصال، لا للتعصب بل للحب. أن اليوم الذي تزهو فيه لكل منا شخصية قوية هو اليوم الذي يكثر فيه التعامل بيننا والارتباط. أما فناؤنا جميعا في شخصية العرب الغابرين فأمر لا يمكن أن يكون، لأنه مخالف لطبيعة الأشياء. أن لكل ارض صفات من التاريخ سابقة على عهد العرب. ماذا نفعل بهذه الصفات؟ أنمزقها كما يصنع البرابرة المتوحشون أم نطالعها ونستخرج منها ما يفيد الإنسانية؟ لا بد أن يكون لكل ارض لون. ولكل ارض اسم ورسم وجسم. ولقد كان الأمر كذلك حتى أيام دولة العرب. فكانت الشام غير العراق غير مصر غير الأندلس. والفن والشعر والأدب اظهر دليل على وجود الفروق الجلية، وعلى صدق ذلك القانون: تشابه بين تلك الأقطار لا كل التشابه. واختلاف بينهما لا كل الاختلاف. فكيف يكون الأمر غير ذلك؟ ونغضب إذ تكون هناك مصر وهناك شام وهناك عراق؟ مثل ما كانت دولة العرب أمس. ينبغي للعالم العربي اليوم أن يكون: (وحدة شاملة وكتلة بنيان في شئون السياسة والذود والدفاع، وشخصيات منوعة الألوان في شئون الفن والخلق والإبداع.) جملة القول عندي أن أسلوب الله في صنع الكون هو وحده منبع الفن، هو وحده مصدر ذلك الإدراك الإنساني للجمال منذُ مبدأ الأجيال. أما نقاد القرن التاسع عشر فلا احسبهم رفعوا أبصارهم إلى هذا الأسلوب مستلهمين. إنما هم قد خروا أمام تمثال العلم ساجدين، أنظارهم خاشعة ترنو في رجاء إلى شعاعين من الكهرباء صادرين من عدسات عينيه الجامدتين. القرن التاسع عشر قرن تأليه العلم. فلقد بهر العلم العالم بانتصارات حاسمات متواليات، فاذا الأدب والفن والفلسفة كلها تهرع إليه تقرى له بالغلبة والسلطان. وإذا كل شئ يطلب إلى العلم تفسيرا. وإذا العلم في نشوة الظافر وبسمة الواثق لا يأبى أن يقضى فيما يعنيه وفيما لا يعنيه. وإذا العلم وهو علم المادة يريد أن يتحدث في شئون الروح. وإذا سئل عن الروح قال دونكم هذا الطريق وأشار إلى عين الطرائق التي أدت إلى الفوز في شئون المادة: التحليل والتركيب والتجربة والقياس والاستنتاج والاستقراء الخ. بهت العالم لنظرية النشوء والارتقاء. وآمن الناس أن أصلنا من ماء وخلايا حية وحيوان ظل يسمو في المرتبة على مدى الأزمان حتى بلغ القرد جد الإنسان! نظرية جميلة، خلب جمالها اللب على الرغم من بشاعة ذلك الجد الغول. أما صدقها فجائز من حيث المادة والأجسام. وهنا تبدو قضية: أتصدق هذه النظرية على الروح أيضا وشئون الروح؟ الإحساس بالجمال: أيخضع أيضا للنشوء والارتقاء؟ نعم، نعم، نعم. كذلك قالت المدرسة الإنجليزية (سبنسر، جرانت الن، رسكن). وكان لا بدلهذه العقول التي فتنتها نظرية التطور في المادة أن تبرز للإنسان نظرية التطور في الجمال.
وعجب الناس لنظريات علم طبقات الأرض وعلم الحيوان وعلم الحياة وأبحاث (لامارك) في تأثير البيئة والمناخ وظروف الحياة على طبيعة الأجسام، فقامت المدرسة الفرنسية (هيوليت تين) تخرج للفكر والأدب نظرية للجمال والفن: الوحي فيها والإلهام مقاييس الحرارة وموازين الأحجام! بل إني لأرى إصبع العلم قبل ذلك بقرن يقود المدرسة الألمانية إلى نظريتها في الجمال. ولم يكف العلم هذا التوجيه والتأثير بل تناول بيديه في هذا العهد الحديث جسم الجمال: واعمل فيه المشرط والمسبار (علم النفس الحديث) قضى الأمر، وخرج الجمال من حدائق الفلسفة إلى معامل العلم. .! لست ارزى على طرائق العلم. فهي وسائل البشرية التي لا تملك غيرها. واذكر يوم كنت ارصد وقتا للتفكير في هذه المسائل أني بسطت أمام نفسي هذا السؤال الساذج: الحيوان ما علمه بالجمال؟ حصان بين مهرتين أحدهما جميلة مليئة شهباء والأخرى قبيحة هزيلة عرجاء، إلى أيتهما يميل؟ ما ترددت يومئذ أن أقول في ثقة واقتناع: (إلى الجميلة يميل، ما وجه الترجيح؟ لست أدري، وحبذا التجربة فهي الحكم الفصل!). لكنى يومئذ كنت أفكر تفكيرا صرفا في قهوة صاخبة اعتقدت أن آوى اليها للتفكير الهادئ، فأين لي بالخيول والأفراس أجري عليها التجاريب؟ فهاأنذا أقر بأن التجربة وسيلة بشرية طبيعية للوصول إلى المعرفة. واقر باني شعرت يوما بالحاجة إلى ممارستها في شئون الجمال. غير أني على الرغم من هذا لا احب أن اعتقد ببساطة أن نظريات العلم في شئون المادة تصدق دائما في شؤون الروح. لا شيء يستطيع أن يقنعني بأن إحساس الجمال وليد تطور ونشوء. بي رغبة أن أصيح بغير دليل في يدي أن إدراك الجمال ولد كاملا في قلب الإنسان منذ رفع بصره وبصيرته إلى أسلوب الله فرعاه. إني أخشى أن نقع في الغلط إذ نطبق نظرية المادة في مسائل الروح، وهل يستطيع الدكتور أن يجيز قول رسكن وجرانت الن في الإلياذة: (. . . ما كان يعنى الأقدمون بالطبيعة ولا بجمالها ألا حين يتصلان بعيش الإنسان. ففي الإلياذة ما كان يوصف منظر طبيعي لذاته، بل لنفعته للإنسان، كان يكون مكانا خصيبا يفيض بالحنطة أو تكثر فيه الجياد. ما كانت الطبيعة سوى إطار للحوادث والاشخاص، لا انها لذاتها محل للوصف. أن الطبيعة لم تحب لذاتها ألا في العصر الحديث، حيث استيقظ الإحساس بها، إحساس صافي خالص لا تشوبه شائبة النفع أو المصلحة. . .) ماذا أقول في هذا الكلام؟ اهو جهل بمشاعر الأقدمين؟ أم تورط في تطبيق نظرية التطور والنشوء؟ أنصدق حقا أن الشعور الرفيع بجمال الطبيعة لم يعرفه القدماء خالصا لدنوهم من الحيوانية؟ أنصدق أن (هومير) لم يحس جمال الطبيعة لذاتها؟ أهذا رسكن يقول هذا الكلام أما أنا فقد مضى كلامي في الطبيعة والقدماء. ورأيي الذي أبديته في رسالتي الأولى أن الأقدمون كانوا أقرب منا إلى الطبيعة والى فهمها. لقد كان الأقدمون يحسون إنهم جزء من الطبيعة ونغم من أنغامها. أما رسكن وألن أو الإنسان الحديث فلا يحس ألا ذاته الآدمية منفصلة عن الطبيعة وعن كل شئ. دليلي فن القدماء من مصريين وإغريق. أهذا فن قوم لا يحسون الطبيعة لذاتها ولا يدركون قوانينها وأساليبها؟! إلى هذا الحد يصل الانقياد إلى النظريات؟ من اجل هذا لا أريد التمكين للعلم حتى يجلس على عرش النقد دون شريك. احب طرائق العلم. لكنى أخشى نتائج العلم. فلنرتفع بالروح قليلا. لست أريد أن أضع الروح تحت مبضع العلم، رهبة منى أن يشقها فيجدها غلافا أجوف. وإني لا أنسى يوم شاهدت تشريح جثة آدمي للمرة الأولى. أي قلق يومئذ مزق إيماني بقيمة الإنسان! كلا. أني كرجل من رجال الروح لا أريد أن افجع في خير ما أعيش به وله. يريح نفسي دائما أن أقول أنى عقل العلم لا يكفي. ولا بد دون إدراك الجمال والروح من العودة إلى القلب. أريد ألا يخرجني العلم من ذلك الإيمان الذي كان يضيء في قلوب المصريين القدماء إيمان قربهم من الخالق، فإذا هم ببصائرهم العميقة العجيبة أول آدميين استطاعوا فهم أسلوب الله والنفوذ إلى قوانين إبداعه. أن أقصى العلم الإيمان. احب ذلك العلم المؤمن الشاعر الذي عرفه أيضا الفلكيون العظام في القرنين السادس عشر والسابع عشر: كوبرنيك، وجاليليه وكبلر، آخر قطرة من ذلك العلم الممزوج بالإيمان كانوا ينظرون إلى الكواكب كما نظر اليها من قبل المصريون الأقدمون. لا بعين العقل، بل بعين القلب أيضا. كانت السماء والنجوم في نظرهم مخلوقات حية. كانوا أيضا يحسون في كتلة النجوم وفي هذا الكون بأكمله الروح الخالقة ويد المبدع الأعظم. ما أروع هذه العبارة من كبلر، فيها تلخيص جميل لكل ما يملأ نفسي: (. . . كل الخليقة ليست إلا سمفونية عجيبة في مجال الروح والأفكار كما هي في مجال الأجسام والأحياء. كل شئ متماسك مرتبط بعرى متبادلة لا تنفصم. كل شئ يكون كلا متناسقا. أن الله قد خلقنا على صورته، وأعطانا الإحساس بالتناسق. كل ما يوجد حي متحرك، لأن كل شئ متتابع متصل. كل كوكب وكل نجم أن هو ألا حيوان ذو نفس. أن روح النجوم هي سر حركتها، وسبب ذلك الحب الذي يربط بعضها إلى بعض وتعليل ذلك النظام الذي تسير عليه الظواهر الطبيعية. .) أولئك رجال ساروا في بيداء العقل دون أن ينسوا دليل القلب. أولئك هم العلماء العظام! أرى الدكتور قد استشف رأيي بعد هذا التمهيد. نعم ولا أخشى أن أجيب ألان عن السؤال فأقول أن التيارات الثلاثة التي ذكرها الدكتور تصدق أيضا في النقد. كما تصدق في الخلق. أما التيار الأوربي في النقد فهو المرتكز على العلم. ولقد وصل إلينا هذا التيار بالفعل وتأثرنا به. وإن بعض كتب النقد التي طهرت في مصر الحديثة تنم على هذا الاتجاه العلمي. وهو أمر لا بأس به، بل هو واجب محتوم، على شريطة أن نقرن به. نظيف إليه عناصر جديدة ووسائل أخرى مستخرجة من أرضنا وتراثنا إذا أردنا أن ننشئ لآدابنا طريقة شخصية كاملة في النقد. فأما التيار المصري القديم فهو النقد المعتمد على الذوق، أي سليقة المنطق والتناسق. وهو عند المصريين القدماء سليقة المنطق الداخل للأشياء والتناسق الباطن أي القانون الذي يربط الشيء بالشيء. أي جمال للأهرام غير ذلك التناسق الهندسي الخفي وتلك القوانين المستترة التي قامت عليها تلك الكتلة من الأحجار! جمال عقلي داخلي. كذلك أسلوب الخالق لا يعني بالجمال الظاهر وحده في خلق الطبيعة. فأي جمال للثعبان والجعران؟ أن الجمال الظاهر نسبي لا يقدره غير الإنسان. إنما المنطق الداخليللأشياء هو كل جمالها الحقيقي. هذا المقياس المصري القديم للجمال ما احسبه قد أثر بعد في حياتنا الفكرية أو في أحكامنا الفنية. أما التيار العربي القديم فهو النقد الذي قوامه ذوق الحس. أي سليقة المنطق الظاهر والتناسق الخارجي. الجمال عند العرب هو الجمال الظاهر الذي يسر العين ويلذ الأذن. أنستطيع أن نتخيل العرب تبني الأهرام أو تقدر فيها جمالا؟ لقد جاء العرب مصر وتحدثوا بجمال نيلها وأرضها وسمائها ولم يروا في الأهرام ألا شيئا قد يحوي نقودا مخبوءة، أما بناؤه فشيء لا يحسب في الفن. إنما الحسن عند العرب حسن الهيئة قبل كل شيء. المساجد كالعرائس تكاد تخطر حسنا بزخارفها، زينة للناظرين. بغير هذا فلا عمارة ولا فن. الشعر رنين لذيذ، وخيال جميل، ومعان لطيفة، وألفاظ مختارة ظريفة، بغير هذا فلا شعر ولا فن. الجمال عند العرب جمال إنساني. والفن عندهم شيء صنعه الإنسان لنفسه وللذته. الفن العربي القديم فن إنساني دنيوي. والفن المصري القديم فن إلهي ديني. لهذا اختلفت المقاييس في الجمال بين الفنين. أحدهما يعنى بالتناسق الذي يروق الإنسان، والثاني يعنى بالتناسق الخفي بغير التفات إلى الإنسان. ولعل المقياس العربي القديم هو في مصر المنفرد حتى اليوم بالحكم في قضايا الشعر والأدب. ولعل اقرب مثل إلى الذاكرة ذلك الحكم الذي أصدره الدكتور على بيت للأستاذ العقاد:
هي كأس من كؤوس الخالدين ... لم يشبها المزج من ماء وطين
ألم يكن مقياس الدكتور في التقدير ذلك الذوق الحسي وذلك المنطق الخارجي الذي يربط الألفاظ، فوجد اتصالا غير متسق بين الكؤوس والطين سمع له شيئاً كالطنين يشوب صفاء الرنين؟ هذا المقياس العربي ذو الإبرة الدقيقة عجيب في تسجيل كل انحراف عن منطق الألفاظ. إنما هنالك في اعتقادي منطق آخر مستتر أمره يعنى المقياس المصري. ترى لو أن الدكتور رجع إليه أما كان يحكم لبيت العقاد لا عليه؟ أما كان يرى فيه تناسقا داخليا محكما هو كل ما عنى بأدائه الشاعر؟ إني يوم قلت بمزج الروح بالمادة في آدابنا. كان يجب على أيضاً أن أقول بوضع المقياس المصري في النقد بجانب المقياس العربي. وبعد، فإني ولا ريب قد استأثرت منك ومن وقتك مقدار لاحق لي فيه. غير أنى لولاك ما وضعت أفكاري في رسائل. إنما أنا اكتب لك. أي ضمان أنت في الشرق لحياة الفكر والبيان! وهل أستطيع أن أنسى ما كنت لي وما تكون؟ إني أضع بين يديك كل إخلاص؟
كوم حمادة في 14 سبتمبر سنة 1933. توفيق الحكيم
********************
توفيق الحكيم
عزيزي الدكتور طه حسين
يظهر أني سييء الحظ معك، أو أنك سييء الحظ معي هذا الاسبوع فلقد قرأت مقالك عن شهرزاد، وما احسبنا تلاقينا فيه عند رأي، فأما قولك اني أدخلت في الأدب العربي فنا جديدا وأتيت بحدث لم يسبقني اليه أحد، فهذا اسراف سبق لي أن أشرت اليه في خطاب مني اليك عن أدب الجاحظ ذكرت فيه يومئذ أن للجاحظ ملكة في انشاء الحوار تذكرنا ببعض كتاب المسرح من الغربيين. فما أنا اذن بمبتدع وانما أنا أحد السائرين في طريق شقه الشرق من قبل. وأما نصيب قصصي من البقاء فلست أعتقد أن لناقد معاصر حق الجزم به، وما بلغت من البساطة حد تصديق ناقد يتكلم في هذا، فإن الزمن وحده، هو الكفيل بالحكم للأعمال بالبقاء. فأنا كما تري لا أسمح لنفسي بقبول مثل هذا الثناء، كذلك لست أسمح لأحد أن يخاطبني بلسان التشجيع. فما أنا في حاجة الي ذلك. فإني منذ أمد بعيد أعرف ما أصنع. ولقد أنفقت الأعوام أراجع ما أكتب قبل أن أنشر وأذيع. كما أني لست في حاجة الي أن يملي علي ناقد قراءة بعينها، فإني منذ زمن طويل أعرف ماذا أقرأ. وما اخالك تجهل أني قرأت في الفلسفة القديمة والحديثة وحدها ما لا يقل عما قرأت أنت. وما أحسبك كذلك تجهل أني أعرف الناس بما عندي من نقص وأعلم الناس بما أحتاج اليه من أدوات. فأرجو منك أن تصحح موقفي أمام الناس وألا تضطرني الي أن أتولي ذلك بنفسي.
وتقبل أطيب التحيات من المخلص
توفيق الحكيم
*******************

يا دكتور
يعنيك طبعاً أن تعلم كيف يرى الجيل الجديد عملك وعمل أصحابك، إن رسالتي إليك ليست حكماً يصدره الجيل الجديد، إنما هي تفسير لذلك العمل، لك أن تقره ولك أن تنكره. لا ريب إن العقلية المصرية قد تغيرت اليوم تحت عصاك السحرية، كيف تغيرت؟ هذا هو موضوع الكلام، إن شئون الفكر في مصر حتى قبل ظهور جيلك كانت قاصرة على المحاكاة والتقليد، محاكاة التفكير العربي وتقليده، كنا في شبه إغماء، لا شعور لنا بالذات، لا نرى أنفسنا ولكن نرى العرب الغابرين، لا نحس بوجودناولكن نحس بوجودهم هم، لم تكن كلمة (أنا) معروفة للعقل المصري. لم تكن فكرة الشخصية المصرية قد ولدت بعد. رجل واحد لمعت في نفسه تلك الفكرة فأضاء لكم الطريق: (لطفي بك السيد)، وسرتم ركضاً حتى بلغتم اليوم هذه الغاية، وإذا الجيل الجديد أمام روح جديدة وأمام عمل جديد. لم يعد الأدب مجرد تقليد أو مجرد استمرار للأدب العربي القديم في روحه وشكله، وإنما هو إبداع وخلق لم يعرفهما العرب. وبدت الذاتية المصرية واضحة لا في روح الكتابة وحدها بل في الأسلوب واللغة أيضاً، من ذا يستطيع أن يرد أسلوب طه حسين إلى أصل عربي قديم؟ بون شاسع بين الأمس واليوم. حتى أمس القريب كانت مقامات الحريري ورسائل عبد الحميد وبديع الزمان مثلاً تحتذي في كتابات حفني ناصف والمويلحي وغيرهما ممن رسفوا في أغلال التقليد راضين أو مرغمين. لقد بدأنا نعي ونحس بوجودنا، وأول مظاهر الوعي شخصية الأسلوب واستقلال طريقة التعبير وما يتبعها من ألفاظ وأخيلة، بهذا يبشر صاحبكم احمد أمين اليوم، ويصيح في هذا الجيل كي ينظر فيما حوله ويعبر عما يراه بخياله هو لا بخيال العرب. كل هذا جلي معروف، ولم أبعث برسالتي من أجله، حاجة مصر إلى الاستقلال الفكري أمر لا نزاع اليوم فيه، وعملك أنت وأصحابك لهذا الاستقلال أمر لا نزاع فيه أيضاً. ولقد مضى كلامكم في هذا، إنما الأمر الذي يحتاج إلى كلام هو معرفة مميزات الفكر المصري. معرفة أنفسنا: حتى تتبين لجيلنا مهمته. هذه هي المسألة، لقد فهمنا عنكم مميزات الأسلوب والشكل، وما فهمنا بعد جيداً مميزات النفس والروح، ما هي مميزات العقلية المصرية في الماضي والحاضر والمستقبل؟ ما روح مصر؟ ما مصر؟ إن اختلاطنا بالروح العربية هذا الاختلاط العجيب كاد ينسينا إن لنا روحاً خاصة تنبض نبضات ضعيفة تثقل تحت ثقل تلك الروح الأخرى الغالبة. وإن أول واجب عليكم لنا استخراج أحد العنصرين من الآخر. حتى إذا ما تم تمييز الروحين إحداهما من الأخرى كان لنا أن نأخذ أحسن ما عندهما، وكان لكم أن تقولوا لنا: (ها نحن أولاء أنرنا لكم الطريق إلى أنفسكم فسيروا) لا بد لنا إذن أن نعرف ما المصري وما العربي؟ هذا السؤال ألقيته على نفسي منذ ست سنوات إذ كنت ادرس الفنين المصري والإغريقي. وكانت المسالة عندي وقتئذ: ما المصري وما الإغريقي؟ وأذكر أني أثرت هذه المسألة أمام بعض أصدقائي في حي (مونبارناس)، أذكر أني لخصت لهم الفرق بين العقليتين بمثل واحد في فن النحت سائلاً: ما بال تماثيل الآدميين عند المصريين مستورة الأجساد وعند الإغريق عارية الأجساد؟ هذه الملاحظة الصغيرة تطوي تحتها الفرق كله، نعم كل شيء مستتر خفي عند المصريين، وعار جلي عند الإغريق، كل شيء في مصر خفي كالروح، وكل شيء عند الإغريق عار كالمادة. كل شيء عند المصريين مستتر كالنفس، وكل شيء عند الإغريق جلي كالمنطق. في مصر الروح والنفس، وفي اليونان المادة والعقل. نظرةٌ أخرى في أسلوب النحت تدعم هذا الكلام. أن المثّال المصري لا يعنيه جمال الجسد ولا جمال الطبيعة من حيث هي شكل ظاهر، إنما تعنيه الفكرة، انه يستنطق الحجر كلاماً وأفكاراً وعقائد. على انه يشعر مع ذلك بالتناسق الداخلي، يشعر بالقوانين المستترة التي تسيطر على الأشكال، يشعر بالهندسة غير المنظورة التي تربط كل شيء بكل شيء، يشعر بالكل في الجزء، وبالجزء في الكل، وتلك أولى علامات الوعي في الخلق والبناء؛ هذا كله يحسه الفنان المصري لأن له بصيرة غريزية أو مدبرة تنفذ إلى ما وراء الأشكال الظاهرة لتحيط بقوانينها المستترة، فنان عجيب لا يصرفه الجمال الظاهر للأشياء عن الجمال الباطن. إنه يريد أن يصور روح الأشكال لا أجسامها، وما روح الشكل إلا القانون العام الأعلى المستتر خلفه؛ إن ولع المصريين بالقوانين الخفية لشيء يبلغ حد المرض، مرض إلهي، لو أن الآلهة تمرض لكان هذا مرضها: فرط البحث عن القانون! كل شئ في مصر إلهي، لأن مصر التي منحتها الطبيعة الخير واليسر وسهولة العيش وكفتها مشقة الإجهاد في سبيل المادة استلقت منذ الأزل تتأمل ما وراء المادة. . حظها في هذا حظ الهند: أمة كثيرة الخير كذلك دانية القطوف لا حاجة بها إلى الكفاح ولا عمل لها إلا استمراء ترف الحكمة العليا، انقطعت هي أيضاً من قديم تحت أشجارها المقدسة تبحث عما وراء الحقيقة.
مصر والهند حضارتان قامتا على الروح لأنهما قد شبعتا من المادة، الإغريق على النقيض، أمة لم تشبع من المادة، أمة نشأت في العسر والفاقة، أرضها لا تدر من الخير إلا قليلا، كان لزاماً عليها الكفاح في سبيل العيش، وكان حتماً عليها الجري وراء المادة، حرب تلو حرب، وفتح بعد فتح، وضرب في مشارق الأرض ومغاربها، على هذا النحو لم يكن للإغريق ذلك الضمير المطمئن ولا ذلك الشعور بالاستقرار، ولا ذلك الإيمان بالأرض الذي يوحي بالتفكير فيما وراء الأرض والحياة، إن عاطفة الاستقرار والإيمان ممزوجة بالدم عند المصريين، لأن المصريين نزلوا من بطن الأزل إلى أرض مصر، لا يعرف لهم نسب آخر على وجه التحقيق، واختلاف العلماء في أمر أصلهم لم ينته بعد، وفي كل يوم يبدو دليل على أن العمران والاستقرار وجدا في مصر قبل التاريخ المعروف، ولقد ظهرت الحضارة المصرية في التاريخ تامة كاملة دفعة واحدة، كما يظهر قرص الشمس في الأفق عند الشروق، ولقد قال سولون: إن الكهنة المصريين يعنون العناية كلها بذكريات تلك القارة العظيمة ذات المدنية الزاهرة التي أبتلعها المحيط قبل مبدأ التواريخ: (قارة الأتلانتيد). أترى كانت الحضارة المصرية استمراراً لتلك المدنية المندثرة؟. . . لم يقم دليل، على كل فرض. مصر أمة مستقرة مؤمنة زهدها عمرها الطويل وخيرها الكثير في مباذل الحياة، وهذا الزهد والتفكير فيما وراء الحياة ظهر أثرهما على وجه الفن المصري، ولا شيءيدل على عواطف أمة وعلى عقليتها مثل فنها. فلقد طالع العالم الحديث على وجه الفن المصري الصرامة والجد والعمق ولا أكاد أفتح كتاباً في الفن المصري حتى أجد كلمة (الصرامة) نعتاً من نعوت هذا الفن، ولا أفتح كتاباً في الفن الإغريقي إلا وجدت كلمة (الحياة) وكلمة (الإنسانية) من نعوت هذا الفن، نعم. الحياة هي كل شيء عند الإغريق، قد يدفعهما حب البحث إلى لمس حدود الحياة الأخرى فيلمسونها بالعقل والمنطق لا بالقلب والروح. فلسفتهم فلسفة العقل والمنطق والحياة، فلسفة الحركة لا فلسفة السكون، عند مصر والهند السكون، عند الإغريق الحركة، قرأت حديثاً (المقبرة البحرية) لـ (بول فاليري) وهو المتصل اتصالاً مباشراً بالفلسفة اليونانية. فإذا هو يشير في القصيدة إلى الحركة والسكون، وإذا الحركة عنده من خصائص الكينونة الواعية الفانية، والسكون من خصائص العدم الخالد غير الواعي، وهو يعارض زينون الألياتي في إنكاره للحركة ويتغنى في آخر القصيدة بانتصار الحركة على قصرها وفنائها، فهو في ذلك لم يخرج عن يونانيته المكتسبة. ولم يفهم في رأيي روح مصر والهند، ولم يشرف على ذلك العالم الخالد غير الواعي، كان دون هذا الإشراف والاتصال والتجرد التام من كل عقل آدمي أو منطق بشري، هذه هي الصعوبة في فهم مصر والهند، وهذا ما جعل الفن المصري سراً مغلقاً حتى أوائل هذا القرن، وما صرف الناس إلى دراسة اليونان وحدها، فهي واضحة المعنى يسيرة المنال. لأنها لزمت شاطئ الحياة.
حظ الإغريق في كل هذا حظ العرب. العرب أيضاً أمة نشأت في فقر لم تعرفه أمة غيرها، صحراء قفراء، قليل من الماء يثير الحرب والدماء، جهاد وكفاح لا ينقطعان في سبيل العيش والحياة، أمة لاقت الحرمان وجهاً لوجه، وما عرفت طيب الثمار وجري الأنهار ورغد العيش ومعنى اللذة إلا في السير والأخبار، كان حتماً عليها ألا تحس المثل الأعلى في غير الحياة الهنيئة، والجنات الخضراء، والماء الجاري، وألوان النعيم واللذائذ التي لا تنضب ولا تنتهي، أمة بأسرها حلمت بلذة الحياة ولذة الشبع، فأعطاها ربها اللذة ومنحها الشبع. كل تفكير العرب وكل فن العرب في لذة الحس والمادة، لذة سريعة منهومة مختطفة اختطافاً، لأن كل شيْ عند العرب سرعة ونهب واختطاف، عند الإغريق الحركة، أي الحياة، وعند العرب السرعة، أي اللذة، لم تفتح أمة العالم بأسرع من العرب، ومر العرب بحضارات مختلفة فاختطفوا من أطايبها اختطافاً ركضاً على ظهور الجياد، كل شيء قد يحسونه إلا عاطفة الاستقرار. وكيف يعرفون الاستقرار وليس لهم أرض ولا ماضٍ ولا عمران! دولة أنشأتها الظروف ولم تنشئها الأرض، وحيث لا أرض فلا استقرار، وحيث لا أستقرار فلا تأمل، وحيث لا تأمل فلا ميثولوجيا ولا خيال واسع ولا تفكير عميق ولا إحساس بالبناء، لهذا السبب لم تعرف العرب البناء، سواء في العمارة أو الأدب أو النقد، الأسلوب العربي في العمارة من أوهى أساليب العمارة التي عرفها تاريخ الفن، وإذا عاش لليوم فإنما يعيش بالزخرف، فن الزخرف العربي أنقذ العمارة العربية، إن العمارة العربية ـ إلا في مصر ـ ما هي في رأيي سوى زخرف لا بناء، فلا أعمدة هائلة ولا جبهة عريضة ولا وقفة قوية ولا بساطة عظيمة ولا روعة عميقة، إنما هي وشي كثير وجمال كجمال الحلي المرصع يهز البصر ولا فكر خلفه. أما فن الزخرف العربي فهو في الحق أجمل وأعجب فن للزخرف خلده التاريخ. والزخرف عند العرب وليد ذلك الحلم باللذة والترف، كل شيء عند العرب زخرف. الأدب نثر وشعر لا يقوم على البناء، فلا ملاحم ولا قصص ولا تمثيل، إنما هو وشي مرصع جميل يلذ الحس، فسيفساء اللفظ والمعنى، و (آرابسك) العبارات والجمل. كل مقامة للحريري كأنها باب جامع المؤيد، تقطيع هندسي بديع. وتطعيم بالذهب والفضة لا يكاد الإنسان يقف عليه حتى يترنح مأخوذاً بالبهرج الخلاب، كذلك الغناء العربي (آرابسك) صوتي، فلا مجموعة أصوات متسقة البناء كما في (الديتيرامب) أو (الأوركسترا) الإغريقية أو كما في (الكورس) الجنائزي المصري، ولا حتى مجرد صوت ينطلق حراً بسيطاً مستقيما. إنما هو صوت محمل بألوان المحسنات من تعاريج وانحناءات والتواءات وتقاسيم كأنها (ستالاكتيتات) غرناطية، لا يكاد يسمعه (القاضي الفاضل) حتى يستخفه الطرب ويضع نعله فوق رأسه؛ كان هذا في العهد الأول للموسيقى إذ كانت عند جميع الشعوب بسيطة عارية تخرج من القلب تعبيراً عما في القلب، أو رمزاً لفكرة من الأفكار. والموسيقى كالعمارة من الفنون الرمزية لا الشكلية، ولكن العرب لا يحبون الرموز، ولا طاقة لهم بالفن الرمزي، ولا يردون إلّا التعبير المباشر بغير رموز، وإلا الصلة المباشرة بالحس، فجعلوا من الموسيقى لذة للأذن لا أكثر ولا أقل، ولقد حاول الفارابي فيما أذكر التقريب بين الموسيقى العربية والموسيقى الإغريقية، وكان لا بد له من الإخفاق لأسباب قد أذكرها بعد، كذلك التصوير العربي على جماله ودقته ليس إلا مجرد تزيين وزخرف للكتب والمخطوطات لم يؤَدِ لغير تلك الغاية (المنياتور) الفارسي. قد يكون للدين دخل في تأخر النحت والتصوير عند العرب، غير أني أعتقد براءة الدين. أن العرب كانوا دائماً ضد الدين كلما وقف الدين دون رغبات طبائعهم، لقد حرم الدين الشراب، فأحلوا هم الشراب في قصور الخلفاء، وما وصفت الخمر ولا مجالس الخمر في أدب أمة بأحسن مما وصفت في الأدب العربي، لا شيء في الأرض ولا في السماء يستطيع أن يحول بينهم وبين اللذة، أما النحت أو التصوير الكبير فليس في طبيعتهم، لأن تلك فنون تتطلب فيمن يزاولها إحساساً عميقاً بالتناسق العام مبناه التأمل الطويل والوعي الداخلي للكل في الجزء وللجزء في الكل، وليس هذا عند العرب، فهم لا يرون إلا الجزء المنفصل وهم يستمتعون بكل جزء على انفراد، لا حاجة لهم بالبناء الكامل المتسق في الأدب، لأنهم لا يحتاجون إلا للذة الجزء واللحظة، قليل من الكتب العربية في الأدب تقوم على موضوع واحد متصل، إنما أكثر الكتب كشاكيل في شتى الموضوعات تأخذ من كل شيء بطرف سريع: من حكمة وأخلاق ودين ولهو وشعر ونثر ومأكل ومشرب وفوائد طبية ولذة جسدية، وحتى إذ يترجمون عن غيرهم يسقطون كل أدب قائم على البناء، فلم ينقلوا ملحمة واحدة ولا تراجيديا واحدة ولا قصة واحدة، العقلية العربية لا تشعر بالوحدة الفنية في العمل الفني الكبير، لأنها تتعجل اللذة، يكفيها بيت شعر واحد أو حكمة واحدة أو نغم واحد أو زخرف واحد لتمتلئ طرباً وإعجاباً، لهذا كله قصر العرب وظيفة الفن على ما نرى من الترف الدنيوي وإشباع لذات الحس، حتى الحكمة، وشعراء الحكمة كانوا يؤدون عين الوظيفة: إشباع لذة المنطق، والمنطق جمال دنيوي ولا استغرب غضب نيتشه على إيروبيد لإسرافه في هذا المنطق على حساب الموسيقى، ومن المستحيل أن نرى في الحضارة العربية كلها أي ميل لشؤون الروح والفكر بالمعنى الذي تفهمه مصر والهند من كلمتي الروح والفكر. إن العرب أمة عجيبة، تحقق حلمها في هذه الحياة، فتتشبث به تشبث المحروم، وأبت إلا أن تروي ظمأها من الحياة وأن تعب من لذتها عباً قبل أن يزول الحلم وتعود إلى شقاوة الصحراء، وقد كان. إن موضع الحضارة العربية من (سانفونية) البشر كموضع الـ (سكِيْرتزو) من سانفونية بيتهوفن: نغم سريع مفرح لذيذ!!
لا ريب عندي أن مصر والعرب طرفا نقيض: مصر هي الروح، هي السكون، هي الاستقرار، هي البناء، والعرب هي المادة، هي السرعة، هي الظعن، هي الزخرف!
مقابلة عجيبة: مصر والعرب وجها الدرهم، وعنصرا الوجود، أي أدب عظيم يخرج من هذا التلقيح! إني أؤمن بما أقول يا دكتور. وأتمنى للأدب المصري الحديث هذا المصير: زواج الروح بالمادة، والسكون بالحركة، والاستقرار بالقلق، والبناء بالزخرف! تلك ينابيع فكر كامل ومدنية متزنة لم تعرف البشرية لها من نظير، إن أكثر المدنيات تميل إما إلى ناحية الروح وإما إلى ناحية المادة.
حضارة واحدة قيل أنها استطاعت في وقت ما هذا المزج بين الروح والمادة وهذا الاتزان بين عنصري الوجود، تلك حضارة الإغريق. نعم أعود فأرد إلى أمة الإغريق اعتبارها، وأعترف أني عندما وضعتها في كفة المادة كنت متأثراً بكلام (تين) فضللت السبيل. (تين) عقل خلاب لكنه عقل. والعقل وحده بعيد عن فهم الجانب الروحي للمدنيات. ما هداني إلى الحق إلا القلب. . . ألا طول تأملي في جبهة (البارتينون). من دماغ ذلك الجواد الذي خلقته يد (فيدياس) فوق هذا المعبد خرجت أفكار توحي إلي بأن أولئك القوم كانوا أعمق مما نظن، وكانوا يشعرون بشيء آخر غير مجرد المادة الظاهرة، وما لبثت (ميلبومين) أن جاءتني ببينة أخرى، وتأملت قليلاً فرأيت القناع قد كشف. ذكرت أن أصل الإغريق جنسان مختلفان: اليونان القادمون من آسيا المعروفون عند الهنود باسم (اليافاناس) أي عباد (يونا) والدوريون الحربيون البرابرة الهابطون من الشمال، اله اليونانيين: (ديونيزوس) إله الدوريين (أبولون). وهاهنا تفسير الإغريق: في هذا الصراع بين ديونيزوس رمز الروح والقوى الشائعة والنشوة. . . وبين أبولون رمز الفردية والشخصية الفارزة والوعي، الصراع بين الروح والمادة، وبين القلب والعقل، وبين النشوة والوعي، ديونيزوس إله آسيوي فيما يخيل إلي، جلب من الهند بالأمراء. فغدا في اليونان ينبوع الموسيقى، لهذا السبب قدرت إخفاق الفارابي، أن الموسيقى العربية وليدة عقل واع، لأن العرب أمة الفردية والوعي والمنطق العقلي والظاهر المحسوس، إن العرب من عباد أبولون وهم لا يشعرون. إن العرب لا يمكن أن يفهموا ديونيزوس ولا نشوة ديونيزوس. تلك النشوة الدينية الجارفة التي تخرج صاحبها من سيطرة العقل والوعي كي تصله مباشرة بالطبيعة. إن أغاني عباد (باكوس) الحماسية في الغابات ومزامير الـ (ساتير) لشيء بعيد إدراكه على العقلية الفردية، شعور الإنسان في لحظة أنه انقلب مخلوقا له جسم جواد ورأس رجل أو أرجل ماعز. هذا الاتحاد بين الحيوان والإنسان إحساس ليس له مثيل إلا عند المصريين القدماء، وهذا التلاقي بين الأنواع وبين القوى في مخلوق واحد لهو عند الأولين بقية ذكرى تلك المحلوقات الإلهية البائدة التي كانت تحكم الأرض قبل ظهور الإنسان. . . مخلوقات لا هي من الإناث ولا هي من الذكور، ولا هي من الحيوان، ولا هي من الإنسان، لأن الأجناس والفصائل لم تكن قد فرزت. كذلك (الساتير) في الميثولوجيا الإغريقية رمز الإنسان الأول، ذلك الإنسان الداني من الحيوان القريب من الآلهة، يدنو من الحيوان بغريزته الجنسية المتيقظة ينبوع القوة الخالقة عند الإغريق كما هي عند المصريين، ويقرب من الآلهة بغريزته الروحية المتصلة بقوى الطبيعة الإلهية، فهو ما زال يحتفظ بقبس من الحكمة العليا بدون أن يشعر، وببريق من ذلك النور الروحي والإلهام الذاتي يرى به كتلة الزمن من ماضي وحاضر ومستقبل في شبه لمحة واحدة.
تلك القدرة الخفية هي حاسة بائدة كانت للإنسان الأول، وفقدناها اليوم، نعم فقدنا كل القوى الروحية التي منحتنا إياها الطبيعة يوم كنا نحبها ونتصل بها، ولم يبقى لنا اليوم إلا العقل المحدود والمنطق القاصر. وها نحن اليوم في هذا الكون الهائل مخلوقات منفردة منبوذة! أين ذهب ديونيزوس؟ وهل يبعث من جديد؟ وإذا بعث فهل يجد من يعرفه في هذا العصر ذي الحضارة المادية الفردية؟!
رجل واحد ما زال يذكر هذا الإله ويستطيع أن يعرفه إذا ظهر كل عرف غالياس أصحاب الكهف!! وهو وحده كذلك الذي يستطيع أن يستقبله باسم هذا العصر، هذا الغالياس العصري هو: (تاجور) انه يتكلم كثيراً عن ذلك الاتحاد بين الإنسان والطبيعة. وعن ذلك الفاصل المرفوع بين الحياة الخاصة والحياة العظمى التي تخترق الكون. وعن ذلك الحب بين الإنسان والجماد. هذا كلام جميل. لكن هل تراه يشعر بحقيقته؟ يخيل إلي أن تلك الحقائق قد انطوت بانقضاء دولة الإغريق. بل لقد انقضت قبل أن تنقضي دولة الإغريق. انقضت بطغيان منطق سقراط على روح هوميروس. انقضت بطرد ديونيزوس من تراجيديات ايروبيد (غضبة نيتشه المعروفة) انقضت بظهور براكسيتيل على فيدياس، انقضت بغلبة الإحساس العقلي على الإحساس الروحي، انقضت بانتصار (أبولون) في النهاية على (ديونيزوس). وهكذا اختل التوازن، ورجحت كفة المادة، وانطفأت الحضارة الإغريقية إلى الأبد. ولم ترث أوربا منها غير كنوز العقل والمنطق، وبقيت في الظلام كنوز ديونيزوس الخفية.
لم تنجح اليونان إذن النجاح المطلوب في تطعيم الروح بالمادة، فهل تأمل مصر بلوغ هذه الغاية يوماً؟ أرجو من الدكتور أن يجيب، أنت وأصحابك ومدرستك قد فرغتم من تصوير وجه الأدب المصري، ولم يبقى إلا صبغه باللون الخاص، وطبعه بالروح الخاصة، فما هو هذا اللون؟ وما هي هذه الروح؟ إن ردك على هذا السؤال نور يلقي على طريق الجيل الجديد.
******
رسالة من طه حسين إلى توفيق الحكيم
15- 06 - 1933
سيدي الأستاذ
لست أدري أيعنيني حقا ويعني أصحابي، أن نعرف رأي الجيل الجديد في جهدنا الأدبي وما أحدثنا من أثر في حياتنا الأدبية الجديدة. لأن العلم الصحيح برأي المعاصرين لا سبيل له، أو لا تكاد توجد السبيل التي توصل إليه. أو قل أن هذا الجيل الجديد نفسه قد يشق عليه جدا أن يصور لنفسه فينا رأياً صحيحاً مستقيماً بريئاً من هذه العواطف الحادة الجامحة التي تسيطر على نفوس الشباب، وتؤثر أشد التأثير فيما يكونون لأنفسهم من آراء في الكتاب والشعراء المعاصرين. فهم بين معجب يدفعه الإعجاب إلى الإغراق في الثناء، وبين ساخط يدفعه السخط إلى الإغراق في الذم. وأكاد أعتقد أن ليس من اليسير لكاتب أو شاعر أن يعرف رأي الناس فيه حقا، لأن هذا الرأي لا يظهرواضحا جليا بريئا من تأثير العواطف والأهواء والظروف، إلاحين يصبح الكاتب أو الشاعر وديعة في ذمة التاريخ. ومع ذلك فأنا أشكر لك أجمل الشكر رأيك في أصحابي وفيّ، وثناءك على أصحابي وعليّ ويسرهم كما يسرني أن يكون رأيك فينا صحيحاً، وأن يكون ثناؤك علينا خالصاً من الإسراف في الحب الذي يدعو إلى الإسراف في التقدير.
لقد قرأت كتابك الممتع فترك في نفسي آثارا مختلفة، ولكن أظهرها الإعجاب بهذا التفكير المستقيم العميق، وهذا الاطلاع الواسع الغني، وهذا الاتجاه الخصب إلى تعرف الروح الأدبي لمصر في حياتها الماضية والحاضرة والمستقبلة. وقد دفعني إعجابي بكتابك القيّم إلى ألاّ أختص به نفسي فآثرت به قرّاء الرسالة وأذعته فيهم. وأنا واثق بأنهم قد رأوا فيه مثل ما رأيت وحمدوا منه مثل ما حمدت، وأثنوا عليك بمثل ما أثنيت، وهموا أن يناقشوا بعض ما جاء فيه من الآراء كما أريد أنا الآن أن أناقشها. ولست أدري أيقف أمر كتابك هذا عند إذاعته في الرسالة وردي عليه، أو يتجاوزهما إلى مناقشة طويلة عريضة، يشترك فيها كتاب مختلفون ونقاد كثيرون. فكتابك خليق بهذه المناقشة لأن أسلوب التفكير فيه جديد قيّم، ومهما أفعل فلن أستطيع أن أتناول كل ما أشعر بالحاجة إلى تناوله بالنقد والتمحيص من آرائك الكثيرة المتباينة التي أفعمت بها كتابك إفعاماً. ولكني أقف عند طائفة قليلة من هذه الآراء، لا أستطيع أن أدعها تمضي من غير نقد ولا تعليق.
وأول ما أقف عنده من هذه الآراء رأيك فيما تسميه شؤون الفكر في مصر، قبل الجيل الذي نشأنا فيه، فقد ترى أن هذه الشؤون كانت كلها محاكاة وتقليداً وتأثراً للعرب، واحتذاءً خالصا لمثلهم الأدبية، حتى جاء الأستاذ لطفي السيد ففتح لنا طريق الاستقلال الأدبي. وفي رأيك هذا شيء من الحق، لكن فيه شيئا من الإسراف غير قليل، فلست أعتقد أن الشخصية المصرية محيت من الأدب المصري محواً تاماً في يوم من الأيام، ولست أعتقد أن كلمة أنا لم يكن لها مدلول في لغة المصريين، ولست أعتقد أن المصريين كانوا في شبه إغماء حتى أقبل هذا الجيل الذي تتحدث عنه، فرد عليهم الحياة والنشاط. كل ما يمكن أن يصح لك هو أن الشخصية المصرية في الأدب كانت ذاوية ذابلة إلى حد بعيد في وقت من الأوقات لعلّه يبتدئ بآخر عصر المماليك. ولكن هذه الشخصية على ذبولها وفتورها لم تمت ولم تمح، بل ظلت حية تتردد أشعتها الضئيلة في آثار الكتاب والشعراء والعلماء، إلى أن كان العصر الحديث. ويكفي أن تقرأ الأدب المصري في أيام المماليك وقبل أيام المماليك، لتعلم أنّ شخصيتنا الأدبية كانت قوية منتجة، وكانت جذابة خلاّبة في كل فرع من فروع حياتنا المعنوية. كانت في الشعر بنوع خاص أقوى منها في هذه الأيام، وأقرأ ديوان البهاء زهير فستجد صورتك فيه واضحة، وستجد نفسك فيه ظاهرة، وستجد عواطفك فيه ممثلة، وستجد هذا كله أشد جلاء وقوة عند هذا الشاعر القديم منه عند شعرائنا المعاصرين. والأمر ليس مقصورا على هذا الشاعر، بل هو شائع في شعرائنا جميعا قبل فتح الترك لمصر. وهو كذلك شائع في كتّابنا وعلمائنا، ولو قد كانت شخصيتنا ضعيفة فانية وفاترة واهية، لما أتيح لنا أن نؤدي الحضارة الإسلامية ونحفظها من الضياع حين أخذ التتار والأوروبيون عليها أقطار الشرق والغرب. ولم تكن هذه الشخصية في عصور الضعف والوهن خفية ولا غامضة، فأنت تجدها واضحة في شعر هؤلاء الشعراء المتأخرين الذين عاشوا في أول القرن الماضي وفي أثنائه، والذين لا نحب شعرهم ولا نطيل النظر فيه، والذين يخيل إلينا انهم كانوا يقلّدون فيسرفون في التقليد، ولكنهم برغم هذا التقليد الشديد لم يستطيعوا أن يمحوا مصريتهم ولا أن يخفوها. ولست أستطيع أن أضرب لك الأمثال هنا فذلك شيء لا ينتهي، ولكني أؤكد لك أن حكمك على هذه الشخصية المصرية في الأدب محتاج إلى التصحيح، وأنت قادر على هذا التصحيح، إن قرأت أدبنا المصري كما تقرأ الأدب الغربي وكما تقرأ الأدب العربي القديم، ستجد فيه تقليداً، وستجد فيه بديعاً كثيراً، ولكنك ستجد فيه نزعة مصرية واضحة تحسّها حيثما ذهبت، وأينما وجهت من أرض مصر، وتجدها عند المصريين المعاصرين الذين لم تخرّجهم الثقافة الأوروبية عن أطوارهم المألوفة، في الشعور والتفكير وفي النظر إلى الحياة والتأثر بها والحكم عليها. هذه النزعة صوفية بعض الشيء، فيها مزاج معتدل من الإذعان للقضاء والابتسام للحوادث، وفيها مزاج معتدل من حزن ليس شديد الظلمة، ولا مسرفاً في العمق، ومن سخرية ليست عنيفة ولا شديدة اللذع ولكنها على ذلك بالغة مقنعة، تمضي في كثير من الأحيان، ولعلك تجد هذه النزعة نفسها قريبا جداً منك. لعلك تجدها في أهل الكهف. فجيلنا إذن لم يحدث شخصية مصرية لم تكن، وإنما جلا هذه الشخصية وأزال عنها الحجب والأستار، وجيلنا لم يمنحها الحياة، وإنما منحها النشاط، وزاد حظها من الاستقلال وغيّر وجهتها، فلفتها إلى الأمام بعد أن كانت تصر على الالتفات إلى وراء، وليس هذا بالشيء القليل. وأنا معجب بآرائك في الفن المصري، وفي الفن الإغريقي، ولكني لا أحب لك هذا الإسراع إلى استخلاص الأحكام العامة، وإقامة القواعد التي لا تثبت للنقد والتمحيص. وآية ذلك أنك أنت نفسك قد أحسست بعض هذا الإسراع فأصلحته حين قضيت على اليونان في أول الكتاب ثم قضيت لهم في آخره. وستر أنك أسرعت في الأولى وأسرعت في الثانية، وكنت خليقا أن تصطنع الأناة فيهما جميعا. فليس من الحق أن اليونان كانوا أصحاب مادة ليس غير، وليس من الحق أن روحية اليونان هذه التي أنكرتها في أول الكتاب، وعرفتها في آخره قد جاءتهم من إلههم ديونيزوس وحده. فحظ اليونان من الروحية قديم تجده بيّنا في شعرهم القصصي في الإلياذة والأوديسا قبل أن تظهر فيهم الآثار العنيفة لدين ديونيزوس، وأنت تعلم أن ظهور هذا الإله عند اليونان متأخر العصر، وأنه في أكبر الظن اله أجنبي جاءهم من تراقيا، وأنه لم يعطهم هذه الحياة الروحية العليا، التي نجدها عند سقراط وعند تلاميذه، وعند أفلاطون بنوع خاص، وإنما أعطاهم حياة روحية أخرى كلّها تصوف وكلّها طموح إلى عالم مجهول مختلط تحيط به الأسرار والألغاز، وتعبّر عنه الرموز والكنايات. وكان هذا النوع من الروحية ذا مظهرين مختلفين، أحدهما شائع مشترك، يساهم فيه الشعب كله، وأهل الريف منهم خاصة، والآخر مقصور على طائفة معينة، هي هذه التي تتعلم الأسرار وتشترك في إقامتها وإحيائها. فكان دين ديونيزوس أشبه شيء بطرق الصوفية عندنا، علمها الصحيح مقصور على خاصة المتصوفة، ونشاطها العملي الغليظ شائع في أفراد الشعب جميعاً. وقد كان أثر ديونيزوس في الأدب اليوناني قوياً عميقاً. وحسبك إنه إله التمثيل، ولكن روحية اليونان الخصبة حقاً، الممتازة حقاً، التي أزعم معتذراً إليك إنك لا تستطيع أن تجد لها شبيهاً ولا مقارباً في مصر الروحية. هذه الروحية اليونانية تجدها واضحة جلية، عذبة ساحرة عند فلاسفة اليونان من تلاميذ سقراط، وعند أفلاطون بنوع خاص. ستقول كما قال كثيرون من قبل: إن أفلاطون قد زار مصر، وأخذ منها. ولست أنكر روحية مصر، ولكني لا أعرف عنها شيئاً كثيراً، ولعلي مدين لليونان بما أعرفه من الروحية المصرية. ومهما يكن من شئ فأنت توافقني على أن اليونان لم يكونوا أصحاب مادة فحسب، ولم تأتهم روحيتهم من ديونيزوس وحده، وإنما اليونان مزاج معتدل من المادة والروح. هم الذين يحققون مثلك الأعلى من المزاوجة بين المادة والروح، والملائمة بين الحركة والسكون، وبين القلق والاضطراب، ولذلك كان اليونان هم الذين أخرجوا للإنسانية في العصر القديم أرقى تراث في الأدب والفن والفلسفة.
قلت إني لا أنكر روحية المصريين. وأقول أيضا إني مؤمن بروحية الهنود، ومعترف بتأثير الروحية المصرية والهندية في حياة اليونان. ولكني لا أعرف من روحية المصريين شيئاً كثيراً لأننا لا نعرف للمصريين فناً ناطقاً، لا نعرف لهم أدباً بالمعنى الصحيح لهذه الكلمة. وأنت ترى معي أن الأدب هو أوضح مصور لحياة العقول والقلوب، لأنه يحقق مقداراً مشتركاً يمكن الاتفاق عليه، ويصعب الاختلاف فيه. فنحن إذا قرأنا الشعر أو النثر معاً، فهمنا فهماً واحداً أو فهمين متقاربين، ولكن الفن الصامت فن البحث والتصوير وما إليهما يثير في نفوس الناس معانٍ مهما تكن متقاربة متشابهة، فهي تختلف باختلاف الأشخاص والبيئات والعصور، ها أنت ذا تفهم من الفن المصري ما تفهم، ويشاركك فيه كثير من المثقفين ثقافة أوربية، ولكن أواثق أنت حقاً بأن قدماء المصريين كانوا يرون تماثيلهم وعماراتهم كما تراها، ويفهمونها كما تفهمها، ويستلهمونها كما تستلهمها؟ أرأيتك لو سألت مصرياً معاصراً لرمسيس عن رأيه في تمثال من التماثيل، أو عمارة من العمارات، أيقول فيهما مثل ما تقول؟ ومثل هذا يقال في الفن اليوناني، وفي كل الفنون الصامتة، فليس من الخير أن نعتمد عليها وحدها في تشخيص عقلية الأمم وروحيتها، إنما المشخص الصحيح للعقول والقلوب والأرواح هو الكلام، والكلام الجميل الذي نسميه الأدب ونقسمه شعراً ونثراً. فإلى أن يكشف لنا علماء الآثار المصرية عن أدب مصري قديم خليق بهذا الاسم أرجو أن تأذن لي في أن أشك في كثير جداً من هذه الأحكام التي يرسلها الأدباء والشعراء وأصحاب الفن على عقلية المصريين القدماء وروحيتهم، وبعدهم عن المادة، وقربهم من الروح.
كل هذه عندي أحكام يتعجل بها أصحابها، ويرسلونها على غير تحقيق، وإذن فقد يكون من الإسراف أن تتخذ هذه الروحية المصرية الغامضة التي يسرع إليها الشك، والتي تعجز عن أن تثبت للبحث، والتي توشك إن تكون خيالاً تخيلته أنت وتخيله أصحابك من الأدباء ورجال الفن أساساً لأدبنا المصري الحديث. فمن يدري لعل البحث عن آثار مصر أن يكشف لنا بعد زمن طويل أو قصير عن حياة مصرية قديمة تغاير كل المغايرةهذا الخيال الذي تحبونه تطمئنون إليه، ويخيل إليكم أن الفن المصري القديم يوحيه ويمليه وينطق به.
نحن إذاً أمام أمرين أحدهما عرضة للشك الشديد، لا نكاد نعرف منه شيئاً، والآخر لا سبيل إلى الشك فيه؛ أحدهما حياة مصر القديمة وحضارتها العقلية - إن صح هذا التعبير - والآخر حياة العرب وحضارتهم. فإلى أي الأمرين نفزع لنقيم عليه بناء أدبنا الجديد؟ أإلى الشك أم إلى اليقين؟ وهنا يظهر الخلاف بينك وبيني شديداً حقاً، فقد أصلحت أنت رأيك في اليونان، ولا أستطيع مناقشتك في أحكامك على المصريين لأنها أثر الإلهام الفني، ولكن رأيك في العرب وآثارهم في حاجة شديدة جداً إلى التقويم. فقد كنّا نرى أن ابن خلدون جار على العرب فإذا أنت أشد منه جوراً وأقل منه عذراً. فقد يسّر الله لك من أسباب العلم بالتاريخ القديم، وتاريخ القرون الوسطى وتاريخ الحياة الأدبية والفنية والعقلية لمختلف الأمم والشعوب ما لم ييسّره لابن خلدون. فإذا قبل من هذا المؤرخ الفيلسوف أن يتورّط في الخطأ لأن عقله الواسع لم يحط من أمور اليونان والرومان والهند والفرس والمصريين القدماء بما نستطيع نحن الآن أن نحيط به أو نمعن فيه. فليس يقبل منك أنت هذا الخطأ وليس يقبل من المعاصرين بوجه عام. وقد ذهب إلى مثل ما ذهبت إليه جماعة من المستشرقين منهم دوزي ورينان، وأحسبكم جميعاً تظلمون العرب ظلماً شديداً وتقضون في أمرهم بغير الحق. فلو أنكم ذهبتم تقارنون بين العرب وبين الهنود والفرس، والمصريين القدماء لما كان من حقكم أن تقدموا هذه الأمم في الأدب على الأمة العربية بحال من الأحوال، لأننا لا نكاد نعرف من آداب هذه الأمم في تاريخها القديم شيئاً يقاس إلى ما بين أيدينا من الأدب العربي. فإلى أن يستكشف أدب هذه الأمم إن كان لها أدب أكثر من هذا الذي نعرفه، يجب أن نؤمن للعرب بالتفوق عليها في الشعر والنثر جميعاً. للمصريين فنهم، وللهنود قصصهم وفلسفتهم، ولكن للعرب شعرهم ونثرهم ودينهم، ولهم قصصهم أيضاً. فإذا أردت أن تقارن بين العرب والرومان فأظنك توافقني على أن الأدب العربي الخالص أرقى جداً من الأدب الروماني الخالص، أيأن الأدب الروماني إنما ارتقى حقاً حين أثّر فيه الأدب اليوناني، فالرومان تلاميذ اليونان في الأدب والفن والفلسفة، والعرب يشبهونهم في ذلك. ولكن العرب كان لهم أدب ممتاز قبل أن يتأثّروا بالحضارة اليونانية، ولم يكن للرومان من هذا الأدب الروماني الممتاز الخالص حظ يذكر. وقد تفوق الرومان في الفقه، ولكنهم لم يسبقوا العرب في هذه الناحية من نواحي الإنتاج، ولعل الأمة الوحيدة التي يمكن أن تشبه بالرومان في الفقه إنما هي الأمة العربية.
لم يبق إذن إلاّ أدب اليونان، هو الذي يمكن أن يقال فيه انه متفوق على الأدب العربي حقا، ولكن من الذي يقيس رقي الأدب في أمة من الأمم برقي الأدب في أمة أخرى؟ فإذا كانت ظروف الحياة العربية مخالفة أشد المخالفة لظروف الحياة اليونانية، فطبيعي أن تختلف الآداب عند الأمتين. وليس من شك في أن الأدب العربي قد صوّر حياة العرب تصويرا صادقا فأدى واجبه أحسن الأداء، وكل ما يؤخذ به الأدب العربي القديم هو أنّه لا يصوّر حياتنا نحن الآن، ولكن أواثق أنت بأن الأدب اليوناني القديم قادر على أن يصور الحياة الحديثة تصويراً يرضي أهلها؟! أمّا أنا فلا أتردد في الجواب على مثل هذا السؤال، فالأدب اليوناني القديم خصب غني ممتع من غير شك، ولكنه كالأدب العربي قد صوّر حياة القدماء، وهو قادر على أن يلهم المحدثين لا أكثر ولا أقل.
وأراك تذكر الفن العربي فتعيبه وتغض منه، وقد تكون موفقا في ذلك، ولكن أليس من الظلم أن تحمل هذا الفن على العرب وإنّما هو فن إسلامي ساهمت فيه الأمم الإسلامية المختلفة واستمدت أكثره من البيزنطيين. فإذا كان لك أن تعيب هذا الفن أو تحمده، فأحب أن تقتصد في إضافته إلى العرب، والخير أن تضيفه إلى الأمم الإسلامية. وأمر العرب بالقياس إلى الفن والأدب والعلم والفلسفة بعد العصر العباسي الأول، كأمر اليونان بالقياس إلى هذه الأشياء كلها بعد غارة الاسكندر على الشرق. كانوا ملهمين باعثين للنشاط دافعين إلى الإنتاج، مقدمين لغتهم وعاء لما تنتجه العقول والملكات على اختلافها، وقد يكون من الحق أن كل مقامة من مقامات الحريري أشبه بباب من أبواب جامع المؤيد، ولكن من الحق أيضا أن الآثار الأدبية التي تشبه مقامات الحريري والآثار الفنية التي تشبه أبواب جامع المؤيد كثيرة جدا عند اليونان في العصر المتأخر، وعند البيزنطيين، ولعل هذه الآثار اليونانية البيزنطية هي التي أحدثت عند المسلمين مقامات الحريري وأبواب جامع المؤيد. وأنت تميز اليونان بالحركة، وتميز العرب بالسرعة، وتستنبط من هذه السرعة ظلماً كثيراً للعرب، كما فعل أبن خلدون من قبل، وليس من شك في أن العرب يشاركون اليونان في الحركة، ولكن ليس من شك أيضاً في انك تغلو غلواً شديداً في وصفهم بالسرعة. إنما أسرع العرب في الخروج من باديتهم، ولكنهم حين بلغوا الأمصار استقرّوا فيها، وطال بهم المقام، فأثروا في أهلها وتأثروا بهم، وكانوا في القرون الوسطى أشبهالأمم باليونان في العصر القديم. ورأيك في الموسيقى العربية واليونانية في حاجة إلى التصحيح أيضا، فنحن نعلم من الموسيقى اليونانية شيئاً يسيراً غير مضبوط، ولا نعلم من الموسيقى العربية شيئاً، ولست أدري إلى أي أمة أو إلى أي جيل نستطيع أن نرد هذه الموسيقى، وهذا الغناء اللذين نتحدث عنهما. ولكن الشيء الذي لا أشك فيه هو أن من العسير جداً أن نردهما إلى العرب القدماء. وكل شئ يدل على أن الموسيقى والغناء العربي كما كان يعرفهما العرب أيام الأمويين والعباسيين وفي الأندلس كانا متأثرين أشد التأثر بالموسيقى البيزنطية والغناء البيزنطي. فإذا أردت أن تعيبهما فلا تنس أن تعيب أصلهما اليوناني القديم.
وأريد الآن أن أدع هذه المناقشات التي تمس أموراً جزئية وأن أخلص إلى جوهر الموضوع الذي تريد أن تعرف رأيي فيه، وهو: الروح المصري الذي ينبغي أن يقوم عليه الأدب الحديث ما هو؟ وما العناصر التي تؤلفه؟ وأنا استأذنك في أن أكون يسيراً سهلاً، لا متعمقاً ولا متكلّفاً، ولا باحثاً عن الظهر في الساعة الرابعة عشرة (كما يقول الفرنسيون) فالأمر أيسر جداً من هذا كله. عناصر ثلاثة تكون منها الروح الأدبي المصري، منذ استعربت مصر، أولها العنصر المصري الخالص الذي ورثناه عن المصريين القدماء على اتصال الأزمان بهم، وعلى تأثرهم بالمؤثرات المختلفة التي خضعت لها حياتهم، والذي نستمده دائماً من أرض مصر وسمائها، ومن نيل مصر وصحرائها. وهذا العنصر موجود دائما في الأدب المصري الخالص، قد حاولت تشخيصه بعض الشيء في أول هذا الفصل، فيه شيء من التصوف، وفيه شيء من الحزن، وفيه شيء من السماحة، وفيه شيء من السخرية. والعنصر الآخر هو العنصر العربي الذي يأتينا من اللغة ومن الدين ومن الحضارة، والذي مهما نفعل فلن نستطيع أن نخلص منه، ولا أن نضعفه ولا أن نخفف تأثيره في حياتنا، لأنه قد امتزج بهذه الحياة امتزاجاً مكوناً لها مقوماً لشخصيتها، فكل إفساد له إفساد لهذه الحياة ومحو لهذه الشخصية، ولا تقل انه عنصر أجنبي، فليس أجنبياً هذا العنصر الذي تمصر منذ قرون وقرون، وتأثر بكل المؤثرات التي تتأثر بها الأشياء في مصر من خصائص الإقليم المصري، فليست اللغة العربية فينا لغة أجنبية، وإنما هي لغتنا وهي أقرب إلينا ألف مرّة ومرّة من لغة المصريين القدماء. وقل مثل ذلك في الدين، وقل مثله في الأدب.
أما العنصر الثالث، فهو هذا العنصر الأجنبي الذي اثّر في الحياة المصرية دائماً، والذي سيؤثّر فيها دائماً، والذي لا سبيل لمصر إلى أن تخلص منه، ولا خير لها في أن تخلص منه، لأن طبيعتها الجغرافية تقتضيه، وهو هذا الذي يأتيها من اتصالها بالأمم المتحضّرة في الشرق والغرب. جاءها من اليونان والرومان واليهود والفينيقيين في العصر القديم، وجاءها من العرب والترك والفرنجة في القرون الوسطى، ويجيئها من أوربا وأميركا في العصر الحديث. فخذ الآن أي أثر أدبي مصري فحلله إلى عناصره التي يتكون منها، فستجد فيه هذه العناصر الثلاثة دائما. ولكنك ستجد بعضها أقوى من بعض بمقدار حظ المؤلف أو المنشئ من هذه الثقافات الثلاث المختلفة. بعض هذه الآثار يغلب فيه العنصر العربي، وبعضها يغلب فيه العنصر الأوربي، وقليل جدا منها يظهر فيه العنصر المصري القديم. فإذا لم يكن بد من أن أصور المثل الأعلى لروحنا المصري في أدبنا الحديث، فأني أحب أن يقوم التعليم المصري على شيء واضح من الملاءمة بين هذه العناصر الثلاثة فتشتد عنايته جدا بالتاريخ المصري، والفن المصري، والأدب المصري على اختلاف العصور. وتشتد عنايته جداً بالأدب العربي، والتاريخ العربي، والدين الإسلامي. ثم تشتد عنايته بالثقافة الحديثة. وأخوف ما أخافه على هذا الروح المصري شيئان: أحدهما أن تلهينا الثقافة الأوربية عن الثقافة المصرية والعربية، وكل شيء يغرينا بها ويغريها بنا فهي ضرورة من ضرورات الحياة، فمن الحق علينا أن لا نضيع حظنا منها، ولكن من الحق علينا ألاّ نفني أنفسنا فيها. الثاني أن نؤثر ثقافة أوربية على ثقافة أوربية فنؤثر الثقافة الإنكليزية (كما يريد قوم وكما تريد سياسة الدولة) أو نؤثر الثقافة اللاتينية (كما يريد قوم آخرون، وكما كانت تريد سياسة الدولة من قبل) هذا خطر لأنه يجعل الروح المصري الناشئ وجها لوجه أمام روح أوربية أقوى منه وأشد بأسا. فيوشك أن يخضع له ويفنى فيه، فلو قد فتحنا أبوابنا للثقافات الأجنبية على اختلافها، لانتفعنا بها كلها ولأضعف بعضها بعضا، وحال بعضها دون بعض أن يفنينا أو يسيطر علينا. لذلك تمنيت وما زلت أتمنى لو لم تفرض على مصر لغة بعينها من لغات الأوربيين، بل جعلت اللغات الحية الراقية كلها مباحة للطلاب يأخذون منها ما يشاءون.
هذا الروح المصري الذي يتكون من هذه العناصر الثلاثة، هو الذي نشهده الآن عندك وعند كثير من أمثالك المثقفين، وهو الذي نجد في نشره وإذاعته بين المصريين جميعا، وهو الذي سيطبع أدبنا المصري الحديث بطابعه القوي سواء أردنا أم لم نرد. فشخصيتنا المصرية العربية أقوى بحمد الله من أن تمحى أو تزول، والحضارة الأوربية أقوى وألزم من أن نعرض عنها، أو نقصر في الأخذ بحظنا منها. ستسألني: ولكن الأديب؛ من أين يستمد خواطره، ويستلهم وحيه؟ فأجيبك: من هذه العناصر كلها، أو من أي من هذه العناصر شاء، سيكون منّا الأديب الذي يستلهم العنصر المصري القديم؛ أليس بين الفرنسيين من يستلهم اليونان؟ وسيكون منّا الأديب الذي يستلهم العنصر العربي؛ أليس من الفرنسيين من يستلهم الرومان؟ وسيكون منّا أن يستلهم العنصر الأوربي، أليس من الفرنسيين من يستلهم السكسونيين؟ بل من يستلهم الشرق الأقصى، أو الشرق الأوسط، أو الشرق القريب، بلى. والأمر كذلك عند الإنجليز وعند الألمان، وعند غيرهم من الأمم الحية. فأنت ترى أن أمر هذا الروح المصري أيسر من أن يدعو إلى الخوف أو يضطر إلى الحيرة وأكبر الظن أنّ مصدر هذه الحيرة وذلك الخوف إنّما هو اضطراب سياسة التعليم في مصر وقيامها على غير أساس، وسيرها في غير طريق، ولو قد وضحت هذه السياسة واستقامت منذ زمن بعيد لما تساءلنا الآن عن الروح المصري، ولا عن الأدب المصري من أين يستمد الحياة.
أمّا بعد؛ فقد كنت أريد أن أقتصد وأؤثر الإيجاز، ولكن الحديث معك أغراني بالإطالة وحببها إليّ، وأرجو أن لا أكون عليك ولا على غيرك من القرّاء، وأرجو أن تقبل تحيتي الخالصة.
****
رسالة من الأستاذ توفيق الحكيم إلى الدكتور طه حسين
عزيزي الدكتور
قرأت الرد، ومرة أخرى أتأمل ما بيمينك. هذه العصا عجيبة التركيب، إنك لا تلمس شيئاً حتى ينقلب إلى الحق، حق كبير يبتلع كل رأي، ويلقف كل حجة. تلك عصا الأستاذية. ما كنت اجهل أنك حاملها في هذا العصر. نحن متفقان. ولا خلاف بيننا في الغاية. وهو مطلبنا. هنالك تفاصيل افترق فيها عن الدكتور ولن أعود اليها. فأنا أفزع من النظر إلى الوراء، خشية أن أتحول إلى تمثال من الملح، أو حتى إلى تمثال من الذهب. نفسي تصدف أحيانا عن الفكرة الجامدة مهما تكن خالدة، ويحلو لي أحيانا أن انثر الأفكار عابثا من نافذة قطار. أن رسائلنا في حقيقتها لا تعني أكثر من إثارة الغبار في أرض ناعمة مفروشة بالحصى. لسنا نصدر أحكاما بهذه الكتب السريعة. إنما نحن نطرح مسائل ونلقى بفروض سوف يلتقطها ويجمعها الباحثون المنقطعون يوم تستيقظ الأجيال. اتفقنا إذن. أو ينبغي لنا أن نتفق على أي حال، حتى ننصرف إلى شيء جديد. أن البحث عن الجديد هو الخليق عندي بالمجهود. ولقد فتح لنا اليوم باب الجديد الأستاذ احمد أمين. قال لي ذات مساء أنه يضع كتابا في أصول النقد، ويود أن يوليني شرف المشاركة في البحث من بعض وجوهه. النقد؟ لفظ رن في أذني. وذكرت للفور أن رسالتي الأولى للدكتور كان موضوعها (الخلق). وقلت في نفسي ما يمنع من إتمام الكلام في رسالة ثانية يكون موضوعها (النقد) وإذا الأمر ينكشف لي عن قضية كبيرة: أنعد النقد كالخلق خاضعا لسلطان التيارات الفكرية الثلاثة التي ذكرها الدكتور: التيار المصري القديم، والتيار العربي، والتيار الأوربي؟ أم نعد النقد كالعلم لا يخضع لمثل هذه المؤثرات؟ أما أنا فلن أجيب عن فوري عن هذا السؤال. فأنا أكتب ولا أدري أين يحط بي القلم. دعني أولا أنشئ على هذا النغم بعض (تقاسيم) دون أن أعني الآن بالغاية. أن الغاية أحيانا رخيصة بجانب الوسيلة على الأقل في نظر الفن. لأن الغاية في الفن لا تبرر الوسيلة. الحياة كذلك، تلك القطعة الفنية التي أبدعها الخالق، أهي شيء غير وسيلة متينة التكوين؟ ألها معنى في غير ذلك الطريق المبين الذي أوله ضباب وآخره ضباب؟ خط هندسي رسم على لوح الوجود، كيف أبتدأ، كيف انتهى؟ لا يعنى ذلك علم الهندسة. انه خط بين نقطتين وكفى. ليس لنا أن نسأل عن غاية الحياة، ولا عن غاية الفن، ولا عن غاية العلم. أن الغاية لا تهم. إنما المعنى كله في الوسيلة. الحياة هي الطريق. العلم هو الطريقة. الفن هو الأسلوب. أما الغاية فلا غاية. وهل يترجى من العلم أو من الفن أو من الحياة غاية مطلقة يوما من الأيام؟ محال. ما نحن ألا أسلوب الخالق. ما الكون ألا أسلوب. الأسلوب كل شيء عند كل خالق وفي كل خلق. أن الخالق اعظم من أن يحبس إرادته الخالدة في حدود، غاية، لفظ يدل بذاته على معنى الانتهاء. في اعتقادي أن كلمة (غاية) هي من صنع العقل البشرى الصغير. هذا العقل المحدود الذي يضع كل شيء دائماً داخل حدود، ويأبى ألا أن يكون لكل شيء أول وآخر. إنما الخلود في الأسلوب. لأن الأسلوب لا أول له ولا آخر، فهو شيء كائن دائماً، لا علاقة له بالزمن. أن رجل الفن، وهو المقلد الأصغر للمبدع الأكبر، يدرك أن الفن لا يعيش بالغاية. لأن الغاية فانية كاسمها. وانما يعيش الفن بالأسلوب. لقد انقضت الغاية من تشييد الأهرام، وفنيت الغاية من بناء البارتينون. دفن الموتى أو عبادة الآلهة الغابرين غاية قد ماتت وبقى أسلوب الفن وحده خالداً في الأهرام والبارتينون. خدمة الإنسانية غاية العلم في نظر البسطاء. لو سئل عالم في ذلك لابتسم: (مالي وللإنسانية! إنما أنا أبحث عن سر أسلوب الصانع الأعظم. إنما هي لذة البحث وحدها. إنما هي طريقة البحث وأسلوبه. ولولا ذلك السرور الذي يملأ نفسي إذ ينكشف لعيني الباحثة عن جمال أسلوب الله لما تجشمت النصب في سبيل العلم، ولما كان للعلم هذا المعنى الرفيع.) المخترعات كذلك ليست غاية العلم. هي تطبيق للعلم. إنما العلم هو البحث الخالص المجرد عن كل غاية وعن كل استغلال. لقد كان الإغريق يبحثون ولا يطبقون. فيثاغورس مثل من أمثلة الأسلوب الخالد للعلم الخالص. الأسلوب إذن هو محور النقد كما هو عماد الخلق، وكلمة الأسلوب رحبة عميقة كالبحر، في جوفها كل كنوز المعرفة التي يصبوا اليها البشر. ولعل كل ما أوتيه الإنسان من سليقة سامية منذ أول الأزمان ليس ألا انعكاس أسلوب الخالق في نفس الإنسان. هذا المنطق الذي نشأنا عليه، ونرجع إليه في كل حياتنا، هذا الإحساس بالنتيجة والسبب، هذا الشعور بالتناسق والتناسب، هذا الإدراك للصلة التي تربط الشيء بالشيء، من أين جاءنا هذا نحن البشر؟ أهناك مصدر آخر غير أسلوب الخالق؟ فتحت البشرية عينيها فالفته حولها. فهو موجود قبلها وقبل الخليفة كما يوجد الرسم والتصميم قبل البناء. أن أسلوب المبدع في صنع الخليقة هو وحدة المنبع الأزلي لهذه الصفات كلها: المنطق، ارتباط السبب بالنتيجة والشيء بالشيء. والجزء بالكل، والتناسق والتناسب. صفات هي بعينها صفات الأسلوب السليم لكل عمل فني عظيم. أسلوب الله هو المعلم الأول والأخير. وما أول صورة رسمها الإنسان على الأحجار وعظام الحيوان سوى إعلان شعوره الخفي بتلك الصفات، أن رجل الفن الأول هو أول إنسان عرف (المنطق) صفة فنية بعد أن كان المنطق سليقة سامية تسبح في أنحاء نفسه ولا يعرف ما هي. أن المنطق الذي شيد الأهرام صورة محكمة لهو المنطق الذي شيد الكون. ما المنطق؟ ما معنى المنطق؟ سره في تلك المرآة العظيمة الصافية التي تحيط بنا كالجدران: الوجود، أجمل مثال للمنطق في الأسلوب ينبغي لرجل الفن والأدب والعلم أن يطيل فيه النظر. كل شيء في هذا الوجود مصنوع على طريقة واحدة وعلى قاعدة واحدة. ما القاعدة التي بني عليها الوجود؟ هي القاعدة التي بنيت عليها الأهرام. هي قاعدة كل بناء: التماسك بين الأجزاء في كل واحد متسق. هذا التماسك ما علته وكيف يكون؟ قانون أستطيع أن أفرغه كما يفعل الرياضيون في صيغة بسيطة من لفظين: (الأخذ والعطاء). كل شيء في هذا الوجود يحيا على نمط واحد. وكل حياة في هذا الوجود لها مظهر واحد: اخذ وعطاء في حركات متصلة متشابهة: زفير وشهيق عند الإنسان والأحياء، اكتساب وإشعاع عند النجوم والأشياء. الأخذ والعطاء قانون التماسك والاتصال في حياة الفرد والمجتمع والأمة والأمم. وفى حياة الأخلاق والسياسة والاقتصاد. وفي حياة المادة والروح. وفي حياة الأرض والأجرام والسدم. ليس في الوجود شيء لا يأخذ ولا يعطى. وليس في الوجود شيء يعطى ولا يأخذ. كل شيء يعتمد على كل شيء في هذا الكون. بنيان مرصوص يشد بعضه بعضا.
وكل خلق بنيان. ولا بنيان بغير وحدة شاملة، ولا وحدة شاملة بغير تضامن بين الحجر والحجر، وبين الجزء والجزء. هذا التضامن وليد ذلك القانون: (الأخذ والعطاء) وليس هذا كل المنطق في صنع الوجود وانما المنطق في تركيب ذلك القانون. ما قوام الأخذ والعطاء؟ هل يكون اخذ وعطاء إلا بين كائنات متشابهة؟ ما الحال لو أن الخالق أبدع في وجودا آخر على أسلوب آخر، فصنع أناسا يعيشون بالزفير ولا يعرفون الشهيق، ومخلوقات تأكل ولا تصرف، وأجراما تكتسب الحرارة والضوء ولا تشع؟ أي اتصال يمكن أن يقوم بين كائنات خلقت على غير أسلوب واحد؟ لا اتصال، وحيث لا اتصال لا بناء. لا خلق ولا بناء. أي اتصال بيني وبين أخي وابني لو أن الخالق صنعني من عناصر غير عناصرهما فجعلني من يابس ورطب وجعلهما من نور ونار وغاز وبخار؟ أي ارتباط لو انه جعل كل مخلوق منفردا بمادته وهيئته وعناصره عن كل مخلوق. وأي هرم يمكن أن يشيد بأحجار، أحدها من صخر، وآخر من عجين، والثالث من ورق، والرابع من طين؟ لا ارتباط من غير تشابه وتماثل. ولا تضامن بين أجزاء غير متجانسة في التركيب. إن كل ما نحس بوجوده يتحد معنا في بعض العناصر. بغير هذا ما كنا نعترف له بوجود. إنا نعرف الأجرام لأن أجسامنا تعرف الحرارة والضوء والحديد. التشابه شرط الأخذ والعطاء. الاختلاف كذلك شرط آخر. هل يقوم آخذ وعطاء إلا بين كائنات مختلفة؟ ما الحال لو أن الخالق صنع كل شئ ككل شئ، فجعل كل رجل ككل رجل، وكل جرم ككل جرم؟ طبع واحد، ومنظر واحد، وحجم واحد. أليس هذا التشابه المطلق ينفي الشخصية؟ وحيث لا شخصية فلا أخذ ولا عطاء، ولا تماسك ولا اتصال، وهل من صلة بيني وبين غيري إلا الاختلاف شخصه عن شخص وما عنده عما عندي؟ وهل رابطة الأجرام إلا اختلافها في الأحجام؟ الجاذبية، الحب، هل علتهما اختلاف النسب في القوى والأشكال؟ أن مثل هذا الكون المتماثل لا يمكن كذلك أن يشيد أو يوجد. مثله مثل قصة تمثيلية أشخاصهم لهم عين الاسم والجسم والطبع والحظ، يتكلمون عين الكلام، ويتحركون عين الحركات، ويتصرفون عين التصرفات! أي علاقة يمكن أن تنشأ بين هذه المخلوقات؟ وهل يشعر أحدهم بوجود الآخر؟ وهل يدرك أحد منهم معنى كلمة (أنا)؟ لا بد من بعض الاختلاف بين الكائنات حتى يتميز كل كائن من الآخر. ومتى تميزت الأشخاص والأشياء والأجزاء نشأ بينها الأخذ والعطاء، سر تماسك في كل بناء. . . ها هنا إذن قوام التناسق: (التشابه لا كل التشابه، الاختلاف لا كل الاختلاف!) بيتهوفن الذي كشف لي منذ ست سنوات عن سر التأليف بين صوتين في عين الوقت. لاحظت انه يجمع بين صوتين متشابهين لا كل التشابه مختلفين لا كل الاختلاف. وأدركت انه لا تناسق بغير هذا. فلو انه جعل الصوتين متشابهين كل التشابه لفنى أحدهما في الآخر. وما يميزنا شيئاً غير صوت واحد. ولو انه جعلهما مختلفين كل الاختلاف لاستحال على الأذن أن تصل بينهما وهما متباعدان متنافران. فأساس (التناسق) في الموسيقى والفن كأساس التناسق في الحياة والكون: ائتلاف بين الأجزاء لا كل الائتلاف واختلاف بينهما لا كل الاختلاف. ملاحظة أخرى داخل القوسين: كلامي عن المصرية والعربية في رسالتي الأولى ليس ألا رغبة مني في فرز خصائص أمم هذا العالم العربي الذي أخشى انحلال آدابه إنما الحب والتضامن في اختلاف ما عندنا عما عند إخواننا الجيران بعض الاختلاف. إن التشابه مضمون باللغة الواحدة والتراث الواحد. فليبحث كل منا عن شخصيته المميزة في ماضيه الطويل بأكمله. المصري في مصر القديمة وما بعدها من عصور. والسوري في فينيقيا وما بعدها. والعراقي في بابل وما بعدها وما قبلها من تواريخ الخ الخ. . . كل يستخرج من بطن الأرض التي يحيا عليها كل محاسن طبيعتها وكل كنوز ماضيها. أن الفن أبن الأرض. الولد للفراش والفن للأرض. أني أقول بالمصرية والعراقية والسورية الخ الخ لا للانفصال بل للاتصال، لا للتعصب بل للحب. أن اليوم الذي تزهو فيه لكل منا شخصية قوية هو اليوم الذي يكثر فيه التعامل بيننا والارتباط. أما فناؤنا جميعا في شخصية العرب الغابرين فأمر لا يمكن أن يكون، لأنه مخالف لطبيعة الأشياء. أن لكل ارض صفات من التاريخ سابقة على عهد العرب. ماذا نفعل بهذه الصفات؟ أنمزقها كما يصنع البرابرة المتوحشون أم نطالعها ونستخرج منها ما يفيد الإنسانية؟ لا بد أن يكون لكل ارض لون. ولكل ارض اسم ورسم وجسم. ولقد كان الأمر كذلك حتى أيام دولة العرب. فكانت الشام غير العراق غير مصر غير الأندلس. والفن والشعر والأدب اظهر دليل على وجود الفروق الجلية، وعلى صدق ذلك القانون: تشابه بين تلك الأقطار لا كل التشابه. واختلاف بينهما لا كل الاختلاف. فكيف يكون الأمر غير ذلك؟ ونغضب إذ تكون هناك مصر وهناك شام وهناك عراق؟ مثل ما كانت دولة العرب أمس. ينبغي للعالم العربي اليوم أن يكون: (وحدة شاملة وكتلة بنيان في شئون السياسة والذود والدفاع، وشخصيات منوعة الألوان في شئون الفن والخلق والإبداع.) جملة القول عندي أن أسلوب الله في صنع الكون هو وحده منبع الفن، هو وحده مصدر ذلك الإدراك الإنساني للجمال منذُ مبدأ الأجيال. أما نقاد القرن التاسع عشر فلا احسبهم رفعوا أبصارهم إلى هذا الأسلوب مستلهمين. إنما هم قد خروا أمام تمثال العلم ساجدين، أنظارهم خاشعة ترنو في رجاء إلى شعاعين من الكهرباء صادرين من عدسات عينيه الجامدتين. القرن التاسع عشر قرن تأليه العلم. فلقد بهر العلم العالم بانتصارات حاسمات متواليات، فاذا الأدب والفن والفلسفة كلها تهرع إليه تقرى له بالغلبة والسلطان. وإذا كل شئ يطلب إلى العلم تفسيرا. وإذا العلم في نشوة الظافر وبسمة الواثق لا يأبى أن يقضى فيما يعنيه وفيما لا يعنيه. وإذا العلم وهو علم المادة يريد أن يتحدث في شئون الروح. وإذا سئل عن الروح قال دونكم هذا الطريق وأشار إلى عين الطرائق التي أدت إلى الفوز في شئون المادة: التحليل والتركيب والتجربة والقياس والاستنتاج والاستقراء الخ. بهت العالم لنظرية النشوء والارتقاء. وآمن الناس أن أصلنا من ماء وخلايا حية وحيوان ظل يسمو في المرتبة على مدى الأزمان حتى بلغ القرد جد الإنسان! نظرية جميلة، خلب جمالها اللب على الرغم من بشاعة ذلك الجد الغول. أما صدقها فجائز من حيث المادة والأجسام. وهنا تبدو قضية: أتصدق هذه النظرية على الروح أيضا وشئون الروح؟ الإحساس بالجمال: أيخضع أيضا للنشوء والارتقاء؟ نعم، نعم، نعم. كذلك قالت المدرسة الإنجليزية (سبنسر، جرانت الن، رسكن). وكان لا بدلهذه العقول التي فتنتها نظرية التطور في المادة أن تبرز للإنسان نظرية التطور في الجمال.
وعجب الناس لنظريات علم طبقات الأرض وعلم الحيوان وعلم الحياة وأبحاث (لامارك) في تأثير البيئة والمناخ وظروف الحياة على طبيعة الأجسام، فقامت المدرسة الفرنسية (هيوليت تين) تخرج للفكر والأدب نظرية للجمال والفن: الوحي فيها والإلهام مقاييس الحرارة وموازين الأحجام! بل إني لأرى إصبع العلم قبل ذلك بقرن يقود المدرسة الألمانية إلى نظريتها في الجمال. ولم يكف العلم هذا التوجيه والتأثير بل تناول بيديه في هذا العهد الحديث جسم الجمال: واعمل فيه المشرط والمسبار (علم النفس الحديث) قضى الأمر، وخرج الجمال من حدائق الفلسفة إلى معامل العلم. .! لست ارزى على طرائق العلم. فهي وسائل البشرية التي لا تملك غيرها. واذكر يوم كنت ارصد وقتا للتفكير في هذه المسائل أني بسطت أمام نفسي هذا السؤال الساذج: الحيوان ما علمه بالجمال؟ حصان بين مهرتين أحدهما جميلة مليئة شهباء والأخرى قبيحة هزيلة عرجاء، إلى أيتهما يميل؟ ما ترددت يومئذ أن أقول في ثقة واقتناع: (إلى الجميلة يميل، ما وجه الترجيح؟ لست أدري، وحبذا التجربة فهي الحكم الفصل!). لكنى يومئذ كنت أفكر تفكيرا صرفا في قهوة صاخبة اعتقدت أن آوى اليها للتفكير الهادئ، فأين لي بالخيول والأفراس أجري عليها التجاريب؟ فهاأنذا أقر بأن التجربة وسيلة بشرية طبيعية للوصول إلى المعرفة. واقر باني شعرت يوما بالحاجة إلى ممارستها في شئون الجمال. غير أني على الرغم من هذا لا احب أن اعتقد ببساطة أن نظريات العلم في شئون المادة تصدق دائما في شؤون الروح. لا شيء يستطيع أن يقنعني بأن إحساس الجمال وليد تطور ونشوء. بي رغبة أن أصيح بغير دليل في يدي أن إدراك الجمال ولد كاملا في قلب الإنسان منذ رفع بصره وبصيرته إلى أسلوب الله فرعاه. إني أخشى أن نقع في الغلط إذ نطبق نظرية المادة في مسائل الروح، وهل يستطيع الدكتور أن يجيز قول رسكن وجرانت الن في الإلياذة: (. . . ما كان يعنى الأقدمون بالطبيعة ولا بجمالها ألا حين يتصلان بعيش الإنسان. ففي الإلياذة ما كان يوصف منظر طبيعي لذاته، بل لنفعته للإنسان، كان يكون مكانا خصيبا يفيض بالحنطة أو تكثر فيه الجياد. ما كانت الطبيعة سوى إطار للحوادث والاشخاص، لا انها لذاتها محل للوصف. أن الطبيعة لم تحب لذاتها ألا في العصر الحديث، حيث استيقظ الإحساس بها، إحساس صافي خالص لا تشوبه شائبة النفع أو المصلحة. . .) ماذا أقول في هذا الكلام؟ اهو جهل بمشاعر الأقدمين؟ أم تورط في تطبيق نظرية التطور والنشوء؟ أنصدق حقا أن الشعور الرفيع بجمال الطبيعة لم يعرفه القدماء خالصا لدنوهم من الحيوانية؟ أنصدق أن (هومير) لم يحس جمال الطبيعة لذاتها؟ أهذا رسكن يقول هذا الكلام أما أنا فقد مضى كلامي في الطبيعة والقدماء. ورأيي الذي أبديته في رسالتي الأولى أن الأقدمون كانوا أقرب منا إلى الطبيعة والى فهمها. لقد كان الأقدمون يحسون إنهم جزء من الطبيعة ونغم من أنغامها. أما رسكن وألن أو الإنسان الحديث فلا يحس ألا ذاته الآدمية منفصلة عن الطبيعة وعن كل شئ. دليلي فن القدماء من مصريين وإغريق. أهذا فن قوم لا يحسون الطبيعة لذاتها ولا يدركون قوانينها وأساليبها؟! إلى هذا الحد يصل الانقياد إلى النظريات؟ من اجل هذا لا أريد التمكين للعلم حتى يجلس على عرش النقد دون شريك. احب طرائق العلم. لكنى أخشى نتائج العلم. فلنرتفع بالروح قليلا. لست أريد أن أضع الروح تحت مبضع العلم، رهبة منى أن يشقها فيجدها غلافا أجوف. وإني لا أنسى يوم شاهدت تشريح جثة آدمي للمرة الأولى. أي قلق يومئذ مزق إيماني بقيمة الإنسان! كلا. أني كرجل من رجال الروح لا أريد أن افجع في خير ما أعيش به وله. يريح نفسي دائما أن أقول أنى عقل العلم لا يكفي. ولا بد دون إدراك الجمال والروح من العودة إلى القلب. أريد ألا يخرجني العلم من ذلك الإيمان الذي كان يضيء في قلوب المصريين القدماء إيمان قربهم من الخالق، فإذا هم ببصائرهم العميقة العجيبة أول آدميين استطاعوا فهم أسلوب الله والنفوذ إلى قوانين إبداعه. أن أقصى العلم الإيمان. احب ذلك العلم المؤمن الشاعر الذي عرفه أيضا الفلكيون العظام في القرنين السادس عشر والسابع عشر: كوبرنيك، وجاليليه وكبلر، آخر قطرة من ذلك العلم الممزوج بالإيمان كانوا ينظرون إلى الكواكب كما نظر اليها من قبل المصريون الأقدمون. لا بعين العقل، بل بعين القلب أيضا. كانت السماء والنجوم في نظرهم مخلوقات حية. كانوا أيضا يحسون في كتلة النجوم وفي هذا الكون بأكمله الروح الخالقة ويد المبدع الأعظم. ما أروع هذه العبارة من كبلر، فيها تلخيص جميل لكل ما يملأ نفسي: (. . . كل الخليقة ليست إلا سمفونية عجيبة في مجال الروح والأفكار كما هي في مجال الأجسام والأحياء. كل شئ متماسك مرتبط بعرى متبادلة لا تنفصم. كل شئ يكون كلا متناسقا. أن الله قد خلقنا على صورته، وأعطانا الإحساس بالتناسق. كل ما يوجد حي متحرك، لأن كل شئ متتابع متصل. كل كوكب وكل نجم أن هو ألا حيوان ذو نفس. أن روح النجوم هي سر حركتها، وسبب ذلك الحب الذي يربط بعضها إلى بعض وتعليل ذلك النظام الذي تسير عليه الظواهر الطبيعية. .) أولئك رجال ساروا في بيداء العقل دون أن ينسوا دليل القلب. أولئك هم العلماء العظام! أرى الدكتور قد استشف رأيي بعد هذا التمهيد. نعم ولا أخشى أن أجيب ألان عن السؤال فأقول أن التيارات الثلاثة التي ذكرها الدكتور تصدق أيضا في النقد. كما تصدق في الخلق. أما التيار الأوربي في النقد فهو المرتكز على العلم. ولقد وصل إلينا هذا التيار بالفعل وتأثرنا به. وإن بعض كتب النقد التي طهرت في مصر الحديثة تنم على هذا الاتجاه العلمي. وهو أمر لا بأس به، بل هو واجب محتوم، على شريطة أن نقرن به. نظيف إليه عناصر جديدة ووسائل أخرى مستخرجة من أرضنا وتراثنا إذا أردنا أن ننشئ لآدابنا طريقة شخصية كاملة في النقد. فأما التيار المصري القديم فهو النقد المعتمد على الذوق، أي سليقة المنطق والتناسق. وهو عند المصريين القدماء سليقة المنطق الداخل للأشياء والتناسق الباطن أي القانون الذي يربط الشيء بالشيء. أي جمال للأهرام غير ذلك التناسق الهندسي الخفي وتلك القوانين المستترة التي قامت عليها تلك الكتلة من الأحجار! جمال عقلي داخلي. كذلك أسلوب الخالق لا يعني بالجمال الظاهر وحده في خلق الطبيعة. فأي جمال للثعبان والجعران؟ أن الجمال الظاهر نسبي لا يقدره غير الإنسان. إنما المنطق الداخليللأشياء هو كل جمالها الحقيقي. هذا المقياس المصري القديم للجمال ما احسبه قد أثر بعد في حياتنا الفكرية أو في أحكامنا الفنية. أما التيار العربي القديم فهو النقد الذي قوامه ذوق الحس. أي سليقة المنطق الظاهر والتناسق الخارجي. الجمال عند العرب هو الجمال الظاهر الذي يسر العين ويلذ الأذن. أنستطيع أن نتخيل العرب تبني الأهرام أو تقدر فيها جمالا؟ لقد جاء العرب مصر وتحدثوا بجمال نيلها وأرضها وسمائها ولم يروا في الأهرام ألا شيئا قد يحوي نقودا مخبوءة، أما بناؤه فشيء لا يحسب في الفن. إنما الحسن عند العرب حسن الهيئة قبل كل شيء. المساجد كالعرائس تكاد تخطر حسنا بزخارفها، زينة للناظرين. بغير هذا فلا عمارة ولا فن. الشعر رنين لذيذ، وخيال جميل، ومعان لطيفة، وألفاظ مختارة ظريفة، بغير هذا فلا شعر ولا فن. الجمال عند العرب جمال إنساني. والفن عندهم شيء صنعه الإنسان لنفسه وللذته. الفن العربي القديم فن إنساني دنيوي. والفن المصري القديم فن إلهي ديني. لهذا اختلفت المقاييس في الجمال بين الفنين. أحدهما يعنى بالتناسق الذي يروق الإنسان، والثاني يعنى بالتناسق الخفي بغير التفات إلى الإنسان. ولعل المقياس العربي القديم هو في مصر المنفرد حتى اليوم بالحكم في قضايا الشعر والأدب. ولعل اقرب مثل إلى الذاكرة ذلك الحكم الذي أصدره الدكتور على بيت للأستاذ العقاد:
هي كأس من كؤوس الخالدين ... لم يشبها المزج من ماء وطين
ألم يكن مقياس الدكتور في التقدير ذلك الذوق الحسي وذلك المنطق الخارجي الذي يربط الألفاظ، فوجد اتصالا غير متسق بين الكؤوس والطين سمع له شيئاً كالطنين يشوب صفاء الرنين؟ هذا المقياس العربي ذو الإبرة الدقيقة عجيب في تسجيل كل انحراف عن منطق الألفاظ. إنما هنالك في اعتقادي منطق آخر مستتر أمره يعنى المقياس المصري. ترى لو أن الدكتور رجع إليه أما كان يحكم لبيت العقاد لا عليه؟ أما كان يرى فيه تناسقا داخليا محكما هو كل ما عنى بأدائه الشاعر؟ إني يوم قلت بمزج الروح بالمادة في آدابنا. كان يجب على أيضاً أن أقول بوضع المقياس المصري في النقد بجانب المقياس العربي. وبعد، فإني ولا ريب قد استأثرت منك ومن وقتك مقدار لاحق لي فيه. غير أنى لولاك ما وضعت أفكاري في رسائل. إنما أنا اكتب لك. أي ضمان أنت في الشرق لحياة الفكر والبيان! وهل أستطيع أن أنسى ما كنت لي وما تكون؟ إني أضع بين يديك كل إخلاص؟
كوم حمادة في 14 سبتمبر سنة 1933. توفيق الحكيم
********************
توفيق الحكيم
عزيزي الدكتور طه حسين
يظهر أني سييء الحظ معك، أو أنك سييء الحظ معي هذا الاسبوع فلقد قرأت مقالك عن شهرزاد، وما احسبنا تلاقينا فيه عند رأي، فأما قولك اني أدخلت في الأدب العربي فنا جديدا وأتيت بحدث لم يسبقني اليه أحد، فهذا اسراف سبق لي أن أشرت اليه في خطاب مني اليك عن أدب الجاحظ ذكرت فيه يومئذ أن للجاحظ ملكة في انشاء الحوار تذكرنا ببعض كتاب المسرح من الغربيين. فما أنا اذن بمبتدع وانما أنا أحد السائرين في طريق شقه الشرق من قبل. وأما نصيب قصصي من البقاء فلست أعتقد أن لناقد معاصر حق الجزم به، وما بلغت من البساطة حد تصديق ناقد يتكلم في هذا، فإن الزمن وحده، هو الكفيل بالحكم للأعمال بالبقاء. فأنا كما تري لا أسمح لنفسي بقبول مثل هذا الثناء، كذلك لست أسمح لأحد أن يخاطبني بلسان التشجيع. فما أنا في حاجة الي ذلك. فإني منذ أمد بعيد أعرف ما أصنع. ولقد أنفقت الأعوام أراجع ما أكتب قبل أن أنشر وأذيع. كما أني لست في حاجة الي أن يملي علي ناقد قراءة بعينها، فإني منذ زمن طويل أعرف ماذا أقرأ. وما اخالك تجهل أني قرأت في الفلسفة القديمة والحديثة وحدها ما لا يقل عما قرأت أنت. وما أحسبك كذلك تجهل أني أعرف الناس بما عندي من نقص وأعلم الناس بما أحتاج اليه من أدوات. فأرجو منك أن تصحح موقفي أمام الناس وألا تضطرني الي أن أتولي ذلك بنفسي.
وتقبل أطيب التحيات من المخلص
توفيق الحكيم
*******************