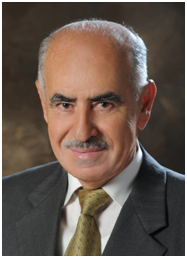كانت هيئة جارنا " أبو حسن " من الصور الرئيسة التي علقت بذاكرتي منذ أيام طفولتي الأولى، خاصة أيام الجُمَع، عندما كان يمر من أمام بيتنا في طريقه إلى المسجد. فقد كنت أتأمل عن بُعد قامته المديدة، وقمبازه الكحلي الوحيد، وكوفيته الناصعة البياض، فإذا اقترب منا نحن جماعة الأطفال الصغار المتحلقين حول بعضهم، اللاهين بألعابهم، تمعنت عن قرب قسمات وجهه الأبيض الممتلئ، وذقنه الحليقة وشاربه المشذب بعناية على غير عادة الرجال عندنا، وملامحه التي تشي بالعز والوجاهة لصاحب هذه الطلة البهية.
هذا ما كنت أستشعره كل يوم جمعة، وأنا أترقب إطلالة " أبو حسن " في غدوه لصلاة الجمعة ورواحه منها، وأنا بعد طفل لم ألج أبواب المدرسة. فقد كانت هيئته أيام الجمع مغايرة لهيئته في باقي أيام الأسبوع، التي كان يمضيها عاملا زراعيا بأجر يومي عند مُلاك القرية، فيوما تجده حاملا فأسه على كتفه، متجها صوب كرم ليعزق أرض فلان، ويقتلع منها الأعشاب، ويعتني بالأشجار فيجعل لكل منها حوضا خاصا تتجمع فيه مياه الأمطار، ويوما تجده يقلم الأشجار في بستان شخص آخر، ويوما يقيم جدارا تهاوى في مزرعة شخص ثالث، أما في موسم حصاد القمح والشعير أو موسم قطاف الزيتون، فإن "أبو حسن" كان يجد فرصة لعمل متواصل لأيام معدوات دون توقف، بدل البحث عن عمل متقطع يوما بعد يوم.
هكذا عرفت أبو حسن في باقي أيام السنة، مرتديا قميصه وسرواله ومعطفه البني، الذي لا يفارقه في ذهابه وإيابه، لكنه يتخلى عنه مؤقتا ويودعه غصن شجرة أثناء عمله.
لم يكن مسكن " أبو حسن " بعيدا عن بيتنا، فقد كان على بعد أمتار قليلة ناحية الجنوب. بيت متواضع مكون من غرفة واحدة ومطبخ، وحوله ساحة صغيرة. يعيش فيه مع "أبو حسن" زوجته أم حسن، التي كانت تمضي نهارها وراء ماكنة الخياطة أثناء غياب زوجها في الحقول، فقد كانت الخيّاطة الوحيدة في القرية، تقصدها النساء لخياطة ثيابهن وسراويلهن وثياب بناتهن.
ورغم هذه الكنية التي اشتهر بها أبو حسن، والتي لم أكن أعرف له اسما غيرها، فإنه لم يكن لديه لا حسن ولا غير حسن من البنين، إن هي إلا ابنة وحيدة. أما شقيقتاه فقد كانتا تأويان في جحر مجاور يمكن أن يسمى تجاوزا مسكنا، وإن كان أقرب إلى تجويف المغارة منه إلى أي مأوى آخر.
لم يكن لأبي حسن أقارب أو أصهار في قريتنا، حتى شقيقتاه على جمالهما فإنهما قد كبرتا وتجاوزتا سن الزواج، ولم يتقدم لخطبتهما أحد فيما أعلم.
وكنت على صغري آنذاك أرثي لحال أبي حسن، وأجد في نفسي حنينا وميلا يقربني منه، وأرى في نظراته وملامح وجهه ما يشي بمهابة آفلة وأيام عزٍ قديم، ويظل السؤال يحيرني:
لماذا يعيش أبو حسن في قريتنا وكأنه غصن مقطوع من شجرة، لا عم له فيها ولا خال؟ ولماذا لا يملك فيها شبر أرض، ولا حتى مكان المسكن الذي يأويه؟ من أين أتى؟ ولماذا لا يأتيه أحد زائرا؟ ولم نسمع يوما أنه ذهب لزيارة قريب؟
ترى هل هو مطالب بدم وملاحقٌ قد أُجليَ من بلده إلى قريتنا، فلا يستطيع العودة إليها؟
كانت تلك الأسئلة تدور في رأسي الصغير وتستقر فيه، فأحتفظ بها لنفسي ولا أفاتح بها أحدا سوى الأقربين من أهل بيتي.
بقيت سنوات في حيرتي بشأن " أبو حسن"، حتى كان يوم من أيام شهر حزيران عام ألف وتسع مئة وسبعة وستين، بعد أيام معدودات من احتلال إسرائيل للضفة الغربية، عندما تجمع نفر من أبناء قريتنا شيبا وشبانا، واستأجروا حافلة لتذهب بهم إلى فلسطين المحتلة قبلنا عام ألف وتسع مئة وثمانية وأربعين، والتي لم تشاهدها عين أحدهم قبل ذلك، سوى القلة القليلة من كبار السن الذين يعرفونها قبل احتلالها، وحتى هؤلاء على قلتهم أبى أكثرهم الذهاب، وفضّل أن يبقى محتفظا بالصورة التي تختزنها ذاكرته ليافا وحيفا وعكا،على أن يراها على هيئتها الحالية، وقد خلت من أهلها واستوطنها الأغراب، وتبدلت من حال إلى حال. لكن ما حيرني أن " أبو حسن " وأم حسن كانا أول الصاعدين إلى الحافلة، وجلسا في المقعد الأمامي خلف السائق مباشرة، ولعل هذا ما حفزني على المشاركة في هذه المغامرة.
دسست نفسي على صغري بين الحشود التي ملأت الحافلة، متشوقا أن أرى فلسطين التي لهجت ألسنتنا، وبُحت حناجرنا بالهتاف لها منذ تفتحت أعيننا على الحياة، والتي طالما حلمنا بالعودة إليها على هيئة غير هيئة عودتنا الحالية.
ذهلت عن نفسي، وما تذكرت أنني لم أخبر أحدا من أهلي، بأنني ذاهب مع الركب المتوجه صوب يافا أولا، ثم سائر مدن فلسطين، إلا بعد حين وبعد أن قطعنا شوطا من الطريق، لم يعد معه التذكر مجديا.
رغم لهاث حافلتنا القديمة وزفراتها المتقطعة، إلا أن الطريق إلى يافا التي كانت قبل بضعة أيام تبعد عنا مسافة دهر بطوله، ما استغرقت منا سوى أقل من ساعتين، عندما صاح السائق الذي يعرف أبو حسن ويعرف يافا جيدا:
نحن الآن على أبواب يافا، وسأريكم ميدان الساعة أولا، ومسجد حسن بيك وحي المنشية، وأبو حسن يقاطعه ويستحثه:
بل إلى طريق "سلمة" الله يخليك. فيرد عليه السائق:
لن نتأخر كثيرا، جولة سريعة ليشاهد الشباب وسط المدينة، وبعدها نتوجه حيث تريد، هذا إذا بقيت "سلمة" وبقيت "يازور" وبقيت " العباسية" وبقيت "الشيخ مونس" وبقيت "بيت دجن" وبقي شيء مما تعرف يا أبو حسن، فقد وطئتهن " تل أبيب" بأقدامها، وجثمت على صدورهن.
جالت بنا الحافلة سريعا وسط المدينة، وعدد لنا السائق معالم يافا الشهيرة القليلة الباقية على حالها، ثم انطلق بنا تحت إلحاح "أبو حسن" إلى طريق "سلمة" التي يعرفها جيدا .
كانت الدنيا غير الدنيا التي يتحدث عنها سائق الحافلة مع "أبو حسن"، حيث البنايات الشاهقة على جانبي الطريق، والمزارع التي يعرفانها قد تبدلت أحياء سكنية، وأسواقا حديثة تشقها شوارع واسعة، لكن السائق استمر في سيره وهو يكرر لأبي حسن:
لن تجد شيئا على حاله يا "أبو حسن".
وما هي إلا دقائق معدودة حتى توقف سائق الحافلة فجأة، وأشار بيده ناحية اليمين، ورأيت "أبو حسن" ينتصب من مقعده واقفا، ويلقي بنفسه من باب الحافلة، ميمما وجهه صوب البناية التي وقفت الحافلة أمامها فاردا ذراعيه على سعتهما، كأنما يريد أن يحتضن العمارة ذات الطوابق الأربعة كلها. خطوات قليلة توقف بعدها أبو حسن عن اندفاعه، كأنما زاغ بصره وتنكبت خطواته، وخرَّ على وجهه صعقا.
واندفع ركاب الحافلة يحيطون به محاولين إيقاظه من غيبوبته، بينما هرعت أنا الفتى الصغير بينهم إلى أقرب شقة في العمارة، التي كان أبو حسن يتوجه صوبها باحثا عن قليل من الماء، نرشه على وجهه، لعله يفيق من غيبوبته.
وسمعت سائق الحافلة يقول للركاب:
إنها عمارته وهذه الأرض التي ترونها على مد البصر أرضه، وبياراته التي كانت كلها لأبي حسن الذي لا تعرفونه، ابن مختار "سلمة" وكل هذه الأرض كانت ملكا لأبيه.
كان سكان الشقق الثماني يتطلعون من شرفات مساكنهم أو من نوافذها صوبنا نحن ركاب الحافلة، المتحلقين حول رجل منا ملقى على الأرض في غيبوبة.
قرعت باب أول شقة في الدور الأرضي وطلبت قليلا من الماء. ناولتني المرأة ساكنة الشقة وعاء فيه ماء، عدت به مسرعا فرششنا منه قليلا على وجه أبي حسن فأفاق من غيبوبته، وعدت من فوري لأرد الوعاء للمرأة فإذا بها تسألني بلغة عربية ولهجة مصرية:
جرى له إيه الراجل ده؟! فأجبتها:
إن هذه العمارة عمارته.
فصمتت ولم تعلق بشيء، أو أنني ما انتظرت حتى أسمع منها أو من غيرها من سكان العمارة أي تعليق .
عدت إلى ركاب الحافلة الذين ساعدوا "أبو حسن" على النهوض والصعود إلى الحافلة، وساعدوا زوجته أم حسن التي أغمي عليها أيضا عندما شاهدت زوجها على تلك الحال، وعدنا أدراجنا منكسي الرؤوس طيلة الطريق كأن على رؤوسنا الطير. ما رأينا من فلسطين غير جزء يسير من يافا، وعمارة "أبو حسن" في سلمة.
عندما توقفت بنا الحافلة في ساحة القرية كانت الشمس قد آذنت بالمغيب، فانسل كل منا صامتا إلى بيته، ووجدت أهلي ينتظرونني في قلق وحيرة، بسبب غيابي طيلة النهار دون أن أعلمهم عن وجهتي ومكاني. واستقبلني والدي من غيظه بسيل من الشتائم والصراخ، وتبعني بعصاه يريد أن يهوي بها على بدني، فيكسر بها أطرافي جراء ما جلبته لهم من همٍ وغمٍ طيلة النهار، وحتى لا أعود لمثلها مرة ثانية. كان يجهد نفسه في تتبعي، وأنا أفر من أمامه صائحا:
هل تعلم أن أبو حسن طلع ابن مختار " سلمة "، وعنده عمارة وبيارات وابن عز مثلما قلت لكم دائما.
توقف والدي عن مطاردتي وهو يسأل:
ماذا قلت؟
قلت الذي سمعت، "أبو حسن" ابن مختار "سلمة"، وله عمارة أربعة طوابق وأملاك كثيرة، وقد سقط اليوم مغشيا عليه عندما رأى عمارته. فذهل والدي مما سمع، وكف عن مطاردتي وتقريعي، وغاب في صمت عميق.
( سلمة ويازور والعباسية والشيخ مونس وبيت دجن) أسماء قرى مجاورة لمدينة يافا. 30/1/2014
هذا ما كنت أستشعره كل يوم جمعة، وأنا أترقب إطلالة " أبو حسن " في غدوه لصلاة الجمعة ورواحه منها، وأنا بعد طفل لم ألج أبواب المدرسة. فقد كانت هيئته أيام الجمع مغايرة لهيئته في باقي أيام الأسبوع، التي كان يمضيها عاملا زراعيا بأجر يومي عند مُلاك القرية، فيوما تجده حاملا فأسه على كتفه، متجها صوب كرم ليعزق أرض فلان، ويقتلع منها الأعشاب، ويعتني بالأشجار فيجعل لكل منها حوضا خاصا تتجمع فيه مياه الأمطار، ويوما تجده يقلم الأشجار في بستان شخص آخر، ويوما يقيم جدارا تهاوى في مزرعة شخص ثالث، أما في موسم حصاد القمح والشعير أو موسم قطاف الزيتون، فإن "أبو حسن" كان يجد فرصة لعمل متواصل لأيام معدوات دون توقف، بدل البحث عن عمل متقطع يوما بعد يوم.
هكذا عرفت أبو حسن في باقي أيام السنة، مرتديا قميصه وسرواله ومعطفه البني، الذي لا يفارقه في ذهابه وإيابه، لكنه يتخلى عنه مؤقتا ويودعه غصن شجرة أثناء عمله.
لم يكن مسكن " أبو حسن " بعيدا عن بيتنا، فقد كان على بعد أمتار قليلة ناحية الجنوب. بيت متواضع مكون من غرفة واحدة ومطبخ، وحوله ساحة صغيرة. يعيش فيه مع "أبو حسن" زوجته أم حسن، التي كانت تمضي نهارها وراء ماكنة الخياطة أثناء غياب زوجها في الحقول، فقد كانت الخيّاطة الوحيدة في القرية، تقصدها النساء لخياطة ثيابهن وسراويلهن وثياب بناتهن.
ورغم هذه الكنية التي اشتهر بها أبو حسن، والتي لم أكن أعرف له اسما غيرها، فإنه لم يكن لديه لا حسن ولا غير حسن من البنين، إن هي إلا ابنة وحيدة. أما شقيقتاه فقد كانتا تأويان في جحر مجاور يمكن أن يسمى تجاوزا مسكنا، وإن كان أقرب إلى تجويف المغارة منه إلى أي مأوى آخر.
لم يكن لأبي حسن أقارب أو أصهار في قريتنا، حتى شقيقتاه على جمالهما فإنهما قد كبرتا وتجاوزتا سن الزواج، ولم يتقدم لخطبتهما أحد فيما أعلم.
وكنت على صغري آنذاك أرثي لحال أبي حسن، وأجد في نفسي حنينا وميلا يقربني منه، وأرى في نظراته وملامح وجهه ما يشي بمهابة آفلة وأيام عزٍ قديم، ويظل السؤال يحيرني:
لماذا يعيش أبو حسن في قريتنا وكأنه غصن مقطوع من شجرة، لا عم له فيها ولا خال؟ ولماذا لا يملك فيها شبر أرض، ولا حتى مكان المسكن الذي يأويه؟ من أين أتى؟ ولماذا لا يأتيه أحد زائرا؟ ولم نسمع يوما أنه ذهب لزيارة قريب؟
ترى هل هو مطالب بدم وملاحقٌ قد أُجليَ من بلده إلى قريتنا، فلا يستطيع العودة إليها؟
كانت تلك الأسئلة تدور في رأسي الصغير وتستقر فيه، فأحتفظ بها لنفسي ولا أفاتح بها أحدا سوى الأقربين من أهل بيتي.
بقيت سنوات في حيرتي بشأن " أبو حسن"، حتى كان يوم من أيام شهر حزيران عام ألف وتسع مئة وسبعة وستين، بعد أيام معدودات من احتلال إسرائيل للضفة الغربية، عندما تجمع نفر من أبناء قريتنا شيبا وشبانا، واستأجروا حافلة لتذهب بهم إلى فلسطين المحتلة قبلنا عام ألف وتسع مئة وثمانية وأربعين، والتي لم تشاهدها عين أحدهم قبل ذلك، سوى القلة القليلة من كبار السن الذين يعرفونها قبل احتلالها، وحتى هؤلاء على قلتهم أبى أكثرهم الذهاب، وفضّل أن يبقى محتفظا بالصورة التي تختزنها ذاكرته ليافا وحيفا وعكا،على أن يراها على هيئتها الحالية، وقد خلت من أهلها واستوطنها الأغراب، وتبدلت من حال إلى حال. لكن ما حيرني أن " أبو حسن " وأم حسن كانا أول الصاعدين إلى الحافلة، وجلسا في المقعد الأمامي خلف السائق مباشرة، ولعل هذا ما حفزني على المشاركة في هذه المغامرة.
دسست نفسي على صغري بين الحشود التي ملأت الحافلة، متشوقا أن أرى فلسطين التي لهجت ألسنتنا، وبُحت حناجرنا بالهتاف لها منذ تفتحت أعيننا على الحياة، والتي طالما حلمنا بالعودة إليها على هيئة غير هيئة عودتنا الحالية.
ذهلت عن نفسي، وما تذكرت أنني لم أخبر أحدا من أهلي، بأنني ذاهب مع الركب المتوجه صوب يافا أولا، ثم سائر مدن فلسطين، إلا بعد حين وبعد أن قطعنا شوطا من الطريق، لم يعد معه التذكر مجديا.
رغم لهاث حافلتنا القديمة وزفراتها المتقطعة، إلا أن الطريق إلى يافا التي كانت قبل بضعة أيام تبعد عنا مسافة دهر بطوله، ما استغرقت منا سوى أقل من ساعتين، عندما صاح السائق الذي يعرف أبو حسن ويعرف يافا جيدا:
نحن الآن على أبواب يافا، وسأريكم ميدان الساعة أولا، ومسجد حسن بيك وحي المنشية، وأبو حسن يقاطعه ويستحثه:
بل إلى طريق "سلمة" الله يخليك. فيرد عليه السائق:
لن نتأخر كثيرا، جولة سريعة ليشاهد الشباب وسط المدينة، وبعدها نتوجه حيث تريد، هذا إذا بقيت "سلمة" وبقيت "يازور" وبقيت " العباسية" وبقيت "الشيخ مونس" وبقيت "بيت دجن" وبقي شيء مما تعرف يا أبو حسن، فقد وطئتهن " تل أبيب" بأقدامها، وجثمت على صدورهن.
جالت بنا الحافلة سريعا وسط المدينة، وعدد لنا السائق معالم يافا الشهيرة القليلة الباقية على حالها، ثم انطلق بنا تحت إلحاح "أبو حسن" إلى طريق "سلمة" التي يعرفها جيدا .
كانت الدنيا غير الدنيا التي يتحدث عنها سائق الحافلة مع "أبو حسن"، حيث البنايات الشاهقة على جانبي الطريق، والمزارع التي يعرفانها قد تبدلت أحياء سكنية، وأسواقا حديثة تشقها شوارع واسعة، لكن السائق استمر في سيره وهو يكرر لأبي حسن:
لن تجد شيئا على حاله يا "أبو حسن".
وما هي إلا دقائق معدودة حتى توقف سائق الحافلة فجأة، وأشار بيده ناحية اليمين، ورأيت "أبو حسن" ينتصب من مقعده واقفا، ويلقي بنفسه من باب الحافلة، ميمما وجهه صوب البناية التي وقفت الحافلة أمامها فاردا ذراعيه على سعتهما، كأنما يريد أن يحتضن العمارة ذات الطوابق الأربعة كلها. خطوات قليلة توقف بعدها أبو حسن عن اندفاعه، كأنما زاغ بصره وتنكبت خطواته، وخرَّ على وجهه صعقا.
واندفع ركاب الحافلة يحيطون به محاولين إيقاظه من غيبوبته، بينما هرعت أنا الفتى الصغير بينهم إلى أقرب شقة في العمارة، التي كان أبو حسن يتوجه صوبها باحثا عن قليل من الماء، نرشه على وجهه، لعله يفيق من غيبوبته.
وسمعت سائق الحافلة يقول للركاب:
إنها عمارته وهذه الأرض التي ترونها على مد البصر أرضه، وبياراته التي كانت كلها لأبي حسن الذي لا تعرفونه، ابن مختار "سلمة" وكل هذه الأرض كانت ملكا لأبيه.
كان سكان الشقق الثماني يتطلعون من شرفات مساكنهم أو من نوافذها صوبنا نحن ركاب الحافلة، المتحلقين حول رجل منا ملقى على الأرض في غيبوبة.
قرعت باب أول شقة في الدور الأرضي وطلبت قليلا من الماء. ناولتني المرأة ساكنة الشقة وعاء فيه ماء، عدت به مسرعا فرششنا منه قليلا على وجه أبي حسن فأفاق من غيبوبته، وعدت من فوري لأرد الوعاء للمرأة فإذا بها تسألني بلغة عربية ولهجة مصرية:
جرى له إيه الراجل ده؟! فأجبتها:
إن هذه العمارة عمارته.
فصمتت ولم تعلق بشيء، أو أنني ما انتظرت حتى أسمع منها أو من غيرها من سكان العمارة أي تعليق .
عدت إلى ركاب الحافلة الذين ساعدوا "أبو حسن" على النهوض والصعود إلى الحافلة، وساعدوا زوجته أم حسن التي أغمي عليها أيضا عندما شاهدت زوجها على تلك الحال، وعدنا أدراجنا منكسي الرؤوس طيلة الطريق كأن على رؤوسنا الطير. ما رأينا من فلسطين غير جزء يسير من يافا، وعمارة "أبو حسن" في سلمة.
عندما توقفت بنا الحافلة في ساحة القرية كانت الشمس قد آذنت بالمغيب، فانسل كل منا صامتا إلى بيته، ووجدت أهلي ينتظرونني في قلق وحيرة، بسبب غيابي طيلة النهار دون أن أعلمهم عن وجهتي ومكاني. واستقبلني والدي من غيظه بسيل من الشتائم والصراخ، وتبعني بعصاه يريد أن يهوي بها على بدني، فيكسر بها أطرافي جراء ما جلبته لهم من همٍ وغمٍ طيلة النهار، وحتى لا أعود لمثلها مرة ثانية. كان يجهد نفسه في تتبعي، وأنا أفر من أمامه صائحا:
هل تعلم أن أبو حسن طلع ابن مختار " سلمة "، وعنده عمارة وبيارات وابن عز مثلما قلت لكم دائما.
توقف والدي عن مطاردتي وهو يسأل:
ماذا قلت؟
قلت الذي سمعت، "أبو حسن" ابن مختار "سلمة"، وله عمارة أربعة طوابق وأملاك كثيرة، وقد سقط اليوم مغشيا عليه عندما رأى عمارته. فذهل والدي مما سمع، وكف عن مطاردتي وتقريعي، وغاب في صمت عميق.
( سلمة ويازور والعباسية والشيخ مونس وبيت دجن) أسماء قرى مجاورة لمدينة يافا. 30/1/2014