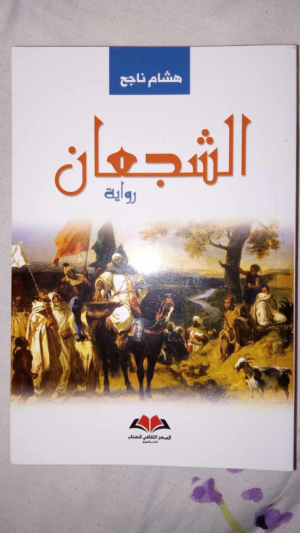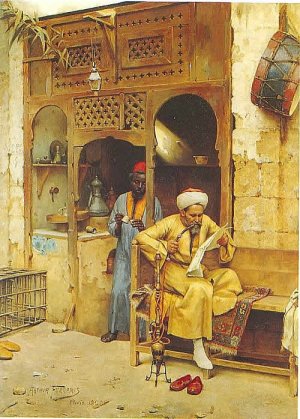“العنوان في التراث العربي” هو الموضوع الذي نعنى به في هذه الدراسة ، وسنحاول أن نتأمل الظاهرة (ظاهرة العنونة) في نشأتها وتطورها ، ودوافع هذا التطور الاجتماعية ، والنفسية ، والثقافية ، والمنهجية . ونعرف – بالخبرة العملية المباشرة – أن العنوان – بالنسبة للكتاب ، أو للمقالة – يشغل مكان “التسمية” للمولود ، فتسمية هذا المولود هي إعلان واعتراف عام بوجوده ، وصحة نسبته ، وهذا شأن العنوان بالنسبة للكتاب ، حتى وإن كان عنوان الكتاب أو أية مدونة ، آخر ما يخطه المؤلف ، غير أنه سيبقى أول ما يقرؤه المتلقي ، ويتفاعل معه ، وهذه أمور أصبحت بدهية.
الاهتمام بالعنوان يشغل مساحة واضحة في اهتمام الدراسات النقدية المعاصرة ، ويمكن أن نزعم أننا قرأنا أكثرها في صورتها الأصلية ، أو تعرفنا عليها من خلال عناية الباحثين السابقين بهذه الدراسات ، التي سبقتهم بالطبع . وقد يعد هذا بمثابة “ثغرة” في هذه الدراسة ، لأننا نعرف أنه لا يحق لباحث أن يفيد من مصدر وسيط ، فلا مناص من استقاء الرأي من مصدره الأول ! غير أننا في توجهنا عبر صفحات هذا البحث ، ستكون لنا وقفة تعريفية مختصرة بأهم جهود هؤلاء السابقين في بحوثهم حول (العنونة) لتكون مجرد توطئة لما يتوجه إليه اهتمامنا ، وهو : “العنوان في التراث العربي” . ولن نغفل جهود الباحثين السابقين ، الذين أعطوا العنوان في التراث العربي مساحة من اهتمامهم ، غير أن هذا الاهتمام بالعنوان في التراث – وكما سنبرهن عملياً في هذه الدراسة – ظل محدوداً جداً ، أو متعجلاً ، أو خاضعاً في قراءته لمفاهيم نقدية وفلسفية غربية ، أو بعبارة أخرى : ليست من ابتداع العقل العربي أو ثمرة لتأمل نشاطه في هذا الاتجاه (اتجاه العنونة) ، كما أنها لم تكن متشبعة بالمفاهيم ، والتوجهات التي حددت مسار هذا التراث العربي عبر القرون .
وبالإجمال يمكن القول إن النسبة العالية من مساحة الاهتمام النقدي العربي بالعنوان ، تستقر على قاعدة من مفاهيم الفكر النقدي الغربي: الفرنسي/ الأوروبي/ الأمريكي(1) غالبا ، أو دائما ، وهذا الانحصار في المصطلح النقدي الغربي أفاد بدرجة كبيرة ، في كشف أسرار العنونة ، وبخاصة فيما يؤدي إلى الكشف عن وظائف العنوان ، وأثره في المتلقي ، وصلته ، أو صلاته بالمتن الذي يتصدره ، سواء كان قصيدة ، أو ديواناً شعريا ، أو رواية ، أو مسرحية .. إلخ . غير أننا نلاحظ أن الغالبية العظمى من العناوين المستدعاة لأداء هذا الدور – أو هذه الأدوار – الكاشفة ، إنما هي عناوين عصرية ، أو حديثة ، اختيرت بعناية لتؤدي الدور المنوط بها ، بتوجهات تلك التقسيمات، والمصطلحات الممنهجة – لدى الباحثين الغربيين – لما يتوقعون من علاقات عناوينهم بإبداعاتهم(الغربية)(2) ، ومن ثم ظل العقل العربي ، والوجدان العربي العام – في جوهر خصوصيته – خارج دائرة الاهتمام ، أو يحتل مساحة محدودة ، باستثناء دراسة محمد عويس (أستاذ الأدب العربي بجامعة المنيا) وهي بعنوان : “العنوان في الأدب العربي : النشأة والتطور” من ثم تعد المحاولة المؤسسة للبحث في هذا الاتجاه ، وسنعرض لهذه الدراسة المميزة ، ولغيرها التي أسهمت في كشف أقنعة ظاهرة العنونة من زوايا مختلفة، وإن تكن عنايتها بالعنوان في التراث العربي ، تأتي عابرة ، كما تأتي اختياراتها ، مما آثرت من عناوين الإبداع العربي – في أشكال مختلفة – مستقاة في إطار المنتج الأدبي عبر القرن العشرين ، أو النصف الثاني منه على الأكثر .
أولا : العنوان : اللفظ والدلالة في المعجم :
جاء في “معجم لسان العرب”(3) ، في مادة (ع ن ن = عنن) : عنَّ عن الشيء يعِن ، ويعُن ، عنناً ، وعنوناً : ظهر أمامك ، وعنَّ يعِن ويعُن عناً وعنوناً واعتن : اعترض وعرض .. والاعتنان : الاعتراض . والعُنُنُ : المعترضون بالفضول … ورجل مِعَنّ : يعرض في شيء ، ويدخل فيما لا يعنيه ، ويقال : امرأة مِعِنّه ، ورجل مِعِنْ : تعتن وتعترض في كل شيء .. والمِعَنْ : الخطيب .. وفي حديث طهفة : برئنا إليك من الوثن والعنن ، الوثن : الصنم ، والعنن : الاعتراض ، من عنّ الشيء : أي اعترضه … وفي حديث عليّ في ذم الدنيا : ألا وهي المتصدية العنون، أي التي تتعرض للناس ، وفعول للمبالغة … والعَنُّ : المصدر ، والعنن : الاسم ، ومنه سمي العِنان من اللجام ، عناناً لأنه يعترضه من ناحيته ، لا يدخل فمه منه شيء … والعانُّ من السحاب : الذي يعترض في الأفق … ويقال للرجل الشريف العظيم السؤدد : إنه لطويل العِنان ، ويقال : إنه ليأخذ في كل فن وعن وسن ، بمعنى واحد …. وفي حديث عبدالله بن مسعود : كان رجلٌ في أرض له إذ مرت به عَنانةٌ ترهيأ ؛ العانة والعَنانة : السحابة ، وجمعها عَنان ، وفي الحديث : لو بلغت خطيئته عَنان السماء ؛ العَنان ، بالفتح : السحاب …. وأعنان السماء: نواحيها … وأعنان الشجر : أطرافه ونواحيه .
لقد أطلنا – نسبيا- بتعقب تقلبات مادة (عنن) ، واختلاف معانيها ، لنؤكد أمرين : أن هذه المادة ذات المعاني المختلفة ، كانت معروفة ، ومألوفة لدى العصور القديمة، وأنها – في دلالتها العامة – تعني : الضبط ، والمنع ، والتحكم ، والاتساع ، والارتفاع ، والظهور … إلخ ، مما يمكن تأويله أو استلهامه من معنى عِنان (بالكسر)= اللجام ، وعَنان (بالفتح) = السحاب . وليس يصعب أن ندرك ما يعنيه مصطلح “العنوان” الذي لم يغادر المعنيين السابقين .
على أننا نصل في النهاية إلى “عنوان الكتاب” ، وهنا يقول لسان العرب : “وعننت الكتاب ، وأعننته لكذا ، أي عرضته له ، وصرفته إليه . وعَنّ الكتاب .. كعنونه ، وعنونته ، وعلونته بمعنى واحد مشتق من المعنى .. وسمي عِنواناً ، وعُنوانا ، لأنه يعن الكتاب من ناحيتيه .. ومن قال “علوان الكتاب” جعل النون لاماً ، لأنها أخف وأظهر من النون ، ويقال للرجل الذي يُعرّض ولا يصرح : قد جعل كذا وكذا عنوانا لحاجته .. والعنوان : الأثر ؛ قال سوّار بن المضرب :
وحاجة دون أخرى قد سنحت بها = جعلتها للتي أخفيت عنوانا
قال (ابن بري) : وكلما استدللت بشيء : تظهره على غيره فهو عنوان …
قال الليث : العلوان لغة في العنوان غير جيدة ، والعنوان بالضم ، هي اللغة الفصيحة .
وقال أبو داوود الرواسيّ : لمن طلل كعنوان الكتاب .
وقال (ابن بري : ومثله لأبي الأسود الدؤلي ) :
نظرت إلى عنوانه فنبذته = كنبذك نعلا أخلقت من نعالكا
لقد انتهى ما اقتبسناه عن (لسان العرب) ، والطريف أنه أوصلنا – بعد الصبر والتعقب – إلى أن مصطلح : “عنوان الكتاب” قد استخدمها شاعر قديم : “لمن طلل كعنوان الكتاب” ، وأن التعبير العامي الشائع في بعض جهات ريف مصر ، حين يقولون :العلوان، باللام ، ليس خطأ ، وليس لحنا ، وإن لم يكن الأفصح!!
وقد نجد أهم ما نطلب في تحديد العنوان : وصفاً ، وتحديداً ، ووظيفة لدى صانعه ، ولدى متلقيه ، في عبارة جامعة – مختصرة عند جيرارد جينيت ، وهذا نصها :
Title
A title is a set of linguistic signs that may appear at the head of a book or any other published text or work of art to designate it, indicate its subject matter as a whole, and to entice the targeted public. The three functions are not necessarily all fulfilled at the same time: only the first is obligatory. The other two are optional and supplementary (4)
* * *
ثانيا : تنوير جانبي مؤثر من مقدمة ابن خلدون :
قد ينتابنا مستوى من العجب لغرائب العناوين التي نصادفها في مؤلفات تراثية عربية في شكل “كتب” أو “مقالات” – (مما كان يدعى “رسالة” ، مثل : رسائل الجاحظ ، ورسائل إخوان الصفاء ، فيما بعد ، وعناوين المقامات فيما بعد البعد) . وستكون لنا وقفة مع هذه العناوين الطريفة ، على الأقل من زاوية علاقة العنوان بالموضوع/المضمون الذي يتصدره . وما من شك في أن عجبنا يزداد حين “نكتشف” أن ظاهرة العنونة في التراث العربي ، مع ما تتسم به من الغرابة والطرافة ، لم يلتفت إليها باحث قديم ، وإن جرى التعليق على بعض منها (وهذا غير ما نتقصده من طرح الظاهرة في صورتها الشاملة ، وتعقب مراحلها ومظاهرها) . وقد يزداد العجب إذ ندرك أن “العنوان” ظاهرة قديمة جداً ، وأنه يشغل مكاناً في الإدراك الفطري للأشياء . فقد تواترت المعارف/المدركات على العقل البشري ، ومن ثم راح يختزنها مكوناً ما نطلق عليه “الذاكرة” ، وهذه الذاكرة لا تأذن بالفوضى (في غير حالات مرضية) ، وإنما تستعين بتقسيم المدركات إلى أنواع ، وسلالات ، وسياقات ، وتداعيات ، وتراتب أزمنة ، وعلاقات … إلخ ، مما يجعل من الاهتداء إلى ضرورة وجود (علامة مميزة) فارقة ، تساعد الذهن على استعادة بعض ما يختزنه من المعرفة ، وعلى هذا الأساس وُجد تقسيم “الحقول المعرفية” ، وخواص الحواس ، والحقول الدلالية .. وما إليها .
وقد حرصت الكتب المقدسة على أن تميز نصوصها ، أو مراحلها ، بأرقام وعناوين ، وهذه الكتب المقدسة من أقدم المدونات التي عرفها الإنسان ، وتداولتها المجتمعات التي تقبلتها ، واتخذتها إماماً للدين والدنيا ، وقرأها الناس على مستوياتهم.
ففي “العهد القديم” تتعاقب “الأسفار الخمسة” المكونة للتوراة [ سفر التكوين – سفر الخروج – سفر اللاويين – سفر العدد – سفر التثنية ] ومن بعدها تتوالى أعمال الرسل ، ومن بعدها مزامير داوود ، ومن بعده “نشيد الإنشاد الذي لسليمان” ، وهكذا تصدر العنوان محاور العقيدة ، وتسلسل أنبيائها ، والتعريف بأهم ما نُسب إلى كل منهم . ولا يختلف (كتاب العهد الجديد لربنا ومخلصنا يسوع المسيح) عن النسق السابق ، فبين أيدينا أربعة من الأناجيل التي اعترفت بها الكنيسة ، يحمل كلٌ منها اسم الحواري أو الرسول الذي كتب النص [ متّى – ومرقس – ولوقا – ويوحنا ] وهكذا تتعاقب أعمال الرسل مرة أخرى . أما القرآن الكريم ، فقد حملت سوره (الأربع عشرة بعد المائة) عناوينها ما بين [ فاتحة الكتاب و سورة الناس ] . هذا التقسيم ، وهذه العناوين (أسماء السور) أساس من أسس العقيدة ، لا يملك بشر أن يغير فيه ، غير أن الجهد البشري ما لبث أن أدخل تفصيلا إضافياً لييسر للذاكرة عملية الحفظ ، وعملية الاستعادة ، فكانت : الأجزاء ، والأحزاب ، والأرباع ، وكل ذلك من صنع البشر ، بقصد تيسير المعرفة والحفظ ، والاهتداء إلى مواقع الحاجة حين تعن إليها ضرورة .
ويمكن أن نلتمس للعقل البشري عذراً في غفلته عن تأمل الأقسام ، وما يتصدرها من عناوين ، بما يترتب على ذلك من تشريح الظاهرة (ظاهرة العنونة) ، والكشف عن وظائفها ، وعلاقاتها ، وأثرها في استجابة المتلقي للنص . أما الاعتذار عن الغفلة فيرجع إلى الألفة ، والعادة ، وقد يضاف إليهما – من ناحية الكتب المقدسة خاصة – أن قدسيتها عند قارئها قد تكبح إرادته في التفتيش أو التفتيت للكشف عن أسرار النص ، وبخاصة إذا كان هذا النص يصل إلى متلقيه عبر وسائط بشرية (الأحبار ، والكهنة ، والمشايخ) فإنهم إذا لم يتولوا هذا بأنفسهم ، لن يأذنوا لأحد من غير المنضوين إلى أنساقهم ، القيام بمثل هذا العمل !!
وهنا نصل إلى ابن خلدون (ولد 732هـ- توفي 808 م) ، ففي مقدمته الضافية(5)، التي أرخت للعمران البشري ، وكشفت عن شرائط تقدم الأمم والجماعات ، وأسباب تخلفها ثم انهيارها ، لتعقبها غيرها ، في هذه الدراسة الشاملة سنجد عبر أكثر من ثمانمائة صفحة ما يمكن أن نكتشف فيه (جانبا) من أسباب غفلة العقل العربي (المثقف) عن الاهتمام بظاهرة العنونة ، ودراستها ، على الرغم من أنه أهمل كتابة العنوان حينا ، ومارسها بقوة ، وبتفصيل ، وبكثير من التحري والدقة ، في أحيان أخرى كثيرة ، وكانت لهذا العقل العربي توجهات ، وطرائق ، وتصانيف خاصة ، انفرد بها (تراثنا) عن أي محرر قديم ، سابق عليه ، أو لاحق به !! وهذا هو المحور الأساسي الذي نعنى به في هذه الدراسة .
أما ابن خلدون فقد ذكر في تعليلاته لتراجع الخلافة الإسلامية ، أو الدول العربية من بعدها ، ما يمكن أن يعد – بالتأمل – سبباً أساسيا في جمود أساليب التأليف ، وتقاليده في الكتابة ، بعد أن غادر الفكر العربي ، والإبداع العربي ، عصر التداول الشفاهي للمعرفة ، ودخوله عصر الكتابة ، عبر الوراقين ، والنساخ ، وحتى مشارف عصر المطبعة .
في اهتمام ابن خلدون بالعلوم (الشرعية والفكرية والأدبية) أشار – تبعا- إلى ما يمكن أن يعد اقتراحا بالتقسيم ، وصورة مبكرة للعنونة ، فمثلا يستخدم مصطلح : الباب أو الأبواب ، وهو مسبوق إلى هذه القسمة ، غير أنه في رصده لتفاصيل النشاط العلمي يضع أمام أعيننا “عناوين” واضحة ، من حقها أن تتصدر أبواباً وفصولا ، وأن تغادر موقعها السياقي في أن تكون (حُكما) يصف أو يلاحق موضوعا جزئيا بعينه ، ففي علم الحديث – على سبيل المثال – نجد المصطلحات : الصحيح – الحسن – الناسخ والمنسوخ – الغريب – المؤتلف والمختلف ، وفي الفقه نصادف عناوين الأقسام : الوجوب – الحظر – الندب – الإباحة – الكراهة – التحليل .. إلخ .
وفي فقرة مطولة –نسبيا- يعرض ابن خلدون لمستويات تدخل العقل في الموروث العلمي الذي أنتجه السابقون ، فيحصرها في :
استنباط فروع أو أقسام أو أبواب أو مسائل يضيفها لتعم المنفعة .
أن يتدخل بالشرح والإبانة لما عساه أن يكون قد استغلق على غيره .
أن يعثر المتأخر على غلط أو خطأ في كلام المتقدمين ، ممن اشتهر فضله ، وبعد في الإفادة صيته .
أن يكون الفن الواحد قد نقصت منه مسائل أو فصول .
أن تكون مسائل العلم قد وقعت غير مرتبة في أبوابها ، ولا منتظمة ، فيرتبها ويهذبها .
أن تكون مسائل العلم مفرقة في أبواب مختلفة من علوم أخرى ، فيجمعها تحت عنوان مبتكر .
أن يكون الشيء من التآليف التي هي أمهات للفنون مطولا مسهباً ، فيقصد إلى تلخيصه .(6)
وبتأمل هذه المسارب السبعة التي رخص فيها ابن خلدون لجيل محدث بالتدخل في المنجز العلمي الموروث ، نلاحظ أنه يحوم حول ضرورة ضبط تفاصيل العلوم بمصطلحات هي “عناوين” جديدة ، دون أن يصرح بهذا تحديداً .
ولا يتردد هذا المؤسس العظيم لعلم الاجتماع ، على غير سابقة ، في أن يدين اتجاهات ، وحركات ، وسياسات ، اشتركت جميعها في تعطيل التقدم العلمي العربي ، وتراجعه ، ولعل في مقدمة أسباب الخذلان ، والجمود العلمي : ارتكاس التطلع الحضاري للأمة العربية (في جهات متعددة منها ، بعد أن تقسمت في ممالك ودول مختلفة)، فبعد أن كانت الغلبة لنزعة التحضر ، وتأسيس المدن ، والاهتمام بالعلم ، حدث ما يمكن أن يعد نوعا من الردة ، إذ استيقظت طموحات البداوة(7) ، وتحولت إلى مثل أعلى للقوة ولبناء الشخصية والدولة على السواء ، مما صرف دعاة العمران عن الاهتمام بالتجديد والبحث، وأيقظ لدى المغامرين أحلام الفتح والغلبة والاحتكام إلى القوة ، والحشد ، وليس إلى الحضارة والتقدم . ويقدم مثلا بالحياة العلمية في مصر ، في زمانه ، إذ كانت زاهرة عامرة بالمؤسسات العلمية ، المحتشدة بطلابها ، وبما يحتاج هؤلاء الطلاب من المؤلفات والنفقات ، وأسباب الإقامة .. إلخ ، بالقياس إلى ما يشاهده – في زمانه – بمدينة فاس وسائر أقطار المغرب التي يصفها بأنها خلت من حسن التعليم(8) ، من لدن انقراض تعليم قرطبة والقيروان ، ولم يتصل سند التعليم فيهم ، فعسر عليهم حصول الملكة ، والحذق في العلوم !! فكأن ابن خلدون يرى أن “التحضر” و “التقدم” سياق ينبغي أن تتواصل حلقاته ، وتتدافع موجاته ، فيصل إلى الابتكار ، والتجديد المستمرين ، أما إذا انقطع خط التواصل فإن الجمود ثم التراجع هو القانون الذي يحكم في هذه الحالة . كما يحمل ابن خلدون على اتجاه الفكر العربي/الإسلامي إلى اختصار المطولات ، ونظم العلوم الذي شاع في زمانه ، ويرى أن هذا الاتجاه يخل بأسس التعليم ، ويعطل ملكة الابتكار .
وفي أماكن أخرى متناثرة من دراسته الضافيه ، يعلي من شأن تعليم الخط في مصر خاصة ، ويذكر أن بها معلمين مختصين لتعليم الخط ، كما يذكر أن الطباع المتحضرة مركوز فيها الاستزادة من العلم بعد المعرفة بالمنجز فيه . ويشير إلى مبدأ منهجي مهم ، وهو ضرورة أن تتراتب دراسة العلوم على أسس الإدراك والاستطاعة ، والإلمام بالمبادئ ، ويذكر على سبيل التمثيل : أن النظر في القرآن والحديث لابد أن تتقدمه العلوم اللسانية (علم اللغة ، وعلم النحو ، وعلم البيان ، وعلم الآداب .. إلخ)(9). ويدلل ابن خلدون على سعة إطلاعه على مؤلفات السابقين بأن يرصد تطور التأليف في بعض العلوم ، وكيف تتفرع الأبواب ، وتتعدد الفصول مع استمرار التحصيل والتجريب(10) . وقبل أن ننهي هذه الإضاءة على جهد ابن خلدون في التعليل للجمود العلمي (بل التراجع) الذي أصاب حركة التأليف في زمانه ، ومن ثم عطل ملكة الابتكار ، يقدم – فيما نحن بصدده تحديداً ، تفسيراً لثلاثة عناوين محددة من التراث السابق على زمانه :
فحين عرض لجهد الخليل بن أحمد الفراهيدي في وضع معجمه بعنوان :”كتاب العين”(11) أبان عن طريقته في تحديد أصول الكلمات ، وتقلباتها ، ومن ثم إمكان حصرها ، فإذا عرض لسبب تسمية هذا المعجم بـ(العين) ذكر أن الخليل بن أحمد مضى في أثر المتقدمين من المؤلفين العرب ، الذين كانوا يذهبون في تسمية دواوينهم إلى مثل هذا ، وهو تسميته بأول ما يقع فيه من الكلمات والألفاظ.
وبما ذكر في (أ) كأنما أبان لنا عن سبب تسمية القصائد بمطالعها ، فنقول قصيدة : (هل غادر الشعراء) لعنترة – و(قفا نبك) لامرئ القيس – و(بانت سعاد) لكعب بن زهير .. وهكذا . وهذه إحدى وسائل “العنونة” التي اختصت بها الثقافة العربية ، وليس لها سابقة في ثقافة أخرى ، ويمكن أن نضيف في هذا السياق أن ذكر المطلع كعلامة ، أو عنوان يمكن أن يتخلى عن موقعه في مواقف بعينها ، ليفرد مكانا لتخصيص أكثر دقة ، ويتجلى هذا في ذكر قافية القصيدة المختارة ، أو المقصودة بالإشارة ، كأن نقول : (لامية العرب) للشنفرى ، و(تائية) كثير عزة، و(سينية) البحتري ، و(همزية) البوصيري .. وهكذا .
(ج) في معرض حديثه عن كتاب :”الأغاني” (للأصفهاني) علل هذه العنونة بالآتي : ” ألف القاضي أبو الفرج الأصبهاني كتابه في “الأغاني” ، جمع فيه أخبار العرب ، وأشعارهم ، وأنسابهم ، وأيامهم ، ودولهم ، وجعل مبناه على الغناء في المئة صوتاً التي اختارها المغنون للرشيد” .. إلخ . وبهذا شرح سبب اختيار الأصفهاني لعنوان كتابه .(12)
وفي ختام هذا العرض الموجز لجُهد ابن خلدون (المبكر) في ذكر بعض العناوين ، ومحاولة التعليل لها (العين – الأغاني ) فلا نشك في أن استيعاب مادة “المقدمة” ستكشف عن إضاءات أخرى . أما فيما نحن بصدده ، فقد كشف لنا بوضوح أن انصراف العقل العربي عن الابتكار ، والكشف ، ونقد المنجز الذي سبقت به العصور ، وتنميته ، يتأسس على غياب المثل الأعلى الطامح إلى التقدم ، وانحراف الإدراك العام إلى اعتناق قيم البداوة ، والانخداع بما تتصف به من العصبية ، وحب الغلبة ، وهذا – في جملته – معطلٌ للتقدم العلمي ، وللإتقان بوجه عام .
* * *
ثالثا : تنوير مؤسس للعنوان في التراث العربي :
يعد صدور كتاب “العنوان في الأدب العربي : النشأة والتطور” لمؤلفه محمد عويس (أستاذ الأدب العربي بجامعة المنيا) بمثابة وضع حجر الأساس لبناء تصور فكري وفني للعنوان في التراث العربي . وهذا الكتاب (الذي صدرت طبعته الأولى عام 1988) لا يمثل أول طرح للقضية ، فقد اتجهت جهود التراجمة العرب في المغرب ، ثم في المشرق لاستمداد نظريات ، وأفكار ، وفلسفات لغوية – في لغاتها الأجنبية – عن العنوان وفنونه ، وانعكاساته .. إلخ . ونقلها إلى اللسان العربي ، ولكن هذه الترجمات لم توجه الأفهام (عندنا) إلى استثارة الموضوع من منظور تأسيسي ، يكشف عن جذور فنون العنونة في التراث العربي ، وإنما اتجهت جهود نقادنا (وفي مقدمتهم محمد فكري الجزار في مصر ، وبسام موسى قطوس في الأردن ، فضلا عن مقالات مترجمة أو موضوعة غير قليلة) إلى الكشف عن أبعاد المصطلح ، وتقلباته ، وآثاره .. إلخ ، معتمدين على تلك الدراسات التي سبق إليها نقاد الغرب ، ليتوجهوا – أعقاب ذلك – إلى اختيار بعض عناوين الكتب ، والدواوين ، والقصائد ، والروايات المعاصرة ، أو الحديثة ليجروا عليها تطبيقاتهم المستمدة من تلك المصادر الأجنبية . وهذا جهد علمي مشكور ، ومؤثر ، وإيجابي بدرجة ما ، غير أنه استبعد تماماً – أو انشغل عن – محاولة الكشف عن جذور العنونة في تراثنا العربي ، ربما لأن هذا الموضوع يحتاج إلى جهد زائد ، واتساع في التخصص ، وصبر على تعقب الظواهر ، ومن هنا تأتي أهمية ما صنع محمد عويس الذي وجه النصيب الأوفى من دراسته عن: “النشأة والتطور” إلى الموروث العربي في مجال العنونة ، وبهذا ملأ فراغا بحثيا ، لم يسبق التعرض له . لقد بدأ بداية تقليدية بأن طرح معاني وتقلبات مادة (العنوان) في المعاجم العربية ، وهذا ما اخذ به كل من عرض للموضوع فيما بعد ، وإن تقاصر جهدهم عن تلك المحاولة المبكرة ، التي ربما استفاضت حتى تجاوزت مطالب البحث في العنونة .
تتكون دراسة محمد عويس من سبعة فصول ، عن :
المعنى والمبنى .
العنوان قبل انتشار التدوين .
عوامل تطور العنوان في عصر التدوين .
العنوان في عصر الطباعة إلى أوائل القرن العشرين .
عنوان المقالات الأدبية في النصف الأول من القرن العشرين .
عنونة القصيدة العربية في النصف الأول من القرن العشرين .
العنوان في الشعر المعاصر : دراسة فنية وتطبيقية .
وكما نرى فقد قدم الباحث في ما يتجاوز أربعمائة صفحة ، دراسة وافية ، ضافية، ربما أثقلها شيء من الإسهاب ، والإطالة التي لا يحتملها موضوع شديد التركيز ، مثل : “العنوان“ . وقد نشير إلى شيء من ذلك ، وبخاصة حين تؤدي رغبة الإشباع ، والإطالة إلى استدراج البحث ، لطرح نقاط هو في غنى عنها ، ونحدد بعض الأمثلة على ما ذكرنا:
فقد ربط الباحث بين أسماء الأماكن والعناوين ، وهذا صحيح بالمعنى العام، فاسم الشخص ، أو اسم المكان محدد لهويته ، فكأنما يؤدي إحدى أهم وظائف العنوان ، ولكننا لا نملك أن نوافق الباحث على أن يعد كل اسم هو عنوان للرابطة العرفية أو الطبيعية بين الاسم والعنوان ، إذ يقول “إن أسماء الأماكن والبلدان ، وما شابهها كانت عنوانات وضعها العربي لربط معارفه الشفهية المختزنة بعضها ببعض ، حتى أسماء آلهته المتعددة ، كانت عنوانات رامزة إلى تعدد الآلهة في المعتقد الديني الوثني لدى عرب الجاهلية”(13) . بل ينبه إلى أن العربي القديم كان ينسب نفسه إلى هذه الآلهة ، مثل عبد يغوث ، وعبد اللات ، وعبد العزى ، كما ينبه إلى أن شيوع اتخاذ العربي لنفسه كنية ولقباً بالإضافة إلى اسمه ، كان إمعانا في العنونة الدالة على شخصيته(14) . ويرى الباحث الفاضل في مثل هذا ما يحمل معنى العنوان “غير المباشر” .
وحتى مع تخفيف وصف العنوان بأنه غير مباشر ، لا يصح في رأينا ، على الأقل لأن هذا المسلك إنساني عام ، وليس مختصا بالعرب ، فتسمية الأشياء فطرة مركوزة في العقل الإنساني ، ومن ثم لا مجال لإفراد العرب وتخصيصهم بها ، وتقصيها وكأنها اختراع وعلامة خاصة بهم .
وقد تطرق الباحث إلى الأسماء التي حملتها سور القرآن ، ذكرنا ذلك سابقاً في حدود إمكان طرح سؤال عن : إذا كان القرآن مكونا من سور/موضوعات ، استقل كل منها بعنوان ، لماذا لم يستلهم الباحث العربي ، أو الأديب العربي هذه الطريقة فيما يكتب من شعر أو نثر ، وانتظر أزمنة مترامية ، حتى جاءته الالتفاتة من الغرب ؟ غير أن محمد عويس يمتد بهذا المعنى فيخرج به عن مغزاه ، ويثير بلبلة وقلقاً لا علاقة لهما بموضوع دراسته ، وذلك حين يستعين بنص منقول عن السيوطي ، وفيه يقول :” ولك أن تسأل فتقول : قد سميت سور جرت فيها قصص أنبياء بأسمائهم .. وقصص أقوام كذلك .. ومع هذا كله لم يفرد لموسى سورة تسمى به ، مع كثرة ذكره في القرآن ، حتى قال بعضهم : كاد القرآن أن يكون كله موسى ، وكان أولى سورة أن تسمى به سورة طه ، أو القصص ، والأعراف ، لبسط قصته في الثلاثة .. وكذلك قصة آدم ، ذكرت في عدة سور ، ولم تسم به سورة ، وكأنه اكتفاء بسورة الإنسان ، وكذلك قصة الذبيح من بدائع القصص ، ولم تسم به سورة الصافات ، وقصة داوود ذكرت في سورة ص ، ولم تسم به ..” إلخ . ولا نريد أن نطيل في طرح مثل هذه التأملات التي لا تخلو من غرابة ، لأننا – نحن البشر – لا نملك أن نقترح على الله تعالى ، كما أن كبار مفسري القرآن لم يفتهم أن يعللوا لأسباب التسمية ، وليس شرطاً أن يكون المعنى الظاهر أو الطريف سببا مقنعاً للتسمية(15) .
ويذكر صاحب كتاب (العنوان في الأدب العربي) – معانداً قوانين التطور ، وثوابت التقدم الحضاري : أن العنوان عند الغربيين ، قد استمد فكرته من العناوين العربية أو من العنوان العربي !! لقد بدأ طرحه بما يمكن أن يعد من قبيل المسلمات ، من مثل : أن الغرب هو الذي سبق إلى العناية بالتراث العربي ، وتحقيقه ، وطبعه ونشره ، غير أنه يرتب على هذا بأنه – محمد عويس – لا يستبعد وجود آثار عربية دفعت العنوان الغربي الحديث إلى التطور ؟!(16) . وقد يستعين بعبارة اريك دي جرولييه ، الذي يؤكد أن للحضارة العربية أهمية كبرى لتاريخ الكتاب ، ومن ثم لتاريخ تطور العنوان ، فالعرب هم الذين أدخلوا الورق إلى أوروبا ، وكانت حضارتهم بعد الإسلام ملتقى التيارات الحضارية التي جاءت من الصين والهند واليونان !!(17) . والمقدمات صحيحة ، فالحضارة العربية في بلاد الشمس المشرقة ، سابقة بالضرورة لحضارة بلاد الجليد والضباب ، وهي التي اقتنصت ما امتازت به الحضارات المعاصرة لها ، والسابقة عليها ،و نقلتها إلى أنحاء العالم ، ولكن ما علاقة هذا كله – بما فيه التعريف بالورق ، والوراقة – باستحداث تقليد أن يتصدر الوثيقة (الكتاب ، أو الرسالة ، أو القصيدة) عنوان مميز ، محدد ، قصد به توطئة قبول المتلقي لهذه الوثيقة ؟!
باستثناء هذه المسائل المحددة ، التي رأينا أنها زائدة عن المطلوب ، أو متجاوزة لما هو موثق ومشهور ، نؤكد أن كتاب محمد عويس ، هو المؤسس الحقيقي للموضوع الذي نطرحه في هذه الدراسة عن (العنوان في التراث العربي) ، ولا يؤثر في هذا – سلبا أو إيجابا- أن تطلعنا إلى البحث عن العنوان في التراث ، لم يكن بدافع من هذا الكتاب – موافقة أو مناقضة – بل لم نكن سمعنا به قبل أن ختم محمد فكري الجزار كتابه: (العنوان وسيميوطيقا الاتصال الأدبي) بذكر عناوين الفصول والمسائل التي طرحها كتاب عويس – حتى وإن حمل معنى الإشادة والتقدير- فإنه سلوك لا يخلو من غرابة وتساؤل(18) . وسنرى أننا سنستعين بالكتابين معاً (عويس والجزار ، ومن بعدهما : قطوس) ما احتاج الأمر إلى ذلك ، وإذا كان كتاب “عويس” قد أعطى الشق التراثي أربعة فصول متصلة تجاوزت صفحاتها المائتين والثلاثين من الصفحات ، فقد أصبح مطلوباً في هذه الدراسة أكثر من الآخرين ، على أن هذه الدراسات جميعاً – بما فيها دراسة محمد عويس – لم تحاول أن تكشف عن أساس فلسفي ونفسي وحضاري للطريقة العربية (المبكرة) لبدائل العنونة ، قبل أن تتعرف عليها في نمطها الحديث ، من خلال الدراسات الغربية عن فنون المقالة بصفة خاصة .
* * *
رابعا : في البدء كان الإنسان :
من أهم ما يلاحظ في منهج دراسة “العنوان” ، سواء عند محمد فكري الجزار في كتابه : “العنوان وسيميوطيقا الاتصال الأدبي” ، أو بسام موسى قطوس في كتابه : “سيمياء العنوان” – ولعلنا سبق أن اشرنا إلى شيء من هذا – اعتناؤهما ، وغيرهما من الباحثين، بالتأسيس النظري الغربي ، والاجتهاد في تطبيقه على عناوين مختارة ، كما لاحظنا : منتقاة من الإبداع العربي الحديث والمعاصر ، وهذه الاختيارات لابد أن يتوافر فيها الاستجابة لأسس النظرية لفلسفة العنوان ، من حيث التكوين (التشكيل اللغوي) والدلالة ، والاتصال بجسد الكتابة أو المقالة ، وأثره المنعكس على وجدان المتلقي وفكره من الوهلة الأولى .. إلخ . فإذا تطرق الباحثون إلى العناوين التراثية المرتبطة بزمن الثقافة الشفاهية ، وإنشاد الشعر (وليس كتابته) فإنهم غالبا ما يكتفون بإشارات عامة أصبحت مألوفة ، بل تتقارضها البحوث الخاصة بهذا الحقل المعرفي ، دون أن تبذل جهدا حقيقيا في التعليل والتفسير ، الذي لن يسفر عن نفسه إلا بعد تقصي الظاهرة – ظاهرة العنونة – عبر الأزمنة والمواقع ، والصيغ ، والنزعات ، والوظائف .
أصبح معروفاً أن القصائد القديمة (في العصر الجاهلي ، وحتى بداية عصر التدوين ) كانت تُعرف بالجملة الأولى من البيت/مطلع القصيدة ، مثل : قفا نبكِ ، لخولة أطلالٌ ، هل غادر الشعراء … وأمثال هذا معروف ومألوف ، وسبق في هذه الدراسة أن أشرنا إلى شيء منه ، وأضفنا إليه أنه “ربما” عرفت القصيدة – وبخاصة إذا كانت شهيرة جداً بقافيتها ، أو رويها ، واقترانه باسم شاعرها ، كأن نشير إلى عينية أبي ذؤيب ، فلا يخطئ المتلقي الخبير أن القصيدة المعنية هي تلك المطولة المشهورة ، التي تتصدر ديوان الهذليين ، ومطلعها :
أمن المنون وريبها تتوجعُ = والدهر ليس بمعتبٍ من يجزعُ(19)
فإذا أشير إلى الأبيات الثلاثة البائية لعامر بن الطفيل ، فإن المتلقي الخبير يعرف أن القصد قوله مفتخرا بنفسه :
إني وإن كنت ابن سيد عامرٍ = وفارسها المندوبُ في كل مـــوكبِ
فما سودتني عامرٌ عن قرابةٍ = أبى الله أن أسمــــــــو بأمٍ ولا أبِ
ولكنني أحمي حماها وأتقـي = أذاها ، وأرمي من رماها بمنكبِ(20)
فإذا أشار المتكلم إلى دالية الشريف الرضى في رثاء أبي إسحاق الصابي ، فقد أراد كلمته التي مطلعها :
أعلمت من حملوا على الأعواد = أرأيت كيف خبا ضياءُ النادي(21)
فإذا كانت الإشارة إلى حائية ابن مطروح في تهديد الفرنسيس ، فقد دلت الإشارة على أن القطعة المعنية ، هي تلك التي مطلعها :
قل للفرنسيس إذا جئتــه مقال صدق من قؤول فصيح
…..
دار ابن لقمان على حالها = والقيد باق والطواشي صبيح(22)
ومثل هذا كثير في ديوان الشعر العربي ، غير أن التلقي العجول للظاهرة (ظاهرة تعريف القصائد برويها وشاعرها) لم يثر اهتمام هذا الفريق الحرص على ذكر أسماء الشعراء ، وهو الأكثر تداولا ، والأدق في تمييز القصيدة من ذكر مطلعها مجرداً ، بما يعني – وهذا ما نرمي إلى إبرازه بدقة – أن اسم الشاعر ،وصحة انتساب النص إليه هو المعنى الأهم ، ولهذا المسلك دلالة توثيقية غير قابلة للالتباس ، بعد ذكر صوت الروي ، واسم الشاعر ، ودلالة ذاتية ، إذ تتميز شخصية الشاعر دون التباس ، أو اشتراك . لقد علّم الله – سبحانه – آدم أبا البشر – الأسماء كلها ، بمعنى أنه وضع في قدراته المعرفية إمكان تسمية الأشياء ، وتمييزها ، ووضع حدود فاصلة بين مفرداتها بخصوصية هذه التسمية ، التي تلتقي في معناها العام ، وهدفها ، وتختلف (في ملفوظها) حسب اللغات والطبقات ، وقدرات النطق !!
لقد اهتم العرب القدماء بأسماء آبائهم ، وأبنائهم ، فكانت المعرفة بالأنساب علماً ودراية ذات قيمة عالية عند من يتقنها ، وإذ نقلب بعض صفحات تلك الحقب التاريخية ، سنجد أن للأسماء ، وما تدل عليه من عراقة ومكانة أهمية بالغة عند العرب ، وفي القرآن الكريم مماحكة جاهلية في التملص من الإيمان بمحمد (صلى الله عليه وسلم) فيما لو كان القرآن ) نزل على رجل من القريتين عظيم ( ، ومن بعد – في التمهيد لمعركة بدر – خرج ثلاثة من فرسان قريش لمنازلة المسلمين قبل الالتحام العام ، وكان هؤلاء الثلاثة من الأنصار ، فاستنكف محاربو مكة من منازلة من لا يعرفون أنسابهم ، فنادى مناديهم : يا محمد .. أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا !! وهكذا خرج لهم ثلاثة آخرون من المهاجرين من عليا قريش في مقدمتهم حمزة وعلي – رضي الله عنهما – ومن قبل بعْثة محمد (عليه السلام) كان “حلف الفضول” وفيه تعاقد نفر من سادات قريش على التكافل في مقاومة الظلم ورد الحقوق ، وهذا فضل مشهود ، وقيل في سبب التسمية – إلى ما سبق – أن هؤلاء السادة تصادف أن كان اسم كل منهم “فضل” فسمي “حلف الفضول” . وكان من تقاليد المنازلات والمبارزات بين الجيشين ، وقبل الالتحام العام ، أن يبرز فارس معلم ، ويتوسط الساحة معلنا اسمه ونسبه ، وطالبا من أعدائه أن يتقدم أحدهم ممن يجد في نفسه أنه كفؤ له ، فينتسب ، ثم ينازله ، فإذا تغلب أحدهما على منازله ، ربما كانت عبارة: “خذها وأنا ….” ويذكر اسمه” إعلاءً لفروسيته ” .
هذه الاضاءات ، وإن تكن جزئية – تحمل معنى تقديس الاسم ، وأنه سمة لا تشاركها سمة أخرى ، ولعل هذا يعني – فيما يعنيه – أن “الإنسان” هو الأساس والجوهر في تقدير المواقف ، والمنازل ، والأعمال .. إلخ . ومن ثم باستطاعتنا بعد هذه الإشارة أن نقول : إن التراث الشعري لأية أمة ، وفي أية لغة ، لم يكن له هذا المسلك الخاص جداً في تعريف القصائد ، وتمييزها على النحو الذي أشرنا إليه .
إننا نتمهل عند هذه الخاصية (الإنسان) ، ونرى أنها – فضلا عن كونها علامة (تراثية) فارقة – تحمل جوهر الحضارة العربية ، منذ زمن بداوتها ، وحتى سطوع شمسها ، بل شموسها على أنحاء العالم وإلى اليوم .
إن ظاهرة اسم الشاعر ، أو اسم المؤلف ، أو اسم الكاتب ، أو الخطيب مرتكز أساسي في تمييز الأعمال ، وكأن هذا الاسم يقوم مقام العنوان قبل الانتباه إلى أهمية ذكر العنوان ، وإذا كانت البحوث المتعلقة بالشعر القديم في عصر المشافهة ، قد تنبهت إلى سبيلين من سبل تمييز القصائد [ بذكر المطلع – أو بذكر الروي والشاعر ] ، فإن هذه البحوث – بصفة عامة – لم تنظر لاسم الشاعر على أنه سمة فارقة ، وأنه “عنوان” قبل عصر العنونة ، وأنه ظل أساساً للتقسيم (تقسيم قصائد الشعر ، وأغراضه ، وعصوره) يُذكر مع كل نص . ولعل هذا يرجع إلى رواج بضاعة الشعر وانتشار تداوله ، والحاجة إلى الاستشهاد به ، إذ هو خلاصة (المعرفة) العربية ، الفكرية ، والفنية في زمن الجاهلية ، ومن ثم كان تمييز القصيدة بذكر أولها ، أو قافيتها قسيما لاسم الشاعر نفسه لتأكيد هذه الخصوصية التي نجدها في العنونة ، في زماننا هذا .
لقد عُني مدونو الأحاديث النبوية بذكر أسمائهم في صدر صحائفهم ، تقديراً لعظم مسؤوليتهم عما دونوا ، وكذلك سجلت أسماء النفر ، الذين عهد إليهم الخليفة الراشد (عثمان بن عفان) بكتابة المصحف وترتيب سوره ، ولم يتخل الشعر عن هذا التوثيق الإنساني ، فعرفت مجاميع الشعر المبكرة بأسماء جامعيها ، فلدينا المفضليات ، والأصمعيات ، ومن بعد : ديوان الهذليين ، وغيرهم كثير ، وفي جميع الحالات – دون استثناء- يسجل اسم جامع النصوص ، كما تسجل أسماء الشعراء في مفتتح قصائدهم ، إذا كان معروفا ، موثوقا ، غير ظنين .
ولعلنا نلاحظ – في مجال العناية بالإنسان ، وأنه صانع الفكر ، ومبدع الفن ، ومتلقيه كذلك – أن المؤلفين العرب ، في محاولاتهم المبكرة ، لم يتخلوا عن حتمية نسبة الأشعار إلى قائليها ، وذكر رواتها ، وربما تطرقوا إلى اختلاف الرواة ، أو اختلاف الرواية ، وهذا كله من منطلق العناية الفائقة بالجهد الإنساني ، بالإبداع ، بالتميز ، بإعلاء الحدود والفواصل ، وهنا يمكن أن نذهب إلى مؤلفين مبكرين ، شغلا بالتعريف بالشعر وقائليه ، وهما : محمد بن سلام الجمحي (139 – 232 هـ) ، في كتابه : “طبقات فحول الشعراء”(23) ، وابن قتيبة (213 – 276هـ) ، في كتابه : “الشعر والشعراء”(24).
لقد قسم أولهما الشعراء إلى طبقات (عشر طبقات جاهلية ، وعشر طبقات إسلامية .. إلخ) وفي كل طبقة أربعة شعراء ، فيكون اسم الشاعر البادئة الأساسية في التعريف بشعره وبمكانته ، ولم يتخل عن هذه الثوابت على امتداد كتابه الضخم ، أما ابن قتيبة في “الشعر والشعراء” فإن ما ذكر عن شعرائه – (وهم كثر = 206 شاعرا)– لم يستند إلى التقسيم الفني ، ولم يعتمد مبدأ التسلسل التاريخي ، ولم يأخذ بالشهرة ، أو الأهمية ، أو الأبجدية. لقد تقاطر الشعراء في هذا المصدر الضخم : كل شاعر بذاته ، يتصدر اسمه قبل كل شيء، ثم تأتي بعد ذلك النماذج ، وآراء النقاد في الشعر ، والأخبار التي تميز حياة هذا الشاعر ، وفنه .
خلاصة ما نريد ، وما نحاول توثيقه ، والتدليل عليه في هذه الفقرة ، وتعقب تحولاته ، وآثاره ، وشموله في أشعار الأزمنة الآتية ، بعد هذين العالمين الكبيرين (ابن سلام وابن قتيبة) ، هو أن الاسم ، اسم الشاعر تحديداً ، هو العنوان القديم ، والوسيط ، والحديث ، ربما إلى عصر المطبعة ، وإلى عصرنا ، وهذا ما سنحاول البرهنة عليه فيما يأتي .
سنعرف – في هذه الفقرة – بأهم عملين موسوعيين ، اتخذا من إحصاء أو محاولة حصر المؤلفات ، وتصنيفها تحت عناوين تكشف عن مضامينها ، ومن حقنا أن نبرز ، وأن نفاخر بسبق العقل العربي إلى إنجاز مثل هذه العملية الإحصائية ، على ضخامتها وتنوع اتجاهات مؤلفاتها . وسنرمي من وراء ذلك إلى تحصيل فائدتين :
الأولى : هذا الحرص العربي على ذكر أسماء المؤلفين ، والحفاوة به ، وإبرازه ، والتأريخ له أحيانا ، بما يجعله بيناً ، محدداً ، حتى قبل تصفح كتابه ، وسنرى أمثلة متعددة لذلك .
أما الفائدة الأخرى : فقد غلبت الحمية على موضوعية بعض الباحثين في هذا المجال المعرفي ، حتى رأى هذا البعض أن المؤلفين العرب هم الذين ابتدعوا العنوان – في صوره المختلفة ، وأنهم بهذا السبق قد علموا الكاتب الأوروبي كيف يختار عناوين إبداعاته . وعلى الإجمال : إذا كنا نرى في الأمر الأول ما يدل على الصواب ، فإن الأمر الآخر لا يجد سنداً موثقاً يؤكد هذا الزعم . وليس لنا أن نتألم ، أو نلوم أسلافنا ، متسائلين : إذا كنتم قد سبقتم العالم إلى وضع نسق للأعمال الإحصائية الموسوعية ، التي تعنى بالمؤلفات ، فعرفتم – من ثم – عناوين هذه المؤلفات ، وعناوين محتوياتها الداخلية : كيف غاب عنكم ألا تتوجوا خطبكم ، وقصائدكم ، وفصول مؤلفاتكم بمثل هذه العناوين ، التي – فيما نزعم – سبقكم إليها مؤلفو الغرب ؟
هناك منطق آخر يحكم هذه العملية ، فالسابق لا يبقى سابقاً أبد الدهر ، والمتخلف لا يظل حبيس تخلفه إلا في حدود عوامل موضوعية محكومة بسياق الزمن ، واختلاف الأحداث ، وتطور المجتمعات .. إلخ . ولهذا لا نستطيع أن “نعتب” على العقل العربي ، الذي وضع الموسوعات في مرحلة مبكرة (قبل أية ثقافة أخرى) . كيف لم يفطن إلى أهمية أن يضع في صدر القصيدة عنواناً ؟!
من الواضح أنه لا شيء يوجد من لا شيء ، فالمبدأ أن كل موجود يتأسس على موجود سابق عليه ، وغاية الجهد أن يطوره ، أو يتوسع فيه ، أو يضيف إليه (ولا نتقيد في هذه المسألة بالمجال الذي قرره ابن خلدون في فقرة سبق ذكرها ، تضمنت ثمانية مجالات ، غير أنها ليست جامعة ولا مانعة ، وإنما هي استرشاد لمطالب المرحلة) . فحين نراجع الذاكرة العربية سنجدها تطور ما بدأته في القرن الثالث الهجري ، بالجمع بين الأشباه والنظائر من المؤلفين ، كما في :”طبقات فحول الشعراء” ، و “الشعر والشعراء” ، على نحو ما بينا . إذا عرفت القرون التالية مؤلفات لا تحبس نفسها في موضوع واحد “كالشعر والشعراء” وإنما تأخذ في اتجاهات شتى ، على سبيل الاستطراد ، وكان الهدف من هذه المؤلفات ، كما نجدها عند (الجاحظ) الذي سبق – ولو على سبيل التبشير- بالتأليف حسب وحدة الموضوع العام ، واختلاف المشكلين للظاهرة ، وهذا ما تحقق في “البيان والتبيين” و “البخلاء” و “الحيوان” . فهذه الدراسات المبكرة (إذا توفي الجاحظ عام 255هـ) نلاحظ أنه – بعد مقدمته الكاشفة عن أسلوبه ، وخصوصية تفكيره – يأخذ في رواية الأسماء والأحداث ، ويعلق على الطبائع ، والسلوكيات . ويذكر الغرائب والطرائف ، دون أن يشعرك بأنه قد غادر جانب الجد ، ودخل بك في عالم الهزل، ترويحا عنك . هذه الطريقة التي أسس لها الجاحظ في مؤلفاته المشار إليها (وهنا نسكت عن كتابه”المحاسن والأضداد” فحوله كلام كثير) غير أننا لا نستطيع أن نغفل عشرات الرسائل التي شغل بها فراغ وقته ، أو رأى أن يداعب بها كبار زمانه ، أو يعلق على طرائف وتناقضات مظاهر الحياة من حوله . يمكن أن نقرأ في الهامش بعض عناوين الرسائل (والرسالة : بديل مصطلح “الدراسة” أو “المقالة” في زماننا) ، لنرى مدى التنوع في عناوينه التي تصدرت الرسائل ، ولكنها لم تتصدر موسوعاته الضافية التي أشرنا إليها من قبل(25) .
فكما نرى من عناوين هذه “الرسائل/المقالات” ، فإن كلا منها يتصدرها عنوانها ، وينبسط موضوعها على مساحتها ، ويجرب فيها الجاحظ كل ما أوتي من بداهة الفكر ، وطلاوة التعبير ، وذكاء الملاحظة ، والقدرة على قراءة طبائع المجتمع من حوله .
ولم يكن الجاحظ فريداً في تحرير “الرسائل/المقالات” ، إذ يبدو أنه مع نشاط الفكر العربي ، وتعدد مجالاته ، ورغبة الكتاب في نشر أقوالهم ، واكتساب مؤيدين – تعدد كتاب الرسائل ، على أنها لم تكن تأخذ بخصوصية أسلوب الجاحظ ، الذي لا يجارى ، وهذا طبيعي ومتوقع ، وبخاصة مع اختلاف الغرض من الرسائل ، فبين أيدينا – في أعقاب زمن الجاحظ من القرن الثالث الهجري – نشط (إخوان الصفا) ، ولسنا بصدد التعريف بهويتهم ، أو أهدافهم المختلف عليها ، وإنما يعنينا في هذا السياق أنهم ألفوا المقالات غير منسوبة لكاتبها ، وإنما تنسب للجماعة ، على الرغم من أن المتوقع أن يكتبها فرد ، حتى وإن أجازها سائر الجماعة ، ويمكننا أن نقرأ بعض عناوين رسائلهم ، لنكتشف منحاهم الفلسفي ، ومبناهم الفكري(26) .
وخلاصة القول – فيما نرجح- أن التراث العربي عرف العنونة ، وفنونها ، قبل أن يتصل بالثقافات الأوروبية ، غير أن هذا لا يؤدي بالضرورة إلى أن تكون فنون العنونة العربية هي التي ألهمت المفكر أو المؤلف الغربي بأن يضع عنوانا . ولسنا نذهب إلى التاريخ البعيد (الإغريقي/الروماني) لنستجلي عناوين الأساطير ، مقرونة بأسماء أبطالها، أو بالملاحم ، وبخاصة إذا كنا نربط بين ظهور “العنونة” ، وظهور “الصحافة” ، إذ لابد للخبر الصحفي أو التحليل من عنوان يحدد ماهيته ، ويستجلب انتباه القارئ ، على أن هذه القاعدة ذاتها ، يمكن ، بل تجب مراعاتها حين نتأمل عناوين المطبوعات العربية المبكرة ، وبخاصة في مجال دواوين الشعر . وقد كتب محمد عويس الفصل السادس من دراسته الضافية ، يناقش فيها تأخر عنوان القصيدة العربية في النصف الأول من القرن العشرين(27) ، فقد رأى أن تنوع الأجناس الأدبية ، وتعريب الإبداعات الغربية ، وظهور مذاهب أدبية منوعة التوجهات .. كانت العوامل التي أدت إلى ظهور “العنونة” عند كتابنا العرب ، كما أن العنونة في الشعر تأخرت عنها في النثر ، وقد أجرى الباحث الفاضل دراسة استقصائية على ديواني حافظ وشوقي ، فنبه إلى تصدر ذكر مناسبة القصيدة ، أو من توجه إليه ، دون النص على عنوان منفرد وملهم للمبدع والمتلقي (ربما باستثناء القصائد على لسان الحيوان ، التي أبدعها شوقي للأطفال)(28) . وفيما سبق دليل على ضعف القول بوجود آثار عربية دفعت العنوان الغربي الحديث إلى التطور ، وإذا كان اسم (اريك دي جرولييه) في كتابه “تاريخ الكتاب” يذكر ليؤيد هذه المقولة ، معتمداً على التأثير الحضاري العام ، والقول بأن العرب هم الذين أدخلوا الورق إلى أوروبا(29) . وقد حاولنا اختبار هذه العلامات المؤثرة على تاريخ العنوان في التراث العربي ، فاخترنا شاعرين تقاربا في زمن رحيلهما (وهما : عائشة التيمورية ومحمود سامي البارودي) ، فقد توفيت عائشة التيمورية (عام1902) ، وأعقبها محمود سامي البارودي (عام1904) فوجدنا ديوانيهما (المطبوعين) يجري على منهج الوصف أو ذكر المناسبة ، وليس العنونة ، ففي ديوان “حلية الطراز” للتيمورية ، نجد هذه العناوين :
وقالت توسلا بالمقام النبوي (صلى الله عليه وسلم) .
وقالت عند وضع أخٍ لها .
وقالت تهنئة بمولود .
وقالت تهنئ الخديوي السابق بقدومه إلى مصر .
وقالت ترثي ابنتها .(30) وهكذا ..
ولا يذهب ديوان البارودي بعيداً عن هذا النمط من العنونة/ الوصف ، إذ نجد :
وقال وهو في حرب الروس مع الدولة العثمانية .
وقال يروض الشعر .
وقال في النسيب .
وقال في الفخر .
وقال يصف أيام الربيع ، ويذكر مواسم له في عصر الشباب …(31)
ولابد أن نحاول التعليل لتأخر عنونة القصائد في الإبداع العربي ، إلى زمن ليس بالبعيد (زمن حافظ إبراهيم وشوقي) ، وإن لم يكونا على مبعدة من زمن خليل مطران ، وعباس العقاد ، وعلي محمود طه ، وإيليا أبو ماضي(في المهجر) . وقد قيل في التعليل: إن اعتماد الشعر العربي على المشافهة ، وأن وسيلة انتقاله بين المبدع والمتلقي تقوم على المواجهة ، والسماع ، كان من آثارها العملية تجنب “العنونة” أو عدم إحساس الشاعر بضرورة أن يضع عنواناً يؤطر تجربته . وقد استمر هذا التقليد حتى بعد أن أصبحت القصائد تنشر في الصحف ، ويتلقاها القراء بعيونهم وليس بآذانهم ، ومن ثم اجتهد محررو الصحف في اختيار عناوين تتصدر القصائد ، ثم تبعهم الشعراء !!
* * *
خامسا : تجربة متمردة على زمنها :
سبقت الإشارة إلى عناية العربي باسمه ونسبه وقبيلته ، وهو ما حرص على أن ميز به إبداعات قومه ، فقد يهمه أن يقال : امرأ القيس الكندي ، ويقال النابغة الذبياني ، وعنترة العبسي ، وكعب بن زهير بن أبي سلمى المازني ، فيمتد بنسبه إلى القبيلة ، وهذا عنده خير عنوان يحرص على ذكره ، في مجال الانتماء والتخصيص .
وهنا باستطاعتنا أن ننظر في موسوعاتنا التاريخية ، من مثل : تاريخ الطبري المتوفى (عام 310هـ) ، والكامل في التاريخ لابن الأثير المتوفى(عام630هـ) ، فليس لواحد من هذين العلمين رؤية كلية ، أو نظرة تحليلية في التاريخ جملة ، أو في حقب أو دول منه ، وإنما هو تاريخ أشخاص لهم تأثير في أحداث زمانهم . وهكذا سنجد أهم المؤلفات التاريخية الإسلامية تقوم على مبدأ (الحوليات) أي تسجيل أحداث كل عام بذاته، مستقلا عما سبقه وما تبعه ، وفي حدود هذا العام يذكر اسم من مات فيه من الكبراء ، ويسجل تاريخ حياته .. فهكذا نلاحظ أن (الأسماء) لا تزال مهيمنة على العقل العربي ، وأن الخصوصية المميزة لكل ذات ، هي التي تصنع التاريخ !!(32)
وقد سبقت الإشارة إلى “عناوين” لا يشك في استقلالها ، وتصدرها لدراسات مميزة ، حتى لو لم نطلع على المخطوطات التي تحملها ، وقد يكون من حقنا أن نتشكك في “المقامات” : مقامات بديع الزمان الهمذاني (358-395هـ) ، ومقامات الحريري البصري (446- 516هـ) ، كما نرى فإن بين زمن ولادة كل من الأديبين قرنا من الزمان (قد ينقص عامين) على أن أولهما (الهمذاني) لم يعش طويلا ،وقد وضعنا هذا في الاعتبار ، ونحن نسعى إلى الكشف عن أحد الأصول الخطية لمقامات كل منهما . وهنا ينبغي أن نضع تحفظاً في أننا – عبر قدرات الشبكة العنكبوتية – لم نستطع أن نحدد تاريخ نسخ المخطوطة ومدى الالتزام بالأصل الصادر عن مؤلفها أو كاتبها الأول . مع هذا كان الفرق في “العنونة” بين مقامات الهمذاني ومقامات الحريري كبيراً جداً ، ففي مقامات الهمذاني تتابع المقامات تحمل أرقامها (المتسلسلة) في أي موقع من السياق ، حيث تنتهي المقامة السابقة ، وكل ما هناك أن يذكر رقم المقامة الجديدة ، وأن تكتب عبارة (المقامة رقم …) بالحبر الأحمر ، ليستمر الكلام بعدها ، وهكذا قدمت هذه المقامات لقارئها وكأنها نص واحد ، متدافع الصفحات ، متتابع الأحداث . أما مقامات الحريري فقد تصدر كل مقامة رقم وعنوان : مثل : “المقامة الثالثة والعشرون البغدادية” – “المقامة الرابعة والعشرون النحوية” – “المقامة الثامنة والعشرون السمرقندية” – “المقامة الثانية والثلاثون الفقهية” – “المقامة الرابعة والثلاثون الزبيدية” .. وهكذا حملت كل مقامة عنواناً صادرا عن أهم ما يميزها : المكان ، أو الفعل ، أو القضية الثقافية .. إلخ .
إلى أن نصل إلى كتاب : “صبح الأعشى في صناعة الإنشا” لمؤلفه : أبي العباس أحمد بن علي القلقشندي (المصري)- (756 – 821 هـ) . وهذا الكتاب المترامي الصفحات (أربعة عشر جزءاً) ، يفاجئنا في مخطوطته التي نسخت عام (1193هـ) وهي تساوي (1779م) بأنها – فيما يخص “العنونة” ترتقي بتوزيع المادة العلمية إلى ضروب من الدقة ، والوعي بالفروق ، والالتزام بالتحديد الزمني والفني لكل عنوان ، بما يجعله يتمايز تماماً عن كل ما سبقه ، وعن كثير مما لحقه ، وسنعرض لشيء من هذا ، ونعتقد – بكل الصدق – أن القلقشندي – وإن كان في زمن هبوط مستوى الثقافة العربية عامة ، وانغلاقها على ذاتها قبل الاتصال المتفاعل بالثقافة الأوروبية ، والاهتمام بالمطبوع – قدم أهم ما ينبغي على المثقف العربي أن يدركه في مستويات مختلفة ، كلها – بدرجة ما – مطلوبة لتربية مداركه ، كما أن الإلمام ببعض الأبواب مطلوب في جملته وتفاصيله ، لبعض أهل الصنائع من محترفي الكتابة ، وشاغلي وظائف الإدارة على مستوياتها .
عاش القلقشندي زمن الحاكم المملوكي “الأمير برقوق” ، ونرجح أن ضعف الاحتفاء بجهده العلمي ، ووعيه السابق لزمانه بالتأليف ومطالبه ، يرجع إلى هذه الصفة، بمعنى أنه محسوب على العصر المملوكي الذي يوسم (عادة) بالضعف والانغلاق ، وتوقف الإبداع العلمي . إن ما أجملته (الشبكة العنكبوتية) – في التعريف بالقلقشندي وقيمة جهده ، يستحق أن يستعاد بنصه ، على طوله ، ولا نغفل غرابة العنوان الذي اتخذه القلقشندي لكتابه ، فهو “صبح الأعشى في صناعة الإنشا” ومع أحقيته في الحصول على سجعة متوازنة بين “الأعشى” و “الإنشا” ، فإنه كانت لديه مندوحة لاختيار اسم كاشف للمحتوى الشامل (غير المسبوق) في هذا الكتاب ، ولعل المؤلف قد تأثر – بدرجة ما – بذلك النوع من العناوين التي ستبرز أصحاب العاهات والمناقص من العميان ، والعرجان ، والبرصان ، ومن إليهم ، من ثم منح كتابه تلك القدرة الفائقة على تجاوز أمراض العيون المصابة بالعشى (والعشى : العجز عن الرؤية في الليل) .
وهذا نص ما سجلته “الشبكة العنكبوتية“ عن الكاتب وكتابه :
[ صبح الأعشى في صناعة الإنشا هو كتاب يتكون من 14 جزء من تأليف أبو العباس القلقشندي المتوفى سنة 821 هـ 1418م، الذي كان يتولى منصب ديوان الإنشاء في عهد السلطان الظاهر برقوق ، ويعتبر الكتاب موسوعة شاملة لجميع العلوم الشرعية والأدبية والجغرافية والتاريخية.
تعد هذه الموسوعة أحد المصادر العربية الواسعة التي تتناول مواضيع منذ الفترات الأولى في الإسلام عن أنظمة الحكم، والإدارة، والسياسة، والاقتصاد، والمكتبات، والولايات والعهود والعادات والتقاليد والملابس. في الشرق العربي، وفي الكتاب يتناول القلقشندي صفات كاتب الإنشاء ومؤهلاته وأدوات الكتابة وتاريخ الدواوين التي تعرف في الوقت الحاضر بمسمى الوزارات، وأيضاً يتناول الإنشاء في البلاد العربية وفنون الكتابة وأساليبها، ويصف الكتاب أشكال ملابس الجنود، والأسلحة، ومواكب تنصيب الخلفاء والسلاطين، وعن مناسبات استطلاع هلال رمضان، وموائد الإفطار، وملاعب السباق والألعاب الرياضية، ويصف أشكال العمائم والملابس ومراكب الدواب، ومظاهر المجتمع العربي وتقاليده وأعرافه وظواهره الإجتماعية .
جاء في كشف الظنون أن صبح الأعشى يقع في “سبعة أجزاء كل منها في صناعة الإنشاء لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا ذكرها وجعل بابا من أبوابه مخصوصا بعلم الخط وأدواته” .
كما أطنب القلقشندي في الجوانب السياسية والإدارية في مصر وبلاد الشام والدول المجاورة لها في عصره ، وهو العصر المملوكي، وأثبت وثائق مهمة عن الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية والجغرافية في عصره ، فجاء الكتاب موسوعة في فن الكتابة للدولة ، وفن الترسل ، وما يتعلق بهما ]
وقد نرى أن هذا الوصف الذي تجاوزنا به حد المأذون بنقله عن المراجع ، لا يزال مقصراً ، لا يفضي بكل المنجز العلمي الذي حققه القلقشندي في كتابه ، غير أننا سنتوقف عند طريقته في العنونة ، وفي تعاقب العناوين ما بين العام والخاص والأخص ، فنجد أنه قد أخذ بنسق غير مسبوق ، وهو النسق الذي نأخذ به في مؤلفاتنا إلى اليوم ، مما يعني أن هذا الرجل كان يملك تصوراً شاملا قادرا على الضبط والاحتكام إلى أسس معرفية موضوعية ، أعانته على صحة التقسيم ، وصحة العناوين التي اتخذها للأقسام ، ثم صحة توزيع المسائل (التفصيلية أو الصغيرة) التي تدخل في نطاق هذه الأقسام ، وسنكتفي بتقريب الصورة/النمط الذي انتهجه في توزيع مادة كتابه ، وإجمالا : فقد قسم كتابه إلى “مقالات” ، وكل مقالة تنقسم إلى “أبواب” ، وكل باب ينقسم إلى “فصول” ، وكل فصل ينطوي على “مسائل” محددة تتعلق بالمطلوب فيه . ونختار (المقالة الرابعة) التي يُعنى فيها بأمور أنواع المكاتبات والولايات ، وهذه المقالة في بابين :
الباب الأول : في فصلين :
الفصل الأول : في مقدمات المكاتبات ، من أصول يعتمدها الكاتب ، فيها من حسن الافتتاح ، وبراعة الاستهلال ، وتقديم مقدمة تناسب المكتوب فيه في أول المكاتبة (!!) ، ومعرفة الفرق بين الألفاظ الجارية في الخطاب ونحوه ، وما يناسب المكتوب إليه منها ، ومواقع الدعاء فيها ، والإتيان لكل مقصد من مقاصد المكاتبات ، بما يناسبه ، ومخاطبة كل أحد من المكتوب إليهم على قدر طبقته من اللغة العربية ، ومراعاة الفصاحة والبلاغة في الكتابة إلى من يتعاناها ، ومراعاة رتبة المكتوب عنه ، والمكتوب إليه ، ومواقع الشعر من المكاتبات ، وحسن الاختتام ، وما يجري مجرى ذلك ، وبيان مقادير المكاتبات وما يناسبها من البسط والإيجاز ، وما يلائمها من المعاني ، ومعرفة ما يختص من ذلك بالأجوبة ، وبيان ترتيبها .
الفصل الثاني : في بيان أصول المكاتبات وترتيبها ، وبيان لواحقها ولوازمها ، ومذاهب الكتاب فيما تفتتح به المكاتبات في القديم والحديث ، وما يخاطب به أهل الإسلام (وغيرهم) في المكاتبات ، وبيان كيفية طي الكتاب ، وختمه ، وحمله ، وتأديته ، وفضه ، وقراءته ، وحفظه في الإضبارة .
هذا ما وصفه القلقشندي نفسه في مقدمة كتابه ، معرفا بمحتواه . نكتفي منه بباب واحد في فصلين ، وكما نرى فإنه لم يذكر “العنونة” لفظاً ، ولكنه قصد إليها وصفا ، وأنه قدم من التوجيهات ما يستحق أن يكون درساً متاحاً لكل من يتصدى لصناعة الكتابة، لا نقول الكتابة الديوانية ، وإنما نقول الكتابة على الإطلاق ، وقد حدد من مبادئ “البروتوكول” في زمانه ما يعجز عنه مؤلفو الروايات التاريخية ، ومؤلفو المسرح ، والدراما التلفزيونية – عن تصوره ، أو الاهتداء إليه في كتاباتهم العصرية . وإن الباب الثاني المكون من ثمانية فصول سيبسط القول في حقب الماضي بتسجيل مكاتبات الخلفاء من الصحابة ، وممن جاء بعدهم إلى أمراء الأندلس ، ودولة الموحدين بأفريقيا ، ومن المهم أنه حين يسجل صيغة مكاتبة ، فإنه لا يغفل عن أهمية تسجيل صيغة الجواب عليها، وبهذا يقدم دروساً مستفادة في اتجاهات حضارية مختلفة ، كما يرصد تغير العبارات الافتتاحية بين الخلفاء ، والملوك ، والأمراء ، العرب ، وغير العرب . من الطريف أن ينهي فصله الثامن من هذا الباب الثاني ، في معرفة إخفاء ما في الكتب من السر ، إما بطريق المترجم ، وإما بمعالجة الكتابة ، بمعنى أنه عرّف “بالحبر السري” و “الكتابة بالشفرة” المتفق عليها .
لا تملك هذه الدراسة المختصرة عن كتاب القلقشندي أن تمنحه مساحة أوسع مما أتيح ، غير أننا نعتقد بأنه كتاب مهم ، وأنه يستحق دراسة خاصة ، تفصيلية ، عصرية المنهج والهدف ، تستخرج ما تنطوي عليه مقالاته ، وأبوابه ، وفصوله – على الترتيب- ثم تضع تحت المجهر تلك العناوين التي تصدرت المسائل على كثرتها ، فكانت تعبيرا محكماً عن محتواها العلمي ، والأدبي ، والفكري ، والحضاري بوجه عام .
* * *
سادسا : خطوة سابقة :
إذا تحقق لنا قدرٌ من الاطمئنان إلى صحة تاريخ ميلاد ووفاة أعلام العرب ، قبل عصر الطباعة ، فإن “صبح الأعشى” للقلقشندي: (المتوفى 821 هـ) يقع في وسط المسافة الزمنية بين كتاب “الفهرست” لابن النديم (المتوفى 387هـ) ، وكتاب “كشاف اصطلاحات العلوم والفنون” للتهانوي (المتوفى 1191هـ ، على الأرجح)(33) ، ومن ثم فإن ابن النديم وضع كتابه الشامل على غير قياس من تجربة سابقة ، حتى وإن كان مصطلح (الكامل= الكامل في التاريخ – الكامل في الأدب..إلخ) أخذ يتكرر إعلانا عن الطابع الشمولي للثقافة ، ومن المهم أن نلاحظ أن ابن النديم من ثمرات القرن الرابع الهجري ، وهو القرن الذي شهد نهضة عربية في أوج سطوعها ، وقوتها ، وقدرتها على استيعاب ثقافات الأمم والحضارات الأخرى ، ويتضح هذا في محتوى كتابه . ولسنا نظن أن “الفهرست” كان ملهماً للقلقشندي ، لأن الكتاب الأول لا يتجاوز كونه بمثابة “كشاف” يدل على المؤلفات ، فيضعها تحت عناوين تنظم سياقها ، ويعرف بمؤلفيها ، وفي أحيان يجمل فكرتها ، وهذا ليس بالجهد القليل ، غير أنه يختلف كثيراً عن الطابع الموسوعي المختص بفنون الكتابة والتأليف ، التي حصر القلقشندي جهده فيها.
وقد عُني ابن النديم بالعنونة ، إذ قسم كتابه إلى عشر (مقالات) [ وقد توزعت المقالات العشر على اثنين وثلاثين فنا ] ، اختصت كل مقالة بعدة فنون ، حسب ما تتسع له الظاهرة ، فعلى سبيل المثال : (المقالة الرابعة) وهي : فنان في الشعر والشعراء : الفن الأول : في طبقات الشعراء الجاهليين والإسلاميين ممن لحق الجاهلية ، وصناع دواوينهم ، وأسماء رواتهم . الفن الثاني : في طبقات الشعراء الإسلاميين ، وشعراء المحدثين ، إلى عصرنا هذا [أي إلى عصر المؤلف] . وفي تقديم عبد الحكيم راضي لطبعة (الهيئة العامة لقصور الثقافة – القاهرة – 2006) يشير إلى تميز عناوين الفهرست بالنسبة لما سبقه من موسوعات (بصفة خاصة كتاب الخوارزمي) ، فيقول عن العناوين في مفتاح العلوم : إنها تهتم بأسماء العلوم ، وأسماء تفريعاتها على سبيل الوصف والتعريف ، وليس أكثر “أما في كتاب الفهرست ، فالطابع الموسوعي الرامي إلى ذكر المؤلفين والمؤلفات هو المسيطر ، وإذا صح أن عناوين الكتاب في الأصل كانت على نحو ما يلقانا في طبعاته الحديثة ، تأكد لنا هذا المنحى ، وعلى سبيل المثال ، فإن العنوان المتكرر لأجزاء الكتاب الداخلية ، ينص دائما على أنه (في أخبار العلماء المصنفين القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم ، وكذلك عناوين المقالات التي جاءت في أخبار هذا الفريق ، أو ذاك من العلماء ، وأسماء كتبهم ، أو أخبار العلماء ، وما صنفوه في أخبار … أو ما صنفوه من الكتب ؛ وترد أسماء العلماء والمؤلفين ، والترجمة لهم تباعاً ، وكأننا أمام كتاب من كتب التراجم)(34)
إن المرتكز الذي نعنى بإبرازه يتمثل في عناية ابن النديم بذكر الأسماء ، ثم دلالة المصطلحات لتعبيرها عن الوقائع أو فهم الوقائع ، وخلاصة القول في “الفهرست” أن عنايته كانت في ذكر التراجم والسير ، بمعنى أنها مرتبطة بالأشخاص وسيرهم ، وجهودهم العلمية . وقد تدل عبارة المؤلف في صدر كتابه على تقديم عناوين الكتب على أسماء مؤلفيها ، غير أن سياق العبارة سيوصل إلى عكس ذلك . يقول ” هذا فهرست كتب جميع الأمم من العرب والعجم ، الموجود منها بلغة العرب وقلمها ، في أصناف العلوم وأخبار مصنفيها ، وطبقات مؤلفيها ، وأنسابهم ، وتاريخ مواليدهم ، ومبلغ أعمارهم ، وأوقات وفاتهم ، وأماكن بلدانهم ، ومناقبهم ومسالبهم منذ ابتداء كل علم اخترع إلى عصرنا هذا، وهو سنة سبع وسبعين وثلاثمائة للهجرة”(35) . وهكذا يبدو لنا أن العناية بـ “الإنسان” المبدع أو المؤلف والمنتج ، تسبق في الإدراك العربي أهمية منتجه العلمي ، فعلى سبيل المثال : ما أهمية أن يخبرنا في (أخبار الخليل بن أحمد) أنه أول من سمي في الإسلام بأحمد ، وأصله من الأزد من فراهيد ، وكان يونس يقول : فرهودي مثل أردوسي .. إلخ(36) .
وفي العنونة لكل مقالة ، يحرص على أن يبدأ العنوان بذكر الأشخاص (الإنسان) ، ثم الجوانب التي تميز هؤلاء الأشخاص عن غيرهم ، فتحت عنوان :
” الفن الثالث من المقالة الثالثة من كتاب الفهرست في أخبار العلماء وأسماء ما صنفوه من الكتب ، ويحتوي على أخبار الندماء والجلساء ، والأدباء ، والمغنين ، والصفادمة ، والصفاعنة ، والمضحكين ، وأسماء كتبهم “(37)
على أنه يستهل هذا الفن الثالث من المقالة الثالثة بالعنوان الذي يصوغه كالآتي :
“أخبار إسحاق بن إبراهيم الموصلي ، وابنه ، وأهله “
فهنا – فيما نتصور – يتصدر الاهتمام بالشخص وارتباطاته بالنسب قبل كل شيء، ثم يأتي الفن المميز له لاحقا .
غير أن (ابن النديم) يؤسس لمنهج آخر في تحديد الظواهر الثقافية ، والعلمية ، وهو ما سنجده – فيما بعد – مؤثراً في مؤلفات عدة سنشير إليها . ففي فقرة من المقالة الرابعة يضع عنوان : ” أسماء الشعراء الذين عمل أبو سعيد السكري أشعارهم ” . ومن ثم يكون محتوى هذه الفقرة ذكر أسماء شعراء مختلفين في العصر أو في الطريقة ، متوخياً ما يثق في روايته من أشعارهم ، فكأنما كان السكري يستأنف ما سبق إليه المفضل الضبي(المتوفى 168 هـ) ، والأصمعي (المتوفى 216هـ) .. وقد توفي السكري عام (275هـ) ، والجمع في طريقتهم هو الاكتفاء بنسبة الأشعار إلى راويتها ، والاستغناء بالقطعة (من عدة أبيات) دون حرص على إيراد النص كاملا – غير أنه يثق في نسبته إلى صاحبه . وهذا تأكيد للعناية بالعنصر الإنساني المنتج للثقافة عند العرب .
تبقى “العنونة” في “فهرست” ابن النديم ، حريصة على البدء بالإنسان ، سواء في حالة الرضا عن جهده ، أو الغضب ، أو حتى الرفض لهذا الجزء . هكذا نجد عناوين مثل: ” الحلاج ومذاهبه ، والحكايات عنه ، وأسماء كتبه ، وكتبه أصحابه”(38) . وكذلك “الشافعي وأصحابه”(39) ، و “الطبري وأصحابه”(40) ، وكذلك صنع مع الفلاسفة ، والعشاق ، حتى بلغ “أسماء العفاريت الذين دخلوا على سليمان بن داوود”(41) .
وفي ختام هذه الفقرة عن “الفهرست” لا نزعم أن ابن النديم التزم بهذا النهج ، لم يفارقه : نهج البدء بأسماء الأعلام ، والتعريف بهم ، وسلاسل مؤلفاتهم وتابعيهم .. إلخ. فمن الواضح أن الظاهرة الثقافية كانت أكثر فيضانا من أن تستخلص من أسماء ، أو يُكتفى فيها بذكر الأسماء ، ومن هنا نجد عناوين لموضوعات ذات أهمية واضحة مثل : “الكلام على مذهب الإسماعيلية”(42) ، أما فيما يتعلق بفلاسفة اليونان ، فقد ذكرهم بأسمائهم ، وأحصى كتبهم ، وحاول جلاء نظرياتهم أو مقولاتهم ، ونادراً ما يشير إلى وشائج تربط بينهم ، إلا أن يجد ذلك مسطوراً في المصادر التي يعتمد عليها .
* * *
سابعا : تأكيد الملمح التراثي في العنونة بالأسماء :
من حق التهانوي (محمد بن علي ابن القاضي الفاروقي الحنفي التهانوي – المتوفى 1191هـ = 1745 م ) أن يعد خاتمة الجهود التراثية في مجال رسم المسارات العلمية بفنونها المختلفة (العربية والمعربة) ، وتوثيقها بنسبتها إلى مؤلفيها ، مع تراتب درجات هؤلاء المؤلفين ، إذ تبدأ الظاهرة العلمية أو الفنية بذكر عنوانها ، ثم النص على اسم مبتدعها الأول ، الذي بشر بها ودعا إليها ، ثم تتعاقب الأسماء حسب التسلسل الزمني ، ودرجة الأهمية المستمدة من تعدد المؤلفات ، في هذا الفن المعين.
هذه خلاصة النهج العربي في العنونة ، عبر مسارات مختلفة ، اتخذ بعضها شكل التعدد في إطار الموسوعة ، مثلما أشرنا قبل إلى “الفهرست” ، وكما نرى الآن في “كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم” وما بينهما ممن حذا حذو السابق على زمانه . وإذ يدل الإحصاء على أن “الكشاف” وقد عرّف بأكثر من ثلاثة آلاف مصطلح ، ونسبها إلى أصحابها أو تابعيها ، فإن عدد الأسماء (الأعلام) التي اعتمد عليها بلغ (868) عَلماً(43) ونلاحظ أن أسماء الأعلام التي أوردها لا تعكس مدى شهرتها أو حضورها التاريخي ، بما يعني أن التهانوي اعتمد على المؤلفات أولا ، وعلى المذاهب ثانيا ، فنجد ممن ذكر مرة واحدة : الطبراني ، الطبري ، العرجي ، عروة بن الزبير ، الفرزدق ، أبو الشيص ، أبو اليزيد البسطامي ، الحلاج ، أهرمن ، الواحدي ، ورقة بن نوفل .. إلخ . وممن ذكر مرتين : الرشيد الوطواط ، محمد بن الحنفية ، آدم أبو البشر ، الحجاج ، الجصاص ، واصل بن عطاء ، أبو بكر الصديق ، عمر بن الخطاب .. إلخ . ومن ذكر ثلاث مرات : معاوية . في حين ذكر أبو حنيفة (56) مرة ، والشافعي (58) مرة ، ومالك (13) مرة ، والرازي (37) مرة .. وهذا الإحصاء يعطي مؤشرا خاصا لتوجه الموسوعة ، واهتمامها بالمسارات المذهبية ، والعلمية ، والفلسفية أكثر من عنايتها بأحداث التاريخ التي كانت تبدو للمثقف العربي مجرد أعمال متواترة ، أو متعاقبة ، تفتقد العلية ، ولا تعود إلى مبدأ الفاعل ، أو نظام مؤثر ، قدر اعتمادها على الأشخاص ، ومن ثم كان ذكر اسم العلم ، الذي أسند إليه الحدث – مهما كانت أهمية هذا الحدث – لمرة واحدة ، كافيا حسب منهج كشاف اصطلاحات الفنون ، كما ارتآه التهانوي .
على أن مصطلحات الكشاف بالنسبة للعلوم المستجدة على العقل العربي – كما يذكر رفيق العجم ، المشرف على مراجعة طبعة مكتبة لبنان- كانت لها صورة في الثقافات السابقة (كاليونانية) ، فاتخذت منها مثالا يحتذى ، ثم بذلت جهود في الضبط والصياغة ، حتى استقر المصطلح على أسس السلوك اللغوي عند العرب ، ومن ثم يشيد بجهود ابن النديم السابق إلى نحت المصطلح المستحدث ، وتعريبه ، وقابلية بنيته للتحديث ، ويستعين (رفيق العجم) بتعريفات الجرجاني عن مفهوم الاصطلاح ، وأنه “عبارة عن اتفاق قومي على تسمية الشيء باسم ما ينقل عن واضعه الأول”(44) .
إن “الاسم” في اللغة العربية هو الأكثر ثباتا ، والأتم دلالة ، وهو مستغنى عن “الفعل” – دون العكس – وهو المقدر دائما ، أو غالبا في مجال “العنونة” المختزلة ، والأسماء هي صانعة الحقل الدلالي ، وفيها القدرة على الإيحاء بخصوصية الأجيال والحضارات . ومن الصحيح ما ذكره كاتب المقدمة : “أن الأبحاث التي شغلت الأمم في عصور ازدهارها ، وانبثاق الكشوف العلمية لديها ، وتشعب تجربتها الفكرية والوجدانية، قد أغنت لغات هذه الأمم بالألفاظ ، والأسماء ، والمصطلحات ، فعبرت اللغة تلك عن المعاني ، وتحددت تلك المعاني بخاصية هذه اللغة من دون سواها ، وبحسب الأقوام الذين تناوبت الحضارة والعلم على أيديهم”(45) . ونلاحظ الربط بين الألفاظ والأسماء والمصطلحات ، فالاسم اصطلاح ، كما أنه عنوان للفرد ، وللجماعة التي ينتمي إليها ، والمصطلح عنوان لابتكار لم يكن موجوداً ، وبعد استعماله ، وشيوعه ، فإنه يستقر استقرار اسم العلم ، ويثبت حضوره الزمني والسياقي في مجال تعاقب الأجيال والعصور . ومن هنا تبرز أهمية “الأسماء” التي احتفى بها العرب ، احتفاءً ظاهرا منذ زمن جاهليتهم، وكان من مأثور عباراتهم ، أن الغريب الوافد ، إذا لجأ إلى قوم ، وطمح إلى حمايتهم ، كان أول ما يفعل أن “ينتسب” – أي أن يذكر اسمه وقبيلته – ومن ثم يستحق الرعاية والحماية(46) . على أننا يمكن أن نفيد من إشارة مهمة عن العلاقة بين اللفظ والمعنى في الأسماء ، فالمعنى لا يتحد باللفظ ، اتحاد الروح بالجسد ، وإنما يكشف المعنى عن ذاته في استعمال الكلمة . بما يعني أن معنى الكلمة يتغير تبعاً لتغير استعمالها . وهذا يضع أسماء الأعلام في مساحة ملتبسة ، فاسم العلم يستمد مضمونه/مكانته من علاقة المردد لهذا الاسم بصاحب الاسم ذاته . ومن ثم يكون اسم مثل “الحسين” له انطباعات ، واستجابات شتى عند المتلقين له ، إلى أن يحدد بذكر النسب ، فتختلف العلاقة ، ومثل هذا يمكن أن يقال عن شخصيات التاريخ المؤثرة . وهنا نذكر أن “تيمورلنك” (توفي 1405م)(47) الذي بذر الرعب في شعوب المشرق العربي ، حين أقبل عليه غازيا – يعني اسمه : تيمور = الحديد ، لنك = الأعرج – وهو عند قومه “تيمور شاه” أي الملك المعظم تيمور ، أما عند العرب ، وجيرانه الذين اغتصب بلادهم فهو : تيمورلنك = تيمور الأعرج ، ليس أكثر . وهذا يكشف لنا ما تعنيه الأسماء المتداولة في اللغات المختلفة ، وما يكتنفها من ألقاب التعظيم ، أو الإزراء !!
على أن اللغة – أية لغة – ليست مجرد وسيلة للتفكير ، وتناقل المعلومات – على جلالة هذه الوظيفة ، وأهميتها ، فإنها – اللغة – القالب الذي يتشكل فيه الفكر ، كما أن “لغة جماعة إنسية ما تفكر داخل اللغة وتتكلم بها ، هي المنظم لتجربتها ، وهي بهذا تصنع عالمها ، وواقعها الاجتماعي .. إن كل لغة تحتوي على تصور خاص بهذا العالم”(48) .
إننا نتعقب مثل هذه الطروحات اللغوية ، لنؤكد على العلاقة العضوية بين الإعلاء من شأن الأسماء في الثقافة العربية ، وفي مقدمتها : أسماء الأعلام ، والقبائل ، والجماعات ، والطوائف …إلخ ، والنظام العربي الاجتماعي السائد عبر مراحل التاريخ القديم . وإذا كانت متغيرات العصر الحديث قد تركت أثراً في التكوين الاجتماعي ، فإن أصداء هذا التغيير ، مع أسباب أخرى أشير إليها فيما سبق (مثل : تراجع المشافهة ، والاعتماد على الصحافة ، واعتماد أسماء المواليد ، حسب نسق خاص …) قد تركت أثرها في درجة الاهتمام بذكر اسم المبدع/المنتج باكتنازه عناصر العنونة ، ومن ثم اختيار ألفاظ أخرى لتمييز هذا المنتج الأدبي أو العلمي أو الفكري ، وهذه العبارة المختارة ، قد توضع وصفاً – أو في موقع الوصف – لاسم العلم ، وقد تكون توطئة لذكره في صدر هذا المنتج الإبداعي الخاص .
ومما ينبغي ذكره في ختام هذا العرض الموجز لـ “كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم ” أن التهانوي لم يتخذ من أسماء مؤلفي الكتب والرسائل رؤوسا للموضوعات التي طرحها ، وفي مقدمته أشار إلى التقسيم المعتمد عنده ، وهو تقسيم فرضته العلوم المدونة ، ما بين نظرية وعملية ، وتقسيم الصناعات .. إلخ . وكان التهانوي في هذا متسقاً مع هدفه العلمي ، ومع التجارب السابقة في هذا النمط من التأليف في التراث العربي . وما يعنينا – ونرجو أن نكون قد وفينا بذلك- أنه بعد هذا التقسيم الموضوعي ، اعتمد في طرح المذاهب والظواهر والطوائف ، والتعريف بالكتب والرسائل – على ذكر المؤلف أولاً ، أي : العناية بالإنسان – صانع هذا العلم ، أو مؤلف هذا الكتاب … إلخ . فهذا الإنسان هو الحقيقة الكبرى في إدارة هذا العالم ، وهو صانع الحضارة ، ومنتج العلم والأدب والفن ، وكل ما يجمل الحياة ، ويضيف إليها ، ويتطور بها . وبذلك استحق تلك الصدارة التي حرصت عليها “الرؤية العربية” للتعريف بأي شيء : أي “العنونة” الجامعة المختصرة لهذا الشيء .
* * *
ثامنا : هذا المنحى الفريد في العنونة بالأسماء :
للعربي الجاهلي من طبيعته الصحراوية المكشوفة ، نصيب معلوم في تحديد الأشياء ، والتفريق بينها ، بصفات بينة ، وتسميتها بأسمائها . وقد يسهم الكيان القبلي في تحبيذ توجهات معينة ، ولعلنا في هذا المجال نذكر من أخذ على العرب تسميتهم أبناءهم بأسماءٍ غير مستحبة ، كأسماء الحيوان (فهد ، وأسد ، ونمر ، وثعلب) أو الطبيعة القاسية مثل (جبل ، صخر ، وشمس ، ومطر) إلخ .. في حين أنهم – العرب- يطلقون على عبيدهم وخدمهم أسماء مستحبة مثل : (سرور ، وسعيد ، وجميلة ..إلخ) فكان الجواب : إننا نختار الأسماء المسعدة لأتباعنا ، لأنهم في خدمتنا ، ولمسرتنا . أما أولادنا فإننا نختار ما يشد أزرهم في ملاقاة أعدائهم !! وسواء وافقنا على هذا التعليل أم أنه يحتاج إلى شيء من التحفظ ، والاستقصاء ، فإنه – من وجه – يبين عن القيم السائدة ، وتأثيرها في اختيار الأسماء . أما تحدد مظاهر الطبيعة وقسوتها ، فكان – فيما نرى – أقوى حضوراً في تسمية العيوب الخِلقية (الجسدية) بأسمائها ، وإلصاقها كصفات بأسماء من أصابتهم هذه الآفة أو تلك من انحراف التكوين الجسدي أو نقصه .
لقد شاع هذا في الجاهلية ، في أسماء بعض الأعلام المشهورة ، ذات السيادة والصدارة المجتمعية ، ومع ذلك لم يتردد الرواة في ذكرها واستخدامها ، لأنها أصبحت (علامة) ، أو (سمة) مميزة ، تخدم الاسم ، وتفصله عن غيره ، ممن يتسمى به ، وقد شاعت هذه الطريقة في الوصف حتى لم يعد أحد – تقريبا – يشعر بغرابتها ، أو بإمكان تجنبها ، أو تبديلها ، على الأخص في ذلك الزمن القديم .
وقبل أن نتوسع في هذه المسألة ، نذكر أن السليقة العربية – بوجه عام – جرت على تسمية المناسبات والأماكن والأحداث المهمة بما يميزها ، فهناك حرب البسوس، وحرب الفجار ، ويوم بعاث ، ويوم بدر ، ويوم حنين ، وصلح الحديبية ، وحتى بيعة الرضوان تحت الشجرة المعروفة . وقد أخذ القرآن الكريم بهذا النهج السائد في تسمية بعض الأشخاص بإطلاق كنى وصفات مميزة ، بقصد الإعلاء من شأنهم ، أو الحط من أقدارهم ، فلدينا إبراهيم الخليل ، وموسى الكليم ، ويوسف الصديق ، وأبو لهب ، وامرأته حمالة الحطب ، وفي صدر الإسلام : عُرف الصديق ، والفاروق ، وذو النورين ، ومن الطريف أن القرآن الكريم استخدم في تعريف عبدالله ابن أم مكتوم ، وصفه المميز بالأعمى : ) عَبَسَ وَتَوَلَّى (1) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ( ، وذلك لإبراز نقطة الضعف المسوغة لمزيد العناية بهذا الشخص ، ومع ذلك فإن الأحاديث النبوية نهت عن ذكر العيوب الجسدية ، مع التسليم بأنها مشاهدة وواقعية(49) .
في زمن الجاهلية (واستمر الأمر فيما بعده من عصور) شاعت صفات وكنى ، مثل: تأبط شرا (ثابت بن جابر – توفي 607م) ، والأعشى (أعشى قيس صاحب المعلقة(توفي 629 هـ) ، وفي العصر الأموي : أعشى همدان (الذي قتله الحجاج بن يوسف عام 83 هـ) ، وعمرو بن سعيد (الأشدق – قتل 70 هـ) . وكان بشار بن برد (توفي 168هـ) يحمل أربع علامات تميزه عن غيره : فهو بشار بن برد ، وهو بشار الأعمى ، وهو المرعث ، وهو المشنف ، وكلها تنبئ عن الشخص نفسه ، وكذلك “الجاحظ” ، وهو وصف لصورة عينيه . كما فرق العرب بين الشفه العليا المشقوقة (مثل الأرنب) ، فأطلقوا على صاحبها (الأعلم) ، وهنا نتذكر (الأعلم الشنتمري – توفي 467هـ ) . إما إذا كان مشوق الشفه السفلى فهو (الأشرم) . وهنا نتذكر (أبرهة الأشرم الحبشي– توفي 570م – عام ولادة الرسول عليه السلام ) وهو الذي تجرأ على الكعبة . وكما مُيز بشار بعماه ، ففي الأندلس نجد (الأعمى التطيلي – توفي 513هـ تقريبا) . أما أبو العلاء فيلسوف المعرة ( توفي 449هـ) ، الذي وصف نفسه بأنه : “مستطيع بغيره”، وبأنه : “رهين المحبسين” ، فإن إجلال شخصه ، برأه من صفة فقد البصر ، فلم ينتشر وصفه بالأعمى ، على كثرة خصومه ، وشيوع اتهامه في عقيدته(50) .
هذه إذن حالة خاصة بالعرب ، في جاهليتهم ، كما فيما ورثوه عن هذه الجاهلية من الطبائع ، وأساليب الكلام ، والرغبة في اختصاره ، وتحديده ، بحيث يصل إلى حد (الأيقونة) ، أو العلامة المميزة الفارقة ، التي لا يمكن أن يخلط السامع ، أو القارئ بين صاحبها ، وغيره من البشر . هكذا نتعرف على أبرهة الأشرم ، وعزة الميلاء ( وهي احدى القيان (الجواري المغنيات) ذوات الشهرة في العصر الأموي – توفيت 115هـ) ، والمنخل اليشكري (عمرو بن مسعود اليشكري ، وهو بحار وشاعر – توفي 607م)(51)، وعبد بني الحسحاس(52) ، وابن الطقطقي (توفي 709هـ) ، والطغرائي (توفي 513هـ) ، واللجلاج الحارثي (طفيل بن زيد بن عبد يغوث بن الحارث: شاعر جاهلي يماني– تاريخ وفاته مجهول) ، وطلحة الطلحات (وكان أحد ثلاثة أجواد في البصرة تذكر أسماؤهم في زمانهم) ، وأبو الشمقمق (توفي 200هـ) ، وأم الحليس ، وأبو نواس (توفي 199هـ) ، وأبو الدرداء (توفي32هـ) ، وسلم الخاسر(توفي 186هـ) ، وكراع النمل (وهو علي بن الحسن الدوسي ، وسمي بكراع النمل لدمامته وقصره – توفي 316 هـ تقريبا) ، والوطواط (رشيد الدين الوطواط – توفي 573هـ) ، والوأواء الدمشقي ( توفي 551هـ على الأرجح) .
هذه أسماءٌ ، وصفاتٌ ، وكُنى ، شاعت في أزمنة عربية متطاولة ، ما بين الجاهلية والعصور الوسطى الإسلامية ، وتداولها الناس في صورتها دون حرج ، مع ما يمكن أن تحمل من صفات النقص الجسدي ، أو النطقي ، أو النفسي . لقد اكتسبت حق وجودها بالتداول على امتداد زمن المشافهة ، وتأكد حضورها وأحقيتها في التدليل على أصحابها دون تغيير في طبائعهم ، أو صفاتهم حين أهل عصر الكتابة ، ولنا هنا ملاحظتان بعد هذا العرض العام ، الذي اخترنا فيه أشهر تلك الأسماء والصفات والكنى الغريبة ، وسجلناها كما تداولها الناس ، وكما كتبت في المصادر الأولى ، واستمرت إلى زمن الطباعة – وإلى زماننا هذا :
الملاحظة الأولى : أن هذه (الأسماء) السابقة ، يغلب عليها طابع رصد العيوب الظاهرة في الوجه أو في البدن عامة ، أو في النطق . ولسنا ندري : هل كان هذا الاستخدام يبلغ أذن الشخص المعني به ، أم أنه كان يتداول بعيداً عن إدراكه الخاص ، أو سماعه . ويغلب على ظننا أنه كان يعرف ما أطلق عليه بين نظرائه ، وأنه حتى وإن ضاق صدره بالإشارة إلى ما هو سلبي في شخصيته ، فإنه لم يكن يملك تغييره ، بل لعله وجد فيه باباً من أبواب التميز والشهرة . وهناك (أسماء) مستحبة ، تحمل معنى الفضيلة ، أو القوة والشجاعة ، مثل : ملاعب الأسنة ، والمنخل ، وأبي نواس (واسمه الحسن بن هانئ ، وإنما غلبت عليه هذه الكنية بسبب تلك الضفيرة التي جدلتها له أمه وهو صبي ، فكانت تنوس = تتحرك ذهابا وجيئة خلف ظهره) .
الملاحظة الثانية : أن هذا الميراث الغريب ، الذي لا نظن أننا نجد له شبيهاً في أية حضارة غير الحضارة العربية وتراثها ، في اتساعه خاصة ، حتى يبلغ مبلغ الظاهرة ، والصيغة المتداولة دون حرج .. هذا الميراث الذي بدأ شفاهيا ما لبث أن فرض وجوده على عصر الكتابة ، وبذلك استقر وتأبد.
* * *
تاسعا : الجاحظ يؤسس للتأليف عن الظاهرة :
أبو عثمان ، عمرو بن بحر الجاحظ (159 – 255هـ) ، وقد لحقه نصيب من هذه الظاهرة الخاصة في إطلاق الكُنى ، والصفات ، وتثبيتها ، بحيث تتحول – مع شيوع الاستخدام واستمراره – إلى أسماء ، أيقونات(53) خاصة بأصحابها ، فقد أوشك اسمه أن يختفي بتصدر “أيقونته” – أو وصفه الشائع – (الجاحظ) ، وإن كنا لا ندري – بدرجة اليقين – أنه سمع هذا الوصف البديل لاسمه ، أم ظل يذكر في حضوره بكنيته (أبو عثمان) أو باسمه (عمرو بن بحر)؟! . مهما يكن من أمر فإن هذا (الجاحظ) كان يملك من شجاعة الرأي وصفاء الرؤية ما جعله يتقبل الواقع (بما فيه الواقع اللغوي ، والواقع الاجتماعي) كما هو ، ونجد أمثلة متعددة في تقبله للألفاظ الشائنة ، كما في كتاب “الحيوان” . فبعد أن ذكر بعض المفردات المستقبحة ، رأى أنه لا يجد عيبا في تداولها ، بدعوى أنها وجدت ، وأنها ما وجدت إلا لتستخدم(54) . وفي هذا السياق فإن الجاحظ هو مؤلف كتاب : “البخلاء” ، ومع كراهية صفة البخل ، فقد صرح فيه بأسماء حقيقية ، وأخرى اخترعها ، ليكسب كتابه طابعه الفني النادر . كما سبقت الإشارة إلى عدد من “رسائله” التي حملت عناوينها عبارات مستكرهة ، أو مستقبحة . غير أن الجاحظ هو المفكر والأديب الذي يستطيع أن ينقلك إلى واقع زمانه ، أو ينقل واقع زمانه إليك دون حرج!!
أما كتابه الذي نعنيه ، فهو بعنوان :”كتاب البرصان والعرجان والعميان والحولان”، وقد حققه عبد السلام هارون(55) ، والجاحظ – في ملاحظة متكررة بالنسبة إليه – قد لا يكون البادئ بطرح الظاهرة (ظاهرة ذكر العيوب كعلامات أو سمات)، غير أنه حين يعرض لها ، فإنه يوفيها حقها من كافة جهاته ، فلا يكاد يترك مزيداً لمستزيد . وهو في توجهه لأصحاب النقائص البدنية المذكورة ، مسبوق بمن ذكره في مقدمته : “الهيثم بن عدي” على أنه لم يتحرج أن يذكر نواقص ، وقصور هذه المحاولة المبكرة.
والجاحظ في محاولته هذه يعرف الفرق بين الاسم والصفة ، كما نعرفه الآن ، “فالاسم” : ما يدل على الذات ، وهو غير قابل للتغير ، سواء في البشر أو في سائر المخلوقات . أما “الصفة” : فإنها معنى قائم بالذات ، زائد عليها ، وهذه الصفة قابلة للتغير بإحلال صفة أخرى ، أو بإضافة ، وربما انتقلت الصفة إلى نقيضها ، وهذه أمور معهودة نلحظها في التداول العام لأسماء الأشخاص والأشياء ، وصفاتهم .
والجاحظ في عنايته بمن نطلق عليهم الآن : (ذوي الاحتياجات الخاصة) نظراً لقصور قدراتهم ، يدرك في ذلك الزمن المبكر ، أن أصحاب هذه العاهات يملكون من التعويض ، ما يغطي على هذا العجز الذي يعانونه قسراً ، بل إن الجاحظ – بصرف النظر مؤقتا عن حصر العاهات التي عرض لها – عُني في مقدمة دراسته بأمرين :
الأول : معرفته بطبيعة النفس العربية ، وغلبة روح التحدي ، ورغبة التخطي لما يمكن أن يعد من المناقص ، بل إن هذه النفس العربية لا تتردد في أن تعلن عن هذا النقص (وليس أن تحاول إخفاءه أو مواراته) ، وأن تبرره وتعتذر عنه ، وربما لج بها العناد ، فراحت تفاخر به ، وتقلبه من المساوئ إلى المحاسن، ومن العجز إلى القوة والتفرد . وسنجد لهذا أمثلة عديدة من الأشعار والأقوال السائرة .
الثاني : أن الجاحظ بخبرته الواسعة بطبائع الحيوان (الذي ألف فيه موسوعة ضخمة باسم كتاب “الحيوان” – مع الوضع في الاعتبار تأثره بما كتب أرسطو عن الحيوان(56)) قد عُني في كتابه الذي نحن بصدده ، بتلك العلل التي يصاب بها الحيوان ، كما يصاب بها الإنسان ، مثل : العرج ، والحول ، والبرص ...إلخ.
وهنا ينبغي أن نكشف عما يمثله الاهتمام (العلمي) بالعيوب الجسدية التي تعرض للإنسان ، وأهمية هذا لما تميز به (العنوان في التراث العربي) من حيث اهتمامه بالإنسان ، فقد رأينا صوراً مختلفة ، ما بين الجاهلية (الشفاهية) ومقاربة زماننا (عصر التدوين ، ثم يليه عصر المطبعة) من التعامل مع أسماء الأعلام في اتخاذها عناوين ، أو علامات تحدد شخص المنتج/المبدع ، ثم تعرف بإنتاجه . وما يعنيه هذا من إعلاء الشعور بالإنسان ، بالشخص في ذاته ، بالمبدع الذي هو المفتاح ، والمدخل الطبيعي لما أبدع ، وإدراكه لاتجاهه : فاسم المبدع ، كما يعبر نقديا الآن : (عتبة) ، كما أن عنوان العمل عتبة أخرى ، وقد تفضل إحدى العتبات على غيرها من منظور إدراك المتلقي ، وما عساه أن يفتقده فيما يحاول أن يدركه من أبواب المعرفة . إن أصحاب النواقص من العميان والعوران والعرجان والبرصان وغيرهم ، ممن ذكرهم الجاحظ وغيره ، من المؤكد أن مشاهيرهم من أصحاب التميز في الصناعة ، قد ذكروا ضمناً في سياق التعريف بالفنون التي أتقنوها ، فلعله لم تكن هناك ضرورة لاختصاصهم بالتأليف في الموضوع المعين ، الخاص ، الذي يبدو وكأنه نوع من التشهير . غير أن التمعن في الأسماء المذكورة بعيوبها (الشديدة القادحة أحيانا) يعيد أمر هذا الاهتمام إلى نصابه ، فليس التشهير قصداً ، ولا مجرد إبراز الظاهرة في ذاتها ، وإنما القصد ما كشفنا عن جانب منه في مقدمة هذه الفقرة ، وهو اعتزاز العربي بذاته ، وبالمعنى الأصيل لشخصه المتجسد في النسب ، والصفات المعنوية ، والخلق ، والقدرة على الإبداع ، بما يطغى على هذا النقص العضوي ، الذي يغالب العربي (البدوي غالبا) طبيعته ، بأن يجعله موضعا للفخر ، ونضيف إلى هذا العامل النفسي التراثي ، عاملاً (حضاريا) آخر ، وهو أنه بإفراد هذه الشخصيات المصابة في أبدانها ، بدراسات تحاول أن تكون حصرية ، أو مستوعبة للأكثر والأهم ، ليس أن تقدم لنا صورة عن انتشار الآفات الجسدية في مجتمعات صحراوية ، تقل فيها أسباب الأخذ بالمبادئ العلمية ، والرعاية الصحية ، وإنما أن تؤكد لنا أنه على الرغم من هذه المعوقات المعلنة ، فإن هذه الشخصيات شغلت مواقع السيادة ، والقيادة ، والريادة في مجتمعاتها ، على مستوى القبيلة ، والمهنة ، والدولة في أحيان ليست قليلة.(57)
وقبل أن نستطرد إلى تقديم نماذج للإبداع في هذه الاتجاهات ، نشير إلى ما ذكره الجاحظ عن سبق عنترة إلى اتخاذ صورة (الأجذم) لهدف جمالي ، غير مسبوق ، وغير ملحوق ، لأنها صورة يتيمة فريدة ، تفضح من يسرقها ، وهي قوله في وصف الروضة، وطنين الذباب بها(58) :
فترى الذباب بها يغني وحده = هزجاً كفعل الشارب المتــرنمِ
غرداً يحك ذراعــه بذراعـــه = فعل المكـب على الزنادِ الأجذمِ
بل يشير إلى حرص بشار بن برد (الأعمى) على أن يعلل لذكاء الطفل الذي يولد أعمى ، وذلك في قوله:
وجدكَ أهدى من بصيرٍ وأجولا
إِذَا وُلِــدَ المَولود أعمى وجَـدْتَه
فجئتُ عجيبَ الظن للعِلم مَعْقِلا
عمِيتُ جَنِينا والذكاءُ من العَمَــى
بقلْبٍ إِذا مَا ضَيَّعَ النَّاسُ حَصَّلا
وغَاضَ ضياءُ العينِ للقلب فاغْتَدَى
بقَوْلٍ إِذَا ما أَحْزنَ الشِّعْرُ أَسْهَلاَ
وشعر كنور الروضِ لاءمتُ بينـهُ
ولكي يبرهن الجاحظ على أن قوة النفس الإنسانية وعظمتها ، لا ترتبط بكمالها العضوي ، ولا بجمالها الخِلْقي ، بقدر ما تعود إلى الإرادة ، ونماء الشخصية ، يقدم أمثلة (عملية) بمن يطلق عليهم : العرج الأشراف ، وفي مقدمتهم : أبو طالب ، معاذ بن جبل ، عبدالله بن جدعان ، الجموح الأنصاري ، عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، ويقول الجاحظ في عبارة جامعة : “والعرج الأشراف – أبقاك الله – كثير ، والعُمي الأشراف أكثر” ، كما يشير الجاحظ إلى : الحارث الأعرج الغساني الذي مدحه (النابغة الذبياني) فقال :
هذا غلام حسنٌ وجهه = مستقبل الخير سريع التمام
وإلى الحسن حفيد الإمام الحسن – رضي الله عنهما – ويذكر من الأشراف العرجان : قيس بن عاصم أحد بني مالك ، ومثله : الحارث بن شريك الشيباني ، ومن العرجان الأشراف أيضا : أبو الأسود الدؤلي ، والأحوص الأنصاري الشاعر ، ويونس بن حبيب النحوي .. إلخ . فلا يكاد الجاحظ يترك قبيلة أو صناعة إلا ويذكر مشاهير العرجان ، الذين تسيدوها ، أو برعوا فيها .
ولا تبرأ محاولة الجاحظ من نزعة المداعبة والاستطراف ، فيذكر من بين العرجان: عمران بن مره ، كما يذكر أنه كان بطلا ، وأنه الذي أسر الأقرع بن حابس ، وهو أعرج كذلك ، فكان الآسر والمأسور من طائفة العرجان!!
ويذكر الجاحظ- من سيكولوجية الأعرج – أنه يحاول أن يتغلب على ضعف منظره قدر المستطاع ، وإلا بحث عن وجه من القوة ، يتحول بالنقيصة إلى مفخرة ، فمن حيل العرجان : أنهم كانوا يفضلون قتال الفروسية ، فالأعرج يختفي عرجه ، لمجرد اعتلائه فرسه ، فإذا كان مقاتلا كفؤاً لم يؤثر عرجه في قدرته القتالية . وقد يصف أعمالا قتالية نادرة ، اقترنت بالعرج ، إذ يذكر حاتم بن عتاب بن قيس بن قشير ، وهو الذي كان ينشد رجله وهو يقاتل ، فسمي ناشد رجله ، وهو الذي كان يحجل يوم اليرموك على الأخرى ، ويقاتل الروم ، وذهب إلى قدر زيت تغلي ، فأدخل رجله فيها لتكويها ، ويقطع عنها النزف !! ويحكي عن : حكيم بن جبلة ، من عبد القيس ، أنه قطعت رجله بفخذها ، فتناولها فرمى بها قاطع رجله ، فكبده بها ، فسقط ، فزحف إليه حتى ذبحه ، ثم استرخى من النزف ، فاتكأ على قتيله وهو قاطع رجله ، فمر به رجلٌ فقال : من بك ؟ قال : وسادي !! وما إلى ذلك من عجائب ونوادر!!
ولا يختلف ذكر البرصان عن ذكر العرجان إلا في الأسماء ، فممن أصيب بالبرص من هم سادة ، ومن هم فرسان ، وأشراف ، بل وملوك ، وهناك من فخر بالبرص كذلك . يذكر من البرصان السادة ، والفرسان القادة : الربيع بن زياد وهو أحد الكملة ، وكان قائد عبس ، وعبدالله بن غطفان في حرب داحس . كما يُذكّر بالملك جذيمة الأبرش (الأبرص) ، ويرصد الجاحظ – في تدقيق نادر – كيف يتلطف العربي في ذكر الصفة ، تبعاً لموقع الموصوف ، فقد كان جذيمة بن مالك (صاحب الزباء وقصير) يقال له : جذيمة الأبرص ، فلما ملك قالوا على وجه الكناية : جذيمة الأبرش ، فلما عظم شأنه قالوا : جذيمة الوضاح .(59)
ومن البرصان كذلك : شمر بن ذي الجوشن الضبابي قاتل الإمام الحسين ، وعلي بن جبلة (العَكَوْك) وذكر في العميان كذلك(60) . ويذكر الجاحظ في “قائمة” البرصان أسماء شهيرة مثل : أيمن بن خريم (وهو تابعي وشاعر وراوية للحديث النبوي) ، وبشر بن المعتمر (صاحب الصحيفة الشهيرة في صناعة الكلام التي أوردها الجاحظ في البيان والتبيين) .
ويمكن أن ننهي هذه الفقرة ، وننهي هذا العرض عن ذوي العاهات ، ممن عرض لهم الجاحظ بذكر : جعفر بن دينار – من البرصان – وقد اصطنعه المأمون ، فقاد الجيوش ، وفتح الفتوح ، وولى الولايات . بل يذكر أن علويه المغني كان أبرص كذلك ، كما يصف مهارته في الضرب على الآلات ، وبخاصة آلة العود التي كان يجيدها بكلتا يديه .
نكتفي بما ذكر الجاحظ عن ( البرصان والعرجان ) عن سائر من أحصاهم في كتابه هذا ، فليس القصد أن نقف على مادته ، بقدر ما أن نستخرج منهجه ودوافعه ، وما ترتب عليه من ذكر أثره في العنونة بالأسماء ، وهو موضوع هذه الدراسة في الأساس .
* * *
عاشرا : هذه الإضافة الأخيرة عن العنونة بالأسماء في التراث العربي :
ونعني بها ما أضافه خليل بن أيبك الصفدي (صلاح الدين : 696هـ – 764هـ)، فلعله الوحيد الذي تأثر بتجربة الجاحظ في هذا المجال ، وإن أغفل الإشارة إليه في من ذكرهم في مقدمته لكتابه :”نَكْت الهميان في نُكَت العُميان”(61) . وفي هذه المقدمة أشار إلى ما سبق إليه (ابن قتيبة – توفي 276هـ) في كتابه ” المعارف” ، وقد ضمنه فصلا عن المكافيف ، ثم(أحمد بن علي بن بابه – توفي510 هـ) في كتابه “رأس مال النديم” ، ومن بعده (ابن الجوزي – توفي 597هـ) وقد يدل كتاب الصفدي على الاتجاه العام في الاختصاص بذكر طائفة محددة من ذوي العاهات الجسدية ، وهو اتجاه يبدأ بمقدمات لغوية وتاريخية ، ثم يفيض في ذكر النوادر والطرائف المقبولة والمرذولة على السواء.
وكذلك في كتاب الصفدي (صلاح الدين خليل بن أيبك) في كتابه الآخر : “الشعور بالعور” ، فقد ترجم لمن أصابتهم هذه النقيصة ، وبخاصة كبار المشاهير من الشعراء والقادة ، وزعماء القبائل ، فكأنما أفاد من تلك الأسماء التي تقدم بها الجاحظ ، وأضاف إليها المشاهير ، الذين ذكرهم التاريخ العام ، والتاريخ الأدبي ، أو رويت عنهم الطرائف والغرائب ، ما بين زمن الجاحظ (القرن الثالث الهجري) إلى زمان الصفدي (القرن الثامن الهجري) .
يمكن أن نقرر في ختام هذه الفقرة أننا قصدنا فيها إلى إبراز أهمية الاسم ، وخصوصية الوصف في مجال اتخاذه عنواناً لكتاب ، أو لرسالة ، أو لمبحث ، أو لمسألة، أو لترجمة خاصة لصاحبها ، بما يكشف عن اتجاه عقلي ، حضاري ، يكتنزه الضمير العربي ، إذ يعد الإنسان – ( بما هو إنسان) – بمثابة المفتاح ، أو كلمة السر التي ينبغي أن تكون مدخلا للإدراك في أي مسألة مثيرة للفكر ، أو للخيال ، أو للبحث العلمي على السواء . وقد عنينا – في ختام هذه الدراسة ، على إيجازها – بأصحاب القدرات الخاصة (العاهات) ، بما يكشف عن هذه القدرات الخاصة ، ويؤكدها في شخصياتهم وسلوكياتهم ، ومناحي تفكيرهم ، وإبداعاتهم على تنوعها . على أن ملاحظتنا الأخيرة على ما أضافه (خليل بن أيبك الصفدي) ، وما سبق أن أشار إليه من كتابات : ابن قتيبة ، وابن الجوزي، وابن بابه ، قد غلب عليه طابع الاستطراف والغرابة ، والميل إلى الإدهاش والإثارة ، وهذا يخرج عن طبيعة هذه الدراسة ، ويمكن أن يعود إليه من يرغب فيه ، ولهذا السبب عددنا الجاحظ صاحب البداية ، وواضع الأسس النفسية والفكرية ، الذي أوحى بالمعنى الفلسفي لاستخدام صفات النقص دليلاً على الكمال ، وتأكيداً لطابع الشخصية العربية في استوائها ، كما في مناقصها ، إذ تغالب هذه المناقص حتى تتغلب عليها ، وقد تتفاخر بها ، أو تحسن تعليلها ، كما بينا في مكانه .
الهوامش :
اهتمت دراسات نقدية فرنسية ، وإنجليزية ، وأمريكية (بصفة خاصة) بالسيميولوجيا – أو السيميوطيقا ، كما يؤثرها المؤلفون الفرنسيون خاصة ، والسيميوطيقا كما يؤثرها الباحثون الأمريكان ، وفي هذا السياق تطرح قضية العنونة ، وصلة العنوان بالمدونة ، كما تذكر أسماء : رولان بارت ، وبيرس ، ودو سوسير ، وجان كوهان ، وجان جينيت ، وجريماس .. وغيرهم .
يراجع في ذلك : دراسة بعنوان : “السيميوطيقا والعنونة” للدكتور جميل حمداوي – عالم الفكر (الكويتية) – يناير/مارس (1997) – ص79 – 112.
في دراسة الدكتور محمد فكري الجزار ، بعنوان : “العنوان وسيميوطيقا الاتصال الأدبي” – الهيئة المصرية العامة للكتاب – 1998 ، في النصف الثاني من دراسته يتجه إلى مقالات ، ودراسات ، ودواوين شعر ، وروايات حديثة . تنظر الصفحات 48 ، 49 ، 69 ، 72 ، 82 ، 115 ، 121 ، وغيرها . وفيها عرض لمقال صحفي ، وختم تنويعاته تطبيقياً برواية : (صاحبة البيت) ، للدكتور لطيفة الزيات ، ورواية (ذات) لصنع الله إبراهيم
وفي دراسة الدكتور بسام قطوس بعنوان : “سيمياء العنوان” – بسام موسى قطوس – الناشر : مكتبة كتانة ، إربد – 2001 ، يختار عدداً من عناوين الدواوين ، مثل: (حليب أسود) للمتوكل طه – ص54 ، و (شيء كالظل) للشاعر عفيفي مطر ، كما يتوقف عند (لافتات) أحمد مطر- ص83 ، وبعض عناوين قصائد معين بسيسو ، وسميح القاسم ، ومحمود درويش .
“معجم لسان العرب” لابن منظور المصري ، مادة ( ع ن ن ) .
Gerard, Genette,(1987).Paratexts: Thresholds of Interpretation. Cambridge: Cambridge University Press . P76
وترجمة عبارة جينيت : العنوان مجموعة من العلامات اللغوية التي تتصدر كتابا أو نصا مطبوعا أو عملا فنيا ، وهو بمثابة اسم لهذا العمل ، ووظيفته أن يعرف بالعمل أو يوصل ملخصا بمضمونه أو يثير فضول الجمهور المستهدف ، ويجتذبه للإطلاع عليه . ولا يشترط تحقق الوظائف الثلاث في آن واحد ، بل إن الوظيفة الأولى بمثابة الوظيفة الأساسية التي لابد للعنوان أن يؤديها ، أما الوظيفتان الأخريان فإنهما اختياريتان و مكملتان للوظيفة الأولى.
مقدمة “تاريخ ابن خلدون” – دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع – بيروت – طبعة أولى – 1981 .
انظر : مقدمة ابن خلدون – ص731 – 733 .
اقرأ عن التراجع عن المدنية ، واعتناق أحلام القوى والبداوة (المقدمة) ص542 ، 544 .
ينظر : مقدمة ابن خلدون – ص545 .
مقدمة ابن خلدون – ص550 .
مقدمة ابن خلدون – ص575 وما بعدها . وفي هذا المكان يعرض لعدد من المؤلفات التراثية المهمة ، وكيف تراتبت مسائلها على ما تقدمها .
مقدمة ابن خلدون – ص757 .
مقدمة ابن خلدون – ص764 .
العنوان في الأدب العربي : النشأة والتطور – الدكتور محمد عويس – مكتبة الأنجلو المصرية – طبعة أولى – 1988 – ص48 .
المرجع السابق نفسه .
ينظر المرجع السابق – ص89 . أما نص السيوطي فمن كتابه “الإتقان في علوم القرآن” – ج1 – ص161 .
المرجع السابق – ص180 .
المرجع السابق نفسه .
لم نصادف – على كثرة ما قرأنا – أن مؤلفاً في موضوع ما ، يختم دراسته بالنص على العناوين التفصيلية لكتاب أعجبه في الموضوع نفسه ، غير أن المألوف أن يشار إلى هذا الكتاب موضع الإعجاب ، وأن تفرز مسائله ، وتناقش القضايا التي تستحق النقاش فيه ، وفي هذا من الإشادة والصدق والدقة العلمية ما يكفي .
هذه القصيدة للشاعر الجاهلي الإسلامي “أبو ذؤيب الهذلي” وهي تتصدر ديوان الهذليين – تحقيق : أحمد الزين – ثلاثة أجزاء في مجلد – مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة – 1995 – ص1 .
انظر : ديوان عامر بن الطفيل – تحقيق : تشارلز لايل – دار الكتب والوثائق القومية – القاهرة – 2009 – ص3 .
هذا البيت في مطلع قصيدة رثاء من 83 بيتا ، في رثاء أبي إسحاق إبراهيم ابن هلال الصابي – ينظر نص القصيدة في ديوان “الشريف الرضي” – الجزء الأول – الناشر – مؤسسة الأعلمي للمطبوعات – بيروت – د .ت – ص 294 .
القصيدة في أحد عشر بيتا ، ينظر : ديوان ابن مطروح – تحقيق : الدكتور حسين نصار – دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة – 2004 – ص48 .
عن ابن سلام ، ينظر ما كتب صاحب هذه الدراسة عنه في كتابه :”مقدمة في النقد الأدبي” – دار البحوث العلمية – الكويت – 1975 – الطبعة الأولى – ص506 – 537 .
عن ابن قتيبة ، ينظر : المرجع السابق – ص538 – 563 .
كتب الجاحظ العدد من الرسائل (المقالات) مختلفة العناوين ، حققها العلامة عبد السلام هارون ، ومن أهمها :
رسالة التربيع والتدوير – الحنين إلى الأوطان – الجد والهزل – فصل ما بين العداوة والحسد – صناعة القواد (القادة) – مفاخرة الجواري والغلمان – فخر السودان على البيضان – القيان .. إلخ .
إخوان الصفا وخلان الوفا – وهي مقسمة في أربعة أقسام ، أو مستويات معرفية: الرسائل الرياضية – والرسائل النفسانية العقلية – والرسائل الجسمانية الطبيعية – والرسائل الناموسية الإلهية ، وتحت كل نوع مجموعة من الرسائل القصيرة تشرح جوهر الفكرة ، وتقدم البراهين العقلية على صوابها .
ينظر : “العنوان في الأدب العربي :النشأة والتطور” – مرجع سابق – ص273 وما يعدها .
المرجع السابق – ص 276 ، 278 ، 282 ، 284 ، 287 ، 289 ، 290 ، 294 ، وانظر خلاصة الرأي ص302 .
المرجع السابق – ص180 ، والمصدر المذكور بهامشه .
ديوان عائشة تيمور – طبعة مصر – 1886 .
ديوان البارودي – المجلد الأول – تحقيق علي الجارم ومحمد شفيق معروف – الهيئة المصرية العامة للكتاب – 1992 .
وفي كتاب(الكامل في التاريخ) يتأكد الحرص على ذكر الأسماء ، حتى أسماء من تولوا إمارة الحج في الموسم ، مع وجود أحداث كبرى لم يهتم مسجل التاريخ بأن يتعقب مسارها ، وآثارها . وبالنسبة لموسم الحج ، فقد دأب المصدر المذكور على تسجيل من أوكلت إليه الخلافة رياسة موسم الحج ، وقد تذكر هجوم الأعراب ، وانتهابهم لموكب التشريفة التي تبعث بها مصر إلى الكعبة كل عام ، وخطف نساء القافلة ، وقتل رجالها . يذكر هذا دون تعليق .
راجع ما كتبناه في كتاب (منافذ إلى الماضي المستمر) – الدراسة الثالثة بعنوان :
“الإبداع في مجتمع حر” – ص41 وما بعدها . وانظر بخاصة ما ذكر في صفحة51 -53 .
يرى البعض أن التهانوي توفي سنة إتمامه كتابه “كشاف اصطلاحات الفنون” أي عام 1158 ، ويقرر بعض من أرخوا له أنه وجد توقيع التهانوي على وثائق وفتاوى بتاريخ 1191 .
انظر : تعريف الدكتور عبد الحكيم راضي بكتاب “الفهرست” لابن النديم – مقدمة الجزء الأول – من طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب – القاهرة – 2006 .
ينظر “الفهرست” لابن النديم – ج1 – تحقيق : محمد عوني عبد الرؤوف ، إيمان السعيد جلال – ص2 .
المصدر السابق – ص42 .
المصدر السابق – ص140 .
هذا العنوان في المصدر السابق – ص190 .
المصدر السابق – ص209 .
المصدر السابق – ص234 .
المصدر السابق – ص309 .
المصدر السابق – ص186 .
هذا حسب إحصائنا ، اعتمدنا فيه على فهرس الفرق الأعلام والقبائل ، فضلا عن عدد غير قليل ذكر فيه أسماء أعلام غير منسوبة .
تعريف الدكتور رفيق العجم في مقدمة الكشاف ، وكتاب التعريفات للجرجاني ، ينظر الهامش – ص xx .
ينظر : المقدمة السابقة – ص vill .
يتوسع محرر المقدمة في هذه النقطة ، فيذكر أن مصطلحات الكشاف ، وضعت القارئ أمام ألفاظ وأسماء لم تقتصر على الوصف ، إنما اصطنعت ألفاظاً جديدة بألعاب في اللغة ، عن طريق التفعيلات تارة ، وعن طريق الخروج عن العادة تارة أخرى – المقدمة السابقة – ص xvll .
تيمورلنك : قائد أوزبكي ، مؤسس العائلة التيمورية الحاكمة ، حاول غزو الشرق العربي ، ووصل إلى بلاد الشام .
المقدمة السابقة – رقم xxiv. وينسب هذا القول إلى الألماني يوهان جوتفريدهردر (توفي 1803م) . ينظر الهامش التوثيقي في ذات الصفحة .
جاء في الحديث الشريف ، فيما أورده مسلم في صحيحه : حدثنايحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة ، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : أتدرون ما الغيبة ؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال : ذكرك أخاك بما يكره. قيل : أفرأيت إن كان في أخي ما أقول . قال : إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته ، وإن لم يكن فيه فقد بهته ” صدق رسول الله .
بمناسبة مرور ألف عام على مولد شيخ المعرة ، صدر كتاب بإشراف الدكتور طه حسين ، جمع أهم البحوث التي كتبت قديما عن أبي العلاء وأدبه ، وهذا الكتاب بعنوان : “تعريف القدماء بأبي العلاء” – الدار القومية للطباعة والنشر – 1965 ، عن نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية – 1944 ، وقد تصفحت هذا الكتاب المستوعب ، فنادراً ما وجدت اهتماماً بخصوصية طاقته التصويرية في (رسالة الغفران) ، أو قدرته الشعرية في ديوانيه ، قدر ما وجدت من الاهتمام (بالتفتيش) في عقيدته ، وهل مات أبو العلاء مؤمناً أم ملحداً متشككاً ؟! وهذا أمر مؤسف ، ومحبط بالنسبة لتاريخ الفكر العربي .
المنخل اليشكري : شاعر مقل ، ولكنه يجيد تنخل الكلام ، أم تنقيته ، وتدقيقه ، وله قطعة من عدة أبيات (في أثناء قصيدة) واسعة التداول في أغراض الوصف والغزل في العصر الجاهلي ، وهذا نصها :
وَلَقَدْ دَخَلـْتُ عَلَـى الفَتـَــــا = ةِ الخِـــــدْرَ فِي الْيـَوْمِ الْمَطِيـرِ
الْكَــاعِـــبِ الْحَسْنَــــاءِ تـَرْ = فُلُ فِي الدِّمَقْـسِ وَفِي الْحَرِيرِ
فَــدَفَعْتُهَــــــا فــتـَدَافَعَــتْ = مَشْــيَ الْقَطَــــاةِ إِلَى الْغَدِيرِ
وَلَثَمْتُهَــــــا فَتَنَفَّسَـــــــتْ = كَتَنَفُّــــسِ الظَّبْــــــيِ الْبَهِيـرِ
فَــدَنَــــتْ وَقَــــالَتْ يَا مُنَـ = ـخَّلُ مَا بِجِسْمِـــــكَ مِنْ حَرُورِ
مَا شَفَّ جِسْمِي غَيْرُ حُـ = ـبِّكِ فَاهْدَئِي عَنِّي وَسِيـــرِي
وَأُحِبُّهَـــــــــــا وَتُحِبُّنـــِي = وَيُحِـبُّ نَـاقَتَهــــــا بَعِـيــــــرِي
عبد بني الحسحاس : هو أحد عبيد قبيلة بني الحسحاس ، وله ديوان شعر مشهور ، وقد تغزل في نساء القبيلة ، فأفحش ، مما أدى إلى قتله ، ومن ثم خصص بوصف (عبد بنمي الحسحاس) ، وليس هو الوحيد الذي يوصف بهذا الوصف .
أيقونة icon : هو تعريب لكلمة يونانية تعني صورة ، أو شبه مثال ، والعبارة المتداولة – بصرف النظر عن المدلول الديني – تعني اكتناز دلالة محددة في صورة أو عبارة مختصرة . فهي رسم أو رمز يميز أمراً معيناً (مكانا ، أو فعلا ، أو زمنا ، أو شخصا ، أو مهنة .. الخ) .
ينظر ما كتب تحت عنوان “تناسب الألفاظ مع الأغراض – الوقار والتكلف – تسمح بعض الأئمة في ذكر الألفاظ – لكل مقام مقال ” فقرات من كتاب “الحيوان للجاحظ – الجزء 3 – ص39 – 43- تحقيق : عبد السلام هارون – طبعة ثانية – مصطفى البابي الحلبي في مصر – 1965 .
كتاب “البرصان والعرجان والعميان والحولان ” الطبعة الأولى– الناشر : دار الجيل – بيروت – 1410هـ .
هناك إشارات لتأثر الجاحظ بدراسة أرسطو تحت العنوان نفسه ، غير أننا نرى أن هذا التأثر لم يجاوز الإطار العام ، فالحيوان الذي عني به الجاحظ ينتمي إلى بيئته الشرقية الحارة غالبا ، على أن عنايته بأنواع الحيوان تتجلى من خلال مختارات شعرية ، واقتباسات ، وأقوال تنتمي إلى عصور تالية لزمن أرسطو .
وإلى اليوم أستعيد ذكرى قديمة ، وأنا طفل ، وكان جارنا يقرأ في كتاب عن الفتنة الكبرى ، بصوت مسموع ، ليتمكن المتحلقون حوله من سماعه ، فجاء ذكر معركة صفين ، وعرفت – أنا الطفل – أن قائد الإمام علي فيها هو : مالك بن الحارث الأشتر ، وأن هذا القائد البطل كان أعور ، فاستوعبت أذني معنى الكلام ، وعجبت – في طفولتي – كيف يكون قائداً لجيش فاقداً إحدى عينيه ؟! غير أن كتاب الجاحظ ، الذي استقصى الظاهرة في كافة اتجاهاتها ، كشف عن أن هذه النواقص كثيراً ما تعوض بقدرات متجاوزة .
والذباب : كل ما يطير من الهوام ، وليس ما نطلق عليه الآن هذا اللفظ ، فالنحل، والزنابير وأشباهها من الذباب كذلك.
وهذا الرصد الدقيق لأوصاف البَرَص ، واختلافه مع أصحاب المنزلة الاجتماعية يغري بعقد دراسة عن الأوصاف في اللغة العربية ، المناظرة أو المسامتة للطبائع والمنازل والطبقات .
يذكر الجاحظ من طرائف الشاعر العكوْك : أنه كان مع عمائه وشُنعة برصه يتعشق جارية ، ويتعشقها شاعرة ظريفة أديبة ، وكان انشد حميد بن عبد الحميد شعراً ، فوهب له مائتي دينار ، فانصرف من دار حميد إلى منزل المعشوقة ، فصب الدنانير في حجرها ، ثم مضى إلى منزله ، وليس فيه درهم ، ولا شيء قيمته درهم ، وكان أحسن خلق الله إنشاداً ، ما رأيت مثله بدويا ولا حضرياً .
“نكتب الهميان في نكت العميان”: الهميان: كيس النقود أو ما نحفظ فيه الأشياء العزيزة ، والنكت (بسكون الكاف) يعني : الكشف، والنُكَت (بفتح الكاف) تعني الطرائف والنوادر . وقد نشرته : الهيئة المصرية العامة لقصور الثقافة – القاهرة – 2012 .
أ. د. محمد حسن عبدالله
* [ نشرت في مجلة ” عالم الفكر ” العدد 180 ( أكتوبر – ديسمبر 2019) ]
 prof-mohamedhassan.com
prof-mohamedhassan.com
الاهتمام بالعنوان يشغل مساحة واضحة في اهتمام الدراسات النقدية المعاصرة ، ويمكن أن نزعم أننا قرأنا أكثرها في صورتها الأصلية ، أو تعرفنا عليها من خلال عناية الباحثين السابقين بهذه الدراسات ، التي سبقتهم بالطبع . وقد يعد هذا بمثابة “ثغرة” في هذه الدراسة ، لأننا نعرف أنه لا يحق لباحث أن يفيد من مصدر وسيط ، فلا مناص من استقاء الرأي من مصدره الأول ! غير أننا في توجهنا عبر صفحات هذا البحث ، ستكون لنا وقفة تعريفية مختصرة بأهم جهود هؤلاء السابقين في بحوثهم حول (العنونة) لتكون مجرد توطئة لما يتوجه إليه اهتمامنا ، وهو : “العنوان في التراث العربي” . ولن نغفل جهود الباحثين السابقين ، الذين أعطوا العنوان في التراث العربي مساحة من اهتمامهم ، غير أن هذا الاهتمام بالعنوان في التراث – وكما سنبرهن عملياً في هذه الدراسة – ظل محدوداً جداً ، أو متعجلاً ، أو خاضعاً في قراءته لمفاهيم نقدية وفلسفية غربية ، أو بعبارة أخرى : ليست من ابتداع العقل العربي أو ثمرة لتأمل نشاطه في هذا الاتجاه (اتجاه العنونة) ، كما أنها لم تكن متشبعة بالمفاهيم ، والتوجهات التي حددت مسار هذا التراث العربي عبر القرون .
وبالإجمال يمكن القول إن النسبة العالية من مساحة الاهتمام النقدي العربي بالعنوان ، تستقر على قاعدة من مفاهيم الفكر النقدي الغربي: الفرنسي/ الأوروبي/ الأمريكي(1) غالبا ، أو دائما ، وهذا الانحصار في المصطلح النقدي الغربي أفاد بدرجة كبيرة ، في كشف أسرار العنونة ، وبخاصة فيما يؤدي إلى الكشف عن وظائف العنوان ، وأثره في المتلقي ، وصلته ، أو صلاته بالمتن الذي يتصدره ، سواء كان قصيدة ، أو ديواناً شعريا ، أو رواية ، أو مسرحية .. إلخ . غير أننا نلاحظ أن الغالبية العظمى من العناوين المستدعاة لأداء هذا الدور – أو هذه الأدوار – الكاشفة ، إنما هي عناوين عصرية ، أو حديثة ، اختيرت بعناية لتؤدي الدور المنوط بها ، بتوجهات تلك التقسيمات، والمصطلحات الممنهجة – لدى الباحثين الغربيين – لما يتوقعون من علاقات عناوينهم بإبداعاتهم(الغربية)(2) ، ومن ثم ظل العقل العربي ، والوجدان العربي العام – في جوهر خصوصيته – خارج دائرة الاهتمام ، أو يحتل مساحة محدودة ، باستثناء دراسة محمد عويس (أستاذ الأدب العربي بجامعة المنيا) وهي بعنوان : “العنوان في الأدب العربي : النشأة والتطور” من ثم تعد المحاولة المؤسسة للبحث في هذا الاتجاه ، وسنعرض لهذه الدراسة المميزة ، ولغيرها التي أسهمت في كشف أقنعة ظاهرة العنونة من زوايا مختلفة، وإن تكن عنايتها بالعنوان في التراث العربي ، تأتي عابرة ، كما تأتي اختياراتها ، مما آثرت من عناوين الإبداع العربي – في أشكال مختلفة – مستقاة في إطار المنتج الأدبي عبر القرن العشرين ، أو النصف الثاني منه على الأكثر .
أولا : العنوان : اللفظ والدلالة في المعجم :
جاء في “معجم لسان العرب”(3) ، في مادة (ع ن ن = عنن) : عنَّ عن الشيء يعِن ، ويعُن ، عنناً ، وعنوناً : ظهر أمامك ، وعنَّ يعِن ويعُن عناً وعنوناً واعتن : اعترض وعرض .. والاعتنان : الاعتراض . والعُنُنُ : المعترضون بالفضول … ورجل مِعَنّ : يعرض في شيء ، ويدخل فيما لا يعنيه ، ويقال : امرأة مِعِنّه ، ورجل مِعِنْ : تعتن وتعترض في كل شيء .. والمِعَنْ : الخطيب .. وفي حديث طهفة : برئنا إليك من الوثن والعنن ، الوثن : الصنم ، والعنن : الاعتراض ، من عنّ الشيء : أي اعترضه … وفي حديث عليّ في ذم الدنيا : ألا وهي المتصدية العنون، أي التي تتعرض للناس ، وفعول للمبالغة … والعَنُّ : المصدر ، والعنن : الاسم ، ومنه سمي العِنان من اللجام ، عناناً لأنه يعترضه من ناحيته ، لا يدخل فمه منه شيء … والعانُّ من السحاب : الذي يعترض في الأفق … ويقال للرجل الشريف العظيم السؤدد : إنه لطويل العِنان ، ويقال : إنه ليأخذ في كل فن وعن وسن ، بمعنى واحد …. وفي حديث عبدالله بن مسعود : كان رجلٌ في أرض له إذ مرت به عَنانةٌ ترهيأ ؛ العانة والعَنانة : السحابة ، وجمعها عَنان ، وفي الحديث : لو بلغت خطيئته عَنان السماء ؛ العَنان ، بالفتح : السحاب …. وأعنان السماء: نواحيها … وأعنان الشجر : أطرافه ونواحيه .
لقد أطلنا – نسبيا- بتعقب تقلبات مادة (عنن) ، واختلاف معانيها ، لنؤكد أمرين : أن هذه المادة ذات المعاني المختلفة ، كانت معروفة ، ومألوفة لدى العصور القديمة، وأنها – في دلالتها العامة – تعني : الضبط ، والمنع ، والتحكم ، والاتساع ، والارتفاع ، والظهور … إلخ ، مما يمكن تأويله أو استلهامه من معنى عِنان (بالكسر)= اللجام ، وعَنان (بالفتح) = السحاب . وليس يصعب أن ندرك ما يعنيه مصطلح “العنوان” الذي لم يغادر المعنيين السابقين .
على أننا نصل في النهاية إلى “عنوان الكتاب” ، وهنا يقول لسان العرب : “وعننت الكتاب ، وأعننته لكذا ، أي عرضته له ، وصرفته إليه . وعَنّ الكتاب .. كعنونه ، وعنونته ، وعلونته بمعنى واحد مشتق من المعنى .. وسمي عِنواناً ، وعُنوانا ، لأنه يعن الكتاب من ناحيتيه .. ومن قال “علوان الكتاب” جعل النون لاماً ، لأنها أخف وأظهر من النون ، ويقال للرجل الذي يُعرّض ولا يصرح : قد جعل كذا وكذا عنوانا لحاجته .. والعنوان : الأثر ؛ قال سوّار بن المضرب :
وحاجة دون أخرى قد سنحت بها = جعلتها للتي أخفيت عنوانا
قال (ابن بري) : وكلما استدللت بشيء : تظهره على غيره فهو عنوان …
قال الليث : العلوان لغة في العنوان غير جيدة ، والعنوان بالضم ، هي اللغة الفصيحة .
وقال أبو داوود الرواسيّ : لمن طلل كعنوان الكتاب .
وقال (ابن بري : ومثله لأبي الأسود الدؤلي ) :
نظرت إلى عنوانه فنبذته = كنبذك نعلا أخلقت من نعالكا
لقد انتهى ما اقتبسناه عن (لسان العرب) ، والطريف أنه أوصلنا – بعد الصبر والتعقب – إلى أن مصطلح : “عنوان الكتاب” قد استخدمها شاعر قديم : “لمن طلل كعنوان الكتاب” ، وأن التعبير العامي الشائع في بعض جهات ريف مصر ، حين يقولون :العلوان، باللام ، ليس خطأ ، وليس لحنا ، وإن لم يكن الأفصح!!
وقد نجد أهم ما نطلب في تحديد العنوان : وصفاً ، وتحديداً ، ووظيفة لدى صانعه ، ولدى متلقيه ، في عبارة جامعة – مختصرة عند جيرارد جينيت ، وهذا نصها :
Title
A title is a set of linguistic signs that may appear at the head of a book or any other published text or work of art to designate it, indicate its subject matter as a whole, and to entice the targeted public. The three functions are not necessarily all fulfilled at the same time: only the first is obligatory. The other two are optional and supplementary (4)
* * *
ثانيا : تنوير جانبي مؤثر من مقدمة ابن خلدون :
قد ينتابنا مستوى من العجب لغرائب العناوين التي نصادفها في مؤلفات تراثية عربية في شكل “كتب” أو “مقالات” – (مما كان يدعى “رسالة” ، مثل : رسائل الجاحظ ، ورسائل إخوان الصفاء ، فيما بعد ، وعناوين المقامات فيما بعد البعد) . وستكون لنا وقفة مع هذه العناوين الطريفة ، على الأقل من زاوية علاقة العنوان بالموضوع/المضمون الذي يتصدره . وما من شك في أن عجبنا يزداد حين “نكتشف” أن ظاهرة العنونة في التراث العربي ، مع ما تتسم به من الغرابة والطرافة ، لم يلتفت إليها باحث قديم ، وإن جرى التعليق على بعض منها (وهذا غير ما نتقصده من طرح الظاهرة في صورتها الشاملة ، وتعقب مراحلها ومظاهرها) . وقد يزداد العجب إذ ندرك أن “العنوان” ظاهرة قديمة جداً ، وأنه يشغل مكاناً في الإدراك الفطري للأشياء . فقد تواترت المعارف/المدركات على العقل البشري ، ومن ثم راح يختزنها مكوناً ما نطلق عليه “الذاكرة” ، وهذه الذاكرة لا تأذن بالفوضى (في غير حالات مرضية) ، وإنما تستعين بتقسيم المدركات إلى أنواع ، وسلالات ، وسياقات ، وتداعيات ، وتراتب أزمنة ، وعلاقات … إلخ ، مما يجعل من الاهتداء إلى ضرورة وجود (علامة مميزة) فارقة ، تساعد الذهن على استعادة بعض ما يختزنه من المعرفة ، وعلى هذا الأساس وُجد تقسيم “الحقول المعرفية” ، وخواص الحواس ، والحقول الدلالية .. وما إليها .
وقد حرصت الكتب المقدسة على أن تميز نصوصها ، أو مراحلها ، بأرقام وعناوين ، وهذه الكتب المقدسة من أقدم المدونات التي عرفها الإنسان ، وتداولتها المجتمعات التي تقبلتها ، واتخذتها إماماً للدين والدنيا ، وقرأها الناس على مستوياتهم.
ففي “العهد القديم” تتعاقب “الأسفار الخمسة” المكونة للتوراة [ سفر التكوين – سفر الخروج – سفر اللاويين – سفر العدد – سفر التثنية ] ومن بعدها تتوالى أعمال الرسل ، ومن بعدها مزامير داوود ، ومن بعده “نشيد الإنشاد الذي لسليمان” ، وهكذا تصدر العنوان محاور العقيدة ، وتسلسل أنبيائها ، والتعريف بأهم ما نُسب إلى كل منهم . ولا يختلف (كتاب العهد الجديد لربنا ومخلصنا يسوع المسيح) عن النسق السابق ، فبين أيدينا أربعة من الأناجيل التي اعترفت بها الكنيسة ، يحمل كلٌ منها اسم الحواري أو الرسول الذي كتب النص [ متّى – ومرقس – ولوقا – ويوحنا ] وهكذا تتعاقب أعمال الرسل مرة أخرى . أما القرآن الكريم ، فقد حملت سوره (الأربع عشرة بعد المائة) عناوينها ما بين [ فاتحة الكتاب و سورة الناس ] . هذا التقسيم ، وهذه العناوين (أسماء السور) أساس من أسس العقيدة ، لا يملك بشر أن يغير فيه ، غير أن الجهد البشري ما لبث أن أدخل تفصيلا إضافياً لييسر للذاكرة عملية الحفظ ، وعملية الاستعادة ، فكانت : الأجزاء ، والأحزاب ، والأرباع ، وكل ذلك من صنع البشر ، بقصد تيسير المعرفة والحفظ ، والاهتداء إلى مواقع الحاجة حين تعن إليها ضرورة .
ويمكن أن نلتمس للعقل البشري عذراً في غفلته عن تأمل الأقسام ، وما يتصدرها من عناوين ، بما يترتب على ذلك من تشريح الظاهرة (ظاهرة العنونة) ، والكشف عن وظائفها ، وعلاقاتها ، وأثرها في استجابة المتلقي للنص . أما الاعتذار عن الغفلة فيرجع إلى الألفة ، والعادة ، وقد يضاف إليهما – من ناحية الكتب المقدسة خاصة – أن قدسيتها عند قارئها قد تكبح إرادته في التفتيش أو التفتيت للكشف عن أسرار النص ، وبخاصة إذا كان هذا النص يصل إلى متلقيه عبر وسائط بشرية (الأحبار ، والكهنة ، والمشايخ) فإنهم إذا لم يتولوا هذا بأنفسهم ، لن يأذنوا لأحد من غير المنضوين إلى أنساقهم ، القيام بمثل هذا العمل !!
وهنا نصل إلى ابن خلدون (ولد 732هـ- توفي 808 م) ، ففي مقدمته الضافية(5)، التي أرخت للعمران البشري ، وكشفت عن شرائط تقدم الأمم والجماعات ، وأسباب تخلفها ثم انهيارها ، لتعقبها غيرها ، في هذه الدراسة الشاملة سنجد عبر أكثر من ثمانمائة صفحة ما يمكن أن نكتشف فيه (جانبا) من أسباب غفلة العقل العربي (المثقف) عن الاهتمام بظاهرة العنونة ، ودراستها ، على الرغم من أنه أهمل كتابة العنوان حينا ، ومارسها بقوة ، وبتفصيل ، وبكثير من التحري والدقة ، في أحيان أخرى كثيرة ، وكانت لهذا العقل العربي توجهات ، وطرائق ، وتصانيف خاصة ، انفرد بها (تراثنا) عن أي محرر قديم ، سابق عليه ، أو لاحق به !! وهذا هو المحور الأساسي الذي نعنى به في هذه الدراسة .
أما ابن خلدون فقد ذكر في تعليلاته لتراجع الخلافة الإسلامية ، أو الدول العربية من بعدها ، ما يمكن أن يعد – بالتأمل – سبباً أساسيا في جمود أساليب التأليف ، وتقاليده في الكتابة ، بعد أن غادر الفكر العربي ، والإبداع العربي ، عصر التداول الشفاهي للمعرفة ، ودخوله عصر الكتابة ، عبر الوراقين ، والنساخ ، وحتى مشارف عصر المطبعة .
في اهتمام ابن خلدون بالعلوم (الشرعية والفكرية والأدبية) أشار – تبعا- إلى ما يمكن أن يعد اقتراحا بالتقسيم ، وصورة مبكرة للعنونة ، فمثلا يستخدم مصطلح : الباب أو الأبواب ، وهو مسبوق إلى هذه القسمة ، غير أنه في رصده لتفاصيل النشاط العلمي يضع أمام أعيننا “عناوين” واضحة ، من حقها أن تتصدر أبواباً وفصولا ، وأن تغادر موقعها السياقي في أن تكون (حُكما) يصف أو يلاحق موضوعا جزئيا بعينه ، ففي علم الحديث – على سبيل المثال – نجد المصطلحات : الصحيح – الحسن – الناسخ والمنسوخ – الغريب – المؤتلف والمختلف ، وفي الفقه نصادف عناوين الأقسام : الوجوب – الحظر – الندب – الإباحة – الكراهة – التحليل .. إلخ .
وفي فقرة مطولة –نسبيا- يعرض ابن خلدون لمستويات تدخل العقل في الموروث العلمي الذي أنتجه السابقون ، فيحصرها في :
استنباط فروع أو أقسام أو أبواب أو مسائل يضيفها لتعم المنفعة .
أن يتدخل بالشرح والإبانة لما عساه أن يكون قد استغلق على غيره .
أن يعثر المتأخر على غلط أو خطأ في كلام المتقدمين ، ممن اشتهر فضله ، وبعد في الإفادة صيته .
أن يكون الفن الواحد قد نقصت منه مسائل أو فصول .
أن تكون مسائل العلم قد وقعت غير مرتبة في أبوابها ، ولا منتظمة ، فيرتبها ويهذبها .
أن تكون مسائل العلم مفرقة في أبواب مختلفة من علوم أخرى ، فيجمعها تحت عنوان مبتكر .
أن يكون الشيء من التآليف التي هي أمهات للفنون مطولا مسهباً ، فيقصد إلى تلخيصه .(6)
وبتأمل هذه المسارب السبعة التي رخص فيها ابن خلدون لجيل محدث بالتدخل في المنجز العلمي الموروث ، نلاحظ أنه يحوم حول ضرورة ضبط تفاصيل العلوم بمصطلحات هي “عناوين” جديدة ، دون أن يصرح بهذا تحديداً .
ولا يتردد هذا المؤسس العظيم لعلم الاجتماع ، على غير سابقة ، في أن يدين اتجاهات ، وحركات ، وسياسات ، اشتركت جميعها في تعطيل التقدم العلمي العربي ، وتراجعه ، ولعل في مقدمة أسباب الخذلان ، والجمود العلمي : ارتكاس التطلع الحضاري للأمة العربية (في جهات متعددة منها ، بعد أن تقسمت في ممالك ودول مختلفة)، فبعد أن كانت الغلبة لنزعة التحضر ، وتأسيس المدن ، والاهتمام بالعلم ، حدث ما يمكن أن يعد نوعا من الردة ، إذ استيقظت طموحات البداوة(7) ، وتحولت إلى مثل أعلى للقوة ولبناء الشخصية والدولة على السواء ، مما صرف دعاة العمران عن الاهتمام بالتجديد والبحث، وأيقظ لدى المغامرين أحلام الفتح والغلبة والاحتكام إلى القوة ، والحشد ، وليس إلى الحضارة والتقدم . ويقدم مثلا بالحياة العلمية في مصر ، في زمانه ، إذ كانت زاهرة عامرة بالمؤسسات العلمية ، المحتشدة بطلابها ، وبما يحتاج هؤلاء الطلاب من المؤلفات والنفقات ، وأسباب الإقامة .. إلخ ، بالقياس إلى ما يشاهده – في زمانه – بمدينة فاس وسائر أقطار المغرب التي يصفها بأنها خلت من حسن التعليم(8) ، من لدن انقراض تعليم قرطبة والقيروان ، ولم يتصل سند التعليم فيهم ، فعسر عليهم حصول الملكة ، والحذق في العلوم !! فكأن ابن خلدون يرى أن “التحضر” و “التقدم” سياق ينبغي أن تتواصل حلقاته ، وتتدافع موجاته ، فيصل إلى الابتكار ، والتجديد المستمرين ، أما إذا انقطع خط التواصل فإن الجمود ثم التراجع هو القانون الذي يحكم في هذه الحالة . كما يحمل ابن خلدون على اتجاه الفكر العربي/الإسلامي إلى اختصار المطولات ، ونظم العلوم الذي شاع في زمانه ، ويرى أن هذا الاتجاه يخل بأسس التعليم ، ويعطل ملكة الابتكار .
وفي أماكن أخرى متناثرة من دراسته الضافيه ، يعلي من شأن تعليم الخط في مصر خاصة ، ويذكر أن بها معلمين مختصين لتعليم الخط ، كما يذكر أن الطباع المتحضرة مركوز فيها الاستزادة من العلم بعد المعرفة بالمنجز فيه . ويشير إلى مبدأ منهجي مهم ، وهو ضرورة أن تتراتب دراسة العلوم على أسس الإدراك والاستطاعة ، والإلمام بالمبادئ ، ويذكر على سبيل التمثيل : أن النظر في القرآن والحديث لابد أن تتقدمه العلوم اللسانية (علم اللغة ، وعلم النحو ، وعلم البيان ، وعلم الآداب .. إلخ)(9). ويدلل ابن خلدون على سعة إطلاعه على مؤلفات السابقين بأن يرصد تطور التأليف في بعض العلوم ، وكيف تتفرع الأبواب ، وتتعدد الفصول مع استمرار التحصيل والتجريب(10) . وقبل أن ننهي هذه الإضاءة على جهد ابن خلدون في التعليل للجمود العلمي (بل التراجع) الذي أصاب حركة التأليف في زمانه ، ومن ثم عطل ملكة الابتكار ، يقدم – فيما نحن بصدده تحديداً ، تفسيراً لثلاثة عناوين محددة من التراث السابق على زمانه :
فحين عرض لجهد الخليل بن أحمد الفراهيدي في وضع معجمه بعنوان :”كتاب العين”(11) أبان عن طريقته في تحديد أصول الكلمات ، وتقلباتها ، ومن ثم إمكان حصرها ، فإذا عرض لسبب تسمية هذا المعجم بـ(العين) ذكر أن الخليل بن أحمد مضى في أثر المتقدمين من المؤلفين العرب ، الذين كانوا يذهبون في تسمية دواوينهم إلى مثل هذا ، وهو تسميته بأول ما يقع فيه من الكلمات والألفاظ.
وبما ذكر في (أ) كأنما أبان لنا عن سبب تسمية القصائد بمطالعها ، فنقول قصيدة : (هل غادر الشعراء) لعنترة – و(قفا نبك) لامرئ القيس – و(بانت سعاد) لكعب بن زهير .. وهكذا . وهذه إحدى وسائل “العنونة” التي اختصت بها الثقافة العربية ، وليس لها سابقة في ثقافة أخرى ، ويمكن أن نضيف في هذا السياق أن ذكر المطلع كعلامة ، أو عنوان يمكن أن يتخلى عن موقعه في مواقف بعينها ، ليفرد مكانا لتخصيص أكثر دقة ، ويتجلى هذا في ذكر قافية القصيدة المختارة ، أو المقصودة بالإشارة ، كأن نقول : (لامية العرب) للشنفرى ، و(تائية) كثير عزة، و(سينية) البحتري ، و(همزية) البوصيري .. وهكذا .
(ج) في معرض حديثه عن كتاب :”الأغاني” (للأصفهاني) علل هذه العنونة بالآتي : ” ألف القاضي أبو الفرج الأصبهاني كتابه في “الأغاني” ، جمع فيه أخبار العرب ، وأشعارهم ، وأنسابهم ، وأيامهم ، ودولهم ، وجعل مبناه على الغناء في المئة صوتاً التي اختارها المغنون للرشيد” .. إلخ . وبهذا شرح سبب اختيار الأصفهاني لعنوان كتابه .(12)
وفي ختام هذا العرض الموجز لجُهد ابن خلدون (المبكر) في ذكر بعض العناوين ، ومحاولة التعليل لها (العين – الأغاني ) فلا نشك في أن استيعاب مادة “المقدمة” ستكشف عن إضاءات أخرى . أما فيما نحن بصدده ، فقد كشف لنا بوضوح أن انصراف العقل العربي عن الابتكار ، والكشف ، ونقد المنجز الذي سبقت به العصور ، وتنميته ، يتأسس على غياب المثل الأعلى الطامح إلى التقدم ، وانحراف الإدراك العام إلى اعتناق قيم البداوة ، والانخداع بما تتصف به من العصبية ، وحب الغلبة ، وهذا – في جملته – معطلٌ للتقدم العلمي ، وللإتقان بوجه عام .
* * *
ثالثا : تنوير مؤسس للعنوان في التراث العربي :
يعد صدور كتاب “العنوان في الأدب العربي : النشأة والتطور” لمؤلفه محمد عويس (أستاذ الأدب العربي بجامعة المنيا) بمثابة وضع حجر الأساس لبناء تصور فكري وفني للعنوان في التراث العربي . وهذا الكتاب (الذي صدرت طبعته الأولى عام 1988) لا يمثل أول طرح للقضية ، فقد اتجهت جهود التراجمة العرب في المغرب ، ثم في المشرق لاستمداد نظريات ، وأفكار ، وفلسفات لغوية – في لغاتها الأجنبية – عن العنوان وفنونه ، وانعكاساته .. إلخ . ونقلها إلى اللسان العربي ، ولكن هذه الترجمات لم توجه الأفهام (عندنا) إلى استثارة الموضوع من منظور تأسيسي ، يكشف عن جذور فنون العنونة في التراث العربي ، وإنما اتجهت جهود نقادنا (وفي مقدمتهم محمد فكري الجزار في مصر ، وبسام موسى قطوس في الأردن ، فضلا عن مقالات مترجمة أو موضوعة غير قليلة) إلى الكشف عن أبعاد المصطلح ، وتقلباته ، وآثاره .. إلخ ، معتمدين على تلك الدراسات التي سبق إليها نقاد الغرب ، ليتوجهوا – أعقاب ذلك – إلى اختيار بعض عناوين الكتب ، والدواوين ، والقصائد ، والروايات المعاصرة ، أو الحديثة ليجروا عليها تطبيقاتهم المستمدة من تلك المصادر الأجنبية . وهذا جهد علمي مشكور ، ومؤثر ، وإيجابي بدرجة ما ، غير أنه استبعد تماماً – أو انشغل عن – محاولة الكشف عن جذور العنونة في تراثنا العربي ، ربما لأن هذا الموضوع يحتاج إلى جهد زائد ، واتساع في التخصص ، وصبر على تعقب الظواهر ، ومن هنا تأتي أهمية ما صنع محمد عويس الذي وجه النصيب الأوفى من دراسته عن: “النشأة والتطور” إلى الموروث العربي في مجال العنونة ، وبهذا ملأ فراغا بحثيا ، لم يسبق التعرض له . لقد بدأ بداية تقليدية بأن طرح معاني وتقلبات مادة (العنوان) في المعاجم العربية ، وهذا ما اخذ به كل من عرض للموضوع فيما بعد ، وإن تقاصر جهدهم عن تلك المحاولة المبكرة ، التي ربما استفاضت حتى تجاوزت مطالب البحث في العنونة .
تتكون دراسة محمد عويس من سبعة فصول ، عن :
المعنى والمبنى .
العنوان قبل انتشار التدوين .
عوامل تطور العنوان في عصر التدوين .
العنوان في عصر الطباعة إلى أوائل القرن العشرين .
عنوان المقالات الأدبية في النصف الأول من القرن العشرين .
عنونة القصيدة العربية في النصف الأول من القرن العشرين .
العنوان في الشعر المعاصر : دراسة فنية وتطبيقية .
وكما نرى فقد قدم الباحث في ما يتجاوز أربعمائة صفحة ، دراسة وافية ، ضافية، ربما أثقلها شيء من الإسهاب ، والإطالة التي لا يحتملها موضوع شديد التركيز ، مثل : “العنوان“ . وقد نشير إلى شيء من ذلك ، وبخاصة حين تؤدي رغبة الإشباع ، والإطالة إلى استدراج البحث ، لطرح نقاط هو في غنى عنها ، ونحدد بعض الأمثلة على ما ذكرنا:
فقد ربط الباحث بين أسماء الأماكن والعناوين ، وهذا صحيح بالمعنى العام، فاسم الشخص ، أو اسم المكان محدد لهويته ، فكأنما يؤدي إحدى أهم وظائف العنوان ، ولكننا لا نملك أن نوافق الباحث على أن يعد كل اسم هو عنوان للرابطة العرفية أو الطبيعية بين الاسم والعنوان ، إذ يقول “إن أسماء الأماكن والبلدان ، وما شابهها كانت عنوانات وضعها العربي لربط معارفه الشفهية المختزنة بعضها ببعض ، حتى أسماء آلهته المتعددة ، كانت عنوانات رامزة إلى تعدد الآلهة في المعتقد الديني الوثني لدى عرب الجاهلية”(13) . بل ينبه إلى أن العربي القديم كان ينسب نفسه إلى هذه الآلهة ، مثل عبد يغوث ، وعبد اللات ، وعبد العزى ، كما ينبه إلى أن شيوع اتخاذ العربي لنفسه كنية ولقباً بالإضافة إلى اسمه ، كان إمعانا في العنونة الدالة على شخصيته(14) . ويرى الباحث الفاضل في مثل هذا ما يحمل معنى العنوان “غير المباشر” .
وحتى مع تخفيف وصف العنوان بأنه غير مباشر ، لا يصح في رأينا ، على الأقل لأن هذا المسلك إنساني عام ، وليس مختصا بالعرب ، فتسمية الأشياء فطرة مركوزة في العقل الإنساني ، ومن ثم لا مجال لإفراد العرب وتخصيصهم بها ، وتقصيها وكأنها اختراع وعلامة خاصة بهم .
وقد تطرق الباحث إلى الأسماء التي حملتها سور القرآن ، ذكرنا ذلك سابقاً في حدود إمكان طرح سؤال عن : إذا كان القرآن مكونا من سور/موضوعات ، استقل كل منها بعنوان ، لماذا لم يستلهم الباحث العربي ، أو الأديب العربي هذه الطريقة فيما يكتب من شعر أو نثر ، وانتظر أزمنة مترامية ، حتى جاءته الالتفاتة من الغرب ؟ غير أن محمد عويس يمتد بهذا المعنى فيخرج به عن مغزاه ، ويثير بلبلة وقلقاً لا علاقة لهما بموضوع دراسته ، وذلك حين يستعين بنص منقول عن السيوطي ، وفيه يقول :” ولك أن تسأل فتقول : قد سميت سور جرت فيها قصص أنبياء بأسمائهم .. وقصص أقوام كذلك .. ومع هذا كله لم يفرد لموسى سورة تسمى به ، مع كثرة ذكره في القرآن ، حتى قال بعضهم : كاد القرآن أن يكون كله موسى ، وكان أولى سورة أن تسمى به سورة طه ، أو القصص ، والأعراف ، لبسط قصته في الثلاثة .. وكذلك قصة آدم ، ذكرت في عدة سور ، ولم تسم به سورة ، وكأنه اكتفاء بسورة الإنسان ، وكذلك قصة الذبيح من بدائع القصص ، ولم تسم به سورة الصافات ، وقصة داوود ذكرت في سورة ص ، ولم تسم به ..” إلخ . ولا نريد أن نطيل في طرح مثل هذه التأملات التي لا تخلو من غرابة ، لأننا – نحن البشر – لا نملك أن نقترح على الله تعالى ، كما أن كبار مفسري القرآن لم يفتهم أن يعللوا لأسباب التسمية ، وليس شرطاً أن يكون المعنى الظاهر أو الطريف سببا مقنعاً للتسمية(15) .
ويذكر صاحب كتاب (العنوان في الأدب العربي) – معانداً قوانين التطور ، وثوابت التقدم الحضاري : أن العنوان عند الغربيين ، قد استمد فكرته من العناوين العربية أو من العنوان العربي !! لقد بدأ طرحه بما يمكن أن يعد من قبيل المسلمات ، من مثل : أن الغرب هو الذي سبق إلى العناية بالتراث العربي ، وتحقيقه ، وطبعه ونشره ، غير أنه يرتب على هذا بأنه – محمد عويس – لا يستبعد وجود آثار عربية دفعت العنوان الغربي الحديث إلى التطور ؟!(16) . وقد يستعين بعبارة اريك دي جرولييه ، الذي يؤكد أن للحضارة العربية أهمية كبرى لتاريخ الكتاب ، ومن ثم لتاريخ تطور العنوان ، فالعرب هم الذين أدخلوا الورق إلى أوروبا ، وكانت حضارتهم بعد الإسلام ملتقى التيارات الحضارية التي جاءت من الصين والهند واليونان !!(17) . والمقدمات صحيحة ، فالحضارة العربية في بلاد الشمس المشرقة ، سابقة بالضرورة لحضارة بلاد الجليد والضباب ، وهي التي اقتنصت ما امتازت به الحضارات المعاصرة لها ، والسابقة عليها ،و نقلتها إلى أنحاء العالم ، ولكن ما علاقة هذا كله – بما فيه التعريف بالورق ، والوراقة – باستحداث تقليد أن يتصدر الوثيقة (الكتاب ، أو الرسالة ، أو القصيدة) عنوان مميز ، محدد ، قصد به توطئة قبول المتلقي لهذه الوثيقة ؟!
باستثناء هذه المسائل المحددة ، التي رأينا أنها زائدة عن المطلوب ، أو متجاوزة لما هو موثق ومشهور ، نؤكد أن كتاب محمد عويس ، هو المؤسس الحقيقي للموضوع الذي نطرحه في هذه الدراسة عن (العنوان في التراث العربي) ، ولا يؤثر في هذا – سلبا أو إيجابا- أن تطلعنا إلى البحث عن العنوان في التراث ، لم يكن بدافع من هذا الكتاب – موافقة أو مناقضة – بل لم نكن سمعنا به قبل أن ختم محمد فكري الجزار كتابه: (العنوان وسيميوطيقا الاتصال الأدبي) بذكر عناوين الفصول والمسائل التي طرحها كتاب عويس – حتى وإن حمل معنى الإشادة والتقدير- فإنه سلوك لا يخلو من غرابة وتساؤل(18) . وسنرى أننا سنستعين بالكتابين معاً (عويس والجزار ، ومن بعدهما : قطوس) ما احتاج الأمر إلى ذلك ، وإذا كان كتاب “عويس” قد أعطى الشق التراثي أربعة فصول متصلة تجاوزت صفحاتها المائتين والثلاثين من الصفحات ، فقد أصبح مطلوباً في هذه الدراسة أكثر من الآخرين ، على أن هذه الدراسات جميعاً – بما فيها دراسة محمد عويس – لم تحاول أن تكشف عن أساس فلسفي ونفسي وحضاري للطريقة العربية (المبكرة) لبدائل العنونة ، قبل أن تتعرف عليها في نمطها الحديث ، من خلال الدراسات الغربية عن فنون المقالة بصفة خاصة .
* * *
رابعا : في البدء كان الإنسان :
من أهم ما يلاحظ في منهج دراسة “العنوان” ، سواء عند محمد فكري الجزار في كتابه : “العنوان وسيميوطيقا الاتصال الأدبي” ، أو بسام موسى قطوس في كتابه : “سيمياء العنوان” – ولعلنا سبق أن اشرنا إلى شيء من هذا – اعتناؤهما ، وغيرهما من الباحثين، بالتأسيس النظري الغربي ، والاجتهاد في تطبيقه على عناوين مختارة ، كما لاحظنا : منتقاة من الإبداع العربي الحديث والمعاصر ، وهذه الاختيارات لابد أن يتوافر فيها الاستجابة لأسس النظرية لفلسفة العنوان ، من حيث التكوين (التشكيل اللغوي) والدلالة ، والاتصال بجسد الكتابة أو المقالة ، وأثره المنعكس على وجدان المتلقي وفكره من الوهلة الأولى .. إلخ . فإذا تطرق الباحثون إلى العناوين التراثية المرتبطة بزمن الثقافة الشفاهية ، وإنشاد الشعر (وليس كتابته) فإنهم غالبا ما يكتفون بإشارات عامة أصبحت مألوفة ، بل تتقارضها البحوث الخاصة بهذا الحقل المعرفي ، دون أن تبذل جهدا حقيقيا في التعليل والتفسير ، الذي لن يسفر عن نفسه إلا بعد تقصي الظاهرة – ظاهرة العنونة – عبر الأزمنة والمواقع ، والصيغ ، والنزعات ، والوظائف .
أصبح معروفاً أن القصائد القديمة (في العصر الجاهلي ، وحتى بداية عصر التدوين ) كانت تُعرف بالجملة الأولى من البيت/مطلع القصيدة ، مثل : قفا نبكِ ، لخولة أطلالٌ ، هل غادر الشعراء … وأمثال هذا معروف ومألوف ، وسبق في هذه الدراسة أن أشرنا إلى شيء منه ، وأضفنا إليه أنه “ربما” عرفت القصيدة – وبخاصة إذا كانت شهيرة جداً بقافيتها ، أو رويها ، واقترانه باسم شاعرها ، كأن نشير إلى عينية أبي ذؤيب ، فلا يخطئ المتلقي الخبير أن القصيدة المعنية هي تلك المطولة المشهورة ، التي تتصدر ديوان الهذليين ، ومطلعها :
أمن المنون وريبها تتوجعُ = والدهر ليس بمعتبٍ من يجزعُ(19)
فإذا أشير إلى الأبيات الثلاثة البائية لعامر بن الطفيل ، فإن المتلقي الخبير يعرف أن القصد قوله مفتخرا بنفسه :
إني وإن كنت ابن سيد عامرٍ = وفارسها المندوبُ في كل مـــوكبِ
فما سودتني عامرٌ عن قرابةٍ = أبى الله أن أسمــــــــو بأمٍ ولا أبِ
ولكنني أحمي حماها وأتقـي = أذاها ، وأرمي من رماها بمنكبِ(20)
فإذا أشار المتكلم إلى دالية الشريف الرضى في رثاء أبي إسحاق الصابي ، فقد أراد كلمته التي مطلعها :
أعلمت من حملوا على الأعواد = أرأيت كيف خبا ضياءُ النادي(21)
فإذا كانت الإشارة إلى حائية ابن مطروح في تهديد الفرنسيس ، فقد دلت الإشارة على أن القطعة المعنية ، هي تلك التي مطلعها :
قل للفرنسيس إذا جئتــه مقال صدق من قؤول فصيح
…..
دار ابن لقمان على حالها = والقيد باق والطواشي صبيح(22)
ومثل هذا كثير في ديوان الشعر العربي ، غير أن التلقي العجول للظاهرة (ظاهرة تعريف القصائد برويها وشاعرها) لم يثر اهتمام هذا الفريق الحرص على ذكر أسماء الشعراء ، وهو الأكثر تداولا ، والأدق في تمييز القصيدة من ذكر مطلعها مجرداً ، بما يعني – وهذا ما نرمي إلى إبرازه بدقة – أن اسم الشاعر ،وصحة انتساب النص إليه هو المعنى الأهم ، ولهذا المسلك دلالة توثيقية غير قابلة للالتباس ، بعد ذكر صوت الروي ، واسم الشاعر ، ودلالة ذاتية ، إذ تتميز شخصية الشاعر دون التباس ، أو اشتراك . لقد علّم الله – سبحانه – آدم أبا البشر – الأسماء كلها ، بمعنى أنه وضع في قدراته المعرفية إمكان تسمية الأشياء ، وتمييزها ، ووضع حدود فاصلة بين مفرداتها بخصوصية هذه التسمية ، التي تلتقي في معناها العام ، وهدفها ، وتختلف (في ملفوظها) حسب اللغات والطبقات ، وقدرات النطق !!
لقد اهتم العرب القدماء بأسماء آبائهم ، وأبنائهم ، فكانت المعرفة بالأنساب علماً ودراية ذات قيمة عالية عند من يتقنها ، وإذ نقلب بعض صفحات تلك الحقب التاريخية ، سنجد أن للأسماء ، وما تدل عليه من عراقة ومكانة أهمية بالغة عند العرب ، وفي القرآن الكريم مماحكة جاهلية في التملص من الإيمان بمحمد (صلى الله عليه وسلم) فيما لو كان القرآن ) نزل على رجل من القريتين عظيم ( ، ومن بعد – في التمهيد لمعركة بدر – خرج ثلاثة من فرسان قريش لمنازلة المسلمين قبل الالتحام العام ، وكان هؤلاء الثلاثة من الأنصار ، فاستنكف محاربو مكة من منازلة من لا يعرفون أنسابهم ، فنادى مناديهم : يا محمد .. أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا !! وهكذا خرج لهم ثلاثة آخرون من المهاجرين من عليا قريش في مقدمتهم حمزة وعلي – رضي الله عنهما – ومن قبل بعْثة محمد (عليه السلام) كان “حلف الفضول” وفيه تعاقد نفر من سادات قريش على التكافل في مقاومة الظلم ورد الحقوق ، وهذا فضل مشهود ، وقيل في سبب التسمية – إلى ما سبق – أن هؤلاء السادة تصادف أن كان اسم كل منهم “فضل” فسمي “حلف الفضول” . وكان من تقاليد المنازلات والمبارزات بين الجيشين ، وقبل الالتحام العام ، أن يبرز فارس معلم ، ويتوسط الساحة معلنا اسمه ونسبه ، وطالبا من أعدائه أن يتقدم أحدهم ممن يجد في نفسه أنه كفؤ له ، فينتسب ، ثم ينازله ، فإذا تغلب أحدهما على منازله ، ربما كانت عبارة: “خذها وأنا ….” ويذكر اسمه” إعلاءً لفروسيته ” .
هذه الاضاءات ، وإن تكن جزئية – تحمل معنى تقديس الاسم ، وأنه سمة لا تشاركها سمة أخرى ، ولعل هذا يعني – فيما يعنيه – أن “الإنسان” هو الأساس والجوهر في تقدير المواقف ، والمنازل ، والأعمال .. إلخ . ومن ثم باستطاعتنا بعد هذه الإشارة أن نقول : إن التراث الشعري لأية أمة ، وفي أية لغة ، لم يكن له هذا المسلك الخاص جداً في تعريف القصائد ، وتمييزها على النحو الذي أشرنا إليه .
إننا نتمهل عند هذه الخاصية (الإنسان) ، ونرى أنها – فضلا عن كونها علامة (تراثية) فارقة – تحمل جوهر الحضارة العربية ، منذ زمن بداوتها ، وحتى سطوع شمسها ، بل شموسها على أنحاء العالم وإلى اليوم .
إن ظاهرة اسم الشاعر ، أو اسم المؤلف ، أو اسم الكاتب ، أو الخطيب مرتكز أساسي في تمييز الأعمال ، وكأن هذا الاسم يقوم مقام العنوان قبل الانتباه إلى أهمية ذكر العنوان ، وإذا كانت البحوث المتعلقة بالشعر القديم في عصر المشافهة ، قد تنبهت إلى سبيلين من سبل تمييز القصائد [ بذكر المطلع – أو بذكر الروي والشاعر ] ، فإن هذه البحوث – بصفة عامة – لم تنظر لاسم الشاعر على أنه سمة فارقة ، وأنه “عنوان” قبل عصر العنونة ، وأنه ظل أساساً للتقسيم (تقسيم قصائد الشعر ، وأغراضه ، وعصوره) يُذكر مع كل نص . ولعل هذا يرجع إلى رواج بضاعة الشعر وانتشار تداوله ، والحاجة إلى الاستشهاد به ، إذ هو خلاصة (المعرفة) العربية ، الفكرية ، والفنية في زمن الجاهلية ، ومن ثم كان تمييز القصيدة بذكر أولها ، أو قافيتها قسيما لاسم الشاعر نفسه لتأكيد هذه الخصوصية التي نجدها في العنونة ، في زماننا هذا .
لقد عُني مدونو الأحاديث النبوية بذكر أسمائهم في صدر صحائفهم ، تقديراً لعظم مسؤوليتهم عما دونوا ، وكذلك سجلت أسماء النفر ، الذين عهد إليهم الخليفة الراشد (عثمان بن عفان) بكتابة المصحف وترتيب سوره ، ولم يتخل الشعر عن هذا التوثيق الإنساني ، فعرفت مجاميع الشعر المبكرة بأسماء جامعيها ، فلدينا المفضليات ، والأصمعيات ، ومن بعد : ديوان الهذليين ، وغيرهم كثير ، وفي جميع الحالات – دون استثناء- يسجل اسم جامع النصوص ، كما تسجل أسماء الشعراء في مفتتح قصائدهم ، إذا كان معروفا ، موثوقا ، غير ظنين .
ولعلنا نلاحظ – في مجال العناية بالإنسان ، وأنه صانع الفكر ، ومبدع الفن ، ومتلقيه كذلك – أن المؤلفين العرب ، في محاولاتهم المبكرة ، لم يتخلوا عن حتمية نسبة الأشعار إلى قائليها ، وذكر رواتها ، وربما تطرقوا إلى اختلاف الرواة ، أو اختلاف الرواية ، وهذا كله من منطلق العناية الفائقة بالجهد الإنساني ، بالإبداع ، بالتميز ، بإعلاء الحدود والفواصل ، وهنا يمكن أن نذهب إلى مؤلفين مبكرين ، شغلا بالتعريف بالشعر وقائليه ، وهما : محمد بن سلام الجمحي (139 – 232 هـ) ، في كتابه : “طبقات فحول الشعراء”(23) ، وابن قتيبة (213 – 276هـ) ، في كتابه : “الشعر والشعراء”(24).
لقد قسم أولهما الشعراء إلى طبقات (عشر طبقات جاهلية ، وعشر طبقات إسلامية .. إلخ) وفي كل طبقة أربعة شعراء ، فيكون اسم الشاعر البادئة الأساسية في التعريف بشعره وبمكانته ، ولم يتخل عن هذه الثوابت على امتداد كتابه الضخم ، أما ابن قتيبة في “الشعر والشعراء” فإن ما ذكر عن شعرائه – (وهم كثر = 206 شاعرا)– لم يستند إلى التقسيم الفني ، ولم يعتمد مبدأ التسلسل التاريخي ، ولم يأخذ بالشهرة ، أو الأهمية ، أو الأبجدية. لقد تقاطر الشعراء في هذا المصدر الضخم : كل شاعر بذاته ، يتصدر اسمه قبل كل شيء، ثم تأتي بعد ذلك النماذج ، وآراء النقاد في الشعر ، والأخبار التي تميز حياة هذا الشاعر ، وفنه .
خلاصة ما نريد ، وما نحاول توثيقه ، والتدليل عليه في هذه الفقرة ، وتعقب تحولاته ، وآثاره ، وشموله في أشعار الأزمنة الآتية ، بعد هذين العالمين الكبيرين (ابن سلام وابن قتيبة) ، هو أن الاسم ، اسم الشاعر تحديداً ، هو العنوان القديم ، والوسيط ، والحديث ، ربما إلى عصر المطبعة ، وإلى عصرنا ، وهذا ما سنحاول البرهنة عليه فيما يأتي .
سنعرف – في هذه الفقرة – بأهم عملين موسوعيين ، اتخذا من إحصاء أو محاولة حصر المؤلفات ، وتصنيفها تحت عناوين تكشف عن مضامينها ، ومن حقنا أن نبرز ، وأن نفاخر بسبق العقل العربي إلى إنجاز مثل هذه العملية الإحصائية ، على ضخامتها وتنوع اتجاهات مؤلفاتها . وسنرمي من وراء ذلك إلى تحصيل فائدتين :
الأولى : هذا الحرص العربي على ذكر أسماء المؤلفين ، والحفاوة به ، وإبرازه ، والتأريخ له أحيانا ، بما يجعله بيناً ، محدداً ، حتى قبل تصفح كتابه ، وسنرى أمثلة متعددة لذلك .
أما الفائدة الأخرى : فقد غلبت الحمية على موضوعية بعض الباحثين في هذا المجال المعرفي ، حتى رأى هذا البعض أن المؤلفين العرب هم الذين ابتدعوا العنوان – في صوره المختلفة ، وأنهم بهذا السبق قد علموا الكاتب الأوروبي كيف يختار عناوين إبداعاته . وعلى الإجمال : إذا كنا نرى في الأمر الأول ما يدل على الصواب ، فإن الأمر الآخر لا يجد سنداً موثقاً يؤكد هذا الزعم . وليس لنا أن نتألم ، أو نلوم أسلافنا ، متسائلين : إذا كنتم قد سبقتم العالم إلى وضع نسق للأعمال الإحصائية الموسوعية ، التي تعنى بالمؤلفات ، فعرفتم – من ثم – عناوين هذه المؤلفات ، وعناوين محتوياتها الداخلية : كيف غاب عنكم ألا تتوجوا خطبكم ، وقصائدكم ، وفصول مؤلفاتكم بمثل هذه العناوين ، التي – فيما نزعم – سبقكم إليها مؤلفو الغرب ؟
هناك منطق آخر يحكم هذه العملية ، فالسابق لا يبقى سابقاً أبد الدهر ، والمتخلف لا يظل حبيس تخلفه إلا في حدود عوامل موضوعية محكومة بسياق الزمن ، واختلاف الأحداث ، وتطور المجتمعات .. إلخ . ولهذا لا نستطيع أن “نعتب” على العقل العربي ، الذي وضع الموسوعات في مرحلة مبكرة (قبل أية ثقافة أخرى) . كيف لم يفطن إلى أهمية أن يضع في صدر القصيدة عنواناً ؟!
من الواضح أنه لا شيء يوجد من لا شيء ، فالمبدأ أن كل موجود يتأسس على موجود سابق عليه ، وغاية الجهد أن يطوره ، أو يتوسع فيه ، أو يضيف إليه (ولا نتقيد في هذه المسألة بالمجال الذي قرره ابن خلدون في فقرة سبق ذكرها ، تضمنت ثمانية مجالات ، غير أنها ليست جامعة ولا مانعة ، وإنما هي استرشاد لمطالب المرحلة) . فحين نراجع الذاكرة العربية سنجدها تطور ما بدأته في القرن الثالث الهجري ، بالجمع بين الأشباه والنظائر من المؤلفين ، كما في :”طبقات فحول الشعراء” ، و “الشعر والشعراء” ، على نحو ما بينا . إذا عرفت القرون التالية مؤلفات لا تحبس نفسها في موضوع واحد “كالشعر والشعراء” وإنما تأخذ في اتجاهات شتى ، على سبيل الاستطراد ، وكان الهدف من هذه المؤلفات ، كما نجدها عند (الجاحظ) الذي سبق – ولو على سبيل التبشير- بالتأليف حسب وحدة الموضوع العام ، واختلاف المشكلين للظاهرة ، وهذا ما تحقق في “البيان والتبيين” و “البخلاء” و “الحيوان” . فهذه الدراسات المبكرة (إذا توفي الجاحظ عام 255هـ) نلاحظ أنه – بعد مقدمته الكاشفة عن أسلوبه ، وخصوصية تفكيره – يأخذ في رواية الأسماء والأحداث ، ويعلق على الطبائع ، والسلوكيات . ويذكر الغرائب والطرائف ، دون أن يشعرك بأنه قد غادر جانب الجد ، ودخل بك في عالم الهزل، ترويحا عنك . هذه الطريقة التي أسس لها الجاحظ في مؤلفاته المشار إليها (وهنا نسكت عن كتابه”المحاسن والأضداد” فحوله كلام كثير) غير أننا لا نستطيع أن نغفل عشرات الرسائل التي شغل بها فراغ وقته ، أو رأى أن يداعب بها كبار زمانه ، أو يعلق على طرائف وتناقضات مظاهر الحياة من حوله . يمكن أن نقرأ في الهامش بعض عناوين الرسائل (والرسالة : بديل مصطلح “الدراسة” أو “المقالة” في زماننا) ، لنرى مدى التنوع في عناوينه التي تصدرت الرسائل ، ولكنها لم تتصدر موسوعاته الضافية التي أشرنا إليها من قبل(25) .
فكما نرى من عناوين هذه “الرسائل/المقالات” ، فإن كلا منها يتصدرها عنوانها ، وينبسط موضوعها على مساحتها ، ويجرب فيها الجاحظ كل ما أوتي من بداهة الفكر ، وطلاوة التعبير ، وذكاء الملاحظة ، والقدرة على قراءة طبائع المجتمع من حوله .
ولم يكن الجاحظ فريداً في تحرير “الرسائل/المقالات” ، إذ يبدو أنه مع نشاط الفكر العربي ، وتعدد مجالاته ، ورغبة الكتاب في نشر أقوالهم ، واكتساب مؤيدين – تعدد كتاب الرسائل ، على أنها لم تكن تأخذ بخصوصية أسلوب الجاحظ ، الذي لا يجارى ، وهذا طبيعي ومتوقع ، وبخاصة مع اختلاف الغرض من الرسائل ، فبين أيدينا – في أعقاب زمن الجاحظ من القرن الثالث الهجري – نشط (إخوان الصفا) ، ولسنا بصدد التعريف بهويتهم ، أو أهدافهم المختلف عليها ، وإنما يعنينا في هذا السياق أنهم ألفوا المقالات غير منسوبة لكاتبها ، وإنما تنسب للجماعة ، على الرغم من أن المتوقع أن يكتبها فرد ، حتى وإن أجازها سائر الجماعة ، ويمكننا أن نقرأ بعض عناوين رسائلهم ، لنكتشف منحاهم الفلسفي ، ومبناهم الفكري(26) .
وخلاصة القول – فيما نرجح- أن التراث العربي عرف العنونة ، وفنونها ، قبل أن يتصل بالثقافات الأوروبية ، غير أن هذا لا يؤدي بالضرورة إلى أن تكون فنون العنونة العربية هي التي ألهمت المفكر أو المؤلف الغربي بأن يضع عنوانا . ولسنا نذهب إلى التاريخ البعيد (الإغريقي/الروماني) لنستجلي عناوين الأساطير ، مقرونة بأسماء أبطالها، أو بالملاحم ، وبخاصة إذا كنا نربط بين ظهور “العنونة” ، وظهور “الصحافة” ، إذ لابد للخبر الصحفي أو التحليل من عنوان يحدد ماهيته ، ويستجلب انتباه القارئ ، على أن هذه القاعدة ذاتها ، يمكن ، بل تجب مراعاتها حين نتأمل عناوين المطبوعات العربية المبكرة ، وبخاصة في مجال دواوين الشعر . وقد كتب محمد عويس الفصل السادس من دراسته الضافية ، يناقش فيها تأخر عنوان القصيدة العربية في النصف الأول من القرن العشرين(27) ، فقد رأى أن تنوع الأجناس الأدبية ، وتعريب الإبداعات الغربية ، وظهور مذاهب أدبية منوعة التوجهات .. كانت العوامل التي أدت إلى ظهور “العنونة” عند كتابنا العرب ، كما أن العنونة في الشعر تأخرت عنها في النثر ، وقد أجرى الباحث الفاضل دراسة استقصائية على ديواني حافظ وشوقي ، فنبه إلى تصدر ذكر مناسبة القصيدة ، أو من توجه إليه ، دون النص على عنوان منفرد وملهم للمبدع والمتلقي (ربما باستثناء القصائد على لسان الحيوان ، التي أبدعها شوقي للأطفال)(28) . وفيما سبق دليل على ضعف القول بوجود آثار عربية دفعت العنوان الغربي الحديث إلى التطور ، وإذا كان اسم (اريك دي جرولييه) في كتابه “تاريخ الكتاب” يذكر ليؤيد هذه المقولة ، معتمداً على التأثير الحضاري العام ، والقول بأن العرب هم الذين أدخلوا الورق إلى أوروبا(29) . وقد حاولنا اختبار هذه العلامات المؤثرة على تاريخ العنوان في التراث العربي ، فاخترنا شاعرين تقاربا في زمن رحيلهما (وهما : عائشة التيمورية ومحمود سامي البارودي) ، فقد توفيت عائشة التيمورية (عام1902) ، وأعقبها محمود سامي البارودي (عام1904) فوجدنا ديوانيهما (المطبوعين) يجري على منهج الوصف أو ذكر المناسبة ، وليس العنونة ، ففي ديوان “حلية الطراز” للتيمورية ، نجد هذه العناوين :
وقالت توسلا بالمقام النبوي (صلى الله عليه وسلم) .
وقالت عند وضع أخٍ لها .
وقالت تهنئة بمولود .
وقالت تهنئ الخديوي السابق بقدومه إلى مصر .
وقالت ترثي ابنتها .(30) وهكذا ..
ولا يذهب ديوان البارودي بعيداً عن هذا النمط من العنونة/ الوصف ، إذ نجد :
وقال وهو في حرب الروس مع الدولة العثمانية .
وقال يروض الشعر .
وقال في النسيب .
وقال في الفخر .
وقال يصف أيام الربيع ، ويذكر مواسم له في عصر الشباب …(31)
ولابد أن نحاول التعليل لتأخر عنونة القصائد في الإبداع العربي ، إلى زمن ليس بالبعيد (زمن حافظ إبراهيم وشوقي) ، وإن لم يكونا على مبعدة من زمن خليل مطران ، وعباس العقاد ، وعلي محمود طه ، وإيليا أبو ماضي(في المهجر) . وقد قيل في التعليل: إن اعتماد الشعر العربي على المشافهة ، وأن وسيلة انتقاله بين المبدع والمتلقي تقوم على المواجهة ، والسماع ، كان من آثارها العملية تجنب “العنونة” أو عدم إحساس الشاعر بضرورة أن يضع عنواناً يؤطر تجربته . وقد استمر هذا التقليد حتى بعد أن أصبحت القصائد تنشر في الصحف ، ويتلقاها القراء بعيونهم وليس بآذانهم ، ومن ثم اجتهد محررو الصحف في اختيار عناوين تتصدر القصائد ، ثم تبعهم الشعراء !!
* * *
خامسا : تجربة متمردة على زمنها :
سبقت الإشارة إلى عناية العربي باسمه ونسبه وقبيلته ، وهو ما حرص على أن ميز به إبداعات قومه ، فقد يهمه أن يقال : امرأ القيس الكندي ، ويقال النابغة الذبياني ، وعنترة العبسي ، وكعب بن زهير بن أبي سلمى المازني ، فيمتد بنسبه إلى القبيلة ، وهذا عنده خير عنوان يحرص على ذكره ، في مجال الانتماء والتخصيص .
وهنا باستطاعتنا أن ننظر في موسوعاتنا التاريخية ، من مثل : تاريخ الطبري المتوفى (عام 310هـ) ، والكامل في التاريخ لابن الأثير المتوفى(عام630هـ) ، فليس لواحد من هذين العلمين رؤية كلية ، أو نظرة تحليلية في التاريخ جملة ، أو في حقب أو دول منه ، وإنما هو تاريخ أشخاص لهم تأثير في أحداث زمانهم . وهكذا سنجد أهم المؤلفات التاريخية الإسلامية تقوم على مبدأ (الحوليات) أي تسجيل أحداث كل عام بذاته، مستقلا عما سبقه وما تبعه ، وفي حدود هذا العام يذكر اسم من مات فيه من الكبراء ، ويسجل تاريخ حياته .. فهكذا نلاحظ أن (الأسماء) لا تزال مهيمنة على العقل العربي ، وأن الخصوصية المميزة لكل ذات ، هي التي تصنع التاريخ !!(32)
وقد سبقت الإشارة إلى “عناوين” لا يشك في استقلالها ، وتصدرها لدراسات مميزة ، حتى لو لم نطلع على المخطوطات التي تحملها ، وقد يكون من حقنا أن نتشكك في “المقامات” : مقامات بديع الزمان الهمذاني (358-395هـ) ، ومقامات الحريري البصري (446- 516هـ) ، كما نرى فإن بين زمن ولادة كل من الأديبين قرنا من الزمان (قد ينقص عامين) على أن أولهما (الهمذاني) لم يعش طويلا ،وقد وضعنا هذا في الاعتبار ، ونحن نسعى إلى الكشف عن أحد الأصول الخطية لمقامات كل منهما . وهنا ينبغي أن نضع تحفظاً في أننا – عبر قدرات الشبكة العنكبوتية – لم نستطع أن نحدد تاريخ نسخ المخطوطة ومدى الالتزام بالأصل الصادر عن مؤلفها أو كاتبها الأول . مع هذا كان الفرق في “العنونة” بين مقامات الهمذاني ومقامات الحريري كبيراً جداً ، ففي مقامات الهمذاني تتابع المقامات تحمل أرقامها (المتسلسلة) في أي موقع من السياق ، حيث تنتهي المقامة السابقة ، وكل ما هناك أن يذكر رقم المقامة الجديدة ، وأن تكتب عبارة (المقامة رقم …) بالحبر الأحمر ، ليستمر الكلام بعدها ، وهكذا قدمت هذه المقامات لقارئها وكأنها نص واحد ، متدافع الصفحات ، متتابع الأحداث . أما مقامات الحريري فقد تصدر كل مقامة رقم وعنوان : مثل : “المقامة الثالثة والعشرون البغدادية” – “المقامة الرابعة والعشرون النحوية” – “المقامة الثامنة والعشرون السمرقندية” – “المقامة الثانية والثلاثون الفقهية” – “المقامة الرابعة والثلاثون الزبيدية” .. وهكذا حملت كل مقامة عنواناً صادرا عن أهم ما يميزها : المكان ، أو الفعل ، أو القضية الثقافية .. إلخ .
إلى أن نصل إلى كتاب : “صبح الأعشى في صناعة الإنشا” لمؤلفه : أبي العباس أحمد بن علي القلقشندي (المصري)- (756 – 821 هـ) . وهذا الكتاب المترامي الصفحات (أربعة عشر جزءاً) ، يفاجئنا في مخطوطته التي نسخت عام (1193هـ) وهي تساوي (1779م) بأنها – فيما يخص “العنونة” ترتقي بتوزيع المادة العلمية إلى ضروب من الدقة ، والوعي بالفروق ، والالتزام بالتحديد الزمني والفني لكل عنوان ، بما يجعله يتمايز تماماً عن كل ما سبقه ، وعن كثير مما لحقه ، وسنعرض لشيء من هذا ، ونعتقد – بكل الصدق – أن القلقشندي – وإن كان في زمن هبوط مستوى الثقافة العربية عامة ، وانغلاقها على ذاتها قبل الاتصال المتفاعل بالثقافة الأوروبية ، والاهتمام بالمطبوع – قدم أهم ما ينبغي على المثقف العربي أن يدركه في مستويات مختلفة ، كلها – بدرجة ما – مطلوبة لتربية مداركه ، كما أن الإلمام ببعض الأبواب مطلوب في جملته وتفاصيله ، لبعض أهل الصنائع من محترفي الكتابة ، وشاغلي وظائف الإدارة على مستوياتها .
عاش القلقشندي زمن الحاكم المملوكي “الأمير برقوق” ، ونرجح أن ضعف الاحتفاء بجهده العلمي ، ووعيه السابق لزمانه بالتأليف ومطالبه ، يرجع إلى هذه الصفة، بمعنى أنه محسوب على العصر المملوكي الذي يوسم (عادة) بالضعف والانغلاق ، وتوقف الإبداع العلمي . إن ما أجملته (الشبكة العنكبوتية) – في التعريف بالقلقشندي وقيمة جهده ، يستحق أن يستعاد بنصه ، على طوله ، ولا نغفل غرابة العنوان الذي اتخذه القلقشندي لكتابه ، فهو “صبح الأعشى في صناعة الإنشا” ومع أحقيته في الحصول على سجعة متوازنة بين “الأعشى” و “الإنشا” ، فإنه كانت لديه مندوحة لاختيار اسم كاشف للمحتوى الشامل (غير المسبوق) في هذا الكتاب ، ولعل المؤلف قد تأثر – بدرجة ما – بذلك النوع من العناوين التي ستبرز أصحاب العاهات والمناقص من العميان ، والعرجان ، والبرصان ، ومن إليهم ، من ثم منح كتابه تلك القدرة الفائقة على تجاوز أمراض العيون المصابة بالعشى (والعشى : العجز عن الرؤية في الليل) .
وهذا نص ما سجلته “الشبكة العنكبوتية“ عن الكاتب وكتابه :
[ صبح الأعشى في صناعة الإنشا هو كتاب يتكون من 14 جزء من تأليف أبو العباس القلقشندي المتوفى سنة 821 هـ 1418م، الذي كان يتولى منصب ديوان الإنشاء في عهد السلطان الظاهر برقوق ، ويعتبر الكتاب موسوعة شاملة لجميع العلوم الشرعية والأدبية والجغرافية والتاريخية.
تعد هذه الموسوعة أحد المصادر العربية الواسعة التي تتناول مواضيع منذ الفترات الأولى في الإسلام عن أنظمة الحكم، والإدارة، والسياسة، والاقتصاد، والمكتبات، والولايات والعهود والعادات والتقاليد والملابس. في الشرق العربي، وفي الكتاب يتناول القلقشندي صفات كاتب الإنشاء ومؤهلاته وأدوات الكتابة وتاريخ الدواوين التي تعرف في الوقت الحاضر بمسمى الوزارات، وأيضاً يتناول الإنشاء في البلاد العربية وفنون الكتابة وأساليبها، ويصف الكتاب أشكال ملابس الجنود، والأسلحة، ومواكب تنصيب الخلفاء والسلاطين، وعن مناسبات استطلاع هلال رمضان، وموائد الإفطار، وملاعب السباق والألعاب الرياضية، ويصف أشكال العمائم والملابس ومراكب الدواب، ومظاهر المجتمع العربي وتقاليده وأعرافه وظواهره الإجتماعية .
جاء في كشف الظنون أن صبح الأعشى يقع في “سبعة أجزاء كل منها في صناعة الإنشاء لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا ذكرها وجعل بابا من أبوابه مخصوصا بعلم الخط وأدواته” .
كما أطنب القلقشندي في الجوانب السياسية والإدارية في مصر وبلاد الشام والدول المجاورة لها في عصره ، وهو العصر المملوكي، وأثبت وثائق مهمة عن الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية والجغرافية في عصره ، فجاء الكتاب موسوعة في فن الكتابة للدولة ، وفن الترسل ، وما يتعلق بهما ]
وقد نرى أن هذا الوصف الذي تجاوزنا به حد المأذون بنقله عن المراجع ، لا يزال مقصراً ، لا يفضي بكل المنجز العلمي الذي حققه القلقشندي في كتابه ، غير أننا سنتوقف عند طريقته في العنونة ، وفي تعاقب العناوين ما بين العام والخاص والأخص ، فنجد أنه قد أخذ بنسق غير مسبوق ، وهو النسق الذي نأخذ به في مؤلفاتنا إلى اليوم ، مما يعني أن هذا الرجل كان يملك تصوراً شاملا قادرا على الضبط والاحتكام إلى أسس معرفية موضوعية ، أعانته على صحة التقسيم ، وصحة العناوين التي اتخذها للأقسام ، ثم صحة توزيع المسائل (التفصيلية أو الصغيرة) التي تدخل في نطاق هذه الأقسام ، وسنكتفي بتقريب الصورة/النمط الذي انتهجه في توزيع مادة كتابه ، وإجمالا : فقد قسم كتابه إلى “مقالات” ، وكل مقالة تنقسم إلى “أبواب” ، وكل باب ينقسم إلى “فصول” ، وكل فصل ينطوي على “مسائل” محددة تتعلق بالمطلوب فيه . ونختار (المقالة الرابعة) التي يُعنى فيها بأمور أنواع المكاتبات والولايات ، وهذه المقالة في بابين :
الباب الأول : في فصلين :
الفصل الأول : في مقدمات المكاتبات ، من أصول يعتمدها الكاتب ، فيها من حسن الافتتاح ، وبراعة الاستهلال ، وتقديم مقدمة تناسب المكتوب فيه في أول المكاتبة (!!) ، ومعرفة الفرق بين الألفاظ الجارية في الخطاب ونحوه ، وما يناسب المكتوب إليه منها ، ومواقع الدعاء فيها ، والإتيان لكل مقصد من مقاصد المكاتبات ، بما يناسبه ، ومخاطبة كل أحد من المكتوب إليهم على قدر طبقته من اللغة العربية ، ومراعاة الفصاحة والبلاغة في الكتابة إلى من يتعاناها ، ومراعاة رتبة المكتوب عنه ، والمكتوب إليه ، ومواقع الشعر من المكاتبات ، وحسن الاختتام ، وما يجري مجرى ذلك ، وبيان مقادير المكاتبات وما يناسبها من البسط والإيجاز ، وما يلائمها من المعاني ، ومعرفة ما يختص من ذلك بالأجوبة ، وبيان ترتيبها .
الفصل الثاني : في بيان أصول المكاتبات وترتيبها ، وبيان لواحقها ولوازمها ، ومذاهب الكتاب فيما تفتتح به المكاتبات في القديم والحديث ، وما يخاطب به أهل الإسلام (وغيرهم) في المكاتبات ، وبيان كيفية طي الكتاب ، وختمه ، وحمله ، وتأديته ، وفضه ، وقراءته ، وحفظه في الإضبارة .
هذا ما وصفه القلقشندي نفسه في مقدمة كتابه ، معرفا بمحتواه . نكتفي منه بباب واحد في فصلين ، وكما نرى فإنه لم يذكر “العنونة” لفظاً ، ولكنه قصد إليها وصفا ، وأنه قدم من التوجيهات ما يستحق أن يكون درساً متاحاً لكل من يتصدى لصناعة الكتابة، لا نقول الكتابة الديوانية ، وإنما نقول الكتابة على الإطلاق ، وقد حدد من مبادئ “البروتوكول” في زمانه ما يعجز عنه مؤلفو الروايات التاريخية ، ومؤلفو المسرح ، والدراما التلفزيونية – عن تصوره ، أو الاهتداء إليه في كتاباتهم العصرية . وإن الباب الثاني المكون من ثمانية فصول سيبسط القول في حقب الماضي بتسجيل مكاتبات الخلفاء من الصحابة ، وممن جاء بعدهم إلى أمراء الأندلس ، ودولة الموحدين بأفريقيا ، ومن المهم أنه حين يسجل صيغة مكاتبة ، فإنه لا يغفل عن أهمية تسجيل صيغة الجواب عليها، وبهذا يقدم دروساً مستفادة في اتجاهات حضارية مختلفة ، كما يرصد تغير العبارات الافتتاحية بين الخلفاء ، والملوك ، والأمراء ، العرب ، وغير العرب . من الطريف أن ينهي فصله الثامن من هذا الباب الثاني ، في معرفة إخفاء ما في الكتب من السر ، إما بطريق المترجم ، وإما بمعالجة الكتابة ، بمعنى أنه عرّف “بالحبر السري” و “الكتابة بالشفرة” المتفق عليها .
لا تملك هذه الدراسة المختصرة عن كتاب القلقشندي أن تمنحه مساحة أوسع مما أتيح ، غير أننا نعتقد بأنه كتاب مهم ، وأنه يستحق دراسة خاصة ، تفصيلية ، عصرية المنهج والهدف ، تستخرج ما تنطوي عليه مقالاته ، وأبوابه ، وفصوله – على الترتيب- ثم تضع تحت المجهر تلك العناوين التي تصدرت المسائل على كثرتها ، فكانت تعبيرا محكماً عن محتواها العلمي ، والأدبي ، والفكري ، والحضاري بوجه عام .
* * *
سادسا : خطوة سابقة :
إذا تحقق لنا قدرٌ من الاطمئنان إلى صحة تاريخ ميلاد ووفاة أعلام العرب ، قبل عصر الطباعة ، فإن “صبح الأعشى” للقلقشندي: (المتوفى 821 هـ) يقع في وسط المسافة الزمنية بين كتاب “الفهرست” لابن النديم (المتوفى 387هـ) ، وكتاب “كشاف اصطلاحات العلوم والفنون” للتهانوي (المتوفى 1191هـ ، على الأرجح)(33) ، ومن ثم فإن ابن النديم وضع كتابه الشامل على غير قياس من تجربة سابقة ، حتى وإن كان مصطلح (الكامل= الكامل في التاريخ – الكامل في الأدب..إلخ) أخذ يتكرر إعلانا عن الطابع الشمولي للثقافة ، ومن المهم أن نلاحظ أن ابن النديم من ثمرات القرن الرابع الهجري ، وهو القرن الذي شهد نهضة عربية في أوج سطوعها ، وقوتها ، وقدرتها على استيعاب ثقافات الأمم والحضارات الأخرى ، ويتضح هذا في محتوى كتابه . ولسنا نظن أن “الفهرست” كان ملهماً للقلقشندي ، لأن الكتاب الأول لا يتجاوز كونه بمثابة “كشاف” يدل على المؤلفات ، فيضعها تحت عناوين تنظم سياقها ، ويعرف بمؤلفيها ، وفي أحيان يجمل فكرتها ، وهذا ليس بالجهد القليل ، غير أنه يختلف كثيراً عن الطابع الموسوعي المختص بفنون الكتابة والتأليف ، التي حصر القلقشندي جهده فيها.
وقد عُني ابن النديم بالعنونة ، إذ قسم كتابه إلى عشر (مقالات) [ وقد توزعت المقالات العشر على اثنين وثلاثين فنا ] ، اختصت كل مقالة بعدة فنون ، حسب ما تتسع له الظاهرة ، فعلى سبيل المثال : (المقالة الرابعة) وهي : فنان في الشعر والشعراء : الفن الأول : في طبقات الشعراء الجاهليين والإسلاميين ممن لحق الجاهلية ، وصناع دواوينهم ، وأسماء رواتهم . الفن الثاني : في طبقات الشعراء الإسلاميين ، وشعراء المحدثين ، إلى عصرنا هذا [أي إلى عصر المؤلف] . وفي تقديم عبد الحكيم راضي لطبعة (الهيئة العامة لقصور الثقافة – القاهرة – 2006) يشير إلى تميز عناوين الفهرست بالنسبة لما سبقه من موسوعات (بصفة خاصة كتاب الخوارزمي) ، فيقول عن العناوين في مفتاح العلوم : إنها تهتم بأسماء العلوم ، وأسماء تفريعاتها على سبيل الوصف والتعريف ، وليس أكثر “أما في كتاب الفهرست ، فالطابع الموسوعي الرامي إلى ذكر المؤلفين والمؤلفات هو المسيطر ، وإذا صح أن عناوين الكتاب في الأصل كانت على نحو ما يلقانا في طبعاته الحديثة ، تأكد لنا هذا المنحى ، وعلى سبيل المثال ، فإن العنوان المتكرر لأجزاء الكتاب الداخلية ، ينص دائما على أنه (في أخبار العلماء المصنفين القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم ، وكذلك عناوين المقالات التي جاءت في أخبار هذا الفريق ، أو ذاك من العلماء ، وأسماء كتبهم ، أو أخبار العلماء ، وما صنفوه في أخبار … أو ما صنفوه من الكتب ؛ وترد أسماء العلماء والمؤلفين ، والترجمة لهم تباعاً ، وكأننا أمام كتاب من كتب التراجم)(34)
إن المرتكز الذي نعنى بإبرازه يتمثل في عناية ابن النديم بذكر الأسماء ، ثم دلالة المصطلحات لتعبيرها عن الوقائع أو فهم الوقائع ، وخلاصة القول في “الفهرست” أن عنايته كانت في ذكر التراجم والسير ، بمعنى أنها مرتبطة بالأشخاص وسيرهم ، وجهودهم العلمية . وقد تدل عبارة المؤلف في صدر كتابه على تقديم عناوين الكتب على أسماء مؤلفيها ، غير أن سياق العبارة سيوصل إلى عكس ذلك . يقول ” هذا فهرست كتب جميع الأمم من العرب والعجم ، الموجود منها بلغة العرب وقلمها ، في أصناف العلوم وأخبار مصنفيها ، وطبقات مؤلفيها ، وأنسابهم ، وتاريخ مواليدهم ، ومبلغ أعمارهم ، وأوقات وفاتهم ، وأماكن بلدانهم ، ومناقبهم ومسالبهم منذ ابتداء كل علم اخترع إلى عصرنا هذا، وهو سنة سبع وسبعين وثلاثمائة للهجرة”(35) . وهكذا يبدو لنا أن العناية بـ “الإنسان” المبدع أو المؤلف والمنتج ، تسبق في الإدراك العربي أهمية منتجه العلمي ، فعلى سبيل المثال : ما أهمية أن يخبرنا في (أخبار الخليل بن أحمد) أنه أول من سمي في الإسلام بأحمد ، وأصله من الأزد من فراهيد ، وكان يونس يقول : فرهودي مثل أردوسي .. إلخ(36) .
وفي العنونة لكل مقالة ، يحرص على أن يبدأ العنوان بذكر الأشخاص (الإنسان) ، ثم الجوانب التي تميز هؤلاء الأشخاص عن غيرهم ، فتحت عنوان :
” الفن الثالث من المقالة الثالثة من كتاب الفهرست في أخبار العلماء وأسماء ما صنفوه من الكتب ، ويحتوي على أخبار الندماء والجلساء ، والأدباء ، والمغنين ، والصفادمة ، والصفاعنة ، والمضحكين ، وأسماء كتبهم “(37)
على أنه يستهل هذا الفن الثالث من المقالة الثالثة بالعنوان الذي يصوغه كالآتي :
“أخبار إسحاق بن إبراهيم الموصلي ، وابنه ، وأهله “
فهنا – فيما نتصور – يتصدر الاهتمام بالشخص وارتباطاته بالنسب قبل كل شيء، ثم يأتي الفن المميز له لاحقا .
غير أن (ابن النديم) يؤسس لمنهج آخر في تحديد الظواهر الثقافية ، والعلمية ، وهو ما سنجده – فيما بعد – مؤثراً في مؤلفات عدة سنشير إليها . ففي فقرة من المقالة الرابعة يضع عنوان : ” أسماء الشعراء الذين عمل أبو سعيد السكري أشعارهم ” . ومن ثم يكون محتوى هذه الفقرة ذكر أسماء شعراء مختلفين في العصر أو في الطريقة ، متوخياً ما يثق في روايته من أشعارهم ، فكأنما كان السكري يستأنف ما سبق إليه المفضل الضبي(المتوفى 168 هـ) ، والأصمعي (المتوفى 216هـ) .. وقد توفي السكري عام (275هـ) ، والجمع في طريقتهم هو الاكتفاء بنسبة الأشعار إلى راويتها ، والاستغناء بالقطعة (من عدة أبيات) دون حرص على إيراد النص كاملا – غير أنه يثق في نسبته إلى صاحبه . وهذا تأكيد للعناية بالعنصر الإنساني المنتج للثقافة عند العرب .
تبقى “العنونة” في “فهرست” ابن النديم ، حريصة على البدء بالإنسان ، سواء في حالة الرضا عن جهده ، أو الغضب ، أو حتى الرفض لهذا الجزء . هكذا نجد عناوين مثل: ” الحلاج ومذاهبه ، والحكايات عنه ، وأسماء كتبه ، وكتبه أصحابه”(38) . وكذلك “الشافعي وأصحابه”(39) ، و “الطبري وأصحابه”(40) ، وكذلك صنع مع الفلاسفة ، والعشاق ، حتى بلغ “أسماء العفاريت الذين دخلوا على سليمان بن داوود”(41) .
وفي ختام هذه الفقرة عن “الفهرست” لا نزعم أن ابن النديم التزم بهذا النهج ، لم يفارقه : نهج البدء بأسماء الأعلام ، والتعريف بهم ، وسلاسل مؤلفاتهم وتابعيهم .. إلخ. فمن الواضح أن الظاهرة الثقافية كانت أكثر فيضانا من أن تستخلص من أسماء ، أو يُكتفى فيها بذكر الأسماء ، ومن هنا نجد عناوين لموضوعات ذات أهمية واضحة مثل : “الكلام على مذهب الإسماعيلية”(42) ، أما فيما يتعلق بفلاسفة اليونان ، فقد ذكرهم بأسمائهم ، وأحصى كتبهم ، وحاول جلاء نظرياتهم أو مقولاتهم ، ونادراً ما يشير إلى وشائج تربط بينهم ، إلا أن يجد ذلك مسطوراً في المصادر التي يعتمد عليها .
* * *
سابعا : تأكيد الملمح التراثي في العنونة بالأسماء :
من حق التهانوي (محمد بن علي ابن القاضي الفاروقي الحنفي التهانوي – المتوفى 1191هـ = 1745 م ) أن يعد خاتمة الجهود التراثية في مجال رسم المسارات العلمية بفنونها المختلفة (العربية والمعربة) ، وتوثيقها بنسبتها إلى مؤلفيها ، مع تراتب درجات هؤلاء المؤلفين ، إذ تبدأ الظاهرة العلمية أو الفنية بذكر عنوانها ، ثم النص على اسم مبتدعها الأول ، الذي بشر بها ودعا إليها ، ثم تتعاقب الأسماء حسب التسلسل الزمني ، ودرجة الأهمية المستمدة من تعدد المؤلفات ، في هذا الفن المعين.
هذه خلاصة النهج العربي في العنونة ، عبر مسارات مختلفة ، اتخذ بعضها شكل التعدد في إطار الموسوعة ، مثلما أشرنا قبل إلى “الفهرست” ، وكما نرى الآن في “كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم” وما بينهما ممن حذا حذو السابق على زمانه . وإذ يدل الإحصاء على أن “الكشاف” وقد عرّف بأكثر من ثلاثة آلاف مصطلح ، ونسبها إلى أصحابها أو تابعيها ، فإن عدد الأسماء (الأعلام) التي اعتمد عليها بلغ (868) عَلماً(43) ونلاحظ أن أسماء الأعلام التي أوردها لا تعكس مدى شهرتها أو حضورها التاريخي ، بما يعني أن التهانوي اعتمد على المؤلفات أولا ، وعلى المذاهب ثانيا ، فنجد ممن ذكر مرة واحدة : الطبراني ، الطبري ، العرجي ، عروة بن الزبير ، الفرزدق ، أبو الشيص ، أبو اليزيد البسطامي ، الحلاج ، أهرمن ، الواحدي ، ورقة بن نوفل .. إلخ . وممن ذكر مرتين : الرشيد الوطواط ، محمد بن الحنفية ، آدم أبو البشر ، الحجاج ، الجصاص ، واصل بن عطاء ، أبو بكر الصديق ، عمر بن الخطاب .. إلخ . ومن ذكر ثلاث مرات : معاوية . في حين ذكر أبو حنيفة (56) مرة ، والشافعي (58) مرة ، ومالك (13) مرة ، والرازي (37) مرة .. وهذا الإحصاء يعطي مؤشرا خاصا لتوجه الموسوعة ، واهتمامها بالمسارات المذهبية ، والعلمية ، والفلسفية أكثر من عنايتها بأحداث التاريخ التي كانت تبدو للمثقف العربي مجرد أعمال متواترة ، أو متعاقبة ، تفتقد العلية ، ولا تعود إلى مبدأ الفاعل ، أو نظام مؤثر ، قدر اعتمادها على الأشخاص ، ومن ثم كان ذكر اسم العلم ، الذي أسند إليه الحدث – مهما كانت أهمية هذا الحدث – لمرة واحدة ، كافيا حسب منهج كشاف اصطلاحات الفنون ، كما ارتآه التهانوي .
على أن مصطلحات الكشاف بالنسبة للعلوم المستجدة على العقل العربي – كما يذكر رفيق العجم ، المشرف على مراجعة طبعة مكتبة لبنان- كانت لها صورة في الثقافات السابقة (كاليونانية) ، فاتخذت منها مثالا يحتذى ، ثم بذلت جهود في الضبط والصياغة ، حتى استقر المصطلح على أسس السلوك اللغوي عند العرب ، ومن ثم يشيد بجهود ابن النديم السابق إلى نحت المصطلح المستحدث ، وتعريبه ، وقابلية بنيته للتحديث ، ويستعين (رفيق العجم) بتعريفات الجرجاني عن مفهوم الاصطلاح ، وأنه “عبارة عن اتفاق قومي على تسمية الشيء باسم ما ينقل عن واضعه الأول”(44) .
إن “الاسم” في اللغة العربية هو الأكثر ثباتا ، والأتم دلالة ، وهو مستغنى عن “الفعل” – دون العكس – وهو المقدر دائما ، أو غالبا في مجال “العنونة” المختزلة ، والأسماء هي صانعة الحقل الدلالي ، وفيها القدرة على الإيحاء بخصوصية الأجيال والحضارات . ومن الصحيح ما ذكره كاتب المقدمة : “أن الأبحاث التي شغلت الأمم في عصور ازدهارها ، وانبثاق الكشوف العلمية لديها ، وتشعب تجربتها الفكرية والوجدانية، قد أغنت لغات هذه الأمم بالألفاظ ، والأسماء ، والمصطلحات ، فعبرت اللغة تلك عن المعاني ، وتحددت تلك المعاني بخاصية هذه اللغة من دون سواها ، وبحسب الأقوام الذين تناوبت الحضارة والعلم على أيديهم”(45) . ونلاحظ الربط بين الألفاظ والأسماء والمصطلحات ، فالاسم اصطلاح ، كما أنه عنوان للفرد ، وللجماعة التي ينتمي إليها ، والمصطلح عنوان لابتكار لم يكن موجوداً ، وبعد استعماله ، وشيوعه ، فإنه يستقر استقرار اسم العلم ، ويثبت حضوره الزمني والسياقي في مجال تعاقب الأجيال والعصور . ومن هنا تبرز أهمية “الأسماء” التي احتفى بها العرب ، احتفاءً ظاهرا منذ زمن جاهليتهم، وكان من مأثور عباراتهم ، أن الغريب الوافد ، إذا لجأ إلى قوم ، وطمح إلى حمايتهم ، كان أول ما يفعل أن “ينتسب” – أي أن يذكر اسمه وقبيلته – ومن ثم يستحق الرعاية والحماية(46) . على أننا يمكن أن نفيد من إشارة مهمة عن العلاقة بين اللفظ والمعنى في الأسماء ، فالمعنى لا يتحد باللفظ ، اتحاد الروح بالجسد ، وإنما يكشف المعنى عن ذاته في استعمال الكلمة . بما يعني أن معنى الكلمة يتغير تبعاً لتغير استعمالها . وهذا يضع أسماء الأعلام في مساحة ملتبسة ، فاسم العلم يستمد مضمونه/مكانته من علاقة المردد لهذا الاسم بصاحب الاسم ذاته . ومن ثم يكون اسم مثل “الحسين” له انطباعات ، واستجابات شتى عند المتلقين له ، إلى أن يحدد بذكر النسب ، فتختلف العلاقة ، ومثل هذا يمكن أن يقال عن شخصيات التاريخ المؤثرة . وهنا نذكر أن “تيمورلنك” (توفي 1405م)(47) الذي بذر الرعب في شعوب المشرق العربي ، حين أقبل عليه غازيا – يعني اسمه : تيمور = الحديد ، لنك = الأعرج – وهو عند قومه “تيمور شاه” أي الملك المعظم تيمور ، أما عند العرب ، وجيرانه الذين اغتصب بلادهم فهو : تيمورلنك = تيمور الأعرج ، ليس أكثر . وهذا يكشف لنا ما تعنيه الأسماء المتداولة في اللغات المختلفة ، وما يكتنفها من ألقاب التعظيم ، أو الإزراء !!
على أن اللغة – أية لغة – ليست مجرد وسيلة للتفكير ، وتناقل المعلومات – على جلالة هذه الوظيفة ، وأهميتها ، فإنها – اللغة – القالب الذي يتشكل فيه الفكر ، كما أن “لغة جماعة إنسية ما تفكر داخل اللغة وتتكلم بها ، هي المنظم لتجربتها ، وهي بهذا تصنع عالمها ، وواقعها الاجتماعي .. إن كل لغة تحتوي على تصور خاص بهذا العالم”(48) .
إننا نتعقب مثل هذه الطروحات اللغوية ، لنؤكد على العلاقة العضوية بين الإعلاء من شأن الأسماء في الثقافة العربية ، وفي مقدمتها : أسماء الأعلام ، والقبائل ، والجماعات ، والطوائف …إلخ ، والنظام العربي الاجتماعي السائد عبر مراحل التاريخ القديم . وإذا كانت متغيرات العصر الحديث قد تركت أثراً في التكوين الاجتماعي ، فإن أصداء هذا التغيير ، مع أسباب أخرى أشير إليها فيما سبق (مثل : تراجع المشافهة ، والاعتماد على الصحافة ، واعتماد أسماء المواليد ، حسب نسق خاص …) قد تركت أثرها في درجة الاهتمام بذكر اسم المبدع/المنتج باكتنازه عناصر العنونة ، ومن ثم اختيار ألفاظ أخرى لتمييز هذا المنتج الأدبي أو العلمي أو الفكري ، وهذه العبارة المختارة ، قد توضع وصفاً – أو في موقع الوصف – لاسم العلم ، وقد تكون توطئة لذكره في صدر هذا المنتج الإبداعي الخاص .
ومما ينبغي ذكره في ختام هذا العرض الموجز لـ “كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم ” أن التهانوي لم يتخذ من أسماء مؤلفي الكتب والرسائل رؤوسا للموضوعات التي طرحها ، وفي مقدمته أشار إلى التقسيم المعتمد عنده ، وهو تقسيم فرضته العلوم المدونة ، ما بين نظرية وعملية ، وتقسيم الصناعات .. إلخ . وكان التهانوي في هذا متسقاً مع هدفه العلمي ، ومع التجارب السابقة في هذا النمط من التأليف في التراث العربي . وما يعنينا – ونرجو أن نكون قد وفينا بذلك- أنه بعد هذا التقسيم الموضوعي ، اعتمد في طرح المذاهب والظواهر والطوائف ، والتعريف بالكتب والرسائل – على ذكر المؤلف أولاً ، أي : العناية بالإنسان – صانع هذا العلم ، أو مؤلف هذا الكتاب … إلخ . فهذا الإنسان هو الحقيقة الكبرى في إدارة هذا العالم ، وهو صانع الحضارة ، ومنتج العلم والأدب والفن ، وكل ما يجمل الحياة ، ويضيف إليها ، ويتطور بها . وبذلك استحق تلك الصدارة التي حرصت عليها “الرؤية العربية” للتعريف بأي شيء : أي “العنونة” الجامعة المختصرة لهذا الشيء .
* * *
ثامنا : هذا المنحى الفريد في العنونة بالأسماء :
للعربي الجاهلي من طبيعته الصحراوية المكشوفة ، نصيب معلوم في تحديد الأشياء ، والتفريق بينها ، بصفات بينة ، وتسميتها بأسمائها . وقد يسهم الكيان القبلي في تحبيذ توجهات معينة ، ولعلنا في هذا المجال نذكر من أخذ على العرب تسميتهم أبناءهم بأسماءٍ غير مستحبة ، كأسماء الحيوان (فهد ، وأسد ، ونمر ، وثعلب) أو الطبيعة القاسية مثل (جبل ، صخر ، وشمس ، ومطر) إلخ .. في حين أنهم – العرب- يطلقون على عبيدهم وخدمهم أسماء مستحبة مثل : (سرور ، وسعيد ، وجميلة ..إلخ) فكان الجواب : إننا نختار الأسماء المسعدة لأتباعنا ، لأنهم في خدمتنا ، ولمسرتنا . أما أولادنا فإننا نختار ما يشد أزرهم في ملاقاة أعدائهم !! وسواء وافقنا على هذا التعليل أم أنه يحتاج إلى شيء من التحفظ ، والاستقصاء ، فإنه – من وجه – يبين عن القيم السائدة ، وتأثيرها في اختيار الأسماء . أما تحدد مظاهر الطبيعة وقسوتها ، فكان – فيما نرى – أقوى حضوراً في تسمية العيوب الخِلقية (الجسدية) بأسمائها ، وإلصاقها كصفات بأسماء من أصابتهم هذه الآفة أو تلك من انحراف التكوين الجسدي أو نقصه .
لقد شاع هذا في الجاهلية ، في أسماء بعض الأعلام المشهورة ، ذات السيادة والصدارة المجتمعية ، ومع ذلك لم يتردد الرواة في ذكرها واستخدامها ، لأنها أصبحت (علامة) ، أو (سمة) مميزة ، تخدم الاسم ، وتفصله عن غيره ، ممن يتسمى به ، وقد شاعت هذه الطريقة في الوصف حتى لم يعد أحد – تقريبا – يشعر بغرابتها ، أو بإمكان تجنبها ، أو تبديلها ، على الأخص في ذلك الزمن القديم .
وقبل أن نتوسع في هذه المسألة ، نذكر أن السليقة العربية – بوجه عام – جرت على تسمية المناسبات والأماكن والأحداث المهمة بما يميزها ، فهناك حرب البسوس، وحرب الفجار ، ويوم بعاث ، ويوم بدر ، ويوم حنين ، وصلح الحديبية ، وحتى بيعة الرضوان تحت الشجرة المعروفة . وقد أخذ القرآن الكريم بهذا النهج السائد في تسمية بعض الأشخاص بإطلاق كنى وصفات مميزة ، بقصد الإعلاء من شأنهم ، أو الحط من أقدارهم ، فلدينا إبراهيم الخليل ، وموسى الكليم ، ويوسف الصديق ، وأبو لهب ، وامرأته حمالة الحطب ، وفي صدر الإسلام : عُرف الصديق ، والفاروق ، وذو النورين ، ومن الطريف أن القرآن الكريم استخدم في تعريف عبدالله ابن أم مكتوم ، وصفه المميز بالأعمى : ) عَبَسَ وَتَوَلَّى (1) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ( ، وذلك لإبراز نقطة الضعف المسوغة لمزيد العناية بهذا الشخص ، ومع ذلك فإن الأحاديث النبوية نهت عن ذكر العيوب الجسدية ، مع التسليم بأنها مشاهدة وواقعية(49) .
في زمن الجاهلية (واستمر الأمر فيما بعده من عصور) شاعت صفات وكنى ، مثل: تأبط شرا (ثابت بن جابر – توفي 607م) ، والأعشى (أعشى قيس صاحب المعلقة(توفي 629 هـ) ، وفي العصر الأموي : أعشى همدان (الذي قتله الحجاج بن يوسف عام 83 هـ) ، وعمرو بن سعيد (الأشدق – قتل 70 هـ) . وكان بشار بن برد (توفي 168هـ) يحمل أربع علامات تميزه عن غيره : فهو بشار بن برد ، وهو بشار الأعمى ، وهو المرعث ، وهو المشنف ، وكلها تنبئ عن الشخص نفسه ، وكذلك “الجاحظ” ، وهو وصف لصورة عينيه . كما فرق العرب بين الشفه العليا المشقوقة (مثل الأرنب) ، فأطلقوا على صاحبها (الأعلم) ، وهنا نتذكر (الأعلم الشنتمري – توفي 467هـ ) . إما إذا كان مشوق الشفه السفلى فهو (الأشرم) . وهنا نتذكر (أبرهة الأشرم الحبشي– توفي 570م – عام ولادة الرسول عليه السلام ) وهو الذي تجرأ على الكعبة . وكما مُيز بشار بعماه ، ففي الأندلس نجد (الأعمى التطيلي – توفي 513هـ تقريبا) . أما أبو العلاء فيلسوف المعرة ( توفي 449هـ) ، الذي وصف نفسه بأنه : “مستطيع بغيره”، وبأنه : “رهين المحبسين” ، فإن إجلال شخصه ، برأه من صفة فقد البصر ، فلم ينتشر وصفه بالأعمى ، على كثرة خصومه ، وشيوع اتهامه في عقيدته(50) .
هذه إذن حالة خاصة بالعرب ، في جاهليتهم ، كما فيما ورثوه عن هذه الجاهلية من الطبائع ، وأساليب الكلام ، والرغبة في اختصاره ، وتحديده ، بحيث يصل إلى حد (الأيقونة) ، أو العلامة المميزة الفارقة ، التي لا يمكن أن يخلط السامع ، أو القارئ بين صاحبها ، وغيره من البشر . هكذا نتعرف على أبرهة الأشرم ، وعزة الميلاء ( وهي احدى القيان (الجواري المغنيات) ذوات الشهرة في العصر الأموي – توفيت 115هـ) ، والمنخل اليشكري (عمرو بن مسعود اليشكري ، وهو بحار وشاعر – توفي 607م)(51)، وعبد بني الحسحاس(52) ، وابن الطقطقي (توفي 709هـ) ، والطغرائي (توفي 513هـ) ، واللجلاج الحارثي (طفيل بن زيد بن عبد يغوث بن الحارث: شاعر جاهلي يماني– تاريخ وفاته مجهول) ، وطلحة الطلحات (وكان أحد ثلاثة أجواد في البصرة تذكر أسماؤهم في زمانهم) ، وأبو الشمقمق (توفي 200هـ) ، وأم الحليس ، وأبو نواس (توفي 199هـ) ، وأبو الدرداء (توفي32هـ) ، وسلم الخاسر(توفي 186هـ) ، وكراع النمل (وهو علي بن الحسن الدوسي ، وسمي بكراع النمل لدمامته وقصره – توفي 316 هـ تقريبا) ، والوطواط (رشيد الدين الوطواط – توفي 573هـ) ، والوأواء الدمشقي ( توفي 551هـ على الأرجح) .
هذه أسماءٌ ، وصفاتٌ ، وكُنى ، شاعت في أزمنة عربية متطاولة ، ما بين الجاهلية والعصور الوسطى الإسلامية ، وتداولها الناس في صورتها دون حرج ، مع ما يمكن أن تحمل من صفات النقص الجسدي ، أو النطقي ، أو النفسي . لقد اكتسبت حق وجودها بالتداول على امتداد زمن المشافهة ، وتأكد حضورها وأحقيتها في التدليل على أصحابها دون تغيير في طبائعهم ، أو صفاتهم حين أهل عصر الكتابة ، ولنا هنا ملاحظتان بعد هذا العرض العام ، الذي اخترنا فيه أشهر تلك الأسماء والصفات والكنى الغريبة ، وسجلناها كما تداولها الناس ، وكما كتبت في المصادر الأولى ، واستمرت إلى زمن الطباعة – وإلى زماننا هذا :
الملاحظة الأولى : أن هذه (الأسماء) السابقة ، يغلب عليها طابع رصد العيوب الظاهرة في الوجه أو في البدن عامة ، أو في النطق . ولسنا ندري : هل كان هذا الاستخدام يبلغ أذن الشخص المعني به ، أم أنه كان يتداول بعيداً عن إدراكه الخاص ، أو سماعه . ويغلب على ظننا أنه كان يعرف ما أطلق عليه بين نظرائه ، وأنه حتى وإن ضاق صدره بالإشارة إلى ما هو سلبي في شخصيته ، فإنه لم يكن يملك تغييره ، بل لعله وجد فيه باباً من أبواب التميز والشهرة . وهناك (أسماء) مستحبة ، تحمل معنى الفضيلة ، أو القوة والشجاعة ، مثل : ملاعب الأسنة ، والمنخل ، وأبي نواس (واسمه الحسن بن هانئ ، وإنما غلبت عليه هذه الكنية بسبب تلك الضفيرة التي جدلتها له أمه وهو صبي ، فكانت تنوس = تتحرك ذهابا وجيئة خلف ظهره) .
الملاحظة الثانية : أن هذا الميراث الغريب ، الذي لا نظن أننا نجد له شبيهاً في أية حضارة غير الحضارة العربية وتراثها ، في اتساعه خاصة ، حتى يبلغ مبلغ الظاهرة ، والصيغة المتداولة دون حرج .. هذا الميراث الذي بدأ شفاهيا ما لبث أن فرض وجوده على عصر الكتابة ، وبذلك استقر وتأبد.
* * *
تاسعا : الجاحظ يؤسس للتأليف عن الظاهرة :
أبو عثمان ، عمرو بن بحر الجاحظ (159 – 255هـ) ، وقد لحقه نصيب من هذه الظاهرة الخاصة في إطلاق الكُنى ، والصفات ، وتثبيتها ، بحيث تتحول – مع شيوع الاستخدام واستمراره – إلى أسماء ، أيقونات(53) خاصة بأصحابها ، فقد أوشك اسمه أن يختفي بتصدر “أيقونته” – أو وصفه الشائع – (الجاحظ) ، وإن كنا لا ندري – بدرجة اليقين – أنه سمع هذا الوصف البديل لاسمه ، أم ظل يذكر في حضوره بكنيته (أبو عثمان) أو باسمه (عمرو بن بحر)؟! . مهما يكن من أمر فإن هذا (الجاحظ) كان يملك من شجاعة الرأي وصفاء الرؤية ما جعله يتقبل الواقع (بما فيه الواقع اللغوي ، والواقع الاجتماعي) كما هو ، ونجد أمثلة متعددة في تقبله للألفاظ الشائنة ، كما في كتاب “الحيوان” . فبعد أن ذكر بعض المفردات المستقبحة ، رأى أنه لا يجد عيبا في تداولها ، بدعوى أنها وجدت ، وأنها ما وجدت إلا لتستخدم(54) . وفي هذا السياق فإن الجاحظ هو مؤلف كتاب : “البخلاء” ، ومع كراهية صفة البخل ، فقد صرح فيه بأسماء حقيقية ، وأخرى اخترعها ، ليكسب كتابه طابعه الفني النادر . كما سبقت الإشارة إلى عدد من “رسائله” التي حملت عناوينها عبارات مستكرهة ، أو مستقبحة . غير أن الجاحظ هو المفكر والأديب الذي يستطيع أن ينقلك إلى واقع زمانه ، أو ينقل واقع زمانه إليك دون حرج!!
أما كتابه الذي نعنيه ، فهو بعنوان :”كتاب البرصان والعرجان والعميان والحولان”، وقد حققه عبد السلام هارون(55) ، والجاحظ – في ملاحظة متكررة بالنسبة إليه – قد لا يكون البادئ بطرح الظاهرة (ظاهرة ذكر العيوب كعلامات أو سمات)، غير أنه حين يعرض لها ، فإنه يوفيها حقها من كافة جهاته ، فلا يكاد يترك مزيداً لمستزيد . وهو في توجهه لأصحاب النقائص البدنية المذكورة ، مسبوق بمن ذكره في مقدمته : “الهيثم بن عدي” على أنه لم يتحرج أن يذكر نواقص ، وقصور هذه المحاولة المبكرة.
والجاحظ في محاولته هذه يعرف الفرق بين الاسم والصفة ، كما نعرفه الآن ، “فالاسم” : ما يدل على الذات ، وهو غير قابل للتغير ، سواء في البشر أو في سائر المخلوقات . أما “الصفة” : فإنها معنى قائم بالذات ، زائد عليها ، وهذه الصفة قابلة للتغير بإحلال صفة أخرى ، أو بإضافة ، وربما انتقلت الصفة إلى نقيضها ، وهذه أمور معهودة نلحظها في التداول العام لأسماء الأشخاص والأشياء ، وصفاتهم .
والجاحظ في عنايته بمن نطلق عليهم الآن : (ذوي الاحتياجات الخاصة) نظراً لقصور قدراتهم ، يدرك في ذلك الزمن المبكر ، أن أصحاب هذه العاهات يملكون من التعويض ، ما يغطي على هذا العجز الذي يعانونه قسراً ، بل إن الجاحظ – بصرف النظر مؤقتا عن حصر العاهات التي عرض لها – عُني في مقدمة دراسته بأمرين :
الأول : معرفته بطبيعة النفس العربية ، وغلبة روح التحدي ، ورغبة التخطي لما يمكن أن يعد من المناقص ، بل إن هذه النفس العربية لا تتردد في أن تعلن عن هذا النقص (وليس أن تحاول إخفاءه أو مواراته) ، وأن تبرره وتعتذر عنه ، وربما لج بها العناد ، فراحت تفاخر به ، وتقلبه من المساوئ إلى المحاسن، ومن العجز إلى القوة والتفرد . وسنجد لهذا أمثلة عديدة من الأشعار والأقوال السائرة .
الثاني : أن الجاحظ بخبرته الواسعة بطبائع الحيوان (الذي ألف فيه موسوعة ضخمة باسم كتاب “الحيوان” – مع الوضع في الاعتبار تأثره بما كتب أرسطو عن الحيوان(56)) قد عُني في كتابه الذي نحن بصدده ، بتلك العلل التي يصاب بها الحيوان ، كما يصاب بها الإنسان ، مثل : العرج ، والحول ، والبرص ...إلخ.
وهنا ينبغي أن نكشف عما يمثله الاهتمام (العلمي) بالعيوب الجسدية التي تعرض للإنسان ، وأهمية هذا لما تميز به (العنوان في التراث العربي) من حيث اهتمامه بالإنسان ، فقد رأينا صوراً مختلفة ، ما بين الجاهلية (الشفاهية) ومقاربة زماننا (عصر التدوين ، ثم يليه عصر المطبعة) من التعامل مع أسماء الأعلام في اتخاذها عناوين ، أو علامات تحدد شخص المنتج/المبدع ، ثم تعرف بإنتاجه . وما يعنيه هذا من إعلاء الشعور بالإنسان ، بالشخص في ذاته ، بالمبدع الذي هو المفتاح ، والمدخل الطبيعي لما أبدع ، وإدراكه لاتجاهه : فاسم المبدع ، كما يعبر نقديا الآن : (عتبة) ، كما أن عنوان العمل عتبة أخرى ، وقد تفضل إحدى العتبات على غيرها من منظور إدراك المتلقي ، وما عساه أن يفتقده فيما يحاول أن يدركه من أبواب المعرفة . إن أصحاب النواقص من العميان والعوران والعرجان والبرصان وغيرهم ، ممن ذكرهم الجاحظ وغيره ، من المؤكد أن مشاهيرهم من أصحاب التميز في الصناعة ، قد ذكروا ضمناً في سياق التعريف بالفنون التي أتقنوها ، فلعله لم تكن هناك ضرورة لاختصاصهم بالتأليف في الموضوع المعين ، الخاص ، الذي يبدو وكأنه نوع من التشهير . غير أن التمعن في الأسماء المذكورة بعيوبها (الشديدة القادحة أحيانا) يعيد أمر هذا الاهتمام إلى نصابه ، فليس التشهير قصداً ، ولا مجرد إبراز الظاهرة في ذاتها ، وإنما القصد ما كشفنا عن جانب منه في مقدمة هذه الفقرة ، وهو اعتزاز العربي بذاته ، وبالمعنى الأصيل لشخصه المتجسد في النسب ، والصفات المعنوية ، والخلق ، والقدرة على الإبداع ، بما يطغى على هذا النقص العضوي ، الذي يغالب العربي (البدوي غالبا) طبيعته ، بأن يجعله موضعا للفخر ، ونضيف إلى هذا العامل النفسي التراثي ، عاملاً (حضاريا) آخر ، وهو أنه بإفراد هذه الشخصيات المصابة في أبدانها ، بدراسات تحاول أن تكون حصرية ، أو مستوعبة للأكثر والأهم ، ليس أن تقدم لنا صورة عن انتشار الآفات الجسدية في مجتمعات صحراوية ، تقل فيها أسباب الأخذ بالمبادئ العلمية ، والرعاية الصحية ، وإنما أن تؤكد لنا أنه على الرغم من هذه المعوقات المعلنة ، فإن هذه الشخصيات شغلت مواقع السيادة ، والقيادة ، والريادة في مجتمعاتها ، على مستوى القبيلة ، والمهنة ، والدولة في أحيان ليست قليلة.(57)
وقبل أن نستطرد إلى تقديم نماذج للإبداع في هذه الاتجاهات ، نشير إلى ما ذكره الجاحظ عن سبق عنترة إلى اتخاذ صورة (الأجذم) لهدف جمالي ، غير مسبوق ، وغير ملحوق ، لأنها صورة يتيمة فريدة ، تفضح من يسرقها ، وهي قوله في وصف الروضة، وطنين الذباب بها(58) :
فترى الذباب بها يغني وحده = هزجاً كفعل الشارب المتــرنمِ
غرداً يحك ذراعــه بذراعـــه = فعل المكـب على الزنادِ الأجذمِ
بل يشير إلى حرص بشار بن برد (الأعمى) على أن يعلل لذكاء الطفل الذي يولد أعمى ، وذلك في قوله:
وجدكَ أهدى من بصيرٍ وأجولا
إِذَا وُلِــدَ المَولود أعمى وجَـدْتَه
فجئتُ عجيبَ الظن للعِلم مَعْقِلا
عمِيتُ جَنِينا والذكاءُ من العَمَــى
بقلْبٍ إِذا مَا ضَيَّعَ النَّاسُ حَصَّلا
وغَاضَ ضياءُ العينِ للقلب فاغْتَدَى
بقَوْلٍ إِذَا ما أَحْزنَ الشِّعْرُ أَسْهَلاَ
وشعر كنور الروضِ لاءمتُ بينـهُ
ولكي يبرهن الجاحظ على أن قوة النفس الإنسانية وعظمتها ، لا ترتبط بكمالها العضوي ، ولا بجمالها الخِلْقي ، بقدر ما تعود إلى الإرادة ، ونماء الشخصية ، يقدم أمثلة (عملية) بمن يطلق عليهم : العرج الأشراف ، وفي مقدمتهم : أبو طالب ، معاذ بن جبل ، عبدالله بن جدعان ، الجموح الأنصاري ، عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، ويقول الجاحظ في عبارة جامعة : “والعرج الأشراف – أبقاك الله – كثير ، والعُمي الأشراف أكثر” ، كما يشير الجاحظ إلى : الحارث الأعرج الغساني الذي مدحه (النابغة الذبياني) فقال :
هذا غلام حسنٌ وجهه = مستقبل الخير سريع التمام
وإلى الحسن حفيد الإمام الحسن – رضي الله عنهما – ويذكر من الأشراف العرجان : قيس بن عاصم أحد بني مالك ، ومثله : الحارث بن شريك الشيباني ، ومن العرجان الأشراف أيضا : أبو الأسود الدؤلي ، والأحوص الأنصاري الشاعر ، ويونس بن حبيب النحوي .. إلخ . فلا يكاد الجاحظ يترك قبيلة أو صناعة إلا ويذكر مشاهير العرجان ، الذين تسيدوها ، أو برعوا فيها .
ولا تبرأ محاولة الجاحظ من نزعة المداعبة والاستطراف ، فيذكر من بين العرجان: عمران بن مره ، كما يذكر أنه كان بطلا ، وأنه الذي أسر الأقرع بن حابس ، وهو أعرج كذلك ، فكان الآسر والمأسور من طائفة العرجان!!
ويذكر الجاحظ- من سيكولوجية الأعرج – أنه يحاول أن يتغلب على ضعف منظره قدر المستطاع ، وإلا بحث عن وجه من القوة ، يتحول بالنقيصة إلى مفخرة ، فمن حيل العرجان : أنهم كانوا يفضلون قتال الفروسية ، فالأعرج يختفي عرجه ، لمجرد اعتلائه فرسه ، فإذا كان مقاتلا كفؤاً لم يؤثر عرجه في قدرته القتالية . وقد يصف أعمالا قتالية نادرة ، اقترنت بالعرج ، إذ يذكر حاتم بن عتاب بن قيس بن قشير ، وهو الذي كان ينشد رجله وهو يقاتل ، فسمي ناشد رجله ، وهو الذي كان يحجل يوم اليرموك على الأخرى ، ويقاتل الروم ، وذهب إلى قدر زيت تغلي ، فأدخل رجله فيها لتكويها ، ويقطع عنها النزف !! ويحكي عن : حكيم بن جبلة ، من عبد القيس ، أنه قطعت رجله بفخذها ، فتناولها فرمى بها قاطع رجله ، فكبده بها ، فسقط ، فزحف إليه حتى ذبحه ، ثم استرخى من النزف ، فاتكأ على قتيله وهو قاطع رجله ، فمر به رجلٌ فقال : من بك ؟ قال : وسادي !! وما إلى ذلك من عجائب ونوادر!!
ولا يختلف ذكر البرصان عن ذكر العرجان إلا في الأسماء ، فممن أصيب بالبرص من هم سادة ، ومن هم فرسان ، وأشراف ، بل وملوك ، وهناك من فخر بالبرص كذلك . يذكر من البرصان السادة ، والفرسان القادة : الربيع بن زياد وهو أحد الكملة ، وكان قائد عبس ، وعبدالله بن غطفان في حرب داحس . كما يُذكّر بالملك جذيمة الأبرش (الأبرص) ، ويرصد الجاحظ – في تدقيق نادر – كيف يتلطف العربي في ذكر الصفة ، تبعاً لموقع الموصوف ، فقد كان جذيمة بن مالك (صاحب الزباء وقصير) يقال له : جذيمة الأبرص ، فلما ملك قالوا على وجه الكناية : جذيمة الأبرش ، فلما عظم شأنه قالوا : جذيمة الوضاح .(59)
ومن البرصان كذلك : شمر بن ذي الجوشن الضبابي قاتل الإمام الحسين ، وعلي بن جبلة (العَكَوْك) وذكر في العميان كذلك(60) . ويذكر الجاحظ في “قائمة” البرصان أسماء شهيرة مثل : أيمن بن خريم (وهو تابعي وشاعر وراوية للحديث النبوي) ، وبشر بن المعتمر (صاحب الصحيفة الشهيرة في صناعة الكلام التي أوردها الجاحظ في البيان والتبيين) .
ويمكن أن ننهي هذه الفقرة ، وننهي هذا العرض عن ذوي العاهات ، ممن عرض لهم الجاحظ بذكر : جعفر بن دينار – من البرصان – وقد اصطنعه المأمون ، فقاد الجيوش ، وفتح الفتوح ، وولى الولايات . بل يذكر أن علويه المغني كان أبرص كذلك ، كما يصف مهارته في الضرب على الآلات ، وبخاصة آلة العود التي كان يجيدها بكلتا يديه .
نكتفي بما ذكر الجاحظ عن ( البرصان والعرجان ) عن سائر من أحصاهم في كتابه هذا ، فليس القصد أن نقف على مادته ، بقدر ما أن نستخرج منهجه ودوافعه ، وما ترتب عليه من ذكر أثره في العنونة بالأسماء ، وهو موضوع هذه الدراسة في الأساس .
* * *
عاشرا : هذه الإضافة الأخيرة عن العنونة بالأسماء في التراث العربي :
ونعني بها ما أضافه خليل بن أيبك الصفدي (صلاح الدين : 696هـ – 764هـ)، فلعله الوحيد الذي تأثر بتجربة الجاحظ في هذا المجال ، وإن أغفل الإشارة إليه في من ذكرهم في مقدمته لكتابه :”نَكْت الهميان في نُكَت العُميان”(61) . وفي هذه المقدمة أشار إلى ما سبق إليه (ابن قتيبة – توفي 276هـ) في كتابه ” المعارف” ، وقد ضمنه فصلا عن المكافيف ، ثم(أحمد بن علي بن بابه – توفي510 هـ) في كتابه “رأس مال النديم” ، ومن بعده (ابن الجوزي – توفي 597هـ) وقد يدل كتاب الصفدي على الاتجاه العام في الاختصاص بذكر طائفة محددة من ذوي العاهات الجسدية ، وهو اتجاه يبدأ بمقدمات لغوية وتاريخية ، ثم يفيض في ذكر النوادر والطرائف المقبولة والمرذولة على السواء.
وكذلك في كتاب الصفدي (صلاح الدين خليل بن أيبك) في كتابه الآخر : “الشعور بالعور” ، فقد ترجم لمن أصابتهم هذه النقيصة ، وبخاصة كبار المشاهير من الشعراء والقادة ، وزعماء القبائل ، فكأنما أفاد من تلك الأسماء التي تقدم بها الجاحظ ، وأضاف إليها المشاهير ، الذين ذكرهم التاريخ العام ، والتاريخ الأدبي ، أو رويت عنهم الطرائف والغرائب ، ما بين زمن الجاحظ (القرن الثالث الهجري) إلى زمان الصفدي (القرن الثامن الهجري) .
يمكن أن نقرر في ختام هذه الفقرة أننا قصدنا فيها إلى إبراز أهمية الاسم ، وخصوصية الوصف في مجال اتخاذه عنواناً لكتاب ، أو لرسالة ، أو لمبحث ، أو لمسألة، أو لترجمة خاصة لصاحبها ، بما يكشف عن اتجاه عقلي ، حضاري ، يكتنزه الضمير العربي ، إذ يعد الإنسان – ( بما هو إنسان) – بمثابة المفتاح ، أو كلمة السر التي ينبغي أن تكون مدخلا للإدراك في أي مسألة مثيرة للفكر ، أو للخيال ، أو للبحث العلمي على السواء . وقد عنينا – في ختام هذه الدراسة ، على إيجازها – بأصحاب القدرات الخاصة (العاهات) ، بما يكشف عن هذه القدرات الخاصة ، ويؤكدها في شخصياتهم وسلوكياتهم ، ومناحي تفكيرهم ، وإبداعاتهم على تنوعها . على أن ملاحظتنا الأخيرة على ما أضافه (خليل بن أيبك الصفدي) ، وما سبق أن أشار إليه من كتابات : ابن قتيبة ، وابن الجوزي، وابن بابه ، قد غلب عليه طابع الاستطراف والغرابة ، والميل إلى الإدهاش والإثارة ، وهذا يخرج عن طبيعة هذه الدراسة ، ويمكن أن يعود إليه من يرغب فيه ، ولهذا السبب عددنا الجاحظ صاحب البداية ، وواضع الأسس النفسية والفكرية ، الذي أوحى بالمعنى الفلسفي لاستخدام صفات النقص دليلاً على الكمال ، وتأكيداً لطابع الشخصية العربية في استوائها ، كما في مناقصها ، إذ تغالب هذه المناقص حتى تتغلب عليها ، وقد تتفاخر بها ، أو تحسن تعليلها ، كما بينا في مكانه .
الهوامش :
اهتمت دراسات نقدية فرنسية ، وإنجليزية ، وأمريكية (بصفة خاصة) بالسيميولوجيا – أو السيميوطيقا ، كما يؤثرها المؤلفون الفرنسيون خاصة ، والسيميوطيقا كما يؤثرها الباحثون الأمريكان ، وفي هذا السياق تطرح قضية العنونة ، وصلة العنوان بالمدونة ، كما تذكر أسماء : رولان بارت ، وبيرس ، ودو سوسير ، وجان كوهان ، وجان جينيت ، وجريماس .. وغيرهم .
يراجع في ذلك : دراسة بعنوان : “السيميوطيقا والعنونة” للدكتور جميل حمداوي – عالم الفكر (الكويتية) – يناير/مارس (1997) – ص79 – 112.
في دراسة الدكتور محمد فكري الجزار ، بعنوان : “العنوان وسيميوطيقا الاتصال الأدبي” – الهيئة المصرية العامة للكتاب – 1998 ، في النصف الثاني من دراسته يتجه إلى مقالات ، ودراسات ، ودواوين شعر ، وروايات حديثة . تنظر الصفحات 48 ، 49 ، 69 ، 72 ، 82 ، 115 ، 121 ، وغيرها . وفيها عرض لمقال صحفي ، وختم تنويعاته تطبيقياً برواية : (صاحبة البيت) ، للدكتور لطيفة الزيات ، ورواية (ذات) لصنع الله إبراهيم
وفي دراسة الدكتور بسام قطوس بعنوان : “سيمياء العنوان” – بسام موسى قطوس – الناشر : مكتبة كتانة ، إربد – 2001 ، يختار عدداً من عناوين الدواوين ، مثل: (حليب أسود) للمتوكل طه – ص54 ، و (شيء كالظل) للشاعر عفيفي مطر ، كما يتوقف عند (لافتات) أحمد مطر- ص83 ، وبعض عناوين قصائد معين بسيسو ، وسميح القاسم ، ومحمود درويش .
“معجم لسان العرب” لابن منظور المصري ، مادة ( ع ن ن ) .
Gerard, Genette,(1987).Paratexts: Thresholds of Interpretation. Cambridge: Cambridge University Press . P76
وترجمة عبارة جينيت : العنوان مجموعة من العلامات اللغوية التي تتصدر كتابا أو نصا مطبوعا أو عملا فنيا ، وهو بمثابة اسم لهذا العمل ، ووظيفته أن يعرف بالعمل أو يوصل ملخصا بمضمونه أو يثير فضول الجمهور المستهدف ، ويجتذبه للإطلاع عليه . ولا يشترط تحقق الوظائف الثلاث في آن واحد ، بل إن الوظيفة الأولى بمثابة الوظيفة الأساسية التي لابد للعنوان أن يؤديها ، أما الوظيفتان الأخريان فإنهما اختياريتان و مكملتان للوظيفة الأولى.
مقدمة “تاريخ ابن خلدون” – دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع – بيروت – طبعة أولى – 1981 .
انظر : مقدمة ابن خلدون – ص731 – 733 .
اقرأ عن التراجع عن المدنية ، واعتناق أحلام القوى والبداوة (المقدمة) ص542 ، 544 .
ينظر : مقدمة ابن خلدون – ص545 .
مقدمة ابن خلدون – ص550 .
مقدمة ابن خلدون – ص575 وما بعدها . وفي هذا المكان يعرض لعدد من المؤلفات التراثية المهمة ، وكيف تراتبت مسائلها على ما تقدمها .
مقدمة ابن خلدون – ص757 .
مقدمة ابن خلدون – ص764 .
العنوان في الأدب العربي : النشأة والتطور – الدكتور محمد عويس – مكتبة الأنجلو المصرية – طبعة أولى – 1988 – ص48 .
المرجع السابق نفسه .
ينظر المرجع السابق – ص89 . أما نص السيوطي فمن كتابه “الإتقان في علوم القرآن” – ج1 – ص161 .
المرجع السابق – ص180 .
المرجع السابق نفسه .
لم نصادف – على كثرة ما قرأنا – أن مؤلفاً في موضوع ما ، يختم دراسته بالنص على العناوين التفصيلية لكتاب أعجبه في الموضوع نفسه ، غير أن المألوف أن يشار إلى هذا الكتاب موضع الإعجاب ، وأن تفرز مسائله ، وتناقش القضايا التي تستحق النقاش فيه ، وفي هذا من الإشادة والصدق والدقة العلمية ما يكفي .
هذه القصيدة للشاعر الجاهلي الإسلامي “أبو ذؤيب الهذلي” وهي تتصدر ديوان الهذليين – تحقيق : أحمد الزين – ثلاثة أجزاء في مجلد – مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة – 1995 – ص1 .
انظر : ديوان عامر بن الطفيل – تحقيق : تشارلز لايل – دار الكتب والوثائق القومية – القاهرة – 2009 – ص3 .
هذا البيت في مطلع قصيدة رثاء من 83 بيتا ، في رثاء أبي إسحاق إبراهيم ابن هلال الصابي – ينظر نص القصيدة في ديوان “الشريف الرضي” – الجزء الأول – الناشر – مؤسسة الأعلمي للمطبوعات – بيروت – د .ت – ص 294 .
القصيدة في أحد عشر بيتا ، ينظر : ديوان ابن مطروح – تحقيق : الدكتور حسين نصار – دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة – 2004 – ص48 .
عن ابن سلام ، ينظر ما كتب صاحب هذه الدراسة عنه في كتابه :”مقدمة في النقد الأدبي” – دار البحوث العلمية – الكويت – 1975 – الطبعة الأولى – ص506 – 537 .
عن ابن قتيبة ، ينظر : المرجع السابق – ص538 – 563 .
كتب الجاحظ العدد من الرسائل (المقالات) مختلفة العناوين ، حققها العلامة عبد السلام هارون ، ومن أهمها :
رسالة التربيع والتدوير – الحنين إلى الأوطان – الجد والهزل – فصل ما بين العداوة والحسد – صناعة القواد (القادة) – مفاخرة الجواري والغلمان – فخر السودان على البيضان – القيان .. إلخ .
إخوان الصفا وخلان الوفا – وهي مقسمة في أربعة أقسام ، أو مستويات معرفية: الرسائل الرياضية – والرسائل النفسانية العقلية – والرسائل الجسمانية الطبيعية – والرسائل الناموسية الإلهية ، وتحت كل نوع مجموعة من الرسائل القصيرة تشرح جوهر الفكرة ، وتقدم البراهين العقلية على صوابها .
ينظر : “العنوان في الأدب العربي :النشأة والتطور” – مرجع سابق – ص273 وما يعدها .
المرجع السابق – ص 276 ، 278 ، 282 ، 284 ، 287 ، 289 ، 290 ، 294 ، وانظر خلاصة الرأي ص302 .
المرجع السابق – ص180 ، والمصدر المذكور بهامشه .
ديوان عائشة تيمور – طبعة مصر – 1886 .
ديوان البارودي – المجلد الأول – تحقيق علي الجارم ومحمد شفيق معروف – الهيئة المصرية العامة للكتاب – 1992 .
وفي كتاب(الكامل في التاريخ) يتأكد الحرص على ذكر الأسماء ، حتى أسماء من تولوا إمارة الحج في الموسم ، مع وجود أحداث كبرى لم يهتم مسجل التاريخ بأن يتعقب مسارها ، وآثارها . وبالنسبة لموسم الحج ، فقد دأب المصدر المذكور على تسجيل من أوكلت إليه الخلافة رياسة موسم الحج ، وقد تذكر هجوم الأعراب ، وانتهابهم لموكب التشريفة التي تبعث بها مصر إلى الكعبة كل عام ، وخطف نساء القافلة ، وقتل رجالها . يذكر هذا دون تعليق .
راجع ما كتبناه في كتاب (منافذ إلى الماضي المستمر) – الدراسة الثالثة بعنوان :
“الإبداع في مجتمع حر” – ص41 وما بعدها . وانظر بخاصة ما ذكر في صفحة51 -53 .
يرى البعض أن التهانوي توفي سنة إتمامه كتابه “كشاف اصطلاحات الفنون” أي عام 1158 ، ويقرر بعض من أرخوا له أنه وجد توقيع التهانوي على وثائق وفتاوى بتاريخ 1191 .
انظر : تعريف الدكتور عبد الحكيم راضي بكتاب “الفهرست” لابن النديم – مقدمة الجزء الأول – من طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب – القاهرة – 2006 .
ينظر “الفهرست” لابن النديم – ج1 – تحقيق : محمد عوني عبد الرؤوف ، إيمان السعيد جلال – ص2 .
المصدر السابق – ص42 .
المصدر السابق – ص140 .
هذا العنوان في المصدر السابق – ص190 .
المصدر السابق – ص209 .
المصدر السابق – ص234 .
المصدر السابق – ص309 .
المصدر السابق – ص186 .
هذا حسب إحصائنا ، اعتمدنا فيه على فهرس الفرق الأعلام والقبائل ، فضلا عن عدد غير قليل ذكر فيه أسماء أعلام غير منسوبة .
تعريف الدكتور رفيق العجم في مقدمة الكشاف ، وكتاب التعريفات للجرجاني ، ينظر الهامش – ص xx .
ينظر : المقدمة السابقة – ص vill .
يتوسع محرر المقدمة في هذه النقطة ، فيذكر أن مصطلحات الكشاف ، وضعت القارئ أمام ألفاظ وأسماء لم تقتصر على الوصف ، إنما اصطنعت ألفاظاً جديدة بألعاب في اللغة ، عن طريق التفعيلات تارة ، وعن طريق الخروج عن العادة تارة أخرى – المقدمة السابقة – ص xvll .
تيمورلنك : قائد أوزبكي ، مؤسس العائلة التيمورية الحاكمة ، حاول غزو الشرق العربي ، ووصل إلى بلاد الشام .
المقدمة السابقة – رقم xxiv. وينسب هذا القول إلى الألماني يوهان جوتفريدهردر (توفي 1803م) . ينظر الهامش التوثيقي في ذات الصفحة .
جاء في الحديث الشريف ، فيما أورده مسلم في صحيحه : حدثنايحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة ، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : أتدرون ما الغيبة ؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال : ذكرك أخاك بما يكره. قيل : أفرأيت إن كان في أخي ما أقول . قال : إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته ، وإن لم يكن فيه فقد بهته ” صدق رسول الله .
بمناسبة مرور ألف عام على مولد شيخ المعرة ، صدر كتاب بإشراف الدكتور طه حسين ، جمع أهم البحوث التي كتبت قديما عن أبي العلاء وأدبه ، وهذا الكتاب بعنوان : “تعريف القدماء بأبي العلاء” – الدار القومية للطباعة والنشر – 1965 ، عن نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية – 1944 ، وقد تصفحت هذا الكتاب المستوعب ، فنادراً ما وجدت اهتماماً بخصوصية طاقته التصويرية في (رسالة الغفران) ، أو قدرته الشعرية في ديوانيه ، قدر ما وجدت من الاهتمام (بالتفتيش) في عقيدته ، وهل مات أبو العلاء مؤمناً أم ملحداً متشككاً ؟! وهذا أمر مؤسف ، ومحبط بالنسبة لتاريخ الفكر العربي .
المنخل اليشكري : شاعر مقل ، ولكنه يجيد تنخل الكلام ، أم تنقيته ، وتدقيقه ، وله قطعة من عدة أبيات (في أثناء قصيدة) واسعة التداول في أغراض الوصف والغزل في العصر الجاهلي ، وهذا نصها :
وَلَقَدْ دَخَلـْتُ عَلَـى الفَتـَــــا = ةِ الخِـــــدْرَ فِي الْيـَوْمِ الْمَطِيـرِ
الْكَــاعِـــبِ الْحَسْنَــــاءِ تـَرْ = فُلُ فِي الدِّمَقْـسِ وَفِي الْحَرِيرِ
فَــدَفَعْتُهَــــــا فــتـَدَافَعَــتْ = مَشْــيَ الْقَطَــــاةِ إِلَى الْغَدِيرِ
وَلَثَمْتُهَــــــا فَتَنَفَّسَـــــــتْ = كَتَنَفُّــــسِ الظَّبْــــــيِ الْبَهِيـرِ
فَــدَنَــــتْ وَقَــــالَتْ يَا مُنَـ = ـخَّلُ مَا بِجِسْمِـــــكَ مِنْ حَرُورِ
مَا شَفَّ جِسْمِي غَيْرُ حُـ = ـبِّكِ فَاهْدَئِي عَنِّي وَسِيـــرِي
وَأُحِبُّهَـــــــــــا وَتُحِبُّنـــِي = وَيُحِـبُّ نَـاقَتَهــــــا بَعِـيــــــرِي
عبد بني الحسحاس : هو أحد عبيد قبيلة بني الحسحاس ، وله ديوان شعر مشهور ، وقد تغزل في نساء القبيلة ، فأفحش ، مما أدى إلى قتله ، ومن ثم خصص بوصف (عبد بنمي الحسحاس) ، وليس هو الوحيد الذي يوصف بهذا الوصف .
أيقونة icon : هو تعريب لكلمة يونانية تعني صورة ، أو شبه مثال ، والعبارة المتداولة – بصرف النظر عن المدلول الديني – تعني اكتناز دلالة محددة في صورة أو عبارة مختصرة . فهي رسم أو رمز يميز أمراً معيناً (مكانا ، أو فعلا ، أو زمنا ، أو شخصا ، أو مهنة .. الخ) .
ينظر ما كتب تحت عنوان “تناسب الألفاظ مع الأغراض – الوقار والتكلف – تسمح بعض الأئمة في ذكر الألفاظ – لكل مقام مقال ” فقرات من كتاب “الحيوان للجاحظ – الجزء 3 – ص39 – 43- تحقيق : عبد السلام هارون – طبعة ثانية – مصطفى البابي الحلبي في مصر – 1965 .
كتاب “البرصان والعرجان والعميان والحولان ” الطبعة الأولى– الناشر : دار الجيل – بيروت – 1410هـ .
هناك إشارات لتأثر الجاحظ بدراسة أرسطو تحت العنوان نفسه ، غير أننا نرى أن هذا التأثر لم يجاوز الإطار العام ، فالحيوان الذي عني به الجاحظ ينتمي إلى بيئته الشرقية الحارة غالبا ، على أن عنايته بأنواع الحيوان تتجلى من خلال مختارات شعرية ، واقتباسات ، وأقوال تنتمي إلى عصور تالية لزمن أرسطو .
وإلى اليوم أستعيد ذكرى قديمة ، وأنا طفل ، وكان جارنا يقرأ في كتاب عن الفتنة الكبرى ، بصوت مسموع ، ليتمكن المتحلقون حوله من سماعه ، فجاء ذكر معركة صفين ، وعرفت – أنا الطفل – أن قائد الإمام علي فيها هو : مالك بن الحارث الأشتر ، وأن هذا القائد البطل كان أعور ، فاستوعبت أذني معنى الكلام ، وعجبت – في طفولتي – كيف يكون قائداً لجيش فاقداً إحدى عينيه ؟! غير أن كتاب الجاحظ ، الذي استقصى الظاهرة في كافة اتجاهاتها ، كشف عن أن هذه النواقص كثيراً ما تعوض بقدرات متجاوزة .
والذباب : كل ما يطير من الهوام ، وليس ما نطلق عليه الآن هذا اللفظ ، فالنحل، والزنابير وأشباهها من الذباب كذلك.
وهذا الرصد الدقيق لأوصاف البَرَص ، واختلافه مع أصحاب المنزلة الاجتماعية يغري بعقد دراسة عن الأوصاف في اللغة العربية ، المناظرة أو المسامتة للطبائع والمنازل والطبقات .
يذكر الجاحظ من طرائف الشاعر العكوْك : أنه كان مع عمائه وشُنعة برصه يتعشق جارية ، ويتعشقها شاعرة ظريفة أديبة ، وكان انشد حميد بن عبد الحميد شعراً ، فوهب له مائتي دينار ، فانصرف من دار حميد إلى منزل المعشوقة ، فصب الدنانير في حجرها ، ثم مضى إلى منزله ، وليس فيه درهم ، ولا شيء قيمته درهم ، وكان أحسن خلق الله إنشاداً ، ما رأيت مثله بدويا ولا حضرياً .
“نكتب الهميان في نكت العميان”: الهميان: كيس النقود أو ما نحفظ فيه الأشياء العزيزة ، والنكت (بسكون الكاف) يعني : الكشف، والنُكَت (بفتح الكاف) تعني الطرائف والنوادر . وقد نشرته : الهيئة المصرية العامة لقصور الثقافة – القاهرة – 2012 .
أ. د. محمد حسن عبدالله
* [ نشرت في مجلة ” عالم الفكر ” العدد 180 ( أكتوبر – ديسمبر 2019) ]
العنوان في التراث العربي - محمد حسن عبدالله
العنوان في التراث العربي منظور تأسيسي في تأصيل ظاهرة العنونة بالأسماء في التراث العربي ودلالتها ال
 prof-mohamedhassan.com
prof-mohamedhassan.com