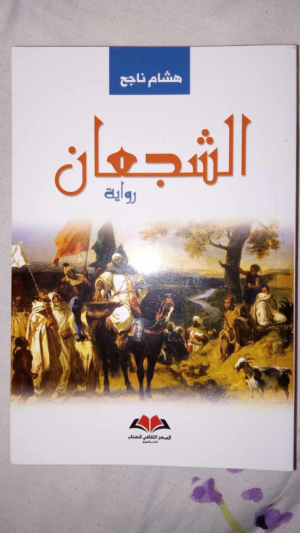بغداد ـ «القدس العربي» ـ من صفاء ذياب:
منذ أن أصدر «شخص حزين يستطيع الضحك»، انتبه القراء والمهتمون بالقصة القصيرة لكاتب اسمه صابر رشدي، هذا القاص الذي ينشر هنا وهناك، غير أنه لم يأبه بجمع نصوصه في كتاب يمكن أن يقرأ كاملاً ويدرس، نجاح مجموعته الأولى دفع الناشر لإصدار مجموعة قصصية ثانية «الرجل القادم من الجنة»، فضلاً عن إصداره لطبعة ثانية من المجموعة الأولى.
يسعى رشدي لتقديم نصوصه بلغة بسيطة، لكنها عميقة في الوقت نفسه، فضلاً عن موضوعاته التي يستمدها من واقعيته التي يعيش فيها، رافضاً التحليق بعيداً عن هموم الناس والشارع اللذين ينتمي إليهما.. هكذا تراه يسرد لنا حيواتنا، بطرائق متقنة وأسلوب شيّق.
■ سنوات طويلة كنت عازفاً عن النشر، على الرغم من متابعتك للوسط الثقافي وحياتك في داخله، لماذا كل هذا الابتعاد؟ ما الذي تغير لتقرر بعدها إصدار مجموعتين خلال مدة قصيرة؟
□ التهيب، نعم، فثمة رهبة شديدة وحالة من القداسة يضفيان ظلالهما على الفعل الإبداعي. لا أتصور أن هذا الأمر بتلك البساطة، أن يلتقط المرء قلماً، أو يضرب على أزرار الكيبورد, كى ينشئ نصاً. فهناك شخصيات تقارب حد الأسطورة مارست هذا الفعل من قبل، هوميروس، أسخيلوس، يوربيدس، شكسبير، سيرفانتس، فوكنر، ديستويفسكي، تولستوي، فرجينيا وولف، كافكا، نجيب محفوظ، كونديرا…أين نحن من هؤلاء؟
لا بد من الاستعداد الجيد، وعدم المغامرة، أو عدم التبجح- إن شئت الدقة- فأنت هنا تنضم إلى مسيرة العقول الفذة، المتفوقين من البشر، فلا يصح الإساءة إليهم. يجب الإضافة إلى هذا المنجز الإنساني أو الجلوس في مقاعد القراء، مستهلكي الثقافة، وهذا شيء عظيم أيضاً ويدعو إلى التقدير. أما إصدار مجموعتين خلال فترة قصيرة، فقد جاء تحت ضغط نظرات أبنائي، إنهم يكبرون، والمكتبة تتضخم، تتكدس بالكتب، ولا يوجد بين الرفوف مجلد واحد يحمل اسمي، كانوا يحلمون بكتاب لي يجاورهذه الكتب. لابد من عمل.. في لحظة فريدة، قررت مراجعة نفسي، كان الأمر أكثر بساطة مما تصورت، قمت بتجميع مجموعة من القصص التي نشرت لي، وأضفت لها مجموعة أخرى لم تر النور، كانت حبيسة الأدراج، محافظاً على وحدة االنصوص، الأسلوب والأجواء النفسية، ربما أيضاً المقام الموسيقي الذي يربط تناغمها. هذا عن «شخص حزين يستطيع الضحك». في ما يخص «الرجل القادم من الجنة» كان هناك فيض نوراني وروحاني وراء كتابة هذه النصوص «البينية»، حالة من الصفاء الذهني التام، تركت نفسي مشدوداً ومتلقياً لها، محلقاً في رحابها. عام كامل، أطاوع القلم، مخدراً ومنذهلاً، نص وراء الآخر، حتى اكتملت هذه التجربة الفريدة بعدما استنفدتني تماماً، ولكنها قدمتني إلى جميع الأصدقاء في الوطن العربي، وجعلت كثيرين يتفضلون عليّ بإعادة نشرها على المواقع والصفحات والمطبوعات الورقية، محسنين الظن في جودتها، كما طلب أكثر من ناشر طباعتها، عندما رأى كمَّ التفاعل معها.
■ اتجه أغلب القصاصين لكتابة الرواية، وكان بعضهم راكضاً خلف الجوائز، ليس الرواية بوصفها فناً سردياً، لكنك ما زلت مصراً على أن القصة القصيرة عالم أكثر اتساعاً، وتستوعب أحوال البشر. إلى أي مدى تتمكن القصة من التعبير عما يريده الكاتب دون غيرها من الفنون الأدبية، الشعرية أو السردية؟
□ بجملة واحدة، تستطيع القول إن القصة القصيرة هي (لعبة المحترفين) الفن الأكثر صعوبة، الذي تتكسر على أعتابه كثير من الأسماء، إذا لم تولِ هذا الأمر عناية فائقة، أنظر إلى عدد الكتاب الكبار في هذا المضمار عربياً وعالمياً، عدد محدود بلا شك، بإمكانك إحصاؤهم بسهولة. على الجانب الآخر، كم يستغرق الوقت كي تحصي عدد الروائيين؟ لكن، هناك فارق يجب الانتباه إليه: من يكتبون قصة جيدة هم روائيون كبار، والعكس قد لا يكون صحيحاً، أنظر إلى همنغواي، ماركيز، بنديتيي، كورتاثر، بوتزاتي، لوكليزيو. نعم، الجوائز جرت حشوداً هائلة تجاه الرواية، سعياً وراء الجوائز، والمنح السخية المرصودة لهذا الفن الجميل طبعاً، لكن هناك أسباباً أخرى، قد يكون من بينها صعوبة بناء قصة قصيرة على نحو جيد، ففرص الإخفاق في إنشائها عامل لا يقل أهمية، التعقيدات الفنية، مهارة الحذف، والعمل بميزان الذهب، أدوات لا تتوافر بسهولة لدى البعض، إنها «موهبة المتمردين» كما وصفتها منذ فترة، الذين لا يعرفون السأم أو الضجر أثناء الكتابة، ولا يسعون وراء شهرة زائفة، إنهم كأصحاب المهن اليدوية الدقيقة، لا مجال أمامهم للفشل. في إمكانك تعويض كل عيوب الرواية.. فصل ضعيف، يقوم فصل آخر بستره والمداراة عليه، ما يقع منك هنا، تجده هناك، في صفحات أخرى، أيضاً، كل الأبواب مفتوحة، الناشرون يفضلون الرواية، إنها الكلمة السحرية التي تزيل كل العقبات، لا يهم المستوى الفني والتقـــــني، فهي سوق باذخة تجزل العطاء، وتراكم خيباتنا الروائية… القصة القصيرة، أكثر حميمية، تخترق بها كل الحجب.
■ تسعى دائما لتقديم نصوصك بلغة بسيطة وعميقة في الوقت ذاته، وهو ما أشرت إليه كونك تلميذاً للمدرسة الروسية وأمريكا اللاتينية لتخرج من خلاله بفن قصصي مصري، يقترب إلى حد بعيد من الواقعية «الحكواتية» إلى أين تريد أن تمضي بقصصك؟ وكيف تمكنت من التعلم على يد مدرستين مختلفتين تماماً؟
□ البساطة والعمق! إنهما أمنية كل مبدع حقيقي، أن يلمس أعقد الأمور وأكثرها إيغالاً في الغامض والميتافيزيقي والفانتازي، ثم يكون في النهاية مقروءاً وناجزاً، لقد فعلها سوفوكليس، الأب الروحي لهذه الأشياء الجميلة، تناول الأسطورة، وصراع الآلهة مع البشر، الأقدار المأساوية الملغزة، الجرائم الإنسانية الكبرى، قتل الأب، معاشرة الأم، الأحاجي، الحبكة البوليسية، الإثارة، التشويق، المتعة الفنية الخالصة، لقد استعان بكل شيء فوق هذه الأرض، والعبورالآمن بتلك البساطة الآسرة والأكثر عمقاً في تاريخ الأدب، عبر رائعته «أوديب». العمق لا يجيء مطيعاً… إنه نتاج أكوام من الكتب مقبلة من كل العصور، من كل الثقافات، من التأملات، واصطياد الأفكار الشاردة، هبة العين البصيرة التي تخترق الحجب، هبة الخبرة والمهارة، أما البساطة فهي خديعة الكاتب، ولعبته الماكرة لاصطياد قارئه. نحن أبناء الحكايات والأساطير، جلسات النميمة، والموروث الشفاهي، الثرثرات التي لا تنقطع. لدى كل مصري ألف رواية، تحمل كل العناصر المتعارف عليها، وتتكئ على محاور درامية لا تنتهي. تقول الكاتبة الإنكليزية هيلاري مانتل الحاصلة على أكثر من بوكر «معضلتي ليست الأفكار، معضلتي هي الوقت». لا نستطيع الإلمام بجانب واحد من الحياة في مصر، الحكايات كثيرة جداً، والحوادث في حالة سيولة، في كل لحظة حدث كبير، الأهم، كيفية التقاط الخيوط والتفاصيل، الأكثر أهمية هو شق مسار يبتعد بك عن الزحام الشديد، عن المألوف، والمكرر، عما تتوقع حضوره وعيناك تجري فوق السطور، إنها مهمة صعبة، تحتاج إلى إدراك ووعي وتركيز مكثف.
الأدب الروسي، هو أدب التأسيس، الأكثر عمقاً، وملامسة للروح، استطاع عظماء هذا الأدب: ديستويفسكي، تولستوي، تورجنيف، تيشخوف إعادة كتابة تاريخ النفس الإنسانية على نحو جديد، عبر المواطن الروسي، والروح السلافية، استبطان الداخل، وأنسنة أخطاء البشر، والتحريض على رفض الظلم، تثوير العامة، رصد كل مناحي التحلل والتفسخ داخل المجتمع، لقد علمونا البكاء والحزن، وزرعوا الأسى في داخلنا، مخلفين جراحاً لا تندمل، كان لي الحظ في التهام جل أعمالهم، حتى التشبع، ربما ورثت عنهم هذه الشفقة، على شخوصي، أحياناً كنت أكتب والدموع تفر من عينيّ حزناً على أحد أبطالي، حدث ذلك حقيقة. أقرأ «فقراء» ديستويفسكي، أو «الجريمة والعقاب» أو «مذلون مهانون»… أقرا «المغفلة» لتشيكوف أو «موت موظف» أو «الحوذي»… هناك تضامن واضح، وعدم حيادية، كتابة بمشاعر رحيمة، دون أن تفقد وهج الإبداع، أو تفسد النص.. يا سيدي: هؤلاء أنبياء، نادوا بالعدالة والمساواة وتحريرالعبـــيد وبشروا بالثورة، واحترام البشر.
المدرسة الأخرى التي أخذت مني وقتاً مساوياً، أمريكا اللاتينية. هؤلاء سحرة، لاعبون مهرة، مدركون تماماً لظرفهم التاريخي، يكتبون وفي أذهانهم عاملان: التفوق على آداب العالم، والنهوض بالقارة التعسة، وتخليصها من الديكتاتوريات المشينة، والجنرالات الفسدة، وقد نجحوا بامتياز في الأمرين، نحن الأقرب لهم سياسياً، ولكن ماذا فعل المبدع العربي، هل خاض غمار هذه المجابهات السردية؟ أشك.
■ في شهادة لك، قلت إن السرد لا يحل مشكلة، ولكنه يفعل ما هو أكثر، إنه يحقق إنسانيتنا، ويؤكد انتماءنا إلى هذه الأرض… لماذا السرد تحديدا؟ وكيف يفعل ذلك؟
□ عندما تلتقط القلم لتخط فوق الورق قصة، رواية، مذكرات، رسالة، اعترافات، شهادة أدبية، سيرة ذاتية. فأنت هنا خاضع لهذا المصطلح المبهر: السرد. السرد شيء مدهش، يسعدك في المقام الأول وأنت تمارسه، لن تصبح أنت أنت، ستكون واحداً من هؤلاء الإستثنائين، مواطن غير عادي، سيمتد بك الأجل طويلاً، ستعمر سيرتك أكثر من أصدقائك الذين لم يحترفوا الكتابة، السرد ينتج ذرية أخرى تحمل اسمك، وتحقق إنسانيتك، قد تشير قصة إلى وجودك على هذه الأرض، ربما بعد ألف عام. هل تعرف أبناء سيرفانتس، فوكنر، ماركيز؟ لا.. لكنك حتماً تعرف دون كيخوتة، دي لامانشا، وبينجي، والجنرال بوين ديا، وخوسيه أركاديو… النصوص ستؤدي إليك في نهاية الأمر، وتحفظ هويتك من الضياع. السرد لا يحل مشكلة، ولكنه يشير إليها ويحدد مخاطرها، يطرح الأسئلة، ويثير العواطف، ويتنبأ أحياناً، ويحفظ تواريخنا من الفناء والتبدد. لن تفهم تاريخ مصر المعاصر إلا عن طريق نجيب محفوظ ويوسف إدريس ورفاقهما. ما الذي كان يحدث في اليونان أول القرن الماضي، سيجيبك كانتزاكيس، وسروده الرفيعة.
السرد هبة الله للبشرية، لهؤلاء الذين استطاعوا تحدي القوة المطلقة للنظم الفاسدة، ورصدوا كل التحولات، الانتصارات والهزائم، الخيبات وأيام المجد، الانكسارات والنهوض، الاضطرابات والهدوء. السرد لم يترك شيئاً إلا وأتى به إلى الأدب.
■ على الرغم من إعلانك هروبك من السياسة غير أن مجموعتك «شخص حزين يستطيع الضحك» تحفر في أرض سياسية غير معلنة، ابتداءً من العنوان، وليس انتهاء بنصوصها… كيف يمكن للكاتب أن يخلع عنه ثوب الأيديولوجيا؟ وهل هذا ممكن؟
□ هذا حقيقي. واقعي جداً أن تكون سياسياً، مستغرقا بكاملك في مستنقع السياسة، هذا الماخور العفن، لا أحد يستطيع الهروب منه كلياً، فنحن أبناء أكثر المناطق خطورة على هذا الكوكب، الشرق الأوسط، برميل البارود والبترول، والديكتاتوريات البغيضة، الفساد، التعصب، الحروب التي لا تنتهي. نعم لا تستطيع الهروب بسهولة، ولكنه انسحاب جزئي حتى لا ينفطر قلبك وتفقد السيطرة على انفعالاتك وقراراتك ووقتك وإبداعك. إذا كان هناك ثائر داخلك فليمارس دوره على الورق. الاستغراق الكلي قد يصيب المرء بالإحباط أو الجنون، أو كلاهما، منقذفاً خارج الدائرة.
الأدب أكثر جمالاً، شكل متسام من الحياة، يستبطن كل ما بداخلك، المضمر والمطمور في اللاوعي واللاشعور. ستقع في النهاية أسيراً لكمائنه مهما تظاهرت بالابتعاد. لم أرتدِ يوماً ثوب الأيديولوجيا، كنت أسعى وراء الحقيقة دائماً، فلتأت من أي مصدر، سأتبعها حتماً. الكاتب تعيقه الأيديولوجيا، وربما تصل بنصه إلى طريق مسدود، كما حدث مع كتاب الواقعية الاشتراكية الذين قضوا على أمجاد الأدب الروسي العظيم وأوقفوا تطوره وخطه التصاعدي. لكم هذا لا يمنع من تبني وجهة نظر معينة حيال كثير من الأمور والأحداث، واتخاذ مواقف محددة، قد تكون صائبة أو غير صائبة، ولكني لا ألجأ إلى الصمت، في نهاية الأمر، المبدع باقٍ، والسياسيون سيذهبون إلى الجحيم.
■ بعد هاتين المجموعتين في القصة القصيرة، ما الذي تعمل عليه، وما المغاير الذي ستقدمه في المقبل من الأيام؟
□ أعمل الآن على كتابين مختلفين، ولكن تجمعهما فضيلة السرد: متتالية قصصية، دعني أبوح بها للورق، سعيداً ومستمتعاً بكتابتها، فهي عالم آخر أمضي فيه متهيباً، فثمة منافسون أقوياء سبقوني إليه، وتركوا فيه بصمات قوية تمثل تحدياً شرساً وعنيداً، على رأسهم المؤلف المجهول لـ«ألف ليلة وليلة»، هذا العمل الإنساني الخالد، عوالم اخترقها بعد ذلك بورخس الأسطوري وماركيز، وإيتالو كالفينو. العمل الآخر، الذي قارب على الانتهاء، هو مجموعة بورتريهات عن الوجوه والملامح والحياة الثقافية في مصر، الحكايات السرية، اللحظات المنسية، وإنقاذ الغائبين من الدخول في النسيان. مجهود كتابة بورتريه يعادل مجهود كتابة قصة، ربما أكثر. لا أبالغ إن قلت إن بعض هذه البورتريهات كانت بمثابة قبلة الحياة التي أعادت البعض إلى النور مرة أخرى. على أي حال، هي كتابة قائمة على المحبة في المقام الأول، فأنا لا أكتب عن شخص أكرهه، أو شخص سيكافئني أو يوفر لي فرصة في عالم الأدب من خلال موقعه. أكتب عن الموتى والأحياء المنسيين والمهدرة حقوقهم، لأستقطب الاهتمام بهم. فليمنحنا رب الكلمات فيضا من محبته.
منذ أن أصدر «شخص حزين يستطيع الضحك»، انتبه القراء والمهتمون بالقصة القصيرة لكاتب اسمه صابر رشدي، هذا القاص الذي ينشر هنا وهناك، غير أنه لم يأبه بجمع نصوصه في كتاب يمكن أن يقرأ كاملاً ويدرس، نجاح مجموعته الأولى دفع الناشر لإصدار مجموعة قصصية ثانية «الرجل القادم من الجنة»، فضلاً عن إصداره لطبعة ثانية من المجموعة الأولى.
يسعى رشدي لتقديم نصوصه بلغة بسيطة، لكنها عميقة في الوقت نفسه، فضلاً عن موضوعاته التي يستمدها من واقعيته التي يعيش فيها، رافضاً التحليق بعيداً عن هموم الناس والشارع اللذين ينتمي إليهما.. هكذا تراه يسرد لنا حيواتنا، بطرائق متقنة وأسلوب شيّق.
■ سنوات طويلة كنت عازفاً عن النشر، على الرغم من متابعتك للوسط الثقافي وحياتك في داخله، لماذا كل هذا الابتعاد؟ ما الذي تغير لتقرر بعدها إصدار مجموعتين خلال مدة قصيرة؟
□ التهيب، نعم، فثمة رهبة شديدة وحالة من القداسة يضفيان ظلالهما على الفعل الإبداعي. لا أتصور أن هذا الأمر بتلك البساطة، أن يلتقط المرء قلماً، أو يضرب على أزرار الكيبورد, كى ينشئ نصاً. فهناك شخصيات تقارب حد الأسطورة مارست هذا الفعل من قبل، هوميروس، أسخيلوس، يوربيدس، شكسبير، سيرفانتس، فوكنر، ديستويفسكي، تولستوي، فرجينيا وولف، كافكا، نجيب محفوظ، كونديرا…أين نحن من هؤلاء؟
لا بد من الاستعداد الجيد، وعدم المغامرة، أو عدم التبجح- إن شئت الدقة- فأنت هنا تنضم إلى مسيرة العقول الفذة، المتفوقين من البشر، فلا يصح الإساءة إليهم. يجب الإضافة إلى هذا المنجز الإنساني أو الجلوس في مقاعد القراء، مستهلكي الثقافة، وهذا شيء عظيم أيضاً ويدعو إلى التقدير. أما إصدار مجموعتين خلال فترة قصيرة، فقد جاء تحت ضغط نظرات أبنائي، إنهم يكبرون، والمكتبة تتضخم، تتكدس بالكتب، ولا يوجد بين الرفوف مجلد واحد يحمل اسمي، كانوا يحلمون بكتاب لي يجاورهذه الكتب. لابد من عمل.. في لحظة فريدة، قررت مراجعة نفسي، كان الأمر أكثر بساطة مما تصورت، قمت بتجميع مجموعة من القصص التي نشرت لي، وأضفت لها مجموعة أخرى لم تر النور، كانت حبيسة الأدراج، محافظاً على وحدة االنصوص، الأسلوب والأجواء النفسية، ربما أيضاً المقام الموسيقي الذي يربط تناغمها. هذا عن «شخص حزين يستطيع الضحك». في ما يخص «الرجل القادم من الجنة» كان هناك فيض نوراني وروحاني وراء كتابة هذه النصوص «البينية»، حالة من الصفاء الذهني التام، تركت نفسي مشدوداً ومتلقياً لها، محلقاً في رحابها. عام كامل، أطاوع القلم، مخدراً ومنذهلاً، نص وراء الآخر، حتى اكتملت هذه التجربة الفريدة بعدما استنفدتني تماماً، ولكنها قدمتني إلى جميع الأصدقاء في الوطن العربي، وجعلت كثيرين يتفضلون عليّ بإعادة نشرها على المواقع والصفحات والمطبوعات الورقية، محسنين الظن في جودتها، كما طلب أكثر من ناشر طباعتها، عندما رأى كمَّ التفاعل معها.
■ اتجه أغلب القصاصين لكتابة الرواية، وكان بعضهم راكضاً خلف الجوائز، ليس الرواية بوصفها فناً سردياً، لكنك ما زلت مصراً على أن القصة القصيرة عالم أكثر اتساعاً، وتستوعب أحوال البشر. إلى أي مدى تتمكن القصة من التعبير عما يريده الكاتب دون غيرها من الفنون الأدبية، الشعرية أو السردية؟
□ بجملة واحدة، تستطيع القول إن القصة القصيرة هي (لعبة المحترفين) الفن الأكثر صعوبة، الذي تتكسر على أعتابه كثير من الأسماء، إذا لم تولِ هذا الأمر عناية فائقة، أنظر إلى عدد الكتاب الكبار في هذا المضمار عربياً وعالمياً، عدد محدود بلا شك، بإمكانك إحصاؤهم بسهولة. على الجانب الآخر، كم يستغرق الوقت كي تحصي عدد الروائيين؟ لكن، هناك فارق يجب الانتباه إليه: من يكتبون قصة جيدة هم روائيون كبار، والعكس قد لا يكون صحيحاً، أنظر إلى همنغواي، ماركيز، بنديتيي، كورتاثر، بوتزاتي، لوكليزيو. نعم، الجوائز جرت حشوداً هائلة تجاه الرواية، سعياً وراء الجوائز، والمنح السخية المرصودة لهذا الفن الجميل طبعاً، لكن هناك أسباباً أخرى، قد يكون من بينها صعوبة بناء قصة قصيرة على نحو جيد، ففرص الإخفاق في إنشائها عامل لا يقل أهمية، التعقيدات الفنية، مهارة الحذف، والعمل بميزان الذهب، أدوات لا تتوافر بسهولة لدى البعض، إنها «موهبة المتمردين» كما وصفتها منذ فترة، الذين لا يعرفون السأم أو الضجر أثناء الكتابة، ولا يسعون وراء شهرة زائفة، إنهم كأصحاب المهن اليدوية الدقيقة، لا مجال أمامهم للفشل. في إمكانك تعويض كل عيوب الرواية.. فصل ضعيف، يقوم فصل آخر بستره والمداراة عليه، ما يقع منك هنا، تجده هناك، في صفحات أخرى، أيضاً، كل الأبواب مفتوحة، الناشرون يفضلون الرواية، إنها الكلمة السحرية التي تزيل كل العقبات، لا يهم المستوى الفني والتقـــــني، فهي سوق باذخة تجزل العطاء، وتراكم خيباتنا الروائية… القصة القصيرة، أكثر حميمية، تخترق بها كل الحجب.
■ تسعى دائما لتقديم نصوصك بلغة بسيطة وعميقة في الوقت ذاته، وهو ما أشرت إليه كونك تلميذاً للمدرسة الروسية وأمريكا اللاتينية لتخرج من خلاله بفن قصصي مصري، يقترب إلى حد بعيد من الواقعية «الحكواتية» إلى أين تريد أن تمضي بقصصك؟ وكيف تمكنت من التعلم على يد مدرستين مختلفتين تماماً؟
□ البساطة والعمق! إنهما أمنية كل مبدع حقيقي، أن يلمس أعقد الأمور وأكثرها إيغالاً في الغامض والميتافيزيقي والفانتازي، ثم يكون في النهاية مقروءاً وناجزاً، لقد فعلها سوفوكليس، الأب الروحي لهذه الأشياء الجميلة، تناول الأسطورة، وصراع الآلهة مع البشر، الأقدار المأساوية الملغزة، الجرائم الإنسانية الكبرى، قتل الأب، معاشرة الأم، الأحاجي، الحبكة البوليسية، الإثارة، التشويق، المتعة الفنية الخالصة، لقد استعان بكل شيء فوق هذه الأرض، والعبورالآمن بتلك البساطة الآسرة والأكثر عمقاً في تاريخ الأدب، عبر رائعته «أوديب». العمق لا يجيء مطيعاً… إنه نتاج أكوام من الكتب مقبلة من كل العصور، من كل الثقافات، من التأملات، واصطياد الأفكار الشاردة، هبة العين البصيرة التي تخترق الحجب، هبة الخبرة والمهارة، أما البساطة فهي خديعة الكاتب، ولعبته الماكرة لاصطياد قارئه. نحن أبناء الحكايات والأساطير، جلسات النميمة، والموروث الشفاهي، الثرثرات التي لا تنقطع. لدى كل مصري ألف رواية، تحمل كل العناصر المتعارف عليها، وتتكئ على محاور درامية لا تنتهي. تقول الكاتبة الإنكليزية هيلاري مانتل الحاصلة على أكثر من بوكر «معضلتي ليست الأفكار، معضلتي هي الوقت». لا نستطيع الإلمام بجانب واحد من الحياة في مصر، الحكايات كثيرة جداً، والحوادث في حالة سيولة، في كل لحظة حدث كبير، الأهم، كيفية التقاط الخيوط والتفاصيل، الأكثر أهمية هو شق مسار يبتعد بك عن الزحام الشديد، عن المألوف، والمكرر، عما تتوقع حضوره وعيناك تجري فوق السطور، إنها مهمة صعبة، تحتاج إلى إدراك ووعي وتركيز مكثف.
الأدب الروسي، هو أدب التأسيس، الأكثر عمقاً، وملامسة للروح، استطاع عظماء هذا الأدب: ديستويفسكي، تولستوي، تورجنيف، تيشخوف إعادة كتابة تاريخ النفس الإنسانية على نحو جديد، عبر المواطن الروسي، والروح السلافية، استبطان الداخل، وأنسنة أخطاء البشر، والتحريض على رفض الظلم، تثوير العامة، رصد كل مناحي التحلل والتفسخ داخل المجتمع، لقد علمونا البكاء والحزن، وزرعوا الأسى في داخلنا، مخلفين جراحاً لا تندمل، كان لي الحظ في التهام جل أعمالهم، حتى التشبع، ربما ورثت عنهم هذه الشفقة، على شخوصي، أحياناً كنت أكتب والدموع تفر من عينيّ حزناً على أحد أبطالي، حدث ذلك حقيقة. أقرأ «فقراء» ديستويفسكي، أو «الجريمة والعقاب» أو «مذلون مهانون»… أقرا «المغفلة» لتشيكوف أو «موت موظف» أو «الحوذي»… هناك تضامن واضح، وعدم حيادية، كتابة بمشاعر رحيمة، دون أن تفقد وهج الإبداع، أو تفسد النص.. يا سيدي: هؤلاء أنبياء، نادوا بالعدالة والمساواة وتحريرالعبـــيد وبشروا بالثورة، واحترام البشر.
المدرسة الأخرى التي أخذت مني وقتاً مساوياً، أمريكا اللاتينية. هؤلاء سحرة، لاعبون مهرة، مدركون تماماً لظرفهم التاريخي، يكتبون وفي أذهانهم عاملان: التفوق على آداب العالم، والنهوض بالقارة التعسة، وتخليصها من الديكتاتوريات المشينة، والجنرالات الفسدة، وقد نجحوا بامتياز في الأمرين، نحن الأقرب لهم سياسياً، ولكن ماذا فعل المبدع العربي، هل خاض غمار هذه المجابهات السردية؟ أشك.
■ في شهادة لك، قلت إن السرد لا يحل مشكلة، ولكنه يفعل ما هو أكثر، إنه يحقق إنسانيتنا، ويؤكد انتماءنا إلى هذه الأرض… لماذا السرد تحديدا؟ وكيف يفعل ذلك؟
□ عندما تلتقط القلم لتخط فوق الورق قصة، رواية، مذكرات، رسالة، اعترافات، شهادة أدبية، سيرة ذاتية. فأنت هنا خاضع لهذا المصطلح المبهر: السرد. السرد شيء مدهش، يسعدك في المقام الأول وأنت تمارسه، لن تصبح أنت أنت، ستكون واحداً من هؤلاء الإستثنائين، مواطن غير عادي، سيمتد بك الأجل طويلاً، ستعمر سيرتك أكثر من أصدقائك الذين لم يحترفوا الكتابة، السرد ينتج ذرية أخرى تحمل اسمك، وتحقق إنسانيتك، قد تشير قصة إلى وجودك على هذه الأرض، ربما بعد ألف عام. هل تعرف أبناء سيرفانتس، فوكنر، ماركيز؟ لا.. لكنك حتماً تعرف دون كيخوتة، دي لامانشا، وبينجي، والجنرال بوين ديا، وخوسيه أركاديو… النصوص ستؤدي إليك في نهاية الأمر، وتحفظ هويتك من الضياع. السرد لا يحل مشكلة، ولكنه يشير إليها ويحدد مخاطرها، يطرح الأسئلة، ويثير العواطف، ويتنبأ أحياناً، ويحفظ تواريخنا من الفناء والتبدد. لن تفهم تاريخ مصر المعاصر إلا عن طريق نجيب محفوظ ويوسف إدريس ورفاقهما. ما الذي كان يحدث في اليونان أول القرن الماضي، سيجيبك كانتزاكيس، وسروده الرفيعة.
السرد هبة الله للبشرية، لهؤلاء الذين استطاعوا تحدي القوة المطلقة للنظم الفاسدة، ورصدوا كل التحولات، الانتصارات والهزائم، الخيبات وأيام المجد، الانكسارات والنهوض، الاضطرابات والهدوء. السرد لم يترك شيئاً إلا وأتى به إلى الأدب.
■ على الرغم من إعلانك هروبك من السياسة غير أن مجموعتك «شخص حزين يستطيع الضحك» تحفر في أرض سياسية غير معلنة، ابتداءً من العنوان، وليس انتهاء بنصوصها… كيف يمكن للكاتب أن يخلع عنه ثوب الأيديولوجيا؟ وهل هذا ممكن؟
□ هذا حقيقي. واقعي جداً أن تكون سياسياً، مستغرقا بكاملك في مستنقع السياسة، هذا الماخور العفن، لا أحد يستطيع الهروب منه كلياً، فنحن أبناء أكثر المناطق خطورة على هذا الكوكب، الشرق الأوسط، برميل البارود والبترول، والديكتاتوريات البغيضة، الفساد، التعصب، الحروب التي لا تنتهي. نعم لا تستطيع الهروب بسهولة، ولكنه انسحاب جزئي حتى لا ينفطر قلبك وتفقد السيطرة على انفعالاتك وقراراتك ووقتك وإبداعك. إذا كان هناك ثائر داخلك فليمارس دوره على الورق. الاستغراق الكلي قد يصيب المرء بالإحباط أو الجنون، أو كلاهما، منقذفاً خارج الدائرة.
الأدب أكثر جمالاً، شكل متسام من الحياة، يستبطن كل ما بداخلك، المضمر والمطمور في اللاوعي واللاشعور. ستقع في النهاية أسيراً لكمائنه مهما تظاهرت بالابتعاد. لم أرتدِ يوماً ثوب الأيديولوجيا، كنت أسعى وراء الحقيقة دائماً، فلتأت من أي مصدر، سأتبعها حتماً. الكاتب تعيقه الأيديولوجيا، وربما تصل بنصه إلى طريق مسدود، كما حدث مع كتاب الواقعية الاشتراكية الذين قضوا على أمجاد الأدب الروسي العظيم وأوقفوا تطوره وخطه التصاعدي. لكم هذا لا يمنع من تبني وجهة نظر معينة حيال كثير من الأمور والأحداث، واتخاذ مواقف محددة، قد تكون صائبة أو غير صائبة، ولكني لا ألجأ إلى الصمت، في نهاية الأمر، المبدع باقٍ، والسياسيون سيذهبون إلى الجحيم.
■ بعد هاتين المجموعتين في القصة القصيرة، ما الذي تعمل عليه، وما المغاير الذي ستقدمه في المقبل من الأيام؟
□ أعمل الآن على كتابين مختلفين، ولكن تجمعهما فضيلة السرد: متتالية قصصية، دعني أبوح بها للورق، سعيداً ومستمتعاً بكتابتها، فهي عالم آخر أمضي فيه متهيباً، فثمة منافسون أقوياء سبقوني إليه، وتركوا فيه بصمات قوية تمثل تحدياً شرساً وعنيداً، على رأسهم المؤلف المجهول لـ«ألف ليلة وليلة»، هذا العمل الإنساني الخالد، عوالم اخترقها بعد ذلك بورخس الأسطوري وماركيز، وإيتالو كالفينو. العمل الآخر، الذي قارب على الانتهاء، هو مجموعة بورتريهات عن الوجوه والملامح والحياة الثقافية في مصر، الحكايات السرية، اللحظات المنسية، وإنقاذ الغائبين من الدخول في النسيان. مجهود كتابة بورتريه يعادل مجهود كتابة قصة، ربما أكثر. لا أبالغ إن قلت إن بعض هذه البورتريهات كانت بمثابة قبلة الحياة التي أعادت البعض إلى النور مرة أخرى. على أي حال، هي كتابة قائمة على المحبة في المقام الأول، فأنا لا أكتب عن شخص أكرهه، أو شخص سيكافئني أو يوفر لي فرصة في عالم الأدب من خلال موقعه. أكتب عن الموتى والأحياء المنسيين والمهدرة حقوقهم، لأستقطب الاهتمام بهم. فليمنحنا رب الكلمات فيضا من محبته.