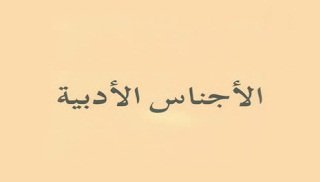المَوصِل - أمُ الرَبيعَّين (1)
المدن والحواضر الكبرى، عناوين تاريخ؛ حاضر يحمله الأمس على كتفيّه، وغدٍ يكبر في أحشاء البنايات والأشجار، سحب ورائحة مطر ممزوج بتراب الدروب العتيقة. تشهد عليها أزقتها الملتوية، ميادينها الفسيحة، أطفالها، شيوخها، نساؤها تنسجن من تجاعيد وجوههن خيمةً يستظل تحتها الوطن.
هناك مدن وليدة لم تعدُ الفطام بعد، لا تشم لها عبقًا، لا تستشعر لها جلالًا، لم يُسَطر لها سطرًا واحدًا في كتب التاريخ، مدن بلاستيكية، ليس لها رائحة، رغم ألوانها الزاهية!
على الجانب الآخر؛ هناك مدن يعبر تاريخها حاجز الألف عام وأكثر، حفظها الزمان فلم تنمحِ، عاشت راسخة، يملؤها التاريخ شموخًا وزهوًا، سحرها وأصالتها وصمودها لمصائب الدهر يبعث على الفخر.
ربما قضت الحروب والصراعات، أو الكوارث الطبيعية، على بعضها، لكن الإنسان الذي قام بتشييدها، قادر على أن يعيدها سيرتها الأولى، كأن شيئًا لم يكن!
باريس، برلين، هيروشيما وناجازاكي؛ مدنٌ تم محوها، لكن الشعوب القادرة على كتابة التاريخ، أعادوا الحياة إلى مدنهم الزائلة. منحوها ما تميزت به من طبائع عمرانية، استخدموا الصور والأفلام التسجيلية والوثائق، كي ترجع تنهض المدينة من جديد، مدينة متفردة، باقية رغم أنف الموت وقنابل الأعداء.
شاهدت منذ أيام مدينة الموصل العراقية، صاحبة الأسماء الكثر، نذكر منها الأيسر والأكثر شيوعًا:
المَوْصِل هي البيضاء، الخضراء، أم الرَبيعَين، أم العُلا، أم الرِمَاح، أم الحِصْنَين، أم القِلاع، الحَدْبَاء، الفَيْحَاء، الزهراء، باعَرَبايا، خولان، أرض التَيَّمن، مَسْبِيَّلا، كذلك حصن عَبُورِي وأرض قديسة يوفيميا، وجنة الأرض. أسماء تحمل في طياتها جميعًا المعنى والأثر والتأصيل في كتب التاريخ!
عاشت الموصل مئات السنين، ثبتت، قاومت كر السنوات وتتابع المحن. تحملت جور الإنسان، لكنها بعد حكم داعش (الدولة الإسلامية في بلاد العراق والشام) صارت أثرًا بعد عين، شمسًا غاربة رغم فرار أبو بكر البغدادي الذي تركها أطلالًا، مدينة أشباح لا تصلح لشيء!
شاهدت ما أصاب أم الربيعين؛ غلبتني الحسرة، وطَفَتْ الذكريات إلى السطح، تداعت من الذكريات أجملها أمام عينَّي دون عائق، ذكرت الموصل فتذكرت أبي، الذي سافر إليها في منتصف سبعينيات القرن الماضي. تذكرت سنوات عشتها في رحابها، براحها، عزها وعز أبي. رأيت غاباتها، أزقتها، مآذنها، مطاعمها، مخابزها، شلالاتها، مدارسها، طلابها، دواوينها، شوارعها، محلاتها، حوانيتها، كل التفاصيل المطمورة تحت ركام أربعين عامًا!
نرجع إلى الوراء كل هذه السنوات؛ ذلك أدعى إلى السعادة دون حسرة، وإلى تجديد الذكرى دون بكاء على الأطلال. لَكَمْ بكينا حتى صار البكاء ملاذًا للرجال، ولَكَمْ ناحت النساء حتى أمسى النواح ملازمًا لهن في منطقتنا المنكوبة منذ سنوات طويلة!
في عام 1975 ترك والدي مصر متجهًا إلى العراق؛ حينئذٍ لم يكن السفر إلى العراق يحتاج إلى تأشيرة دخول، لا كفيل، لا أوراق أو تعقيدات، وطن واحد من المحيط إلى الخليج.
يكفي أن تحجز تذكرتك، ثم تسافر إلى مطار بغداد، لتجد البسمة والترحيب في انتظارك، وتلمح بعينيك في كل مكان "أمة عربية خالدة.. ذات رسالة خالدة".
ترك أبي وظيفته في مصر دون أن يُقدم طلبًا رسميًا بإجازة سنوية، أو يمنح جهة العمل استقالته! كان محاسبًا في "بنك التسليف الزراعي". لقد أيقن والدي أن الوضع في مصر، يحتاج إلى مغامرة، سَيُكتَب لها النجاح بكل تأكيد.
كانت العراق حينئذٍ تشق طريقها نحو النمو والتقدم والازدهار؛ لذلك سافر والدي رغم اعتراض جدي، فلم يكن مرحبًا بسفر ابنه الأكبر إلى بلد بعيد، يقص ابنه شريط السفر إليها، دون تجربة أو سابقة من أحد شباب العائلة، حينها لم يكن مستساغًا اغتراب الأبناء، ورحيلهم بعيدًا عن الأهل والبلد.
الموصل؛ كانت وجهة أبي، فضلها على بغداد؛ فكان من أوائل المصريين الذين استقروا فيها، ومن بعده توافد إليها آلاف المصريين، حتى بلغ عددهم خمسة ملايين مصري، فغدت شوارع العراق تبدو للسائرين كأنهم يتجولون في شوارع مصر!
لست في حاجة هنا إلى الحديث عن كفاحه، اجتهاده كي يجد عملًا مناسبًا. قص علينا والدي المثقف العظيم ما كابده من عذاب حتى استطاع الحصول على وظيفة جيدة في مدينة الموصل.
عمل والدي محاسبًا في "شركة أخشاب الشمال" كانت أكبر شركة لصناعة الأخشاب في المنطقة العربية كلها.
يعمل عامًا كاملًا، ثم يعود إلينا، يقضي إجازته السنوية معنا، شهرًا أو أكثر قليلًا، ثم يعود إلى الموصل من جديد، لكنه لم يحتمل هذا الوضع ثلاث سنوات متتابعة، فبدأ يستعد لاستدعاء أسرته، لعله ينعم معنا بدفء الأسرة.
روى لي والدي عن صديقه الذي أحبه، كيف عاشا سويًا في مسكن واحد، كيف هذا الصديق ترك الشقة وانتقل إلى أخرى حين علم بمجيئنا، وحين لم ترُق له شراكته مع زميل آخر في السكن الجديد، آثر الرحيل، فعاد إلى مصر.
عاد صديق والدي إلى مدينتنا الصغيرة، استقر مع أسرته، ثم بدأ في مزاولة مهنته التي يتقنها، خياطًا شهيرًا يملك محلًا يُعرف بـ "ترزي الأناقة".
بعدها بدأ والدي في تجهيز مسكن الموصل لاستقبالنا؛ ما زلت أذكر حكاياته، كان يواصل النهار بالليل، ليصنع بيده الأسرة وخزائن الملابس، مائدة الطعام والمقاعد، يستخدم ألواحًا من "الخشب الحبيبي"، أحد أنواع الخشب الصناعي، كان عبارة عن بقايا الخشب الناتج من التقطيع بواسطة الماكينات (نشارة الخشب)، يتم تجميع هذه النشارة وكبسها بمكابس خاصة مخلوطة بالغِراء، فتصبح ألواحًا خشبية صلبة، لكنها ليست في متانة الأخشاب الطبيعية، لذلك كانت زهيدة الثمن. يقضي والدي الليل في النجارة ثم يذهب في الصباح إلى عمله دون نومٍ.
قضى والدي شهورًا في صنع أثاث البيت وتجهيزه لنا؛ عندما حضر إلى مصر لنسافر معه، رأيت ما أصاب يداه من جروح وبقع زرقاء، نجمت عن عدم إتقانه استخدام المنشار والمطرقة.
كل ما سبق كان تفسيرًا للقادم؛ استدعاءً لذكريات أُحبُها، ربما القارئ ليس في حاجة إليها، لكنها تداعت دون قصد، استجلابًا للسعادة!
حضرنا إلى الموصل، بيت القصيد؛ عائلة من خمسة أفراد، رب أسرة مع زوجة وثلاثة أبناء.
في الموصل أعد لنا أصدقاء أبي من العراقيين، حفل استقبال بعد أسبوع، طعام وشراب وسمر، أحاديث عن السينما، أسئلة كانوا يختزنونها ليطرحوها علينا في أول لقاء! هل نقابل عادل إمام؟ هل تسكن نجلاء فتحي بالقرب من بيتنا؟ هل مرفت أمين -على حقيقتها- بكل هذا القدر من الجمال؟
تلك كانت أسئلة السيدات العراقيات من أسرتي صديقيّ والدي المقربين، شُهدي بك -أبو أحمد- مدير شركة الأخشاب، التي يعمل بها والدي، وعمي رياض صديق والدي المُقرب.
الموصل؛ مدينة عراقية بديعة، ما زلت أذكر شوارعها، أزقتها وحاراتها، كنا نسكن في أحد أهم شوارعها، شارع خالد بن الوليد. شارع فسيح، جميل، ينتهي ناحية شارع النچفي (القرطاسية) بمنظر خلاب لنهر دجلة، والأطفال يبيعون الماء البارد في صيفها شديد الحرارة، والبعض منهم ينادي على الكولا (بارد.. بارد) بخمسة وعشرين فلسًا، الدينار هناك كالجنيه، 100 فلس عراقي بدلًا من القرش. كنا في ذلك الوقت نستطيع شراء كل شيء بدينار! الصَّمُون الحَجَري بخمس فلسات، طبق من القيمر العراقي اللذيذ (قشطة)، الطازج، تجهيز بواكير الصباح، مع الكاهي (الفطير) والعسل أو دبس التمر بنصف دينار!
ما دمت قد تحدثت عن الإفطار؛ فإن للموصلي عاداته الفريدة في إفطاره، ربما لا يشبهه أحدٌ في طقوسه!
لقد اعتاد الموصليون تناول وجبة الفطور في الشوارع على العربات وفي المطاعم الشعبية؛ قرب مبنى محافظة "نينوى" نجد أشهر المطاعم الشعبية لبيع "الباچة" (لحم رأس الخرفان) كذلك "الكَراعين" (كوارع الخرفان). تبدأ المطاعم في العمل بعد منتصف الليل، حيث يتم تقطيع كميات ضخمة من البصل وتجهيز "الباچة" والكَراعين بتنظيفهم من الشعر بالحرق تقريبًا. بعدها تُغسل جيدًا، ثم توضع في قدور كبيرة الحجم ليبدأ الطهي الذي يستغرق ساعتين.
يبدأ قدوم رواد المطاعم والعربات للإفطار مع تباشير الصباح؛ يتناولون "الباچة والكَراعين" بتلذذ ونَهمٍ، حتى تصبح القدور فارغةً في غضون سويعات قليلة، فتغلق المطاعم أبوابها قرب السابعة صباحًا!
يفطر الموصليون أيضًا على الفشافيش (الفشة - الرئة) حيث توضع في أسياخ ثم تُطهى على الفحم، وكذلك التكة والكباب. العراقيون يعشقون تناول اللحوم، يعتقدون أنه يمنحهم الطاقة والصمود أمام الأشغال الصعبة، كالحدادين والبنائين وسائقي سيارات النقل الكبيرة، كما أنهم يحبون شرب العرق، المصنوع من التمور.
هذا لمَن يعشق اللحوم، من تكة وكباب وكفتة مع التمن (الأرز).
المباني والمعمار الموصلي عمومًا، وشارع خالد بن الوليد والنچفي تحديدًا، صُمما على الطراز العثماني، فنجد نظام البواكي الجميل، كما في منطقة الكوربة بمصر الجديدة، وشارع المديرية في طنطا.
هذا التصميم الرائع؛ يحجب الأمطار في الشتاء، ويوفر الظل للمارة ساعات الظهيرة، كما يُقلِل الإحساس بالرطوبة والحرارة العالية في فصل الصيف، إذ يدفع تيارات الهواء البارد لتتخلل هذه البواكي فتعمل على تلطيف الطقس.
عم سعدون البقال؛ كان صاحب محل للبقالة أسفل البناية التي نقطنها. أنزل في الصباح فأجده يضع في واجهة المحل صوانٍ كبيرة من القيمر (قشطة) خاصة، مبرومة، مبروكة، تحمل كل خيرات اللبن!
حين شاهدني لأول مرة؛ سألني أنت "علاوي" ابن أبو علاوي؟
لم يمهلنِ وقتًا كي أجيب عن سؤاله، إذ بادرني بقوله:
هلا علاوي.. إيش لونك عيني؟
كنت سعيدًا بلهجته؛ لم أفهم مراده صراحة، لكني أعدت عليه "الحمدلله" عدة مرات!
- ادلل علاوي؛ شي تريد، ريّوك؟ (ما يتريق به الإنسان - الإفطار)
- بابا بيقولك هات بنص دينار "جيمر وكاهاي"
ضحك عم سعدون بلطف، أوحت ابتسامته الرقيقة ونبرات صوته الدافئة، أنه رجل مهذب.
أعاد عم سعدون ما قلته بطريقة موصلية سليمة فقال:
"ادلل علاوي.. كَيمر وكَاهي أبو حسين"
مد يده وأخذ مني طبقًا كبيرًا، وضع فيه ألذ وأجمل قشطة جاموسي أكلتها في حياتي، لها ترميلة عجيبة، الدسم جعلها حلوة المذاق، سُكر!
قسم الكَاهي إلى قطع صغيرة مستطيلة، ثم وضعها في علاجة (كيس من البلاستيك) والكَاهي يشبه الفطير الفلاحي في مصر، مفعمٌ برائحة الزبد البلدي.
بجانب عم سعدون، كان يقف في الصباح الباكر الحاج "ليث" مع زوجته أمام عربة لبيع الباكَلَّة أو البَاقِلاء (الفول المدمس)، تُصنع الباقِلَّاء في قدور كبيرة، تمامًا كما نفعل في مصر.
يغرف "عم ليث" البَاقِلاء من القدرة، ثم يضعها في طبق مع الغراء، ثم ينقع فيه الخبز العراقي ليتشرب بالغراء، في الوقت الذي تكون زوجته قد انتهت من تجهيز البيض المقلي في الزبد العربي (البلدي) الذي يسمونه أيضًا الزبد الحر، فيناولها الطبق لتضع فوقه البيض مع قليلٍ من النعناع.
وهذا الطبق مفرط في دسامته، لهذا يحبذ العراقيون تناوله في فصل الشتاء، لأن الزبد العربي المستخدم في تجهيزه وفير، يبعث في أبدانهم الدفء.
علي حسن
المدن والحواضر الكبرى، عناوين تاريخ؛ حاضر يحمله الأمس على كتفيّه، وغدٍ يكبر في أحشاء البنايات والأشجار، سحب ورائحة مطر ممزوج بتراب الدروب العتيقة. تشهد عليها أزقتها الملتوية، ميادينها الفسيحة، أطفالها، شيوخها، نساؤها تنسجن من تجاعيد وجوههن خيمةً يستظل تحتها الوطن.
هناك مدن وليدة لم تعدُ الفطام بعد، لا تشم لها عبقًا، لا تستشعر لها جلالًا، لم يُسَطر لها سطرًا واحدًا في كتب التاريخ، مدن بلاستيكية، ليس لها رائحة، رغم ألوانها الزاهية!
على الجانب الآخر؛ هناك مدن يعبر تاريخها حاجز الألف عام وأكثر، حفظها الزمان فلم تنمحِ، عاشت راسخة، يملؤها التاريخ شموخًا وزهوًا، سحرها وأصالتها وصمودها لمصائب الدهر يبعث على الفخر.
ربما قضت الحروب والصراعات، أو الكوارث الطبيعية، على بعضها، لكن الإنسان الذي قام بتشييدها، قادر على أن يعيدها سيرتها الأولى، كأن شيئًا لم يكن!
باريس، برلين، هيروشيما وناجازاكي؛ مدنٌ تم محوها، لكن الشعوب القادرة على كتابة التاريخ، أعادوا الحياة إلى مدنهم الزائلة. منحوها ما تميزت به من طبائع عمرانية، استخدموا الصور والأفلام التسجيلية والوثائق، كي ترجع تنهض المدينة من جديد، مدينة متفردة، باقية رغم أنف الموت وقنابل الأعداء.
شاهدت منذ أيام مدينة الموصل العراقية، صاحبة الأسماء الكثر، نذكر منها الأيسر والأكثر شيوعًا:
المَوْصِل هي البيضاء، الخضراء، أم الرَبيعَين، أم العُلا، أم الرِمَاح، أم الحِصْنَين، أم القِلاع، الحَدْبَاء، الفَيْحَاء، الزهراء، باعَرَبايا، خولان، أرض التَيَّمن، مَسْبِيَّلا، كذلك حصن عَبُورِي وأرض قديسة يوفيميا، وجنة الأرض. أسماء تحمل في طياتها جميعًا المعنى والأثر والتأصيل في كتب التاريخ!
عاشت الموصل مئات السنين، ثبتت، قاومت كر السنوات وتتابع المحن. تحملت جور الإنسان، لكنها بعد حكم داعش (الدولة الإسلامية في بلاد العراق والشام) صارت أثرًا بعد عين، شمسًا غاربة رغم فرار أبو بكر البغدادي الذي تركها أطلالًا، مدينة أشباح لا تصلح لشيء!
شاهدت ما أصاب أم الربيعين؛ غلبتني الحسرة، وطَفَتْ الذكريات إلى السطح، تداعت من الذكريات أجملها أمام عينَّي دون عائق، ذكرت الموصل فتذكرت أبي، الذي سافر إليها في منتصف سبعينيات القرن الماضي. تذكرت سنوات عشتها في رحابها، براحها، عزها وعز أبي. رأيت غاباتها، أزقتها، مآذنها، مطاعمها، مخابزها، شلالاتها، مدارسها، طلابها، دواوينها، شوارعها، محلاتها، حوانيتها، كل التفاصيل المطمورة تحت ركام أربعين عامًا!
نرجع إلى الوراء كل هذه السنوات؛ ذلك أدعى إلى السعادة دون حسرة، وإلى تجديد الذكرى دون بكاء على الأطلال. لَكَمْ بكينا حتى صار البكاء ملاذًا للرجال، ولَكَمْ ناحت النساء حتى أمسى النواح ملازمًا لهن في منطقتنا المنكوبة منذ سنوات طويلة!
في عام 1975 ترك والدي مصر متجهًا إلى العراق؛ حينئذٍ لم يكن السفر إلى العراق يحتاج إلى تأشيرة دخول، لا كفيل، لا أوراق أو تعقيدات، وطن واحد من المحيط إلى الخليج.
يكفي أن تحجز تذكرتك، ثم تسافر إلى مطار بغداد، لتجد البسمة والترحيب في انتظارك، وتلمح بعينيك في كل مكان "أمة عربية خالدة.. ذات رسالة خالدة".
ترك أبي وظيفته في مصر دون أن يُقدم طلبًا رسميًا بإجازة سنوية، أو يمنح جهة العمل استقالته! كان محاسبًا في "بنك التسليف الزراعي". لقد أيقن والدي أن الوضع في مصر، يحتاج إلى مغامرة، سَيُكتَب لها النجاح بكل تأكيد.
كانت العراق حينئذٍ تشق طريقها نحو النمو والتقدم والازدهار؛ لذلك سافر والدي رغم اعتراض جدي، فلم يكن مرحبًا بسفر ابنه الأكبر إلى بلد بعيد، يقص ابنه شريط السفر إليها، دون تجربة أو سابقة من أحد شباب العائلة، حينها لم يكن مستساغًا اغتراب الأبناء، ورحيلهم بعيدًا عن الأهل والبلد.
الموصل؛ كانت وجهة أبي، فضلها على بغداد؛ فكان من أوائل المصريين الذين استقروا فيها، ومن بعده توافد إليها آلاف المصريين، حتى بلغ عددهم خمسة ملايين مصري، فغدت شوارع العراق تبدو للسائرين كأنهم يتجولون في شوارع مصر!
لست في حاجة هنا إلى الحديث عن كفاحه، اجتهاده كي يجد عملًا مناسبًا. قص علينا والدي المثقف العظيم ما كابده من عذاب حتى استطاع الحصول على وظيفة جيدة في مدينة الموصل.
عمل والدي محاسبًا في "شركة أخشاب الشمال" كانت أكبر شركة لصناعة الأخشاب في المنطقة العربية كلها.
يعمل عامًا كاملًا، ثم يعود إلينا، يقضي إجازته السنوية معنا، شهرًا أو أكثر قليلًا، ثم يعود إلى الموصل من جديد، لكنه لم يحتمل هذا الوضع ثلاث سنوات متتابعة، فبدأ يستعد لاستدعاء أسرته، لعله ينعم معنا بدفء الأسرة.
روى لي والدي عن صديقه الذي أحبه، كيف عاشا سويًا في مسكن واحد، كيف هذا الصديق ترك الشقة وانتقل إلى أخرى حين علم بمجيئنا، وحين لم ترُق له شراكته مع زميل آخر في السكن الجديد، آثر الرحيل، فعاد إلى مصر.
عاد صديق والدي إلى مدينتنا الصغيرة، استقر مع أسرته، ثم بدأ في مزاولة مهنته التي يتقنها، خياطًا شهيرًا يملك محلًا يُعرف بـ "ترزي الأناقة".
بعدها بدأ والدي في تجهيز مسكن الموصل لاستقبالنا؛ ما زلت أذكر حكاياته، كان يواصل النهار بالليل، ليصنع بيده الأسرة وخزائن الملابس، مائدة الطعام والمقاعد، يستخدم ألواحًا من "الخشب الحبيبي"، أحد أنواع الخشب الصناعي، كان عبارة عن بقايا الخشب الناتج من التقطيع بواسطة الماكينات (نشارة الخشب)، يتم تجميع هذه النشارة وكبسها بمكابس خاصة مخلوطة بالغِراء، فتصبح ألواحًا خشبية صلبة، لكنها ليست في متانة الأخشاب الطبيعية، لذلك كانت زهيدة الثمن. يقضي والدي الليل في النجارة ثم يذهب في الصباح إلى عمله دون نومٍ.
قضى والدي شهورًا في صنع أثاث البيت وتجهيزه لنا؛ عندما حضر إلى مصر لنسافر معه، رأيت ما أصاب يداه من جروح وبقع زرقاء، نجمت عن عدم إتقانه استخدام المنشار والمطرقة.
كل ما سبق كان تفسيرًا للقادم؛ استدعاءً لذكريات أُحبُها، ربما القارئ ليس في حاجة إليها، لكنها تداعت دون قصد، استجلابًا للسعادة!
حضرنا إلى الموصل، بيت القصيد؛ عائلة من خمسة أفراد، رب أسرة مع زوجة وثلاثة أبناء.
في الموصل أعد لنا أصدقاء أبي من العراقيين، حفل استقبال بعد أسبوع، طعام وشراب وسمر، أحاديث عن السينما، أسئلة كانوا يختزنونها ليطرحوها علينا في أول لقاء! هل نقابل عادل إمام؟ هل تسكن نجلاء فتحي بالقرب من بيتنا؟ هل مرفت أمين -على حقيقتها- بكل هذا القدر من الجمال؟
تلك كانت أسئلة السيدات العراقيات من أسرتي صديقيّ والدي المقربين، شُهدي بك -أبو أحمد- مدير شركة الأخشاب، التي يعمل بها والدي، وعمي رياض صديق والدي المُقرب.
الموصل؛ مدينة عراقية بديعة، ما زلت أذكر شوارعها، أزقتها وحاراتها، كنا نسكن في أحد أهم شوارعها، شارع خالد بن الوليد. شارع فسيح، جميل، ينتهي ناحية شارع النچفي (القرطاسية) بمنظر خلاب لنهر دجلة، والأطفال يبيعون الماء البارد في صيفها شديد الحرارة، والبعض منهم ينادي على الكولا (بارد.. بارد) بخمسة وعشرين فلسًا، الدينار هناك كالجنيه، 100 فلس عراقي بدلًا من القرش. كنا في ذلك الوقت نستطيع شراء كل شيء بدينار! الصَّمُون الحَجَري بخمس فلسات، طبق من القيمر العراقي اللذيذ (قشطة)، الطازج، تجهيز بواكير الصباح، مع الكاهي (الفطير) والعسل أو دبس التمر بنصف دينار!
ما دمت قد تحدثت عن الإفطار؛ فإن للموصلي عاداته الفريدة في إفطاره، ربما لا يشبهه أحدٌ في طقوسه!
لقد اعتاد الموصليون تناول وجبة الفطور في الشوارع على العربات وفي المطاعم الشعبية؛ قرب مبنى محافظة "نينوى" نجد أشهر المطاعم الشعبية لبيع "الباچة" (لحم رأس الخرفان) كذلك "الكَراعين" (كوارع الخرفان). تبدأ المطاعم في العمل بعد منتصف الليل، حيث يتم تقطيع كميات ضخمة من البصل وتجهيز "الباچة" والكَراعين بتنظيفهم من الشعر بالحرق تقريبًا. بعدها تُغسل جيدًا، ثم توضع في قدور كبيرة الحجم ليبدأ الطهي الذي يستغرق ساعتين.
يبدأ قدوم رواد المطاعم والعربات للإفطار مع تباشير الصباح؛ يتناولون "الباچة والكَراعين" بتلذذ ونَهمٍ، حتى تصبح القدور فارغةً في غضون سويعات قليلة، فتغلق المطاعم أبوابها قرب السابعة صباحًا!
يفطر الموصليون أيضًا على الفشافيش (الفشة - الرئة) حيث توضع في أسياخ ثم تُطهى على الفحم، وكذلك التكة والكباب. العراقيون يعشقون تناول اللحوم، يعتقدون أنه يمنحهم الطاقة والصمود أمام الأشغال الصعبة، كالحدادين والبنائين وسائقي سيارات النقل الكبيرة، كما أنهم يحبون شرب العرق، المصنوع من التمور.
هذا لمَن يعشق اللحوم، من تكة وكباب وكفتة مع التمن (الأرز).
المباني والمعمار الموصلي عمومًا، وشارع خالد بن الوليد والنچفي تحديدًا، صُمما على الطراز العثماني، فنجد نظام البواكي الجميل، كما في منطقة الكوربة بمصر الجديدة، وشارع المديرية في طنطا.
هذا التصميم الرائع؛ يحجب الأمطار في الشتاء، ويوفر الظل للمارة ساعات الظهيرة، كما يُقلِل الإحساس بالرطوبة والحرارة العالية في فصل الصيف، إذ يدفع تيارات الهواء البارد لتتخلل هذه البواكي فتعمل على تلطيف الطقس.
عم سعدون البقال؛ كان صاحب محل للبقالة أسفل البناية التي نقطنها. أنزل في الصباح فأجده يضع في واجهة المحل صوانٍ كبيرة من القيمر (قشطة) خاصة، مبرومة، مبروكة، تحمل كل خيرات اللبن!
حين شاهدني لأول مرة؛ سألني أنت "علاوي" ابن أبو علاوي؟
لم يمهلنِ وقتًا كي أجيب عن سؤاله، إذ بادرني بقوله:
هلا علاوي.. إيش لونك عيني؟
كنت سعيدًا بلهجته؛ لم أفهم مراده صراحة، لكني أعدت عليه "الحمدلله" عدة مرات!
- ادلل علاوي؛ شي تريد، ريّوك؟ (ما يتريق به الإنسان - الإفطار)
- بابا بيقولك هات بنص دينار "جيمر وكاهاي"
ضحك عم سعدون بلطف، أوحت ابتسامته الرقيقة ونبرات صوته الدافئة، أنه رجل مهذب.
أعاد عم سعدون ما قلته بطريقة موصلية سليمة فقال:
"ادلل علاوي.. كَيمر وكَاهي أبو حسين"
مد يده وأخذ مني طبقًا كبيرًا، وضع فيه ألذ وأجمل قشطة جاموسي أكلتها في حياتي، لها ترميلة عجيبة، الدسم جعلها حلوة المذاق، سُكر!
قسم الكَاهي إلى قطع صغيرة مستطيلة، ثم وضعها في علاجة (كيس من البلاستيك) والكَاهي يشبه الفطير الفلاحي في مصر، مفعمٌ برائحة الزبد البلدي.
بجانب عم سعدون، كان يقف في الصباح الباكر الحاج "ليث" مع زوجته أمام عربة لبيع الباكَلَّة أو البَاقِلاء (الفول المدمس)، تُصنع الباقِلَّاء في قدور كبيرة، تمامًا كما نفعل في مصر.
يغرف "عم ليث" البَاقِلاء من القدرة، ثم يضعها في طبق مع الغراء، ثم ينقع فيه الخبز العراقي ليتشرب بالغراء، في الوقت الذي تكون زوجته قد انتهت من تجهيز البيض المقلي في الزبد العربي (البلدي) الذي يسمونه أيضًا الزبد الحر، فيناولها الطبق لتضع فوقه البيض مع قليلٍ من النعناع.
وهذا الطبق مفرط في دسامته، لهذا يحبذ العراقيون تناوله في فصل الشتاء، لأن الزبد العربي المستخدم في تجهيزه وفير، يبعث في أبدانهم الدفء.
علي حسن