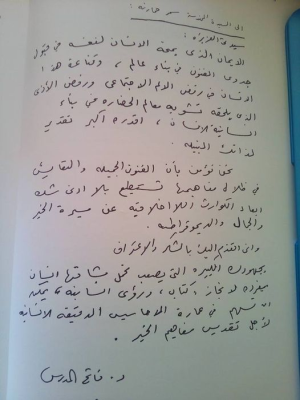... حين عدت إلى بيت جدي الريفي في الظهيرة، في أحد أيام الصيف القائظة، وجدت على المنضدة كتيبات..تناولتها ونظرت فيها، فإذا هي روايات (للجيب) للناشئة، بعضها من سلسلة (ملف المستقبل)، وبعضها من (المغامرون الخمسة)، وبعضها من (رجل المستحيل)…
رجل المستحيل! وما عسى أن يكون هذا الرجل؟!
قرأت التعريف به في أول الرواية، فإذا هو رجلل يجيد ست لغات حية إجادةً تامة، ويجيد قيادة جميع المركبات حتى الطائرات، ويجيبد التنكر وتقليد الأصوات والحركات على نحو باهر، ويجيد جميع الألعاب القتالية، وهو منتصر أبدًا، مقدَّم أبدًا..رباه! ما هذا؟! ليتني كنت (رجل المستحيل)! ليتني كنت (أدهم صبري)!
هذا ما تمناه آنذاك غلام في الثانية عشرة من عمره..
لم يرقني الإرهاص بالمستقبل الذي رأيته في روايات (ملف المستقبل)، ولا ذكاءء المغامرة في روايات (المغامرون الخمسة)، وإنما بُهرت بهذا الذي أوتي من كل شيء: رجل المستحيل! وقد تبينت فيما بعد أن شدة احتفائي بأمثال هذه النماذج البشرية العليا موصول السبب بإيماني الراسخ بفكرة الكمال البشري، (الإنسان الكامل) على طريقة الصوفية، لا (السوبر مان) على طريقة نيتشه. وكم كانت سعادتي بقول الشيخ الأكبر محيي الدين ابن عربي (قدس سره)، يخاطب قارئه: “إنك على استعداد الكمال لو عقَلت”! كم يسرني من يقول لي: استعن الله، وستبلغ! وكم يسوءني من يقول لي: ما ترك الأول للآخر شيئًا! ولست أعلم كلمة هي أفسدُ للعقول، وأقعد بالهمم من هذه الكلمة. ولما انتهيت إلى أصول الفقه، وطالعت أبوابه ومسائله، ما ضقت بشيء ضيقي بمن أغلق باب الاجتهاد جملةً، وأحال المتأخرين زوامل لكلام المتقدمين، وبدا لي أن من أعدل الكلام وأضبطه في تنزيل النظر على مرتبة الناظر في قضية (الاجتهاد والتقليد) ما ذهب إليه أبو محمد ابن حزم (رحمه الله) في كتابه (إحكام الأحكام)، فإنه وفَّى كل مرتبة حقها، وليست الحكمة إلا هذا.
ولأَعُدْ إلى ما كنت بصدده، ولأطلب إليك ـ أيها القارئ الكريم ـ أن تتأمل الفقرة السابقةة من كلامي، فسترى أنها بدأت بالحديث عن روايات (ملف المستقبل)، و(المغامرون الخمسة)، و(رجل المستحيل)، وانتهت بكتاب (إحكام الأحكام) في أصول الفقه، وفي هذا خير تصوير للطفرة التي وقعت لي في عالم الكتب والمطالعة، فقد انتقلتُ عن غرارة الصبا إلى حكمة الكهولة في نحو عام.
لم أزل أذكر عنوان أول رواية قرأتها في سلسلة (رجل المستحيل): الجوهرة السوداء… كنت آنذاك في الصف الأول الإعدادي، وقد تبعتْها روايات أخرى، حتى طالعت كل ما صدر إلى ما فوق العدد الستين، غير أني صُرفت في الصف الثالث الإعدادي إلى لعبة الشِّطرنج، فجمعت فيها طائفة من الكتب، وعرفت ما فيها من الخطط الدفاعية، كالدفاع الإنجليزي، والدفاع الفرنسي، ودفاع الكاروكان، وغيرها، ونفَّذت على رقعة الشطرنج جميع الأدوار المحفوظة في كتاب (الكامل في الشطرنج)، وهو مجلد ضخم لفائق دحدوح فيما أذكر، وكذلك حميع الأدوار التي كانت بين بطلي العالم الروسيين: جاري كاسباروف، وأناتولي كاربوف، والتي جُمعت في كتيب مستقل. وانضممت إلى فريق القليوبية للشطرنج، ممثلا لمن تحت ١٧ عامًا، غير أني لم ألعب دورًا واحدًا في دوري الشطرنج؛ إذ سرعان ما انصرفت عنه، في أوائل المرحلة الثانوية، حين اجتذبتني كتب الشريعة، وأُغرمت بالمشيخة، وتاقت نفسي إلى أن أكون للمتقين إمامًا! وشرعتُ في تكوين مكتبة خاصة بي شغلتْ أولَ الأمر جزءًا صغيرًا من مكتبة أبي، ثم ما لبثت أن زادت مع الأيام حتى فاقت مكتبة أبي، واستقلت حين استقل صاحبها. وإن تعجب فعجبٌ أنها حوت بعد حين كتيبًا عنوانه (شرح شطرنج العارفين)!
في الصف الأول الثانوي كان في فصلنا طالب إخواني وآخر جهادي. كان الأول ودودًا،، حسن المعشر، يجمع الطلاب حوله في غير عناء، وكان الآخر غليظًا في فجاجة يظنها دينًا. لفتني حديثهما إلى الدين عامةً، غير أني اخترت طريقًا آخر، وهو التصوف، وحَدَاني على ذلك تلك الدروس التي كنت أشهدها للشيخ (حسن شحاته) قبل أن يتشيع هذا التشيع الحاد، وقد عرفته عن كثب حين كان يتحدث في التصوف ورجاله ويكبرهم، وعرفت أسرته، وصادقت ولده (محسن)، وكان من أقراني، وفيه أنس ومودة وميل كبير إلى التصوف، ولما زاغت الأهواء بأبيه إلى هذا التشيع المقيت، الذي يرى سباب كبار الأصحاب (رضي الله عنهم) ولعنهم عبادةً، أنكر عليه إنكارًا شديدًا، وأبغضه، وخاصمه خصومة الحارث المحاسبي أباه (فقد ذكر الرواة أن المحاسبي رضي الله عنه أبى أن يأخذ حقه من ميراث أبيه لأن أباه كان قدريًّا). غير أني سأرجئ الحديث عن هذا الأمر، وعن معرفتي بحسن شحاته إلى موضع آخر بإذن الله تعالى، وحسبي أن أذكر هنا أني فارقت مجلسه قبل أن يتشيع لسبب آخر، خلاصته أني تبينت أن بضاعة الرجل من العلم لم تكن إلا منطقًا فخمًا، ليس وراءه شيء يُعول عليه.
لقد كنت أرقب مقدم العطلة الدراسية لأفرغ لما أهوى، وكنت أستخرج من مكتبتي ــ قبل أيام من انتهاء الامتحانات ـ طائفةً من الكتب التي أزمع قراءتها خلال أيام العطلة، بل كنت ربما تعجلت ـ والعجلة في أصل تكويني ـ فجعلت أطالع الكتب قبيل أيام الامتحانات، ولقد قرأت خمسة كتب وأنا أتهيأ لامتحانات الفرقة الثالثة بالكلية، أذكر منها الآن كتاب (التفكير الفلسفي في الإسلام) للدكتور عبد الحليم محمود (رحمه الله). وكنت أُستدرج إلى ذلك استدراجًا، وصورة هذا الاستدراج أن تحدثني نفسي إذا أصبحت وتهيأت للاستذكار والدرس، قائلة: الرأي أن تعتصر من غُصة الاستذكار الإجباري بشيء من المطالعة الحرة، ولتقرأ ساعة، ثم تفرغ سائر يومك للواجب المنوط بك، فكنت أتناول الكتاب في التاسعة، والعزم معقود على تركه في العاشرة، لأبدأ الاستذكار بعدها، فإذا بلغتُ العاشرة نظرت فإذا الفصل الذي أقرأه قد بقيت فيه وريقات، فأقول: لا بأس من نصف ساعة تُتم فيها هذا الفصل، ثم يمر الوقت دون أن أفرغ، فأقول: لا بأس! فلتقرأ إلى الحادية عشرة، ثم تأخذْ بعدها في الاستذكار، فإذا بلغتُ الحادية عشرة قلت لنفسي: ليس دون الظهر إلا ساعة، فلتهنأ بالقراءة الحرة حتى تصلي الظهر، ثم تنقطع بعد ذلك إلى الاستذكار والدرس. وهكذا يمضي الحال في كل يوم، أقرأ بطريقة (الاستدراج).
وشغفت بطه حسين في أول أمري، وما أظن إلا أن أسلوبه وملكته البيانية كلمةة إجماع، كما يقول أصحابنا من الفقهاء، وما أرى في وصف ذلك أنسب من مقالة ابن الأثير في شعر البحتري، قال: “وأما أبو عبادة البحتري، فإنه أحسن في سبك اللفظ على المعنى، وأراد أن يَشعر فغنَّى، ولقد حاز طرفي الرقة والجزالة على الإطلاق، فبينا يكون في شظف نجد إذ تشبث بريف العراق”.
كنت إذا قرأت كلام الرجل أشعر أنه يبذل ـ فيما يقول ويكتب ـ جهدًا مضنيا، فليسس كلامه، عرفتَ ما فيه أم أنكرتَه، بالذي حيك بليل، ثم أذيع في الناس بنهار، وليس رأيه في مسألة من المسائل بذلك الرأي الفطير، الذي أخرجته السليقة دون إحكام وتدبير.
والغريب أنه كان يدّعي في بعض ما يكتب غير ذلك! اقرأ مقدمة كتابه “مع المتنبي” ترََ عجبًا، فهو يبدؤه قائلا: “لا أريد أن أدرس المتنبي، فأنا لم أترك القاهرة، ولم أعبر البحر، ولم آو إلى هذه القرية للبحث والدرس، وإنما اصطنعت هذا كله طلبا للراحة، وإيثارًا للفراغ الذي أخلو فيه إلى نفسي”، ثم يقول بعد أسطر: “لا أريد إذن أن أدرس المتنبي …”، ثم يخبرك بعد أسطر أخرى أنه لم يصطحب معه إلى فرنسا حيث أنفق شهور الصيف إلا أيسر طبعة من طبعات المتنبي، دون ما كتبه الشراح والنقاد عليه قديما وحديثا؛ لأنه لا يريد درسا وبحثا، وإنما يريد صحبة ومرافقة ليس غير. ثم هو لا يؤثر المتنبي ولا يقدمه على غيره من الشعراء، يقول: “ولعله بعيد كل البعد من أن يبلغ من نفسي منزلة الحب والإيثار”، ثم يتكلم كلاما طويلا عريضا عن حبه معاندة نفسها وسومَها ما لا تشتهي من الأمر، ليختم كلامه قائلا: “لا أريد أن أدرس المتنبي إذن، فالذين يقرؤون هذه الفصول لا ينبغي أن يقرؤوها على أنها علم، ولا على أنها نقد، ولا ينبغي أن ينتظروا منها ما ينتظرون من كتب العلم والنقد، وإنما هو خواطر مرسلة تثيرها في نفسي قراءة المتنبي في قرية من قرى الألب في فرنسا، (…) هي قراءةٌ إن صورت شيئا، فإنما تصور طغيان المرء على نفسه، ولعبه بوقته، وعبثه بعقله، وعصيانه لهواه، وطاعته لهذا الهوى أحيانا”.
ويعجب المرء من هذا الكلام حين ينظر في فهرس الكتاب، ثم يقلب بصره في محتواه،، فإذا فيه درس، وبحث، ونظر، ومقارنة، وحجاج، ورأي، ونقد، وعلم، وفراغ من الكاتب للشاعر وشراحه وناقديه من القدماء والمحدثين على السواء. وفي الجملة تُثبت فيه جميع ما أنكره الكاتب في مقدمته!
وربما أُريدَ بمثل هذا أن يسأل أغرار القراء أنفسهم بعد فراغهم من قراءة الكتاب: إذاا كان هذا ثمرةَ لهوه وعبثه، فكيف إذا جد في عمله؟! سألت نفسي هذا السؤال حينذاك، فطاش لبي!
ثم مرت سنون، وشاء الله أن أطالع كتاب (معي) للدكتور شوقي ضيف (رحمه اللهه تعالى)، وهو سيرته الذاتية، فكان مما حكاه فيه أنه مضى إلى طه حسين في منزله يحمل رسالته للماجستير، وكان العميد مشرفًا عليها، فسأله طه حسين عن رأيه في محاضرة كان قد ألقاها في الجامعة الأمريكية، فأجابه شوقي ضيف وقد غلبه الحياء: “كانت جيدة أو حسنة”، فضحك طه حسين، وقال له: محاضرة أعدها منذ شهر، ثم لا تحظى منك إلا بهذا الوصف! ها هنا رُدَّ إلي عازبُ حلمي، فذكرت مقدمة (مع المتنبي)، وعلمت أن الرجل غلبه فيها ما يغلب الشعراء حين يقولون ما لا يفعلون، وإلا فكيف يستقيم أن ينفق المرء شهرًا في إعداد محاضرة، ثم يلهو ويعبث وهو يكتب كتابًا عن المتنبي؟!
ومن ذكرياتي مع العميد أن أستاذنا الدكتور صلاح رزق (رحمه الله) ـ وكان يدرس لناا تاريخ الأدب الجاهلي في الفرقة الأولى بدار العلوم ـ قد وعدنا ـ نحن طلابه ـ أن من قرأ منا كتاب (الأدب الجاهلي) لطه حسين، فسينال خمس درجات، فبادرت إلى اقتناء الكتاب، وقراءته، وقرأت من قبله كتاب (الشعر الجاهلي) له أيضًا، بعد أن حصلت على نسخة مصورة منه، كانت تباع آنذاك سرًّا، وقرأت كذلك بعض ما كُتب في نقد هذا الكتاب، وترامت إليَّ أنباء كتاب (مصادر الشعر الجاهلي) للدكتور ناصر الدين الأسد (رحمه الله) ـ وهو رسالته للدكتوراه فيما أظن ـ فسعيت في اقتنائه، ولما أعيتني الحيلة، استعرته وصورته، ثم مضيت فرحًا تياهًا بما حصَّلت من العلم، وما طالعت من الكتب لأبشر أستاذنا (رحمه الله)، ففرح فرحًا كبيرًا، غير أني لما استنجزته ما وعد من أمر الدرجات الخمس أخبرني أن ذلك لا سبيل إليه في النظام الجامعي، وأنه إنما قال ما قال حفزًا للهمم، فشق ذلك عليَّ، لا ندمًا على ما بذلت من جهد، فقد كنت ـ ولم أزل ـ أستعذب النَّصَبَ في الطَّلَب، وإنما هي هذه المرارةُ التي يجدها الآمل حين يُخفق في تحصيل المأمول. وكان أستاذنا (رحمه الله) يقول: لو لم يكن لطه حسين من فضل على الدرس الأدبي الحديث سوى أنه حرك ماء المستنقع لكفاه! (يريد بعث الهمم على البحث والنظر بما أثاره من الشكوك وما بعثه من الرِّيَب).
ومهما يكن من شيء، فقد فُتنت بطه حسين، ولم تزل في نفسي إلى الآن أَثَارَةٌ منن هذه الفتنة القديمة، فتراني أطالع كل حين شيئًا من كتبه، ثم يدعوني الشيء إلى أشياء، ثم لا ينجيني من الإغراق في ذلك إلا صوارف العمل، وما أثقلها! وشواغل الحياة، وما أكثرها! وقد بلغت بي الفتنة بالرجل أني كتبت فقرة قصصية ذات يوم أحاكي فيها أسلوبه، ثم عرضتها على أبي، ولم أخبره بكاتبها، فنسبها إلى طه حسين غيرَ شاك ولا مستريب، وأوشك أن يكذبني حين أخبرته بحقيقة أمرها… ليتني احتفظت بهذه الفقرة! ولعلك ـ أيها القارئ الكريم ـ واجدٌ في بعض ما تقرأ من كلامي أثرًا لما أقول؛ فإن للبدايات أحكامًا لا تزول آثارها بالكلية وإن بعد العهد، فكيف والعَوْدُ إليها دائم، فكأنما هي في النفس كما قال الشاعر القديم: “زُبُرٌ تُجِدُّ متونَها أقلامُها”؟!
على أن أشد ما أخشاه من آثار البدايات أن يكون إقبالي على طه حسين أولا، ثم علىى العقاد بعد ذلك سببًا في هذا الميل الذي أجده عن الرافعي، وفي هذا الانحراف عن المدرسة الشاكرية، غير قالٍ ولا سالٍ، ولكنَّ نوعَ الجمال الذي في كتب هذين العظيمين ( الرافعي وشاكر رحمهما الله) ليس هو ذاك الذي تنعطف إليه نفسي، وتطرب له روحي. ولقد أذكر أني قرأت (مع المتنبي) لطه حسين، ثم (المتنبي) لشاكر، فما وقع الثاني من نفسي موقع الأول، ولولا بعد العهد بهما لفصلت الكلام في ذلك تفصيلا، غير أني أذكر الآن أن الشيخ شاكرًا (رحمه الله) أقام الدنيا ولم يقعدها لأن طه حسن شك في أن المتنبي وُلِد لِغِيَّة (من الزنا)، ثم لم ير الشيخ بأسًا في أن يرمي طائفة من العلويين بالتآمر لقتل المتنبي، لأدلة رآها، لا يصلح مثلها ـ في رأيي ـ لإثبات هذا الزعم. وأذكر كذلك أني تلمست منهج الشيخ في التذوق ـ الذي أطال النفَس في الحديث عنه ـ في كتابه، فلم أوفق لإدراكه والوقوف عليه. وتحصَّل في نفسي كذلك رأي في أدلة الشيخ وفي طريقته في الاستدلال، غير أن عبارتي لم تَقم به آنذاك، حتى انتهيت إلى ما كان بينه وبين الأستاذ سعيد الأفغاني (رحمه الله) من مكاتبات ومباحثات، أوردها الشيخ ملحقةًَ بالكتاب، وفي بعضها قول الأستاذ سعيد: “ولست أجد كلامًا في تصوير عمل الأستاذ [شاكر] وأصوله في بحوثه أصدق من قول الجاحظ في إبراهيم النَّظَّام، وهو هذا: (وكان عيبه الذي لا يفارقه سوء ظنه وجودة قياسه على العارض والخاطر السابق الذي لا يوثق بمثله، فلو كان بدل تصحيحه القياس التمس تصحيح الأصل الذي قاس عليه، لكان أمره على الخلاص، ولكنه يظن الظن، ثم يقيس عليه، وينسى أن بدء أمره كان ظنًا)” (المتنبي، ص٥٤٤). لقد وقع مني هذا القول مواقع الماء من ذي الغُلة الصادي، وكأن الرأي الذي رأيتُه في الشيخ ومنهجه وعجزت عن صياغته قد قام شاخصًا بين يدي، وكأني أتبين قسماته في غير مشقة ولا ارتياب، فلا تَسَلْ عما وجدت حينها من اللذة والمتاع!
* نقلا عن موقع د محمد حماسة عبد اللطيف
رجل المستحيل! وما عسى أن يكون هذا الرجل؟!
قرأت التعريف به في أول الرواية، فإذا هو رجلل يجيد ست لغات حية إجادةً تامة، ويجيد قيادة جميع المركبات حتى الطائرات، ويجيبد التنكر وتقليد الأصوات والحركات على نحو باهر، ويجيد جميع الألعاب القتالية، وهو منتصر أبدًا، مقدَّم أبدًا..رباه! ما هذا؟! ليتني كنت (رجل المستحيل)! ليتني كنت (أدهم صبري)!
هذا ما تمناه آنذاك غلام في الثانية عشرة من عمره..
لم يرقني الإرهاص بالمستقبل الذي رأيته في روايات (ملف المستقبل)، ولا ذكاءء المغامرة في روايات (المغامرون الخمسة)، وإنما بُهرت بهذا الذي أوتي من كل شيء: رجل المستحيل! وقد تبينت فيما بعد أن شدة احتفائي بأمثال هذه النماذج البشرية العليا موصول السبب بإيماني الراسخ بفكرة الكمال البشري، (الإنسان الكامل) على طريقة الصوفية، لا (السوبر مان) على طريقة نيتشه. وكم كانت سعادتي بقول الشيخ الأكبر محيي الدين ابن عربي (قدس سره)، يخاطب قارئه: “إنك على استعداد الكمال لو عقَلت”! كم يسرني من يقول لي: استعن الله، وستبلغ! وكم يسوءني من يقول لي: ما ترك الأول للآخر شيئًا! ولست أعلم كلمة هي أفسدُ للعقول، وأقعد بالهمم من هذه الكلمة. ولما انتهيت إلى أصول الفقه، وطالعت أبوابه ومسائله، ما ضقت بشيء ضيقي بمن أغلق باب الاجتهاد جملةً، وأحال المتأخرين زوامل لكلام المتقدمين، وبدا لي أن من أعدل الكلام وأضبطه في تنزيل النظر على مرتبة الناظر في قضية (الاجتهاد والتقليد) ما ذهب إليه أبو محمد ابن حزم (رحمه الله) في كتابه (إحكام الأحكام)، فإنه وفَّى كل مرتبة حقها، وليست الحكمة إلا هذا.
ولأَعُدْ إلى ما كنت بصدده، ولأطلب إليك ـ أيها القارئ الكريم ـ أن تتأمل الفقرة السابقةة من كلامي، فسترى أنها بدأت بالحديث عن روايات (ملف المستقبل)، و(المغامرون الخمسة)، و(رجل المستحيل)، وانتهت بكتاب (إحكام الأحكام) في أصول الفقه، وفي هذا خير تصوير للطفرة التي وقعت لي في عالم الكتب والمطالعة، فقد انتقلتُ عن غرارة الصبا إلى حكمة الكهولة في نحو عام.
لم أزل أذكر عنوان أول رواية قرأتها في سلسلة (رجل المستحيل): الجوهرة السوداء… كنت آنذاك في الصف الأول الإعدادي، وقد تبعتْها روايات أخرى، حتى طالعت كل ما صدر إلى ما فوق العدد الستين، غير أني صُرفت في الصف الثالث الإعدادي إلى لعبة الشِّطرنج، فجمعت فيها طائفة من الكتب، وعرفت ما فيها من الخطط الدفاعية، كالدفاع الإنجليزي، والدفاع الفرنسي، ودفاع الكاروكان، وغيرها، ونفَّذت على رقعة الشطرنج جميع الأدوار المحفوظة في كتاب (الكامل في الشطرنج)، وهو مجلد ضخم لفائق دحدوح فيما أذكر، وكذلك حميع الأدوار التي كانت بين بطلي العالم الروسيين: جاري كاسباروف، وأناتولي كاربوف، والتي جُمعت في كتيب مستقل. وانضممت إلى فريق القليوبية للشطرنج، ممثلا لمن تحت ١٧ عامًا، غير أني لم ألعب دورًا واحدًا في دوري الشطرنج؛ إذ سرعان ما انصرفت عنه، في أوائل المرحلة الثانوية، حين اجتذبتني كتب الشريعة، وأُغرمت بالمشيخة، وتاقت نفسي إلى أن أكون للمتقين إمامًا! وشرعتُ في تكوين مكتبة خاصة بي شغلتْ أولَ الأمر جزءًا صغيرًا من مكتبة أبي، ثم ما لبثت أن زادت مع الأيام حتى فاقت مكتبة أبي، واستقلت حين استقل صاحبها. وإن تعجب فعجبٌ أنها حوت بعد حين كتيبًا عنوانه (شرح شطرنج العارفين)!
في الصف الأول الثانوي كان في فصلنا طالب إخواني وآخر جهادي. كان الأول ودودًا،، حسن المعشر، يجمع الطلاب حوله في غير عناء، وكان الآخر غليظًا في فجاجة يظنها دينًا. لفتني حديثهما إلى الدين عامةً، غير أني اخترت طريقًا آخر، وهو التصوف، وحَدَاني على ذلك تلك الدروس التي كنت أشهدها للشيخ (حسن شحاته) قبل أن يتشيع هذا التشيع الحاد، وقد عرفته عن كثب حين كان يتحدث في التصوف ورجاله ويكبرهم، وعرفت أسرته، وصادقت ولده (محسن)، وكان من أقراني، وفيه أنس ومودة وميل كبير إلى التصوف، ولما زاغت الأهواء بأبيه إلى هذا التشيع المقيت، الذي يرى سباب كبار الأصحاب (رضي الله عنهم) ولعنهم عبادةً، أنكر عليه إنكارًا شديدًا، وأبغضه، وخاصمه خصومة الحارث المحاسبي أباه (فقد ذكر الرواة أن المحاسبي رضي الله عنه أبى أن يأخذ حقه من ميراث أبيه لأن أباه كان قدريًّا). غير أني سأرجئ الحديث عن هذا الأمر، وعن معرفتي بحسن شحاته إلى موضع آخر بإذن الله تعالى، وحسبي أن أذكر هنا أني فارقت مجلسه قبل أن يتشيع لسبب آخر، خلاصته أني تبينت أن بضاعة الرجل من العلم لم تكن إلا منطقًا فخمًا، ليس وراءه شيء يُعول عليه.
لقد كنت أرقب مقدم العطلة الدراسية لأفرغ لما أهوى، وكنت أستخرج من مكتبتي ــ قبل أيام من انتهاء الامتحانات ـ طائفةً من الكتب التي أزمع قراءتها خلال أيام العطلة، بل كنت ربما تعجلت ـ والعجلة في أصل تكويني ـ فجعلت أطالع الكتب قبيل أيام الامتحانات، ولقد قرأت خمسة كتب وأنا أتهيأ لامتحانات الفرقة الثالثة بالكلية، أذكر منها الآن كتاب (التفكير الفلسفي في الإسلام) للدكتور عبد الحليم محمود (رحمه الله). وكنت أُستدرج إلى ذلك استدراجًا، وصورة هذا الاستدراج أن تحدثني نفسي إذا أصبحت وتهيأت للاستذكار والدرس، قائلة: الرأي أن تعتصر من غُصة الاستذكار الإجباري بشيء من المطالعة الحرة، ولتقرأ ساعة، ثم تفرغ سائر يومك للواجب المنوط بك، فكنت أتناول الكتاب في التاسعة، والعزم معقود على تركه في العاشرة، لأبدأ الاستذكار بعدها، فإذا بلغتُ العاشرة نظرت فإذا الفصل الذي أقرأه قد بقيت فيه وريقات، فأقول: لا بأس من نصف ساعة تُتم فيها هذا الفصل، ثم يمر الوقت دون أن أفرغ، فأقول: لا بأس! فلتقرأ إلى الحادية عشرة، ثم تأخذْ بعدها في الاستذكار، فإذا بلغتُ الحادية عشرة قلت لنفسي: ليس دون الظهر إلا ساعة، فلتهنأ بالقراءة الحرة حتى تصلي الظهر، ثم تنقطع بعد ذلك إلى الاستذكار والدرس. وهكذا يمضي الحال في كل يوم، أقرأ بطريقة (الاستدراج).
وشغفت بطه حسين في أول أمري، وما أظن إلا أن أسلوبه وملكته البيانية كلمةة إجماع، كما يقول أصحابنا من الفقهاء، وما أرى في وصف ذلك أنسب من مقالة ابن الأثير في شعر البحتري، قال: “وأما أبو عبادة البحتري، فإنه أحسن في سبك اللفظ على المعنى، وأراد أن يَشعر فغنَّى، ولقد حاز طرفي الرقة والجزالة على الإطلاق، فبينا يكون في شظف نجد إذ تشبث بريف العراق”.
كنت إذا قرأت كلام الرجل أشعر أنه يبذل ـ فيما يقول ويكتب ـ جهدًا مضنيا، فليسس كلامه، عرفتَ ما فيه أم أنكرتَه، بالذي حيك بليل، ثم أذيع في الناس بنهار، وليس رأيه في مسألة من المسائل بذلك الرأي الفطير، الذي أخرجته السليقة دون إحكام وتدبير.
والغريب أنه كان يدّعي في بعض ما يكتب غير ذلك! اقرأ مقدمة كتابه “مع المتنبي” ترََ عجبًا، فهو يبدؤه قائلا: “لا أريد أن أدرس المتنبي، فأنا لم أترك القاهرة، ولم أعبر البحر، ولم آو إلى هذه القرية للبحث والدرس، وإنما اصطنعت هذا كله طلبا للراحة، وإيثارًا للفراغ الذي أخلو فيه إلى نفسي”، ثم يقول بعد أسطر: “لا أريد إذن أن أدرس المتنبي …”، ثم يخبرك بعد أسطر أخرى أنه لم يصطحب معه إلى فرنسا حيث أنفق شهور الصيف إلا أيسر طبعة من طبعات المتنبي، دون ما كتبه الشراح والنقاد عليه قديما وحديثا؛ لأنه لا يريد درسا وبحثا، وإنما يريد صحبة ومرافقة ليس غير. ثم هو لا يؤثر المتنبي ولا يقدمه على غيره من الشعراء، يقول: “ولعله بعيد كل البعد من أن يبلغ من نفسي منزلة الحب والإيثار”، ثم يتكلم كلاما طويلا عريضا عن حبه معاندة نفسها وسومَها ما لا تشتهي من الأمر، ليختم كلامه قائلا: “لا أريد أن أدرس المتنبي إذن، فالذين يقرؤون هذه الفصول لا ينبغي أن يقرؤوها على أنها علم، ولا على أنها نقد، ولا ينبغي أن ينتظروا منها ما ينتظرون من كتب العلم والنقد، وإنما هو خواطر مرسلة تثيرها في نفسي قراءة المتنبي في قرية من قرى الألب في فرنسا، (…) هي قراءةٌ إن صورت شيئا، فإنما تصور طغيان المرء على نفسه، ولعبه بوقته، وعبثه بعقله، وعصيانه لهواه، وطاعته لهذا الهوى أحيانا”.
ويعجب المرء من هذا الكلام حين ينظر في فهرس الكتاب، ثم يقلب بصره في محتواه،، فإذا فيه درس، وبحث، ونظر، ومقارنة، وحجاج، ورأي، ونقد، وعلم، وفراغ من الكاتب للشاعر وشراحه وناقديه من القدماء والمحدثين على السواء. وفي الجملة تُثبت فيه جميع ما أنكره الكاتب في مقدمته!
وربما أُريدَ بمثل هذا أن يسأل أغرار القراء أنفسهم بعد فراغهم من قراءة الكتاب: إذاا كان هذا ثمرةَ لهوه وعبثه، فكيف إذا جد في عمله؟! سألت نفسي هذا السؤال حينذاك، فطاش لبي!
ثم مرت سنون، وشاء الله أن أطالع كتاب (معي) للدكتور شوقي ضيف (رحمه اللهه تعالى)، وهو سيرته الذاتية، فكان مما حكاه فيه أنه مضى إلى طه حسين في منزله يحمل رسالته للماجستير، وكان العميد مشرفًا عليها، فسأله طه حسين عن رأيه في محاضرة كان قد ألقاها في الجامعة الأمريكية، فأجابه شوقي ضيف وقد غلبه الحياء: “كانت جيدة أو حسنة”، فضحك طه حسين، وقال له: محاضرة أعدها منذ شهر، ثم لا تحظى منك إلا بهذا الوصف! ها هنا رُدَّ إلي عازبُ حلمي، فذكرت مقدمة (مع المتنبي)، وعلمت أن الرجل غلبه فيها ما يغلب الشعراء حين يقولون ما لا يفعلون، وإلا فكيف يستقيم أن ينفق المرء شهرًا في إعداد محاضرة، ثم يلهو ويعبث وهو يكتب كتابًا عن المتنبي؟!
ومن ذكرياتي مع العميد أن أستاذنا الدكتور صلاح رزق (رحمه الله) ـ وكان يدرس لناا تاريخ الأدب الجاهلي في الفرقة الأولى بدار العلوم ـ قد وعدنا ـ نحن طلابه ـ أن من قرأ منا كتاب (الأدب الجاهلي) لطه حسين، فسينال خمس درجات، فبادرت إلى اقتناء الكتاب، وقراءته، وقرأت من قبله كتاب (الشعر الجاهلي) له أيضًا، بعد أن حصلت على نسخة مصورة منه، كانت تباع آنذاك سرًّا، وقرأت كذلك بعض ما كُتب في نقد هذا الكتاب، وترامت إليَّ أنباء كتاب (مصادر الشعر الجاهلي) للدكتور ناصر الدين الأسد (رحمه الله) ـ وهو رسالته للدكتوراه فيما أظن ـ فسعيت في اقتنائه، ولما أعيتني الحيلة، استعرته وصورته، ثم مضيت فرحًا تياهًا بما حصَّلت من العلم، وما طالعت من الكتب لأبشر أستاذنا (رحمه الله)، ففرح فرحًا كبيرًا، غير أني لما استنجزته ما وعد من أمر الدرجات الخمس أخبرني أن ذلك لا سبيل إليه في النظام الجامعي، وأنه إنما قال ما قال حفزًا للهمم، فشق ذلك عليَّ، لا ندمًا على ما بذلت من جهد، فقد كنت ـ ولم أزل ـ أستعذب النَّصَبَ في الطَّلَب، وإنما هي هذه المرارةُ التي يجدها الآمل حين يُخفق في تحصيل المأمول. وكان أستاذنا (رحمه الله) يقول: لو لم يكن لطه حسين من فضل على الدرس الأدبي الحديث سوى أنه حرك ماء المستنقع لكفاه! (يريد بعث الهمم على البحث والنظر بما أثاره من الشكوك وما بعثه من الرِّيَب).
ومهما يكن من شيء، فقد فُتنت بطه حسين، ولم تزل في نفسي إلى الآن أَثَارَةٌ منن هذه الفتنة القديمة، فتراني أطالع كل حين شيئًا من كتبه، ثم يدعوني الشيء إلى أشياء، ثم لا ينجيني من الإغراق في ذلك إلا صوارف العمل، وما أثقلها! وشواغل الحياة، وما أكثرها! وقد بلغت بي الفتنة بالرجل أني كتبت فقرة قصصية ذات يوم أحاكي فيها أسلوبه، ثم عرضتها على أبي، ولم أخبره بكاتبها، فنسبها إلى طه حسين غيرَ شاك ولا مستريب، وأوشك أن يكذبني حين أخبرته بحقيقة أمرها… ليتني احتفظت بهذه الفقرة! ولعلك ـ أيها القارئ الكريم ـ واجدٌ في بعض ما تقرأ من كلامي أثرًا لما أقول؛ فإن للبدايات أحكامًا لا تزول آثارها بالكلية وإن بعد العهد، فكيف والعَوْدُ إليها دائم، فكأنما هي في النفس كما قال الشاعر القديم: “زُبُرٌ تُجِدُّ متونَها أقلامُها”؟!
على أن أشد ما أخشاه من آثار البدايات أن يكون إقبالي على طه حسين أولا، ثم علىى العقاد بعد ذلك سببًا في هذا الميل الذي أجده عن الرافعي، وفي هذا الانحراف عن المدرسة الشاكرية، غير قالٍ ولا سالٍ، ولكنَّ نوعَ الجمال الذي في كتب هذين العظيمين ( الرافعي وشاكر رحمهما الله) ليس هو ذاك الذي تنعطف إليه نفسي، وتطرب له روحي. ولقد أذكر أني قرأت (مع المتنبي) لطه حسين، ثم (المتنبي) لشاكر، فما وقع الثاني من نفسي موقع الأول، ولولا بعد العهد بهما لفصلت الكلام في ذلك تفصيلا، غير أني أذكر الآن أن الشيخ شاكرًا (رحمه الله) أقام الدنيا ولم يقعدها لأن طه حسن شك في أن المتنبي وُلِد لِغِيَّة (من الزنا)، ثم لم ير الشيخ بأسًا في أن يرمي طائفة من العلويين بالتآمر لقتل المتنبي، لأدلة رآها، لا يصلح مثلها ـ في رأيي ـ لإثبات هذا الزعم. وأذكر كذلك أني تلمست منهج الشيخ في التذوق ـ الذي أطال النفَس في الحديث عنه ـ في كتابه، فلم أوفق لإدراكه والوقوف عليه. وتحصَّل في نفسي كذلك رأي في أدلة الشيخ وفي طريقته في الاستدلال، غير أن عبارتي لم تَقم به آنذاك، حتى انتهيت إلى ما كان بينه وبين الأستاذ سعيد الأفغاني (رحمه الله) من مكاتبات ومباحثات، أوردها الشيخ ملحقةًَ بالكتاب، وفي بعضها قول الأستاذ سعيد: “ولست أجد كلامًا في تصوير عمل الأستاذ [شاكر] وأصوله في بحوثه أصدق من قول الجاحظ في إبراهيم النَّظَّام، وهو هذا: (وكان عيبه الذي لا يفارقه سوء ظنه وجودة قياسه على العارض والخاطر السابق الذي لا يوثق بمثله، فلو كان بدل تصحيحه القياس التمس تصحيح الأصل الذي قاس عليه، لكان أمره على الخلاص، ولكنه يظن الظن، ثم يقيس عليه، وينسى أن بدء أمره كان ظنًا)” (المتنبي، ص٥٤٤). لقد وقع مني هذا القول مواقع الماء من ذي الغُلة الصادي، وكأن الرأي الذي رأيتُه في الشيخ ومنهجه وعجزت عن صياغته قد قام شاخصًا بين يدي، وكأني أتبين قسماته في غير مشقة ولا ارتياب، فلا تَسَلْ عما وجدت حينها من اللذة والمتاع!
* نقلا عن موقع د محمد حماسة عبد اللطيف