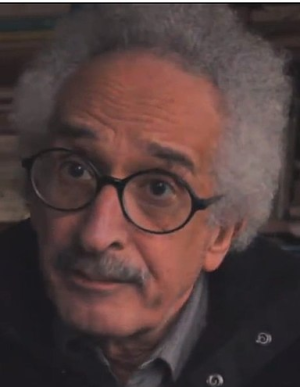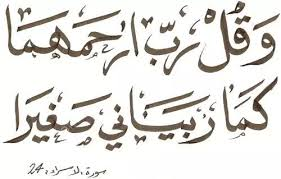يمكن القول، بكثير من الاطمئنان، إن ظهور الموشح والزجل في الأندلس منذ نهاية القرن التاسع الميلادي فصاعداً، يُعدّ مرحلة متقدمة من التطور الذي شهده الشعر العربي منذ امرئ القيس، مروراً بالعصر الأموي فالعباسي، حتى انتقل ﺇلى الأندلس، مع عبد الرحمن الداخل، الأمير الشاعر، صاحب «يا نخلُ أنتِ غريبةٌ مثلي/في الأرضِ نائيةٌ عن الأهلِ». امرؤ القيس كان يخاطب صاحبين اثنين له: قفا نبكِ، وفي آخر ما يُنسب ﺇليه، كان يخاطب صاحباً واحداً: بكى صاحبي لمّا رأى الدربَ دونه. وبقيت مخاطبة الأثنين قائمة في الشعر: يا صاحبَيَّ تقصّيا نظرَيكما.. إلى أن اسقطها أبو نواس في خروجه عن المآلوف: قل لمن يبكي على رَسمٍ دَرَس/واقفاً، ما ضر لو كان جلس!
واتخذ «الخروج» في الشعر العباسي شكل ميل خجول إلى استعمال المفردات غير العربية التي دخلت مع المولدين والأعاجم في بعض الشعر العباسي، من باب «التملّح والتظرُّف». لكن العصر العباسي لم يكن يجرؤ على إظهار صفته «اللاعربية» بسبب قربه الشديد من العصر الأموي الغارق في عربيته وإسلامه. فقد كان الأعاجم قِلَّة ضئيلة في المجتمع العباسي، مما لم يشجع على استعمال المفردات والمواقف غير العربية ـ الإسلامية في الشعر العباسي، ولو أن قليلاً من ذلك قد تسلل من بعض الشعراء، مثل ابي نواس، صاحب «إبليس أشرفُ من أبيكم آدمٍ/فتنبهوا يا معشر الأشرارِ. النار جوهره، وآدمُ طينة/والطينُ لا يسمو سمو النار». لكن التطوير والانفتاح شجَّعا ظهور «القوما، والكان كان، والمخمّس والمسمّط»، خروجاً على نظام الشطرين في الشعر العربي.
وقد انتقلت هذه «التطويرات» في الشعر العربي إلى الأندلس، بفعل الاتصال الدائم بين شعراء الأندلس وشعراء المشرق العباسي، كما تدل عليه كتُب التاريخ و»محاكاة» شعراء الأندلس لشعراء التراث العباسي ببغداد.
على النقيض من المجتمع العباسي، كان العرب في الأندلس بدءاً من الفتح عام 711 قِلَّة، وسط كثرة غير عربية من أهل البلاد، يتكلمون اللغة «اللطينية» أو «الرومانث»، لكن الأجيال العربية الأندلسية صارت ازدواجية اللغة، تتكلم عربية الأب و»لطينية» الأم، بسبب التزاوج بين العرب الفاتحين ونساء البلد الجديد. وقد شجع هذا الوضع على استعمال مفردات رومانث في شعر الاجيال الجديدة، إلى جانب استعداد أكبر لتطوير شكل القصيدة التراثية، استمراراً للمُخَمَّس والمُسمَّط في عدد أسطر/أبيات المقطوعةالشعريّة، والمراوحةبين أوزانها وقوافيها.
كان الشعر المعروف في العصور الوسطى الأوروبية يكاد يكون وقفاً على العارفين باللغة اللاتينية الأدبية، وهؤلاء قليلون خارج حدود رجال الكنيسة الكاثوليكية، المسيطرة على الثقافة، ومنها الشعر الذي لم يكن يخرج كثيراً عن الموضوعات الكنسية والصلوات. ولا شك أن كان هناك نوع من الشعر الدنيوي عند ظهور العامّيّات باللغات الأوروبية من القرن الثاني عشر فصاعداً ولكن هذا مما لا يشكل اساساً لظهور الموشح الأندلسي ومن بعده الزجل بعامية قرطبة، في أواخر القرن الثالث عشر، كما ادَّعى بعض أتباع النظرية الأوروبية، لكي يُبعدوا الأثر العربي من تراث الشعر الغني. فلو كان ثمة من شِعر بلغات عامية أوروبية يستحقّ الحفظ، لما تردَّد الملك «الفونسو العاشر/الحكيم، الذي حكم في قشتالة وليون 32 سنة (1252 ـ 1284) وكان يُعنى بجمع تراث بلاده حفظاً وترجمة في دار الترجمة على غرار «بيت الحكمة» للمأمون العباسي. وبظهور الموشح وتطوره، وقد وضع أساساً للغناء، بدأ الشعراء في إقليم «ﭙروﭭنس» في الجنوب الغربي من فرنسا الحالية بمحاكاة هذا النوع من الشعر العربي الذي جاءهم من جيرانهم العرب المسلمين في الأندلس، ذات العلاقات المتطورة مع ممالك الشمال المسيحي . كان أول هؤلاء الشعراء البروﭭنسين «كيّوم التاسع» أمير آكيتين (1571 ـ 1127) الذي كان معاصراً لعدد من الوشّاحين الأندلسيين، وبخاصة الزجّال «ابن قزمان» وكانت الزيارات متبادلة بين قصور الأندلس، حيث الشعر والغناء والرقص، وبين الممالك المسيحية في الشمال. ويبدو أن الأمير البروﭭنسي قد استهواه ما وجد في القصور الأندلسية من شعر يُغنى، ولم يكن من الصعب عليه أو على غيره من الشعراء الوصول إلى معنى الموشَّحات والأزجال في مجتمع أندلسي يتكلم اللغتين. وقد ترك لنا هذا «التروبادور» الأول، هذا الشاعر الجوال الذي كان يحمل عوده، تلك الآلة الموسيقية التي حملها علي بن نافع، زرياب، من بغداد إلى الأندلس وحمل معه تراثاً شعرياً عربيا، ومواقف من الحب والغزل، لم تكن معروفة في أوروبا الرازحة تحت قرون من السيطرة الكنسية. يتضح لدى التحليل أن عدداً من قصائد كيّوم الإحدى عشرة المعروفة، تتشابه تشابها عجيباً مع موشحات للتطيلي أو أزجال ابن قزمان معاصره. وقد تبع التروبادو الأول حوالي 400 من شعراء ﭙروﭭنس حتى حدود القرن الرابع عشر.
بدأ الباحثون الأوروبيون بالتساؤل عن مصدر هذا الشعر الوليد بعامية أوروبية من القرن الثاني عشر، فنشر الإيطالي «جياماريا بارييري» عام 1571 كتابا عن «أصول الشعر المقفّى» يتحدث عن انتشار الشعر العربي المقفّى بين الإسبان والبروﭭنسيين، ولم تكن القافية معروفة في الشعر الإغريقي أو اللاتيني. فمن أين ظهرت القافية أول مرة في أول شعر دنيوي جديد، مثل الشعر البروﭭنسي؟ وتوالت الدراسات الأوروبية تتساءل عن مصدر أول شعر أوروبي بعامية بروﭭنس أولاً، ثم تطور في شكل الموشح ونظام قوافيه، وفي الموقف من المرأة والحب الدنيوي، الذي لا يوجد مثله الا في هذا الشعر العربي الأندلسي.
وردت أول إشارة إلى الموشَّح في كتب التراث الأندلسي عند ابن بسّام الشنتريني (ت ـ 1147م) في كتابه «الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» (1106 ـ 1181) في قوله إن «مخترع» الموشح هو مُقدَّم بن معافي القبري الضرير، من شعراء الأمير عبد الله بن محمد المرواني (888 ـ 912م) ولا يذكر ابن بسّام أو غيره شيئا من موشحات مقدَّم، بل تذكر مصادر أخرى أمثلة من أول وشّاح معروف، هو «عُبادة بن ماء السماء» (ت 1028) الذي اشتهر بموشحته:
من وَلي ٭في أمَّةٍ أمراً ولم يَعدِل ٭يُعزَلِ ٭ﺇلِإ لحاظ الرشأ الأكحلِ
وقد حذا شعراء أندلسيون آخرون حذو عبادة فتجمع لدينا اليوم 488 موشحة حققها د. سيد غازي (1979) من المخطوطات التي تيسَّرت له. يبدأ الموشح ببيتين، تتبعهما أشطار 5 ـ 7 وتنتهي ببيتين على غرار المطلع، ويغلب أن تكون بلغة الرومانث أو بالعامية الأندلسية، تسمى «الخرجة» يقصد بها التظرُّف وإنهاءالغناء بالتصفيق أو الرقص. أثارت هذه الخرجة باللغة «الأعجمية» أو الرومانث عدداً من الباحثين الأوروبيين، أو الأمريكان، لاحقاً. وحاولوا القول إن هذه الخرجة الأعجمية بقايا شعر رومانثي (ضاع) وراحوا يبحثون ليقولوا ان الموشح يقوم على ذلك الشعر المحلي الرومانثي . ولكن جميع الأبحاث الرصينة تشير إلى قول ابن بسّام إن «الوشّاح يعملها على أشطار الأشعار المهملة، غير المستعملة» أي على الأوزان التي لم يذكرها الخليل من بين بحوره الستة عشر. ولكن التحليل الدقيق للموشحات، وللأزجال من بعدها، يبين أن أوزان غالبية الموشحات تقع على الأوزان الخليليلة الكاملة، وبعضها أوزان مطورة بالمد والخبن والطيّ لتناسب الغناء، وهو ما لم يتطرق اليه الباحثون من غير العرب، وأغلبهم لا يتقن العربية، لذا فهو لا يدرك حساسية الأوزان.
من الملاحظ أن أهم من درس الموشحات والأزجال من ا لأوروبيين هم من الإسبان، ومن رجال الكنيسة الكاثوليكية في الغالب، من أمثال «أنخل كونذالث بالانثيا» و«آسين ﭙالاثيوس» و«إميليو كارثيا كومذ» إلى جانب الفرنسي «ليفي ﭙروﭭنسال». في أبحاث هؤلاء من العناية والدقة ما يقصّر عنه الباحثون العرب، على قلتهم، وهو أمر يؤسف له.
وأول وأهم كتاب من اللاحقين علي ابن بسّام هو المصري ابن سناء المُلك (1155 ـ 1211م) في كتابه «دار الطراز في عمل الموشحات» (1198). مثل ابن بسّام يشير ابن سناء المُلك إن الموشحات «صنعة» فيها براعة الألفاظ والأوزان والصور، أكثر منها إلهاماً كما في الشعر التراثي. وهذه «الصنعة» هي التي دفعت التروبادور البروﭭنسي إلى «صناعة» أغنيته، وغالباً إلى «صناعة «الحانها، كما يخبرنا التروبادور الأول «كيوم التاسع» وأغلب من تبعه من الأربعمئة المعروفين.
بقي الموشح مزدهراً في إقليم ﭙروﭭنس الفرنسي وما جاوره، وتمدد إلى أصقاع أخرى إلى أن هجم على حضارة الجنوب الفرنسي وغناها البابا إنوسنت (البريء) عام 1209 فقضى عليها فتفرق الشعراء التروبادور وأغلبهم حلّ في صقليا حيث كان الامبراطور يرعى الشعراء، وحيث كانت لهجة ﭙروﭭنس مفهومة، بل إن بعض شعراء صقليا كانوا ينظمون بها. ومن صقليا انتشر شعر التروبادور بأوزانه ومقطعاته إلى إيطاليا فتلقفها «دانته» وأتباعه من جماعة «الأسلوب الحلو الجديد» فأشاعوا مفهوم الحب الدنيوي الجديد ومن المرأة، فكانت لدينا «سونيتو» إيطالية، بتلك اللغة العامية المنسلخة عن اللاتينية، وصارت «بياتريجه» و»لورا» من صور النساء التي لم تعرفها أوروبا القروسطية، وامتدت إلى «جولييت» وأمثالها في الشعر الأوروبي في عصر الإنبعاث، وصولاً إلى شكسبير وقصائد الحب، والباحث المنصف لا يخفق في إدراك الشفق الأول فيها من شعر الحب في التراث العربي.
واتخذ «الخروج» في الشعر العباسي شكل ميل خجول إلى استعمال المفردات غير العربية التي دخلت مع المولدين والأعاجم في بعض الشعر العباسي، من باب «التملّح والتظرُّف». لكن العصر العباسي لم يكن يجرؤ على إظهار صفته «اللاعربية» بسبب قربه الشديد من العصر الأموي الغارق في عربيته وإسلامه. فقد كان الأعاجم قِلَّة ضئيلة في المجتمع العباسي، مما لم يشجع على استعمال المفردات والمواقف غير العربية ـ الإسلامية في الشعر العباسي، ولو أن قليلاً من ذلك قد تسلل من بعض الشعراء، مثل ابي نواس، صاحب «إبليس أشرفُ من أبيكم آدمٍ/فتنبهوا يا معشر الأشرارِ. النار جوهره، وآدمُ طينة/والطينُ لا يسمو سمو النار». لكن التطوير والانفتاح شجَّعا ظهور «القوما، والكان كان، والمخمّس والمسمّط»، خروجاً على نظام الشطرين في الشعر العربي.
وقد انتقلت هذه «التطويرات» في الشعر العربي إلى الأندلس، بفعل الاتصال الدائم بين شعراء الأندلس وشعراء المشرق العباسي، كما تدل عليه كتُب التاريخ و»محاكاة» شعراء الأندلس لشعراء التراث العباسي ببغداد.
على النقيض من المجتمع العباسي، كان العرب في الأندلس بدءاً من الفتح عام 711 قِلَّة، وسط كثرة غير عربية من أهل البلاد، يتكلمون اللغة «اللطينية» أو «الرومانث»، لكن الأجيال العربية الأندلسية صارت ازدواجية اللغة، تتكلم عربية الأب و»لطينية» الأم، بسبب التزاوج بين العرب الفاتحين ونساء البلد الجديد. وقد شجع هذا الوضع على استعمال مفردات رومانث في شعر الاجيال الجديدة، إلى جانب استعداد أكبر لتطوير شكل القصيدة التراثية، استمراراً للمُخَمَّس والمُسمَّط في عدد أسطر/أبيات المقطوعةالشعريّة، والمراوحةبين أوزانها وقوافيها.
كان الشعر المعروف في العصور الوسطى الأوروبية يكاد يكون وقفاً على العارفين باللغة اللاتينية الأدبية، وهؤلاء قليلون خارج حدود رجال الكنيسة الكاثوليكية، المسيطرة على الثقافة، ومنها الشعر الذي لم يكن يخرج كثيراً عن الموضوعات الكنسية والصلوات. ولا شك أن كان هناك نوع من الشعر الدنيوي عند ظهور العامّيّات باللغات الأوروبية من القرن الثاني عشر فصاعداً ولكن هذا مما لا يشكل اساساً لظهور الموشح الأندلسي ومن بعده الزجل بعامية قرطبة، في أواخر القرن الثالث عشر، كما ادَّعى بعض أتباع النظرية الأوروبية، لكي يُبعدوا الأثر العربي من تراث الشعر الغني. فلو كان ثمة من شِعر بلغات عامية أوروبية يستحقّ الحفظ، لما تردَّد الملك «الفونسو العاشر/الحكيم، الذي حكم في قشتالة وليون 32 سنة (1252 ـ 1284) وكان يُعنى بجمع تراث بلاده حفظاً وترجمة في دار الترجمة على غرار «بيت الحكمة» للمأمون العباسي. وبظهور الموشح وتطوره، وقد وضع أساساً للغناء، بدأ الشعراء في إقليم «ﭙروﭭنس» في الجنوب الغربي من فرنسا الحالية بمحاكاة هذا النوع من الشعر العربي الذي جاءهم من جيرانهم العرب المسلمين في الأندلس، ذات العلاقات المتطورة مع ممالك الشمال المسيحي . كان أول هؤلاء الشعراء البروﭭنسين «كيّوم التاسع» أمير آكيتين (1571 ـ 1127) الذي كان معاصراً لعدد من الوشّاحين الأندلسيين، وبخاصة الزجّال «ابن قزمان» وكانت الزيارات متبادلة بين قصور الأندلس، حيث الشعر والغناء والرقص، وبين الممالك المسيحية في الشمال. ويبدو أن الأمير البروﭭنسي قد استهواه ما وجد في القصور الأندلسية من شعر يُغنى، ولم يكن من الصعب عليه أو على غيره من الشعراء الوصول إلى معنى الموشَّحات والأزجال في مجتمع أندلسي يتكلم اللغتين. وقد ترك لنا هذا «التروبادور» الأول، هذا الشاعر الجوال الذي كان يحمل عوده، تلك الآلة الموسيقية التي حملها علي بن نافع، زرياب، من بغداد إلى الأندلس وحمل معه تراثاً شعرياً عربيا، ومواقف من الحب والغزل، لم تكن معروفة في أوروبا الرازحة تحت قرون من السيطرة الكنسية. يتضح لدى التحليل أن عدداً من قصائد كيّوم الإحدى عشرة المعروفة، تتشابه تشابها عجيباً مع موشحات للتطيلي أو أزجال ابن قزمان معاصره. وقد تبع التروبادو الأول حوالي 400 من شعراء ﭙروﭭنس حتى حدود القرن الرابع عشر.
بدأ الباحثون الأوروبيون بالتساؤل عن مصدر هذا الشعر الوليد بعامية أوروبية من القرن الثاني عشر، فنشر الإيطالي «جياماريا بارييري» عام 1571 كتابا عن «أصول الشعر المقفّى» يتحدث عن انتشار الشعر العربي المقفّى بين الإسبان والبروﭭنسيين، ولم تكن القافية معروفة في الشعر الإغريقي أو اللاتيني. فمن أين ظهرت القافية أول مرة في أول شعر دنيوي جديد، مثل الشعر البروﭭنسي؟ وتوالت الدراسات الأوروبية تتساءل عن مصدر أول شعر أوروبي بعامية بروﭭنس أولاً، ثم تطور في شكل الموشح ونظام قوافيه، وفي الموقف من المرأة والحب الدنيوي، الذي لا يوجد مثله الا في هذا الشعر العربي الأندلسي.
وردت أول إشارة إلى الموشَّح في كتب التراث الأندلسي عند ابن بسّام الشنتريني (ت ـ 1147م) في كتابه «الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» (1106 ـ 1181) في قوله إن «مخترع» الموشح هو مُقدَّم بن معافي القبري الضرير، من شعراء الأمير عبد الله بن محمد المرواني (888 ـ 912م) ولا يذكر ابن بسّام أو غيره شيئا من موشحات مقدَّم، بل تذكر مصادر أخرى أمثلة من أول وشّاح معروف، هو «عُبادة بن ماء السماء» (ت 1028) الذي اشتهر بموشحته:
من وَلي ٭في أمَّةٍ أمراً ولم يَعدِل ٭يُعزَلِ ٭ﺇلِإ لحاظ الرشأ الأكحلِ
وقد حذا شعراء أندلسيون آخرون حذو عبادة فتجمع لدينا اليوم 488 موشحة حققها د. سيد غازي (1979) من المخطوطات التي تيسَّرت له. يبدأ الموشح ببيتين، تتبعهما أشطار 5 ـ 7 وتنتهي ببيتين على غرار المطلع، ويغلب أن تكون بلغة الرومانث أو بالعامية الأندلسية، تسمى «الخرجة» يقصد بها التظرُّف وإنهاءالغناء بالتصفيق أو الرقص. أثارت هذه الخرجة باللغة «الأعجمية» أو الرومانث عدداً من الباحثين الأوروبيين، أو الأمريكان، لاحقاً. وحاولوا القول إن هذه الخرجة الأعجمية بقايا شعر رومانثي (ضاع) وراحوا يبحثون ليقولوا ان الموشح يقوم على ذلك الشعر المحلي الرومانثي . ولكن جميع الأبحاث الرصينة تشير إلى قول ابن بسّام إن «الوشّاح يعملها على أشطار الأشعار المهملة، غير المستعملة» أي على الأوزان التي لم يذكرها الخليل من بين بحوره الستة عشر. ولكن التحليل الدقيق للموشحات، وللأزجال من بعدها، يبين أن أوزان غالبية الموشحات تقع على الأوزان الخليليلة الكاملة، وبعضها أوزان مطورة بالمد والخبن والطيّ لتناسب الغناء، وهو ما لم يتطرق اليه الباحثون من غير العرب، وأغلبهم لا يتقن العربية، لذا فهو لا يدرك حساسية الأوزان.
من الملاحظ أن أهم من درس الموشحات والأزجال من ا لأوروبيين هم من الإسبان، ومن رجال الكنيسة الكاثوليكية في الغالب، من أمثال «أنخل كونذالث بالانثيا» و«آسين ﭙالاثيوس» و«إميليو كارثيا كومذ» إلى جانب الفرنسي «ليفي ﭙروﭭنسال». في أبحاث هؤلاء من العناية والدقة ما يقصّر عنه الباحثون العرب، على قلتهم، وهو أمر يؤسف له.
وأول وأهم كتاب من اللاحقين علي ابن بسّام هو المصري ابن سناء المُلك (1155 ـ 1211م) في كتابه «دار الطراز في عمل الموشحات» (1198). مثل ابن بسّام يشير ابن سناء المُلك إن الموشحات «صنعة» فيها براعة الألفاظ والأوزان والصور، أكثر منها إلهاماً كما في الشعر التراثي. وهذه «الصنعة» هي التي دفعت التروبادور البروﭭنسي إلى «صناعة» أغنيته، وغالباً إلى «صناعة «الحانها، كما يخبرنا التروبادور الأول «كيوم التاسع» وأغلب من تبعه من الأربعمئة المعروفين.
بقي الموشح مزدهراً في إقليم ﭙروﭭنس الفرنسي وما جاوره، وتمدد إلى أصقاع أخرى إلى أن هجم على حضارة الجنوب الفرنسي وغناها البابا إنوسنت (البريء) عام 1209 فقضى عليها فتفرق الشعراء التروبادور وأغلبهم حلّ في صقليا حيث كان الامبراطور يرعى الشعراء، وحيث كانت لهجة ﭙروﭭنس مفهومة، بل إن بعض شعراء صقليا كانوا ينظمون بها. ومن صقليا انتشر شعر التروبادور بأوزانه ومقطعاته إلى إيطاليا فتلقفها «دانته» وأتباعه من جماعة «الأسلوب الحلو الجديد» فأشاعوا مفهوم الحب الدنيوي الجديد ومن المرأة، فكانت لدينا «سونيتو» إيطالية، بتلك اللغة العامية المنسلخة عن اللاتينية، وصارت «بياتريجه» و»لورا» من صور النساء التي لم تعرفها أوروبا القروسطية، وامتدت إلى «جولييت» وأمثالها في الشعر الأوروبي في عصر الإنبعاث، وصولاً إلى شكسبير وقصائد الحب، والباحث المنصف لا يخفق في إدراك الشفق الأول فيها من شعر الحب في التراث العربي.