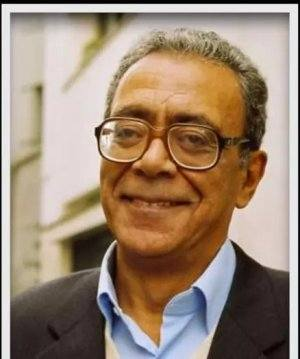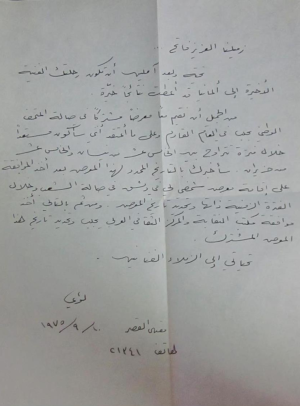بيد أنني أجد لزامًا عليَّ بعد ذلك كله التوضيح بأني لست من أنصار توسيع نطاق الأدب المقارن بحيث يشمل أيضًا المقارنة بين الأدب وغيره من ألوان الإبداع والمعارف طبقًا لما ينادي به رينيه ويليك، وكذلك هـ. هـ. ريماك، الذي يعرفه (حسبما ورد في" Dictionnaire international des Termes Litteraired)" في مادة "Litteraure Comparee/ Comparative literature") على النحو التالي: "The study of literature beyond the confines of one particular country، and the study of the relationships between literature on the one hand and the other areas of Knowledge and belief، such as the arts، philosophy، history، the social sciences، the sciences، religion، etc، on the other hand"، بل أرى في هذا تمييعًا للأمور؛ إذ من الواضح أنه لا يوجد في الواقع تجانس بين هذا اللون من الدراسة والمقارنة بين أدبين مختلفين، إننا في الأدب المقارن ندرس وجوه الاختلاف أو الاتفاق أو الصلة بين أدب وأدب، فلنبقَ داخل دائرة الأدب ولا نوسع الخرق على الراقع، وإلا لم تعد هناك حدود تميز هذا الميدان عن غيره من الميادين، ونحن بطبيعة الحال لا ننكر على أحد أن يدرس ما يشاء، بل كل ما نقوله هو أننا لا نريد تمييع الحدود؛ حتى يكون للأدب المقارن شخصيته مثلما لكل علم آخر من العلوم المتصلة بالأدب وغير الأدب شخصيته الواضحة المحددة، ولا يتحول لمثل مُرقَّعة الدرويش التي تتكون من قصاصات قماش متباينة الألوان والأشكال مخيط بعضها إلى بعض، وعلى هذا فإن مقارنة العقاد والمازني، في شبابهما في عشرينيات القرن البائد مثلًا، بين الشعر وبين الفلسفة والفنون الجميلة، على ما فيها من حساسية فنية وعمق في التحليل وسعة في الأفق، لا تعد في رأيي من الأدب المقارن، على عكس ما حاول د. علي شلش أن يصنفها؛ (انظر كتابه: "الأدب المقارن بين التجربتين الأمريكية والعربية"/ 160 - 161).
لقد كان الدكتور شلش، بإلماحته إلى العقاد والمازني وغيرهما، يرد على د. كمال أبو ديب في دعواه بأن "محاولات تجاوز تحديد الأدب المقارن بدراسة التأثير والتأثير في الغرب غير موجودة في العربية"، ومع هذا فقد انتقد د. حسام الخطيب (في كتابه: "الأدب المقارن من العالمية إلى العولمة"، الذي رأى النور بعد صدور كتاب شلش بست سنوات كاملات)، ضآلة الاهتمام بين النقاد العرب بالربط بين الأدب والفنون الأخرى، بما قد يرجح أنه لم يتنبه إليه وإلى ما رد به على بلديِّه الدكتور أبو ديب؛ (انظر د. حسام الخطيب/ الأدب المقارن من العالمية إلى العولمة/ المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث/ الدوحة/ 2001م/ 46 - 51)، وقد جاء كلام الدكتور الخطيب في سياق الدعوة إلى انفتاح المقارنين على الفنون والمعارف الأخرى طبقًا لما يدعو به ويليك وريماك في أمريكا، وإذا كان الشيء بالشيء يُذكر فقد يكون من المفيد أن أسجل هنا أنني أصدرت منذ أكثر من سنتين كتابًا بعنوان: "التذوق الأدبي" خصصت فيه فصلاً كاملاً من بضع عشرات من الصفحات للمقابلة بين الأدب والفنون الأخرى من خِيَالة ونحت وتصوير وكاريكاتير وموسيقا وعمارة، سواء من ناحية الوسائل التي يتذرع بها كل من الطرفين في التعبير عما يريد، أو من ناحية قوة التأثير والإمكانات التعبيرية التي يوفرها، ومع هذا لم يخطر ببالي أن أعد ما فعلته من "الأدب المقارن" في شيء، بل لست أجد في نفسي مطاوعة لهذا التصنيف، وأرى من الأوفق وضعه في خانة "التذوق الأدبي" كما عنونته، أو ربما يمكن إدخاله باب "نظرية الأدب" إن كان لا بد من البحث له عن ميدان آخر، وأرى أن د. حسام الخطيب وغيره من المقارنين على حق في قلقهم على مستقبل الأدب المقارن من هذه الناحية؛ إذ ينادي في مقال له بالمشباك عنوانه "الأدب المقارن في عصر العولمة - تساؤلات باتجاه المستقبل" بوجوب "حل مشكلة التسارع في توسع الأدب المقارن من ناحية المقارنة المعرفية مع مختلف الفنون والعلوم إلى درجة اهتزاز بؤرة الارتكاز فيه، وصعوبة حصوله على الاعتراف الفكري والقوة المؤسسية في الإطار المعرفي العام، وينتج عن ذلك عادة تقويم أقسام وبرامج الأدب المقارن مقابل ما تتمتع به الآداب القومية من قوة ومكانة"؛ (انظر المقال على الرابط التالي: www.nizwa.com/ volume35/ p75_81.html).
هذا، وقد وقف د. الطاهر مكي بشيء من الأناة عند مصطلح "القومية" الذي يدخل في تعريف "الأدب المقارن" في قولنا: إن الأدب المقارن يقوم على المقابلة بين الآداب القومية المختلفة، محاولاً أن يستكشف أبعاد هذا المصطلح وما يمكن أن يثيره من مشكلات، وأطال وأجاد، لكنه في نهاية المطاف ترك الأمر دون حسم، لقد تساءل قائلاً: "ماذا نفهم من مصطلح "أدب قومي"؟ ما الحدود التي إذا تعديناها جاز لنا أن نتحدث عن أدب أجنبي وعن تأثر به أو تأثير فيه؟ هل يقوم التحديد على أسس سياسية وتاريخية أو على أسس لغوية خالصة؟"، ليجيب بأنه "بعد تأمل جادٍّ يمكن القول: إن الاحتمال الثاني أكثر قربًا وأدق منهجية وأسهل تطبيقًا؛ لأن الحدود اللغوية كانت على امتداد التاريخ أكثر ثباتًا وأقل تقلبًا: مدًّا وجزرًا من الحدود السياسية"، ثم ضرب مثالاً من ألمانيا التي كانت كيانًا سياسيًّا واحدًا إلى نهاية الحرب العالمية الثانية، ثم قسمت إلى دولتين بعدها، لكنهما ظلتا مع هذا تتكلمان لغة واحدة، ومن ثم لا يمكن أن نقارن بين أدبهما بمفهوم الأدب المقارن.
إلا أنه برغم ذلك لم يتوقف عند هذه النتيجة، بل استمر يستعرض أوضاعًا أخرى تختلف عن وضع الألمانيتين: منها مثلًا وضع الجزائريين الذين يكتبون أدبهم باللغة الفرنسية رغم أنهم ليسوا فرنسيين، ومنها وضع الهنود الذي يكتبون أدبهم باللغة الإنجليزية رغم أنهم ليسوا إنجليزًا، ومنها وضع الأدباء الأمريكان، فهم يكتبون أدبهم بالإنجليزية رغم أنهم ليسوا إنجليزًا، وكذلك معظم أدباء أمريكا اللاتينية، فهم يكتبون أدبهم باللغة الإسبانية رغم أنهم ليسوا إسبانًا، ومنها أيضًا وضع الأدباء الكنديين الذين يستخدمون اللغة الإنجليزية، وهي ليست اللغة الوحيدة التي يتحدثها أو يكتب بها الكنديون، بل تشركها في ذلك اللغة الفرنسية، ومثلهم الأدباء السويسريون، الذين لا يكتبون أدبهم بلغة واحدة، بل بلغات ثلاث، هي الفرنسية والألمانية والإيطالية... وهكذا، وهو يشير هنا إلى أن عددًا من الباحثين الأمريكان يرى أن الأدب الأمريكي والأدب الإنجليزي ليسا أدبًا واحدًا، بل أدبين مختلفين؛ لأننا بصدد أمتين متباينتين ثقافيًّا، ومن ثم أدبيًّا (الأدب المقارن - أصوله وتطوره ومناهجه/ 237 - 241).
والملاحظ أن د. الطاهر مكي قد بدأ بجعل اللغة هي الفيصل في تحديد الهوية القومية، وهو ما قاله قبلًا د. محمد غنيمي هلال، الذي يؤكد أن "الحدود الأصيلة بين الآداب القومية هي اللغات؛ فالكاتب أو الشاعر إذا كتب بالعربية عددنا أدبه عربيًّا مهما كان جنسه البشري الذي انحدر منه"؛ (الأدب المقارن/ دار نهضة مصر/ القاهرة/ 1977م/ 15)، وما زال يقول به كذلك المقارنون العرب عمومًا؛ كالدكتور محمد السعيد جمال الدين مثلًا، الذي يقرر ما قرره المرحوم هلال من أن "الحدود الأصلية بين الآداب القومية هي اللغات؛ فالكاتب والشاعر إذا كتب بالعربية عددنا أدبه عربيًّا مهما كان جنسه البشري الذي انحدر منه؛ ولذلك يُعد ما كتبه المؤلفون الفرس الذين دونوا مؤلفاتهم وآثارهم باللغة العربية داخلاً في دائرة الأدب العربي لا الفارسي"؛ (الأدب المقارن - دراسات تطبيقية في الأدبين العربي والفارسي/ ط2/ دار الاتحاد للطباعة/ 1417هـ - 1996م/ 5، ومثل د. هلال ود. مكي ود. جمال الدين في ذلك د. أحمد أبو زيد/ التمهيد الذي كتبه لعدد مجلة "عالم الفكر" الخاص بالأدب المقارن لشهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 1980م/ 8)، لكن د. الطاهر مكي قد تركنا رغم ذلك في حيرة من أمرنا، بل ربما في عَماية منه؛ إذ أثار المشكلات السالفة الذكر دون أن يجيب على الأسئلة الشائكة التي طرحها.
إن الأدباء العرب، على سبيل المثال، الذين يصطنعون في إبداعهم لغة القرآن لا يمثلون، فيما أتصور، أدنى مشكلة في تطابق اللغة والقومية، فنحن كلنا ندين بدين واحد، ونصطنع لغة واحدة في كتابتنا وفي حياتنا اليومية على السواء، بل إن الأقليات التي لها لغة أخرى إلى جانب العربية تتكلم هي أيضًا لغة يعرب، فضلًا عن أن التاريخ القريب والبعيد واحد أو متشابه على الأقل.
وبالمثل، فإن العادات والتقاليد هي أيضًا واحدة، وإن لم يكن من أجل شيء فمن أجل أنها في معظمها مستمدة من الإسلام، كما أننا نعيش في منطقة واحدة متلاصقين لا متقاربين فقط، إلى جانب أننا جميعًا نتطلع إلى أن تقوم بيننا في يوم من الأيام وحدة تجمعنا وتقوينا وتكفل لنا الاحترام الدولي مثلما كان الحال من قبل حين كانت هناك دولة واحدة، أو عدة دول تخضع (ولو خضوعًا اسميًّا) لخليفة واحد، وفوق كل ذلك فإن الإسلام الذين ندين به يدعونا ويلحف في الدعاء إلى أن نعتصم بالتعاون والتساند والتواصل والأخوة الدينية، وأن نبتعد عن أي شيء يمكن أن يهدد هذه الوحدة أو يلحق بها الضرر، ونحن - بحمد الله - ما زلنا نستمسك بديننا رغم وجود أقلية دينية هنا أو جماعة تختلف في اتجاهاتها الفكرية أو السياسية عن التيار العام الهادر هناك، مما لا يمكن أن يخلو منه أي بلد؛ لأن النقاء مستحيل، وبخاصة في هذا العصر الذي زاد فيه تجاور الاتجاهات الثقافية وتعايش الديانات داخل حدود الوطن الواحد.
هذا عن الأدباء العرب الذين يعيشون في الوطن العربي ويبدعون أدبهم باللغة العربية، لكن ماذا عن العرب الذين يعيشون في أمريكا مثلًا ويكتبون أدبهم باللغة الإنجليزية، أو في فرنسا ويكتبون أدبهم باللغة الفرنسية؟ وماذا عن الكرد الذين يعيشون في العراق مثلًا ويبدعون أدبهم باللغة الكردية، أو البربر الذين يعيشون في بلاد المغرب العربي ويكتبون أدبهم بالأمازيغية؟ وماذا عن الفُرس الذين يكتبون أدبهم باللغة العربية؟ إن المسألة في كل حالة من هذه الحالات تحتاج إلى تأنٍّ في التحليل، ومرونة في التفكير، وربما لم نصل بعد ذلك كله إلى حلٍّ مُرْضٍ؛ إذ دائمًا ما توجد على الحدود الفاصلة بين المفاهيم والمبادئ حالات تشكل علامة استفهام وقلق، ولا يصل الباحث بشأنها إلى شيء حاسم.
فأما في حالة الكُرد الذين يكتبون أدبهم باللغة الكردية فأرى أن يطلق على ما يكتبون: "الأدب الكردي"؛ حيث تتطابق في حالتهم اللغة والعرق، ومثلهم في ذلك البربر الذين يكتبون أدبهم بالأمازيعية، فيسمى هذا الأدب بـ: "الأدب الأمازيغي"، لكن الأمر يختلف في حالة العرب الذين يعيشون في فرنسا ويصطنعون لأدبهم الفرنسية، ولكنهم لا يكتبون إلا عن بلادهم الأولى ومشاكل المجتمعات التي وفدوا منها، ولا ينتمون إلى القومية الفرنسية، ولا يشعرون من الناحية السياسية أنهم فرنسيون، حتى لو تجنسوا بالفرنسية.
والدليل على هذا أن أعمالهم إنما تتناول أوطانهم وأوضاع شعوبهم التي نزحوا منها، سواء كان ذلك النزوح نزوحًا أبديًّا أو مؤقتًا، إن العبرة هنا بمضمون الأدب ورُوحه وطَعْمه وتوجهاته واهتماماته، وعلى هذا نقول عن ذلك اللون من الكتابة: إنه "أدب عربي مكتوب بالفرنسية"، وهذا الأدب يمكن أن يكون محل دراسةٍ مقارنةٍ مع الأدب الفرنسي، ولكن من ناحية أخرى هدفها التعرف إلى مدى اختلاف أسلوب الكاتب عن الأسلوب الفرنسي الأصيل أو اتفاقه معه في نكهته ومفرداته وتراكيبه وعباراته وصوره، ومثله ما يكتبه الأدباء الهنود أو أدباء جنوب إفريقيا في بلادهم بالإنجليزية؛ إذ إن أعمالهم في هذه الحالة إنما ترتبط ببلادهم ومجتمعاتها وتاريخها وتطلعاتها ومشاكلها وعاداتها وتقاليدها وأديانها وحياتها اليومية، لا ببلاد جون بول، ولكن إذا كان الأديب من هذا النوع يعيش في فرنسا مثلًا أو بريطانيا واندمج اندماجًا تامًّا في الوسط الجديد، وأضحى يعتنق ما يعتنقه أصحاب ذلك الوسط، ويردد آراءهم، ويتخذ مواقفهم، وينطلق من رؤيتهم الحضارية والقومية، وينصبغ بصبغتهم الاجتماعية، ونسي وطنه وقوميته القديمة، ولم يعد يهتم بمشكلات الأمة التي كان ينتسب إليها من قبل.... إلخ - فعندئذ فالمنطق يقتضي إلحاقه بالأدب الذي يصطنع لغته إذًا.
أما أمريكا، التي يُدرَس أدبها عادة على أنه جزء من الأدب الإنجليزي، فهناك من باحثيها، كما رأينا، من يناضل ضد الفكرة القائلة بأن ما يكتبه الأمريكان والإنجليز هو أدب واحد؛ "لأننا بصدد أمَّتين متباينتين، سلكتا منذ القرن التاسع عشر طريقًا ثقافيًّا، وبالتالي: أدبيًّا، متباعدًا تمامًا، ويرون أن إنتاجهما الأدبي يدخل في مجال الأدب المقارن على الرغم من أنهما مكتوبان في اللغة نفسها"؛ (د. الطاهر مكي/ الأدب المقارن - أصوله وتطوره ومناهجه/ 240)، ولا شك أن أمامنا في هذه الحالة قوميتين مختلفتين لا تتطلعان إلى قيام وحدة بينهما، إن لم يكن بسبب أي شيء آخر فبسبب المسافة الشاسعة التي تفصل بين الشعبين، كما أن بينهما تاريخًا من الصراع والحروب، فضلًا عن الاختلاف في مضمون الأدبين وروحيهما واهتمامات كل منهما وطعمه، مما عليه المعوَّل الأكبر في مثل هذا التمييز كما قلنا من قبل، ومِثْلُ أمريكا في ذلك الأمرِ القارةُ الأسترالية، باختصار نخرج من هذا بأنه في حالة تطابق اللغة والقومية أو الوطن لدى الأديب فحينئذ فلا مشكلة، أما إذا كان ثمة تعارض فالعبرة بالشعور القومي للكاتب واتجاهاته وهمومه وبمضمون العمل الإبداعي وروحه، لكن هل تراني قلت الكلمة الفصل في هذا السبيل؟ لا أظن، بل هي مجرد وجهة نظر ينبغي أن تدرس وتحلل وتُبدَى فيها الآراء، وهذا كل ما أستطيع أن أقوله، ولا أزيد.
كذلك أثار د. محمد السعيد جمال الدين نقطة جديرة بالتأمل والبحث؛ إذ يرى أن نشوء علم "الأدب المقارن" في القرن التاسع عشر يعد مفارقة تستوقف النظر: "والحق أننا نعجب لنشأة هذا العلم في أوربا في وقت سادتها روح العصبية القومية ونشبت الحروب بين دولها، وكان التنازع والتكالب على اكتساب المغانم الاستعمارية على أشُدِّه بينها، مما عمق فكرة الأثرة القومية والعصبية المقيتة في نفوس الشعوب الأوربية، وأخذ كل واحد من هذه الشعوب ينظر إلى الآخر نظرة العداء والازدراء، ووجه العجب هنا أن طبيعة الأدب المقارن لا تتفق مطلقًا مع روح التعصب والأثرة القومية؛ فهو يقف في الوسط ليرصد التيارات الفكرية المتبادلة بين الآداب المختلفة، ويرقب عوامل التأثير والتأثر فيما بينها، فكيف يتسنى لهذا العلم أن يقوم بمهمته هذه في ظل جو مشبع بعوامل الاستعلاء والتميز القومي؟... كيف يمكن لهذا العلم أن يُعنَى بدراسة نقاط الالتقاء بين الآداب والسمات المشتركة بينها في وقت كان همُّ كل أمة من هذه الأمم الأوربية منحصرًا في بيان أوجه الاختلاف والتعارض بين أدبها وآداب غيرها، وفي أن أدبها هو الأكثر كمالًا وفضلًا؟ لقد كان المزاج الأوربي الذي ساد القرنين الثامن عشر والتاسع عشر مشبعًا بأسباب التنافر والتباعد، لا بمظاهر التآزر والتقارب، حقًّا لقد كانت هناك نقط التقاء توحد بين الأدباء الأوربيين في ذلك الوقت؛ إذ كانوا جميعًا يرون في شعراء اليونان واللاتين القدماء مثَلهم الأعلى الذي يتعين عليهم أن يحتذوه، إلا أن روح القومية التي سادت في ذلك الوقت كانت تعصف بكل رغبة في التسليم بتبادل التأثير بين الآداب الأوربية بعضها وبعض.
لكن ظهرت في ألمانيا في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر حركة نادت بـ: "الأدب المقارن"، حيث تتجمع الآداب المختلفة كلها في أدب عالمي واحد يبدو وكأنه نهر يرفده كل أدب من الآداب القومية بأسمى ما لديه من نتاج إبداعي وقيم إنسانية وفنية، وكان زعيم هذا الاتجاه الشاعر الألماني جوته (1749 - 1832م)، الذي عد نفسه نموذجًا تتجمع فيه صفة العالمية؛ فلقد كان مطلعًا على الآداب الأوربية متمثلًا قيمها واتجاهاتها، ومد بصره إلى خارج الحدود الأوربية الضيقة المضطربة، فوجد في الآداب الشرقية الإسلامية عاملاً رحبًا لانهائيًّا من الطُّهر والطمأنينة، بدا له وكأنه قبس من نور النبوة، كما وجد منبعًا صافيًا من الإبداع والإلهام المتجدد، عبَّر عنه بوضوح في ديوان سماه: "الديوان الشرقي للمؤلف الغربي" كتب في مقدمته: "هذه باقة من القصائد يرسلها الغرب إلى الشرق، ويتبين من هذا الديوان أن الغرب قد ضاق بروحانيته الضعيفة الباردة، فتطلع إلى الاقتباس من صدر الشرق".
ولقد استطاع جوته بثقافته العميقة الواسعة ومكانته البارزة وقدرته الفذة على الإبداع أن يجعل فكرة التواصل بين الآداب الأوربية خاصة، والآداب كلها بعامة، تستقر في الأذهان، وتصبح من الأمور المسلمة التي لا تقبل الجدل على الرغم من طغيان العصبية القومية في أوربا... وهكذا بدت دعوة "الأدب العالمي" وكأنها كانت بمثابة تمهيد طبعي لنشوء فكرة "الأدب المقارن"... "(د. محمد السعيد جمال الدين/ الأدب المقارن - دراسات تطبيقية في الأدبين العربي والفارسي/ ط2/ دار الاتحاد للطباعة/ 1417هـ - 1996م/ 7 - 11).
والواقع أنه لا ينبغي أن يكون ثمة عجب ولا يحزنون؛ إذ مَن قال: إن "الأدب المقارن" قد نشأ وهدفه التقريب بين الشعوب والأمم على أساس من روح الأخوة؟ إن هناك فرقًا كبيرًا بين رغبة بعض العلماء والمفكرين في أن يؤدي الأدب المقارن إلى نشوء هذه الروح وبين استجابة النفوس البشرية التي تمارسه وتشتغل (أو على الأقل: تهم) به لهذه الروح؛ ذلك أنه كان هناك دائمًا، وسيظل هناك دائمًا، فجوة بين المثال والواقع، كبرت هذه الفجوة أم صغرت، فهذه هي طبيعة "الطبيعة البشرية"، وعلى أية حال فهناك عوامل أخرى للأدب المقارن كانت وما زالت وراء الاهتمام بهذا الفرع من فروع البحث: منها إرضاء الفضول البشري الذي يريد أن يعرف من أين جاء هذا العنصر أو ذاك إلى ذاك الأدب أو هذا، وإلى أين يمكن أن يذهب بعد ذلك.
ومنها أيضًا الرغبة الفطرية في المقارنة بين المتشابهات والمتخالفات في أي شيئين من جنس واحد، إن لم يكن من أجل شيء، فمن أجل إرضاء النزعة العقلية المقارنية التي لا تهدأ عند بعض الناس إلا إذا اشتغلت، ولا ترتاح إذا بقيت خاملة لا وظيفة لها، ثم هم، بعد هذا كله، لا يمكنهم أن ينسوا قوميتهم ولا حبهم لبلادهم وشعوبهم، ولا إيثارهم لحضارتهم وعاداتهم وتقاليدهم وأذواقهم وفنونهم وآدابهم، وبخاصة إذا كانوا ينمتون إلى أمم قوية تتطلع إلى جر الأمم الأخرى وراءها كأنها القاطرة وعرباتها، ولا تريد لأحد أن يخالف عن رأيها، ولا أن يكون له ذوق يتميز عن ذوقها، بله يمتاز عليه، أما الكلام والتشدق به فما أسهله! لكن الكلام وحده لا يجعل الأمنيات حقيقة واقعة محترمة من الجميع! وإذا كانت الطبيعة البشرية لم يستعص عليها أن تتلاعب بالدين ذاته وأن تحوله إلى أداة للتكسب والخداع والقتل والتدمير في كثير من الأحيان، أفنظن أن الأدب المقارن سوف يصمد أمامها ويكون عندها أقدس وأجل وأكثر تبجيلاً؟!
وفي كلام رينيه ويليك التالي ما يؤكد ما قلته؛ فقد ذكر أنه، وإن كان ظهور الأدب المقارن قد جاء رد فعل ضد القومية الضيقة التي ميزت الكثير من بحوث القرن التاسع عشر احتجاجًا ضد الانعزالية لدى الكثير من مؤرخي الآداب الأوربية، فضلًا عن تصدر التبحر في هذا العلم من بعض العلماء الذين يقعون على مفترق الطرق بين الشعوب أو على الحدود بين شعبين على الأقل؛ أي: ينتمون مثلًا لأبوين من بلدين أوربيين مختلفين - فإن "هذه الرغبة الأصيلة في أن يعمل دارس الأدب المقارن كوسيط بين الشعوب وكمصلح لذات بينها غالبًا ما طمسته وشوهته المشاعر القومية الملتهبة التي سادت في تلك الفترة وفي ذلك الموقع... (و) هذا الدافع الوطني في أساسه، الذي يكمن خلف العديد من دراسات الأدب المقارن في فرنسا وألمانيا وإيطاليا وغيرها أدى إلى نظام غريب من مسك الدفاتر الثقافية، وإلى الرغبة في تنمية مدخرات أمة الباحث عن طريق إثبات أكبر عدد ممكن من التأثيرات التي أثرتها أمته على الشعوب الأخرى، أو عن طريق إثبات أن أمة الكاتب قد هضمت أعمال أحد العظماء الغرباء، وفهمته أكثر من أي أمة أخرى"... ثم مضى ويليك فأعطانا أمثلة على هذا التعصب القومي من واقع الدراسات الأدبية المقارنة في فرنسا وأمريكا؛ (رينيه ويليك/ مفاهيم نقدية/ ترجمة د. محمد عصفور/ 366 - 396).
خلاصة القول: إن الشعارات واللافتات المرفوعة، أو حتى العوامل والبواعث التي تكمن وراء نشوء عمل ما شيء، والواقع الذي ينتهي إليه هذا العمل أو يساق نحوه سوقًا شيء آخر، باختصار: الطبيعة البشرية هي هي الطبيعة البشرية، ولا أحسبها ستتغير في المستقبل حتى لو دخلت تطورات جذرية على التكوين البيولوجي للإنسان، كما يلمح بعض العلماء الآن، اعتمادًا على ما يظنونه أو يرجونه من إمكانات التناسخ البشري، وهل تغير الأوربيون فصاروا أكثر تواضعًا ورحمة ورحابة أفق حضاري وثقافي، وهم الذين بلوروا "الأدب المقارن"، ومارسوه حتى الآن على مدار عشرات السنين، ورفعوا لواء العالمية والكوكبية، وما أدراك من هذا الكلام الكبير، الذي حين نأتي إلى الواقع فإننا لا نرى منه شيئًا؟ إنهم لا يريدون أن يروا إلا ثقافتهم وأذواقهم ونظمهم، وبخاصة أمريكا، التي لا تعرف في فرض رؤيتها على الآخرين إلا الدمار والقتل والسلاح النووي! فليقل الغربيون أو غيرهم ما شاؤوا، فليس على الكلام من حرج، لكن المهم هو التنفيذ على أرض الواقع والحقيقة، والأدب المقارن ما هو إلا علم من العلوم، يمكن أن يستغل استغلالاً حسنًا، ويمكن أيضًا أن يستغل استغلالاً سيئًا، والعبرة بالنية والإرادة عند ممارسيه، مع ملاحظة أننا مهما بذلنا من جهد في سبيل التخلص من الأنانية القومية، فلن ننجح تمام النجاح، مثلما لن ننجح إذا ذهبنا نحاول التخلص تمامًا من أنانيتنا الفردية الشخصية، وحسبنا أن نخفف من غلوائها، ونكفكف من شططها، فلا يجيء التعصب ظالِمًا لا يحتمل، وهذا هو محمد أركون نفسه، على رغم كل تحمسه لما عند الغربيين، يقرر أن "تدريس الأدب المقارن في الجامعات الأوروبية لا يتعرض لدراسة الأدب العربي والإيراني وغيرهما، وكذلك الأمر فيما يتعلق بالفلسفة التي ازدهرت في السياق الإسلامي بين القرنين الثامن والثاني عشر الميلادي، فإن أحدًا لا يهتم بها في الغرب، والعلوم الاجتماعية المختصة بدراسة الأديان لا تزال مستمرة في تجاهلها للإسلام، أو تخصص له مكانة ضئيلة وهامشية"؛ انظر، في موقع "المعرفة" على المشباك، عرض إبراهيم غرابية لكتاب محمد أركون: "الإسلام، أوروبا، الغرب - رهانات المعنى وإرادات الهيمنة")، وهو ما يرينا على نحو أو آخر أن الظن بأن طبيعة الأدب المقارن من شأنها القضاء التلقائي على التعصب القومي أو الديني هو ظن لا يقوم على أساس.
بالتأكيد سوف يساعدنا الأدب المقارن على مزيد من فهم بعضنا بعضًا، لكنه لن ينجح في قلع ما غرس في أغوار نفوسنا العميقة منذ أول الخلق، إن الغربيين بوجه عام، بحسب الرطانة الجديدة، لا يريدون "مثاقفة" بينهم وبين الآخرين، بل يريدون في أقل القليل غزوهم ثقافيًّا، ولعل من الخير الاستعانة بالفقرة التالية، وهي من مقال على المشباك للدكتور مسعود عشوش بعنوان: "المثاقفة أبرز آليات حوار الحضارات" في موقعه: "يمنتا yemenitta"، لتوضيح ما أقصد قوله: "في الأصل المثاقفة هي عملية التغيير أو التطور الثقافي الذي يطرأ حين تدخل جماعات من الناس أو شعوب بأكملها تنتمي إلى ثقافتين مختلفتين في اتصال وتفاعل يترتب عليهما حدوث تغيرات في الأنماط الثقافية الأصلية السائدة في الجماعات كلها أو بعضها.
.
.
لقد كان الدكتور شلش، بإلماحته إلى العقاد والمازني وغيرهما، يرد على د. كمال أبو ديب في دعواه بأن "محاولات تجاوز تحديد الأدب المقارن بدراسة التأثير والتأثير في الغرب غير موجودة في العربية"، ومع هذا فقد انتقد د. حسام الخطيب (في كتابه: "الأدب المقارن من العالمية إلى العولمة"، الذي رأى النور بعد صدور كتاب شلش بست سنوات كاملات)، ضآلة الاهتمام بين النقاد العرب بالربط بين الأدب والفنون الأخرى، بما قد يرجح أنه لم يتنبه إليه وإلى ما رد به على بلديِّه الدكتور أبو ديب؛ (انظر د. حسام الخطيب/ الأدب المقارن من العالمية إلى العولمة/ المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث/ الدوحة/ 2001م/ 46 - 51)، وقد جاء كلام الدكتور الخطيب في سياق الدعوة إلى انفتاح المقارنين على الفنون والمعارف الأخرى طبقًا لما يدعو به ويليك وريماك في أمريكا، وإذا كان الشيء بالشيء يُذكر فقد يكون من المفيد أن أسجل هنا أنني أصدرت منذ أكثر من سنتين كتابًا بعنوان: "التذوق الأدبي" خصصت فيه فصلاً كاملاً من بضع عشرات من الصفحات للمقابلة بين الأدب والفنون الأخرى من خِيَالة ونحت وتصوير وكاريكاتير وموسيقا وعمارة، سواء من ناحية الوسائل التي يتذرع بها كل من الطرفين في التعبير عما يريد، أو من ناحية قوة التأثير والإمكانات التعبيرية التي يوفرها، ومع هذا لم يخطر ببالي أن أعد ما فعلته من "الأدب المقارن" في شيء، بل لست أجد في نفسي مطاوعة لهذا التصنيف، وأرى من الأوفق وضعه في خانة "التذوق الأدبي" كما عنونته، أو ربما يمكن إدخاله باب "نظرية الأدب" إن كان لا بد من البحث له عن ميدان آخر، وأرى أن د. حسام الخطيب وغيره من المقارنين على حق في قلقهم على مستقبل الأدب المقارن من هذه الناحية؛ إذ ينادي في مقال له بالمشباك عنوانه "الأدب المقارن في عصر العولمة - تساؤلات باتجاه المستقبل" بوجوب "حل مشكلة التسارع في توسع الأدب المقارن من ناحية المقارنة المعرفية مع مختلف الفنون والعلوم إلى درجة اهتزاز بؤرة الارتكاز فيه، وصعوبة حصوله على الاعتراف الفكري والقوة المؤسسية في الإطار المعرفي العام، وينتج عن ذلك عادة تقويم أقسام وبرامج الأدب المقارن مقابل ما تتمتع به الآداب القومية من قوة ومكانة"؛ (انظر المقال على الرابط التالي: www.nizwa.com/ volume35/ p75_81.html).
هذا، وقد وقف د. الطاهر مكي بشيء من الأناة عند مصطلح "القومية" الذي يدخل في تعريف "الأدب المقارن" في قولنا: إن الأدب المقارن يقوم على المقابلة بين الآداب القومية المختلفة، محاولاً أن يستكشف أبعاد هذا المصطلح وما يمكن أن يثيره من مشكلات، وأطال وأجاد، لكنه في نهاية المطاف ترك الأمر دون حسم، لقد تساءل قائلاً: "ماذا نفهم من مصطلح "أدب قومي"؟ ما الحدود التي إذا تعديناها جاز لنا أن نتحدث عن أدب أجنبي وعن تأثر به أو تأثير فيه؟ هل يقوم التحديد على أسس سياسية وتاريخية أو على أسس لغوية خالصة؟"، ليجيب بأنه "بعد تأمل جادٍّ يمكن القول: إن الاحتمال الثاني أكثر قربًا وأدق منهجية وأسهل تطبيقًا؛ لأن الحدود اللغوية كانت على امتداد التاريخ أكثر ثباتًا وأقل تقلبًا: مدًّا وجزرًا من الحدود السياسية"، ثم ضرب مثالاً من ألمانيا التي كانت كيانًا سياسيًّا واحدًا إلى نهاية الحرب العالمية الثانية، ثم قسمت إلى دولتين بعدها، لكنهما ظلتا مع هذا تتكلمان لغة واحدة، ومن ثم لا يمكن أن نقارن بين أدبهما بمفهوم الأدب المقارن.
إلا أنه برغم ذلك لم يتوقف عند هذه النتيجة، بل استمر يستعرض أوضاعًا أخرى تختلف عن وضع الألمانيتين: منها مثلًا وضع الجزائريين الذين يكتبون أدبهم باللغة الفرنسية رغم أنهم ليسوا فرنسيين، ومنها وضع الهنود الذي يكتبون أدبهم باللغة الإنجليزية رغم أنهم ليسوا إنجليزًا، ومنها وضع الأدباء الأمريكان، فهم يكتبون أدبهم بالإنجليزية رغم أنهم ليسوا إنجليزًا، وكذلك معظم أدباء أمريكا اللاتينية، فهم يكتبون أدبهم باللغة الإسبانية رغم أنهم ليسوا إسبانًا، ومنها أيضًا وضع الأدباء الكنديين الذين يستخدمون اللغة الإنجليزية، وهي ليست اللغة الوحيدة التي يتحدثها أو يكتب بها الكنديون، بل تشركها في ذلك اللغة الفرنسية، ومثلهم الأدباء السويسريون، الذين لا يكتبون أدبهم بلغة واحدة، بل بلغات ثلاث، هي الفرنسية والألمانية والإيطالية... وهكذا، وهو يشير هنا إلى أن عددًا من الباحثين الأمريكان يرى أن الأدب الأمريكي والأدب الإنجليزي ليسا أدبًا واحدًا، بل أدبين مختلفين؛ لأننا بصدد أمتين متباينتين ثقافيًّا، ومن ثم أدبيًّا (الأدب المقارن - أصوله وتطوره ومناهجه/ 237 - 241).
والملاحظ أن د. الطاهر مكي قد بدأ بجعل اللغة هي الفيصل في تحديد الهوية القومية، وهو ما قاله قبلًا د. محمد غنيمي هلال، الذي يؤكد أن "الحدود الأصيلة بين الآداب القومية هي اللغات؛ فالكاتب أو الشاعر إذا كتب بالعربية عددنا أدبه عربيًّا مهما كان جنسه البشري الذي انحدر منه"؛ (الأدب المقارن/ دار نهضة مصر/ القاهرة/ 1977م/ 15)، وما زال يقول به كذلك المقارنون العرب عمومًا؛ كالدكتور محمد السعيد جمال الدين مثلًا، الذي يقرر ما قرره المرحوم هلال من أن "الحدود الأصلية بين الآداب القومية هي اللغات؛ فالكاتب والشاعر إذا كتب بالعربية عددنا أدبه عربيًّا مهما كان جنسه البشري الذي انحدر منه؛ ولذلك يُعد ما كتبه المؤلفون الفرس الذين دونوا مؤلفاتهم وآثارهم باللغة العربية داخلاً في دائرة الأدب العربي لا الفارسي"؛ (الأدب المقارن - دراسات تطبيقية في الأدبين العربي والفارسي/ ط2/ دار الاتحاد للطباعة/ 1417هـ - 1996م/ 5، ومثل د. هلال ود. مكي ود. جمال الدين في ذلك د. أحمد أبو زيد/ التمهيد الذي كتبه لعدد مجلة "عالم الفكر" الخاص بالأدب المقارن لشهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 1980م/ 8)، لكن د. الطاهر مكي قد تركنا رغم ذلك في حيرة من أمرنا، بل ربما في عَماية منه؛ إذ أثار المشكلات السالفة الذكر دون أن يجيب على الأسئلة الشائكة التي طرحها.
إن الأدباء العرب، على سبيل المثال، الذين يصطنعون في إبداعهم لغة القرآن لا يمثلون، فيما أتصور، أدنى مشكلة في تطابق اللغة والقومية، فنحن كلنا ندين بدين واحد، ونصطنع لغة واحدة في كتابتنا وفي حياتنا اليومية على السواء، بل إن الأقليات التي لها لغة أخرى إلى جانب العربية تتكلم هي أيضًا لغة يعرب، فضلًا عن أن التاريخ القريب والبعيد واحد أو متشابه على الأقل.
وبالمثل، فإن العادات والتقاليد هي أيضًا واحدة، وإن لم يكن من أجل شيء فمن أجل أنها في معظمها مستمدة من الإسلام، كما أننا نعيش في منطقة واحدة متلاصقين لا متقاربين فقط، إلى جانب أننا جميعًا نتطلع إلى أن تقوم بيننا في يوم من الأيام وحدة تجمعنا وتقوينا وتكفل لنا الاحترام الدولي مثلما كان الحال من قبل حين كانت هناك دولة واحدة، أو عدة دول تخضع (ولو خضوعًا اسميًّا) لخليفة واحد، وفوق كل ذلك فإن الإسلام الذين ندين به يدعونا ويلحف في الدعاء إلى أن نعتصم بالتعاون والتساند والتواصل والأخوة الدينية، وأن نبتعد عن أي شيء يمكن أن يهدد هذه الوحدة أو يلحق بها الضرر، ونحن - بحمد الله - ما زلنا نستمسك بديننا رغم وجود أقلية دينية هنا أو جماعة تختلف في اتجاهاتها الفكرية أو السياسية عن التيار العام الهادر هناك، مما لا يمكن أن يخلو منه أي بلد؛ لأن النقاء مستحيل، وبخاصة في هذا العصر الذي زاد فيه تجاور الاتجاهات الثقافية وتعايش الديانات داخل حدود الوطن الواحد.
هذا عن الأدباء العرب الذين يعيشون في الوطن العربي ويبدعون أدبهم باللغة العربية، لكن ماذا عن العرب الذين يعيشون في أمريكا مثلًا ويكتبون أدبهم باللغة الإنجليزية، أو في فرنسا ويكتبون أدبهم باللغة الفرنسية؟ وماذا عن الكرد الذين يعيشون في العراق مثلًا ويبدعون أدبهم باللغة الكردية، أو البربر الذين يعيشون في بلاد المغرب العربي ويكتبون أدبهم بالأمازيغية؟ وماذا عن الفُرس الذين يكتبون أدبهم باللغة العربية؟ إن المسألة في كل حالة من هذه الحالات تحتاج إلى تأنٍّ في التحليل، ومرونة في التفكير، وربما لم نصل بعد ذلك كله إلى حلٍّ مُرْضٍ؛ إذ دائمًا ما توجد على الحدود الفاصلة بين المفاهيم والمبادئ حالات تشكل علامة استفهام وقلق، ولا يصل الباحث بشأنها إلى شيء حاسم.
فأما في حالة الكُرد الذين يكتبون أدبهم باللغة الكردية فأرى أن يطلق على ما يكتبون: "الأدب الكردي"؛ حيث تتطابق في حالتهم اللغة والعرق، ومثلهم في ذلك البربر الذين يكتبون أدبهم بالأمازيعية، فيسمى هذا الأدب بـ: "الأدب الأمازيغي"، لكن الأمر يختلف في حالة العرب الذين يعيشون في فرنسا ويصطنعون لأدبهم الفرنسية، ولكنهم لا يكتبون إلا عن بلادهم الأولى ومشاكل المجتمعات التي وفدوا منها، ولا ينتمون إلى القومية الفرنسية، ولا يشعرون من الناحية السياسية أنهم فرنسيون، حتى لو تجنسوا بالفرنسية.
والدليل على هذا أن أعمالهم إنما تتناول أوطانهم وأوضاع شعوبهم التي نزحوا منها، سواء كان ذلك النزوح نزوحًا أبديًّا أو مؤقتًا، إن العبرة هنا بمضمون الأدب ورُوحه وطَعْمه وتوجهاته واهتماماته، وعلى هذا نقول عن ذلك اللون من الكتابة: إنه "أدب عربي مكتوب بالفرنسية"، وهذا الأدب يمكن أن يكون محل دراسةٍ مقارنةٍ مع الأدب الفرنسي، ولكن من ناحية أخرى هدفها التعرف إلى مدى اختلاف أسلوب الكاتب عن الأسلوب الفرنسي الأصيل أو اتفاقه معه في نكهته ومفرداته وتراكيبه وعباراته وصوره، ومثله ما يكتبه الأدباء الهنود أو أدباء جنوب إفريقيا في بلادهم بالإنجليزية؛ إذ إن أعمالهم في هذه الحالة إنما ترتبط ببلادهم ومجتمعاتها وتاريخها وتطلعاتها ومشاكلها وعاداتها وتقاليدها وأديانها وحياتها اليومية، لا ببلاد جون بول، ولكن إذا كان الأديب من هذا النوع يعيش في فرنسا مثلًا أو بريطانيا واندمج اندماجًا تامًّا في الوسط الجديد، وأضحى يعتنق ما يعتنقه أصحاب ذلك الوسط، ويردد آراءهم، ويتخذ مواقفهم، وينطلق من رؤيتهم الحضارية والقومية، وينصبغ بصبغتهم الاجتماعية، ونسي وطنه وقوميته القديمة، ولم يعد يهتم بمشكلات الأمة التي كان ينتسب إليها من قبل.... إلخ - فعندئذ فالمنطق يقتضي إلحاقه بالأدب الذي يصطنع لغته إذًا.
أما أمريكا، التي يُدرَس أدبها عادة على أنه جزء من الأدب الإنجليزي، فهناك من باحثيها، كما رأينا، من يناضل ضد الفكرة القائلة بأن ما يكتبه الأمريكان والإنجليز هو أدب واحد؛ "لأننا بصدد أمَّتين متباينتين، سلكتا منذ القرن التاسع عشر طريقًا ثقافيًّا، وبالتالي: أدبيًّا، متباعدًا تمامًا، ويرون أن إنتاجهما الأدبي يدخل في مجال الأدب المقارن على الرغم من أنهما مكتوبان في اللغة نفسها"؛ (د. الطاهر مكي/ الأدب المقارن - أصوله وتطوره ومناهجه/ 240)، ولا شك أن أمامنا في هذه الحالة قوميتين مختلفتين لا تتطلعان إلى قيام وحدة بينهما، إن لم يكن بسبب أي شيء آخر فبسبب المسافة الشاسعة التي تفصل بين الشعبين، كما أن بينهما تاريخًا من الصراع والحروب، فضلًا عن الاختلاف في مضمون الأدبين وروحيهما واهتمامات كل منهما وطعمه، مما عليه المعوَّل الأكبر في مثل هذا التمييز كما قلنا من قبل، ومِثْلُ أمريكا في ذلك الأمرِ القارةُ الأسترالية، باختصار نخرج من هذا بأنه في حالة تطابق اللغة والقومية أو الوطن لدى الأديب فحينئذ فلا مشكلة، أما إذا كان ثمة تعارض فالعبرة بالشعور القومي للكاتب واتجاهاته وهمومه وبمضمون العمل الإبداعي وروحه، لكن هل تراني قلت الكلمة الفصل في هذا السبيل؟ لا أظن، بل هي مجرد وجهة نظر ينبغي أن تدرس وتحلل وتُبدَى فيها الآراء، وهذا كل ما أستطيع أن أقوله، ولا أزيد.
كذلك أثار د. محمد السعيد جمال الدين نقطة جديرة بالتأمل والبحث؛ إذ يرى أن نشوء علم "الأدب المقارن" في القرن التاسع عشر يعد مفارقة تستوقف النظر: "والحق أننا نعجب لنشأة هذا العلم في أوربا في وقت سادتها روح العصبية القومية ونشبت الحروب بين دولها، وكان التنازع والتكالب على اكتساب المغانم الاستعمارية على أشُدِّه بينها، مما عمق فكرة الأثرة القومية والعصبية المقيتة في نفوس الشعوب الأوربية، وأخذ كل واحد من هذه الشعوب ينظر إلى الآخر نظرة العداء والازدراء، ووجه العجب هنا أن طبيعة الأدب المقارن لا تتفق مطلقًا مع روح التعصب والأثرة القومية؛ فهو يقف في الوسط ليرصد التيارات الفكرية المتبادلة بين الآداب المختلفة، ويرقب عوامل التأثير والتأثر فيما بينها، فكيف يتسنى لهذا العلم أن يقوم بمهمته هذه في ظل جو مشبع بعوامل الاستعلاء والتميز القومي؟... كيف يمكن لهذا العلم أن يُعنَى بدراسة نقاط الالتقاء بين الآداب والسمات المشتركة بينها في وقت كان همُّ كل أمة من هذه الأمم الأوربية منحصرًا في بيان أوجه الاختلاف والتعارض بين أدبها وآداب غيرها، وفي أن أدبها هو الأكثر كمالًا وفضلًا؟ لقد كان المزاج الأوربي الذي ساد القرنين الثامن عشر والتاسع عشر مشبعًا بأسباب التنافر والتباعد، لا بمظاهر التآزر والتقارب، حقًّا لقد كانت هناك نقط التقاء توحد بين الأدباء الأوربيين في ذلك الوقت؛ إذ كانوا جميعًا يرون في شعراء اليونان واللاتين القدماء مثَلهم الأعلى الذي يتعين عليهم أن يحتذوه، إلا أن روح القومية التي سادت في ذلك الوقت كانت تعصف بكل رغبة في التسليم بتبادل التأثير بين الآداب الأوربية بعضها وبعض.
لكن ظهرت في ألمانيا في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر حركة نادت بـ: "الأدب المقارن"، حيث تتجمع الآداب المختلفة كلها في أدب عالمي واحد يبدو وكأنه نهر يرفده كل أدب من الآداب القومية بأسمى ما لديه من نتاج إبداعي وقيم إنسانية وفنية، وكان زعيم هذا الاتجاه الشاعر الألماني جوته (1749 - 1832م)، الذي عد نفسه نموذجًا تتجمع فيه صفة العالمية؛ فلقد كان مطلعًا على الآداب الأوربية متمثلًا قيمها واتجاهاتها، ومد بصره إلى خارج الحدود الأوربية الضيقة المضطربة، فوجد في الآداب الشرقية الإسلامية عاملاً رحبًا لانهائيًّا من الطُّهر والطمأنينة، بدا له وكأنه قبس من نور النبوة، كما وجد منبعًا صافيًا من الإبداع والإلهام المتجدد، عبَّر عنه بوضوح في ديوان سماه: "الديوان الشرقي للمؤلف الغربي" كتب في مقدمته: "هذه باقة من القصائد يرسلها الغرب إلى الشرق، ويتبين من هذا الديوان أن الغرب قد ضاق بروحانيته الضعيفة الباردة، فتطلع إلى الاقتباس من صدر الشرق".
ولقد استطاع جوته بثقافته العميقة الواسعة ومكانته البارزة وقدرته الفذة على الإبداع أن يجعل فكرة التواصل بين الآداب الأوربية خاصة، والآداب كلها بعامة، تستقر في الأذهان، وتصبح من الأمور المسلمة التي لا تقبل الجدل على الرغم من طغيان العصبية القومية في أوربا... وهكذا بدت دعوة "الأدب العالمي" وكأنها كانت بمثابة تمهيد طبعي لنشوء فكرة "الأدب المقارن"... "(د. محمد السعيد جمال الدين/ الأدب المقارن - دراسات تطبيقية في الأدبين العربي والفارسي/ ط2/ دار الاتحاد للطباعة/ 1417هـ - 1996م/ 7 - 11).
والواقع أنه لا ينبغي أن يكون ثمة عجب ولا يحزنون؛ إذ مَن قال: إن "الأدب المقارن" قد نشأ وهدفه التقريب بين الشعوب والأمم على أساس من روح الأخوة؟ إن هناك فرقًا كبيرًا بين رغبة بعض العلماء والمفكرين في أن يؤدي الأدب المقارن إلى نشوء هذه الروح وبين استجابة النفوس البشرية التي تمارسه وتشتغل (أو على الأقل: تهم) به لهذه الروح؛ ذلك أنه كان هناك دائمًا، وسيظل هناك دائمًا، فجوة بين المثال والواقع، كبرت هذه الفجوة أم صغرت، فهذه هي طبيعة "الطبيعة البشرية"، وعلى أية حال فهناك عوامل أخرى للأدب المقارن كانت وما زالت وراء الاهتمام بهذا الفرع من فروع البحث: منها إرضاء الفضول البشري الذي يريد أن يعرف من أين جاء هذا العنصر أو ذاك إلى ذاك الأدب أو هذا، وإلى أين يمكن أن يذهب بعد ذلك.
ومنها أيضًا الرغبة الفطرية في المقارنة بين المتشابهات والمتخالفات في أي شيئين من جنس واحد، إن لم يكن من أجل شيء، فمن أجل إرضاء النزعة العقلية المقارنية التي لا تهدأ عند بعض الناس إلا إذا اشتغلت، ولا ترتاح إذا بقيت خاملة لا وظيفة لها، ثم هم، بعد هذا كله، لا يمكنهم أن ينسوا قوميتهم ولا حبهم لبلادهم وشعوبهم، ولا إيثارهم لحضارتهم وعاداتهم وتقاليدهم وأذواقهم وفنونهم وآدابهم، وبخاصة إذا كانوا ينمتون إلى أمم قوية تتطلع إلى جر الأمم الأخرى وراءها كأنها القاطرة وعرباتها، ولا تريد لأحد أن يخالف عن رأيها، ولا أن يكون له ذوق يتميز عن ذوقها، بله يمتاز عليه، أما الكلام والتشدق به فما أسهله! لكن الكلام وحده لا يجعل الأمنيات حقيقة واقعة محترمة من الجميع! وإذا كانت الطبيعة البشرية لم يستعص عليها أن تتلاعب بالدين ذاته وأن تحوله إلى أداة للتكسب والخداع والقتل والتدمير في كثير من الأحيان، أفنظن أن الأدب المقارن سوف يصمد أمامها ويكون عندها أقدس وأجل وأكثر تبجيلاً؟!
وفي كلام رينيه ويليك التالي ما يؤكد ما قلته؛ فقد ذكر أنه، وإن كان ظهور الأدب المقارن قد جاء رد فعل ضد القومية الضيقة التي ميزت الكثير من بحوث القرن التاسع عشر احتجاجًا ضد الانعزالية لدى الكثير من مؤرخي الآداب الأوربية، فضلًا عن تصدر التبحر في هذا العلم من بعض العلماء الذين يقعون على مفترق الطرق بين الشعوب أو على الحدود بين شعبين على الأقل؛ أي: ينتمون مثلًا لأبوين من بلدين أوربيين مختلفين - فإن "هذه الرغبة الأصيلة في أن يعمل دارس الأدب المقارن كوسيط بين الشعوب وكمصلح لذات بينها غالبًا ما طمسته وشوهته المشاعر القومية الملتهبة التي سادت في تلك الفترة وفي ذلك الموقع... (و) هذا الدافع الوطني في أساسه، الذي يكمن خلف العديد من دراسات الأدب المقارن في فرنسا وألمانيا وإيطاليا وغيرها أدى إلى نظام غريب من مسك الدفاتر الثقافية، وإلى الرغبة في تنمية مدخرات أمة الباحث عن طريق إثبات أكبر عدد ممكن من التأثيرات التي أثرتها أمته على الشعوب الأخرى، أو عن طريق إثبات أن أمة الكاتب قد هضمت أعمال أحد العظماء الغرباء، وفهمته أكثر من أي أمة أخرى"... ثم مضى ويليك فأعطانا أمثلة على هذا التعصب القومي من واقع الدراسات الأدبية المقارنة في فرنسا وأمريكا؛ (رينيه ويليك/ مفاهيم نقدية/ ترجمة د. محمد عصفور/ 366 - 396).
خلاصة القول: إن الشعارات واللافتات المرفوعة، أو حتى العوامل والبواعث التي تكمن وراء نشوء عمل ما شيء، والواقع الذي ينتهي إليه هذا العمل أو يساق نحوه سوقًا شيء آخر، باختصار: الطبيعة البشرية هي هي الطبيعة البشرية، ولا أحسبها ستتغير في المستقبل حتى لو دخلت تطورات جذرية على التكوين البيولوجي للإنسان، كما يلمح بعض العلماء الآن، اعتمادًا على ما يظنونه أو يرجونه من إمكانات التناسخ البشري، وهل تغير الأوربيون فصاروا أكثر تواضعًا ورحمة ورحابة أفق حضاري وثقافي، وهم الذين بلوروا "الأدب المقارن"، ومارسوه حتى الآن على مدار عشرات السنين، ورفعوا لواء العالمية والكوكبية، وما أدراك من هذا الكلام الكبير، الذي حين نأتي إلى الواقع فإننا لا نرى منه شيئًا؟ إنهم لا يريدون أن يروا إلا ثقافتهم وأذواقهم ونظمهم، وبخاصة أمريكا، التي لا تعرف في فرض رؤيتها على الآخرين إلا الدمار والقتل والسلاح النووي! فليقل الغربيون أو غيرهم ما شاؤوا، فليس على الكلام من حرج، لكن المهم هو التنفيذ على أرض الواقع والحقيقة، والأدب المقارن ما هو إلا علم من العلوم، يمكن أن يستغل استغلالاً حسنًا، ويمكن أيضًا أن يستغل استغلالاً سيئًا، والعبرة بالنية والإرادة عند ممارسيه، مع ملاحظة أننا مهما بذلنا من جهد في سبيل التخلص من الأنانية القومية، فلن ننجح تمام النجاح، مثلما لن ننجح إذا ذهبنا نحاول التخلص تمامًا من أنانيتنا الفردية الشخصية، وحسبنا أن نخفف من غلوائها، ونكفكف من شططها، فلا يجيء التعصب ظالِمًا لا يحتمل، وهذا هو محمد أركون نفسه، على رغم كل تحمسه لما عند الغربيين، يقرر أن "تدريس الأدب المقارن في الجامعات الأوروبية لا يتعرض لدراسة الأدب العربي والإيراني وغيرهما، وكذلك الأمر فيما يتعلق بالفلسفة التي ازدهرت في السياق الإسلامي بين القرنين الثامن والثاني عشر الميلادي، فإن أحدًا لا يهتم بها في الغرب، والعلوم الاجتماعية المختصة بدراسة الأديان لا تزال مستمرة في تجاهلها للإسلام، أو تخصص له مكانة ضئيلة وهامشية"؛ انظر، في موقع "المعرفة" على المشباك، عرض إبراهيم غرابية لكتاب محمد أركون: "الإسلام، أوروبا، الغرب - رهانات المعنى وإرادات الهيمنة")، وهو ما يرينا على نحو أو آخر أن الظن بأن طبيعة الأدب المقارن من شأنها القضاء التلقائي على التعصب القومي أو الديني هو ظن لا يقوم على أساس.
بالتأكيد سوف يساعدنا الأدب المقارن على مزيد من فهم بعضنا بعضًا، لكنه لن ينجح في قلع ما غرس في أغوار نفوسنا العميقة منذ أول الخلق، إن الغربيين بوجه عام، بحسب الرطانة الجديدة، لا يريدون "مثاقفة" بينهم وبين الآخرين، بل يريدون في أقل القليل غزوهم ثقافيًّا، ولعل من الخير الاستعانة بالفقرة التالية، وهي من مقال على المشباك للدكتور مسعود عشوش بعنوان: "المثاقفة أبرز آليات حوار الحضارات" في موقعه: "يمنتا yemenitta"، لتوضيح ما أقصد قوله: "في الأصل المثاقفة هي عملية التغيير أو التطور الثقافي الذي يطرأ حين تدخل جماعات من الناس أو شعوب بأكملها تنتمي إلى ثقافتين مختلفتين في اتصال وتفاعل يترتب عليهما حدوث تغيرات في الأنماط الثقافية الأصلية السائدة في الجماعات كلها أو بعضها.
.
.