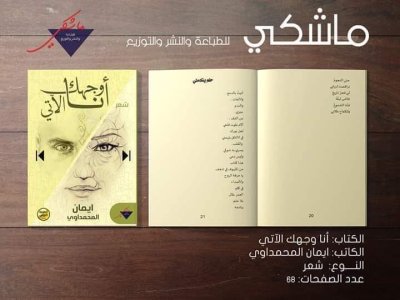- لا تقتل ضميرك، لكن لا تتبعه...
هكذا قالت نفسي لي، وكنت أجلس في ركن المقهي وحيدا حزينا فقيرا استمع إليها وهي تحدثني وواصلت:
- تريد النجاح والإرتقاء إلى الثروة، انبذ الصدق، واكره الصراحة، وابغض الشفافية والوضوح، لا تقل أبدا مافي قلبك، اكذب بصدق بحرارة بقوة، حتى تنبثق الدموع من عينيك، وترتعش كل ذرة في بدنك، صارخة صراخا صادقا، وإن كان لابد أن تقتل ضميرك، افعل إن استطعت... لكن نصيحتى لك حتى تستمر في الكذب الجيد أن لا تقتله، وإنما تقيده وتسجنه في قفص حديد داخل قلبك، لأنه هو من يضمن لك الاستمرار الناجح في الكذب والنفاق والرياء، فتضعهم في المكان المناسب وتوجههم للشخص المناسب تماما، فكلما آلمك ضميرك بالوخذ والصراخ عليك رافضا كذبك، تعرف أنك تكذب، وتتأكد من نجاح كذبك، لكن لو مات تماما، وخلا قلبك منه، لن تعرف وقتها الكذب من الصدق، ويختلط عليك الأمر، وتشك في كل شيء تفعله، ذاهبا هنا وهناك، ومترددا بين هذا وذاك، ومن ثم تفشل فشلا ذريعا في التقدم خطوة احدة... إن الكذاب المحترف، رجل ذو ضمير يقظ جدا، لكنه قادر على السيطرة عليه، وجعله في خدمة كذبه...
هكذا احتفظت بضميري حبيسا في صدري، وخرجت من المقهي ليلا، تابعا نفسي، حتى صرت الكذب يسير على قدمين.
*
إنني رفيع القد طويل الذراعين والساقين، دقيق الرأس أصلع، خبيث الوجه، ماكر الأنف، أعمش العينين، أشعر بالسعادة والسرور كلما أرسلت واحدا إلى خرابة العالم، ليتوه فيها، بعدما أمتص منه قواه، وأعلو بها عليه... وكم هناك من الأغرار في هذا العالم لديهم الاستعداد للتضحية بأنفسهم من أجل الآخرين. فكأنني الطبيب المعكوس، يدخل إليه السليم، ويخرج مريضا قبيحا، ويحيل الطيب شريرا، والصادق كذابا منافقا، والآدمي خنفساء حقيرة، تجوس تحت الأقدام نافثه سمومها... لا حسرة تشملني ولا ندم، ولا ألم الكرامة يمسني، بلا ماء وجه، كأنني آلة للبغضاء والحقارة...
وإن كان ضميري اليقظ يوافق وبشدة على منع أي أحد من محاولة التعرف عليّ، بل ويتمني القبض عليّ، ورمي بالرصاص في ميدان عام، لتخليص البشر مني نهائيا، إلا أنه بذلك الحقد نفسه عليّ، ينبهني ويذكرني بالأساسي المكين: الكذب. إذ أستطيع داخل المحكمة ذاتها، وأنا بين أيدي العدالة الصادقة عينها، إن كانت ثمة عدالة صادقة حقا، إن أقلبها وأحوّلها لصالحي، وأفوز بالبراءة الكاملة، بعدما أجعل القضاة جميعا جنودا لي في مملكة الكذب والنفاق والرياء...
*
والحق أن الفترة التي جاهدت فيها ضميري، متنقلا أثناء ذلك بين مقاهي وحدتي، تائها بين الدروب الفقيرة الكئيبة، حتى حبسته في صدري، وأغلقت عليه قفص إرادتي الحديد، متحولا من صادق سليم الطوية رومانسي، إلى كذاب منافق، ومن إنسان كريم محب للآخرين، إلى حشرة حقيرة، تلدغ ما تطوله منهم، لم تكن سهلة، فالكذب ليس مجرد مهارة تكتسب، وإنما موهبة توهب تلقائيا، وتستمر طويلا في البحث عن نفسها وتجريب طريقها، ومقاومة ضميرها، حتى تنجح في تلمس أول خيوط النجاح، ولقد وفّقت في ذلك بصورة أذهلتني أنا تحديدا، فلم اتصور إن الكذب رغم كل شيء ممكن أن يكون سهلا، سهولة شربة الماء، لكن من ذاق عرف...
صحيح أن الكذب في البداية كان مربكا ومعقدا، لا سيما وأنني كنت أجرّب ارتداء جلد غير جلدي، كنت مشوشا وخائفا أن يُكشف أمري. فكأني الوحيد الكذاب في العالم. لكني وجدت المفتاح فجأة، في الطلاء والتزيين، فلا أذكر عيوب ضحيتي مطلقا، وإنما المحاسن، ولو كانت شكلية وتافهة، والتي إذا بدأت بها أجدها تزداد وتتضخم، كأنها سلسلة يشد بعضها بعضا، إلى درجة أن العيوب تتضائل، ولو كانت في حجم الجبل العالي المنيف. أرفع محاسن ضحيتي التافهة تلك، إلى مصاف الفضائل الكريمة العالية والميزات الخارقة، بل أرى العيوب محاسنا أيضا، لكن خفيّة، كأنها الشوك المحيط بالوردة، وأفاجئ نفسي قبل الآخرين، بأني صرت مبدعا خالقا من الفسيخ شرباتً حقا وصدقا، وإذا بي انتشي وتتفاعل ذرات جسدي مع نجاحي، وترتعش وترتجف وتنبجس الدموع من عيني، كدليل دامغ على صدقي التام، ونزاهتي الحقة، فيسقط الضحية، في حفرة كذبي، أرفعه في وهمها فوق الرؤوس، حتى لو كان مجرد خنفساء حقيرة، فيرى نفسه طاوسا بل نسرا عملاقا يحلّق في الفضاء، ويجوب الأعماق النجمية ذاتها...
*
لكن... ظلّت المشكلة البسيطة تواجهني دائما، لا أجد لها حلا حاسما أنها وكما قدمت: ضميري... نعم مشكلتي هي ضميري اليقظ... فبعدما سجنته في القفص الحديد، وظننته سيعجز عن الهرب، تسلل منه وخرج بسهولة، جعلتني أشك في مهارتي على صنع أقفاص سجون جيدة، فالحق يقال رغم كل شيء، كان القفص ثقيلا وغبيا يسبب لي كرشة نفس، ووجعا في صدري، ثم أنني من لحم ودم، ولست بناءً من الإسمنت والخراسانة المسلحة، لست مخفر شرطة، ولا قسم بوليس حتى احتوي بداخلى زنازين وأقفاص حديد...
لم يهرب ضميري خوفا مني، لمّا اكتشف قدرته على التفلت من كل قيد لي، وإنما تبعني كما يتبع الظل صاحبه، يريد أن يهديني إلى سواء السبيل، الذي هو الصدق والصراحة والشفافية والحياة الراقية العالية الأبية، التي كانت تنهض عليها مملكة فقري وعوزي وقلة حيلتي بين الناس. ولم يتركني أبدا، خصوصا في أماكن شغلى، أي أماكن الكذب والنفاق والرياء.
*
أنه يجلس الآن في الصفوف الأخيرة من القاعة الفارهة يرقبني، كنت منذ وقت مندسا وسط جمهورها، الذي حضر لمناقشة كتاب جديد للنجم الأديب الشاب الشهير، أول كاتب من كتّاب أدب الرعب، في ثقافتنا التي كانت إنسانية باحثة عن الأمن والأمان والعدل والخير والجمال، فإذا بالقائمين على سلطة الحكم- بعد الثورة العظيمة عليهم- يرون ذلك خطرا عليهم، فحبسوهم في قفص حديد داخل صدر المواطن، وقالوا له كلمة واحدة:
- هسّ.
ولما سأل ببراءة رومانسية:
- لماذا ادخلتموهم في صدري إذن.
قالوا:- حتى تعرف أنك لو اخرجتهم، ستدخل مكانهم في القفص بداخل سجن حقيقي.
ثم سمحوا بل نادوا بأتيان بديل لهم، يحل محلهم، ويشغل الناس خصوصا الشباب الغض البريء الرومانسي العائش أزهي لحظات عمره، فلم يجدوا إلا روايات الرعب، التي لا تعدو صفائح قمامة لكل مخلفات النفس الضعيفة المريضة المضروبة بالمخاوف الطفولية القديمة المرعبة، روايات ملطخة بدم القتلى، تجوس فيها أشباح وعفاريت وسحرة وقتلة متسلسلين وخزعبلات قديمة، ظن الناس أنها انتهت مع الغياب القليل للصحوة السلفية المتطرفة- بعد سقوط حكم الأخوان في الثورة الثانية عليهم- ورجالها الفزعين من عذاب القبور وعذاب فتنة النساء غير المحجبات، وهمّ الدنيا كلها، حتى الآخرة ونارها التي لا تبقي ولا تذر، فلا أحد يأمن مكر الله ولو كانت أحدى قدميه في الجنة، وظن الناس أو البعض منهم خصوصا المثقفون، أنهم سيلحقون بالتنوير العقلاني، وستضيء قلوبهم وعقولهم الثقافة العلمية والفلسفية، ويحصلون على حقوقهم الإنسانية ويعيشون في كرامة يقظة حرة، فإذا بهم يرون نهضة ثقافة الرعب الموجه القوية، في روايات تتهاطل عليهم من كل حدب وصوب، وتتدفق من المطابع كالمحيط الهادر لا ينقطع ولا يمتنع بجوار غيرها من توافه الأدب والفن المنحط...
وكان الكاتب الشاب المرفه الملول الكسول، أكثر من استيقظت على يديه كتابة الرعب، حتى نشر الفزع في القلوب، والخبل في العقول، والتم حوله الشباب الغر البريء، مفتونا بلعبته وشهرته الكاسحة، والذي تُفتح له كل مغاليق دور النشر الكبيرة، ويدخل أبوابها المشرّعة، دخول الأبطال الشجعان، وخلفه الحرّاس، يحمونه من شطط المحبين.
كنت مندسا إذن بين الجمهور الذي يضم المحبين البله من عامة الشباب الغر، وقلة من الكارهين الحاقدين الممرورين المعترضين على كتابته، وهم ذوي ثقافة عالية، قادرة على فضح ما يقوم به النجم، من تدليس وسرقة من الأعمال الأجنبية، باسم الاقتباس وغيرها من حيل، يستعين بها على الكتابة بانتظام، ذلك أنه كل شهر تقريبا يخرج كتابا جديدا، فهو كماسورة الصرف المكسورة، تغرق خرابة العالم بالنتن دون توقف... وكما يتلفت القاتل السفاح في غيط الذرة على طريدته، كنت اتلفت برأسي الدقيق لامع الصلعة، أراقب دخول الكاتب الشاب المحظوظ الشهير إلى القاعة، وأحدق في الجوقة التي تتبعه، فردا فردا، آملا أن أكون واحدا منها، إن لم أكن على رأسها...
لمحت واحدا من المعترضين يقوم ناهضا إلى القتال، ثم صال وجال تبخيثا وتشويها في النجم الصاعد الواعد وكتابه الجديد، مؤكدا لحشد الحضور أن الكاتب هذا ظاهرة مرضية من ظواهر عودة النظام القديم، ينبغي التصدي لها بيقظة، خوفا على قلوب الشباب البريئة الرومانسية...
تكهرب جو الندوة التي نظمتها أكبر دور النشر في حديقتها الغناء الواسعة، وحشدت لها الجميع وكل الصحافيين وكانت كاميرات الاذاعة والتلفزيون الثابتة والمحلقة ترصد وتبث للعالم كله وقائع الحفل الكبير...
الجم المثقف الكبير المعترض بمنطقة الثوري العقلاني النافذ الجميع، بمن فيهم الكاتب الصاعد، الواعد نفسه، الذي لم يعرف كيف يصد الهجوم عليه، ولا كيف يرد كلمة، ولو بكلمة...
فطلبت الكلمة، ومضيت حثيثا وسط الشعاب برشاقة، ذاكرا محاسن المعترض الثائر، مجمّلا منها، حتى رفعته إلى مصاف النخبة، التي ينبغي لنا كلنا الاستزادة من علمها العميق، وأنني لا اعتراض لي على كلمة مما قاله، لكني أهيب به رغم ذلك، أن يقف مع الكاتب الشاب الصاعد الطموح، الذي يريد أن يقوي قلوب الشباب، ببث شيء من الخوف فيها، خوف إيجابي متخيل، يحصنهم من الخوف الأصلي، الذي يمكن أن يجدوه في الواقع الفعلي، وأن الكتابة الإنسانية الرومانسية رغم جمالها وتحليقها في عوالم الجديد والمتجدد الحي، إلا أن خطورتها تكمن في تغييب الواقع المظلم الذي يعيشونه، وتجعلهم منفصلين عن رعبه الفعلي الملئ بالقتلة واللصوص والسفاحين والخونة... وعليه يكون كاتبنا الشاب قد قدم خدمة جليلة لثقافتنا ولشبابنا بأعطائهم المصل الذي يقوي جهاز المناعة فيهم، وأنه لهذا السبب يكون ابنا من أبناء أفلاطون، نعم، أقولها بالفم المليان...
كان الجميع ينظرون لي بدهشة تامة حتى المثقف المعترض نفسه الذي لحظ وبقوة قلبي لكلامه، جاعلا اعتراضه لصالح من ينقده، كأنه كان طيلة قدحه، يمدح الشاب ولا يهدم شيئا منه أبدا. وواصلت كلامي بحماس:
- نعم يا أصدقائي إن كاتبنا الشاب الطموح ابن بار من أبناء أفلاطون، ذلك أن الفيلسوف العظيم في كتاب الجمهورية كما أتذكر، دعى بقوة إلى تربية أبناء الأغنياء المرفهين بواسطة مسرحيات مرعبة، تُعرض أمامهم كل حين، تدخل إلى قلوبهم الغضة الرعب، أو شيء منه، حتى يقويهم على الحياة في الخارج، لمّا يكبرون، ويرون الواقع بما فيه من مرعبات وحروب وفساد الخ، فلا يرتعدون أو ترتجف قلوبهم وتهوي، ومن هنا كانت المسرحيات المرعبة علاجا وتقوية، وهذا ما فعله كل كتّاب الرعب الأجانب ومنهم إدجار آلن بو الأمريكي، وموباسان الفرنسي على سبيل المثال، حتى كافكا أيضا في القرن الماضي، كل هؤلاء الكتاب وغيرهم عملوا على تقوية القلب الإنساني ليشتد ويتقوي، ولا يكون عرضة للرومانسية، التي تسم الحياة العادية النهارية، لقد عمل كاتبنا الشاب عملا عظيما، كما نرى، وهو لا يرعب الشباب بغرض شخصي، ليتكسب منهم نقودا وشهرة، لا أبدا، إن النقود والشهرة ما هما إلا نوافل عارضة على فعله الأساسي، الذي هو بثٌ للقوة في قلوبهم، لمّا يشاهدون في كتبه النشيطة الحماسية، العالم الواقعي نفسه، بما فيه من بشر خلقهم الله ومع ذلك تخلوا عن بشريتهم المقدسة، وحب الناس الأهل والأحباب والأصدقاء، واندفعوا للقتل والانتقام، تستبد بهم روح العدم والخراب، فإذا بالقرّاء الشباب وهم يستمتعون بالمغامرات الرهيبة الدموية، لا يخافون الدم، ويعتادون رعب القسوة، وغلظة القلب، وغباء الذهن الإجرامي، ويستسيغون الإنسان المريض النفسي والعقلي، ورأسه المحشودة بالخرافات، فيعلمون بوجوده بينهم، بل هو الكثرة الكاثرة من البشر، وتكون الرواية التي يقرأونها للكاتب الذكي، عونا لهم على فهم أنفسهم وواقعهم والعالم كله، بصورة واقعية صحيحة سليمة أبدا فإذا بهم يعيشون بقلب شديد، ويحيون بروح جسور، شجعانا لا يخافون أبدا...
كان ضميري اليقظ الجالس في آخر القاعة، يستمع للساني الذرب، وهو في غضب عظيم ويقول لي بصوت لو سمعه غيري لقتلوني فورا:
- كذاب مدلس حقير... قالب للمعاني السامية ومحقر للهمم... إن الإثارة ليست في بعث الخوف في النفوس، فالخوف مرض، يعلّم الجبن، ويصرف العقل عن صاحبه، فلا يعرف نفسه، إن كان مقتولا، أو قاتلا.. كف أيها الحقير...
وانطلقت القاعة كلها في التصفيق لي، حتى الكاتب الشاب الصاعد الواعد نفسه، وكان في انبهار من تحويلي هزيمته وفضيحته نصرا وكرامة وعلوا، حتى جعلته فوق كل الأدباء، في القمة، بل نخبة النخبة ذاتها...
سأل الكاتب الشاب جوقته عني، وأرسل في طلبي وأعطاني كارته الذهبي، ودعاني لزيارته، وطلب أن نكون أصدقاءً، وأنه بحاجة ماسة حقيقية ليّ، أنا العارف ببواطن الثقافة الحقة العميقة جدا، هكذا شدد وأضاف ضاحكا:
- أنت مصيبة... دماغ عالية... مكلفة بجد... ابن أفلاطون حتة واحدة... هاهاها... وإنني قادر على تحويل الضعف قوة، وينبغي أن لا أكون بعيدا عنه، بل رجله، والمتحدث باسمه، وكبير موظفي علاقاته العامة...
هكذا فجأة حصلت على وظيفة، سبقت بها غيري من جوقته، وقفزت أولى قفزاتي على مدمار الشهرة، ففي كل لقاء تلفزيوني للنجم، أكون بجواره، أصلح له ما يقول، وأصوّب المعوج من قوله، حتى صار هو المثقف الكامل القيمة، البهي الرائع ابن أفلاطون حقا وحقيقة.
بينما المثقفف الثائر المعارض الذي حولته إلى مجرد سلما صعدت عليه إلى مجدي، غاض ماء وجهه، واحتقنت عيناه، ونظر لي بحقد حاقد، وغضب عارم، فلم أكشّر له كذئب، وكان أحرى بي ذلك في الحقيقة، لكنني لم أفعل طبعا، ولم أتركه أيضا، وإنما اقتربت منه بهدوء بسّام، وسلّمت عليه بحرارة أمام الجميع، حيث لا يستطيع أن يصدني أمامهم جميعا طبعا، وإلا فضح نفسه وأظهر بغضه وغلظته، بل انحنيت وقبّلت كفه، اعترافا مني بفضله عليّ.
فارتبك تماما من هذا التفاني مني، في الاعتراف بفضله، لا يعرف ماذا يقول، وأي فضل هذا الذي اعترفُ له به أمام الجميع، وأنا شوهت قولته كلها، وحولتها عن مقصدها الحقيقي... لكنه ظن على طريقة المثقف الحقيقي الشكاك في نفسه دوما، أنني فعلا صادق تماما، وعليه أن يراجع نفسه، وأن يفكر بطريقة أخرى، في أن الرعب الحقيقي ليس في ما يكتبه النجم الصاعد الواعد، وإنما في الكتابة الإنسانية الرومانسية المحبة الرقيقة، التي هي زيف وإلهاء، عن القوة المحركة للواقع الرأسمالي المرعب المسموم في علاقاته، التي تمتص دم البشر وتقتلهم ذبحا بسكين الأسعار، وتحشد ثلج اللامبالاة فيهم، وتكبلهم بقيود من حديد التحريمات من جهة، مطلقة فيهم حب الشهوات، والأماني الكاذبة، من الجهة الأخرى، وكل تلك الأساليب الرهيبة لا توجد إلا في رواية الرعب واضحة، وإن بصورة رمزية في هيئة سلاسل وسيوف وقتل وذبح وعفاريت ومصاصي دماء، خصوصا في روايات الكاتب اللامع الذكي، الذي يجعلنا جميعا واقفين على اعتاب حقيقة المجتمع المحلي والعالمي الذين صارا كابوسا واحدا، لا فرق بينهما إلا الشكلي فحسب...
*
مازال ضميري يرقبني من خلف الحشود، وكلما التفتُ إليه أراه شبحا ظليا كأنه انعكاس جسدي، وقد شرد مني وتناثر بعيدا، وتلك الحالة كان يقصدها لأشعاري بضياعي، كأني مجرد ظل لمن أقوم بالكذب لصالحهم، والحق أن هذا كان يسعدني، إذ كان شعوري بضياعي مجرد معلومة، تضاف إلى يقظتي، تخبرني بأنني على الطريق الصحيح، الذي يريد هو تسميته بالضياع، في أثر الآخر الزائف، وأسميه أنا طريق صعودي.
وفكرة أنني ذيل للنجم المشهور تلك، لا تعني لي سوءا أبدا، وإنما قدرة وتميز، لأنه ليس سهلا أن تكون ضمن جوقة نجم مشهور تتبعه، وتهلل له، وكوني صرت الأول فيها، فتلك حظوة ورفعة تجعلني منافسا قويا للجوقة وأفرادها المتصارعين على الغنائم المتساقطة من خلف النجم.
*
كان ضميري في حيرة حقيقية وهو يراني لا أطرده ولا أهينه، وإنما اتركه يتبعني، بل حتي يسير بجواري متوترا، واتحدث معه خفية، دون إشعار الآخرين بذلك، وإن شعر أحد، فيظن أنها مجرد عادة لدي، أن أكلم نفسي، شأني في ذلك شأن أصحاب الضمائر اليقظة، أو الأذكياء بافراط، الذين يفيضون حتى على أنفسهم، بعد إفاضتهم على غيرهم طبعا، وإن ظن بي الجنون، فهذا حسن أيضا، إذ يصب في صالح تميزي، وغرابة أطواري، التي بفضلهما أستطيع التفكير بطريقة أفضل من الجميع، وأرى غير ما يرون، وأنني عبقري بالسليقة، بل ومتفاني في إنكار ذاتي، لصالح قضية الإبداع والوطن...
*
كنت أحرص على التواجد المبكر في الندوة الثقافية لمجاملة المشهورين، وتدعيمهم بكل السبل، بداية من السير بجوارهم، واستقبالهم- قبل أي أحد- بالاحتفال اللازم، والأخذ بيد أكبرهم صعودا إلى المنصة، وتجهيز المقعد له، بل والمبادرة بتقديمه للجمهور، قبل المقدم الرسمي، بكلمات لطيفة تشير إلى الحظوة والنعمة التي يمثلها هو الكبير المشهور بحضوره وسطنا نحن المغمورون، الذين نبحث عن نموذج حقيقي واقعي لنقتضي به، ونلمسه ونراه ونتحقق من أنه موجود بيننا، ومن ثم نستطيع أن نرى الأمل فيه، وأن نسير على دربه الصعب، ونتعلّم منه أهمية السعي، وحتمية الوصول إلى الغاية الجميلة، التي يوجد هو فيها باقتدار...
فيشكرني باسما لي، ثم يتوجه للجمهور، ذاكرا خجله من كلماتي الرقيقة، لاسيما وأنه لا يعرفني، بل لم يدعوني إلى ندوته، وأن هذه مبادرة مني نزيهة خالصة لوجه الحق والحقيقة...
وطبعا هو كذّاب، لأنه اتفق معي على ذلك بعد استئذان كاتب الرعب الشاب الصاعد الواعد، واتفق معه على السماح بحضوري في ندوته لتدعيمه في حضور أعدائه وكارهيه، وأن كلماتي المثقفة بحق والعالية على الجميع، حتى لو كانوا أكثر مني ثقافة ووعيا ومعرفة بالمراوغة وقلب الحقائق. إذ أستطيع أنا بنفس المنطق الذي يفضحونه به ويعرونه، أن أقلبه لصالحه، ذاكرا أن الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، وأن النزاهة تحتم علينا قبول الآخر، وعدم الوقوف في طريق المجتهدين الساعين إلى المجد الذي يستحقونه، وأننا جميعا لا نتحارب ضد بعضنا البعض، وإنما نتنافس على الجمال، فكلنا زهور في حديقة الثقافة الجميلة، يدعم بعضنا بعضا...
وازعق بقوة وسط الجمهور:
- لسنا، ولن نكون أبدا، إلا حائط صد ضد المدعين، وفي نفس الوقت نكون سلّما ومعبرا للجادين، خدمة لثقافتنا الراقية، أننا أعضاء في جسد واحد، سليم قوي يعمل الكل فيه لصالح الجزء، مثلما يعمل الجزء لصالح الكل...
فإذا بحديثي يمسّ قلوب الجمهور، وهذا هو الأهم، وليس عقولهم، وإن مسها، فبطريقة إيجابية، لأنه كله إيجابي مطلق يرضي الكل، فهو محفّز في العموم، يشد من ساعد الضعيف ليقويه، ويشد أيضا من ساعد القوي، حتى يزداد قوة ورفعه...
وأصيح:- يا أصدقائي أن الهدف النبيل هو الأهم.
وتستمر الندوة بحماس مراقب مني، يصير فيها النجم سيدا للثقافة ونعمة للأجيال القادمة، حتى اطمئن لمسارها الذي يمضي لصالح مستخدمي، الذي ينظر إليّ، كل حين بامتنان وتقدير، حتى لا يعرف كيف أفعل ذلك، فهو نفسه تأثر، وصدّق ما أقوله، لأنني أقوله بصوت واثق قوي فعّال مندهش حماسي، تدمع له عيناي، وعيون السامعين جميعا، عبر أرجاء القاعة الواسعة الفاخرة اللامعة بالأضواء، لا سيما وأنني أرفض الحديث من خلال الميكروفون تواضعا" حتى لا يعلو صوتي على صوت المنصة الكريمة".
هكذا أقول، فإذا بالجميع يصمتون فلا نأمة تخرج من أحدهم، ويرهفون السمع لي، وأنا أكذب بحنكة...
فيما ألمح هناك ضميري يذهب ويجيء بحيرة وحزن، كأنه ضبابه معتمة حانقة...
قبل انتهاء الندوة بقليل أشرت بطريقة لطيفة للكاتب الشهير برغبتي في الانصراف، فقام من مكانه مستئذنا للحظة، وعارفا أن هذه الإشارة سيم بيننا، واختفينا وراء ستار ثقيل، عانقني بحب، ثم وضع في يدي مبلغا جيدا من المال، رفضت طبعا، لكنه أصر بمحبة، فهو لم يستطع لضيق الوقت احضار هدية ليّ، فما الهدية التي يمكنها أن تساوي فعلى الكبير، الذي دعّمه كل التدعيم، تسلّمت المبلغ في صورة الحزين الخجل المحب له والمضحي، فإذا به يكاد أن يضحك، لكنه لم يستطع مجاراة جديتي، فأنا أكذب وهو يعرف ذلك، لأنه مجرد سطحي تافه، لا يستطيع قول كلمة واحدة لها قيمة للناس، لأنه لا يقرأ، ومشغول بالصراعات على المكاسب واللقاءات والمناصب والتحارب مع الأعداء، أو كما يسميهم الأعدقاء، إذ يرى، أن الأصدقاء أكثر عداءً من الأعداء أنفسهم، لكنني لست من هؤلاء الأعدقاء، ولا الأعداء، وإنما من الأصدقاء العمليين الخلص الفاهمين أين يضعون ثقتهم بالضبط..
في طريقي للخارج لم انظر لضميري الذي تبعني بتحد...
*
- سأفضحك.
هكذا قال مضيفا:
- سأدمر كل ما تفعله...
*
لا يعرف ضميري أنه مثالي محلّق فوق الأرض، عصره انتهى، ومجرد انتيكة، وشيء من الماضي، تذكرة ليّ في أحسن الأحوال. بل أن الحياة دونه قد تكون ممكنة، ولكني لست متأكدا من ذلك حتى الآن، فقد أخسر بغيابه حقا، ما وصلت إليه من مكانة.
ومن الجهة الأخرى كنت متخوفا من أنه طالما تجسّد خارجي ولو في صورة ضبابة ظلية، يمكنه أن يواصل تجسده، بطريقة ما، حتى يصير نسخة أخرى مني، مطابقة ليّ، ومن ثم يخرّب كل افعالي حتى يرغمني العودة إلى ما يعتبره الصواب، لإنه لا يرى نفسه ابن حقبة قديمة، بل مازال يلح على أنه مطلق وأبدي، وليس نسبيا جزئيا احتماليا أبدا...
قررت أن أعطي نفسي فرصة لإعادة هيكلته، وتحويله لصالحي، لكن المعضلة هي أنني لا أريد تحويله ليكون مثلي، أي يكون كذابا، ربما أفضل مني بكثير، إذ سيكون حصل على الحسنيين: التفرقة والتمييز، أي القدرة على الإنتباه للصواب والصحة العقلية، والكذب الممنهج أيضا، بينما أنا لا تنطوي نفسي إلا على الكذب فحسب، واستمد التذكرة منه، لذا كان ينبغي لي الإبقاء عليه كما هو من خلال فكرة طلب الهدنة.
حاولت اقامة حوارا معه أثبت له فيه كذبا طبعا، أنه لو قتلني أو ابعدني- لأنني لن أتغير واتحول عن الكذب- واكتفى بنفسه، سيسقط في الحياة الفعلية النسبية ويتشوه، وتنقص يقظته، ولن يستطيع تنبيه نفسه لما يفعل، ويصير مشوها غير عارف كيف يصدق أو حتى يكذب، في الوقت والمكان والمناسبين، ويخسر كل شيء، وأن عالم الصعود بين الأقوياء يتطلب الحذر كله..
فقال لي ساخرا:- لابد أن أجرّب، فلن أقف مكتوف اليدين، انظر إليك، وأنت تصول وتجول وتستخدمني مطية لك.
قلت:- أليس من الأفضل أن نعقد اتفاقا أو هدنة، تتركني حتى أحقق وصولي إلى القمة، وأصير غنيا ومشهورا، ثم أتوب على يديك، وأعود صادقا بعد أن أكون قد حصّنت نفسي، وصرت رجل المال والأعمال والشهرة، ارجوك اترك لي الفرصة حتى أفعل هذا.
- لماذا اتركك تكذب وتشوه الناس والحياة، حتى تصير أنت المشوه الأكبر؟ إن هذا مرض، أنت مريض، خنفساء تدافع عن حقارتها، وتريدها أن تستفحل وتمتص دماء الأبرياء...
صرخت بغيظ:- أن هذه الطريقة التي تفكر بها قديمة جدا ياعزيزي، لم يعد ثمة أبرياء كما تظن، وإن كان هناك أبرياء حقا ومستقيمين صدقا، فلابد أنهم سيكونون مثلي كذابين، فهذا ما حدث لي، اتعرف ألمي، هل خبرته، هل تعرف الحسرة وفقدان الأمل وأنت ترى السفلة والمنحطين يتسلقون إلى المجد والشهرة فوق الأكتاف، يا عزيزي إن ما تتصوره عن الاستقامة درب من العته والغباء لا غير...
تشوه وجهه بالحزن، ونظر لي باحتقار أعرفه جيدا، لكنه لا يؤثر فيّ أبدا، إلا أنه مع ذلك يذكرني بنجاحي في الحفاظ على طاقة الكذب في.
قال:- التجدد... أنا اطرح عليك الحل السهل الحقيقي وهو التجدد... لا تتبع أحدا، لا تهرق كرامتك في مرض التبعية، لا تبدد موهبتك الجيدة في تركها تتعفن على أعتاب الآخرين، لن يفيدك المال في شيء، وإنما الجوع هو ما يفيدك، أنت مجرّد مرحلة تمر بها الإنسانية في طريقها إلى الجمال، وعليك أن تكون معبرا ليّ، أنا الجمال الحقيقي، تجدد... ابدع ماهو أفضل منك، ولا تكون تابعا لأحد ما...
*
لم يفض النقاش إلى شيء غير الهدنة، التي ستكون فرصة لي لتجريب التجدد الذي يريد، وكان هذا أمرا جيدا جدا، أستطعت في تلك الفترة البسيطة، إنشاء مكتب ووكالة عن الفنانين والكتاب، فصرت مسؤلا عن رعاية الكتاب الكبار منهم طبعا، وليس المبتدئين، أعدّ لهم حفلات توقيع كتبهم، وأرسل لهم من خلال المكتب مقالاتهم إلى الصحف، التي يكتبونها كل شين كان، بعد تصليحها لغويا، فهم جهلة في اللغة والنحو والصرف، فليس لديهم وقت للتعلم، وكذلك في الأفكار أصلحها لهم، وكثيرا ما أكتب أنا المقالات كاملة، وأرسلها باسمائهم إلى المجلات، وأصحح لهم كتبهم، إن لم أكتبها كلها أصلا...
كان المكتب في فيلا الكاتب الشاب الصاعد الواعد، أشهر كتاب الرعب، منحني أياه، لمّا عرف بمشروع الوكالة الأدبية، وأنه سيكون مخصصا لشهرته، بجوار الفنانين والكتاب الآخرين أصحابه.
أتيت بالموظفين والعمال، وكان ثمة حديقة حول المكتب، بها بستاني فقير جلبته من الشارع، كان عجوزا، لكن قويا جدا، أستطاع في مضمار شهر أن يجعل الحديقة جنة مزدهرة، بها الكثير من الأماكن الصالحة لأقامة ندوات ثقافية، محاطة بالأضواء الرقيقة، وبها العمال يخدّمون على طلبات رواد الندوات، التي تُعقد يوميا في كل مجالات الكتابة، وكنت أطوف كل يوم على الحضور، وأرسل لهم تحياتي، وأطلب لهم المشروبات مجانا، حتى شعروا بأنني محسنا كبيرا، أخدم الثقافة حقا وحقيقة...
كنت أحرص أن يترأس كاتب كبير شهير ندوة كل أسبوع، يتحلّق حوله الصغار والمجهولون من الكتاب، يشيدون به وبفكره، ويطرحون عليه أفكارهم وأعمالهم التي يمكن، بفضل الكاميرات التي ترصد كل شيء في الندوة، بعد تفريغها، استخلاص الأفكار، التي يمكن تحويلها إلى كتب باسمه، وبعض الأعمال التي يقدمها الكتاب المغمورون، التي يمكن الاستفادة منها لصالح الكاتب، بعد تغيير بعض أجزاء فيها، وكان هذا كله يحدث بيني وبينه، دون أن يلحظ هو، أو يلحظ، لكنه لا يفكر في أن هذا جريمة وسرقة، إذ لمّا اقترح عليه الفكرة الجديدة، التي طرحها أحد الكتاب، بوصفها ليست جديدة في شيء، وإنما الكاتب استعارها من آخر أجنبي شهير، أسمه كذا أو كيت... أو لا أذكر له مصدر الفكرة، التي فرغّتها من الكاميرات التي ترصد مسار الورشة، أو حتى اقترح عليه فكرة عشوائية ما، أقدمها له يكملها هو، أو أقدمها بعد الانتهاء منها كاملة، فيوقع عليها بعد أن يسدد لي ثمنها وهو كبير طبعا...
*
كان ضميري أثناء الهدنة في حال من الذهول والاكتئاب، نحل جسده الضبابي المعتم، رغم وجوده بصحبتي في المسكن الفاخر الملحق بفيلا كاتب الرعب، الذي أسهر عنده كل ليلة تقريبا صحبة كبار الأدباء المشاهير، تخدّم علينا الفتيات، ونتناقش في أمور الخيال، وكيف يمكن كتابة رواية جديدة، تأخذ بجماع قلوب الشباب...
*
كنت كل ليلة أثناء النوم اترك نفسي لضميري يعذبني بالكوابيس كيفما شاء، حتى أخفف عنه حمله النهاري، فكان يغرقني إغراقا في أحلام مفزعة غبية تكاد تزهق روحي حقا...
ذات مرة رأيت نفسي ميتا، جثة هامدة، لا بل أكثر من هذا، هيكلا عظميا، تخرج من فمي الحشرات، فقمت من نومي ليس حزينا، أو مرتعبا، وإنما فرحا قليلا، فهذه الصورة/ الحالة المفزعة، ستأتي لي بمبلغ كبير، لمّا اتصل بالكاتب الصاعد الواعد، وأخبره بها.
هيأ ضميري لي ذلك الكابوس شديد الإفزاع، قاصدا التعبير الرمزي عن موته فيّ، وأنني بلا حياة حقيقية داخلية، وعليّ الانتباه وترك ما أفعله من سخف وانحطاط في اعقاب الآخرين... لكنني على الرغم من ذلك اعتبرته اهداني هدية ثمينة، بل ألقي لي كنزا، علي استثماره، فاسرعت في كتابة ذلك الحلم الكابوسي الفظيع رواية مرعبة، كتبتها بالتفصيل غير الممل طبعا، عن شخص يتحول كل ليلة أثناء نومه في غرفة نومه الفاخرة الجميلة المزينة بالورود والنساء، هيكلا عظميا، تبلى ملابسه حتى تصير رمادا متساقطة أسفله، ثم يتهرأ جلده ويذوب كالماء الحامض العفن، حتى يتحول إلى هيكل عظمي مرعب مخيف، تعيش فيه الحشرات، وأن هذه هي حقيقته التي يخفيها عن الناس، رغم أنه في الصباح حين تطلع شمس النهار على الدنيا، يعود كما كان إنسانا، من لحم ودم، جميلا شابا انيقا رشيقا فاخر الملبس، تهفوا إليه القلوب، خاصة قلوب الصبايا، محاطا بالشهرة والأموال والسيارات والميكروفونات والطيور تحوم حوله، كأنه شجرة الخير إينما حل وكان، وأثناء ذلك يلقي الزهور للجميع، مع الابتسامات الفرحات جدا، الفاخرات تماما، وأنه بوابة السعادة الحقة، وكلما تذكر موته الليلي وخرابه وفنائه، وتحول غرفته قبرا، ازداد حضور بهجته الزائفة أمام الآخرين، وفرحه وسعادته بوصفه في قمة العالم وفوق سحبه السعيدة...
*
نفحنى الكاتب الشاب الثري وديعة كاملة في البنك، مقابل روايتي البغيضة تلك، وضمها إليه، ووقعها باسمه، بل نشرها فورا في أفخم الطبعات، فراجت سريعا، ورأي فيها الخاصة قبل العامة عمقا فلسفيا حقيقيا، وإنها تلمس عمق الوجود الإنساني الآن، حيث الإنسان في الحقيقة مجرد مظهر براق، يخفي حقيقة فناءة وقبحه...
جعلتني الوديعة الثمينة ثريا نوعا ما، فأنا طماع جشع، وكانت سعادتي تزداد كلما زادت قدرتي على تحويل كوابيسي إلى روايات مرعبة، أبيعها للكاتب الشاب الصاعد الواعد، ولغيره، لقاء المال الوفير...
بينما كان ضميري أثناء ذلك يبكي قهرا على ما وصلتُ إليه من خراب داخلى، تحت الرداء الفاخر الجميل، حيث صرت قبلة الكتاب جميعا، خصوصا الفتيات منهم، وصرت المطلوب في كل محفل ولقاء تلفزيوني، بل والموجّه للثقافة وصانع الكتّاب وطريق الخير للجميع، وفي ذات الوقت تتهاطل الكتب المرعبة التي هي كوابيسي الحقيرة وأمراضي الشخصية وانفصالاتي ورعبي وخوفي وشيزفرونيتي، التي كان ضميري يرفدني بها من أجل افاقتي وصلاحي، ولو شاهدني أحد بالصدفة أكلم ضميري في أحد الأركان بطريقة الهمس، يشعر بأنني في حالة الإبداع وسره الذي يجعلني أستطيع الكلام دائما مع أشخاص غامضين غير مشهورين ومجهولين ليّ، وله، وللعالم كله، وأن لي عالم غامض لا يدخله إلا أنا...
*
ومع أنه يمكنني القول بأنني وصلت إلى ما أريد من الشهرة والثروة والسلطة نسبيا طبعا، إلا أن الطريق مازال طويلا، ووقت الفراغ يتقلص، رغم جيش الموظفين في المكتب الذين يقومون في الحقيقة بكل العمل، بل صار المكتب أو الشركة تعمل وحدها ذاتيا وبكفائة تامة.
اعتاد الموظفون على رؤية ضميري الذي زاد من تجسده خصوصا بعد انتهاء المهلة بيننا، دون أن استجب له، فلا تجديد ولا تغيير حصل. وصار شبيها بي كأنه أخي التوأم، كان يحاورهم فيما يفعلون، ويشوهه لهم، ويحاول أن يخرّبه ويوقف عمل الشركة، إلا أنهم كانوا يقفون في وجه محاولاته كلها، كأنهم أنا فهم يخافون على مصدر دخلهم طبعا، وطالما أن الأمور تسير، ووفود الكتاب تأتي، والحركة مستمرة، إذن فكل شيء على ما يرام...
كان يحاول أن يوضح لهم أن ما يقومون بها من تلفيق وسرقة الموضوعات من أصحابها، وإعادة كتابتها بطرق شتى، بل وأن كتابة الكوابيس تلك لن تأتي إلا بالخراب على المجتمع ككل، وسينداح العمل الفريد في الشبيه المزيف، ولن يتبين الحقيقي من الوهمي، وأن هذا ليس في صالحهم هم أنفسهم، فذات لحظة سينكشف هذا كله، لكنهم كانوا يقولون له:
- بأن هذا يحدث في العالم كله، وأنه قانون النشر الآن، والرواج بين الجماهير، وأن كل الناس تعلم ذلك، وأنهم لا يأتون فعلا منكرا أبدا، وأنه هو من يتمسك بتقاليد قديمة لا تصلح الآن وهنا في عالمنا العولمي الجديد...
كنت اتابع عبر الكاميرات تلك الحوارات، وأرى مدى اليأس والاحباط الذي ينتاب ضميري، حتى بدا يشفّ ويذبل ويكاد يموت كمدا، وكنت أخاف عليه حقا، فهو رغم كل شيء ضميري اليقظ، الذي بدونه لا أعرف إن كنت كاذبا أم لا، بالأضافة إلا أنه سبب الخير كله بفضل الكوابيس المرعبة التي يرسلها لي كل ليلة...
*
كنا نعد للاحتفال السنوي الكبير، برائد كتابة الرعب، صديقي الشاب الذي غمرني بخيره كله، وأعلى من شأني وصرت المتحدث الأول والرسمي باسمه وأعماله المشهورة كلها، التي تباع في كل المكتبات وتعد للإذاعه والسينما، بل كان يعتبرني صاحب فضل كبير عليه، وفي نفس الوقت يخشي مني، إن لم أقل يرتعب، إذ كان يعرف أنني لا أحبه، وأعرف مواطن ضعفه كلها،وما أكثرها، وأنه في الحقيقة مجرد دمية أستطيع تحريكها إينما شئت وكيفما رغبت، لكنني كنت اطمئنه، مدعيا أنه لا يعرف مقدار نفسه، وهذه سمة المبدعين الحقيقيين...
لكنه على حين فجأة سألني مرة سؤالا عميقا، لا أدري كيف جاءه قال لي مرتجفا بجد:
- من فضلك يا صديقي كيف تخرج من نومك كل ليلة صحيحا معافى، بعدما تعيش كل تلك الكوابيس الرهيبة أثناء نومك، والتي قد توقف قلبك يوما، أو حتى تؤدي بك إلى الجنون، فأنت تعيش في مقبرة فعلا وليس في الحياة...
ابتسمت له قائلا:- جميل سؤالك أنه يشير إلى ضمير يقظ يارائد الرعب... لكن ماذا لو كان وجودك نفسه هو السبب، عموما أنا أستطيع تحمل عذابات ضميري الليلية، لكن عذاب الفقر والجوع والإهمال لا أطيقهم أبدا، فلا تقلق عليّ، فلن أموت لأنني ميت فعلا كما تعلم...
*
كان الحفل على أشده، جائته كل الوفود الثقافية، ومذاعا على الهواء مباشرة. جلس صاحبي الشاب الشهير المرعب الفاتن على المنصة بجواري، ورحت أقدمه للجمهور مثل كل مرة خصوصا هذه المرة، حيث انتهينا من طباعة روايته الجديدة
" الجثة في كفنها".
وكانت قد حظت بالشهرة المتوقعة، وجاء الكثير من القراء حشودا ملئوا الصالة وخارجها، حيث كانت تُنقل وقائع الحفل عبر شاشات كبيرة في حديقة المكتب، على جدران الفيلا الواسعة الكبيرة، وكانت الفلاشات تتخاطف بارقة على الوجوه، وكنت في نشاط معتاد وحماس عرفه الجميع فيّ، أقدم العمل الذي لم يصغ فيه الكاتب إلا بعض جمل تافهة، لم آخذ بها إلا قليلا، حتى يكون العمل له، على نحو ما، وكان الجميع منبهرين بالعرض الفاخر للمنصة، والبذلات والاستعدادات الاحتفالية الموشاة بالزينة وحضور الطلبات المجانية والمدفوعة...
وكنت أشرح لهم عمق الرؤية الكابوسية للرواية وأهميتها وجدتها كأني أنا من عاناها في الحلم، حتى كادت عيناي تدمعان ووجهي يحمر بالدم وارتجف حماسة...
*
فجأة، دخلت علينا من وراء ستار المنصة جثة ملفوفة بالكفن...
شهق الجميع وظنوها روح الرواية أتت إلينا فعلا، هاجوا وراح الكثيرون يهربون، لاسيما وأن الأضواء كلها سلطت علىها، توقفت أمام المنصة وتحدثت للجمهور المرعوب قائلة بصوت خشن ممرور حزين:
- لماذا تندهشون... أليس هذا ما أتيتم من أجله: الموت... وهاهو أمامكم...
ازاحت الجثة الكفن، عن رأسها فإذا بها ضميري نفسه وقد اكتمل تجسده تماما لكن ليس في صورتي النهارية الظاهرة، وإنما صورتي الليلية الكابوسية: الهيكل العظمي ذاته قبيحا داميا، يخرج من فمه الحشرات، راح يهبط اليهم بثقل، كانت خطواته ثقيلة خشنة تدب على الدرجات الخشبية ويغوص فيهم، وهم يتساقطون مغما عليهم رعبا... وكان يصرخ فيهم بطريقة إنشائية شجنية:
- أنا الحياة المقتولة، وأنتم من قتلني، وباعني قطعا، وحوّلني إلى جثة وهيكلا عظميا، تجوس فيه الحشرات...
كان الجمهور يهرب صارخا، ويتساقط على بعضه بعضا، ويزوم ويجعّر ويبكي بجنون غير مصدق...
والكاميرات تنقل الحدث ببرود، إلى البث المباشر، وكان ثمة من يصفقون، وأنا منهم بل أولهم، إذ أنني انا الكذاب رحت أصفق بقوة للعرض المسرحي للرواية، حتى استعاد الجمهور شجاعته، واستقام من كبوته، وظن أن الموت مجرد تمثيل، وليس حقيقة، وما الهيكل العظمي إلا رداء من أردية التمثيل، على أنهم كانوا في زهول غير عارفين كيف يفهمون ما يرونه...
هبطتُ إليه باسما لأطمئن الجميع، راغبا في عناقه وتقبيله أمامهم، ثم أخذه بعيدا عن الحفل... توقف واستدار إليّ مبتسما بسخرية، وفجأة صار أمامي بسرعة خارقة حاسمة، وكان يرفع منجلا حادا لامعا، لا أدري كيف اخرجه من هيكله العظمي البشع...
فزع الجمهور وهرب من القاعة والحديقة، بينما رأسي لامع الصلع المتخبط على الأرض، كالكرة، يرى حشد الأقدام الهاربة لآخر مرة، ويبتسم فمي براحة... راحة حقيقة... نهائية آخيرة، كأني في كابوس من كوابيسي الليلية المعتادة.... الكابوس الأخير...
***
هكذا قالت نفسي لي، وكنت أجلس في ركن المقهي وحيدا حزينا فقيرا استمع إليها وهي تحدثني وواصلت:
- تريد النجاح والإرتقاء إلى الثروة، انبذ الصدق، واكره الصراحة، وابغض الشفافية والوضوح، لا تقل أبدا مافي قلبك، اكذب بصدق بحرارة بقوة، حتى تنبثق الدموع من عينيك، وترتعش كل ذرة في بدنك، صارخة صراخا صادقا، وإن كان لابد أن تقتل ضميرك، افعل إن استطعت... لكن نصيحتى لك حتى تستمر في الكذب الجيد أن لا تقتله، وإنما تقيده وتسجنه في قفص حديد داخل قلبك، لأنه هو من يضمن لك الاستمرار الناجح في الكذب والنفاق والرياء، فتضعهم في المكان المناسب وتوجههم للشخص المناسب تماما، فكلما آلمك ضميرك بالوخذ والصراخ عليك رافضا كذبك، تعرف أنك تكذب، وتتأكد من نجاح كذبك، لكن لو مات تماما، وخلا قلبك منه، لن تعرف وقتها الكذب من الصدق، ويختلط عليك الأمر، وتشك في كل شيء تفعله، ذاهبا هنا وهناك، ومترددا بين هذا وذاك، ومن ثم تفشل فشلا ذريعا في التقدم خطوة احدة... إن الكذاب المحترف، رجل ذو ضمير يقظ جدا، لكنه قادر على السيطرة عليه، وجعله في خدمة كذبه...
هكذا احتفظت بضميري حبيسا في صدري، وخرجت من المقهي ليلا، تابعا نفسي، حتى صرت الكذب يسير على قدمين.
*
إنني رفيع القد طويل الذراعين والساقين، دقيق الرأس أصلع، خبيث الوجه، ماكر الأنف، أعمش العينين، أشعر بالسعادة والسرور كلما أرسلت واحدا إلى خرابة العالم، ليتوه فيها، بعدما أمتص منه قواه، وأعلو بها عليه... وكم هناك من الأغرار في هذا العالم لديهم الاستعداد للتضحية بأنفسهم من أجل الآخرين. فكأنني الطبيب المعكوس، يدخل إليه السليم، ويخرج مريضا قبيحا، ويحيل الطيب شريرا، والصادق كذابا منافقا، والآدمي خنفساء حقيرة، تجوس تحت الأقدام نافثه سمومها... لا حسرة تشملني ولا ندم، ولا ألم الكرامة يمسني، بلا ماء وجه، كأنني آلة للبغضاء والحقارة...
وإن كان ضميري اليقظ يوافق وبشدة على منع أي أحد من محاولة التعرف عليّ، بل ويتمني القبض عليّ، ورمي بالرصاص في ميدان عام، لتخليص البشر مني نهائيا، إلا أنه بذلك الحقد نفسه عليّ، ينبهني ويذكرني بالأساسي المكين: الكذب. إذ أستطيع داخل المحكمة ذاتها، وأنا بين أيدي العدالة الصادقة عينها، إن كانت ثمة عدالة صادقة حقا، إن أقلبها وأحوّلها لصالحي، وأفوز بالبراءة الكاملة، بعدما أجعل القضاة جميعا جنودا لي في مملكة الكذب والنفاق والرياء...
*
والحق أن الفترة التي جاهدت فيها ضميري، متنقلا أثناء ذلك بين مقاهي وحدتي، تائها بين الدروب الفقيرة الكئيبة، حتى حبسته في صدري، وأغلقت عليه قفص إرادتي الحديد، متحولا من صادق سليم الطوية رومانسي، إلى كذاب منافق، ومن إنسان كريم محب للآخرين، إلى حشرة حقيرة، تلدغ ما تطوله منهم، لم تكن سهلة، فالكذب ليس مجرد مهارة تكتسب، وإنما موهبة توهب تلقائيا، وتستمر طويلا في البحث عن نفسها وتجريب طريقها، ومقاومة ضميرها، حتى تنجح في تلمس أول خيوط النجاح، ولقد وفّقت في ذلك بصورة أذهلتني أنا تحديدا، فلم اتصور إن الكذب رغم كل شيء ممكن أن يكون سهلا، سهولة شربة الماء، لكن من ذاق عرف...
صحيح أن الكذب في البداية كان مربكا ومعقدا، لا سيما وأنني كنت أجرّب ارتداء جلد غير جلدي، كنت مشوشا وخائفا أن يُكشف أمري. فكأني الوحيد الكذاب في العالم. لكني وجدت المفتاح فجأة، في الطلاء والتزيين، فلا أذكر عيوب ضحيتي مطلقا، وإنما المحاسن، ولو كانت شكلية وتافهة، والتي إذا بدأت بها أجدها تزداد وتتضخم، كأنها سلسلة يشد بعضها بعضا، إلى درجة أن العيوب تتضائل، ولو كانت في حجم الجبل العالي المنيف. أرفع محاسن ضحيتي التافهة تلك، إلى مصاف الفضائل الكريمة العالية والميزات الخارقة، بل أرى العيوب محاسنا أيضا، لكن خفيّة، كأنها الشوك المحيط بالوردة، وأفاجئ نفسي قبل الآخرين، بأني صرت مبدعا خالقا من الفسيخ شرباتً حقا وصدقا، وإذا بي انتشي وتتفاعل ذرات جسدي مع نجاحي، وترتعش وترتجف وتنبجس الدموع من عيني، كدليل دامغ على صدقي التام، ونزاهتي الحقة، فيسقط الضحية، في حفرة كذبي، أرفعه في وهمها فوق الرؤوس، حتى لو كان مجرد خنفساء حقيرة، فيرى نفسه طاوسا بل نسرا عملاقا يحلّق في الفضاء، ويجوب الأعماق النجمية ذاتها...
*
لكن... ظلّت المشكلة البسيطة تواجهني دائما، لا أجد لها حلا حاسما أنها وكما قدمت: ضميري... نعم مشكلتي هي ضميري اليقظ... فبعدما سجنته في القفص الحديد، وظننته سيعجز عن الهرب، تسلل منه وخرج بسهولة، جعلتني أشك في مهارتي على صنع أقفاص سجون جيدة، فالحق يقال رغم كل شيء، كان القفص ثقيلا وغبيا يسبب لي كرشة نفس، ووجعا في صدري، ثم أنني من لحم ودم، ولست بناءً من الإسمنت والخراسانة المسلحة، لست مخفر شرطة، ولا قسم بوليس حتى احتوي بداخلى زنازين وأقفاص حديد...
لم يهرب ضميري خوفا مني، لمّا اكتشف قدرته على التفلت من كل قيد لي، وإنما تبعني كما يتبع الظل صاحبه، يريد أن يهديني إلى سواء السبيل، الذي هو الصدق والصراحة والشفافية والحياة الراقية العالية الأبية، التي كانت تنهض عليها مملكة فقري وعوزي وقلة حيلتي بين الناس. ولم يتركني أبدا، خصوصا في أماكن شغلى، أي أماكن الكذب والنفاق والرياء.
*
أنه يجلس الآن في الصفوف الأخيرة من القاعة الفارهة يرقبني، كنت منذ وقت مندسا وسط جمهورها، الذي حضر لمناقشة كتاب جديد للنجم الأديب الشاب الشهير، أول كاتب من كتّاب أدب الرعب، في ثقافتنا التي كانت إنسانية باحثة عن الأمن والأمان والعدل والخير والجمال، فإذا بالقائمين على سلطة الحكم- بعد الثورة العظيمة عليهم- يرون ذلك خطرا عليهم، فحبسوهم في قفص حديد داخل صدر المواطن، وقالوا له كلمة واحدة:
- هسّ.
ولما سأل ببراءة رومانسية:
- لماذا ادخلتموهم في صدري إذن.
قالوا:- حتى تعرف أنك لو اخرجتهم، ستدخل مكانهم في القفص بداخل سجن حقيقي.
ثم سمحوا بل نادوا بأتيان بديل لهم، يحل محلهم، ويشغل الناس خصوصا الشباب الغض البريء الرومانسي العائش أزهي لحظات عمره، فلم يجدوا إلا روايات الرعب، التي لا تعدو صفائح قمامة لكل مخلفات النفس الضعيفة المريضة المضروبة بالمخاوف الطفولية القديمة المرعبة، روايات ملطخة بدم القتلى، تجوس فيها أشباح وعفاريت وسحرة وقتلة متسلسلين وخزعبلات قديمة، ظن الناس أنها انتهت مع الغياب القليل للصحوة السلفية المتطرفة- بعد سقوط حكم الأخوان في الثورة الثانية عليهم- ورجالها الفزعين من عذاب القبور وعذاب فتنة النساء غير المحجبات، وهمّ الدنيا كلها، حتى الآخرة ونارها التي لا تبقي ولا تذر، فلا أحد يأمن مكر الله ولو كانت أحدى قدميه في الجنة، وظن الناس أو البعض منهم خصوصا المثقفون، أنهم سيلحقون بالتنوير العقلاني، وستضيء قلوبهم وعقولهم الثقافة العلمية والفلسفية، ويحصلون على حقوقهم الإنسانية ويعيشون في كرامة يقظة حرة، فإذا بهم يرون نهضة ثقافة الرعب الموجه القوية، في روايات تتهاطل عليهم من كل حدب وصوب، وتتدفق من المطابع كالمحيط الهادر لا ينقطع ولا يمتنع بجوار غيرها من توافه الأدب والفن المنحط...
وكان الكاتب الشاب المرفه الملول الكسول، أكثر من استيقظت على يديه كتابة الرعب، حتى نشر الفزع في القلوب، والخبل في العقول، والتم حوله الشباب الغر البريء، مفتونا بلعبته وشهرته الكاسحة، والذي تُفتح له كل مغاليق دور النشر الكبيرة، ويدخل أبوابها المشرّعة، دخول الأبطال الشجعان، وخلفه الحرّاس، يحمونه من شطط المحبين.
كنت مندسا إذن بين الجمهور الذي يضم المحبين البله من عامة الشباب الغر، وقلة من الكارهين الحاقدين الممرورين المعترضين على كتابته، وهم ذوي ثقافة عالية، قادرة على فضح ما يقوم به النجم، من تدليس وسرقة من الأعمال الأجنبية، باسم الاقتباس وغيرها من حيل، يستعين بها على الكتابة بانتظام، ذلك أنه كل شهر تقريبا يخرج كتابا جديدا، فهو كماسورة الصرف المكسورة، تغرق خرابة العالم بالنتن دون توقف... وكما يتلفت القاتل السفاح في غيط الذرة على طريدته، كنت اتلفت برأسي الدقيق لامع الصلعة، أراقب دخول الكاتب الشاب المحظوظ الشهير إلى القاعة، وأحدق في الجوقة التي تتبعه، فردا فردا، آملا أن أكون واحدا منها، إن لم أكن على رأسها...
لمحت واحدا من المعترضين يقوم ناهضا إلى القتال، ثم صال وجال تبخيثا وتشويها في النجم الصاعد الواعد وكتابه الجديد، مؤكدا لحشد الحضور أن الكاتب هذا ظاهرة مرضية من ظواهر عودة النظام القديم، ينبغي التصدي لها بيقظة، خوفا على قلوب الشباب البريئة الرومانسية...
تكهرب جو الندوة التي نظمتها أكبر دور النشر في حديقتها الغناء الواسعة، وحشدت لها الجميع وكل الصحافيين وكانت كاميرات الاذاعة والتلفزيون الثابتة والمحلقة ترصد وتبث للعالم كله وقائع الحفل الكبير...
الجم المثقف الكبير المعترض بمنطقة الثوري العقلاني النافذ الجميع، بمن فيهم الكاتب الصاعد، الواعد نفسه، الذي لم يعرف كيف يصد الهجوم عليه، ولا كيف يرد كلمة، ولو بكلمة...
فطلبت الكلمة، ومضيت حثيثا وسط الشعاب برشاقة، ذاكرا محاسن المعترض الثائر، مجمّلا منها، حتى رفعته إلى مصاف النخبة، التي ينبغي لنا كلنا الاستزادة من علمها العميق، وأنني لا اعتراض لي على كلمة مما قاله، لكني أهيب به رغم ذلك، أن يقف مع الكاتب الشاب الصاعد الطموح، الذي يريد أن يقوي قلوب الشباب، ببث شيء من الخوف فيها، خوف إيجابي متخيل، يحصنهم من الخوف الأصلي، الذي يمكن أن يجدوه في الواقع الفعلي، وأن الكتابة الإنسانية الرومانسية رغم جمالها وتحليقها في عوالم الجديد والمتجدد الحي، إلا أن خطورتها تكمن في تغييب الواقع المظلم الذي يعيشونه، وتجعلهم منفصلين عن رعبه الفعلي الملئ بالقتلة واللصوص والسفاحين والخونة... وعليه يكون كاتبنا الشاب قد قدم خدمة جليلة لثقافتنا ولشبابنا بأعطائهم المصل الذي يقوي جهاز المناعة فيهم، وأنه لهذا السبب يكون ابنا من أبناء أفلاطون، نعم، أقولها بالفم المليان...
كان الجميع ينظرون لي بدهشة تامة حتى المثقف المعترض نفسه الذي لحظ وبقوة قلبي لكلامه، جاعلا اعتراضه لصالح من ينقده، كأنه كان طيلة قدحه، يمدح الشاب ولا يهدم شيئا منه أبدا. وواصلت كلامي بحماس:
- نعم يا أصدقائي إن كاتبنا الشاب الطموح ابن بار من أبناء أفلاطون، ذلك أن الفيلسوف العظيم في كتاب الجمهورية كما أتذكر، دعى بقوة إلى تربية أبناء الأغنياء المرفهين بواسطة مسرحيات مرعبة، تُعرض أمامهم كل حين، تدخل إلى قلوبهم الغضة الرعب، أو شيء منه، حتى يقويهم على الحياة في الخارج، لمّا يكبرون، ويرون الواقع بما فيه من مرعبات وحروب وفساد الخ، فلا يرتعدون أو ترتجف قلوبهم وتهوي، ومن هنا كانت المسرحيات المرعبة علاجا وتقوية، وهذا ما فعله كل كتّاب الرعب الأجانب ومنهم إدجار آلن بو الأمريكي، وموباسان الفرنسي على سبيل المثال، حتى كافكا أيضا في القرن الماضي، كل هؤلاء الكتاب وغيرهم عملوا على تقوية القلب الإنساني ليشتد ويتقوي، ولا يكون عرضة للرومانسية، التي تسم الحياة العادية النهارية، لقد عمل كاتبنا الشاب عملا عظيما، كما نرى، وهو لا يرعب الشباب بغرض شخصي، ليتكسب منهم نقودا وشهرة، لا أبدا، إن النقود والشهرة ما هما إلا نوافل عارضة على فعله الأساسي، الذي هو بثٌ للقوة في قلوبهم، لمّا يشاهدون في كتبه النشيطة الحماسية، العالم الواقعي نفسه، بما فيه من بشر خلقهم الله ومع ذلك تخلوا عن بشريتهم المقدسة، وحب الناس الأهل والأحباب والأصدقاء، واندفعوا للقتل والانتقام، تستبد بهم روح العدم والخراب، فإذا بالقرّاء الشباب وهم يستمتعون بالمغامرات الرهيبة الدموية، لا يخافون الدم، ويعتادون رعب القسوة، وغلظة القلب، وغباء الذهن الإجرامي، ويستسيغون الإنسان المريض النفسي والعقلي، ورأسه المحشودة بالخرافات، فيعلمون بوجوده بينهم، بل هو الكثرة الكاثرة من البشر، وتكون الرواية التي يقرأونها للكاتب الذكي، عونا لهم على فهم أنفسهم وواقعهم والعالم كله، بصورة واقعية صحيحة سليمة أبدا فإذا بهم يعيشون بقلب شديد، ويحيون بروح جسور، شجعانا لا يخافون أبدا...
كان ضميري اليقظ الجالس في آخر القاعة، يستمع للساني الذرب، وهو في غضب عظيم ويقول لي بصوت لو سمعه غيري لقتلوني فورا:
- كذاب مدلس حقير... قالب للمعاني السامية ومحقر للهمم... إن الإثارة ليست في بعث الخوف في النفوس، فالخوف مرض، يعلّم الجبن، ويصرف العقل عن صاحبه، فلا يعرف نفسه، إن كان مقتولا، أو قاتلا.. كف أيها الحقير...
وانطلقت القاعة كلها في التصفيق لي، حتى الكاتب الشاب الصاعد الواعد نفسه، وكان في انبهار من تحويلي هزيمته وفضيحته نصرا وكرامة وعلوا، حتى جعلته فوق كل الأدباء، في القمة، بل نخبة النخبة ذاتها...
سأل الكاتب الشاب جوقته عني، وأرسل في طلبي وأعطاني كارته الذهبي، ودعاني لزيارته، وطلب أن نكون أصدقاءً، وأنه بحاجة ماسة حقيقية ليّ، أنا العارف ببواطن الثقافة الحقة العميقة جدا، هكذا شدد وأضاف ضاحكا:
- أنت مصيبة... دماغ عالية... مكلفة بجد... ابن أفلاطون حتة واحدة... هاهاها... وإنني قادر على تحويل الضعف قوة، وينبغي أن لا أكون بعيدا عنه، بل رجله، والمتحدث باسمه، وكبير موظفي علاقاته العامة...
هكذا فجأة حصلت على وظيفة، سبقت بها غيري من جوقته، وقفزت أولى قفزاتي على مدمار الشهرة، ففي كل لقاء تلفزيوني للنجم، أكون بجواره، أصلح له ما يقول، وأصوّب المعوج من قوله، حتى صار هو المثقف الكامل القيمة، البهي الرائع ابن أفلاطون حقا وحقيقة.
بينما المثقفف الثائر المعارض الذي حولته إلى مجرد سلما صعدت عليه إلى مجدي، غاض ماء وجهه، واحتقنت عيناه، ونظر لي بحقد حاقد، وغضب عارم، فلم أكشّر له كذئب، وكان أحرى بي ذلك في الحقيقة، لكنني لم أفعل طبعا، ولم أتركه أيضا، وإنما اقتربت منه بهدوء بسّام، وسلّمت عليه بحرارة أمام الجميع، حيث لا يستطيع أن يصدني أمامهم جميعا طبعا، وإلا فضح نفسه وأظهر بغضه وغلظته، بل انحنيت وقبّلت كفه، اعترافا مني بفضله عليّ.
فارتبك تماما من هذا التفاني مني، في الاعتراف بفضله، لا يعرف ماذا يقول، وأي فضل هذا الذي اعترفُ له به أمام الجميع، وأنا شوهت قولته كلها، وحولتها عن مقصدها الحقيقي... لكنه ظن على طريقة المثقف الحقيقي الشكاك في نفسه دوما، أنني فعلا صادق تماما، وعليه أن يراجع نفسه، وأن يفكر بطريقة أخرى، في أن الرعب الحقيقي ليس في ما يكتبه النجم الصاعد الواعد، وإنما في الكتابة الإنسانية الرومانسية المحبة الرقيقة، التي هي زيف وإلهاء، عن القوة المحركة للواقع الرأسمالي المرعب المسموم في علاقاته، التي تمتص دم البشر وتقتلهم ذبحا بسكين الأسعار، وتحشد ثلج اللامبالاة فيهم، وتكبلهم بقيود من حديد التحريمات من جهة، مطلقة فيهم حب الشهوات، والأماني الكاذبة، من الجهة الأخرى، وكل تلك الأساليب الرهيبة لا توجد إلا في رواية الرعب واضحة، وإن بصورة رمزية في هيئة سلاسل وسيوف وقتل وذبح وعفاريت ومصاصي دماء، خصوصا في روايات الكاتب اللامع الذكي، الذي يجعلنا جميعا واقفين على اعتاب حقيقة المجتمع المحلي والعالمي الذين صارا كابوسا واحدا، لا فرق بينهما إلا الشكلي فحسب...
*
مازال ضميري يرقبني من خلف الحشود، وكلما التفتُ إليه أراه شبحا ظليا كأنه انعكاس جسدي، وقد شرد مني وتناثر بعيدا، وتلك الحالة كان يقصدها لأشعاري بضياعي، كأني مجرد ظل لمن أقوم بالكذب لصالحهم، والحق أن هذا كان يسعدني، إذ كان شعوري بضياعي مجرد معلومة، تضاف إلى يقظتي، تخبرني بأنني على الطريق الصحيح، الذي يريد هو تسميته بالضياع، في أثر الآخر الزائف، وأسميه أنا طريق صعودي.
وفكرة أنني ذيل للنجم المشهور تلك، لا تعني لي سوءا أبدا، وإنما قدرة وتميز، لأنه ليس سهلا أن تكون ضمن جوقة نجم مشهور تتبعه، وتهلل له، وكوني صرت الأول فيها، فتلك حظوة ورفعة تجعلني منافسا قويا للجوقة وأفرادها المتصارعين على الغنائم المتساقطة من خلف النجم.
*
كان ضميري في حيرة حقيقية وهو يراني لا أطرده ولا أهينه، وإنما اتركه يتبعني، بل حتي يسير بجواري متوترا، واتحدث معه خفية، دون إشعار الآخرين بذلك، وإن شعر أحد، فيظن أنها مجرد عادة لدي، أن أكلم نفسي، شأني في ذلك شأن أصحاب الضمائر اليقظة، أو الأذكياء بافراط، الذين يفيضون حتى على أنفسهم، بعد إفاضتهم على غيرهم طبعا، وإن ظن بي الجنون، فهذا حسن أيضا، إذ يصب في صالح تميزي، وغرابة أطواري، التي بفضلهما أستطيع التفكير بطريقة أفضل من الجميع، وأرى غير ما يرون، وأنني عبقري بالسليقة، بل ومتفاني في إنكار ذاتي، لصالح قضية الإبداع والوطن...
*
كنت أحرص على التواجد المبكر في الندوة الثقافية لمجاملة المشهورين، وتدعيمهم بكل السبل، بداية من السير بجوارهم، واستقبالهم- قبل أي أحد- بالاحتفال اللازم، والأخذ بيد أكبرهم صعودا إلى المنصة، وتجهيز المقعد له، بل والمبادرة بتقديمه للجمهور، قبل المقدم الرسمي، بكلمات لطيفة تشير إلى الحظوة والنعمة التي يمثلها هو الكبير المشهور بحضوره وسطنا نحن المغمورون، الذين نبحث عن نموذج حقيقي واقعي لنقتضي به، ونلمسه ونراه ونتحقق من أنه موجود بيننا، ومن ثم نستطيع أن نرى الأمل فيه، وأن نسير على دربه الصعب، ونتعلّم منه أهمية السعي، وحتمية الوصول إلى الغاية الجميلة، التي يوجد هو فيها باقتدار...
فيشكرني باسما لي، ثم يتوجه للجمهور، ذاكرا خجله من كلماتي الرقيقة، لاسيما وأنه لا يعرفني، بل لم يدعوني إلى ندوته، وأن هذه مبادرة مني نزيهة خالصة لوجه الحق والحقيقة...
وطبعا هو كذّاب، لأنه اتفق معي على ذلك بعد استئذان كاتب الرعب الشاب الصاعد الواعد، واتفق معه على السماح بحضوري في ندوته لتدعيمه في حضور أعدائه وكارهيه، وأن كلماتي المثقفة بحق والعالية على الجميع، حتى لو كانوا أكثر مني ثقافة ووعيا ومعرفة بالمراوغة وقلب الحقائق. إذ أستطيع أنا بنفس المنطق الذي يفضحونه به ويعرونه، أن أقلبه لصالحه، ذاكرا أن الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، وأن النزاهة تحتم علينا قبول الآخر، وعدم الوقوف في طريق المجتهدين الساعين إلى المجد الذي يستحقونه، وأننا جميعا لا نتحارب ضد بعضنا البعض، وإنما نتنافس على الجمال، فكلنا زهور في حديقة الثقافة الجميلة، يدعم بعضنا بعضا...
وازعق بقوة وسط الجمهور:
- لسنا، ولن نكون أبدا، إلا حائط صد ضد المدعين، وفي نفس الوقت نكون سلّما ومعبرا للجادين، خدمة لثقافتنا الراقية، أننا أعضاء في جسد واحد، سليم قوي يعمل الكل فيه لصالح الجزء، مثلما يعمل الجزء لصالح الكل...
فإذا بحديثي يمسّ قلوب الجمهور، وهذا هو الأهم، وليس عقولهم، وإن مسها، فبطريقة إيجابية، لأنه كله إيجابي مطلق يرضي الكل، فهو محفّز في العموم، يشد من ساعد الضعيف ليقويه، ويشد أيضا من ساعد القوي، حتى يزداد قوة ورفعه...
وأصيح:- يا أصدقائي أن الهدف النبيل هو الأهم.
وتستمر الندوة بحماس مراقب مني، يصير فيها النجم سيدا للثقافة ونعمة للأجيال القادمة، حتى اطمئن لمسارها الذي يمضي لصالح مستخدمي، الذي ينظر إليّ، كل حين بامتنان وتقدير، حتى لا يعرف كيف أفعل ذلك، فهو نفسه تأثر، وصدّق ما أقوله، لأنني أقوله بصوت واثق قوي فعّال مندهش حماسي، تدمع له عيناي، وعيون السامعين جميعا، عبر أرجاء القاعة الواسعة الفاخرة اللامعة بالأضواء، لا سيما وأنني أرفض الحديث من خلال الميكروفون تواضعا" حتى لا يعلو صوتي على صوت المنصة الكريمة".
هكذا أقول، فإذا بالجميع يصمتون فلا نأمة تخرج من أحدهم، ويرهفون السمع لي، وأنا أكذب بحنكة...
فيما ألمح هناك ضميري يذهب ويجيء بحيرة وحزن، كأنه ضبابه معتمة حانقة...
قبل انتهاء الندوة بقليل أشرت بطريقة لطيفة للكاتب الشهير برغبتي في الانصراف، فقام من مكانه مستئذنا للحظة، وعارفا أن هذه الإشارة سيم بيننا، واختفينا وراء ستار ثقيل، عانقني بحب، ثم وضع في يدي مبلغا جيدا من المال، رفضت طبعا، لكنه أصر بمحبة، فهو لم يستطع لضيق الوقت احضار هدية ليّ، فما الهدية التي يمكنها أن تساوي فعلى الكبير، الذي دعّمه كل التدعيم، تسلّمت المبلغ في صورة الحزين الخجل المحب له والمضحي، فإذا به يكاد أن يضحك، لكنه لم يستطع مجاراة جديتي، فأنا أكذب وهو يعرف ذلك، لأنه مجرد سطحي تافه، لا يستطيع قول كلمة واحدة لها قيمة للناس، لأنه لا يقرأ، ومشغول بالصراعات على المكاسب واللقاءات والمناصب والتحارب مع الأعداء، أو كما يسميهم الأعدقاء، إذ يرى، أن الأصدقاء أكثر عداءً من الأعداء أنفسهم، لكنني لست من هؤلاء الأعدقاء، ولا الأعداء، وإنما من الأصدقاء العمليين الخلص الفاهمين أين يضعون ثقتهم بالضبط..
في طريقي للخارج لم انظر لضميري الذي تبعني بتحد...
*
- سأفضحك.
هكذا قال مضيفا:
- سأدمر كل ما تفعله...
*
لا يعرف ضميري أنه مثالي محلّق فوق الأرض، عصره انتهى، ومجرد انتيكة، وشيء من الماضي، تذكرة ليّ في أحسن الأحوال. بل أن الحياة دونه قد تكون ممكنة، ولكني لست متأكدا من ذلك حتى الآن، فقد أخسر بغيابه حقا، ما وصلت إليه من مكانة.
ومن الجهة الأخرى كنت متخوفا من أنه طالما تجسّد خارجي ولو في صورة ضبابة ظلية، يمكنه أن يواصل تجسده، بطريقة ما، حتى يصير نسخة أخرى مني، مطابقة ليّ، ومن ثم يخرّب كل افعالي حتى يرغمني العودة إلى ما يعتبره الصواب، لإنه لا يرى نفسه ابن حقبة قديمة، بل مازال يلح على أنه مطلق وأبدي، وليس نسبيا جزئيا احتماليا أبدا...
قررت أن أعطي نفسي فرصة لإعادة هيكلته، وتحويله لصالحي، لكن المعضلة هي أنني لا أريد تحويله ليكون مثلي، أي يكون كذابا، ربما أفضل مني بكثير، إذ سيكون حصل على الحسنيين: التفرقة والتمييز، أي القدرة على الإنتباه للصواب والصحة العقلية، والكذب الممنهج أيضا، بينما أنا لا تنطوي نفسي إلا على الكذب فحسب، واستمد التذكرة منه، لذا كان ينبغي لي الإبقاء عليه كما هو من خلال فكرة طلب الهدنة.
حاولت اقامة حوارا معه أثبت له فيه كذبا طبعا، أنه لو قتلني أو ابعدني- لأنني لن أتغير واتحول عن الكذب- واكتفى بنفسه، سيسقط في الحياة الفعلية النسبية ويتشوه، وتنقص يقظته، ولن يستطيع تنبيه نفسه لما يفعل، ويصير مشوها غير عارف كيف يصدق أو حتى يكذب، في الوقت والمكان والمناسبين، ويخسر كل شيء، وأن عالم الصعود بين الأقوياء يتطلب الحذر كله..
فقال لي ساخرا:- لابد أن أجرّب، فلن أقف مكتوف اليدين، انظر إليك، وأنت تصول وتجول وتستخدمني مطية لك.
قلت:- أليس من الأفضل أن نعقد اتفاقا أو هدنة، تتركني حتى أحقق وصولي إلى القمة، وأصير غنيا ومشهورا، ثم أتوب على يديك، وأعود صادقا بعد أن أكون قد حصّنت نفسي، وصرت رجل المال والأعمال والشهرة، ارجوك اترك لي الفرصة حتى أفعل هذا.
- لماذا اتركك تكذب وتشوه الناس والحياة، حتى تصير أنت المشوه الأكبر؟ إن هذا مرض، أنت مريض، خنفساء تدافع عن حقارتها، وتريدها أن تستفحل وتمتص دماء الأبرياء...
صرخت بغيظ:- أن هذه الطريقة التي تفكر بها قديمة جدا ياعزيزي، لم يعد ثمة أبرياء كما تظن، وإن كان هناك أبرياء حقا ومستقيمين صدقا، فلابد أنهم سيكونون مثلي كذابين، فهذا ما حدث لي، اتعرف ألمي، هل خبرته، هل تعرف الحسرة وفقدان الأمل وأنت ترى السفلة والمنحطين يتسلقون إلى المجد والشهرة فوق الأكتاف، يا عزيزي إن ما تتصوره عن الاستقامة درب من العته والغباء لا غير...
تشوه وجهه بالحزن، ونظر لي باحتقار أعرفه جيدا، لكنه لا يؤثر فيّ أبدا، إلا أنه مع ذلك يذكرني بنجاحي في الحفاظ على طاقة الكذب في.
قال:- التجدد... أنا اطرح عليك الحل السهل الحقيقي وهو التجدد... لا تتبع أحدا، لا تهرق كرامتك في مرض التبعية، لا تبدد موهبتك الجيدة في تركها تتعفن على أعتاب الآخرين، لن يفيدك المال في شيء، وإنما الجوع هو ما يفيدك، أنت مجرّد مرحلة تمر بها الإنسانية في طريقها إلى الجمال، وعليك أن تكون معبرا ليّ، أنا الجمال الحقيقي، تجدد... ابدع ماهو أفضل منك، ولا تكون تابعا لأحد ما...
*
لم يفض النقاش إلى شيء غير الهدنة، التي ستكون فرصة لي لتجريب التجدد الذي يريد، وكان هذا أمرا جيدا جدا، أستطعت في تلك الفترة البسيطة، إنشاء مكتب ووكالة عن الفنانين والكتاب، فصرت مسؤلا عن رعاية الكتاب الكبار منهم طبعا، وليس المبتدئين، أعدّ لهم حفلات توقيع كتبهم، وأرسل لهم من خلال المكتب مقالاتهم إلى الصحف، التي يكتبونها كل شين كان، بعد تصليحها لغويا، فهم جهلة في اللغة والنحو والصرف، فليس لديهم وقت للتعلم، وكذلك في الأفكار أصلحها لهم، وكثيرا ما أكتب أنا المقالات كاملة، وأرسلها باسمائهم إلى المجلات، وأصحح لهم كتبهم، إن لم أكتبها كلها أصلا...
كان المكتب في فيلا الكاتب الشاب الصاعد الواعد، أشهر كتاب الرعب، منحني أياه، لمّا عرف بمشروع الوكالة الأدبية، وأنه سيكون مخصصا لشهرته، بجوار الفنانين والكتاب الآخرين أصحابه.
أتيت بالموظفين والعمال، وكان ثمة حديقة حول المكتب، بها بستاني فقير جلبته من الشارع، كان عجوزا، لكن قويا جدا، أستطاع في مضمار شهر أن يجعل الحديقة جنة مزدهرة، بها الكثير من الأماكن الصالحة لأقامة ندوات ثقافية، محاطة بالأضواء الرقيقة، وبها العمال يخدّمون على طلبات رواد الندوات، التي تُعقد يوميا في كل مجالات الكتابة، وكنت أطوف كل يوم على الحضور، وأرسل لهم تحياتي، وأطلب لهم المشروبات مجانا، حتى شعروا بأنني محسنا كبيرا، أخدم الثقافة حقا وحقيقة...
كنت أحرص أن يترأس كاتب كبير شهير ندوة كل أسبوع، يتحلّق حوله الصغار والمجهولون من الكتاب، يشيدون به وبفكره، ويطرحون عليه أفكارهم وأعمالهم التي يمكن، بفضل الكاميرات التي ترصد كل شيء في الندوة، بعد تفريغها، استخلاص الأفكار، التي يمكن تحويلها إلى كتب باسمه، وبعض الأعمال التي يقدمها الكتاب المغمورون، التي يمكن الاستفادة منها لصالح الكاتب، بعد تغيير بعض أجزاء فيها، وكان هذا كله يحدث بيني وبينه، دون أن يلحظ هو، أو يلحظ، لكنه لا يفكر في أن هذا جريمة وسرقة، إذ لمّا اقترح عليه الفكرة الجديدة، التي طرحها أحد الكتاب، بوصفها ليست جديدة في شيء، وإنما الكاتب استعارها من آخر أجنبي شهير، أسمه كذا أو كيت... أو لا أذكر له مصدر الفكرة، التي فرغّتها من الكاميرات التي ترصد مسار الورشة، أو حتى اقترح عليه فكرة عشوائية ما، أقدمها له يكملها هو، أو أقدمها بعد الانتهاء منها كاملة، فيوقع عليها بعد أن يسدد لي ثمنها وهو كبير طبعا...
*
كان ضميري أثناء الهدنة في حال من الذهول والاكتئاب، نحل جسده الضبابي المعتم، رغم وجوده بصحبتي في المسكن الفاخر الملحق بفيلا كاتب الرعب، الذي أسهر عنده كل ليلة تقريبا صحبة كبار الأدباء المشاهير، تخدّم علينا الفتيات، ونتناقش في أمور الخيال، وكيف يمكن كتابة رواية جديدة، تأخذ بجماع قلوب الشباب...
*
كنت كل ليلة أثناء النوم اترك نفسي لضميري يعذبني بالكوابيس كيفما شاء، حتى أخفف عنه حمله النهاري، فكان يغرقني إغراقا في أحلام مفزعة غبية تكاد تزهق روحي حقا...
ذات مرة رأيت نفسي ميتا، جثة هامدة، لا بل أكثر من هذا، هيكلا عظميا، تخرج من فمي الحشرات، فقمت من نومي ليس حزينا، أو مرتعبا، وإنما فرحا قليلا، فهذه الصورة/ الحالة المفزعة، ستأتي لي بمبلغ كبير، لمّا اتصل بالكاتب الصاعد الواعد، وأخبره بها.
هيأ ضميري لي ذلك الكابوس شديد الإفزاع، قاصدا التعبير الرمزي عن موته فيّ، وأنني بلا حياة حقيقية داخلية، وعليّ الانتباه وترك ما أفعله من سخف وانحطاط في اعقاب الآخرين... لكنني على الرغم من ذلك اعتبرته اهداني هدية ثمينة، بل ألقي لي كنزا، علي استثماره، فاسرعت في كتابة ذلك الحلم الكابوسي الفظيع رواية مرعبة، كتبتها بالتفصيل غير الممل طبعا، عن شخص يتحول كل ليلة أثناء نومه في غرفة نومه الفاخرة الجميلة المزينة بالورود والنساء، هيكلا عظميا، تبلى ملابسه حتى تصير رمادا متساقطة أسفله، ثم يتهرأ جلده ويذوب كالماء الحامض العفن، حتى يتحول إلى هيكل عظمي مرعب مخيف، تعيش فيه الحشرات، وأن هذه هي حقيقته التي يخفيها عن الناس، رغم أنه في الصباح حين تطلع شمس النهار على الدنيا، يعود كما كان إنسانا، من لحم ودم، جميلا شابا انيقا رشيقا فاخر الملبس، تهفوا إليه القلوب، خاصة قلوب الصبايا، محاطا بالشهرة والأموال والسيارات والميكروفونات والطيور تحوم حوله، كأنه شجرة الخير إينما حل وكان، وأثناء ذلك يلقي الزهور للجميع، مع الابتسامات الفرحات جدا، الفاخرات تماما، وأنه بوابة السعادة الحقة، وكلما تذكر موته الليلي وخرابه وفنائه، وتحول غرفته قبرا، ازداد حضور بهجته الزائفة أمام الآخرين، وفرحه وسعادته بوصفه في قمة العالم وفوق سحبه السعيدة...
*
نفحنى الكاتب الشاب الثري وديعة كاملة في البنك، مقابل روايتي البغيضة تلك، وضمها إليه، ووقعها باسمه، بل نشرها فورا في أفخم الطبعات، فراجت سريعا، ورأي فيها الخاصة قبل العامة عمقا فلسفيا حقيقيا، وإنها تلمس عمق الوجود الإنساني الآن، حيث الإنسان في الحقيقة مجرد مظهر براق، يخفي حقيقة فناءة وقبحه...
جعلتني الوديعة الثمينة ثريا نوعا ما، فأنا طماع جشع، وكانت سعادتي تزداد كلما زادت قدرتي على تحويل كوابيسي إلى روايات مرعبة، أبيعها للكاتب الشاب الصاعد الواعد، ولغيره، لقاء المال الوفير...
بينما كان ضميري أثناء ذلك يبكي قهرا على ما وصلتُ إليه من خراب داخلى، تحت الرداء الفاخر الجميل، حيث صرت قبلة الكتاب جميعا، خصوصا الفتيات منهم، وصرت المطلوب في كل محفل ولقاء تلفزيوني، بل والموجّه للثقافة وصانع الكتّاب وطريق الخير للجميع، وفي ذات الوقت تتهاطل الكتب المرعبة التي هي كوابيسي الحقيرة وأمراضي الشخصية وانفصالاتي ورعبي وخوفي وشيزفرونيتي، التي كان ضميري يرفدني بها من أجل افاقتي وصلاحي، ولو شاهدني أحد بالصدفة أكلم ضميري في أحد الأركان بطريقة الهمس، يشعر بأنني في حالة الإبداع وسره الذي يجعلني أستطيع الكلام دائما مع أشخاص غامضين غير مشهورين ومجهولين ليّ، وله، وللعالم كله، وأن لي عالم غامض لا يدخله إلا أنا...
*
ومع أنه يمكنني القول بأنني وصلت إلى ما أريد من الشهرة والثروة والسلطة نسبيا طبعا، إلا أن الطريق مازال طويلا، ووقت الفراغ يتقلص، رغم جيش الموظفين في المكتب الذين يقومون في الحقيقة بكل العمل، بل صار المكتب أو الشركة تعمل وحدها ذاتيا وبكفائة تامة.
اعتاد الموظفون على رؤية ضميري الذي زاد من تجسده خصوصا بعد انتهاء المهلة بيننا، دون أن استجب له، فلا تجديد ولا تغيير حصل. وصار شبيها بي كأنه أخي التوأم، كان يحاورهم فيما يفعلون، ويشوهه لهم، ويحاول أن يخرّبه ويوقف عمل الشركة، إلا أنهم كانوا يقفون في وجه محاولاته كلها، كأنهم أنا فهم يخافون على مصدر دخلهم طبعا، وطالما أن الأمور تسير، ووفود الكتاب تأتي، والحركة مستمرة، إذن فكل شيء على ما يرام...
كان يحاول أن يوضح لهم أن ما يقومون بها من تلفيق وسرقة الموضوعات من أصحابها، وإعادة كتابتها بطرق شتى، بل وأن كتابة الكوابيس تلك لن تأتي إلا بالخراب على المجتمع ككل، وسينداح العمل الفريد في الشبيه المزيف، ولن يتبين الحقيقي من الوهمي، وأن هذا ليس في صالحهم هم أنفسهم، فذات لحظة سينكشف هذا كله، لكنهم كانوا يقولون له:
- بأن هذا يحدث في العالم كله، وأنه قانون النشر الآن، والرواج بين الجماهير، وأن كل الناس تعلم ذلك، وأنهم لا يأتون فعلا منكرا أبدا، وأنه هو من يتمسك بتقاليد قديمة لا تصلح الآن وهنا في عالمنا العولمي الجديد...
كنت اتابع عبر الكاميرات تلك الحوارات، وأرى مدى اليأس والاحباط الذي ينتاب ضميري، حتى بدا يشفّ ويذبل ويكاد يموت كمدا، وكنت أخاف عليه حقا، فهو رغم كل شيء ضميري اليقظ، الذي بدونه لا أعرف إن كنت كاذبا أم لا، بالأضافة إلا أنه سبب الخير كله بفضل الكوابيس المرعبة التي يرسلها لي كل ليلة...
*
كنا نعد للاحتفال السنوي الكبير، برائد كتابة الرعب، صديقي الشاب الذي غمرني بخيره كله، وأعلى من شأني وصرت المتحدث الأول والرسمي باسمه وأعماله المشهورة كلها، التي تباع في كل المكتبات وتعد للإذاعه والسينما، بل كان يعتبرني صاحب فضل كبير عليه، وفي نفس الوقت يخشي مني، إن لم أقل يرتعب، إذ كان يعرف أنني لا أحبه، وأعرف مواطن ضعفه كلها،وما أكثرها، وأنه في الحقيقة مجرد دمية أستطيع تحريكها إينما شئت وكيفما رغبت، لكنني كنت اطمئنه، مدعيا أنه لا يعرف مقدار نفسه، وهذه سمة المبدعين الحقيقيين...
لكنه على حين فجأة سألني مرة سؤالا عميقا، لا أدري كيف جاءه قال لي مرتجفا بجد:
- من فضلك يا صديقي كيف تخرج من نومك كل ليلة صحيحا معافى، بعدما تعيش كل تلك الكوابيس الرهيبة أثناء نومك، والتي قد توقف قلبك يوما، أو حتى تؤدي بك إلى الجنون، فأنت تعيش في مقبرة فعلا وليس في الحياة...
ابتسمت له قائلا:- جميل سؤالك أنه يشير إلى ضمير يقظ يارائد الرعب... لكن ماذا لو كان وجودك نفسه هو السبب، عموما أنا أستطيع تحمل عذابات ضميري الليلية، لكن عذاب الفقر والجوع والإهمال لا أطيقهم أبدا، فلا تقلق عليّ، فلن أموت لأنني ميت فعلا كما تعلم...
*
كان الحفل على أشده، جائته كل الوفود الثقافية، ومذاعا على الهواء مباشرة. جلس صاحبي الشاب الشهير المرعب الفاتن على المنصة بجواري، ورحت أقدمه للجمهور مثل كل مرة خصوصا هذه المرة، حيث انتهينا من طباعة روايته الجديدة
" الجثة في كفنها".
وكانت قد حظت بالشهرة المتوقعة، وجاء الكثير من القراء حشودا ملئوا الصالة وخارجها، حيث كانت تُنقل وقائع الحفل عبر شاشات كبيرة في حديقة المكتب، على جدران الفيلا الواسعة الكبيرة، وكانت الفلاشات تتخاطف بارقة على الوجوه، وكنت في نشاط معتاد وحماس عرفه الجميع فيّ، أقدم العمل الذي لم يصغ فيه الكاتب إلا بعض جمل تافهة، لم آخذ بها إلا قليلا، حتى يكون العمل له، على نحو ما، وكان الجميع منبهرين بالعرض الفاخر للمنصة، والبذلات والاستعدادات الاحتفالية الموشاة بالزينة وحضور الطلبات المجانية والمدفوعة...
وكنت أشرح لهم عمق الرؤية الكابوسية للرواية وأهميتها وجدتها كأني أنا من عاناها في الحلم، حتى كادت عيناي تدمعان ووجهي يحمر بالدم وارتجف حماسة...
*
فجأة، دخلت علينا من وراء ستار المنصة جثة ملفوفة بالكفن...
شهق الجميع وظنوها روح الرواية أتت إلينا فعلا، هاجوا وراح الكثيرون يهربون، لاسيما وأن الأضواء كلها سلطت علىها، توقفت أمام المنصة وتحدثت للجمهور المرعوب قائلة بصوت خشن ممرور حزين:
- لماذا تندهشون... أليس هذا ما أتيتم من أجله: الموت... وهاهو أمامكم...
ازاحت الجثة الكفن، عن رأسها فإذا بها ضميري نفسه وقد اكتمل تجسده تماما لكن ليس في صورتي النهارية الظاهرة، وإنما صورتي الليلية الكابوسية: الهيكل العظمي ذاته قبيحا داميا، يخرج من فمه الحشرات، راح يهبط اليهم بثقل، كانت خطواته ثقيلة خشنة تدب على الدرجات الخشبية ويغوص فيهم، وهم يتساقطون مغما عليهم رعبا... وكان يصرخ فيهم بطريقة إنشائية شجنية:
- أنا الحياة المقتولة، وأنتم من قتلني، وباعني قطعا، وحوّلني إلى جثة وهيكلا عظميا، تجوس فيه الحشرات...
كان الجمهور يهرب صارخا، ويتساقط على بعضه بعضا، ويزوم ويجعّر ويبكي بجنون غير مصدق...
والكاميرات تنقل الحدث ببرود، إلى البث المباشر، وكان ثمة من يصفقون، وأنا منهم بل أولهم، إذ أنني انا الكذاب رحت أصفق بقوة للعرض المسرحي للرواية، حتى استعاد الجمهور شجاعته، واستقام من كبوته، وظن أن الموت مجرد تمثيل، وليس حقيقة، وما الهيكل العظمي إلا رداء من أردية التمثيل، على أنهم كانوا في زهول غير عارفين كيف يفهمون ما يرونه...
هبطتُ إليه باسما لأطمئن الجميع، راغبا في عناقه وتقبيله أمامهم، ثم أخذه بعيدا عن الحفل... توقف واستدار إليّ مبتسما بسخرية، وفجأة صار أمامي بسرعة خارقة حاسمة، وكان يرفع منجلا حادا لامعا، لا أدري كيف اخرجه من هيكله العظمي البشع...
فزع الجمهور وهرب من القاعة والحديقة، بينما رأسي لامع الصلع المتخبط على الأرض، كالكرة، يرى حشد الأقدام الهاربة لآخر مرة، ويبتسم فمي براحة... راحة حقيقة... نهائية آخيرة، كأني في كابوس من كوابيسي الليلية المعتادة.... الكابوس الأخير...
***