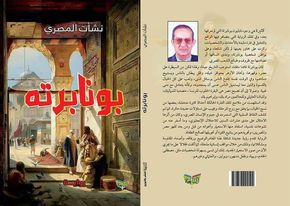قصيدةُ مناجاة لشاعر العرب الأكبر الجواهري، من أروع قصائد الشعر العربي الحديث، وهي بالرغم من قالبها الكلاسيكي ذي الجرس العربي الفصيح، تضج بروح العصر ورقة المدنية الحديثة وأدوات الحضارة المعاصرة التي تشتغل بمدلولات شاعت في القصيدة. يُحسب للشاعر الجواهري أنه مثال فذ لما يعرف بمحاكاة الذات في النموذج، فهو بتمسكه الشديد بعمود الشعر العربي جاء بحجة بالغة دحضت مزاعم الرواد بأن القافية والوزن للقصيدة العربية القديمة تعيق من دفق الشعور وصدق التعبير، فالجواهري عبّر عن أدق خوالج النفس، وما يطرأ على القلب والشعور دون أن يخرج – ولو بضرورات الشعر المعروفة المباحة – عن تلك الضوابط في البحور الشعرية العربية. وقصيدة مناجاة مادة صالحة لما ذُكر؛ ففيها من النعومة ما ينساب رويدا رويدا في البحر الشعري المختار، وعبر الجرس الداخلي لأبيات القصيدة، وقد حشد الشاعر فيها من فنون البلاغة – بقصد وبدون قصد – ما أسبغ عليها رونقا وماء ظهر في وقعها الحسن في الأسماع، وفي القراءة الصامتة أيضا، وفي مواقع التواصل الاجتماعي تشيع هذه القصيدة بإلقاء الشاعر الجواهري نفسه لها، بخفة ظله ومسحة هدوئه. والقصيدة تُظهر مدى براعة الشاعر واتقانه للفنون البلاغية العربية، فهي على قصرها ملأى بأجناس البلاغة من بيان وبديع ومعان، دون تكلف أو تعسف، بل أتت خدمة للغرض – مطابقة مقتضى الحال – وتحقيقا للجمالية المطلوبة، وهي الهدف الأساسي من توظيف الفنون البلاغية. في البيت الأول استهل الشاعر القصيدة بياء الندبة، وهو استهلال بديع يوافق مناسبة القصيدة وغرضها؛ فياء الندبة تجمع النداء مع التوجع، ويحسن البدء بها، لا سيما حين يلم الخطب وتجيش النفس بالشعور المتوثب، أمام مرأى الحبيبة في طيفها وتذكرها وحضورها الآسر، ولتأكيد الندبة انتقل الشاعر إلى النداء المباشر في البيت الثاني، وهو نداء مجازي، لكنه لا يخلو من معنى حقيقي بالنظر إلى الذات المخاطبة (الحبيبة)، فيا النداء هنا جمعت بين الاستغاثة والتوجع والمباشرة، لتحقق التواتر الذي بدأ بقوة في البيت الأول وزادت وتيرته لتبلغ ذروتها في البيت الثاني في قوله (يا شفائي ويا ضنى)، وحين كان النداء بوابة الشاعر للبوح والبث عبر الأبيات الاثني عشر عاد الشاعر من جديد إلى النداء، ولكن هذه المرة ليقرر حقيقة خبرية فصلت بين المسند إليه المخاطب (أنت) وبين الخبر (كم تودين)، وجاء النداء هنا معترضا ليفيد التعليل للغرابة الحاصلة بين المسند والمسند إليه، والعلة هي أنها (مرة الطباع وحلوة المجتنى) ولم يسق الشاعر تلك العلة بأدواتها المعروفة مثل اللام وإن، بل بأسلوب النداء لإفادة الجهر والاعلان، ولتلاؤم البوح مع عمق التجربة والخبرة بتلك الحبيبة الغائبة، علاوة على أن النداء يعيد إلى الأذهان مرة أخرى النداءات السابقة، لتتضافر مع العلة السابقة، ولتتوالى على الأسماع بوتيرة تظهر الأنين والشكوى عبر تكرار النداء الذي من أغراضه التكرار بنية التوجع. وقد أكثر الشاعر في هذه القصيدة من الفن البلاغي المعروف بالطباق، وجاءت تلك الكثرة ملبية للمعنى الذي توخاه الشاعر دون اقحام لألفاظ الطباق، مع ملحظ الناحية الجمالية في اللفظ التي كان يحرص عليها الشاعر كثيرا، وتجد ذلك الطباق في دوال (شفائي/ ضنى، نأى/ دنا، الصبح/ الليل، مرة/ حلوة)، كما تجد فيها ذلك الطباق غير المباشر الذي يلمح بالنظر وإعمال الفكر كما في قوله (مميت ومخيف، هناك وهنا، فقده وهجرانه، تحينت قبره وهو حي)، ويرسم الطباق الوارد في القصيدة صورة التناقضات الحاصلة في نفس الشاعر، وهي حالة حب مبرح تأججت بسببه عاطفة الجواهري فأصبحت بين مد وجزر، رفض وقبول، شح وعطاء؛ ففي حبيبته الشفاء كما أن فيها الضنى، فهي برؤه وسقمه، ومنها البلسم والجرح، وتلك حالة العاطفة التي تتأرج علوا وخفضا بحسب اللحظات الهاربة التي يعانيها الشاعر، وتتوضح جليا في البعد والقرب الذي وصف به الشاعر حبيبته، فهي على الرغم من غيابها، إلا أنها تدنو تارة وتنأى تارة أخرى، وهو ما تولد عنه مجاز آخر في الوجود والعدم والموت والحياة بحسب ذلك الدنو أو النأي، ومن هذه الثيمة بالضبط ينبثق بتلقائية مبدعة طباق الليل والصبح والحلاوة والمرارة، وهو طباق منطقي يصدر عفوا دون قصد، لأنه ترجمة – حرفية – لشعور يتسم بالتناقض العاطفي، دون أن يُعنى باللفظ، بل كان اللفظ ملبيا لكشف ذلك المعنى، فهو دال مباشر لمدلول يمثل الحقيقة، ومعلوم أن في حنايا العاطفة ما يصعب نقله، ولكنه يُحَس فيُقَارب باللفظ دون أن يكون ذلك اللفظ مساويا في اطلاقه لذلك المعنى، فالخوف مثلا تغير ما في العاطفة، وهي تنافي الموت، لكنها تشارفه أيضا، وبين المعنيين اشتراك وتضاد، ويتحصل منها بالنتيجة ذلك الشعور الذي يُحَس كما ألمعنا، ويبقى سره في خبايا النفس التي تعج بالغامض والمبهم والمؤسطر، والمعنى ذاته تجده في إشارة القرب والبعد بين هناك وهنا، فالأولى إشارة إلى الموت والثانية ترميز للخوف، ليأتي ذلك الطباق مسبوقا بنتيجة منطقية معجلة في الفقد وهو من لوازم الموت، والهجران وهو من لوازم الخوف، وبين الاثنين – كما في الأوليين – تشارك وتضاد أيضا، ويُعزى تفسيره فقط إلى العاطفة الحادة التي بلغت من الحدة ذروتها، فأخذت في خطاب الآخر في طباق يُنتزع من دالة القبر والحي، فإذا كان القبر يعني الموت والجمود فيقابله الحي المظروف في مكان (مغتنى) فيه أفانين الحياة الغنّاء. ولا بد من الإشارة إلى أن تأثر الشاعر الشديد بالعمود العربي الكلاسي، وثقافته العربية التراثية الرصينة، كانت سببا وجيها لتوظيف الشاعر فن الطباق البلاغي، لا سيما أن الشعر العربي حافل بمثل هذا الفن، وقد درج الشاعر على منوالهم، مقلدا أسلوبهم، لكن دون أن يكون الفن البلاغي (البديع) فجَّا تنشز عنه الكلمات، بل كان يسير بتوافق (هارمونيا) مع المعاني المنثالة من الألفاظ، ومع الحروف المنسابة بتراتبية منتظمة، ليكون جرسها في النهاية حسنا في الأسماع والأذواق معا. وإذ أخذ الطباق نصيبه الوافر من القصيدة، فإن هناك فنا بلاغيا آخر لا يقل عنه جمالية قد اكتست به الأبيات الشعرية، وهو فن (الجناس)، ووقعه في موسيقى الحرف غير خاف، وربما كانت القصيدة العربية قد تعمدت هذا النوع البلاغي لما له من أثر سمعي طيب يزيد من جمال القصيدة ورونقها، فعلاوة على المعنى المتحصل منه، إلا أن انسيابية الحروف المتشابهة في الكلمات تجعل من البيت الشعري مرنا وقابلا للحفظ بسهولة، بالإضافة إلى الطرافة والملاحة التي تؤخذ من تشابه اللفظ واختلاف المعنى، ولطالما لعب الشعراء العرب بهذا الضرب البلاغي، وتباروا في تحصيله وتوظيفه، وكتب التراث حافلة وحاشدة بمثل هذا، وما كان له أن يشيع ويشتهر لولا تلقيه بالقبول من قبل المتلقين على اختلاف ثقافاتهم. ومثلما صنّف العرب الطباق إلى إيجاب وسلب كذلك صنّفوا الجناس إلى تام وغير تام، ومعلوم أن الجناس غير التام شائع بصورة تفوق الجناس التام، لنزرة الكلمات التي تختلف معنى وتتفق لفظا، وقد لجأ الشاعر إلى الصنف الثاني (الجناس غير التام) وأكثر منه، بعكس الأول؛ إذ لم يرد إلا في موطن واحد في قوله (أرقبُ الصّبحَ موهِنا ودُجى الليلِ مُوهنا)، مما أكسب القصيدة تلك الرقة والنعومة التي ارتسمت بها وسارت عليها حتى ختامها، وإذ يظهر الجناس أنه قد ورد بعفوية في القصيدة، دون تكلف ولا اقحام، إلا أنه قد جاء بقصدية من الشاعر، تلك القصدية التي يمكن اثباتها من خلال الاستشهاد بكثير من الكلمات التي لم يأت بها الشاعر تلبية لهذا الغرض، مع أن في الكلمات التي آثر الشاعر أن يصرف نظره عنها، هي المناسبة وهي ما يرد لأول وهلة عند المقابلة أو ترجمة المعنى. ومما ساعد على توظيف ذلك الفن البلاغي هو تلك القافية التي اختارها الشاعر، فكانت عونا على تجسيد (الجناس) بتلقائية تطابق مقتضى الحال، وهو شرط البلاغة، تجد ذلك في (السنا والونى، وضنى ومنى وأنا، دنا وهنا، موهنا وموهنا، واعتنى وبنى، دنى وغنى). وهناك في القصيدة أيضا كلمات أخرى تتسم بالجناس، لكنه جناس ناقص جدا يغني عنه المذكور سلفا، وهو في الجملة يدخل ضمن الجرس الداخلي للبيت الشعري ويزيده وقعا حسنا، ولاحظ في الجناس التام بين (موهنا وموهنا)، فعلى الرغم من كون اللفظ الثاني جاء متوافقا بالضرورة مع القافية، لكن يمكن الاستغناء عنه حين يكون الكلام مباشرا، أو حتى شعريا، فكم من الألفاظ التي اختصت بشجى الليل وقسوته وطوله، مما لا يمكن حصره، إلا أن الشاعر اختار هنا لفظ (موهنا) ليحقق الجناس التام مع اللفظ الأول (أرقب الصبح موهنا)، ولتزيح عنه القافية المختارة مسحة التكلف التي قد تبدو ظاهرة إذا لم تكن القافية بهذا الشكل. وعلى ذلك يمكن تفسير كل الكلمات (الجناسية) الواردة في القصيدة، كما في السنا والونى، لاحظ أن مفردة (الونى) لها الكثير من المترادفات في العربية، لكن اختيار الشاعر لها كان مناسبا جدا لدرك البغية، ويلاحظ أيضا في دال (الونى) أن حروفه خالية من حروف الاستعلاء، فهي حروف (مستفلة) تتناسب مع رقة القصيدة، وطقسها الأخاذ. وإذ لجأ الشاعر إلى فنون البديع فدبّج بها القصيدة، فإنه في البيان لا يقل مراسا، فوظّف فن الاستعارة في الأبيات الشعرية، وجاء منها بمعان حسنة، لاءمت إلى حد كبير المعنى العام للقصيدة، وموضوعها الذي يدور حول لواعج الحب وصبوته. ومعلوم أن فن الاستعارة يعد من أرقى الفنون العربية، وقد برع فيها العرب؛ لفطنتهم وذكائهم وحضور بديهيتهم، وهي فن لا يتصدى له سوى الفحول؛ لما يتولد منها من كثافة المعنى وعمق الفكرة وبعد النظر، وهي وسيلة لكشف الخفايا المستكنة في النفس، مما يصعب توضيحه وبيانه إلا بالمقاربة والتشبيه، لا سيما أن الاستعارة تتناول الجانب المحسوس (المادي) والمعنوي، فإذا كان الجانب المادي يُقارب بالتشبيه، فإن مقاربة الجانب المعنوي تتسم بالصعوبة، وتحتاج إلى الدقة والضبط، اللذين بدونهما يختلط الأمر ويزيد من الغموض الذي وقع فيها الكثير من الشعراء، كون الاستعارة التي وظفوها لم تقصد الغرض المنشود.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام أحد المتصفحات البديلة.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام أحد المتصفحات البديلة.
مصطفى مزاحم - الشاعر الكبير محمد مهدي الجواهري جماليات البلاغة في قصيدة مناجاة.. الحلقة الأولى
- الكاتب محمد مهدي الجواهري
- تاريخ الإنشاء
-
- اسم الكاتب
- محمد مهدي الجواهري