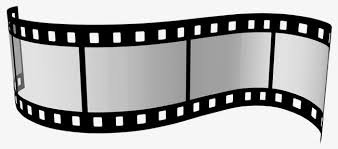ثمة خوف من الصورة لأن فيها دلالة، وتوثيقاً، وفيها أيضًا تضليل. وأن يقال هذا عصر الصورة فهي فعلاً كذلك لأنها أحياناً تقوم مقام الكلمات. ولهذا السبب يمكن القول إن المتلقي في عصرنا الجديد ينظر إلى النص ويقرأ الصورة. وهذا يلقي بالمسؤولية المعرفية والإبداعية على الصورة التي أصبحت موجّهاً لثقافة ليست بصرية فحسب، بل ومسلكية تدفع بالكثيرين إلى تبنّي واعتماد معرفيات قد لا تكون صحيحة. ومن هنا تكون الصورة هي الإشكالية المعرفية الأكثر حساسية في جميع مسارات الإبداع البشري.
دور توجيهي
ولو اعتمدنا سيميائية تشاندلر في الدال والمدلول، فإنه يمكن الغوص لأزمان طويلة ونحن نقرأ ثقافة الصورة وحضارة الإشارات التي تحملها، سواء على المستوى الإبداعي للفن التشكيلي أو على مستوى الإبداع الوظيفي في صناعة الإعلان التي تلعب دوراً توجيهياً يقارب تقنيات علم النفس الجمعي عند يونغ، وما تشير إليه كثير من الرموز أو السيميوزات في حياتنا لتجعل عقولنا تتلقى المعلومة أو الإشارة ونكررها ونرددها ونحتفل بها ونعاديها ونتبناها في لاوعينا. إنها الصورة التي جعلت المسيح في أفريقيا ببشرة داكنة وشعر أسود وفي أوروبا ببشرة بيضاء وشعر أشقر. إنها صورة الانطباعيين التي التقطت لحظة لا يمكن صدها دون معرفة ودون حس رفيع بالتفاصيل والمدلولات.
الصورة موجودة منذ الأزل، من خلال تأمل الإنسان للصور الحية أو الطبيعية كالشجر والنهر والجبل. وقد بدأها الإنسان كأداة لعملية الاكتشاف من خلال علاقته مع هذا الآخر، ويمكن لأي قارئ أن يتخيل حجم التأمل الذي عاشه الإنسان مع الطبيعة، ومواجهته بشكل حقيقي للشكل، الصورة، الجمال المحيط بكل أشكاله وثرائه البصري. وعن طريق التأمل بهذا المحيط، شكّل الإنسان معارفه الأولى التي تطورت عبر البنى الدينية وحتى المعارف المعاصرة، إذا المعرفة جاءت نتيجة العمل في الصورة.
في حياتنا نتأمل ونستكشف حالة الصورة بالعمل الذهني اليومي وحالة تشكل الصورة الإبداعية في المخيلة، حيث لا نستطيع التفكير من دون صور أو من دون تخيلها. ويشكل الإنسان صوره المفترضة فيحلم الفرد ربما بمنزل يرتب شكله وحجمه في المخيلة حتى أدق التفاصيل الصغيرة، وعندما يروى لك عن شخص تستطيع بناء صورته في ذهنك، وليس بالضرورة أن يكون المتخيل يشبه الواقع، وبالتأكيد ثمة مفارقة أحسستها عندما وطأت قدماي الحي اللاتيني بعد ساعات من وصولي، حيث في اللحظات الأولى تسقط تصوراتك السابقة لصالح الواقع الجديد، وكثيرا ما تبنى التصورات المفترضة على الحديث الشفوي والرواة، إن ما يسمى بالاستشراق طبيعياً أن يكون بصورة غير واقعية ومتخيلة لأن الذي يعيش الموضوع غير الذي يراه من الخارج أو يسمع عنه من جهة. ومن جهة أخرى هناك أشياء ساهمت في بناء الصورة المتخيلة مثل ألف ليلة وليلة، فصورة المرأة لدى الغربي آنذاك ليست متخيلة وحسب إنما تم إضفاء الرغبات الذاتية، وبالمقابل تأتي الصورة عن الغرب غير واقعية ومحملة بأحلامنا ورغباتنا.
وفي الواقع إن المعايشة مع الصورة تتعدى ذلك فهي غير مرتبطة بزمن معين، فعندما تقرأ نصا أو حكاية من الماضي تتخيل المكان والشخصيات وربما أدق التفاصيل، من هنا تأتي أهمية الرواية حيث تبني الصورة وتقوم بعملية إخراج لها، إن الكاتب عندما يكتب رواية أو قصة، سيناريو يبني الصورة كاملة في مخيلته وهذا ماد عيناه بالصورة المفترضة، وما فعلته السينما أو الدراما هو حرمانك من التخيل، حيث تأتي الصورة جاهزة، كل ذلك يحدث في حالة من الوعي وما يحدث أحيانا شكل من التداعي الآخر هو غير واعي تماما حيث تظهر الصور في الأحلام أو من العقل الباطن (اللا شعور) أو ما بين النوم واليقظة، وقد استفاد كما هو معروف الفن التشكيلي منها عبر السريالية، ونود الإشارة هنا إلى هذه الصور والأحداث التي تقفز فجأة إلى ساحة الوعي، ومبعث ذلك ربما حادثة قديمة أو شكل وربما رائحة تقودك إلى الطفولة أو إلى مكان عشته. إن تلك المعايشة مع الصورة تمارس نوعا من التأثير وتطور من التجربة.
الصورة المكان
ثمة انعكاس متبادل في علاقة الإنسان مع المحيط والمكان والأشياء، وبمعنى آخر أن المكان هو تجل لتفكير الإنسان وسويته الجمالية. إن المكان من سوية الإنسان الجمالية وبالتالي السلوكية، فأي منزل تدخله وبنظرة عامة تستطيع قراءة صاحبه وتستشف نمط تفكيره، وبدوره المحيط المؤثر لأن الشكل يترك أثره من خلال من علاقاته الخطية واللونية وعلاقة الحجم مع الفراغ، وبالتالي هناك أثر يتركه المستطيل أو طريق متعرج، وهناك فرق بين منزل من الإسمنت وآخر من الطين. إن أحياء دمشق القديمة بتعرجاتها والتقاء شرفاتها تعكس حالة انفعالية واجتماعية لساكنيها بل تعبر عن منظومة من التفكير. إن في علاقتنا مع الأشياء وبنائها نضفي ذواتنا عليها، وفي هذا الأثر الذي نتركه يتحقق التواصل مع الآخرين بحيث يمكن أن يراك الآخر من خلال ما تفعله وذلك ما يطور من الوعي البصري والجمالي، قصارى القول في ذلك إن الوعي الجمالي يعكس ارتقاء إنسانيا.
رغم عالمية الصورة، إلا أنها محلية بكل أصالة. فلوحة الإعدام للفنان الإسباني غويا تثير الكثير من المشاعر لدى الشعب الإسباني، لكنها لغيره هي لوحة جميلة وثقافة جديدة تؤمن بالحرية. وهو الحال نفسه بالنسبة للوحة تصور بيتاً دمشقياً قديماً قد تدفع سورياً للبكاء ولكنها تدفع إيطالياً للإعجاب باللوحة وتقنياتها. ومن هنا تبدو المحلية بوابة للعالمية في بناء الصورة ومدلولاتها. ولكن لا يمكن إهمال الجانب البشري الكلي في الثقافة الإنسانية التي تجعل الصورة محفّزاً لكثير من المواقف والعواطف كصورة طفل مشرد أو لاجئ. ولذلك يمكن اعتبار الفن التشكيلي المرجعية الحضارية لثقافة الشعوب.
الصورة والرقم
في جانب آخر من التفكير في الصورة في علاقتها مع الرقم ثمة انحياز للرقم الذي هو رمز يتم فيه استبدال الصورة أو المكان، الحجم إلى رقم يكون دلالة مختزلة له. وكثيراً ما كنا نلاحظ في أريافنا بقايا التبادل السلعي الذي نادراً ما نجده إلا في بعض القرى على فطرتها، حيث يمكن مثلاً استبدال سلعة بسلعة أخرى. يشكل البيض هنا صورة تم استبدالها برقم (العملة) وقد لاحظ الكاتب البلغاري ايفريم كارانفيلوف عندما زار سورية وفي أحد أسواقها راقب تاجراً (في السوق المسقوف في دمشق) يبيع قماشا حريريا في حانوته الصغير. ولكن بأي حب كان ينظر إليه، وبأي رقة كان يبسطه فكأنما القماش يحيا بين يديه. إنه يقيم صلة روحية بينه وبين زبونه). إذا ثمة علاقة ما بين الصورة والإنسان تحمل إمكانية التخيل وبالتالي تؤكد على الفرادة والتميز. تمنحك الصورة دلالات وأحاسيس مختلفة، فتشعر أحياناً كثيرة عندما ترى فلاحاً في الريف وكأنه قطعة من الطبيعة، لكنك تشعر بالإنسان في المدن الحديثة وكأنه رقم وأشكال مكررة ولا يغيب عنك أبداً مشهد آلاف الناس في محطة (سانت لازار) في باريس، حيث يكاد الناس يلطم بعضهم بعضاً. كل يعيش عالمه الخاص، وهذا ما يعكس تحولاً في الثقافة المعاصرة حيث أضحى الرقم الابن المدلل للمجتمع الحديث والذي لا غنى عنه أحيانا، بل يعمل على تنظيم الحياة الاجتماعية، لكنه أقل خيالاً ويذبح التميز والأحاسيس الخاصة بالفرد في علاقته مع الصورة في حياته اليومية. من هنا تنشأ الحاجة الماسة للإنسان المعاصر في البحث عن نوافذ للتفكير في الصورة والنزهة الجمالية من الحضارة الرقمية. وقد عبر الفن عن توق إلى الحياة الطبيعية وأبدى الفنان أحياناً استنكاره للحضارة الحديثة محاولاً العودة إلى البدء إلى الفطرة.
إن تلك المعايشة مع الصورة بتجلياتها المختلفة تتعدى ذلك مع المبدع وتصبح أكثر عمقاً. إن تراكم التجربة البصرية للفنان يعني إعادة صياغتها في شكل جديد. إنه الانتقال بالصور المتخيلة إلى حيز الواقع، وهو ليس انتقالا آليا إنما هناك تأمل وعمل، غير مقدرة نتيجة العمل عند إخراج العمل الفني وكثيراً ما يحتاج الفنان إلى (كروكيات) كثيرة للوصول إلى الصياغة الأفضل لعمله، وبالتأكيد ليس ذلك مصدر الإلهام الوحيد بالنسبة للفنان وبالتأكيد أيضا أن (معمل) المبدع لا تحد المؤثرات التي تساهم في بنائه. وأحياناً كثيرة يحدث أن تستيقظ فجأة إشراقة ما عند المبدع، إنها مثل / وجدتها / تلك هي اللحظة الإبداعية، لكنها ليست من فراغ، وقد تعود إلى زمن مضى لأن اللاشعور الجمعي حسب تعبير يونغ، قد يكون محملاً بآلاف الصور منذ الإنسان البدائي وحتى الآن، إن معايشة الفنان مع الصورة وبشكل خاص التشكيلي هامة، لأنه ثمة وجود فيزيائي ووجود حدسي أو ماورائي للشكل.
* فنان تشكيلي من سورية
* عن ضفة ثالثة
دور توجيهي
ولو اعتمدنا سيميائية تشاندلر في الدال والمدلول، فإنه يمكن الغوص لأزمان طويلة ونحن نقرأ ثقافة الصورة وحضارة الإشارات التي تحملها، سواء على المستوى الإبداعي للفن التشكيلي أو على مستوى الإبداع الوظيفي في صناعة الإعلان التي تلعب دوراً توجيهياً يقارب تقنيات علم النفس الجمعي عند يونغ، وما تشير إليه كثير من الرموز أو السيميوزات في حياتنا لتجعل عقولنا تتلقى المعلومة أو الإشارة ونكررها ونرددها ونحتفل بها ونعاديها ونتبناها في لاوعينا. إنها الصورة التي جعلت المسيح في أفريقيا ببشرة داكنة وشعر أسود وفي أوروبا ببشرة بيضاء وشعر أشقر. إنها صورة الانطباعيين التي التقطت لحظة لا يمكن صدها دون معرفة ودون حس رفيع بالتفاصيل والمدلولات.
الصورة موجودة منذ الأزل، من خلال تأمل الإنسان للصور الحية أو الطبيعية كالشجر والنهر والجبل. وقد بدأها الإنسان كأداة لعملية الاكتشاف من خلال علاقته مع هذا الآخر، ويمكن لأي قارئ أن يتخيل حجم التأمل الذي عاشه الإنسان مع الطبيعة، ومواجهته بشكل حقيقي للشكل، الصورة، الجمال المحيط بكل أشكاله وثرائه البصري. وعن طريق التأمل بهذا المحيط، شكّل الإنسان معارفه الأولى التي تطورت عبر البنى الدينية وحتى المعارف المعاصرة، إذا المعرفة جاءت نتيجة العمل في الصورة.
في حياتنا نتأمل ونستكشف حالة الصورة بالعمل الذهني اليومي وحالة تشكل الصورة الإبداعية في المخيلة، حيث لا نستطيع التفكير من دون صور أو من دون تخيلها. ويشكل الإنسان صوره المفترضة فيحلم الفرد ربما بمنزل يرتب شكله وحجمه في المخيلة حتى أدق التفاصيل الصغيرة، وعندما يروى لك عن شخص تستطيع بناء صورته في ذهنك، وليس بالضرورة أن يكون المتخيل يشبه الواقع، وبالتأكيد ثمة مفارقة أحسستها عندما وطأت قدماي الحي اللاتيني بعد ساعات من وصولي، حيث في اللحظات الأولى تسقط تصوراتك السابقة لصالح الواقع الجديد، وكثيرا ما تبنى التصورات المفترضة على الحديث الشفوي والرواة، إن ما يسمى بالاستشراق طبيعياً أن يكون بصورة غير واقعية ومتخيلة لأن الذي يعيش الموضوع غير الذي يراه من الخارج أو يسمع عنه من جهة. ومن جهة أخرى هناك أشياء ساهمت في بناء الصورة المتخيلة مثل ألف ليلة وليلة، فصورة المرأة لدى الغربي آنذاك ليست متخيلة وحسب إنما تم إضفاء الرغبات الذاتية، وبالمقابل تأتي الصورة عن الغرب غير واقعية ومحملة بأحلامنا ورغباتنا.
وفي الواقع إن المعايشة مع الصورة تتعدى ذلك فهي غير مرتبطة بزمن معين، فعندما تقرأ نصا أو حكاية من الماضي تتخيل المكان والشخصيات وربما أدق التفاصيل، من هنا تأتي أهمية الرواية حيث تبني الصورة وتقوم بعملية إخراج لها، إن الكاتب عندما يكتب رواية أو قصة، سيناريو يبني الصورة كاملة في مخيلته وهذا ماد عيناه بالصورة المفترضة، وما فعلته السينما أو الدراما هو حرمانك من التخيل، حيث تأتي الصورة جاهزة، كل ذلك يحدث في حالة من الوعي وما يحدث أحيانا شكل من التداعي الآخر هو غير واعي تماما حيث تظهر الصور في الأحلام أو من العقل الباطن (اللا شعور) أو ما بين النوم واليقظة، وقد استفاد كما هو معروف الفن التشكيلي منها عبر السريالية، ونود الإشارة هنا إلى هذه الصور والأحداث التي تقفز فجأة إلى ساحة الوعي، ومبعث ذلك ربما حادثة قديمة أو شكل وربما رائحة تقودك إلى الطفولة أو إلى مكان عشته. إن تلك المعايشة مع الصورة تمارس نوعا من التأثير وتطور من التجربة.
الصورة المكان
ثمة انعكاس متبادل في علاقة الإنسان مع المحيط والمكان والأشياء، وبمعنى آخر أن المكان هو تجل لتفكير الإنسان وسويته الجمالية. إن المكان من سوية الإنسان الجمالية وبالتالي السلوكية، فأي منزل تدخله وبنظرة عامة تستطيع قراءة صاحبه وتستشف نمط تفكيره، وبدوره المحيط المؤثر لأن الشكل يترك أثره من خلال من علاقاته الخطية واللونية وعلاقة الحجم مع الفراغ، وبالتالي هناك أثر يتركه المستطيل أو طريق متعرج، وهناك فرق بين منزل من الإسمنت وآخر من الطين. إن أحياء دمشق القديمة بتعرجاتها والتقاء شرفاتها تعكس حالة انفعالية واجتماعية لساكنيها بل تعبر عن منظومة من التفكير. إن في علاقتنا مع الأشياء وبنائها نضفي ذواتنا عليها، وفي هذا الأثر الذي نتركه يتحقق التواصل مع الآخرين بحيث يمكن أن يراك الآخر من خلال ما تفعله وذلك ما يطور من الوعي البصري والجمالي، قصارى القول في ذلك إن الوعي الجمالي يعكس ارتقاء إنسانيا.
رغم عالمية الصورة، إلا أنها محلية بكل أصالة. فلوحة الإعدام للفنان الإسباني غويا تثير الكثير من المشاعر لدى الشعب الإسباني، لكنها لغيره هي لوحة جميلة وثقافة جديدة تؤمن بالحرية. وهو الحال نفسه بالنسبة للوحة تصور بيتاً دمشقياً قديماً قد تدفع سورياً للبكاء ولكنها تدفع إيطالياً للإعجاب باللوحة وتقنياتها. ومن هنا تبدو المحلية بوابة للعالمية في بناء الصورة ومدلولاتها. ولكن لا يمكن إهمال الجانب البشري الكلي في الثقافة الإنسانية التي تجعل الصورة محفّزاً لكثير من المواقف والعواطف كصورة طفل مشرد أو لاجئ. ولذلك يمكن اعتبار الفن التشكيلي المرجعية الحضارية لثقافة الشعوب.
الصورة والرقم
في جانب آخر من التفكير في الصورة في علاقتها مع الرقم ثمة انحياز للرقم الذي هو رمز يتم فيه استبدال الصورة أو المكان، الحجم إلى رقم يكون دلالة مختزلة له. وكثيراً ما كنا نلاحظ في أريافنا بقايا التبادل السلعي الذي نادراً ما نجده إلا في بعض القرى على فطرتها، حيث يمكن مثلاً استبدال سلعة بسلعة أخرى. يشكل البيض هنا صورة تم استبدالها برقم (العملة) وقد لاحظ الكاتب البلغاري ايفريم كارانفيلوف عندما زار سورية وفي أحد أسواقها راقب تاجراً (في السوق المسقوف في دمشق) يبيع قماشا حريريا في حانوته الصغير. ولكن بأي حب كان ينظر إليه، وبأي رقة كان يبسطه فكأنما القماش يحيا بين يديه. إنه يقيم صلة روحية بينه وبين زبونه). إذا ثمة علاقة ما بين الصورة والإنسان تحمل إمكانية التخيل وبالتالي تؤكد على الفرادة والتميز. تمنحك الصورة دلالات وأحاسيس مختلفة، فتشعر أحياناً كثيرة عندما ترى فلاحاً في الريف وكأنه قطعة من الطبيعة، لكنك تشعر بالإنسان في المدن الحديثة وكأنه رقم وأشكال مكررة ولا يغيب عنك أبداً مشهد آلاف الناس في محطة (سانت لازار) في باريس، حيث يكاد الناس يلطم بعضهم بعضاً. كل يعيش عالمه الخاص، وهذا ما يعكس تحولاً في الثقافة المعاصرة حيث أضحى الرقم الابن المدلل للمجتمع الحديث والذي لا غنى عنه أحيانا، بل يعمل على تنظيم الحياة الاجتماعية، لكنه أقل خيالاً ويذبح التميز والأحاسيس الخاصة بالفرد في علاقته مع الصورة في حياته اليومية. من هنا تنشأ الحاجة الماسة للإنسان المعاصر في البحث عن نوافذ للتفكير في الصورة والنزهة الجمالية من الحضارة الرقمية. وقد عبر الفن عن توق إلى الحياة الطبيعية وأبدى الفنان أحياناً استنكاره للحضارة الحديثة محاولاً العودة إلى البدء إلى الفطرة.
إن تلك المعايشة مع الصورة بتجلياتها المختلفة تتعدى ذلك مع المبدع وتصبح أكثر عمقاً. إن تراكم التجربة البصرية للفنان يعني إعادة صياغتها في شكل جديد. إنه الانتقال بالصور المتخيلة إلى حيز الواقع، وهو ليس انتقالا آليا إنما هناك تأمل وعمل، غير مقدرة نتيجة العمل عند إخراج العمل الفني وكثيراً ما يحتاج الفنان إلى (كروكيات) كثيرة للوصول إلى الصياغة الأفضل لعمله، وبالتأكيد ليس ذلك مصدر الإلهام الوحيد بالنسبة للفنان وبالتأكيد أيضا أن (معمل) المبدع لا تحد المؤثرات التي تساهم في بنائه. وأحياناً كثيرة يحدث أن تستيقظ فجأة إشراقة ما عند المبدع، إنها مثل / وجدتها / تلك هي اللحظة الإبداعية، لكنها ليست من فراغ، وقد تعود إلى زمن مضى لأن اللاشعور الجمعي حسب تعبير يونغ، قد يكون محملاً بآلاف الصور منذ الإنسان البدائي وحتى الآن، إن معايشة الفنان مع الصورة وبشكل خاص التشكيلي هامة، لأنه ثمة وجود فيزيائي ووجود حدسي أو ماورائي للشكل.
* فنان تشكيلي من سورية
* عن ضفة ثالثة