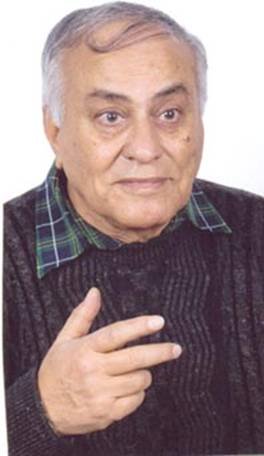- 1 -
يوم أحد خريفي بدا لي عاديا حيث يخفّ الزحام و يقلّ عدد الركاب الذين تأتي بهم سيارات النقل العام الصفراء التي أطلق عليها النّاس " زينة و عزيزة " تيمنا بالراقصتين الشعبيتين الأختين زينة و عزيزة اللتين كان لهما صيتهما و شهرتهما في الحفلات و الأعراس على إمتداد مدن تونس و قراها في ستينات القرن الماضي .
حملتني خطواتي الوئيدة من منزلي إلى محطّة " سليمان كاهيه " للمترو بعد أن توقفت عند دكان عيّاد حيث اقتنيت جريدتي اليوميّة و عبأت هاتفي الجوّال بمبلغ مالي قد أفقده في مكالمة واحدة مع عمان أو بغداد ، حفظت اسم هذه المحطّة رغم أنّني لا أعرف من هو سليمان كاهية و كان على إدارة المترو أن تضع لوحة تعرف فيها بهذا الإسم الذي أطلق على محطة رئيسية من محطاتها ، و لكنّني خمنت أنّه قد يعود لمقاوم من الرعيل الأول الذين ناضلوا لتحرير تونس من الاستعمار الفرنسي ، الإستقلال الذي امتطاه " بورقيبة " رئيسا مدى الحياة بعد أن أزاح عن طريقه كل رموز الاستقلال بكلّ الوسائل المتاحة بما في ذلك الاغتيال كما فعل مع الزعيم الكارزمي صالح بن يوسف .
و رنت في أذني كلمات شيخ تونسي حكيم صادف أن جالسته في مقهى الحاج بباردو .
- كلّ الحكام يتحولون إلى قتلة إذا أحسّوا بأن كراسيهم مهدّدة و لم يكن بورقيبة استثناء رغم أن وجهه تزينه ابتسامة صريحة ، لكنّها ماكرة في الآن نفسه لو تأملناها جيّدا ، كأنّه كان يضحك بها علينا ، يستبلهنا ، و لو أنّه أظهر يديه من القفازين الأبيضين لرأيت أثار الدماء. و عندما تأكد من أنّني منتبه له كليّا تشجع على مواصلة حديثه الحيادي لكونه في العمر الذي تغادر البشر أحلامهم و طموحاتهم ، قال :
- أناخ بورقيبة على صدورنا سنوات طوالا ، و لم يعد يعد في مقدوره حتى قضاء حاجته و مع هذا لم يغادر الكرسي الذي تخشبت عظامه عليه فهو رئيس مدى الحياة و لن تمنعه الشيخوخة و العجز و ضعف كل القدرات البشرية من التشبث بالسلطة دون أن يغادرها بكرامة و يذهب إلى بيت ريفي هادئ يمضي فيه ما تبقى من عمره بسلام فأخرج قسرا بما سموه انقلابا طبيّا ! أ لم تره في أيامه الأخيرة و هم يخرجونه في نشرة أخبار التليفزيون كل مساء و هو يغطس في حوض السباحة للتدليل على شبابه الدائم المتجدّد رغم أنّه لم يكن يقوى على المشي و رؤية طريقه إلا و هو محاط بمجموعة من المساعدين الذين يشدونه من يديه ، و لا أحد يدري متى ينفجر غضبه فيقيل وزراء و ولاة أو حتى حكومة كاملة ليأتي بأخرى و هذا فعله ليأتينا بشرطي وزيرا أوّل سرعان ما انقلب عليه .
أخرج سيكارة وأشعلها و صار يدخنها دون أن يستنشق الدخان كما يفعل مدمنو التدخين ، أطلق حسرة مرّة بينما كانت عيناه تتلألئان ببقايا شباب من المؤكد أنه عشق التمّرد و العناد و واصل القول :
- لم نكن نجد له من شبيه في أحاديثنا إلا فرانكو في اسبانيا حيث وصل الظنّ بالنّاس أنّه سيعيش قرونا و أن له عدّة أعمار لا عمرا واحدا ، و ذكر أنّه عندما مات لم يكن أحد يجرؤ على اعلان نبأ موته علما أنه قد رتب أمور الحكم بعد موته باعادة الملكية لأسبانيا و التي جاءت بالديمقراطية التي كم قاتل الشعب الاسباني من أجل أن يحصل عليها .
و كأنّه ملّ سيكارته فرماها على الأرض و سحقها بحذائه و هو يرّدد :
- الديمقراطية هي السحر الذي يخلب اللب ، و لعلنا هنا في تونس بعد أن انتهت ديكتاتورية اللصوص الكريهة هي مواصلة لما كان في عهد بورقيبة سنفلح في جعل بلدنا ديمقراطيا ، لماذا لا ؟
- 2 -
عندما جاء المترو أخذت مكاني في مقعد على اليسار حتى أبقى في الظلّ ، كانت المقاعد فارغة إلا من بضعة ركاب تناثروا متباعدين .
جلست مسترخيا ، و لم أفكر حتى بفتح جريدتي لأتصفحها .
في أيام الأسبوع الأخرى قد لا يجد المرء مكانا حتى للوقوف فسيارات النقل الصفراء " زينة و عزيزة " ترمي بالبشر ، و عندما يهبطون فجلّهم يهبط جريا تحو محطّة " سليمان كاهية " ، نساء بأكياس سوداء و صرر و حقائب يد من بضاعة " سوق بومنديل " .
و هناك رجال يسعلون ، و عجائز يتمخطّن بمناديل من القماش يضعنها في أكياسهنّ البلاستيكيّة .
و قد اكتشفت أن لبعض من يركبون وسائل النقل العامّة موهبة العثور على أماكن للجلوس ، فما أن يقف المترو حتىّ ينزلقوا داخله و كأن لهم براعة عجيبة في هذا لا يمتلكها حتّى لاعبو السيرك ، و من يمسك بمقعد لن يتركه لآخر فهو له حتى المحطة التي يقصدها .
كان التنقّل من المنزل إلى المدينة ثم العودة مدمّرا للأعصاب و مبدّدا للطاقة ، فالمدينة صغيرة و شوارعها ضيّقة و مع هذا تتحرّك فيها مئات السيارات و بالنسبة لي بعد التعب الذي صرت أعانيه من بصري لم يعد في مقدوري قيادة سيارتي الخاصّة فتركتها للصدأ و الغبار و استعنت بالمترو وسيلة للتحرّك حيث يضيع الوقت و يتبّدد .
التفتّ إلى يساري فاكتشفت ورقة ألصقت حديثا على الزجاج وقرأتها ( أقم صلاتك قبل مماتك ) و لم يكن صعبا عليّ ارجاع هذه الورقة إلى مصدرها إذ أنّها من أدبيّات بعض المجموعات السلفية بالتأكيد .
و عندما توقف المترو في محطة الدندان طالعتني كتابة بالطلاء الأسود على جدار المحطة تقول : ( الشعب يريد شرعيّة اسلامية ) و كأن الجواب قد جاء في المحطة اللاحقة " الصناعات التقليدية " ليناقض الشعار السابق حيث كتب على جدار المحطة : ( الشعب يريد دستورا مدنيا ) .
قبل الثورة لم تكن تونس هكذا ، كانت بلدا خائفا ، لا ينطق المرء بما يفكر فيه إلا بعد أن يدير رأسه إلى كلّ الجهات ليتأكد من غياب الآذان المنصتة ، أما اليوم فقد نزعت خوفها ، لكنّ العض حوله إلى فوضى عارمة ، إلى قاموس ناب تتقاذفه الشفاه و أطلق عليه الأعلام المسموع و المكتوب عبارة " العنف اللفظي" .
شعارات تتصارع ، لا تعكس الإختلاف الحي بل العناد ، كأن كلّ شعار يريد من يرفعه أن يؤكد وجوده حزبا أو مجموعة بأي حجم كان ، أحزاب ( الصفر فاصل ) كما تسمّى ، وهي الأحزاب التي فشلت في ايصال نائب واحد للمجلس التأسيسي رغم علو أصوات منخرطيها.
المدينة فضاء مفتوح لكلّ الشعارات و الرغبات التي كانت مخبأة في الصدور ، وشاة صغار و كتبة تقارير و كاسرو رقاب و جدوا منافذ لهم ، بعضهم امتلك صحفا أو موقعا في جهاز اعلامي و زايد على الجميع .
شعارات معلنة و صريحة تفصح و تقول بمنتهى الصراحة ، تكتب على الجدران و في الصحف ، تسمع أصواتها في الاذاعات و تظهر وجوهها في التلفزات .
كلّ الأصوات عالية ، لا مجال للهمس ، و هذا شيء مبهج جدّا ، و لكن السؤال الذي يردده بعض المراقبين إلى أين كل هذا ؟ و ماذا بعد ؟
لملمت نظراتي التي وزعتها لقراءة الشعارات الكثيرة في محطات المترو ، و بعضها باللغة الفرنسيّة و أخرى شطبت بالطلاء الأسود نفسه الذي كتبت به .
أسئلة كثيرة أسمعها ، أسئلة تفوق عدد الأجوبة الممكنة ، أسئلة لا تخصني بل تخصّ النّاس في احتدامهم و اعتصاماتهم و اضراباتهم و قطعهم للطرق و حرقهم لبعض مراكز الشرطة و المحاكم ، براكين عمياء تنفجر دون مسوّغ .
أحزاب ورقية تريد أن تجد لها موقعا على الخارطة السياسية و لكن عبثا فليكن الهجوم بالشعارات على كلّ شيء .
كنت على استرخائي ، ركاب ينزلون ، و آخرون يصعدون ، و كأن المترو على انسجام مع هذا الإيقاع فيتباطأ هو الآخر ، و لو أن سائقه قد أغضبه راكب ما يظلّ معلقا بالباب لما مضى بهذا الهدوء .
و عندما وصلت شارع باريس غادرت مقعدي و نزلت ، لي ذكريات مضحكة مع هذه المحطة إذ سرقت حافظة فيها نقودي مرتين ، أقول مضحكة لأنّني لا أعرف كيف استطاع السارق اللطيف أن يستغفلني و برمشة عين ليستولي على حافظة القطع النقدية التي يسميها التونسيون " ستوش " رغم أن ما يحويه من نقود مجرّد " فكّة " .
- 3 -
وصلت في الموعد للقاء صديقي اسماعيل الذي كان في انتظاري بمقهى "روتوند " الذي يلذ لنا أحيانا أن " نتبيّر " فيه ، أو " نتقهوأ " و نقلب صحف المدينة التي تعكس صخب الشارع و نستمع إلى ما لذّ و طاب من قاموس العنف اللفظي الذي تنجبه قريحة " المتبيّرين " الصباحيين .
لا نعرف كيف انزلقت أحاديثنا في الأسابيع الأخيرة إلى الدعابات الناعمة بدلا من الجديّة ، حتى كأن السخرية صارت لنا قاموسا ، به نتعامل ، ركام من الفذلكات الطرية و استمرأنا اللعبة حدّ الإتقان .
كانت أصوات الهتافات تصلنا من التظاهرات التي تعبئ شارع بورقيبة الفسيح ، هذا الشارع الذي لا تكتمل التظاهرات إلا باقتحامه فهو ملعبها المفضل .
تظاهرة الأحد هذه انطلقت من ساحة محمد علي الحامي متوجهة نحو مدخل الشارع حيث تمثال ابن خلدون وصولا إلى بمنى وزارة الداخلية .
وكانت مقاهي الرصيف التي تتوّزع على جانبي الشارع مفتوحة كلّها و تعجّ بالرواد ، كما أن بعض المحلات التجارية كانت مفتوحة هي الأخرى ، و كان عدد من الفضوليين في الشارع يختلط بالمتظاهرين ، فكلّ هذا الذي يحصل جديد على البلد الذي كان الرئيس الهارب و الرئيس الذي سبقه يحكمان قبضتيهما الأمنيّة و لا يسمحان بأي احتجاج ، و لا حتى باجتماع حزبي مهما كان عدد الحاضرين فيه .
اخترنا أن نخرج للشارع بدلا من البقاء في المقهى " و بدأنا بالتحرّك إلى جهة المسرح البلدي و عندما وصلنا تعرفنا على بعض الوجوه المسرحية و التلفزية المعروفة فهذا يوم المسرح العالمي كما ذكرت الصحف . و ما دام هذا اليوم يوما استثنائيا للمسرحيين فقد تجمّعوا أمام المسرح البلدي أهمّ مسرح في البلد ، وكان هتاف الحناجر يرّدد ( الشعب يريد مسرحا) . و هو شعار كما يبدو غير مستفزّ لأحد إلا للذين يرون المسرح حراما و لا يتوانى البعض من تكفير العاملين فيه .
وصلنا و وقفنا وسط الشارع لنتطلع إليهم و هم يتكدسون في تلك المساحة الضيقّة أمام المسرح و فوق سلالمه التي يلذّ للشبّان الجلوس عليها في سائر الأيام ليدخّنوا و يثرثروا و يراقبوا حركة الشارع .
لكن اسماعيل همس لي :
- ألا ترى أن أصواتهم لا تسمع أمام هدير المظاهرة الكبيرة التي بدأت بالوصول من جهة تمثال ابن خلدون؟
و تأكد لي هذا إذ انطمست حناجر المسرحيين في مدّ الهتاف الهائل من الموج القادم حيث الرايات المختلفة الألوان التي يطغى عليها اللون الأسود و عبارة " الله أكبر " و لم تكن الهتافات بالحناجر العارية فقط بل و في مكبرات الصوت أيضا : الله أكبر .
و بانت لنا وجوه عشرات الشبّان الملتحين بجلابيبهم القصيرة و أغطية الرأس الخاصة بهم لتميزهم .
قال اسماعيل بتساؤل :
- هل هؤلاء من يسمون بالسلفيين ؟
و ردّدت عليه بجواب حائر :
- يبدو هكذا رغم أن المصطلح غير دقيق كما أتصوّر !
و علّق اسماعيل على الفور :
- هناك السلفيون و هناك أيضا السلفيون الجهاديون ، تشابك لا يحلّ بين المصطلحات !
- لكن هؤلاء بلحاهم و جببهم القصيرة و أحذيتهم الرياضية و الطاقيات التي وضعوها على رؤوسهم يبدون و كأنّهم يبحثون عن زمنهم الخاصّ !
- ربما، خارج زمني و زمنك ؟
- و هذا لا يهمّهم لأنّهم مطمئنون على ماهم فيه ، لهم هذا الحضور الكثيف رغم أنهم لم يجازوا كحزب لأنّهم ببساطة ضد الأحزاب و يعتبرونها حراما .
و لم نبق واقفين ، فأصوات الممثلين التي تهتف رغم ما عرف عنها من فصاحة و جهورية قد غطت عليها هتافات الرجال الملتحين الذين يصرخون بمكبرات الصوت .
و حثني اسماعيل على التحرّك ، و هكذا مضت خطواتنا بين الجموع المتظاهرة أو المتفرجة .
لقد أصبح التفرّج على المظاهرات جزءا من برنامجنا اليومي رغم أننا غير معنيين بها لأننا لسنا طرفا ، و لكن شاءت الظروف أن نكون نحن المنتمين إلى عدد من الأقطار العربية شهودا على أكبر تغيير عرفته تونس و يتمثل بهذه الثورة التي اقتلعت ديكتاتورية متوارثة تقاسم فيها تاريخ تونس الحديث منذ استقلالها رجلان فقط . الأوّل أراح و استراح عندما أعلن نفسه رئيسا مدى الحياة ، و الثاني صار يحرف القانون ليمدد لنفسه ثلاثا و عشرين سنة و خرجت مجموعة المنتفعين منه بما سمته " المناشدة " ليبقى في الحكم مدى العمر ، يناشدونه بأن يرشح في الإنتخابات التي ستكون بعد أربع سنوات و هو ما زال في مطلع فترة انتخابية لم يستوف عامها الأول بعد .
اكتظت الهتافات ، تداخلت ، اختلفت ، و لم نستطع أن نميّز ما تبوح به ، سألت اسماعيل :
- هل فهمت شيئا ؟
رّد :
- أبدا
و صفن قليلا و أضاف بدعابة :
- هل من الضروري أن أفهم ؟
و انطلقت الضحكات من حنجرتينا .
و ازداد اللغط العريض الذي يلهث في شارع " بورقيبة " الفسيح بأشجاره المعمرة التي غادرتها طيورها منذ أن ألقيت أول قنبلة غاز لتفريق الثائرين يوم 14 جانفي المشهود .
ثم تناهى إلينا صراخ وخمّنا أنه من جهة المسرح البلدي فعدنا أدراجنا بإتجاهه ، و كلما اقتربنا صرنا نميز الأصوات و كأنها أصوات أستغاثة من بعض سيدات المسرح بعد أن هوجم تجمّعهم من قبل بعض الفتية السلفيين ،ولا ندري كيف بدأ العراك إذ من الصعوبة في حالات كهذه معرفة كيف تجري الإشتباكات فالديكتاتورية و إن ذهبت كنظام إلا أنها كانت تربية أيضا ، ذهبت الديكاتورية و أبقت على ثمار ما غرست طليقا في الشارع لا رأي إلا رأيه ، و لذا يردد عقلاء السياسيين بأن كل هذا مران على الديمقراطية التي لم نعرفها حيث كان هناك دائما الزعيم الأوحد و الحزب الأوحد .
سحبني اسماعيل من يدي و أدخلني إلى مقهى يطلّ على الشارع من الجهة الأخرى ، كان يستحثني لأن " نتقهوأ " على وقع قضم حبات اللوز المملح .
- 4 -
في نشرة الأخبار المسائية التي تبثّها قناة التلفزة الوطنية أعلنت وزارة الداخلية منع كل التظاهرات في شارع الحبيب بورقيبة .
و في النشرة نفسها أصدرت وزارة الثقافة بيانا نددت فيه بالإعتداء على المسرحيين التونسيين الذين كانوا يحتلفون أمام المسرح البلدي بيوم المسرح العالمي ، و رأينا في النشرة وجوها مسرحيّة أبرزها وجه جليلة بكار احدى سيدات المسرح التونسي المتوجة قبل أسبوع واحد بجائزة محمود درويش للإبداع ، وكانت تروي ما حصل أمام المسرح .
- 5 -
كنت أتحرّك داخل المنزل متذكرا شعارات اليوم سواء ما رفع منها في تظاهرة شارع بورقيبة أو ما كتب على جدران محطات المترو ، كانت هذه الشعارات تتحول إلى ضجيج في رأسي ، و تتبارى كزحام من الأسئلة المؤرقة المحرقة التي لا أستطيع اقتراح مشاريع أجوبة لها .
أغلقت نافذة غرفة نومي لأنعم بقليل من الهدوء أقارع به ضجيج النهار الطويل .
أخرجت هاتفي الجوال و كتبت رسالة قصيرة : ( أقم صلاتك قبل مماتك ) و بحثت عن رقم هاتف اسماعيل الجوّال و كبست عليه فذهبت الرسالة .
بعد لحظات كان ردّه : ( الشعب يريد مسرحا و نحن ماذا نريد ؟ )
أجبته :
- اللا شيء .
* عن جريدة تاتوو
يوم أحد خريفي بدا لي عاديا حيث يخفّ الزحام و يقلّ عدد الركاب الذين تأتي بهم سيارات النقل العام الصفراء التي أطلق عليها النّاس " زينة و عزيزة " تيمنا بالراقصتين الشعبيتين الأختين زينة و عزيزة اللتين كان لهما صيتهما و شهرتهما في الحفلات و الأعراس على إمتداد مدن تونس و قراها في ستينات القرن الماضي .
حملتني خطواتي الوئيدة من منزلي إلى محطّة " سليمان كاهيه " للمترو بعد أن توقفت عند دكان عيّاد حيث اقتنيت جريدتي اليوميّة و عبأت هاتفي الجوّال بمبلغ مالي قد أفقده في مكالمة واحدة مع عمان أو بغداد ، حفظت اسم هذه المحطّة رغم أنّني لا أعرف من هو سليمان كاهية و كان على إدارة المترو أن تضع لوحة تعرف فيها بهذا الإسم الذي أطلق على محطة رئيسية من محطاتها ، و لكنّني خمنت أنّه قد يعود لمقاوم من الرعيل الأول الذين ناضلوا لتحرير تونس من الاستعمار الفرنسي ، الإستقلال الذي امتطاه " بورقيبة " رئيسا مدى الحياة بعد أن أزاح عن طريقه كل رموز الاستقلال بكلّ الوسائل المتاحة بما في ذلك الاغتيال كما فعل مع الزعيم الكارزمي صالح بن يوسف .
و رنت في أذني كلمات شيخ تونسي حكيم صادف أن جالسته في مقهى الحاج بباردو .
- كلّ الحكام يتحولون إلى قتلة إذا أحسّوا بأن كراسيهم مهدّدة و لم يكن بورقيبة استثناء رغم أن وجهه تزينه ابتسامة صريحة ، لكنّها ماكرة في الآن نفسه لو تأملناها جيّدا ، كأنّه كان يضحك بها علينا ، يستبلهنا ، و لو أنّه أظهر يديه من القفازين الأبيضين لرأيت أثار الدماء. و عندما تأكد من أنّني منتبه له كليّا تشجع على مواصلة حديثه الحيادي لكونه في العمر الذي تغادر البشر أحلامهم و طموحاتهم ، قال :
- أناخ بورقيبة على صدورنا سنوات طوالا ، و لم يعد يعد في مقدوره حتى قضاء حاجته و مع هذا لم يغادر الكرسي الذي تخشبت عظامه عليه فهو رئيس مدى الحياة و لن تمنعه الشيخوخة و العجز و ضعف كل القدرات البشرية من التشبث بالسلطة دون أن يغادرها بكرامة و يذهب إلى بيت ريفي هادئ يمضي فيه ما تبقى من عمره بسلام فأخرج قسرا بما سموه انقلابا طبيّا ! أ لم تره في أيامه الأخيرة و هم يخرجونه في نشرة أخبار التليفزيون كل مساء و هو يغطس في حوض السباحة للتدليل على شبابه الدائم المتجدّد رغم أنّه لم يكن يقوى على المشي و رؤية طريقه إلا و هو محاط بمجموعة من المساعدين الذين يشدونه من يديه ، و لا أحد يدري متى ينفجر غضبه فيقيل وزراء و ولاة أو حتى حكومة كاملة ليأتي بأخرى و هذا فعله ليأتينا بشرطي وزيرا أوّل سرعان ما انقلب عليه .
أخرج سيكارة وأشعلها و صار يدخنها دون أن يستنشق الدخان كما يفعل مدمنو التدخين ، أطلق حسرة مرّة بينما كانت عيناه تتلألئان ببقايا شباب من المؤكد أنه عشق التمّرد و العناد و واصل القول :
- لم نكن نجد له من شبيه في أحاديثنا إلا فرانكو في اسبانيا حيث وصل الظنّ بالنّاس أنّه سيعيش قرونا و أن له عدّة أعمار لا عمرا واحدا ، و ذكر أنّه عندما مات لم يكن أحد يجرؤ على اعلان نبأ موته علما أنه قد رتب أمور الحكم بعد موته باعادة الملكية لأسبانيا و التي جاءت بالديمقراطية التي كم قاتل الشعب الاسباني من أجل أن يحصل عليها .
و كأنّه ملّ سيكارته فرماها على الأرض و سحقها بحذائه و هو يرّدد :
- الديمقراطية هي السحر الذي يخلب اللب ، و لعلنا هنا في تونس بعد أن انتهت ديكتاتورية اللصوص الكريهة هي مواصلة لما كان في عهد بورقيبة سنفلح في جعل بلدنا ديمقراطيا ، لماذا لا ؟
- 2 -
عندما جاء المترو أخذت مكاني في مقعد على اليسار حتى أبقى في الظلّ ، كانت المقاعد فارغة إلا من بضعة ركاب تناثروا متباعدين .
جلست مسترخيا ، و لم أفكر حتى بفتح جريدتي لأتصفحها .
في أيام الأسبوع الأخرى قد لا يجد المرء مكانا حتى للوقوف فسيارات النقل الصفراء " زينة و عزيزة " ترمي بالبشر ، و عندما يهبطون فجلّهم يهبط جريا تحو محطّة " سليمان كاهية " ، نساء بأكياس سوداء و صرر و حقائب يد من بضاعة " سوق بومنديل " .
و هناك رجال يسعلون ، و عجائز يتمخطّن بمناديل من القماش يضعنها في أكياسهنّ البلاستيكيّة .
و قد اكتشفت أن لبعض من يركبون وسائل النقل العامّة موهبة العثور على أماكن للجلوس ، فما أن يقف المترو حتىّ ينزلقوا داخله و كأن لهم براعة عجيبة في هذا لا يمتلكها حتّى لاعبو السيرك ، و من يمسك بمقعد لن يتركه لآخر فهو له حتى المحطة التي يقصدها .
كان التنقّل من المنزل إلى المدينة ثم العودة مدمّرا للأعصاب و مبدّدا للطاقة ، فالمدينة صغيرة و شوارعها ضيّقة و مع هذا تتحرّك فيها مئات السيارات و بالنسبة لي بعد التعب الذي صرت أعانيه من بصري لم يعد في مقدوري قيادة سيارتي الخاصّة فتركتها للصدأ و الغبار و استعنت بالمترو وسيلة للتحرّك حيث يضيع الوقت و يتبّدد .
التفتّ إلى يساري فاكتشفت ورقة ألصقت حديثا على الزجاج وقرأتها ( أقم صلاتك قبل مماتك ) و لم يكن صعبا عليّ ارجاع هذه الورقة إلى مصدرها إذ أنّها من أدبيّات بعض المجموعات السلفية بالتأكيد .
و عندما توقف المترو في محطة الدندان طالعتني كتابة بالطلاء الأسود على جدار المحطة تقول : ( الشعب يريد شرعيّة اسلامية ) و كأن الجواب قد جاء في المحطة اللاحقة " الصناعات التقليدية " ليناقض الشعار السابق حيث كتب على جدار المحطة : ( الشعب يريد دستورا مدنيا ) .
قبل الثورة لم تكن تونس هكذا ، كانت بلدا خائفا ، لا ينطق المرء بما يفكر فيه إلا بعد أن يدير رأسه إلى كلّ الجهات ليتأكد من غياب الآذان المنصتة ، أما اليوم فقد نزعت خوفها ، لكنّ العض حوله إلى فوضى عارمة ، إلى قاموس ناب تتقاذفه الشفاه و أطلق عليه الأعلام المسموع و المكتوب عبارة " العنف اللفظي" .
شعارات تتصارع ، لا تعكس الإختلاف الحي بل العناد ، كأن كلّ شعار يريد من يرفعه أن يؤكد وجوده حزبا أو مجموعة بأي حجم كان ، أحزاب ( الصفر فاصل ) كما تسمّى ، وهي الأحزاب التي فشلت في ايصال نائب واحد للمجلس التأسيسي رغم علو أصوات منخرطيها.
المدينة فضاء مفتوح لكلّ الشعارات و الرغبات التي كانت مخبأة في الصدور ، وشاة صغار و كتبة تقارير و كاسرو رقاب و جدوا منافذ لهم ، بعضهم امتلك صحفا أو موقعا في جهاز اعلامي و زايد على الجميع .
شعارات معلنة و صريحة تفصح و تقول بمنتهى الصراحة ، تكتب على الجدران و في الصحف ، تسمع أصواتها في الاذاعات و تظهر وجوهها في التلفزات .
كلّ الأصوات عالية ، لا مجال للهمس ، و هذا شيء مبهج جدّا ، و لكن السؤال الذي يردده بعض المراقبين إلى أين كل هذا ؟ و ماذا بعد ؟
لملمت نظراتي التي وزعتها لقراءة الشعارات الكثيرة في محطات المترو ، و بعضها باللغة الفرنسيّة و أخرى شطبت بالطلاء الأسود نفسه الذي كتبت به .
أسئلة كثيرة أسمعها ، أسئلة تفوق عدد الأجوبة الممكنة ، أسئلة لا تخصني بل تخصّ النّاس في احتدامهم و اعتصاماتهم و اضراباتهم و قطعهم للطرق و حرقهم لبعض مراكز الشرطة و المحاكم ، براكين عمياء تنفجر دون مسوّغ .
أحزاب ورقية تريد أن تجد لها موقعا على الخارطة السياسية و لكن عبثا فليكن الهجوم بالشعارات على كلّ شيء .
كنت على استرخائي ، ركاب ينزلون ، و آخرون يصعدون ، و كأن المترو على انسجام مع هذا الإيقاع فيتباطأ هو الآخر ، و لو أن سائقه قد أغضبه راكب ما يظلّ معلقا بالباب لما مضى بهذا الهدوء .
و عندما وصلت شارع باريس غادرت مقعدي و نزلت ، لي ذكريات مضحكة مع هذه المحطة إذ سرقت حافظة فيها نقودي مرتين ، أقول مضحكة لأنّني لا أعرف كيف استطاع السارق اللطيف أن يستغفلني و برمشة عين ليستولي على حافظة القطع النقدية التي يسميها التونسيون " ستوش " رغم أن ما يحويه من نقود مجرّد " فكّة " .
- 3 -
وصلت في الموعد للقاء صديقي اسماعيل الذي كان في انتظاري بمقهى "روتوند " الذي يلذ لنا أحيانا أن " نتبيّر " فيه ، أو " نتقهوأ " و نقلب صحف المدينة التي تعكس صخب الشارع و نستمع إلى ما لذّ و طاب من قاموس العنف اللفظي الذي تنجبه قريحة " المتبيّرين " الصباحيين .
لا نعرف كيف انزلقت أحاديثنا في الأسابيع الأخيرة إلى الدعابات الناعمة بدلا من الجديّة ، حتى كأن السخرية صارت لنا قاموسا ، به نتعامل ، ركام من الفذلكات الطرية و استمرأنا اللعبة حدّ الإتقان .
كانت أصوات الهتافات تصلنا من التظاهرات التي تعبئ شارع بورقيبة الفسيح ، هذا الشارع الذي لا تكتمل التظاهرات إلا باقتحامه فهو ملعبها المفضل .
تظاهرة الأحد هذه انطلقت من ساحة محمد علي الحامي متوجهة نحو مدخل الشارع حيث تمثال ابن خلدون وصولا إلى بمنى وزارة الداخلية .
وكانت مقاهي الرصيف التي تتوّزع على جانبي الشارع مفتوحة كلّها و تعجّ بالرواد ، كما أن بعض المحلات التجارية كانت مفتوحة هي الأخرى ، و كان عدد من الفضوليين في الشارع يختلط بالمتظاهرين ، فكلّ هذا الذي يحصل جديد على البلد الذي كان الرئيس الهارب و الرئيس الذي سبقه يحكمان قبضتيهما الأمنيّة و لا يسمحان بأي احتجاج ، و لا حتى باجتماع حزبي مهما كان عدد الحاضرين فيه .
اخترنا أن نخرج للشارع بدلا من البقاء في المقهى " و بدأنا بالتحرّك إلى جهة المسرح البلدي و عندما وصلنا تعرفنا على بعض الوجوه المسرحية و التلفزية المعروفة فهذا يوم المسرح العالمي كما ذكرت الصحف . و ما دام هذا اليوم يوما استثنائيا للمسرحيين فقد تجمّعوا أمام المسرح البلدي أهمّ مسرح في البلد ، وكان هتاف الحناجر يرّدد ( الشعب يريد مسرحا) . و هو شعار كما يبدو غير مستفزّ لأحد إلا للذين يرون المسرح حراما و لا يتوانى البعض من تكفير العاملين فيه .
وصلنا و وقفنا وسط الشارع لنتطلع إليهم و هم يتكدسون في تلك المساحة الضيقّة أمام المسرح و فوق سلالمه التي يلذّ للشبّان الجلوس عليها في سائر الأيام ليدخّنوا و يثرثروا و يراقبوا حركة الشارع .
لكن اسماعيل همس لي :
- ألا ترى أن أصواتهم لا تسمع أمام هدير المظاهرة الكبيرة التي بدأت بالوصول من جهة تمثال ابن خلدون؟
و تأكد لي هذا إذ انطمست حناجر المسرحيين في مدّ الهتاف الهائل من الموج القادم حيث الرايات المختلفة الألوان التي يطغى عليها اللون الأسود و عبارة " الله أكبر " و لم تكن الهتافات بالحناجر العارية فقط بل و في مكبرات الصوت أيضا : الله أكبر .
و بانت لنا وجوه عشرات الشبّان الملتحين بجلابيبهم القصيرة و أغطية الرأس الخاصة بهم لتميزهم .
قال اسماعيل بتساؤل :
- هل هؤلاء من يسمون بالسلفيين ؟
و ردّدت عليه بجواب حائر :
- يبدو هكذا رغم أن المصطلح غير دقيق كما أتصوّر !
و علّق اسماعيل على الفور :
- هناك السلفيون و هناك أيضا السلفيون الجهاديون ، تشابك لا يحلّ بين المصطلحات !
- لكن هؤلاء بلحاهم و جببهم القصيرة و أحذيتهم الرياضية و الطاقيات التي وضعوها على رؤوسهم يبدون و كأنّهم يبحثون عن زمنهم الخاصّ !
- ربما، خارج زمني و زمنك ؟
- و هذا لا يهمّهم لأنّهم مطمئنون على ماهم فيه ، لهم هذا الحضور الكثيف رغم أنهم لم يجازوا كحزب لأنّهم ببساطة ضد الأحزاب و يعتبرونها حراما .
و لم نبق واقفين ، فأصوات الممثلين التي تهتف رغم ما عرف عنها من فصاحة و جهورية قد غطت عليها هتافات الرجال الملتحين الذين يصرخون بمكبرات الصوت .
و حثني اسماعيل على التحرّك ، و هكذا مضت خطواتنا بين الجموع المتظاهرة أو المتفرجة .
لقد أصبح التفرّج على المظاهرات جزءا من برنامجنا اليومي رغم أننا غير معنيين بها لأننا لسنا طرفا ، و لكن شاءت الظروف أن نكون نحن المنتمين إلى عدد من الأقطار العربية شهودا على أكبر تغيير عرفته تونس و يتمثل بهذه الثورة التي اقتلعت ديكتاتورية متوارثة تقاسم فيها تاريخ تونس الحديث منذ استقلالها رجلان فقط . الأوّل أراح و استراح عندما أعلن نفسه رئيسا مدى الحياة ، و الثاني صار يحرف القانون ليمدد لنفسه ثلاثا و عشرين سنة و خرجت مجموعة المنتفعين منه بما سمته " المناشدة " ليبقى في الحكم مدى العمر ، يناشدونه بأن يرشح في الإنتخابات التي ستكون بعد أربع سنوات و هو ما زال في مطلع فترة انتخابية لم يستوف عامها الأول بعد .
اكتظت الهتافات ، تداخلت ، اختلفت ، و لم نستطع أن نميّز ما تبوح به ، سألت اسماعيل :
- هل فهمت شيئا ؟
رّد :
- أبدا
و صفن قليلا و أضاف بدعابة :
- هل من الضروري أن أفهم ؟
و انطلقت الضحكات من حنجرتينا .
و ازداد اللغط العريض الذي يلهث في شارع " بورقيبة " الفسيح بأشجاره المعمرة التي غادرتها طيورها منذ أن ألقيت أول قنبلة غاز لتفريق الثائرين يوم 14 جانفي المشهود .
ثم تناهى إلينا صراخ وخمّنا أنه من جهة المسرح البلدي فعدنا أدراجنا بإتجاهه ، و كلما اقتربنا صرنا نميز الأصوات و كأنها أصوات أستغاثة من بعض سيدات المسرح بعد أن هوجم تجمّعهم من قبل بعض الفتية السلفيين ،ولا ندري كيف بدأ العراك إذ من الصعوبة في حالات كهذه معرفة كيف تجري الإشتباكات فالديكتاتورية و إن ذهبت كنظام إلا أنها كانت تربية أيضا ، ذهبت الديكاتورية و أبقت على ثمار ما غرست طليقا في الشارع لا رأي إلا رأيه ، و لذا يردد عقلاء السياسيين بأن كل هذا مران على الديمقراطية التي لم نعرفها حيث كان هناك دائما الزعيم الأوحد و الحزب الأوحد .
سحبني اسماعيل من يدي و أدخلني إلى مقهى يطلّ على الشارع من الجهة الأخرى ، كان يستحثني لأن " نتقهوأ " على وقع قضم حبات اللوز المملح .
- 4 -
في نشرة الأخبار المسائية التي تبثّها قناة التلفزة الوطنية أعلنت وزارة الداخلية منع كل التظاهرات في شارع الحبيب بورقيبة .
و في النشرة نفسها أصدرت وزارة الثقافة بيانا نددت فيه بالإعتداء على المسرحيين التونسيين الذين كانوا يحتلفون أمام المسرح البلدي بيوم المسرح العالمي ، و رأينا في النشرة وجوها مسرحيّة أبرزها وجه جليلة بكار احدى سيدات المسرح التونسي المتوجة قبل أسبوع واحد بجائزة محمود درويش للإبداع ، وكانت تروي ما حصل أمام المسرح .
- 5 -
كنت أتحرّك داخل المنزل متذكرا شعارات اليوم سواء ما رفع منها في تظاهرة شارع بورقيبة أو ما كتب على جدران محطات المترو ، كانت هذه الشعارات تتحول إلى ضجيج في رأسي ، و تتبارى كزحام من الأسئلة المؤرقة المحرقة التي لا أستطيع اقتراح مشاريع أجوبة لها .
أغلقت نافذة غرفة نومي لأنعم بقليل من الهدوء أقارع به ضجيج النهار الطويل .
أخرجت هاتفي الجوال و كتبت رسالة قصيرة : ( أقم صلاتك قبل مماتك ) و بحثت عن رقم هاتف اسماعيل الجوّال و كبست عليه فذهبت الرسالة .
بعد لحظات كان ردّه : ( الشعب يريد مسرحا و نحن ماذا نريد ؟ )
أجبته :
- اللا شيء .
* عن جريدة تاتوو