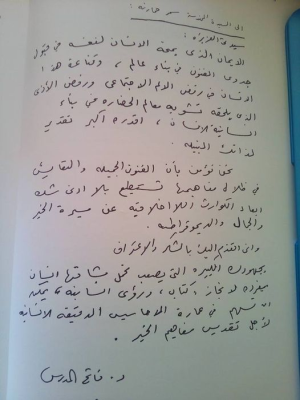يبدو أن مراوغة الشكل في قصيدة النثر هي السبب الأساس في عدم وجود مشروعية وقبول متساويين لها مع شعر التفعيلة أو الشعر العمودي، وتجعلها – إلى حد ما- أقرب إلى الشكل الهامشي رغم وجوده الملموس، ووجود أجيال لها إنتاج بارز في الإبداع العربي على مدى العقود والأزمنة. فالمراوغة أو السيولة تفتيت لوجود القيود وتدمير للقانون الذي يعد ميثاقا للجنس الأدبي أو النوع في تأسيس ملامح هيمنته. ويبدو- أيضا- أن هذا الحال موجودة بكل إشكالياتها مع اختلافات طفيفة في معظم البلدان واللغات في طبيعة الاقتراب أو الابتعاد من قصيدة النثر.
سؤال الماهية أو التحديد جزء أساسي من إشكالية قصيدة النثر، لأن التحديد عمل تصنيفي ضروري يرتبط بطبيعة العقل المؤسس على ضم الشبيه أو النظير إلى تصورات ثابتة، قادرة على الجمع والتسكين انطلاقا من محددات سابقة التجهيز، وارتباطا بالتوقع لحركة النوع أو الجنس الأدبي. ولكن الأمر يختلف مع قصيدة النثر التي أصبح لها تراث ممتد في أدبنا العربي، تراث يتسم بالتنوع والتعدد، فلم تعد ذات هيئة واحدة كما تجلت مع بدايات مجلة شعر اللبنانية مع يوسف الخال وأدونيس، بالإضافة إلى أنسي الحاج وخالدة سعيدة، وأخيرا الماغوط وشوقي أبوشقرا وعصام محفوظ وسركون بولص وصلاح فائق.
هذا التعدد الذي نرى صداه واضحا في منجز قصيدة النثر في كل الأقطار العربية بعيدا عن الارتكان إلى فكرة القيمة يكشف عن صعوبة التحديد، وعن شكل منفتح يؤسس ويقوّض ما يؤسسه بالحركة المستمرة من خلال قدرته على تمثل واستيعاب مساحات ومنطلقات فنية من الأنواع الأخرى، لا تقضي على شرعية وجوده، وإنما تعطيه مدادا لاستمراره وتنوعه. تكشف مقولة غي لافود (لا يمكن تحديد قصيدة النثر هي توجد فقط) عن جدوى السعي في إطار تحديد قصيدة النثر وتحديد أطرها واستبيان واستيلاد قوانينها. فهذا الشكل التدميري الذي يهشم كل ما تعوّد عليه الدارسون من أسس وقواعد شكل يندّ عن التحديد وعن التسييج في أطر تقمعه وتجعله شكلا ثابتا أو نمطا مستهلكا. فهي قصيدة منفتحة على كل الإمكانات اللانهائية في كل أجناس الكتابة الأدبية، خاصة في ظل تصور مغاير لنظرية الأجناس الأدبية. حيث أصبح الجنس الأدبي يتمثل تحديده في مجمل الآليات المرتبطة بالقراءة والتلقي.
الماهية
ظل الباحثون بالرغم من ذلك مهمومين بسؤال الماهية، فالمدى الزمني الممتد، والرصيد الإبداعي المستمر لم يفلحا في كبت ظهور السؤال، وما يوجبه من إعادة نظر ومقاربة، فتشارلز سيميك الشاعر الأمريكي الذي فاز ديوانه بجائزة البوليتزر 1990 وصاحبَ فوزه وجود احتجاجات كبيرة يقول(الشعر النثري موجود منذ قرنين من الزمان تقريبا، ولا يوجد حتى الآن من يستطيع أن يعرّفنا ما المقصود بالشعر النثري؟. التعريف المعتاد والمألوف يقف عند حدود ذكر إنه شعر يكتب في إطار نثري، ويترك الأمر على هذا النحو).
في تحديد قصيدة النثر أو محاولة تحديدها بوصفها نوعا تعرضت لمنعطفات عديدة نتيجة لدينامية النظرية الأدبية، ونظرية الأنواع الأدبية وطريقة توالدها ذاتيا كما في تصور تودروف إما بالتحويل أو المعارضة أو الإزاحة أو الدمج، ونتيجة للتراكم المعرفي الذي صاحب وجودها المستمر. ولكن هناك جزءا رافقها من البداية إلى اللحظة الآنية، وهو المنعطف أو الإشكالية المنطلقة من اسمها الكاشف عن التناقض الظاهري.
إشكالية الصراع في محاولة تحديد قصيدة النثر من خلال فني الشعر والنثر، وكأنهما فنان منفصلان ربما تكون مرتكزا أساسيا في كل هذه المقاربات، لأنها بهذا المسمّى تشكل صورة من صور الصراع في حدوده القصوى انطلاقا من التناقض في الواضح في المسمّى المتجذر في تأسيس ممتد. فثورة قصيدة النثر أدت إلى تقويض نظام الأنواع الأدبية التقليدي المحدد والصارم، فمع بودلير بقصائده النثرية الصغيرة نستطيع أن نقارب خلخلة وزحزحة وتجاوزا لهذا التحديد، لأن ما قدمه وخاصة في سأم باريس يعد تدميرا لكل ما هو مؤسس فنيا.
الموافقة على أن قصيدة النثر دمرت أسس نظرية الأنواع الأدبية بانفتاحها وتمايزها الشكلي المستمر موافقة تحتاج إلى إعادة نظر ومساءلة خاصة حين يرتبط الأمر بطريقة المقاربة، فهل من المقبول أن تظل مقاربتها بعد كل هذه الأزمنة الممتدة على ظهورها، وتعدد أنماطها الكتابية واقفة عند حدود العلاقة بين الشعر والنثر مستندين في ذلك السياق إلى محددات ثابتة وقواعد؟. إن الإجابة عن السؤال السابق مطالبة أن تستحضر حجم الحضور الإبداعي لقصيدة النثر في السياقات الثقافية المختلفة كتابة ومقاربة نقدية، وتستحضر أيضا الطبيعة العامة للأنواع الأدبية التي لم تعد كيانات ذات تخوم وحدود ثابتة، يكشف عن ذلك شيوع مصطلحات لا تكشف عن دلالة تجنيسية مثل( كتابة) و(نص) فظاهرة مثل قصيدة النثر لا يمكن أن تظل محصورة في إطار ذلك الصراع، فهي ظاهرة تحتاج إلى مقاربة ذات خصوصية تنطلق من معاينة التجليات في إطاريها التاريخي والنظري من البداية إلى اللحظة الآنية، وأن يتم النظر إليها بوصفها نوعا غير منته، ومن ثم يصبح هناك توالد مستمر للمعايير والتحديدات الخاصة بها.
الفارق بين النظرتين فارق كبير بين نظرة ساكنة تنطلق من المحدّد والمؤسس، فتصف ما تراه بأنه خرق للمتعارف والمقرّر، ونظرة دينامية تنطلق من معاينة كل التشكلات التاريخية لتلك الظاهرة وترصد وتشكل منها باستمرار معايير أو منطلقات تتكاتف فيما بينها لتشكيل هوية النوع. فقصيدة النثر تحدث مغايرة نوعية، تستطيع من خلالها أن توقف فاعلية النثر الموروثة، فلا تظل خطية نامية، وإنما تغيّر وتحوّر دلالات الجمل شيئا فشيئا حتى وإن كانت تقريرية، فتشحنها شحنا شعريا يتطلب وقوفا وسكونا من القارئ أو المتلقي يدفعه إلى إعادة النظر، وإعادة المقاربة لاستجلاء المغايرة، ومن ثم يجب ألا يتم تناول قصيدة النثر في إطار الثنائية القطبية المتمثلة في الشعر والنثر، فالعلاقة بين الشعر والنثر كما يقول الباحث ستيفان ساويكي مثيرة ومتعددة الأوجه.
تعد الحركة أو البناء أو الانتقال سمة أساسية في فن النثر نظرا لذاكرته التواصلية بين البشر، ويعدّ الثبات- او الحركة من الثبات- سمة من سمات الشعر، لأنه مرتبط بالتأمل العميق سواء ارتبط بالذات أو بكل ما هو خارج الذات من جهة أولى، ومن جهة ثانية مرتبط بالتصوير. وربما يكون هذا فارقا أساسيا بين الشعر والنثر، وجاءت قصيدة النثر مشفوعة ومشكلة لهذه السمات، ولكن الحركة في القصيدة النثرية تتحول إلى ثبات، لأنها تمارس تغييرا مستمرا على مستوى معرفي أكبر في الدلالة الإشارية للكلمات، وتخلق لها ذاكرة جديدة، غير مطابقة إلى ماضيها، ولكنها تشير إليها من طرف خفي، وكأنها تقلّم بالتدريج في هذه المطابقة، لكي تضيف إليها، وتدخلها إلى منحى معرفي جديد من خلال البناء. والثبات الشعري –أيضا- لم يعد ثباتا وإنما أصبح حركة مشفوعة بكل آليات الحفر والنحت، فتتولد الحركة، ولكنها حركة محسوبة مملوءة بالكثافة الشعرية. فالجملة في النثر تدفع وتولد الإحساس بالحركة والتقدم الخطي والنمو، بينما الجملة في الشعر هي مساحة للحفر والعمق داخل سلاسل دلالية ممتدة، تشمل أزمنة متباينة ليست خطية أو ساكنة، هي جمل لانفتاح الذاكرة ولمعاينة مواقف وارتكاسات سابقة.
في ظل النظرة الساكنة تظل قصيدة النثر تعاني من عدم تحديد مزمن، كما يمكن أن نلاحظ في الكثير من المقاربات، بالإضافة إلى تنوع أشكالها مما يوحي بانعدام الشكل أو النمط الثابت، ويجعلها تندّ عن التحديد وفق سياج مستمر. في حديثه عن طريقة الإنتاج والتوزيع التاريخي للأفكار يشير فريدريك جيمسون إلى أن الأنواع الأدبية تأسيس أدبي أو عقد اجتماعي بين كاتب وسياق محدد، وتتمثل أهميتها في تحديد الاستخدام للعنوان المحدد لقطعة أدبية محددة.
إننا مع النظرة الأخرى الدينامية أمام نظرة مغايرة تجعل قصيدة النثر في حالة تشكُّل دائم، فراسل إدسون أهم شعراء قصيدة النثر الأمريكية غالبا في مجمل حواراته يزدري فكرة التصنيف والتسكين التي يقوم بها النقاد والمتابعون. ففي دعوته إلى التحرر من الشعور بالالتزام أو الارتباط أو الشعور بالدَّين حتى للشكل أو للنمط يرى أن الاسم الذي يعطيه المرء للكتابة- أي تحديد النوع- أقل بكثير من العمل نفسه.
وفي ذلك السياق قد أشار سيوران إلى أن تعريف الشيء أو تحديده رفض للشيء، ويجعله فائضا غير ضروري ولا لزوم له. فتحديد ماهية الشيء وفق هذا التصور معناه أنه استنفد كل قدرته على الحركة، ووصل إلى الثبات وإلى مرحلة التأسيس، وبدأ بالتدريج يفقد قدرته على الإضافة، فقد قُصّ جناحاه، ولم يعودا قادرين على التحليق. ويبدو أن كل هذه الإشارات تعود في جانب كبير منها إلى مقولة فريدريك شليجل فهو أول من قال إن كل قصيدة نثر هي نوع في حد ذاتها.
ليس التحديد في حدّ ذاته هو المرفوض هنا، وإنما طبيعة التحديد أو نقطة الانطلاق في هذا التحديد، وتوزّعه بين ارتباطه بمحددات تاريخية سابقة جاهزة أم من خلال منطلقات نصية آنية ممتدة إلى تجليات تاريخية اعتمادا على نماذج فردية نصية لمعاينة التشكلات والإضافات أو عمليات الدمج أو الحذف التي تلحق ببعض منطلقات النوع.
إن التصور الأخير يبعد قصيدة النثر كل البعد عن التقعيد في تحديد النوع، خاصة إذا كان ينطلق من وعي كلاسيكي سكوني مؤمن بالحدود والفصل الواضح بين الأنواع الأدبية، لأن هذه الحدود تؤسس للتطابق لتسكين النصوص داخل أفق أو أطر سابقة ثابتة. المتلقي مع قصيدة النثر يقف أمام شكل تدميري غريب، يجمع الكثير من النكهات والمكونات والمواد الخام، ولكن هذا الشكل يطوّع هذه المكونات أو النكهات لمنطقه الخاص، فإذا كان النثر مشدودا إلى الحركة والبناء التواصلي المتنامي، فإن قصيدة النثر تحوّل من طبيعة النثر وتجعله مشدودا إلى الثبات والتأمل المعرفي، هذا التأمل نتاج- كما يقول تشارلز سيميك- كونه ينسج في ثباته ومكانه.
يبدو أن تلك الحال جزء من مرتكزات قصيدة النثر في تشكلها، فالكلمات- أو الجمل- لا تحيل إلى محدّد واقعي، وإنما تحيل إلى مجموعة من الاندياحات المتباينة زمنيا في لحظة واحدة، من خلال التتابع الحاد للصور، ذلك التتابع الذي يمكن من خلاله تبرير تعدد مستويات الإحالة أو نقارب من خلالها تشوّش مستويات الإحالة وانفتاحها على التنازع بين الحضور والغياب في الآن ذاته، ومن ثم يشعر المتلقي بالمغايرة والاختلاف، ويشعر بوجود الشعر بالرغم من غياب الأطر المحدّدة والثابتة.
قصيدة النثر من خلال هذا التتابع أو التجمع اللحظي لانفتاحها على الحفر الداخلي للذات بجزئياتها الخافتة، أو لجزئيات العالم المحيط، تتخطى الحدود المعهودة المكانية والزمانية، فتصبح- بعيدا عن اللحظة الزمانية الآنية- من خلال هذا الانفتاح مشدودة إلى عوالم سابقة بالمشابهة أو التباين، وتتجذر في إطارات معرفية كبرى ممتدة عبر العصور بتشكلاتها، ومكوناتها المختلفة، ولكنها- في تراصفها المكتوب والمشكّل- تعيد صهر الكلمات والجمل إلى آفاق دلالية سابقة، وتحوّر في هذه الدلالات والمنحنيات، وكأنها تقوم بفعل كنائي على مستوى معرفي، فالكناية المعرفية- على حد تعبير كاسندرا أثرتون وبول هيثرنجتون- هي إحدى خصائص العقل البشري الذي يميل إلى أن يكون ترابطيا واستطراديا ومتشعبا.
هوية النوع
هناك فارق مهم وجوهري بين الماهية والهوية، فالماهية- تحديدا وتنميطا وتعريفا- تستند إلى قواعد وأسس وقوانين يجب الالتزام بها، وتحاول من خلال الوصول إلى تعريف شامل جامع للإمساك بالشيء وكينونته. أما الهوية فهي مشدودة لخصائص أو ملامح الشيء التي تتكرّر باستمرار نتيجة للحركة والدينامية، ولكنها تستند إلى جذع صلب يتمثل في العلاقة المعقدة بين حركة النثر وثبات الشعر، فالعلاقة المعقدة بين التوجهين تنتج نسقا أو نوعا فنيا أكثر تعقيدا.
في إطار الفهم السابق نجد أن القارئ يطالع نوعا ليس شعرا معتادا، ولا يمكن أن يكون بديلا عن الشعر، ولكنه يستند إلى ثباته وحفره الداخلي. ويمكن للقارئ أن يؤسس هوية لهذا النوع مبنية على خصائص وظواهر انطلاقا من معاينة ومقاربة بنياته الآنية وبنياته المؤسسة بمرور الزمن، لأن لهذا النوع تراثا تاريخيا لا يمكن الحد من قيمته. المقاربة يجب أن تتوزّع إلى مقاربة تاريخية وإلى مقاربة نصية آنية لمعاينة التحولات التي شكلّت منطلقات النوع بوصفها قواسم مشتركة لها دور في صناعة أو توليد الإحساس بهوية النوع.
وعلى هذا الأساس فتحديدات سوزان برنار(الوحدة العضوية، والمجانية، والكثافة) تشكل خصائص، ولكنها ليست نهائية، وليست قانونا أو قاعدة، هي فقط تعبر عن هوية النوع في فترة زمنية محددة، ومن ثم فهي منفتحة بالتدريج للحذف والإضافة أو التعديل نظرا لحركة النوع وتعدد أشكاله. فنمط قصيدة النثر لدى بودلير في (سأم باريس) أو في (قصائد نثرية صغيرة) ليس شكلا نهائيا لها، حيث يعتمد من خلال المعاينة على الكتلة النثرية الكاشفة عن المعنى والإثارة العاطفية في نسق يستند إلى منحى يومي. فكل ما قدمه يمثل تجليا واحدا تحركت وتشكلت قصيدة النثر في إطاره وتوزعت إلى مسارب أخرى عديدة، ولكنها أبقت على جزئيات ظلت شرايين مغذية قادرة على البقاء بالرغم من التحولات.
إن مثل هذه الجزئيات التي تطل برأسها مع كل تجلّ بداية من التأسيس الأول أو الظهور المبدئي، وما يعتوره من تقليم أو إضافة أو تحوير أو إعادة توجيه في كل فترة زمنية من تجليات النوع هي التي تعطي إحساسا بالهوية الفنية، لأنها تستند إلى معطى بنائي، وإلى مرتكزات فكرية وثيقة الصلة بالنوع.
يمكننا الوقوف عند محاولة الانفلات من حدود كل ما هو مؤسس أو مقرّر، بل والنفور منه سواء أكان فنيا أو عرفيا، لأن قصيدة النثر لديها نزوع للحرية، وعدم الشعور بالاستدانة إلى كل ما سبق. وفيما يخص النسق الفني المؤسس والخروج عنه، فيتجلى للمتأمل أن حركتها تجاهه لا تنفصل عن طبيعتها التدميرية الأساسية لإثبات أن هناك شعرا يتجاوز حدود المؤسس والمعروف، وقواعد وقوانين النمط المتوارث ارتباطا بالانفتاح على الحرية بكل ما توجده من خروج وتمرد.
التكرار الدوري للأنماط الصورية والإيقاعية غالبا ما يكون سببا في الحد من حرية التدفق الكتابي الذي وجدنا صدى جزئيا له في شعر التفعيلة، ووجدنا له صدى أكبر في قصيدة النثر وإن لم يختف تماما، فقد ظلت هناك أساليب تكرارية منطلقة من سلطة اللغة وتجذّر النسق، ومن القصور الفعلي للغة- أية لغة- في التعبير عن الجزئيات الخافتة للروح وإيقاعها على حد تعبير بودلير، فالشعر النثري على حد تعبير تشارلز سيميك يعتبر علاجا لكل لعنة من لعنات التكلف.
وربما يكون هذا هو السبب الأساسي – الانفلات من المؤسس واعتناق الحرية القصوى في استخدام الخيال- في جعل قصيدة النثر مشدودة إلى الجزئية والتشظي، لأنها ترصد حالات خافتة ومكونات جزئية، وتعطيها من خلال الفقرات والجمل الشكل. فشعراء مثل بودلير ورامبو وآخرين بالضرورة، ليسوا مشدودين إلى آفاق كبرى أو إلى شيء منجز، وإنما تكشف نصوصهم عن وعي جزئي بحاجة دائما للاكتمال، فالشعر النثري بتعبير كاساندرا أثرتون مثل القنفد وسيلة للإمساك بالطبيعة المتغيرة والمتشظية لأعمال خارج النوع، محاولا تسميتها.
وقد ألمح كثير من الباحثين إلى خاصية الجزئية أو التشظي بوصفها سمة عامة في قصيدة النثر، مثل مونرو، ودلفيل، وسانتيلي. وقد استند معظمهم إلى مقولات وتوصيفات شليجل عن الجزء أو القطعة، فهو يرى أن الجزء عمل فني مصغر يجب أن يكون معزولا تماما عن العالم المحيط، ويكون – في الوقت- ذاته كاملا بنفسه، ويلحّ على أن الجزء يحارب بشكل قوي كل محاولات احتوائه وامتصاصه.
وإذا كانت القصيدة النثرية- أو الشعر النثري- في حوار دائم التعلق والتشكل في إطار الجزئية والتشظي والمكتملة في ذاتها، والمحتاجة للاكتمال في ارتباطها بالعالم، فإنها بالضرورة تعاني من النقصان وفي معرض دائم للانفتاح على تشكلات عديدة. فالانفتاح هنا بمعناه الفني يشير إلى عدم قدرة المقاربين على توقع طبيعة تجلياتها القادمة من خلال أشكال حددت أسسها ومرتكزاتها. فقد يتحقق هذا التوقع أو التنبؤ مع النصوص العمودية التراثية الخطية، لأننا أمام بنية ساكنة محددة ومحدودة، وقد يتحقق مع الشعر التفعيلي، لأن هناك بقايا قوانين قد تكشف وتقود إلى النمطية في أحيان ليست قليلة، وإلى توقع طبيعة النهاية أو الإغلاق الفني على مستوى البنية. ولكن توقع القادم مع القصيدة النثرية غير متاح، لأنها تعتمد في الأساس على غياب القوانين والأسس، سواء كانت شكلية أو بنائية، ذلك الغياب الذي يجعلها منفتحة لانهائية الشكل من جهة أولى، ومن جهة أخرى تعتمد على الثبات والحركة- من خلال الشعر والنثر- فتتولد لها قدرة على التهام مساحات لا تتاح للأنواع الشعرية الأخرى.
هذه الخصائص والسمات السابقة كاشفة عن أن التشكلات الممكنة لقصيدة النثر لا نهائية ولا حصر لها، لأنها في انفتاح دائم للإضافة. ولكن هذا التنوع أو التعدد لا يمنعنا من التفكير في تكوين أسس فاعلة تصبح ضرورية لأي نوع أدبي، فأي مقاربة لأية ظاهرة لا يمكن أن تتم بشكل علمي إلا بعد تحديد الأسس أو المنطلقات الفاعلة للنوع، حتى لو كانت هذه الأسس والمنطلقات زلقة إلى حدّ بعيد، وحتى لو كان توصيفنا لها لحظيا وآنيا انطلاقا من مجموعة النصوص التي تشكل الظاهرة أو مجموعة النصوص التي تشكل بتكاتفها الخاص حدود النوع.
إن نظرة فاحصة إلى نماذج من قصائد النثر العربية تكشف عن الموجود آنيا ليس شكلا واحدا للنوع، فهناك أشكال وأنماط عديدة لقصيدة النثر العربية، لكونها شكلا منفتحا ولديه قدرة على التكيف والاتساع ذاتيا، ومن خلال الالتحام بما هو غنائي وملحمي وحواري وسردي وخطابي، وتسمح لكل هذه الأساليب بالتواجد في إطار بنيتها، ولكن فاعليتها تكمن في الطريقة التي تشكل وتكيّف من خلالها وجود هذه الجزئيات، ولذلك فإن أية محاولة لتبسيط قصيدة النثر إلى حدود العلاقة بين الشعر والنثر هي محاولة محكوم عليها بالفشل، وتصبح مجرد تبسيط لا قيمة له.
التعدد في المكونات التي تستند إليها قصيدة النثر في تشكيل وتأسيس وجودها واختلافها، تعدد لا يفضي إلى تشتت. فجانب مهم من جوانب قيمة قصيدة النثر بوصفها نوعا يتشكل في حدود طريقة "الدمج" أو" المزج" أو "التكوين" لهذه العناصر التي ليست فقط متباينة، وإنما متنافرة، بالإضافة إلى أن نتيجة الدمج أو التكوين في قصيدة النثر- الجيدة بالضرورة- ليست ثابتة، بل مختلفة من نص إلى آخر، فكأن كل نص يمثل تجليا جديدا للنوع.
قصيدة النثر تمثل تحولا مفصليا في الشعر العربي، لأنها بالرغم من تعدد أنماطها وأشكالها، وارتباطها بالتوالد اللانهائي، قد استطاعت أن تشكل لها هوية فنية، كل فترة زمنية، وذلك من خلال استنادها إلى خبرة كتابية ملموسة على أقلام أعلامها في كل عصر من جانب، ومن جانب آخر من خلال استناد أصحابها إلى الفكر، وإلى الرؤية المعرفية التي لا تقف عن حدود الآني اللحظي، ولكنها تمتد إلى لحظات وأزمنة غابرة لمقاربة التجليات السابقة للأفكار، ولهذا نجد أن من ضمن مسميات قصيدة النثر (النص المعرفي) للإشارة إلى سمة فاعلة من بداية ظهورها إلى اللحظة الراهنة، ولكن تتشكل بتجليات مختلفة.
قصيدة النثر هي طريقة لمقاربة العالم والالتحام به، وهي طريق جانبية لافتة للإصغاء إلى الصوت الرهيف الخافت الممتد داخل ذواتنا، أو هي آلية مقاربة يستخدمها الشعراء- كما يقول تشارلز سيميك- لتحرير أنفسهم من طريقتهم المعتادة في رؤية العالم، وإيجاد طريقة جديدة لإدهاش أنفسهم.
سؤال الماهية أو التحديد جزء أساسي من إشكالية قصيدة النثر، لأن التحديد عمل تصنيفي ضروري يرتبط بطبيعة العقل المؤسس على ضم الشبيه أو النظير إلى تصورات ثابتة، قادرة على الجمع والتسكين انطلاقا من محددات سابقة التجهيز، وارتباطا بالتوقع لحركة النوع أو الجنس الأدبي. ولكن الأمر يختلف مع قصيدة النثر التي أصبح لها تراث ممتد في أدبنا العربي، تراث يتسم بالتنوع والتعدد، فلم تعد ذات هيئة واحدة كما تجلت مع بدايات مجلة شعر اللبنانية مع يوسف الخال وأدونيس، بالإضافة إلى أنسي الحاج وخالدة سعيدة، وأخيرا الماغوط وشوقي أبوشقرا وعصام محفوظ وسركون بولص وصلاح فائق.
هذا التعدد الذي نرى صداه واضحا في منجز قصيدة النثر في كل الأقطار العربية بعيدا عن الارتكان إلى فكرة القيمة يكشف عن صعوبة التحديد، وعن شكل منفتح يؤسس ويقوّض ما يؤسسه بالحركة المستمرة من خلال قدرته على تمثل واستيعاب مساحات ومنطلقات فنية من الأنواع الأخرى، لا تقضي على شرعية وجوده، وإنما تعطيه مدادا لاستمراره وتنوعه. تكشف مقولة غي لافود (لا يمكن تحديد قصيدة النثر هي توجد فقط) عن جدوى السعي في إطار تحديد قصيدة النثر وتحديد أطرها واستبيان واستيلاد قوانينها. فهذا الشكل التدميري الذي يهشم كل ما تعوّد عليه الدارسون من أسس وقواعد شكل يندّ عن التحديد وعن التسييج في أطر تقمعه وتجعله شكلا ثابتا أو نمطا مستهلكا. فهي قصيدة منفتحة على كل الإمكانات اللانهائية في كل أجناس الكتابة الأدبية، خاصة في ظل تصور مغاير لنظرية الأجناس الأدبية. حيث أصبح الجنس الأدبي يتمثل تحديده في مجمل الآليات المرتبطة بالقراءة والتلقي.
الماهية
ظل الباحثون بالرغم من ذلك مهمومين بسؤال الماهية، فالمدى الزمني الممتد، والرصيد الإبداعي المستمر لم يفلحا في كبت ظهور السؤال، وما يوجبه من إعادة نظر ومقاربة، فتشارلز سيميك الشاعر الأمريكي الذي فاز ديوانه بجائزة البوليتزر 1990 وصاحبَ فوزه وجود احتجاجات كبيرة يقول(الشعر النثري موجود منذ قرنين من الزمان تقريبا، ولا يوجد حتى الآن من يستطيع أن يعرّفنا ما المقصود بالشعر النثري؟. التعريف المعتاد والمألوف يقف عند حدود ذكر إنه شعر يكتب في إطار نثري، ويترك الأمر على هذا النحو).
في تحديد قصيدة النثر أو محاولة تحديدها بوصفها نوعا تعرضت لمنعطفات عديدة نتيجة لدينامية النظرية الأدبية، ونظرية الأنواع الأدبية وطريقة توالدها ذاتيا كما في تصور تودروف إما بالتحويل أو المعارضة أو الإزاحة أو الدمج، ونتيجة للتراكم المعرفي الذي صاحب وجودها المستمر. ولكن هناك جزءا رافقها من البداية إلى اللحظة الآنية، وهو المنعطف أو الإشكالية المنطلقة من اسمها الكاشف عن التناقض الظاهري.
إشكالية الصراع في محاولة تحديد قصيدة النثر من خلال فني الشعر والنثر، وكأنهما فنان منفصلان ربما تكون مرتكزا أساسيا في كل هذه المقاربات، لأنها بهذا المسمّى تشكل صورة من صور الصراع في حدوده القصوى انطلاقا من التناقض في الواضح في المسمّى المتجذر في تأسيس ممتد. فثورة قصيدة النثر أدت إلى تقويض نظام الأنواع الأدبية التقليدي المحدد والصارم، فمع بودلير بقصائده النثرية الصغيرة نستطيع أن نقارب خلخلة وزحزحة وتجاوزا لهذا التحديد، لأن ما قدمه وخاصة في سأم باريس يعد تدميرا لكل ما هو مؤسس فنيا.
الموافقة على أن قصيدة النثر دمرت أسس نظرية الأنواع الأدبية بانفتاحها وتمايزها الشكلي المستمر موافقة تحتاج إلى إعادة نظر ومساءلة خاصة حين يرتبط الأمر بطريقة المقاربة، فهل من المقبول أن تظل مقاربتها بعد كل هذه الأزمنة الممتدة على ظهورها، وتعدد أنماطها الكتابية واقفة عند حدود العلاقة بين الشعر والنثر مستندين في ذلك السياق إلى محددات ثابتة وقواعد؟. إن الإجابة عن السؤال السابق مطالبة أن تستحضر حجم الحضور الإبداعي لقصيدة النثر في السياقات الثقافية المختلفة كتابة ومقاربة نقدية، وتستحضر أيضا الطبيعة العامة للأنواع الأدبية التي لم تعد كيانات ذات تخوم وحدود ثابتة، يكشف عن ذلك شيوع مصطلحات لا تكشف عن دلالة تجنيسية مثل( كتابة) و(نص) فظاهرة مثل قصيدة النثر لا يمكن أن تظل محصورة في إطار ذلك الصراع، فهي ظاهرة تحتاج إلى مقاربة ذات خصوصية تنطلق من معاينة التجليات في إطاريها التاريخي والنظري من البداية إلى اللحظة الآنية، وأن يتم النظر إليها بوصفها نوعا غير منته، ومن ثم يصبح هناك توالد مستمر للمعايير والتحديدات الخاصة بها.
الفارق بين النظرتين فارق كبير بين نظرة ساكنة تنطلق من المحدّد والمؤسس، فتصف ما تراه بأنه خرق للمتعارف والمقرّر، ونظرة دينامية تنطلق من معاينة كل التشكلات التاريخية لتلك الظاهرة وترصد وتشكل منها باستمرار معايير أو منطلقات تتكاتف فيما بينها لتشكيل هوية النوع. فقصيدة النثر تحدث مغايرة نوعية، تستطيع من خلالها أن توقف فاعلية النثر الموروثة، فلا تظل خطية نامية، وإنما تغيّر وتحوّر دلالات الجمل شيئا فشيئا حتى وإن كانت تقريرية، فتشحنها شحنا شعريا يتطلب وقوفا وسكونا من القارئ أو المتلقي يدفعه إلى إعادة النظر، وإعادة المقاربة لاستجلاء المغايرة، ومن ثم يجب ألا يتم تناول قصيدة النثر في إطار الثنائية القطبية المتمثلة في الشعر والنثر، فالعلاقة بين الشعر والنثر كما يقول الباحث ستيفان ساويكي مثيرة ومتعددة الأوجه.
تعد الحركة أو البناء أو الانتقال سمة أساسية في فن النثر نظرا لذاكرته التواصلية بين البشر، ويعدّ الثبات- او الحركة من الثبات- سمة من سمات الشعر، لأنه مرتبط بالتأمل العميق سواء ارتبط بالذات أو بكل ما هو خارج الذات من جهة أولى، ومن جهة ثانية مرتبط بالتصوير. وربما يكون هذا فارقا أساسيا بين الشعر والنثر، وجاءت قصيدة النثر مشفوعة ومشكلة لهذه السمات، ولكن الحركة في القصيدة النثرية تتحول إلى ثبات، لأنها تمارس تغييرا مستمرا على مستوى معرفي أكبر في الدلالة الإشارية للكلمات، وتخلق لها ذاكرة جديدة، غير مطابقة إلى ماضيها، ولكنها تشير إليها من طرف خفي، وكأنها تقلّم بالتدريج في هذه المطابقة، لكي تضيف إليها، وتدخلها إلى منحى معرفي جديد من خلال البناء. والثبات الشعري –أيضا- لم يعد ثباتا وإنما أصبح حركة مشفوعة بكل آليات الحفر والنحت، فتتولد الحركة، ولكنها حركة محسوبة مملوءة بالكثافة الشعرية. فالجملة في النثر تدفع وتولد الإحساس بالحركة والتقدم الخطي والنمو، بينما الجملة في الشعر هي مساحة للحفر والعمق داخل سلاسل دلالية ممتدة، تشمل أزمنة متباينة ليست خطية أو ساكنة، هي جمل لانفتاح الذاكرة ولمعاينة مواقف وارتكاسات سابقة.
في ظل النظرة الساكنة تظل قصيدة النثر تعاني من عدم تحديد مزمن، كما يمكن أن نلاحظ في الكثير من المقاربات، بالإضافة إلى تنوع أشكالها مما يوحي بانعدام الشكل أو النمط الثابت، ويجعلها تندّ عن التحديد وفق سياج مستمر. في حديثه عن طريقة الإنتاج والتوزيع التاريخي للأفكار يشير فريدريك جيمسون إلى أن الأنواع الأدبية تأسيس أدبي أو عقد اجتماعي بين كاتب وسياق محدد، وتتمثل أهميتها في تحديد الاستخدام للعنوان المحدد لقطعة أدبية محددة.
إننا مع النظرة الأخرى الدينامية أمام نظرة مغايرة تجعل قصيدة النثر في حالة تشكُّل دائم، فراسل إدسون أهم شعراء قصيدة النثر الأمريكية غالبا في مجمل حواراته يزدري فكرة التصنيف والتسكين التي يقوم بها النقاد والمتابعون. ففي دعوته إلى التحرر من الشعور بالالتزام أو الارتباط أو الشعور بالدَّين حتى للشكل أو للنمط يرى أن الاسم الذي يعطيه المرء للكتابة- أي تحديد النوع- أقل بكثير من العمل نفسه.
وفي ذلك السياق قد أشار سيوران إلى أن تعريف الشيء أو تحديده رفض للشيء، ويجعله فائضا غير ضروري ولا لزوم له. فتحديد ماهية الشيء وفق هذا التصور معناه أنه استنفد كل قدرته على الحركة، ووصل إلى الثبات وإلى مرحلة التأسيس، وبدأ بالتدريج يفقد قدرته على الإضافة، فقد قُصّ جناحاه، ولم يعودا قادرين على التحليق. ويبدو أن كل هذه الإشارات تعود في جانب كبير منها إلى مقولة فريدريك شليجل فهو أول من قال إن كل قصيدة نثر هي نوع في حد ذاتها.
ليس التحديد في حدّ ذاته هو المرفوض هنا، وإنما طبيعة التحديد أو نقطة الانطلاق في هذا التحديد، وتوزّعه بين ارتباطه بمحددات تاريخية سابقة جاهزة أم من خلال منطلقات نصية آنية ممتدة إلى تجليات تاريخية اعتمادا على نماذج فردية نصية لمعاينة التشكلات والإضافات أو عمليات الدمج أو الحذف التي تلحق ببعض منطلقات النوع.
إن التصور الأخير يبعد قصيدة النثر كل البعد عن التقعيد في تحديد النوع، خاصة إذا كان ينطلق من وعي كلاسيكي سكوني مؤمن بالحدود والفصل الواضح بين الأنواع الأدبية، لأن هذه الحدود تؤسس للتطابق لتسكين النصوص داخل أفق أو أطر سابقة ثابتة. المتلقي مع قصيدة النثر يقف أمام شكل تدميري غريب، يجمع الكثير من النكهات والمكونات والمواد الخام، ولكن هذا الشكل يطوّع هذه المكونات أو النكهات لمنطقه الخاص، فإذا كان النثر مشدودا إلى الحركة والبناء التواصلي المتنامي، فإن قصيدة النثر تحوّل من طبيعة النثر وتجعله مشدودا إلى الثبات والتأمل المعرفي، هذا التأمل نتاج- كما يقول تشارلز سيميك- كونه ينسج في ثباته ومكانه.
يبدو أن تلك الحال جزء من مرتكزات قصيدة النثر في تشكلها، فالكلمات- أو الجمل- لا تحيل إلى محدّد واقعي، وإنما تحيل إلى مجموعة من الاندياحات المتباينة زمنيا في لحظة واحدة، من خلال التتابع الحاد للصور، ذلك التتابع الذي يمكن من خلاله تبرير تعدد مستويات الإحالة أو نقارب من خلالها تشوّش مستويات الإحالة وانفتاحها على التنازع بين الحضور والغياب في الآن ذاته، ومن ثم يشعر المتلقي بالمغايرة والاختلاف، ويشعر بوجود الشعر بالرغم من غياب الأطر المحدّدة والثابتة.
قصيدة النثر من خلال هذا التتابع أو التجمع اللحظي لانفتاحها على الحفر الداخلي للذات بجزئياتها الخافتة، أو لجزئيات العالم المحيط، تتخطى الحدود المعهودة المكانية والزمانية، فتصبح- بعيدا عن اللحظة الزمانية الآنية- من خلال هذا الانفتاح مشدودة إلى عوالم سابقة بالمشابهة أو التباين، وتتجذر في إطارات معرفية كبرى ممتدة عبر العصور بتشكلاتها، ومكوناتها المختلفة، ولكنها- في تراصفها المكتوب والمشكّل- تعيد صهر الكلمات والجمل إلى آفاق دلالية سابقة، وتحوّر في هذه الدلالات والمنحنيات، وكأنها تقوم بفعل كنائي على مستوى معرفي، فالكناية المعرفية- على حد تعبير كاسندرا أثرتون وبول هيثرنجتون- هي إحدى خصائص العقل البشري الذي يميل إلى أن يكون ترابطيا واستطراديا ومتشعبا.
هوية النوع
هناك فارق مهم وجوهري بين الماهية والهوية، فالماهية- تحديدا وتنميطا وتعريفا- تستند إلى قواعد وأسس وقوانين يجب الالتزام بها، وتحاول من خلال الوصول إلى تعريف شامل جامع للإمساك بالشيء وكينونته. أما الهوية فهي مشدودة لخصائص أو ملامح الشيء التي تتكرّر باستمرار نتيجة للحركة والدينامية، ولكنها تستند إلى جذع صلب يتمثل في العلاقة المعقدة بين حركة النثر وثبات الشعر، فالعلاقة المعقدة بين التوجهين تنتج نسقا أو نوعا فنيا أكثر تعقيدا.
في إطار الفهم السابق نجد أن القارئ يطالع نوعا ليس شعرا معتادا، ولا يمكن أن يكون بديلا عن الشعر، ولكنه يستند إلى ثباته وحفره الداخلي. ويمكن للقارئ أن يؤسس هوية لهذا النوع مبنية على خصائص وظواهر انطلاقا من معاينة ومقاربة بنياته الآنية وبنياته المؤسسة بمرور الزمن، لأن لهذا النوع تراثا تاريخيا لا يمكن الحد من قيمته. المقاربة يجب أن تتوزّع إلى مقاربة تاريخية وإلى مقاربة نصية آنية لمعاينة التحولات التي شكلّت منطلقات النوع بوصفها قواسم مشتركة لها دور في صناعة أو توليد الإحساس بهوية النوع.
وعلى هذا الأساس فتحديدات سوزان برنار(الوحدة العضوية، والمجانية، والكثافة) تشكل خصائص، ولكنها ليست نهائية، وليست قانونا أو قاعدة، هي فقط تعبر عن هوية النوع في فترة زمنية محددة، ومن ثم فهي منفتحة بالتدريج للحذف والإضافة أو التعديل نظرا لحركة النوع وتعدد أشكاله. فنمط قصيدة النثر لدى بودلير في (سأم باريس) أو في (قصائد نثرية صغيرة) ليس شكلا نهائيا لها، حيث يعتمد من خلال المعاينة على الكتلة النثرية الكاشفة عن المعنى والإثارة العاطفية في نسق يستند إلى منحى يومي. فكل ما قدمه يمثل تجليا واحدا تحركت وتشكلت قصيدة النثر في إطاره وتوزعت إلى مسارب أخرى عديدة، ولكنها أبقت على جزئيات ظلت شرايين مغذية قادرة على البقاء بالرغم من التحولات.
إن مثل هذه الجزئيات التي تطل برأسها مع كل تجلّ بداية من التأسيس الأول أو الظهور المبدئي، وما يعتوره من تقليم أو إضافة أو تحوير أو إعادة توجيه في كل فترة زمنية من تجليات النوع هي التي تعطي إحساسا بالهوية الفنية، لأنها تستند إلى معطى بنائي، وإلى مرتكزات فكرية وثيقة الصلة بالنوع.
يمكننا الوقوف عند محاولة الانفلات من حدود كل ما هو مؤسس أو مقرّر، بل والنفور منه سواء أكان فنيا أو عرفيا، لأن قصيدة النثر لديها نزوع للحرية، وعدم الشعور بالاستدانة إلى كل ما سبق. وفيما يخص النسق الفني المؤسس والخروج عنه، فيتجلى للمتأمل أن حركتها تجاهه لا تنفصل عن طبيعتها التدميرية الأساسية لإثبات أن هناك شعرا يتجاوز حدود المؤسس والمعروف، وقواعد وقوانين النمط المتوارث ارتباطا بالانفتاح على الحرية بكل ما توجده من خروج وتمرد.
التكرار الدوري للأنماط الصورية والإيقاعية غالبا ما يكون سببا في الحد من حرية التدفق الكتابي الذي وجدنا صدى جزئيا له في شعر التفعيلة، ووجدنا له صدى أكبر في قصيدة النثر وإن لم يختف تماما، فقد ظلت هناك أساليب تكرارية منطلقة من سلطة اللغة وتجذّر النسق، ومن القصور الفعلي للغة- أية لغة- في التعبير عن الجزئيات الخافتة للروح وإيقاعها على حد تعبير بودلير، فالشعر النثري على حد تعبير تشارلز سيميك يعتبر علاجا لكل لعنة من لعنات التكلف.
وربما يكون هذا هو السبب الأساسي – الانفلات من المؤسس واعتناق الحرية القصوى في استخدام الخيال- في جعل قصيدة النثر مشدودة إلى الجزئية والتشظي، لأنها ترصد حالات خافتة ومكونات جزئية، وتعطيها من خلال الفقرات والجمل الشكل. فشعراء مثل بودلير ورامبو وآخرين بالضرورة، ليسوا مشدودين إلى آفاق كبرى أو إلى شيء منجز، وإنما تكشف نصوصهم عن وعي جزئي بحاجة دائما للاكتمال، فالشعر النثري بتعبير كاساندرا أثرتون مثل القنفد وسيلة للإمساك بالطبيعة المتغيرة والمتشظية لأعمال خارج النوع، محاولا تسميتها.
وقد ألمح كثير من الباحثين إلى خاصية الجزئية أو التشظي بوصفها سمة عامة في قصيدة النثر، مثل مونرو، ودلفيل، وسانتيلي. وقد استند معظمهم إلى مقولات وتوصيفات شليجل عن الجزء أو القطعة، فهو يرى أن الجزء عمل فني مصغر يجب أن يكون معزولا تماما عن العالم المحيط، ويكون – في الوقت- ذاته كاملا بنفسه، ويلحّ على أن الجزء يحارب بشكل قوي كل محاولات احتوائه وامتصاصه.
وإذا كانت القصيدة النثرية- أو الشعر النثري- في حوار دائم التعلق والتشكل في إطار الجزئية والتشظي والمكتملة في ذاتها، والمحتاجة للاكتمال في ارتباطها بالعالم، فإنها بالضرورة تعاني من النقصان وفي معرض دائم للانفتاح على تشكلات عديدة. فالانفتاح هنا بمعناه الفني يشير إلى عدم قدرة المقاربين على توقع طبيعة تجلياتها القادمة من خلال أشكال حددت أسسها ومرتكزاتها. فقد يتحقق هذا التوقع أو التنبؤ مع النصوص العمودية التراثية الخطية، لأننا أمام بنية ساكنة محددة ومحدودة، وقد يتحقق مع الشعر التفعيلي، لأن هناك بقايا قوانين قد تكشف وتقود إلى النمطية في أحيان ليست قليلة، وإلى توقع طبيعة النهاية أو الإغلاق الفني على مستوى البنية. ولكن توقع القادم مع القصيدة النثرية غير متاح، لأنها تعتمد في الأساس على غياب القوانين والأسس، سواء كانت شكلية أو بنائية، ذلك الغياب الذي يجعلها منفتحة لانهائية الشكل من جهة أولى، ومن جهة أخرى تعتمد على الثبات والحركة- من خلال الشعر والنثر- فتتولد لها قدرة على التهام مساحات لا تتاح للأنواع الشعرية الأخرى.
هذه الخصائص والسمات السابقة كاشفة عن أن التشكلات الممكنة لقصيدة النثر لا نهائية ولا حصر لها، لأنها في انفتاح دائم للإضافة. ولكن هذا التنوع أو التعدد لا يمنعنا من التفكير في تكوين أسس فاعلة تصبح ضرورية لأي نوع أدبي، فأي مقاربة لأية ظاهرة لا يمكن أن تتم بشكل علمي إلا بعد تحديد الأسس أو المنطلقات الفاعلة للنوع، حتى لو كانت هذه الأسس والمنطلقات زلقة إلى حدّ بعيد، وحتى لو كان توصيفنا لها لحظيا وآنيا انطلاقا من مجموعة النصوص التي تشكل الظاهرة أو مجموعة النصوص التي تشكل بتكاتفها الخاص حدود النوع.
إن نظرة فاحصة إلى نماذج من قصائد النثر العربية تكشف عن الموجود آنيا ليس شكلا واحدا للنوع، فهناك أشكال وأنماط عديدة لقصيدة النثر العربية، لكونها شكلا منفتحا ولديه قدرة على التكيف والاتساع ذاتيا، ومن خلال الالتحام بما هو غنائي وملحمي وحواري وسردي وخطابي، وتسمح لكل هذه الأساليب بالتواجد في إطار بنيتها، ولكن فاعليتها تكمن في الطريقة التي تشكل وتكيّف من خلالها وجود هذه الجزئيات، ولذلك فإن أية محاولة لتبسيط قصيدة النثر إلى حدود العلاقة بين الشعر والنثر هي محاولة محكوم عليها بالفشل، وتصبح مجرد تبسيط لا قيمة له.
التعدد في المكونات التي تستند إليها قصيدة النثر في تشكيل وتأسيس وجودها واختلافها، تعدد لا يفضي إلى تشتت. فجانب مهم من جوانب قيمة قصيدة النثر بوصفها نوعا يتشكل في حدود طريقة "الدمج" أو" المزج" أو "التكوين" لهذه العناصر التي ليست فقط متباينة، وإنما متنافرة، بالإضافة إلى أن نتيجة الدمج أو التكوين في قصيدة النثر- الجيدة بالضرورة- ليست ثابتة، بل مختلفة من نص إلى آخر، فكأن كل نص يمثل تجليا جديدا للنوع.
قصيدة النثر تمثل تحولا مفصليا في الشعر العربي، لأنها بالرغم من تعدد أنماطها وأشكالها، وارتباطها بالتوالد اللانهائي، قد استطاعت أن تشكل لها هوية فنية، كل فترة زمنية، وذلك من خلال استنادها إلى خبرة كتابية ملموسة على أقلام أعلامها في كل عصر من جانب، ومن جانب آخر من خلال استناد أصحابها إلى الفكر، وإلى الرؤية المعرفية التي لا تقف عن حدود الآني اللحظي، ولكنها تمتد إلى لحظات وأزمنة غابرة لمقاربة التجليات السابقة للأفكار، ولهذا نجد أن من ضمن مسميات قصيدة النثر (النص المعرفي) للإشارة إلى سمة فاعلة من بداية ظهورها إلى اللحظة الراهنة، ولكن تتشكل بتجليات مختلفة.
قصيدة النثر هي طريقة لمقاربة العالم والالتحام به، وهي طريق جانبية لافتة للإصغاء إلى الصوت الرهيف الخافت الممتد داخل ذواتنا، أو هي آلية مقاربة يستخدمها الشعراء- كما يقول تشارلز سيميك- لتحرير أنفسهم من طريقتهم المعتادة في رؤية العالم، وإيجاد طريقة جديدة لإدهاش أنفسهم.