مذ كانت الرواية، وقد أشيرَ إليها تاريخياً، حتى كان هناك تحول في النظرة إلى العالم الذي يعيش فيه الإنسان، إنما، معها،وعبْرها، الذي يعيشه هو، ويمثّله بطريقة ما هو نفسه، دون أن يكونه، من خلال الكتابة التي تحيل قارئها إلى آخر قد يكون هو ولا يكون هو، والتي تسمّي كاتبها، أو تُسمَّى من خلاله، لكنه الآخر الذي يتعداه. فالكتابة هي علاقة آخر مع ما لا يتناهى منه. وكانت نشأة الرواية برجَ بابل حيث يتنبه البشر إلى ما هم فيه، وهم في غفلة عما قاموا ويقومون به، وإلى ما لا نهاية. إنها انعطافة حية من نوع شديد التميز في التاريخ، تاريخ الرواية، محرَّر باسم عرِف به: الروائي.
هذا الدساس بما يبتدعه في كل شيء، منتهك الحرمات، اللامؤتمن على سر ، اللعوب، المخادع، باعث الإرباك في النفوس، زير الحياة، السابر لها في العمق، الذي يثير الشبهات في كل ما حوله، مانحاً لكل شيء، ما يخرجه من شيئيته، الطارد لكل ما هو مقلق لسواه والطريد من خلال ما يكتب، وملتبس عليه بطريقه، إيماناً منه أن الصمت قرين الموت. إنه يكتب كرمى حياة غير معهودة. هوذا الروائي. المهرّب الغريب من نوعه، في تكوينه في اللحظة التي وقْع عقداً أبدياً، وهو مأخوذ بالكتابة، لأن الذي يقبل على تناوله هو استشراف حياة وموت، لكنه سعي إلى حياة أخرى، ولهذا يكون المهرّب المغاير لأي مهرب آخر، كما هو معروف باسمه وصفة عمله حديثاً، حيث يقود قراءه، عبر مناطق يدرسها، أو يكون قد منحها تنوير معالم معينة، ليحسن التحرك، في مسالك وممرات بوصفها آمنة، بغية الوصول إلى ما هو منشود من قبل قرائه باعتبارهم ساعين إلى الأمان، يمضي بهم، دون أن يبلغوا الجهة المنشودة، وفي الرواية طمأنة مرفقة بالمتعة حين قراءتها، أن هناك ما يهم قراءه، والوصول الممكن إبرازه يكون مع الانتهاء من قراءة الرواية، وما معايشة المقروء منها، إلا اكتشاف هؤلاء القراء وقد ركبوا المخاطر، ما كانوا ينشدونه، ليكونوا هم أنفسهم مهرّبين لغيرهم، وقد أوقِع بهم ، حيث يمكنهم إثر القراءة أن يتعرفوا على ما لم يكن معروفاً لهم من قبل داخلهم.
وفي الحيوان أمثولة، لطالما انشغلنا بها، لطالما كان يثير متخيلنا الجماعي " في الحكايات والأقوال المأثورة، وما يشار إليه طقوسياً " تعبيراً عما هو طقوسي. الطقوسي معايشة للموت، للحصول على حياة أكثر إمتاعاً للروح !
وفي ذلك نكون قد جاهرنا بما يستقر داخلنا، ما يكونه مجهولنا، وهو معلوم دون التحدث في أمره صراحة.
ويظهر أن الحيوان يتصدر واجهة اهتمامات المعنيين بالكائن الحي حديثاً، جرّاء التحولات العاصفة في عالم اليوم، على أكثر من صعيد: اجتماعي، سياسي، وثقافي. وللحيوان مأثرته الاستثنائية. لقد أصبح لمعلومه الذي كان مجهولاً، أو طي المجهول، لأكثر من سبب، تنام ٍ في رصيده الاعتباري، بمقدار ما اقترب من اسم العلَم في تنوير عالمه.
أتراه فكَّ ارتباط من قبل الإنسان " خليفة الخالق في الأرض " بين ما كان يُثنى عليه، ويعرَّف به امتيازاً له: عقله، وما كان خفياً، مغيَّباً، معتَّماً عليه داخله، جهة تميّزه بعنف ليس في مقدور أي حيوان مجاراته به ، ومن نوعه الغريب؟
أهي قيامته على تلك النوعية الكائنية فيه، في ضوء ما تبيَّن له من تعددية أدوار لتدمير الطبيعة: بما فيها وما عليها، وإزاء بني جنسه بالذات، ليبرز نقيض ما أؤتمن عليه في بناء الكون، وها هو يهدد الكون بكل عوالمه: تفكيراً وتدبيراً؟
أوليس الحديث عن الحيوان، خروجاً من الذات إليها، في لحظة تجلّ لهذا الخفي الحميم، الذي يعلّمنا بما لم نعلَم بعد ؟
ربما كان التوأم الحيواني: الحمار والكلب، كما هو التصنيف الكائني الوسيط والسائد" بين الإنسان والنبات " من بين أكثر التوائم الحيوانية، إن لم يكن أهمها وأبرزها، تصدراً لواجهة الاهتمامات الثقافية، الفنية والأدبية، وللرواية مقامها الرفيع في ذلك. إن كل حديث مرفوع إلى جانب من رواية. غير أن الرواية تنوع في الحديث، وصوغ لعالم يعرَف باسمها.
وإن قلت " التوأم الحيواني " وبالتسمية، فليس لأن هناك قرابة جينية بينهما، وإنما لحضورهما الكبير فيما أشرت إليه ، انطلاقاً من روايتين صدرتا لكاتبين وناقدين سوريين، عن دار " خطوط وظلال – عمّان- الأردن "، وبحسب تاريخ النشر :"جمهورية الكلب- 2020 " لإبراهيم اليوسف، و" تحولات الإنسان الذهبي-2022 " لنبيل سليمان.

سيقال في الحال إن مجريات الأحداث العاصفة في سوريا، منذ عقد زمني ونيف، والدمار التسوناميوي الذي أتى على الحرث والنسل، والحبل على الجرار ، تكون وراء هاتين الروايتين، وسواهما، من الروايات التي تنتمي إلى هذه الأحداث المروعة والكارثية. ذلك ما يمكن تأكيده في الحال طبعاً. لأن الرواية لها شهادتها، ولها طريقة مختلفة عن كاتب التاريخ للتأريخ لها.الرواية، خلاف التاريخ، لا تلتفت إلى الماضي وتكتفي بسرد وقائعه، كما هو مسلك المؤرخ، إنما ما تكاد تنظر فيما كان، ومن زاوية عائدة إلى ذائقة الروائي، وقدرته على الإحاطة بما جرى ويجري، حتى سرعان ما تنظر إلى الآتي، والآتي البعيد، كما لو أنها تحيل تاريخاً بوقائعه، وأشخاصه، وكل المؤثر فيه والمتأثر به، إلى تاريخ كما لو أنه هو وليس هو، عبر ابتداع زمان آخر، ومكان آخر، وأسماء أخرى، قد تمتد في الزمان والمكان، وبأكثر من لغة، لحظة قراءة الرواية. الروائي، يحيل إليه جغرافية الحدث إليه،يعدِمها، ويستوفيها حقها من التشكل المغاير، ويطلق على كائناتها أسمائه، تبعاً لذائقته.
يكون الروائي نفسه هو وما لن يكون هو، وقد تلاشى نيرفانياً في كل حركة من روايته، وكما كتبها بأسلوبه الخاص.
وما سأتعرض له، هو أنني أكتب عن المشترك بينهما، في ضوء العنوان، ومن خلال معرفتي الخاصة بعالمهما، في قراءة لن تسمي أي شيء محدد في الروايتين : اسماً أو قولاً، إنما ما يكونه التلقي من خلال مؤشّر العنوان نفسه، وليس هناك من مقارنة، بمقدار ما يصل بينهما من هذا التنسيب الأدبي: الروائي .

المشهد الموحَّد لكل من الكلب والحمار:
ماالذي يصل ما بينهما؟ ثمة ما يلفت النظر، هو أنهما حيوانان، يجمعان في تكوينهما العضوي البرّي والأهلي.
هناك الكلب الأهلي، والكلب البرّي، وهناك الحمار الأهلي، والحمار البري: حمار الزرد!
في نطاق العنوان: يحضر القطيع من خلالهما: الكلب للحراسة والتنبيه إلى ما يمكن أن يجري ويهدد القطيع، بوجود الراعي، والحمار، للركوب، متنقلاً براعيه من مكان إلى آخر، إذ يتقدم القطيع لحظة التحرك !
القطيع من الخارج، والقطيع من الداخل: هناك وضع تخومي/ حدودي، حيث إن حركة أي جهة تستدعي الأخرى، وتحفّز على النظر فيها. وتبعاً لوضع القطيع يكون تحرك كل من الحمار والكلب.
طبعاً، علي أن أشدد على نقطة مفصلية في العلاقة مع الرواية عموماً، وهي أن الحديث عن الداخل، يستحضر الخارج، والعكس صحيح. إن لعبة الثنائي هنا، واقعاً مفتوحاً، ليس من فاصل جغرافي بينهما. إنها لعبة كتابية، تجاوباً مع حركية السرد القائمة على المفارقة، والمفارقة تعهد بالتداخل بين المتعارضات لاستجلاء الفاعل المشترك فيهما. والانتظار إلى ما يكون استقراراً وإقامة آمنة في المكان.
فالحمار والكلب خدميان: على الكلب أن يكون في كامل اليقظة حرصاً على سلامة القطيع وما هو مطلوب منه، وعلى الحمار أن يكون متهيئاً للتحرك أو يظل واقفاً، حيث يركبه راعيه، وبه يتحرك، وهو يتلفت هنا وهناك متابعاً القطيع وحركة الكلب بالمقابل. بالطريقة هذه، يكون الاثنان عنصري دعم قويين للراعي. يصبح القطيع شعباً، رعية في ذمة الراعي: الحاكم، والكلب في موقع ضبط القطيع، والحمار حامل ثقل الراعي، مأخوذاً بالصبر، والرعي ممثل السلطة .
لا يعود كلٌّ منهما، كما هو، كما هو أمر القطيع، كما هو الراعي نفسه. الكتابة هنا انزياح مجازي لتحقيق نصاب المعنى طبعاً. كما هي مديونية الكتابة التي تهبُ كاتبها ما يجيز له التحرك ساعة يشاء، وإلى أي جهة يشاء !
إنما ماذا أيضاً؟
على كل منهما تأكيد انتمائه إلى ما هو قطيعي، دون أن يكون منه، إنما أقرب إلى الراعي، وبجانبه وليس القطيع.
أي حيث يكون القطيع يتواجد الكلب والحمار، اللذان يفعّلان ماهية السلطة بعلامتها الرعيوية الفارقة، حيث يكون الكلب كلي اليقظة من قبل راعيه، في متابعة كل حركة قطيعية، والحمار هو متحمل ثقل الراعي: الحاكم.
وعلى كل منهما تأكيد انفصاله المؤكَّد مما يصله بالخارج، بما هو برّي أو " وحشي " وما يعنيه ذلك من انضباط هنا، وخروج عن الضبط والتنظيم بالمفهوم السياسي للسلطة .
كل كتابة إنباء عن قطيعية معينة، وللرواية سهمها الوافر، في تمثيل هذا الدور. إنها النظر إلى القمة من قعر الهاوية!
يعني أن على كل منهما إثبات أنه طوع تعليمات الراعي وتحت إمرته، وليس ما يصله بالخارج، وهذا يُتأكَّد بمقدار التفاني في خدمة الراعي، ومواجهة لكل رابطة بالآخر، بما انسلخ عنه .
الغوص في الشبهات:
في مكاشفة سجل كل منهما، ربما ليس هناك حيوان كان محور كتابات تمحورت حول الشأن السياسي والاجتماعي، وإدخال ما هو قيمي ورمزي، مثل هذين : الكلب والحمار!
ليس هناك من سُبَّة لها تاريخها، أكثر مما يوجَّه النظر إليهما، في العلاقة بين إنسان وآخر، عبْر التحقير:
يا كلب! يا حمار ! رغم أن سطوة التكليب أعنف وأوجع وأكثر إيلاماً، من خلال الموقع. من تجري كلبنته، يحال إلى تابع، أمَّعة، منزوعاً من كل قيمة.ومن تجري حميرته، يكون الإيلام أقل، لكن التحويل الدوني ساري المفعول. فالسبة تشير إلى محدودية الفهم . لكن الحالتين قد تستدعيان بعضهماً بعضاً. هل يمكن للكلب، كترمير أن يصبح حماراً، والحمار كلباً؟ ألا يمكن لأي كان، مثلاً، أن يتكلبن ويتحمير في الآن معاً، جهة الضعة والذل والإهانة؟ ألا تعود الكتابة في الحالة هذه تأريخاً للمذلة والإهانة والخفة التي يعيشها أحدنا روائياً. أن تؤرخ لواقعة كهذه، هو أن تؤبد الفاعل المذنب بنفاذ سلطته. الكتابة تفجير الصمت. إماطة اللثام عن الخفي!
حيث ليكون لكل منهما نصيبه المعتبَر مما يقلّل من موقعه الحيواني، في أدبيات الداب على اثنين:
الكلب وخاصية الذل والتبعية، والحمار، وخاصية الضعة ودونية المقام بالمقابل !
هذا يوجه أنظارنا إلى مغزى العنوان: راصدو القطيع، وهم الذين يتعقبون خطوط التحرك في محيط القطيع، وما يكونه القطيع دلالياً، أي يختصر الشعب في مفهومه البشري إلى ما هو دونه: رعيوياً، وعصا الراعي شاهدة على ذلك !
يحضر الكاتبان بروايتهما، حيث لم يكن بينهما من ميعاد، ليحدد كل منهما موضوعاً له، بالصيغة المأتي عليها، وفي فترة زمنية تقربهما من بعضهما بعضاً، رغم أن لكل منهما طريقته في الكتابة، وفي النظرة إلى " حيوانه "!
ومثلما أن ليس من علاقة قربى مباشرة، كما نوَّهتُ، بين كل من الكلب والحمار، أو بالعكس، إنما ليظهرا متناظرين، وفي " جعبة " كل منهما، الكثير الكثير، مما هو مدوَّن تاريخياً، ومشاع ومتردد على الألسنة هنا وهناك، سوى أن مصادفة ما، وهي ليست مصادفة، على وقْع ما جرى في المنطقة عموماً، وفي سوريا خصوصاً من ملمات وفظائع، ليكونا مطلوبين، لأن ليس هناك أي حيوان آخر، يمكن الإشارة إليه، والتأكيد على أنه قادر على تمثيل هذا الدور، بمفهومه الفني .
يأتي الكاتب والمتفتح بكامل قواه الجسدية، وهو يرى، كما يسمع، كما يتنبأ بكامل جسده، من صلب موضوع معين، وليد واقع معين، وباعتبار معين، متجهاً بما يحرر قواه الجسدية من مرجعيته الفيزيائية إلى ما هو متاح تخيلياً، وما ليس رفي مقدور أي كان بسهولة، مكاشفة الخفايا وما يترتب عليها في زاوية كاملة. ليكون القطيع في وضع كهذا حاضراً بأدبياته الكبرى، وهو مستحدث هنا، وفي ضوء القراءة المسبارية، حيث يكون الكلب والحمار مراهناً عليهما. الرواية نفي للقطيعة حتماً !
وحده الكاتب المقتدر، من يستطيع تحرير حيوانه مما هو متحيَون فيه، وفك أسره مما هو عُرفي، تقليدي، طقوسي، أبعد بكثير، مما هو متداول في نطاق " كلية ودمنة "، وما يخص به الإنسان حيوانه، وهو أسير متخيله المتعالي، والخاضع لتصور ثقافي، مساق فنياً، يحيل عبره إلى ما يعنيه، وما يشكله هذا " التكليف " من تحريف لخصوصية حيوانه المسمى هنا، وقد جرّد من كائنيته مرتين: لحظة استدراجه إلى " نطاق ما يريد تحميله به، دون السؤال عن عنف هذا التحميل، أو مراعاته، وهو مجرَّد من كل قوة " ولحظة منحه لساناً ليس لسانه، وتعبيراً من بنات خياله، ليس من نوعه، وما في ذلك من مراوغة، وإشهار لنفاذ سلطته، ليظل هو الآمر الناهي، وعند انتهاء" المهمة " يحيْونه كما هو، وكما يرى " مالكه "!
إضاءة المشهد الحيواني:
من خلال العنوانين، نكون إزاء إقصاء الإنسان عن الرسالة، رسالته المزعومة في بناء الكون، وتحرير الحيوان من الإحالة، إحالته إلى ما ليس له أو فيه . العنوانان يقومان على مساءلة الترميز، والترميز التفاف أدبي على الواقع، مع فارق القرب والبعد. إنها اللعبة الساخنة للمجاز بكل حمولته الدلالية. بخصوص " جمهورية الكلب " ثمة تصعيد بالحدث، وتفجير للمعنى: كيف تكون جمهورية الكلب، والكلب أبعد ما يكون هذا عن الإضافة اللافتة هذه. في " تحولات الإنسان الذهبي " يتطلب العنوان منا بعضاً من الوقت، جهة قراءة الرواية، لمعرفة بنية العنوان.
في الحالة هذه، ثمة تحويل انعطافي في العلاقة: لم يكن للكلب من جمهورية، وهو المعروف بنوعه الحيواني، لكن مفردة الجمهورية تقلق المتصور في حقيقة أمره، وتدفع بالمتخيل إلى ما لم يحصل هذا من قبل: الكلب تأنسن، أو أعطيَ مقام الإنسان، ليكون هناك المزيد من السرد التنويري، وبالكم اللافت من المفارقات. تصوروا لو أننا وضعنا مفردة أخرى بدلاً من " جمهورية " مثل" مدينة الكلب " أو " أرض الكلب "، أو " لعبة الكلب " أو " رهان الكلب "...إلخ، لكان المعنى مختلفاً تماماً، إن ثقل الاسم ببادئته يمنح الرواية طاقة تحرك وإثارة لقارئها .
بصدد العنوان الآخر: تفصح القراءة وبعد جولات وصولات، بما يتناسب والعالم الواسع للحمار في مأثوراته، وحكاياته، وضروب أمثاله، حال الكلب، وفي مناحيَ أخرى، يصبح الحمار إنساناً. وفي هذا تكون ضربة معلَّم من جهة الروائي نبيل سليمان. إذ إن المعروف هو ما يقابل الإنسان بالإنسان: النسخ، الإنسان بالحيوان: المسخ، الإنسان بالنبات: الرسخ، الإنسان بالجماد: الفسخ. أما أن يتحول الحيوان إلى إنسان، وهو بكامل عافيته ومضاء أثره، فليس من صفة دالة عليه. بذلك تكون رواية الحافة الخطرة، إزاء واقع مأخوذ بالهاوية المميتة.
إزاء ذلك، لم يحصل أن كان للكلب جمهورية، كما هو المأخوذ في رواية إبراهيم اليوسف. لم يحصل أن قدَّم الحمار إنساناً ليكون شاهد عليه بالفبركة الفنية هذه .
هنا تكون الجريمة المشتركة بينهما، فيما حاولا تخيله، ومن ثم كتابته في ضوء هذين الحيوانين المنمذجين!
ولكل منهما سابق معرفة عما تردد باسمهما كليهما، ويتردد من خلالهما، حيث يشار إلى الإنسان وهو يستحمر، ويتحمير، ويحمير سواه، في سلوكيات مختلفة، مثلما أنه يعيش كلبية الحالة، الفكرة والمغزى " لنتذكر الكلبيين: حرّاس الفضيلة فلسفياً لدى اليونان "، لنتذكر الإنسان حين يتكلبن، ويستكلب، حين يستنبح، ويشوش على الكلب نفسه مضلاً من هو في الجوار، لغاية في نفسه ...!
أي ما تكون عليه أنسنة الحيوان، في حكم المقبول، لوجود تاريخ طويل له، وما تكون " حيونة " الإنسان في حكم المستفسَر عنه، عما جرى من مستجدات، وما يمضي بنا في نطاق الانعطافة التاريخية الكبرى، لا بل وحتى الاستثائية .
كيف تأتَّى ذلك؟ هناك أرشيف كامل في الروايتين، جهة أدوار كل منهما، على أصعدة مختلفة، وفي أزمنة وأمكنة مختلفة ، وما في ذلك من بحث وتنقيب، ليكون بعد ذلك، فعل البناء والتطويب الروائيين !
أعني بذلك، أن الذي تجمَّع لدى كلا الكاتبين، هو هذا الإثراء الحيواني، وبتعددية المواقع، ليجري التصنيف والتوصيف، وليحسن كل منهما، التصرف بمادته الأرشيفية، وقد آن أوان مباشرة كتابة الرواية، وصهر معلوماته في جسدها الفني!
طبعاً، يبقى الجدير بالذكر، وهو اختلاف الرقعة الجغرافية التي تتنفس فيها رواية كل منهما. والمقدرة على تحريك الشخصيات بالمقابل. حيث لا يُنسى موقع الروائي والناقد نبيل سليمان، وهو في كثافة قراءاته، ومكاشفاته النقدية لنصوص روائية مختلفة، إلى جانب قراءات أخرى: سياسية واجتماعية، وهو متوئم الكتابة: الرواية والنقد، وهو حيث يقيم في قريته " البودي " أو في اللاذقية السورية " طبعاً "، وما حاول الكاتب والباحث إبراهيم اليوسف أن يخوض غماره وهو في كتابة الرواية، وقد عرِف عنه شاعراً بداية، وكتابة نصوص تجمع بين الأدبي والسياسي، منوعاً في كتابته، وبعد استقراره في المغترب: ألمانياً خصوصاً !
هذا التصعيد في الموقف، ثمة ما يسوّغ له، في ضوء الجاري عالمياً، وفي المنطقة بصورة خاصة.
في مقدور أي قارىء، وبسهولة، تحري التناص في لعبة الرواية مباشرة، وبعد قراءة متأنية لكل رواية، وهي في تعقيدات بنيتها، تعقيد الواقع نفسه، جهة الكلب، رغم ندرة الشبيه التليد" جمهورية أفلاطون "، ولكنها التسمية المأخوذة بطابعها الفلسفي، في يوتوبيا الفيلسوف اليوناني. أما أن تكون " جمهورية الكلب " فانفصال تام عن كل ما يمكن التذكير به. في حال تحولات الإنسان الذهبي، تتدفق عناوين وإحالات هنا، رغم وجوب التدقيق في السرد المتشعب بخيوطه: تحولات الحمار الذهبي لأبوليوس، تحولات كافكا، وتحولات أدونيس...إلخ. إنما هناك فسخ لكل علاقة بين هذه العناوين والدعاوى التي يمكن أن تقام لتثبيت رابطة معينة، ورواية سليمان. فالحمار صار في مقام الإنسان، وليس أي إنسان. إنه الإنسان الذهبي، الحمار كاتباً، كما هو حال كارم أسعد، الناطق باسم الحمار، ومتجاوزه. يا للرهبة !
ما ليس في المعهود، يترجم ما ليس معقولاً مما جرى، وقد نسف كل ما له نسَب من المعقول. وبالتالي، فإن التمحور حول الحيوان، بالصيغة الأي عليها روائياً، هو أن الذي عهِد به إلى الحيوان، ليكون إنساناً، في حال رواية سليمان، سوف يفجّر كل شيء، جهة تعريته، فما كان الإنسان يقوم به، من خلال أنسنة الحيوان، هو أن يقوّله، كما يشتهي، هو أن يمرّر عبره ما يريد الإبلاغ عنه، دو أن يستطيع ذلك، وهو في حالته الطبيعية، وما هو معرَّف به، جهة الحيوان والذي صار إنساناً، هو أن ينسف الحدود المألوفة، أن يقول في الإنسان " حامل رسالة " ما سبق أن مارسه فيه على مر آلاف السنين، ولا يتحفظ على أي سر، وما يترتب على هذا الإجراء من تأكيد مقولة: نهاية الإنسان " سيد الكوَّن".
لم تعد الحياة تطاق! هكذا تقول الروايتان، وكما أرى. يا للإقرار الموقَّع عليه وهو المحال عليه بحكم "الغد"!
لا تعود الرواية قابضة على سر دون آخر، إنما الرواية التي أعطِيت صلاحية التحدث في كل مستوى، لأن الذي يجري، لا قِبَل للكائن الحي به، وفي " شخص " الحمار الشاهد التاريخي على " جرائم " الإنسان، وما أكثرها، يترجم ما يمكن أن يحصل تالياً وعن قريب، والحمار الصائر إنساناً، هو الحمار نفسه الذي يمتلك المقدرة الكاملة على الجمع بين المشرق والمغرب، جهة القواسم المشتركة، والتي تؤكد نوع العنف المعمَّد والمعزَّز من قبل الإنسان للإنسان وضد الإنسان .
في حال " كلب " اليوسف، نحن إزاء معايشة من نوع آخر، ومن متابعة تجارب حية ومأساوية، بين الشرق والغرب، وفي مكانة الكلب في كل من الشرق والغرب بأسلوب مختلف، وبين ما كان عليه تاريخياً، وما هو عليه راهناً .
في النظرة إلى الكلب، ينقسم العالم على نفسه، بمقدار ما ينقسم ما الإنسان بدوره على نفسه. فلا يعود الكلب مفهوماً برزخياً في الفصل بين الشرق وما يعرَف به من انتهاكات لحقوق الإنسان، ولحقوق الحياة في عمومها، ومن خلاله بالذات: عالم الكلب المميَّز بالنجاسة والدونية والنفور شرقياً، والغرب، وعالمه المميَّز باللطف والوداعة والطيب كذلك غربياً، وعلى إثر المتفجر في سوريا، والأعداد الهائلة والمرعبة للمهاجرين ممن تركوا كل شيء وراءهم طلباً للحد الأدنى من الأمان .
لكل من الحمار والكلب الدور الذي يجسّده جمعياً، ويضيء به عالماً بكامله. وليس من حدود فاصلة بينهما:
اليوسف يجمهر تلك المعلومات ذات الدلالات المختلفة وما يترتب عليها من علاقات متباينة في قيمتها إنسانياً، أي حيث يقف الإنسان جرّاء ذلك على حافة هاوية مميتة، والسؤال عما يمكن أن يحصل تالياً، وسليمان، الذي أسلس لحماره القياد، وقد برز في هيئة إنسان في أتم عافيته وفطنته وحيويته، ليصل ما بين أمكنة كثيرة، يُدعى إليها، ليتحدث عما يعني الحمار، في سياقات اجتماعية وثقافية مختلفة، ليشهّر في الإنسان الذي استدعاه ليقوّله فيما ليس له " حافر " فيه، وما في ذلك من لزوم " شد الحزام " في واقعة حمْيرية غير مسبوقة كهذه .
في الرواية جهةَ الاسم، ثمة تفريق ما بين طريقتها وحقيقتها:
طريقتها هي فيما يخرج منها " إنه الأسود الذي تخرج منه كل الألوان "، حيث التعبير بأسلوب معين.
حقيقتها، فيما يتعداها، ويصب فيها ولا يحاط بها. لقد حللنا في الأبيض الذي يغيّب كل الألوان، وعلى قارىء الرواية أن يغوص في بحر الألوان باحثاً عما يثيره لونياً دون أن يراه مباشرة، وذلك هو دوره المنتظر منه.
تحضر النظرية النسبية، بكل حيويتها وحكمة المعنى فيها، وهي أن تتلمس في الرواية، في " حيونتها " ما يمكنك إيجاده، والتفاعل معه، في الحدود النسبية لخاصية الكشف القرائية، أي حيث تكون القراءة أكثر عمقاً وأفقاً، ذلك أن ليس للرواية- أصلاً- من عنوان، هذا إذا اعتبرنا عنوانها الذي يشير إليها هنا وهناك، إذ يكون ذلك إجراء تمييزياً لها، عنوانها فيما يقوم به قارئها، دون أن يكون ذلك إعلاماً موجهاً لكاتبها، في الحقيقة المعتبرة بالمطلق. وكما هو الاسم الذي يطلق على مجهول الاسم. حيوان الرواية هو رهان كاتبها، وليس الشخص الذي يكون له اسمه الثلاثي ( سليمان- اليوسف، هنا)، والذي يتفعل في أسماء شخوصه، وبمقدار هذا التفعيل تكون شهادة الرواية على أنه الاسم المقدَّم على وجوده المحلي، المحدود، الآني، والماضي به إلى حيث يكون اللامحدود.
بالطريقة هذه. كل رواية مقاضاة لجريمة، أو أكثر، يرتكبها كاتبها، وهي مفتوحة. والجرائم منازل متباينة، وليس من إصدار للحكم بحق الروائي " مرتكب الجريمة ". لأن ما يأتي منه يخرج على المألوف. والخروج عصيان. إنه المكر المعتمد والمتعمَّد من قبله، واعتماد الخديعة من خلال متخيله، وبذلك لا يشبهه إلا ذاته، وهو في خروجه عن القطيعية !
كلٌّ ينطلق من خبرات خاصة به، ومن مؤشرات الأبلغ في إيصال المعنى، ويا له من صادم لمن هو غافل عما يجري .
قائمة الخبرات هذه لا تُخَندق الرواية هذه أو تلك، بمقدار ما تلغي الحدود أمام كاتب النص الإبداعي، كما لو أننا في عالم جورج أورويل، ورواية " 1984 " ورعب المتخيل، وهو الترجمان الموسَّع لما كان يجري ويتغير في الواقع .
الرواية بالطريقة هذه، تتخلى عن كل تعهد، بما يمكنها قوله، وما يمكنها الكف عن البت فيه، أو التلميح إليه، حيث الواقع متشظّ، في عالم انفجار السرد، وتنحية مفهوم الشخصية الرواية بقالبها السائد جانباً، والرهان على المجهول، لتكون في ضوء هذه الاعتبارات القادرة على أن تعدم في بنيتها كل ما عرِفت به سابقاً، كرمى ما هو متخوَف منه، وهو الذي يكون من شأنه الصريح بحقيقة كونها رواية، وإشهار لامتناهي ولاداتها، واستشرافها على متاهة هي إشعار بقائها تالياً !
في التقابل بي التاريخ والرواية ثانية جهة الحديث عن الفظائع والجرائم المرتكبة في الحروب الداخلية والخارجية، من الصعب جداً إن لم يكن مستحيلاً، الحديث عن تاريخ ينصف في وقائعه، إنه جانبي، بصورة ما، كما هو المتداول هنا وهناك، إنما في الرواية، تكون العلاقة مختلفة. إن عظمة الرواية هي في مقدرتها على تصوير أهوال الحرب والاقتتال الجانبي. وفي التاريخ يكون التخوف من عملية النقل الدقيقة لأهوال الحرب ومشاهد القتل والخراب والعنف، بينما في الرواية، فإنه بمقدر ما تكون هناك جماليات الرعب والقتل والعنف والعنف المميت فنياً، تعزز الرواية مكانتها .
على الصعيد الحيواني، وجِهة صلة الإنسان بالحيوان، لا أحد يشتهي أو يرغب في أن يصبح حيواناً، منفصلاً عن بني جنسه كلياً. لا أحد على الإطلاق. وليس كاتب السطور هذه، بمستثنى مما تقدم. إن من لا يصلح لبني جنسه، لا يمكنه أن يكون صالحاً حين يرغب في التحول. وفي الكتابة أو الفن، العملية مختلفة في التمثيل الرمزي. ثمة تعرية هنا، انتظار ما لا يُنتظَر إلا في الرواية، للحيلولة دون وقوع ما لا يراد له أن يقع. الرواية لا تسمي أحداً لهذا يعطى لها اسمها الفعلي. لكنها تضيء جريمة في الجوار، أو أكثر، وهنا تكون خطورتها المجازة وباقتدار!
في نطاق الرواية التي يكون الحيوان خميرتها، ثمة عجينة يعدّها كاتبها، بغية إبراز ما يغفَل عنه، في تربية الوجدان.
وعلى صعيد المكاشفة التاريخية لما يجري، لا بد أن كاتب الرواية مصاب بعسر هضم ثقيل الوطء، بتسمم الواقع جرّاء التدقيق في حيثياته، وما كتابته لرواية من هذا القبيل، إلا محاولة الالتفاف عليه، وليسمَع بصمته الهادر داخلاً طبعاً.
يكون حيوانه مبرّرَه فيما يلجأ إليه، ضبط مخالفة لواقع لا أمرَّ منه، لعجزه عن القيام بأي ردع، وقد أودعه كتابته !
يشار إلى أن جيل دولوز قد أبان عن صحارى ووحوش تستبطن الإنسان، وما يعنيه ذلك عن أن الإنسان مفارق لحقيقة تكوينه وما يجب عليه القيام به في ردة نوعية على نفسه وفيها ليستطيع رؤية الهوة العميقة داخله، ومعرفة مدى الخلل المريع في نفسه وعقله . أي ما يتعلق بتلك الديون الرمزية لجملة" الوحوش " في ذمته، كي يتمكن من سلوك الطريق الصحيح، وبالتالي، فإن الفظائع التي يرتكبها، وهي في تراكمها لا تحصى، دون ذلك، لما كان هذا النذير النفير !
إننا إزاء فتح محضر ضبط وهو لا ينغلق ما بقيت الحياة، وتدوين حساب قيمي: في الفارق الكبير بين الإنسان والحيوان، هو أن الحيوان مذ كان وهو يحافظ على وجوده الحيواني ويعرف من خلال غريزته. إنها طبيعته التي يحمل مأثرتها طول بقائه في الحياة، والإنسان الذي أدخل في حسابه ما ليس له، تشبيهاً وتمثيلاً، إرضاء لغروره، كما لو أنه طوع أمره، ونسي أو تناسى ما هو فيه وعليه غريزة وعقلاً، وقد تداخلا، فلا هو المأخوذ بالغريزة، كما يقول تاريخه، ولا هو احتمى بالعقل، ليعرف حدوده وحدود سواه من الكائنات الأخرى، ليصبح في تيه مهلك، ومسيء إلى غيره، تيه هو صنيع صورته لذاته .
إننا إزاء وضع إنساني متفجر،وهو رهان الرواية، ورهان الرواية يتوقف على كيفية إبراز جماع مقومات الإبداع داخلها.
خلاف الجاري في الواقع، يتنكر الروائي دائماً لاسمه، لجمله أسمائه في كتاباته السابقة، حيث تتم معايشة شخصيات ورقية من نوع آخر. إن المغايرة نبوءة محتفىً بها.
الحروب في الحالة هذه تدمر، وتشكل مادة غزيرة ومحفزة للمؤرخ، وهو يعتمد على خاصية الإسناد في روايته، مكاناً وزماناً، ولا بد أنها تكون مروّعة في تدوين وقائعها، لكن الرواية تستعذبها، لتحسن نسج نصها، وجمالية القبح بعض ن مآثرها، والإسناد الوحيد هو المعهود به إلى متخيله، وبذلك يسلم الروائي من كل عقاب، وهو يشد هنا وهناك، أن ليس من صلة نسب بين أي واقعة في روايته، وما يُعتقَد أنه إفصاح عنها. إنه نزيل عالمه الذي يبتدعه في روحه.
في بنية كتابة الرواية " الكلبية- الحميرية " ثمة الواقع، ولكنه المحرَّر مما هو فيه، وإلا لانتهى أمر كتابة الرواية، وقد دفع كاتبها ثمناً غالياً ولا يسدَّد أبداً، طالما أنها تتنفس ووجهتها الآتي، والتمثيل الحيواني، هو أعلى درجات التمثيل في الرواية في ضوء خراب الواقع، لتتوقف نباهة القراءة بحرفيتها النقدية على مكاشفة مفتوحة لمغذيات متخيل الروائي.
في كل من " جمهورية الكلب " لليوسف، و" تحولات الإنسان الذهبي " لسليمان، ثمة ما يمكن قوله، دون أن أشير إلى عبارة بحرفيها أترك التنقيب في بنيتها وهي موصولة إلى المؤثر في الروايتين:
إنهم لا يستطيعون تمثيل أنفسهم، لا بد أن يُمثَّلوا !
المتمثّل بالقول هنا، يكون كل من الكلب والحمار، أو بالعكس، لحظة الانتهاء من روايتهما. متى تكون اليقظة؟
هذا الدساس بما يبتدعه في كل شيء، منتهك الحرمات، اللامؤتمن على سر ، اللعوب، المخادع، باعث الإرباك في النفوس، زير الحياة، السابر لها في العمق، الذي يثير الشبهات في كل ما حوله، مانحاً لكل شيء، ما يخرجه من شيئيته، الطارد لكل ما هو مقلق لسواه والطريد من خلال ما يكتب، وملتبس عليه بطريقه، إيماناً منه أن الصمت قرين الموت. إنه يكتب كرمى حياة غير معهودة. هوذا الروائي. المهرّب الغريب من نوعه، في تكوينه في اللحظة التي وقْع عقداً أبدياً، وهو مأخوذ بالكتابة، لأن الذي يقبل على تناوله هو استشراف حياة وموت، لكنه سعي إلى حياة أخرى، ولهذا يكون المهرّب المغاير لأي مهرب آخر، كما هو معروف باسمه وصفة عمله حديثاً، حيث يقود قراءه، عبر مناطق يدرسها، أو يكون قد منحها تنوير معالم معينة، ليحسن التحرك، في مسالك وممرات بوصفها آمنة، بغية الوصول إلى ما هو منشود من قبل قرائه باعتبارهم ساعين إلى الأمان، يمضي بهم، دون أن يبلغوا الجهة المنشودة، وفي الرواية طمأنة مرفقة بالمتعة حين قراءتها، أن هناك ما يهم قراءه، والوصول الممكن إبرازه يكون مع الانتهاء من قراءة الرواية، وما معايشة المقروء منها، إلا اكتشاف هؤلاء القراء وقد ركبوا المخاطر، ما كانوا ينشدونه، ليكونوا هم أنفسهم مهرّبين لغيرهم، وقد أوقِع بهم ، حيث يمكنهم إثر القراءة أن يتعرفوا على ما لم يكن معروفاً لهم من قبل داخلهم.
وفي الحيوان أمثولة، لطالما انشغلنا بها، لطالما كان يثير متخيلنا الجماعي " في الحكايات والأقوال المأثورة، وما يشار إليه طقوسياً " تعبيراً عما هو طقوسي. الطقوسي معايشة للموت، للحصول على حياة أكثر إمتاعاً للروح !
وفي ذلك نكون قد جاهرنا بما يستقر داخلنا، ما يكونه مجهولنا، وهو معلوم دون التحدث في أمره صراحة.
ويظهر أن الحيوان يتصدر واجهة اهتمامات المعنيين بالكائن الحي حديثاً، جرّاء التحولات العاصفة في عالم اليوم، على أكثر من صعيد: اجتماعي، سياسي، وثقافي. وللحيوان مأثرته الاستثنائية. لقد أصبح لمعلومه الذي كان مجهولاً، أو طي المجهول، لأكثر من سبب، تنام ٍ في رصيده الاعتباري، بمقدار ما اقترب من اسم العلَم في تنوير عالمه.
أتراه فكَّ ارتباط من قبل الإنسان " خليفة الخالق في الأرض " بين ما كان يُثنى عليه، ويعرَّف به امتيازاً له: عقله، وما كان خفياً، مغيَّباً، معتَّماً عليه داخله، جهة تميّزه بعنف ليس في مقدور أي حيوان مجاراته به ، ومن نوعه الغريب؟
أهي قيامته على تلك النوعية الكائنية فيه، في ضوء ما تبيَّن له من تعددية أدوار لتدمير الطبيعة: بما فيها وما عليها، وإزاء بني جنسه بالذات، ليبرز نقيض ما أؤتمن عليه في بناء الكون، وها هو يهدد الكون بكل عوالمه: تفكيراً وتدبيراً؟
أوليس الحديث عن الحيوان، خروجاً من الذات إليها، في لحظة تجلّ لهذا الخفي الحميم، الذي يعلّمنا بما لم نعلَم بعد ؟
ربما كان التوأم الحيواني: الحمار والكلب، كما هو التصنيف الكائني الوسيط والسائد" بين الإنسان والنبات " من بين أكثر التوائم الحيوانية، إن لم يكن أهمها وأبرزها، تصدراً لواجهة الاهتمامات الثقافية، الفنية والأدبية، وللرواية مقامها الرفيع في ذلك. إن كل حديث مرفوع إلى جانب من رواية. غير أن الرواية تنوع في الحديث، وصوغ لعالم يعرَف باسمها.
وإن قلت " التوأم الحيواني " وبالتسمية، فليس لأن هناك قرابة جينية بينهما، وإنما لحضورهما الكبير فيما أشرت إليه ، انطلاقاً من روايتين صدرتا لكاتبين وناقدين سوريين، عن دار " خطوط وظلال – عمّان- الأردن "، وبحسب تاريخ النشر :"جمهورية الكلب- 2020 " لإبراهيم اليوسف، و" تحولات الإنسان الذهبي-2022 " لنبيل سليمان.

سيقال في الحال إن مجريات الأحداث العاصفة في سوريا، منذ عقد زمني ونيف، والدمار التسوناميوي الذي أتى على الحرث والنسل، والحبل على الجرار ، تكون وراء هاتين الروايتين، وسواهما، من الروايات التي تنتمي إلى هذه الأحداث المروعة والكارثية. ذلك ما يمكن تأكيده في الحال طبعاً. لأن الرواية لها شهادتها، ولها طريقة مختلفة عن كاتب التاريخ للتأريخ لها.الرواية، خلاف التاريخ، لا تلتفت إلى الماضي وتكتفي بسرد وقائعه، كما هو مسلك المؤرخ، إنما ما تكاد تنظر فيما كان، ومن زاوية عائدة إلى ذائقة الروائي، وقدرته على الإحاطة بما جرى ويجري، حتى سرعان ما تنظر إلى الآتي، والآتي البعيد، كما لو أنها تحيل تاريخاً بوقائعه، وأشخاصه، وكل المؤثر فيه والمتأثر به، إلى تاريخ كما لو أنه هو وليس هو، عبر ابتداع زمان آخر، ومكان آخر، وأسماء أخرى، قد تمتد في الزمان والمكان، وبأكثر من لغة، لحظة قراءة الرواية. الروائي، يحيل إليه جغرافية الحدث إليه،يعدِمها، ويستوفيها حقها من التشكل المغاير، ويطلق على كائناتها أسمائه، تبعاً لذائقته.
يكون الروائي نفسه هو وما لن يكون هو، وقد تلاشى نيرفانياً في كل حركة من روايته، وكما كتبها بأسلوبه الخاص.
وما سأتعرض له، هو أنني أكتب عن المشترك بينهما، في ضوء العنوان، ومن خلال معرفتي الخاصة بعالمهما، في قراءة لن تسمي أي شيء محدد في الروايتين : اسماً أو قولاً، إنما ما يكونه التلقي من خلال مؤشّر العنوان نفسه، وليس هناك من مقارنة، بمقدار ما يصل بينهما من هذا التنسيب الأدبي: الروائي .
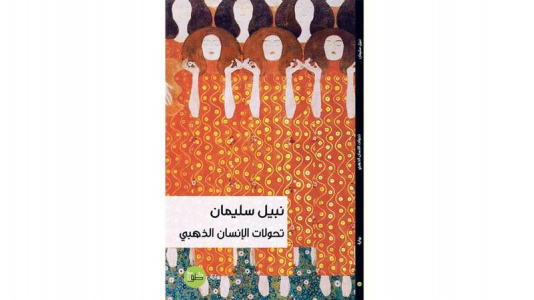
المشهد الموحَّد لكل من الكلب والحمار:
ماالذي يصل ما بينهما؟ ثمة ما يلفت النظر، هو أنهما حيوانان، يجمعان في تكوينهما العضوي البرّي والأهلي.
هناك الكلب الأهلي، والكلب البرّي، وهناك الحمار الأهلي، والحمار البري: حمار الزرد!
في نطاق العنوان: يحضر القطيع من خلالهما: الكلب للحراسة والتنبيه إلى ما يمكن أن يجري ويهدد القطيع، بوجود الراعي، والحمار، للركوب، متنقلاً براعيه من مكان إلى آخر، إذ يتقدم القطيع لحظة التحرك !
القطيع من الخارج، والقطيع من الداخل: هناك وضع تخومي/ حدودي، حيث إن حركة أي جهة تستدعي الأخرى، وتحفّز على النظر فيها. وتبعاً لوضع القطيع يكون تحرك كل من الحمار والكلب.
طبعاً، علي أن أشدد على نقطة مفصلية في العلاقة مع الرواية عموماً، وهي أن الحديث عن الداخل، يستحضر الخارج، والعكس صحيح. إن لعبة الثنائي هنا، واقعاً مفتوحاً، ليس من فاصل جغرافي بينهما. إنها لعبة كتابية، تجاوباً مع حركية السرد القائمة على المفارقة، والمفارقة تعهد بالتداخل بين المتعارضات لاستجلاء الفاعل المشترك فيهما. والانتظار إلى ما يكون استقراراً وإقامة آمنة في المكان.
فالحمار والكلب خدميان: على الكلب أن يكون في كامل اليقظة حرصاً على سلامة القطيع وما هو مطلوب منه، وعلى الحمار أن يكون متهيئاً للتحرك أو يظل واقفاً، حيث يركبه راعيه، وبه يتحرك، وهو يتلفت هنا وهناك متابعاً القطيع وحركة الكلب بالمقابل. بالطريقة هذه، يكون الاثنان عنصري دعم قويين للراعي. يصبح القطيع شعباً، رعية في ذمة الراعي: الحاكم، والكلب في موقع ضبط القطيع، والحمار حامل ثقل الراعي، مأخوذاً بالصبر، والرعي ممثل السلطة .
لا يعود كلٌّ منهما، كما هو، كما هو أمر القطيع، كما هو الراعي نفسه. الكتابة هنا انزياح مجازي لتحقيق نصاب المعنى طبعاً. كما هي مديونية الكتابة التي تهبُ كاتبها ما يجيز له التحرك ساعة يشاء، وإلى أي جهة يشاء !
إنما ماذا أيضاً؟
على كل منهما تأكيد انتمائه إلى ما هو قطيعي، دون أن يكون منه، إنما أقرب إلى الراعي، وبجانبه وليس القطيع.
أي حيث يكون القطيع يتواجد الكلب والحمار، اللذان يفعّلان ماهية السلطة بعلامتها الرعيوية الفارقة، حيث يكون الكلب كلي اليقظة من قبل راعيه، في متابعة كل حركة قطيعية، والحمار هو متحمل ثقل الراعي: الحاكم.
وعلى كل منهما تأكيد انفصاله المؤكَّد مما يصله بالخارج، بما هو برّي أو " وحشي " وما يعنيه ذلك من انضباط هنا، وخروج عن الضبط والتنظيم بالمفهوم السياسي للسلطة .
كل كتابة إنباء عن قطيعية معينة، وللرواية سهمها الوافر، في تمثيل هذا الدور. إنها النظر إلى القمة من قعر الهاوية!
يعني أن على كل منهما إثبات أنه طوع تعليمات الراعي وتحت إمرته، وليس ما يصله بالخارج، وهذا يُتأكَّد بمقدار التفاني في خدمة الراعي، ومواجهة لكل رابطة بالآخر، بما انسلخ عنه .
الغوص في الشبهات:
في مكاشفة سجل كل منهما، ربما ليس هناك حيوان كان محور كتابات تمحورت حول الشأن السياسي والاجتماعي، وإدخال ما هو قيمي ورمزي، مثل هذين : الكلب والحمار!
ليس هناك من سُبَّة لها تاريخها، أكثر مما يوجَّه النظر إليهما، في العلاقة بين إنسان وآخر، عبْر التحقير:
يا كلب! يا حمار ! رغم أن سطوة التكليب أعنف وأوجع وأكثر إيلاماً، من خلال الموقع. من تجري كلبنته، يحال إلى تابع، أمَّعة، منزوعاً من كل قيمة.ومن تجري حميرته، يكون الإيلام أقل، لكن التحويل الدوني ساري المفعول. فالسبة تشير إلى محدودية الفهم . لكن الحالتين قد تستدعيان بعضهماً بعضاً. هل يمكن للكلب، كترمير أن يصبح حماراً، والحمار كلباً؟ ألا يمكن لأي كان، مثلاً، أن يتكلبن ويتحمير في الآن معاً، جهة الضعة والذل والإهانة؟ ألا تعود الكتابة في الحالة هذه تأريخاً للمذلة والإهانة والخفة التي يعيشها أحدنا روائياً. أن تؤرخ لواقعة كهذه، هو أن تؤبد الفاعل المذنب بنفاذ سلطته. الكتابة تفجير الصمت. إماطة اللثام عن الخفي!
حيث ليكون لكل منهما نصيبه المعتبَر مما يقلّل من موقعه الحيواني، في أدبيات الداب على اثنين:
الكلب وخاصية الذل والتبعية، والحمار، وخاصية الضعة ودونية المقام بالمقابل !
هذا يوجه أنظارنا إلى مغزى العنوان: راصدو القطيع، وهم الذين يتعقبون خطوط التحرك في محيط القطيع، وما يكونه القطيع دلالياً، أي يختصر الشعب في مفهومه البشري إلى ما هو دونه: رعيوياً، وعصا الراعي شاهدة على ذلك !
يحضر الكاتبان بروايتهما، حيث لم يكن بينهما من ميعاد، ليحدد كل منهما موضوعاً له، بالصيغة المأتي عليها، وفي فترة زمنية تقربهما من بعضهما بعضاً، رغم أن لكل منهما طريقته في الكتابة، وفي النظرة إلى " حيوانه "!
ومثلما أن ليس من علاقة قربى مباشرة، كما نوَّهتُ، بين كل من الكلب والحمار، أو بالعكس، إنما ليظهرا متناظرين، وفي " جعبة " كل منهما، الكثير الكثير، مما هو مدوَّن تاريخياً، ومشاع ومتردد على الألسنة هنا وهناك، سوى أن مصادفة ما، وهي ليست مصادفة، على وقْع ما جرى في المنطقة عموماً، وفي سوريا خصوصاً من ملمات وفظائع، ليكونا مطلوبين، لأن ليس هناك أي حيوان آخر، يمكن الإشارة إليه، والتأكيد على أنه قادر على تمثيل هذا الدور، بمفهومه الفني .
يأتي الكاتب والمتفتح بكامل قواه الجسدية، وهو يرى، كما يسمع، كما يتنبأ بكامل جسده، من صلب موضوع معين، وليد واقع معين، وباعتبار معين، متجهاً بما يحرر قواه الجسدية من مرجعيته الفيزيائية إلى ما هو متاح تخيلياً، وما ليس رفي مقدور أي كان بسهولة، مكاشفة الخفايا وما يترتب عليها في زاوية كاملة. ليكون القطيع في وضع كهذا حاضراً بأدبياته الكبرى، وهو مستحدث هنا، وفي ضوء القراءة المسبارية، حيث يكون الكلب والحمار مراهناً عليهما. الرواية نفي للقطيعة حتماً !
وحده الكاتب المقتدر، من يستطيع تحرير حيوانه مما هو متحيَون فيه، وفك أسره مما هو عُرفي، تقليدي، طقوسي، أبعد بكثير، مما هو متداول في نطاق " كلية ودمنة "، وما يخص به الإنسان حيوانه، وهو أسير متخيله المتعالي، والخاضع لتصور ثقافي، مساق فنياً، يحيل عبره إلى ما يعنيه، وما يشكله هذا " التكليف " من تحريف لخصوصية حيوانه المسمى هنا، وقد جرّد من كائنيته مرتين: لحظة استدراجه إلى " نطاق ما يريد تحميله به، دون السؤال عن عنف هذا التحميل، أو مراعاته، وهو مجرَّد من كل قوة " ولحظة منحه لساناً ليس لسانه، وتعبيراً من بنات خياله، ليس من نوعه، وما في ذلك من مراوغة، وإشهار لنفاذ سلطته، ليظل هو الآمر الناهي، وعند انتهاء" المهمة " يحيْونه كما هو، وكما يرى " مالكه "!
إضاءة المشهد الحيواني:
من خلال العنوانين، نكون إزاء إقصاء الإنسان عن الرسالة، رسالته المزعومة في بناء الكون، وتحرير الحيوان من الإحالة، إحالته إلى ما ليس له أو فيه . العنوانان يقومان على مساءلة الترميز، والترميز التفاف أدبي على الواقع، مع فارق القرب والبعد. إنها اللعبة الساخنة للمجاز بكل حمولته الدلالية. بخصوص " جمهورية الكلب " ثمة تصعيد بالحدث، وتفجير للمعنى: كيف تكون جمهورية الكلب، والكلب أبعد ما يكون هذا عن الإضافة اللافتة هذه. في " تحولات الإنسان الذهبي " يتطلب العنوان منا بعضاً من الوقت، جهة قراءة الرواية، لمعرفة بنية العنوان.
في الحالة هذه، ثمة تحويل انعطافي في العلاقة: لم يكن للكلب من جمهورية، وهو المعروف بنوعه الحيواني، لكن مفردة الجمهورية تقلق المتصور في حقيقة أمره، وتدفع بالمتخيل إلى ما لم يحصل هذا من قبل: الكلب تأنسن، أو أعطيَ مقام الإنسان، ليكون هناك المزيد من السرد التنويري، وبالكم اللافت من المفارقات. تصوروا لو أننا وضعنا مفردة أخرى بدلاً من " جمهورية " مثل" مدينة الكلب " أو " أرض الكلب "، أو " لعبة الكلب " أو " رهان الكلب "...إلخ، لكان المعنى مختلفاً تماماً، إن ثقل الاسم ببادئته يمنح الرواية طاقة تحرك وإثارة لقارئها .
بصدد العنوان الآخر: تفصح القراءة وبعد جولات وصولات، بما يتناسب والعالم الواسع للحمار في مأثوراته، وحكاياته، وضروب أمثاله، حال الكلب، وفي مناحيَ أخرى، يصبح الحمار إنساناً. وفي هذا تكون ضربة معلَّم من جهة الروائي نبيل سليمان. إذ إن المعروف هو ما يقابل الإنسان بالإنسان: النسخ، الإنسان بالحيوان: المسخ، الإنسان بالنبات: الرسخ، الإنسان بالجماد: الفسخ. أما أن يتحول الحيوان إلى إنسان، وهو بكامل عافيته ومضاء أثره، فليس من صفة دالة عليه. بذلك تكون رواية الحافة الخطرة، إزاء واقع مأخوذ بالهاوية المميتة.
إزاء ذلك، لم يحصل أن كان للكلب جمهورية، كما هو المأخوذ في رواية إبراهيم اليوسف. لم يحصل أن قدَّم الحمار إنساناً ليكون شاهد عليه بالفبركة الفنية هذه .
هنا تكون الجريمة المشتركة بينهما، فيما حاولا تخيله، ومن ثم كتابته في ضوء هذين الحيوانين المنمذجين!
ولكل منهما سابق معرفة عما تردد باسمهما كليهما، ويتردد من خلالهما، حيث يشار إلى الإنسان وهو يستحمر، ويتحمير، ويحمير سواه، في سلوكيات مختلفة، مثلما أنه يعيش كلبية الحالة، الفكرة والمغزى " لنتذكر الكلبيين: حرّاس الفضيلة فلسفياً لدى اليونان "، لنتذكر الإنسان حين يتكلبن، ويستكلب، حين يستنبح، ويشوش على الكلب نفسه مضلاً من هو في الجوار، لغاية في نفسه ...!
أي ما تكون عليه أنسنة الحيوان، في حكم المقبول، لوجود تاريخ طويل له، وما تكون " حيونة " الإنسان في حكم المستفسَر عنه، عما جرى من مستجدات، وما يمضي بنا في نطاق الانعطافة التاريخية الكبرى، لا بل وحتى الاستثائية .
كيف تأتَّى ذلك؟ هناك أرشيف كامل في الروايتين، جهة أدوار كل منهما، على أصعدة مختلفة، وفي أزمنة وأمكنة مختلفة ، وما في ذلك من بحث وتنقيب، ليكون بعد ذلك، فعل البناء والتطويب الروائيين !
أعني بذلك، أن الذي تجمَّع لدى كلا الكاتبين، هو هذا الإثراء الحيواني، وبتعددية المواقع، ليجري التصنيف والتوصيف، وليحسن كل منهما، التصرف بمادته الأرشيفية، وقد آن أوان مباشرة كتابة الرواية، وصهر معلوماته في جسدها الفني!
طبعاً، يبقى الجدير بالذكر، وهو اختلاف الرقعة الجغرافية التي تتنفس فيها رواية كل منهما. والمقدرة على تحريك الشخصيات بالمقابل. حيث لا يُنسى موقع الروائي والناقد نبيل سليمان، وهو في كثافة قراءاته، ومكاشفاته النقدية لنصوص روائية مختلفة، إلى جانب قراءات أخرى: سياسية واجتماعية، وهو متوئم الكتابة: الرواية والنقد، وهو حيث يقيم في قريته " البودي " أو في اللاذقية السورية " طبعاً "، وما حاول الكاتب والباحث إبراهيم اليوسف أن يخوض غماره وهو في كتابة الرواية، وقد عرِف عنه شاعراً بداية، وكتابة نصوص تجمع بين الأدبي والسياسي، منوعاً في كتابته، وبعد استقراره في المغترب: ألمانياً خصوصاً !
هذا التصعيد في الموقف، ثمة ما يسوّغ له، في ضوء الجاري عالمياً، وفي المنطقة بصورة خاصة.
في مقدور أي قارىء، وبسهولة، تحري التناص في لعبة الرواية مباشرة، وبعد قراءة متأنية لكل رواية، وهي في تعقيدات بنيتها، تعقيد الواقع نفسه، جهة الكلب، رغم ندرة الشبيه التليد" جمهورية أفلاطون "، ولكنها التسمية المأخوذة بطابعها الفلسفي، في يوتوبيا الفيلسوف اليوناني. أما أن تكون " جمهورية الكلب " فانفصال تام عن كل ما يمكن التذكير به. في حال تحولات الإنسان الذهبي، تتدفق عناوين وإحالات هنا، رغم وجوب التدقيق في السرد المتشعب بخيوطه: تحولات الحمار الذهبي لأبوليوس، تحولات كافكا، وتحولات أدونيس...إلخ. إنما هناك فسخ لكل علاقة بين هذه العناوين والدعاوى التي يمكن أن تقام لتثبيت رابطة معينة، ورواية سليمان. فالحمار صار في مقام الإنسان، وليس أي إنسان. إنه الإنسان الذهبي، الحمار كاتباً، كما هو حال كارم أسعد، الناطق باسم الحمار، ومتجاوزه. يا للرهبة !
ما ليس في المعهود، يترجم ما ليس معقولاً مما جرى، وقد نسف كل ما له نسَب من المعقول. وبالتالي، فإن التمحور حول الحيوان، بالصيغة الأي عليها روائياً، هو أن الذي عهِد به إلى الحيوان، ليكون إنساناً، في حال رواية سليمان، سوف يفجّر كل شيء، جهة تعريته، فما كان الإنسان يقوم به، من خلال أنسنة الحيوان، هو أن يقوّله، كما يشتهي، هو أن يمرّر عبره ما يريد الإبلاغ عنه، دو أن يستطيع ذلك، وهو في حالته الطبيعية، وما هو معرَّف به، جهة الحيوان والذي صار إنساناً، هو أن ينسف الحدود المألوفة، أن يقول في الإنسان " حامل رسالة " ما سبق أن مارسه فيه على مر آلاف السنين، ولا يتحفظ على أي سر، وما يترتب على هذا الإجراء من تأكيد مقولة: نهاية الإنسان " سيد الكوَّن".
لم تعد الحياة تطاق! هكذا تقول الروايتان، وكما أرى. يا للإقرار الموقَّع عليه وهو المحال عليه بحكم "الغد"!
لا تعود الرواية قابضة على سر دون آخر، إنما الرواية التي أعطِيت صلاحية التحدث في كل مستوى، لأن الذي يجري، لا قِبَل للكائن الحي به، وفي " شخص " الحمار الشاهد التاريخي على " جرائم " الإنسان، وما أكثرها، يترجم ما يمكن أن يحصل تالياً وعن قريب، والحمار الصائر إنساناً، هو الحمار نفسه الذي يمتلك المقدرة الكاملة على الجمع بين المشرق والمغرب، جهة القواسم المشتركة، والتي تؤكد نوع العنف المعمَّد والمعزَّز من قبل الإنسان للإنسان وضد الإنسان .
في حال " كلب " اليوسف، نحن إزاء معايشة من نوع آخر، ومن متابعة تجارب حية ومأساوية، بين الشرق والغرب، وفي مكانة الكلب في كل من الشرق والغرب بأسلوب مختلف، وبين ما كان عليه تاريخياً، وما هو عليه راهناً .
في النظرة إلى الكلب، ينقسم العالم على نفسه، بمقدار ما ينقسم ما الإنسان بدوره على نفسه. فلا يعود الكلب مفهوماً برزخياً في الفصل بين الشرق وما يعرَف به من انتهاكات لحقوق الإنسان، ولحقوق الحياة في عمومها، ومن خلاله بالذات: عالم الكلب المميَّز بالنجاسة والدونية والنفور شرقياً، والغرب، وعالمه المميَّز باللطف والوداعة والطيب كذلك غربياً، وعلى إثر المتفجر في سوريا، والأعداد الهائلة والمرعبة للمهاجرين ممن تركوا كل شيء وراءهم طلباً للحد الأدنى من الأمان .
لكل من الحمار والكلب الدور الذي يجسّده جمعياً، ويضيء به عالماً بكامله. وليس من حدود فاصلة بينهما:
اليوسف يجمهر تلك المعلومات ذات الدلالات المختلفة وما يترتب عليها من علاقات متباينة في قيمتها إنسانياً، أي حيث يقف الإنسان جرّاء ذلك على حافة هاوية مميتة، والسؤال عما يمكن أن يحصل تالياً، وسليمان، الذي أسلس لحماره القياد، وقد برز في هيئة إنسان في أتم عافيته وفطنته وحيويته، ليصل ما بين أمكنة كثيرة، يُدعى إليها، ليتحدث عما يعني الحمار، في سياقات اجتماعية وثقافية مختلفة، ليشهّر في الإنسان الذي استدعاه ليقوّله فيما ليس له " حافر " فيه، وما في ذلك من لزوم " شد الحزام " في واقعة حمْيرية غير مسبوقة كهذه .
في الرواية جهةَ الاسم، ثمة تفريق ما بين طريقتها وحقيقتها:
طريقتها هي فيما يخرج منها " إنه الأسود الذي تخرج منه كل الألوان "، حيث التعبير بأسلوب معين.
حقيقتها، فيما يتعداها، ويصب فيها ولا يحاط بها. لقد حللنا في الأبيض الذي يغيّب كل الألوان، وعلى قارىء الرواية أن يغوص في بحر الألوان باحثاً عما يثيره لونياً دون أن يراه مباشرة، وذلك هو دوره المنتظر منه.
تحضر النظرية النسبية، بكل حيويتها وحكمة المعنى فيها، وهي أن تتلمس في الرواية، في " حيونتها " ما يمكنك إيجاده، والتفاعل معه، في الحدود النسبية لخاصية الكشف القرائية، أي حيث تكون القراءة أكثر عمقاً وأفقاً، ذلك أن ليس للرواية- أصلاً- من عنوان، هذا إذا اعتبرنا عنوانها الذي يشير إليها هنا وهناك، إذ يكون ذلك إجراء تمييزياً لها، عنوانها فيما يقوم به قارئها، دون أن يكون ذلك إعلاماً موجهاً لكاتبها، في الحقيقة المعتبرة بالمطلق. وكما هو الاسم الذي يطلق على مجهول الاسم. حيوان الرواية هو رهان كاتبها، وليس الشخص الذي يكون له اسمه الثلاثي ( سليمان- اليوسف، هنا)، والذي يتفعل في أسماء شخوصه، وبمقدار هذا التفعيل تكون شهادة الرواية على أنه الاسم المقدَّم على وجوده المحلي، المحدود، الآني، والماضي به إلى حيث يكون اللامحدود.
بالطريقة هذه. كل رواية مقاضاة لجريمة، أو أكثر، يرتكبها كاتبها، وهي مفتوحة. والجرائم منازل متباينة، وليس من إصدار للحكم بحق الروائي " مرتكب الجريمة ". لأن ما يأتي منه يخرج على المألوف. والخروج عصيان. إنه المكر المعتمد والمتعمَّد من قبله، واعتماد الخديعة من خلال متخيله، وبذلك لا يشبهه إلا ذاته، وهو في خروجه عن القطيعية !
كلٌّ ينطلق من خبرات خاصة به، ومن مؤشرات الأبلغ في إيصال المعنى، ويا له من صادم لمن هو غافل عما يجري .
قائمة الخبرات هذه لا تُخَندق الرواية هذه أو تلك، بمقدار ما تلغي الحدود أمام كاتب النص الإبداعي، كما لو أننا في عالم جورج أورويل، ورواية " 1984 " ورعب المتخيل، وهو الترجمان الموسَّع لما كان يجري ويتغير في الواقع .
الرواية بالطريقة هذه، تتخلى عن كل تعهد، بما يمكنها قوله، وما يمكنها الكف عن البت فيه، أو التلميح إليه، حيث الواقع متشظّ، في عالم انفجار السرد، وتنحية مفهوم الشخصية الرواية بقالبها السائد جانباً، والرهان على المجهول، لتكون في ضوء هذه الاعتبارات القادرة على أن تعدم في بنيتها كل ما عرِفت به سابقاً، كرمى ما هو متخوَف منه، وهو الذي يكون من شأنه الصريح بحقيقة كونها رواية، وإشهار لامتناهي ولاداتها، واستشرافها على متاهة هي إشعار بقائها تالياً !
في التقابل بي التاريخ والرواية ثانية جهة الحديث عن الفظائع والجرائم المرتكبة في الحروب الداخلية والخارجية، من الصعب جداً إن لم يكن مستحيلاً، الحديث عن تاريخ ينصف في وقائعه، إنه جانبي، بصورة ما، كما هو المتداول هنا وهناك، إنما في الرواية، تكون العلاقة مختلفة. إن عظمة الرواية هي في مقدرتها على تصوير أهوال الحرب والاقتتال الجانبي. وفي التاريخ يكون التخوف من عملية النقل الدقيقة لأهوال الحرب ومشاهد القتل والخراب والعنف، بينما في الرواية، فإنه بمقدر ما تكون هناك جماليات الرعب والقتل والعنف والعنف المميت فنياً، تعزز الرواية مكانتها .
على الصعيد الحيواني، وجِهة صلة الإنسان بالحيوان، لا أحد يشتهي أو يرغب في أن يصبح حيواناً، منفصلاً عن بني جنسه كلياً. لا أحد على الإطلاق. وليس كاتب السطور هذه، بمستثنى مما تقدم. إن من لا يصلح لبني جنسه، لا يمكنه أن يكون صالحاً حين يرغب في التحول. وفي الكتابة أو الفن، العملية مختلفة في التمثيل الرمزي. ثمة تعرية هنا، انتظار ما لا يُنتظَر إلا في الرواية، للحيلولة دون وقوع ما لا يراد له أن يقع. الرواية لا تسمي أحداً لهذا يعطى لها اسمها الفعلي. لكنها تضيء جريمة في الجوار، أو أكثر، وهنا تكون خطورتها المجازة وباقتدار!
في نطاق الرواية التي يكون الحيوان خميرتها، ثمة عجينة يعدّها كاتبها، بغية إبراز ما يغفَل عنه، في تربية الوجدان.
وعلى صعيد المكاشفة التاريخية لما يجري، لا بد أن كاتب الرواية مصاب بعسر هضم ثقيل الوطء، بتسمم الواقع جرّاء التدقيق في حيثياته، وما كتابته لرواية من هذا القبيل، إلا محاولة الالتفاف عليه، وليسمَع بصمته الهادر داخلاً طبعاً.
يكون حيوانه مبرّرَه فيما يلجأ إليه، ضبط مخالفة لواقع لا أمرَّ منه، لعجزه عن القيام بأي ردع، وقد أودعه كتابته !
يشار إلى أن جيل دولوز قد أبان عن صحارى ووحوش تستبطن الإنسان، وما يعنيه ذلك عن أن الإنسان مفارق لحقيقة تكوينه وما يجب عليه القيام به في ردة نوعية على نفسه وفيها ليستطيع رؤية الهوة العميقة داخله، ومعرفة مدى الخلل المريع في نفسه وعقله . أي ما يتعلق بتلك الديون الرمزية لجملة" الوحوش " في ذمته، كي يتمكن من سلوك الطريق الصحيح، وبالتالي، فإن الفظائع التي يرتكبها، وهي في تراكمها لا تحصى، دون ذلك، لما كان هذا النذير النفير !
إننا إزاء فتح محضر ضبط وهو لا ينغلق ما بقيت الحياة، وتدوين حساب قيمي: في الفارق الكبير بين الإنسان والحيوان، هو أن الحيوان مذ كان وهو يحافظ على وجوده الحيواني ويعرف من خلال غريزته. إنها طبيعته التي يحمل مأثرتها طول بقائه في الحياة، والإنسان الذي أدخل في حسابه ما ليس له، تشبيهاً وتمثيلاً، إرضاء لغروره، كما لو أنه طوع أمره، ونسي أو تناسى ما هو فيه وعليه غريزة وعقلاً، وقد تداخلا، فلا هو المأخوذ بالغريزة، كما يقول تاريخه، ولا هو احتمى بالعقل، ليعرف حدوده وحدود سواه من الكائنات الأخرى، ليصبح في تيه مهلك، ومسيء إلى غيره، تيه هو صنيع صورته لذاته .
إننا إزاء وضع إنساني متفجر،وهو رهان الرواية، ورهان الرواية يتوقف على كيفية إبراز جماع مقومات الإبداع داخلها.
خلاف الجاري في الواقع، يتنكر الروائي دائماً لاسمه، لجمله أسمائه في كتاباته السابقة، حيث تتم معايشة شخصيات ورقية من نوع آخر. إن المغايرة نبوءة محتفىً بها.
الحروب في الحالة هذه تدمر، وتشكل مادة غزيرة ومحفزة للمؤرخ، وهو يعتمد على خاصية الإسناد في روايته، مكاناً وزماناً، ولا بد أنها تكون مروّعة في تدوين وقائعها، لكن الرواية تستعذبها، لتحسن نسج نصها، وجمالية القبح بعض ن مآثرها، والإسناد الوحيد هو المعهود به إلى متخيله، وبذلك يسلم الروائي من كل عقاب، وهو يشد هنا وهناك، أن ليس من صلة نسب بين أي واقعة في روايته، وما يُعتقَد أنه إفصاح عنها. إنه نزيل عالمه الذي يبتدعه في روحه.
في بنية كتابة الرواية " الكلبية- الحميرية " ثمة الواقع، ولكنه المحرَّر مما هو فيه، وإلا لانتهى أمر كتابة الرواية، وقد دفع كاتبها ثمناً غالياً ولا يسدَّد أبداً، طالما أنها تتنفس ووجهتها الآتي، والتمثيل الحيواني، هو أعلى درجات التمثيل في الرواية في ضوء خراب الواقع، لتتوقف نباهة القراءة بحرفيتها النقدية على مكاشفة مفتوحة لمغذيات متخيل الروائي.
في كل من " جمهورية الكلب " لليوسف، و" تحولات الإنسان الذهبي " لسليمان، ثمة ما يمكن قوله، دون أن أشير إلى عبارة بحرفيها أترك التنقيب في بنيتها وهي موصولة إلى المؤثر في الروايتين:
إنهم لا يستطيعون تمثيل أنفسهم، لا بد أن يُمثَّلوا !
المتمثّل بالقول هنا، يكون كل من الكلب والحمار، أو بالعكس، لحظة الانتهاء من روايتهما. متى تكون اليقظة؟




