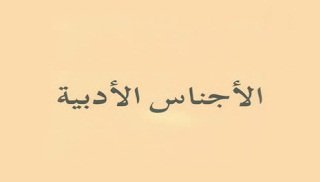رأيته أول مرة في الملعب البلدي _بني ملال، لعلها سنة 1975…
كان أصغر لاعبي فريق الرجاء البيضاوي لكنه كان أكثرهم لفتا للانتباه. لعب يومها دور مدافع أوسط متقدم، وكان الجمهور قد نسي المباراة وراح يتفرس في قدميه ليفضح سر تلك النوابض المخبأة في حذائه، والتي تجعله، وعلى قصر قامته وهزاله، يقفز فوق الجميع ليصد كل الكرات العالية.
كان بلا ملامح، وجه فتي مخفي وسط غابة شعر. كان بلا اسم ولا تاريخ، لكنه، وفي ذلك الوقت المبكر من حياته الكروية، كان يبني لنفسه مجد أن يكون جنديا ونملة شغالة وجدارا شاهقا تتكسر تحته كل محاولات الخصوم.
بعد سنة، سأراه مرة أخرى، كان اليوم ماطرا. تقدم قليلا ولعب وسط الميدان، وخاض في برك ووحل الملعب صراع غلاديورات ملحمي مع بيزا الماكر جدا… السريع جدا.
وما زال مجد من أمجادنا، نحن مجانين الرجاء الملالي، يتمثل في كوننا رأينا الظلمي المهيب، لمرة على الأقل، يندفع في انزلاقات فدائية ولا يجد بين رجليه سوى الوحل والمرارة، بينما يكون بيزا قد مضى بعيدا بالكرة. عرف اللئيم اللحظة الحاسمة التي يرفع فيها الكرة لتتجنب الكاسحة المتقدمة…
لم يكن يمتلك جسدا رياضيا فعموده الفقري مقوس قليلا، وهناك عدم تناسب بين رجليه وباقي جسده، بنيته النحيفة شبه متداعية. امتلك الظلمي جسدا كأجسادنا جميعا يصلح للشقاء والعذاب في حقل أو سوق أو ميناء أو ورش بناء. غير أنه امتلك موهبة جعل هذا الجسد المتواضع مطواعا لدنا. بل عرف كيف يخفي وراء علامات تلك الشيخوخة المبكرة البادية على جسده همة وقوة جبار.
ومثله مثل غارنينشا وريزنبريك ومولير… وغيرهم ممن كانوا يوقعون بأجسادهم الهشة الغريبة حركة اعتراض تاريخية قوية على المتخيل الرياضي منذ الأولمب اليوناني ونحاتيه، الذي قرن الجسد الرياضي بالكمال والتناسق والقوة، كان يعلمنا بأن السر يكمن في الروح، وأن الإنسان في الملعب ليس جماع عضلات وعظام وأطراف تركض وتنازل، بل هو إرادة وأحلام وعقل يعمل ويخطط. لقد زرع الظلمي من الخيال والشعر والأناقة والجمال في الملاعب ما لم يزرعه من أوتوا بسطة في الجسم…
لم يكن الظلمي نجما في كازا وحدها، بل كان نجما وبطلا في كل المدن المغربية. فالفتى الخجول المتكتم خارج الملعب، والذي يمشي بجانب الحائط متمنيا ألا يراه أو يوقفه أحد، الفتى الذي يرتضي لنفسه الظلال والأماكن الخفية في مدينة ضاجة عامرة، يصير مهدارا في الملعب والأشد حضورا. كان كلامه البليغ والوحيد هو ما يقوله في الملعب، هو مجازات وصور ما ينجزه فيه، هو تلك الجواهر التي يخرجها وينثرها بكرم على الجميع. لم تكن في حياته الكروية كلها مقابلة لا أهمية لها، فقد انتمى لتراث كانت فيه الكرة مبجلة وشريفة وأفضل تكريم لها هو أن تكون أنت نفسك في حضرتها. يدخل الملعب كما يدخل المؤمن معبدا ويلعب بإخلاص وتفان وحدب من يؤدي طقسا مقدسا…
بنى الظلمي اسمه ومكانته وحتى سلطته في الملعب شيئا فشيئا. وبعد سنوات من مراكمة الخبرة سيصير المعلم والمايسترو وأحد الصناع الكبار لهوية الرجاء البيضاوي، الفريق الاستثنائي الذي كان يؤمن لاعبوه بأن الاحتفال الحقيقي ليس هو فرح الحصول على بطولة أو كأس وإنما هو ما ينجز في كل مقابلة داخل الملعب من تمريرات ومراوغات وسحر وإدهاش.
ثم في سنوات تألقه لم يكن للفوز ببطولة أو كأس هذه الهالة التي لهما اليوم. لم تكن الجامعة تعطي فلسا واحدا للفائز بالبطولة ولا حتى صينية نحاس أو دعوة لحفل شاي (عندما فاز الرجاء الملالي بالبطولة سنة 1974 كوفئ اللاعبون بوليمة في منتزه عين أسردون. وحين فاز عبد الكريم عشيبات بلقب هداف البطولة سنة 1979 كان التكريم الوحيد الذي تلقاه هو ذكر اسمه في مقالات الصحف وهي تتحدث عن حصيلة السنة الكروية… لم تصله رسالة تهنئة لا من الجامعة ولا من غيرها).
كانت الألقاب صالحة لصور الفرحة العابرة وهواة الإحصائيات فقط. فالبطولة الوطنية آنذاك كانت صيغة مكبرة لدوريات الأحياء، حيث يستبسل أبناء الدرب في تبليل قميص الدرب بلا مقابل. كانت الألقاب عابرة وهشة وسرعان ما تنسى مع ضربة بداية مقابلات السنة التالية. لهذا نزلت فرق كثيرة للقسم الثاني في السنة التي تعقب فوزها بالبطولة. لم يعد للاعبين الذين عرفوا يأس وخواء المنتصرين الحافز النفسي لمعاودة الصراع من أجل لا شيء…
عبد المجيد الظلمي
ولأن الملعب فضاء حقيقة لا يقر إلا بالمجهود والقدرة والجدارة، نادرا ما بني في الكرة صيت كاذب، وقل ما حاز لاعب شهرة غير مستحقة.
لأن كرة القدم كشافة فاضحة، فقد كان الظلمي معلما بحق… معلما في إرسال التمريرات وراء جدار الخصوم، معلما في بناء متاهات من التمريرات القصيرة المدوخة، معلما في رباطة الجأش والقيادة، له عيون في كل جسده، يرى ما لا يراه الآخرون، ويهندس بروية وتأن هجوما صاعقا…
كان معلما في تكسير هجمات الخصوم وخوض النزالات وربحها، ومثلما اجتمع فيه الباني والمخرب، الجنرال الذي يخطط والجندي الذي ينفذ، كان كل شيء يبدأ من رجله وينتهي عندها. هو من يكد ويعمل ويوزع ويوجه، هو من تتجمع كل خيوط اللعبة في رجله.
سواء أمام الفرق الكبرى أو الصغرى، أمام الفتح والنهضة السطاتية والنادي القنيطري أو أمام الألمان والإنجليز والكاميرون… كان الظلمي هو نفسه، لا يشبه أحدا، يلعب كما لعب دوما بإخلاص وثقة في النفس. وكان زملاؤه يحتاجون هذه الثقة التي تفيض منه ويطالهم نصيب منها. يبدو ثابتا حين يرتبك الآخرون، يبدو عارفا ومجربا حين يطمس وجل البداية أبجديات اللعبة في أرجل ضائعة. إنه بدر الليالي الظلماء… وبكل هذا منح الشهرة والنجومية معنى عرفه المغاربة عن قرب مع الدراويش والمجاذيب وأحباب الله… كان يهرب مثلهم تماما من الأضواء كما يهرب الواحد من وباء. يغيب حين يحضر الآخرون، ويصمت حين يتكلمون، وتكاد تحس به يعتذر لكونه الظلمي.
رفض بنقاء روح استثنائي أن يتحول إلى صنم مبجل، لأن الأصنام في النهاية هي فرح وغنم السدنة. لم يصر محللا ولا مدربا ولا خبيرا يفهم في كل شيء وجاهز للكلام في كل شيء. ومن فعلوا كل هذه الأشياء التي تجنبها هو، كانوا يحتاجونه. يحتاجون الهالة التي تشع منه، يحتاجون كنوز المحبة والتقدير التي زرعها هنا وهناك، يحتاجون المفاتيح الكثيرة التي يحملها معه وتفتح بها كل الأبواب المغربية، يحتاجونه إلى جانبهم لأن الصورة ناقصة من دونه…
خان الظلمي في النهاية قلبُه، لأنه طيلة حياته الكروية لم يلعب الكرة برجله بل بقلبه. يختفي العظماء دوما بخفة برق لمع في السماء لأنهم وفي عجلتهم يعرفون بأنهم نحتوا أبدية وراءهم.
كان أصغر لاعبي فريق الرجاء البيضاوي لكنه كان أكثرهم لفتا للانتباه. لعب يومها دور مدافع أوسط متقدم، وكان الجمهور قد نسي المباراة وراح يتفرس في قدميه ليفضح سر تلك النوابض المخبأة في حذائه، والتي تجعله، وعلى قصر قامته وهزاله، يقفز فوق الجميع ليصد كل الكرات العالية.
كان بلا ملامح، وجه فتي مخفي وسط غابة شعر. كان بلا اسم ولا تاريخ، لكنه، وفي ذلك الوقت المبكر من حياته الكروية، كان يبني لنفسه مجد أن يكون جنديا ونملة شغالة وجدارا شاهقا تتكسر تحته كل محاولات الخصوم.
بعد سنة، سأراه مرة أخرى، كان اليوم ماطرا. تقدم قليلا ولعب وسط الميدان، وخاض في برك ووحل الملعب صراع غلاديورات ملحمي مع بيزا الماكر جدا… السريع جدا.
وما زال مجد من أمجادنا، نحن مجانين الرجاء الملالي، يتمثل في كوننا رأينا الظلمي المهيب، لمرة على الأقل، يندفع في انزلاقات فدائية ولا يجد بين رجليه سوى الوحل والمرارة، بينما يكون بيزا قد مضى بعيدا بالكرة. عرف اللئيم اللحظة الحاسمة التي يرفع فيها الكرة لتتجنب الكاسحة المتقدمة…
لم يكن يمتلك جسدا رياضيا فعموده الفقري مقوس قليلا، وهناك عدم تناسب بين رجليه وباقي جسده، بنيته النحيفة شبه متداعية. امتلك الظلمي جسدا كأجسادنا جميعا يصلح للشقاء والعذاب في حقل أو سوق أو ميناء أو ورش بناء. غير أنه امتلك موهبة جعل هذا الجسد المتواضع مطواعا لدنا. بل عرف كيف يخفي وراء علامات تلك الشيخوخة المبكرة البادية على جسده همة وقوة جبار.
ومثله مثل غارنينشا وريزنبريك ومولير… وغيرهم ممن كانوا يوقعون بأجسادهم الهشة الغريبة حركة اعتراض تاريخية قوية على المتخيل الرياضي منذ الأولمب اليوناني ونحاتيه، الذي قرن الجسد الرياضي بالكمال والتناسق والقوة، كان يعلمنا بأن السر يكمن في الروح، وأن الإنسان في الملعب ليس جماع عضلات وعظام وأطراف تركض وتنازل، بل هو إرادة وأحلام وعقل يعمل ويخطط. لقد زرع الظلمي من الخيال والشعر والأناقة والجمال في الملاعب ما لم يزرعه من أوتوا بسطة في الجسم…
لم يكن الظلمي نجما في كازا وحدها، بل كان نجما وبطلا في كل المدن المغربية. فالفتى الخجول المتكتم خارج الملعب، والذي يمشي بجانب الحائط متمنيا ألا يراه أو يوقفه أحد، الفتى الذي يرتضي لنفسه الظلال والأماكن الخفية في مدينة ضاجة عامرة، يصير مهدارا في الملعب والأشد حضورا. كان كلامه البليغ والوحيد هو ما يقوله في الملعب، هو مجازات وصور ما ينجزه فيه، هو تلك الجواهر التي يخرجها وينثرها بكرم على الجميع. لم تكن في حياته الكروية كلها مقابلة لا أهمية لها، فقد انتمى لتراث كانت فيه الكرة مبجلة وشريفة وأفضل تكريم لها هو أن تكون أنت نفسك في حضرتها. يدخل الملعب كما يدخل المؤمن معبدا ويلعب بإخلاص وتفان وحدب من يؤدي طقسا مقدسا…
بنى الظلمي اسمه ومكانته وحتى سلطته في الملعب شيئا فشيئا. وبعد سنوات من مراكمة الخبرة سيصير المعلم والمايسترو وأحد الصناع الكبار لهوية الرجاء البيضاوي، الفريق الاستثنائي الذي كان يؤمن لاعبوه بأن الاحتفال الحقيقي ليس هو فرح الحصول على بطولة أو كأس وإنما هو ما ينجز في كل مقابلة داخل الملعب من تمريرات ومراوغات وسحر وإدهاش.
ثم في سنوات تألقه لم يكن للفوز ببطولة أو كأس هذه الهالة التي لهما اليوم. لم تكن الجامعة تعطي فلسا واحدا للفائز بالبطولة ولا حتى صينية نحاس أو دعوة لحفل شاي (عندما فاز الرجاء الملالي بالبطولة سنة 1974 كوفئ اللاعبون بوليمة في منتزه عين أسردون. وحين فاز عبد الكريم عشيبات بلقب هداف البطولة سنة 1979 كان التكريم الوحيد الذي تلقاه هو ذكر اسمه في مقالات الصحف وهي تتحدث عن حصيلة السنة الكروية… لم تصله رسالة تهنئة لا من الجامعة ولا من غيرها).
كانت الألقاب صالحة لصور الفرحة العابرة وهواة الإحصائيات فقط. فالبطولة الوطنية آنذاك كانت صيغة مكبرة لدوريات الأحياء، حيث يستبسل أبناء الدرب في تبليل قميص الدرب بلا مقابل. كانت الألقاب عابرة وهشة وسرعان ما تنسى مع ضربة بداية مقابلات السنة التالية. لهذا نزلت فرق كثيرة للقسم الثاني في السنة التي تعقب فوزها بالبطولة. لم يعد للاعبين الذين عرفوا يأس وخواء المنتصرين الحافز النفسي لمعاودة الصراع من أجل لا شيء…
عبد المجيد الظلمي
ولأن الملعب فضاء حقيقة لا يقر إلا بالمجهود والقدرة والجدارة، نادرا ما بني في الكرة صيت كاذب، وقل ما حاز لاعب شهرة غير مستحقة.
لأن كرة القدم كشافة فاضحة، فقد كان الظلمي معلما بحق… معلما في إرسال التمريرات وراء جدار الخصوم، معلما في بناء متاهات من التمريرات القصيرة المدوخة، معلما في رباطة الجأش والقيادة، له عيون في كل جسده، يرى ما لا يراه الآخرون، ويهندس بروية وتأن هجوما صاعقا…
كان معلما في تكسير هجمات الخصوم وخوض النزالات وربحها، ومثلما اجتمع فيه الباني والمخرب، الجنرال الذي يخطط والجندي الذي ينفذ، كان كل شيء يبدأ من رجله وينتهي عندها. هو من يكد ويعمل ويوزع ويوجه، هو من تتجمع كل خيوط اللعبة في رجله.
سواء أمام الفرق الكبرى أو الصغرى، أمام الفتح والنهضة السطاتية والنادي القنيطري أو أمام الألمان والإنجليز والكاميرون… كان الظلمي هو نفسه، لا يشبه أحدا، يلعب كما لعب دوما بإخلاص وثقة في النفس. وكان زملاؤه يحتاجون هذه الثقة التي تفيض منه ويطالهم نصيب منها. يبدو ثابتا حين يرتبك الآخرون، يبدو عارفا ومجربا حين يطمس وجل البداية أبجديات اللعبة في أرجل ضائعة. إنه بدر الليالي الظلماء… وبكل هذا منح الشهرة والنجومية معنى عرفه المغاربة عن قرب مع الدراويش والمجاذيب وأحباب الله… كان يهرب مثلهم تماما من الأضواء كما يهرب الواحد من وباء. يغيب حين يحضر الآخرون، ويصمت حين يتكلمون، وتكاد تحس به يعتذر لكونه الظلمي.
رفض بنقاء روح استثنائي أن يتحول إلى صنم مبجل، لأن الأصنام في النهاية هي فرح وغنم السدنة. لم يصر محللا ولا مدربا ولا خبيرا يفهم في كل شيء وجاهز للكلام في كل شيء. ومن فعلوا كل هذه الأشياء التي تجنبها هو، كانوا يحتاجونه. يحتاجون الهالة التي تشع منه، يحتاجون كنوز المحبة والتقدير التي زرعها هنا وهناك، يحتاجون المفاتيح الكثيرة التي يحملها معه وتفتح بها كل الأبواب المغربية، يحتاجونه إلى جانبهم لأن الصورة ناقصة من دونه…
خان الظلمي في النهاية قلبُه، لأنه طيلة حياته الكروية لم يلعب الكرة برجله بل بقلبه. يختفي العظماء دوما بخفة برق لمع في السماء لأنهم وفي عجلتهم يعرفون بأنهم نحتوا أبدية وراءهم.