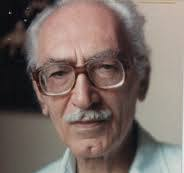منالأجيال والجماعات الأدبية… جدليّة لا تنتهي!جيل الستينيات المصري، جيل البِيت الأمريكي، جماعة 47 الألمانية.. كلها تسميات تحاول وصف مجموعة من الكتاب ظهروا في فترة معينة وتعرضوا لظروف إنسانية ومجتمعية متشابهة، أدت لوجود سمات مشتركة بينهم على صعيد منتجهم الكتابي. ورغم كل تلك التسميات والجماعات والتصنيفات، فإن فكرة «المجايلة» في حد ذاتها تبقى محل خلاف بين الكتّاب المصريين، البعض يراها منطقية، خاصة إذا اتبعنا المعيار العالمي لخلق مثل تلك التصنيفات، وبالتالي فإن النسخة المصرية ومعيارها المرتكز على التقسيم العِقدي لا تقنع هذا الفريق. البعض الآخر ينفيها من الأساس بحجة تناقض محاولة تعبئة الكتّاب في دزينات، مع فكرة ذاتية الأدب.
كتب الناقد صلاح فضل، في إحدى مقالاته: «هناك عوامل فعّالة فى تشكيل الجيل الأدبي، من أهمها بطبيعة الحال تواريخ الميلاد المتقاربة، وأنماط التربية السائدة، ودرجة التواصل الشخصي بين الأفراد، إلى جانب المعايشات الكبرى للهزات التي يتعرض لها أبناء الجيل الواحد، مثل الثورات والحروب والتطورات الحضارية البارزة في اللحظات التاريخية الفاصلة في حياة الشعوب والثقافات، وغالباً ما تتقدم شخصية رائدة، أو أب روحي للجيل يلخّص أثر تلك العوامل كلها في تشكيل وعيه ورؤيته، بطريقة تفوق غيره، وتطبع عصره، وتجعل الآخرين يدورون في فلكه. وتصبح المصطلحات والشعارات التي يرفعها هي الرائجة بين أبناء جيله، مما يمثل فارقاً واضحاً يميزه عن الأجيال السابقة عليه أو اللاحقة له».
ليست في تواريخ الميلاد
في منتصف القرن التاسع عشر صنف الناقد الفرنسي تشارلز سانت بيف الأجيال الأدبية وفقاً لتواريخ ميلاد الأفراد، وهو الأمر الذي لا يتفق معه الروائي إبراهيم عبد المجيد، يقول صاحب «لا أحد ينام في الإسكندرية»: «لو نظرت لأجيال 47 في ألمانيا وجيل أواخر العشرينيات في الأدب الأمريكي ستجد أن المسألة مرتبطة بتعرّض معظم أفراد تلك المجموعات لأحداث كبرى، تلك الأحداث تصنع رؤى جمالية وأشكال أدبية جديدة، الأمر إذن ليس مرتبطاً بأعمار أولئك الأدباء، وللأسف في مصر يتم التقسيم وفقاً للأعمار، أو بتقسيم عِقدي يخرّج دفعة كل عشرة أعوام، وهذا أمر غير منطقي، وهذا التقسيم ذو السنوات العشر وضعه الأكاديميون، وبعض أصحاب المصالح ممن يحتمون وسط جيل يتساوى فيه أفراده، مثلاً، كيف يمكننا التمييز بين من كتبوا الرواية في الستينيات والسبعينيات في مصر؟ كتاب جيل الستينيات أنفسهم لم يكن الواحد منهم قد كتب رواية أو أكثر في عقد الستينيات نفسه، مثل صنع الله إبراهيم وعبد الحكيم قاسم، ثم انطلق الزخم الروائي مع السبعينيات، الذي شهد تدفق روايات الستينيين، وكذلك الأدباء الذين كتبوا في السبعينيات مثل عبده جبير ومحمود الورداني وغيرهما، أعتقد أن السبعينيات هي السنوات الحقيقية للرواية المصرية.
لكن رغم ذلك، ووفقاً لمصطلح «الرواية الستينية» وجيل الستينيات، فأنا أرى أن السرد المصري منذ تلك الفترة وحتى 25 يناير/كانون الثاني هو رواية ستينية بشكل أو بآخر، كلها تيارات للفكرة ذاتها، الهزيمة والتشظي والانسحاق والعشوائيات وأفول القومية.. إلخ، والآن سأنتظر كتابة مغايرة بسبب الأحداث الكبرى التي عاشتها مصر».
أجيال وجماعات مصرية
الشاعر والروائي صبحي موسى، يرصد ظاهرة الجماعات الأدبية التي تكون نواة لجيل، يقول موسى: «لا أحد يعرف من أين أتت فكرة الأجيال، لكنها تسمية تشيع مع توافر مجموعة من الأدباء المتقاربين عمرياً وأحياناً مكانياً، تجمعهم في البدء ظروف اجتماعية متشابهة تترك أثرها على رؤيتهم للعالم من حولهم، ومن ثم تنطلق التسمية وتشيع ويتكاثر المنتمون إلى هذه المجموعة طالما حدث تحقق ملائم لبعض عناصرها، هذا ما حدث في جيل 27 في إسبانيا الذي يضم لوركا، وتكرر في أربعينيات القرن مع المجموعة التي عرفت بالجيل المهزوم في أمريكا، ومن بينها آلن جنسبرج وجاك كيرواك، وتكرر الأمر مع ما عرف بجيل 47 الذي ظهر بعد الحرب العالمية الثانية في ألمانيا، وكان من بينه غونتر غراس، لكن هذه في أغلبها تسميات يطرحها أبناء المجموعة لتمييز أنفسهم، وعادة ما يتوقف النقد ورجاله أمامها كثيراً عندما يتحقق أبناء هذا الجيل، ولابد أن ثمة حركات وأجيالا ومجموعات كثيرة أغفلها التاريخ لعدم بروز أبنائها، ولم تكن مصر بعيدة عن هذا الحراك العالمي ففي الأربعينيات كانت لدينا جماعة «الخبز والحرية» و«مدرسة الديوان» و»مدرسة المهجر» و»الإحيائيين»، وفي الخمسينيات تحوّلت فكرة المدارس إلى فكرة الريادة للقصيدة الحديثة، وفي الستينيات ظهرت مجلة «غاليري 68» التي التف حولها جيل الستينيات وسرعان ما توسعت الفكرة لتصبح جيل الستينيات، وفي نهاية السبعينيات وأوائل الثمانينيات كانت لدينا جماعتا «أصوات» و«إضاءة» اللتان توزع بينهما أبناء السبعينيات، وسرعان ما انتفت الأسماء لنجد أنفسنا أمام كلمة جيل، وفي نهاية الثمانينيات بداية التسعينيات ظهرت مجموعة «الجراد» التي اعتبرت بداية لجيل التسعينيات، رغم أن مؤسسها هو أحد شعراء السبعينيات، وأحد أبناء الجماعتين السابقتين».
ويواصل صاحب «الموريسكي الأخير»: «ربما كان النقاد هم سبب تحويل الجماعات إلى أجيال لدينا تسهيلاً للتعامل النقدي، لكن ذلك لا ينفي أن الأحداث التي مرت بها مصر وربما المنطقة العربية كانت لها تأثيراتها المختلفة التي أحدثت تبايناً في الكتابة، فثورة يوليو/تموز أنتجت جيلاً ينتمي لفكرتها، ومع الستينيات ظهرت فكرة القومية العربية، وفي السبعينيات وبداية الثمانينيات جاءت فكرة الهزيمة رغم نصر أكتوبر/تشرين الأول، ربما لأن فكرة القومية نفسها لاقت هزيمة واضحة بعد النكسة ومع توقيع مصر لمعاهدة كامب ديفيد، وربما الجيل الوحيد الذي لا يمكننا القول إن به ملامح جيل هو الثمانينيات، نظراً لتقارب كتابته مع التسعينيين، فضلاً عن وقوعه في أزمة التوزع بين الكتابة السبعينية والكتابة الجديدة لدى شعراء النثر في التسعينيات، وبالتالي لم يستطيعوا طرح مشروع أو حتى تكتل واضح، فضلاً عن عدم تحقق الكثيرين منهم بشكل يلفت الانتباه لهم كجماعة أو جيل على نقيض السبعينيين والستينيين».
أجيال أم شلليات؟
الروائي محمود الغيطاني، الحائز جائزة ساويرس عن رواية «كادرات بصرية» يرفض التصنيف الحقبي وفكرة الأجيال، يقول الغيطاني: «ليس هناك في الحقيقة ما يمكن أن نُطلق عليه جيل الستينيات، أو جيل السبعينيات، أو غيرها من هذه التسميات التي لا معنى لها، وليس من الطبيعي أو المنطقي القول بأن هذا هو جيل الهزيمة، بينما غيرهم هو جيل الانتصار، وذاك هو جيل الثورة. مثل هذا التقسيم الفج، والمفتئت على الكتاب والمبدعين لا وجود حقيقيا له؛ فالإبداع هو مسيرة بدأت وتظل تسير من دون هذا التصنيف، ولكن من الممكن بالفعل أن نستخدم مثل هذا التقسيم الزمني أو الحقبي في مقام الدراسات النقدية، أو التأريخ للأدب فقط؛ لأن الباحث هنا يحاول أن يُسهل الأمر على نفسه، أو حصر الفترة الزمنية التي يتحدث عنها بحثه، وبالتالي فهو يُحدد الفترة التي يعمل عليها، أما تقسيم الأدب بمثل هذا الشكل الذي من الممكن استخدامه في البحث، هو في حقيقة أمره مفسدة للمسيرة الإبداعية الأدبية، كما أن شيوع مثل هذه التقسيمات ساهم فيه الكثير من الصحافيين والمفسدين من الشلليات في الوسط الثقافي الذي تحاول فيه كل شلّة أدبية أبناء مرحلة عمرية واحدة، أن يكونوا «غيتو» منفصل عن غيرهم ممن سبقوهم أو جاءوا بعدهم، وبالتالي يصورون للجميع في شكل زائف أن هذه الحقبة، أو هذه الشلة هي الأفضل إبداعياً، أو أنها التي حملت لواء الإبداع وحدها، وكل من هو غيرها باطل وقبض الريح، وهذا زيف ودعارة ثقافية يمارسها الكثيرون من الكتاب وأدعياء الثقافة».
الكُتّاب سُلالات
أما الروائي أحمد عبد اللطيف، الحائز جائزة الدولة التشجيعية عن روايته «صانع المفاتيح»، فله رأي مغاير، يقول عبد اللطيف: «لا أعرف إن كانت هناك أجيال أدبية أم لا، لكن أعرف أن النقّاد عادةً ما يكونون في حاجة إلى عمل إطارات ووضع الكُتّاب بداخلها، أعتقد أنهم بهذه الطريقة يسهّلون عملهم: هؤلاء الأفراد ينتمون إلى جيل بعينه وبالتالي يمكن البحث عن السمات الخاصة بهذا الجيل. مع ذلك لا أرفض فكرة الأجيال، بشكل ما أعتقد أن الكاتب ابن مجتمعه، وبشكل ما أعتقد أن مجموعة كُتّاب يعيشون في فترة زمنية واحدة وفي ظرف سياسي واجتماعي واحد قد تجمعهم سمات مشتركة. هذه السمات لا تلغي فردية كل كاتب، ولا تلغي خصوصية رؤيته للعالم، لا تلغي بحثه عن تطوير نفسه أو قراءة واقعه بشكل يخصه. لكن بعيداً عن فكرة الأجيال، أصدق أكثر أن «الكُتّاب أُسر»، وأن «الكُتّاب سلالات»، أصدق بشكل أساسي أن هناك مبدعين تتفق رؤيتهم للعالم رغم البعد الزماني والمكاني، أصدق أن هناك أسرة بلزاك، أسرة ديستوفسكي، أسرة كافكا، وفي كل الأجيال هناك من ينتمي إلى كل أسرة منها، أو لا ينتمي إلى أي منها، غير أن الانتماء لا يعني التقليد، لا يعني السير بالمسطرة على الخطوط المرسومة سلفاً، بل يعني، في ظنّي، التطوير داخل هذه الأسرة السردية. يبدو لي مثلاً أن ساراماغو هو التطور لبورخس الذي ينتمي لأسرة كافكا، يبدو لي أن ألبير كامو ينتمي للأسرة نفسها. ورغم الخيوط الممتدة من أحدهم للآخر، لا يمكن أن تعتقد أنهم ينتمون للجيل نفسه، بالإضافة لذلك، النقاد يضعون أيضاً إطاراً خاصاً بالتيار الأدبي، يقولون هؤلاء يكتبون الواقعية، هؤلاء يكتبون الفانتازيا، هؤلاء يكتبون السريالية، في حين أن المبدع نفسه ربما يكون غير معني بهذه الإطارات، وربما يرفض اختزال عمله في لافتة ينتمي إليها بجزء من كتابته، فيما تنتمي الأجزاء الأخرى لشيء آخر».
كتب الناقد صلاح فضل، في إحدى مقالاته: «هناك عوامل فعّالة فى تشكيل الجيل الأدبي، من أهمها بطبيعة الحال تواريخ الميلاد المتقاربة، وأنماط التربية السائدة، ودرجة التواصل الشخصي بين الأفراد، إلى جانب المعايشات الكبرى للهزات التي يتعرض لها أبناء الجيل الواحد، مثل الثورات والحروب والتطورات الحضارية البارزة في اللحظات التاريخية الفاصلة في حياة الشعوب والثقافات، وغالباً ما تتقدم شخصية رائدة، أو أب روحي للجيل يلخّص أثر تلك العوامل كلها في تشكيل وعيه ورؤيته، بطريقة تفوق غيره، وتطبع عصره، وتجعل الآخرين يدورون في فلكه. وتصبح المصطلحات والشعارات التي يرفعها هي الرائجة بين أبناء جيله، مما يمثل فارقاً واضحاً يميزه عن الأجيال السابقة عليه أو اللاحقة له».
ليست في تواريخ الميلاد
في منتصف القرن التاسع عشر صنف الناقد الفرنسي تشارلز سانت بيف الأجيال الأدبية وفقاً لتواريخ ميلاد الأفراد، وهو الأمر الذي لا يتفق معه الروائي إبراهيم عبد المجيد، يقول صاحب «لا أحد ينام في الإسكندرية»: «لو نظرت لأجيال 47 في ألمانيا وجيل أواخر العشرينيات في الأدب الأمريكي ستجد أن المسألة مرتبطة بتعرّض معظم أفراد تلك المجموعات لأحداث كبرى، تلك الأحداث تصنع رؤى جمالية وأشكال أدبية جديدة، الأمر إذن ليس مرتبطاً بأعمار أولئك الأدباء، وللأسف في مصر يتم التقسيم وفقاً للأعمار، أو بتقسيم عِقدي يخرّج دفعة كل عشرة أعوام، وهذا أمر غير منطقي، وهذا التقسيم ذو السنوات العشر وضعه الأكاديميون، وبعض أصحاب المصالح ممن يحتمون وسط جيل يتساوى فيه أفراده، مثلاً، كيف يمكننا التمييز بين من كتبوا الرواية في الستينيات والسبعينيات في مصر؟ كتاب جيل الستينيات أنفسهم لم يكن الواحد منهم قد كتب رواية أو أكثر في عقد الستينيات نفسه، مثل صنع الله إبراهيم وعبد الحكيم قاسم، ثم انطلق الزخم الروائي مع السبعينيات، الذي شهد تدفق روايات الستينيين، وكذلك الأدباء الذين كتبوا في السبعينيات مثل عبده جبير ومحمود الورداني وغيرهما، أعتقد أن السبعينيات هي السنوات الحقيقية للرواية المصرية.
لكن رغم ذلك، ووفقاً لمصطلح «الرواية الستينية» وجيل الستينيات، فأنا أرى أن السرد المصري منذ تلك الفترة وحتى 25 يناير/كانون الثاني هو رواية ستينية بشكل أو بآخر، كلها تيارات للفكرة ذاتها، الهزيمة والتشظي والانسحاق والعشوائيات وأفول القومية.. إلخ، والآن سأنتظر كتابة مغايرة بسبب الأحداث الكبرى التي عاشتها مصر».
أجيال وجماعات مصرية
الشاعر والروائي صبحي موسى، يرصد ظاهرة الجماعات الأدبية التي تكون نواة لجيل، يقول موسى: «لا أحد يعرف من أين أتت فكرة الأجيال، لكنها تسمية تشيع مع توافر مجموعة من الأدباء المتقاربين عمرياً وأحياناً مكانياً، تجمعهم في البدء ظروف اجتماعية متشابهة تترك أثرها على رؤيتهم للعالم من حولهم، ومن ثم تنطلق التسمية وتشيع ويتكاثر المنتمون إلى هذه المجموعة طالما حدث تحقق ملائم لبعض عناصرها، هذا ما حدث في جيل 27 في إسبانيا الذي يضم لوركا، وتكرر في أربعينيات القرن مع المجموعة التي عرفت بالجيل المهزوم في أمريكا، ومن بينها آلن جنسبرج وجاك كيرواك، وتكرر الأمر مع ما عرف بجيل 47 الذي ظهر بعد الحرب العالمية الثانية في ألمانيا، وكان من بينه غونتر غراس، لكن هذه في أغلبها تسميات يطرحها أبناء المجموعة لتمييز أنفسهم، وعادة ما يتوقف النقد ورجاله أمامها كثيراً عندما يتحقق أبناء هذا الجيل، ولابد أن ثمة حركات وأجيالا ومجموعات كثيرة أغفلها التاريخ لعدم بروز أبنائها، ولم تكن مصر بعيدة عن هذا الحراك العالمي ففي الأربعينيات كانت لدينا جماعة «الخبز والحرية» و«مدرسة الديوان» و»مدرسة المهجر» و»الإحيائيين»، وفي الخمسينيات تحوّلت فكرة المدارس إلى فكرة الريادة للقصيدة الحديثة، وفي الستينيات ظهرت مجلة «غاليري 68» التي التف حولها جيل الستينيات وسرعان ما توسعت الفكرة لتصبح جيل الستينيات، وفي نهاية السبعينيات وأوائل الثمانينيات كانت لدينا جماعتا «أصوات» و«إضاءة» اللتان توزع بينهما أبناء السبعينيات، وسرعان ما انتفت الأسماء لنجد أنفسنا أمام كلمة جيل، وفي نهاية الثمانينيات بداية التسعينيات ظهرت مجموعة «الجراد» التي اعتبرت بداية لجيل التسعينيات، رغم أن مؤسسها هو أحد شعراء السبعينيات، وأحد أبناء الجماعتين السابقتين».
ويواصل صاحب «الموريسكي الأخير»: «ربما كان النقاد هم سبب تحويل الجماعات إلى أجيال لدينا تسهيلاً للتعامل النقدي، لكن ذلك لا ينفي أن الأحداث التي مرت بها مصر وربما المنطقة العربية كانت لها تأثيراتها المختلفة التي أحدثت تبايناً في الكتابة، فثورة يوليو/تموز أنتجت جيلاً ينتمي لفكرتها، ومع الستينيات ظهرت فكرة القومية العربية، وفي السبعينيات وبداية الثمانينيات جاءت فكرة الهزيمة رغم نصر أكتوبر/تشرين الأول، ربما لأن فكرة القومية نفسها لاقت هزيمة واضحة بعد النكسة ومع توقيع مصر لمعاهدة كامب ديفيد، وربما الجيل الوحيد الذي لا يمكننا القول إن به ملامح جيل هو الثمانينيات، نظراً لتقارب كتابته مع التسعينيين، فضلاً عن وقوعه في أزمة التوزع بين الكتابة السبعينية والكتابة الجديدة لدى شعراء النثر في التسعينيات، وبالتالي لم يستطيعوا طرح مشروع أو حتى تكتل واضح، فضلاً عن عدم تحقق الكثيرين منهم بشكل يلفت الانتباه لهم كجماعة أو جيل على نقيض السبعينيين والستينيين».
أجيال أم شلليات؟
الروائي محمود الغيطاني، الحائز جائزة ساويرس عن رواية «كادرات بصرية» يرفض التصنيف الحقبي وفكرة الأجيال، يقول الغيطاني: «ليس هناك في الحقيقة ما يمكن أن نُطلق عليه جيل الستينيات، أو جيل السبعينيات، أو غيرها من هذه التسميات التي لا معنى لها، وليس من الطبيعي أو المنطقي القول بأن هذا هو جيل الهزيمة، بينما غيرهم هو جيل الانتصار، وذاك هو جيل الثورة. مثل هذا التقسيم الفج، والمفتئت على الكتاب والمبدعين لا وجود حقيقيا له؛ فالإبداع هو مسيرة بدأت وتظل تسير من دون هذا التصنيف، ولكن من الممكن بالفعل أن نستخدم مثل هذا التقسيم الزمني أو الحقبي في مقام الدراسات النقدية، أو التأريخ للأدب فقط؛ لأن الباحث هنا يحاول أن يُسهل الأمر على نفسه، أو حصر الفترة الزمنية التي يتحدث عنها بحثه، وبالتالي فهو يُحدد الفترة التي يعمل عليها، أما تقسيم الأدب بمثل هذا الشكل الذي من الممكن استخدامه في البحث، هو في حقيقة أمره مفسدة للمسيرة الإبداعية الأدبية، كما أن شيوع مثل هذه التقسيمات ساهم فيه الكثير من الصحافيين والمفسدين من الشلليات في الوسط الثقافي الذي تحاول فيه كل شلّة أدبية أبناء مرحلة عمرية واحدة، أن يكونوا «غيتو» منفصل عن غيرهم ممن سبقوهم أو جاءوا بعدهم، وبالتالي يصورون للجميع في شكل زائف أن هذه الحقبة، أو هذه الشلة هي الأفضل إبداعياً، أو أنها التي حملت لواء الإبداع وحدها، وكل من هو غيرها باطل وقبض الريح، وهذا زيف ودعارة ثقافية يمارسها الكثيرون من الكتاب وأدعياء الثقافة».
الكُتّاب سُلالات
أما الروائي أحمد عبد اللطيف، الحائز جائزة الدولة التشجيعية عن روايته «صانع المفاتيح»، فله رأي مغاير، يقول عبد اللطيف: «لا أعرف إن كانت هناك أجيال أدبية أم لا، لكن أعرف أن النقّاد عادةً ما يكونون في حاجة إلى عمل إطارات ووضع الكُتّاب بداخلها، أعتقد أنهم بهذه الطريقة يسهّلون عملهم: هؤلاء الأفراد ينتمون إلى جيل بعينه وبالتالي يمكن البحث عن السمات الخاصة بهذا الجيل. مع ذلك لا أرفض فكرة الأجيال، بشكل ما أعتقد أن الكاتب ابن مجتمعه، وبشكل ما أعتقد أن مجموعة كُتّاب يعيشون في فترة زمنية واحدة وفي ظرف سياسي واجتماعي واحد قد تجمعهم سمات مشتركة. هذه السمات لا تلغي فردية كل كاتب، ولا تلغي خصوصية رؤيته للعالم، لا تلغي بحثه عن تطوير نفسه أو قراءة واقعه بشكل يخصه. لكن بعيداً عن فكرة الأجيال، أصدق أكثر أن «الكُتّاب أُسر»، وأن «الكُتّاب سلالات»، أصدق بشكل أساسي أن هناك مبدعين تتفق رؤيتهم للعالم رغم البعد الزماني والمكاني، أصدق أن هناك أسرة بلزاك، أسرة ديستوفسكي، أسرة كافكا، وفي كل الأجيال هناك من ينتمي إلى كل أسرة منها، أو لا ينتمي إلى أي منها، غير أن الانتماء لا يعني التقليد، لا يعني السير بالمسطرة على الخطوط المرسومة سلفاً، بل يعني، في ظنّي، التطوير داخل هذه الأسرة السردية. يبدو لي مثلاً أن ساراماغو هو التطور لبورخس الذي ينتمي لأسرة كافكا، يبدو لي أن ألبير كامو ينتمي للأسرة نفسها. ورغم الخيوط الممتدة من أحدهم للآخر، لا يمكن أن تعتقد أنهم ينتمون للجيل نفسه، بالإضافة لذلك، النقاد يضعون أيضاً إطاراً خاصاً بالتيار الأدبي، يقولون هؤلاء يكتبون الواقعية، هؤلاء يكتبون الفانتازيا، هؤلاء يكتبون السريالية، في حين أن المبدع نفسه ربما يكون غير معني بهذه الإطارات، وربما يرفض اختزال عمله في لافتة ينتمي إليها بجزء من كتابته، فيما تنتمي الأجزاء الأخرى لشيء آخر».