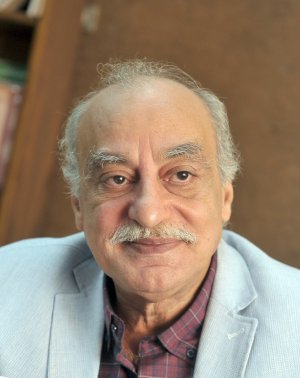الموت ليس النهاية، من يعرف يدرك أنه البداية.
الظلام الذي صاحب الليل داهم أفكاري المشتتة، الساعة تجاوزت العاشرة مساءً بقليل، أعمدة الإنارة حدث بها خلل ما أطفأها، ولسعة برد تؤلم أذني، أمرُّ مسرعًا من أمام «جروبي» قصر النيل، طريقي اليومي المعتاد ما بين مكتبي القريب من هذا المكان، وسيارتي القابعة على بعد شارع واحد في جراج أسفل أحد العقارات..
قفز أمامي فجأة.. لا أعرف من أين.. وقف يتأملني مليًّا.. لم أعِرْهُ اهتمامًا بادئ الأمر وإن بدا شكله مألوفًا لي بشكل ما.. اقترب مني ببطء وهو يتفرسني، ثم صاح صيحة مباغتة وهو يفتح ذراعيه:
- معقول.. نجيب العشري.
مددت يدي بصورة تلقائية أصافحه... أما هو فقد فرد ذراعيه ليأخذني بالأحضان في عناق حميم.. شعرت ببرودة تسري بأوصالي.. وقشعريرة جعلتني أنتفض.. حتى رائحته كانت غريبة.. أجهدْت ذاكرتي حتى أتذكره ولكن الذاكرة لم تسعفني، تساءلت: هل هو شخص وكَّلني ذات يوم بقضية ما؟! وحين شعر بفتور عناقي ابتعد قليلًا وهو يردد:
- طبعًا لا تتذكرني.. أكيد لا تتذكرني.. عيب عليك يا رجل.. تنسى صاحبك وحبيبك!
غمغمت متصنعًا أني بدأت أتذكره.. فسارع حتى لا يشعرني أو يشعر نفسه بالحرج قائلًا وهو يشير لنفسه:
- شكري.. شكري الدهشان.. مدرسة «العهد» الابتدائية يا رجل، لقد كنا في صفٍّ واحد، لا يفصلنا عن بعض غير أمتار قليلة.
تذكرت الاسم.. وإن كان الشكل تبدل بشكل كبير، ضربت رأسي بكفي كمن استعاد الوعي فجأة، صحت غير مصدِّق:
- يا ابن الـ... معقول.. شكري؟! شكلك تغيَّر خالص.. تخيَّل لم أعرفك!
- أكثر من خمس وعشرين سنة.
قالها وهو يتنهد بأسى عميق كأن صوته خارج من قبر.. مما أثار دهشتي.. أين شكري ذو الوجه المتورد؟! أين ضحكته التي كانت لا تنقطع أبدًا؟! ما هذا الأسى النبيل المرسوم على وجهه؟!
ضرب على بطنه الكبير قائلًا:
- لازم نقعد مع بعض.. نتعشى معًا عندي بالبيت.. أظن يوم الخميس يناسبك.. ليتك تحضر المدام.. والأولاد أيضًا... عصام وعزت... يوم الخميس.. إياك تنسى، ما أجمل ملاقاة الأصدقاء القدامى.
حاولت الاعتذار ولكنه لم يترك لي فرصة قائلًا:
- آه لو تعلم كم انتظرت لقاءك لدرجة اليأس، ولكنك ها هنا الآن.
أخرج ورقة بيضاء كتب عليها بسرعة بعض الأشياء قائلًا:
- ها هو العنوان، وهذا هو الرقم، إياك أن تضيعه... وأنت... كم رقمك؟
سألني وهو ممسك بالموبايل... رددت رقمي فسجله وقال في عجالة:
- آسف يا نجيب... عندي موعد هام لا أستطيع تأجيله أكثر من هذا، سأنتظرك يوم الخميس... لن أقبل أعذارًا، إياك أن تنسي هذا الرقم.
أنطلق مهرولًا وأنا أتلفت حولي بذهول.. فظروفي لا تترك لي فراغًا كافيًا لمثل هذه العلاقات الاجتماعية.. ففي النهار أتنقل بأروقة المحكمة متخبطًا بين قاعاتها.. وبالليل مقابلة العملاء والسهر على ملفات القضايا.. حتى إخوتي لا أراهم إلَّا في المناسبات؛ كخطبة أو زواج أحد الأبناء.. وطبعًا في زيارة قبر والدي بالأعياد، أما الولدان فمنذ زمن ألقيت مسؤوليتهما على زوجتي.
تأملت الورقة التي قدمها لي.. لا يوجد بها أي بيانات عنه.. اسمه فقط «شكري الدهشان» تساءلت ماذا يعمل؟!.. محامٍ.. محاسب.. مهندس.. طبيب؟ رقم التليفون والعنوان اللذين تركهما لي كتبهما بخط يده.. الرقم عادي وليس «موبايل» كما قال، وبجواره كلمة «القاهرة».. ولكن كيف عرف اسمي ولديَّ، فأنا لم أره من أيام الطفولة؟!
الأشكال تتغير بطبيعة الحال، ولكن الملامح تظل راسخة وإن طال الزمن، اجتررت ذكرياتي معه كأنها تخرج من سرداب معتم، شقاوته كانت مثيرة للدهشة، خفة ظله التي كانت تجعلنا نضحك من القلب طوال اليوم الدراسي... كم أشتاق لتلك الأيام، ما كنا نحمل في جعبتنا غير اللهو والمرح، أما الآن فالمسؤوليات لا تنتهي، تربطك بخيط ذهبي جميل، ولكنه ملتف حول رقبتك، إن حاولت الفكاك منه بأي صورة كانت تجده يحزّ عنقك ببطء قاتل.
جاء صباح يوم الخميس، كان لا بد من زيارة شكري بالمساء، شعرت أني مثقل بشيء ما، هلاوس وكوابيس مختلفة هاجمتني بلا رحمة طوال الليل، أرجعت كل هذا إلى العشاء الدسم الذي أعدَّته لي زوجتي ليلة أمس..
اعتذرت زوجتي لإصابتها بنزلة برد شديدة... ورفض الولدان أن يأتيا معي... فالخميس بالنسبة لهما هو يوم الانعتاق من المذاكرة والهموم الدراسية.. وهو يوم خروجهما مع الأصدقاء حيث اللهو البريء... لا يحق لي أن أقيدهما بهذا الموعد مع صديق قديم لا يعرفون عنه شيئًا، حتى أنا قررت الاعتذار..
جربت الرقم على كل الوجوه الممكنة، التليفون العادي وخطوط المحمول، ولكن دائمًا الرسالة نفسها.. «هذا الرقم غير موجود بالخدمة»!!.. ربَّما أخطأ بكتابة رقم ما.
وجدت نفسي أرتدي ملابسي وأركب سيارتي متوجهًا إلى العنوان الذي معي.. حدَّثت نفسي.. لا يجب الذهاب له دون إحضار هدية ما، يجب أن آخذ معي علبة حلوى على الأقل، فهي المرة الأولى التي أقوم فيها بزيارته، عرجت بطريقي على أحد المحلات الشهيرة بوسط البلد، الزحام والتدافع بهذا المحل جعلني أعيد التفكير في تلك الزيارة.. نظرت للساعة بتبرم وأنا ألقي بثقلي كله على أحد العاملين وأنفحه ورقة بعشرة جنيهات، في النهاية ظفرت بالعلبة وانطلقت بطريقي، لا أشك أنه ما زال يحتفظ بخفة ظله التي عهدتها به، منَّيتُ نفسي بقضاء أمسية لا تخلو من البهجة.
أتطلع لطفل صغير لصق وجهه بنافذة السيارة التي بجواري في إشارة المرور، أشير له فيبتسم بسعادة، أتساءل.. أي مستقبل ينتظره؟ الإشارة الخضراء تجعل السيارات تتسابق.
وضعت يدي على الجرس... وبعد هنيهة فتحت لي امرأة في عقدها الرابع.. ترتدي فستانًا أسود طويلًا.. مسحة حزن مرسومة فوق وجهها، نظرت لي بدهشة وهي تسألني:
- أي خدمة؟!
ابتسمت لها ابتسامة عريضة.. لا بُدَّ أنها زوجته.. ناظرًا إلى الأرض وعلى استحياء:
- شكري.. الأستاذ شكري.
لم أفهم بماذا تمتمت وهي تفتح الباب على مصراعيه، قدمت لها علبة «الجاتوه» فنظرت لي بذهول ولم تحاول أخذها مني، استدارت تتقدمني لغرفة الصالون وصوت ترتيل القرآن ينساب في أذني.. تبعتها للغرفة فوجدت بعض الأشخاص يجلسون والنساء يتَّشحن بالسواد.. وقفت مشدوهًا وجذبت يد المرأة متسائلًا:
- شكري؟!
نظرت لي باستنكار والدموع في عينيها وغمغمت:
- هو أنت من أصدقائه؟!
وقف أحد الحضور وقد شعر بالحرج الذي أواجهه فمد يده مصافحًا، وجذبني لأجلس وهو يهمس لي بحزن:
- تفضل يا أستاذ.. يبدو أنك لم تعرف بعد.. اليوم ذكرى أربعين المرحوم شكري.
سقطتُ على المقعد واجمًا، قلبت علبة الحلوى بين يدي ربَّما تحمل لي فهمًا لما يحدث، لم أعرف ماذا أصنع بها.. وضعتها على المنضدة بخزي غير مصدق ما أسمع، همهمت، الأربعين؟! كيف؟! أتذكر الحدث.. منذ ثلاثة أيام.. لم يمضِ على لقائنا غير ثلاثة أيام.
تطوع شخص قائلًا:
- تخيل العربة دهسته في عز النهار ولم يستطع أي شخص أخْذ نمرة السيارة التي هربت مسرعة.
ردد شخص آخر:
- من يصدق هذا؟ بوسط البلد وقدام «جروبي» والدنيا مزدحمة ومليئة بالناس، ورغم هذا استطاع الهروب بالسيارة، لم يفكر حتى في التوقف ليسعفه، أو يعرف ماذا حدث له.
- الظاهر لا أحد صار عنده ضمير.
أخرجت الورقة من جيبي والدنيا تدور بي.. نظرت للرقم المكتوب... رقم السيارة المجهول.. القاهرة... مددت يدي لزوجته بالورقة وجسدي كله يرتعد مرددًا بذهول:
- قدام «جروبي»!! قدام «جروبي»!! رقم السيارة.. من ثلاث أيام.. شكري!!
الظلام الذي صاحب الليل داهم أفكاري المشتتة، الساعة تجاوزت العاشرة مساءً بقليل، أعمدة الإنارة حدث بها خلل ما أطفأها، ولسعة برد تؤلم أذني، أمرُّ مسرعًا من أمام «جروبي» قصر النيل، طريقي اليومي المعتاد ما بين مكتبي القريب من هذا المكان، وسيارتي القابعة على بعد شارع واحد في جراج أسفل أحد العقارات..
قفز أمامي فجأة.. لا أعرف من أين.. وقف يتأملني مليًّا.. لم أعِرْهُ اهتمامًا بادئ الأمر وإن بدا شكله مألوفًا لي بشكل ما.. اقترب مني ببطء وهو يتفرسني، ثم صاح صيحة مباغتة وهو يفتح ذراعيه:
- معقول.. نجيب العشري.
مددت يدي بصورة تلقائية أصافحه... أما هو فقد فرد ذراعيه ليأخذني بالأحضان في عناق حميم.. شعرت ببرودة تسري بأوصالي.. وقشعريرة جعلتني أنتفض.. حتى رائحته كانت غريبة.. أجهدْت ذاكرتي حتى أتذكره ولكن الذاكرة لم تسعفني، تساءلت: هل هو شخص وكَّلني ذات يوم بقضية ما؟! وحين شعر بفتور عناقي ابتعد قليلًا وهو يردد:
- طبعًا لا تتذكرني.. أكيد لا تتذكرني.. عيب عليك يا رجل.. تنسى صاحبك وحبيبك!
غمغمت متصنعًا أني بدأت أتذكره.. فسارع حتى لا يشعرني أو يشعر نفسه بالحرج قائلًا وهو يشير لنفسه:
- شكري.. شكري الدهشان.. مدرسة «العهد» الابتدائية يا رجل، لقد كنا في صفٍّ واحد، لا يفصلنا عن بعض غير أمتار قليلة.
تذكرت الاسم.. وإن كان الشكل تبدل بشكل كبير، ضربت رأسي بكفي كمن استعاد الوعي فجأة، صحت غير مصدِّق:
- يا ابن الـ... معقول.. شكري؟! شكلك تغيَّر خالص.. تخيَّل لم أعرفك!
- أكثر من خمس وعشرين سنة.
قالها وهو يتنهد بأسى عميق كأن صوته خارج من قبر.. مما أثار دهشتي.. أين شكري ذو الوجه المتورد؟! أين ضحكته التي كانت لا تنقطع أبدًا؟! ما هذا الأسى النبيل المرسوم على وجهه؟!
ضرب على بطنه الكبير قائلًا:
- لازم نقعد مع بعض.. نتعشى معًا عندي بالبيت.. أظن يوم الخميس يناسبك.. ليتك تحضر المدام.. والأولاد أيضًا... عصام وعزت... يوم الخميس.. إياك تنسى، ما أجمل ملاقاة الأصدقاء القدامى.
حاولت الاعتذار ولكنه لم يترك لي فرصة قائلًا:
- آه لو تعلم كم انتظرت لقاءك لدرجة اليأس، ولكنك ها هنا الآن.
أخرج ورقة بيضاء كتب عليها بسرعة بعض الأشياء قائلًا:
- ها هو العنوان، وهذا هو الرقم، إياك أن تضيعه... وأنت... كم رقمك؟
سألني وهو ممسك بالموبايل... رددت رقمي فسجله وقال في عجالة:
- آسف يا نجيب... عندي موعد هام لا أستطيع تأجيله أكثر من هذا، سأنتظرك يوم الخميس... لن أقبل أعذارًا، إياك أن تنسي هذا الرقم.
أنطلق مهرولًا وأنا أتلفت حولي بذهول.. فظروفي لا تترك لي فراغًا كافيًا لمثل هذه العلاقات الاجتماعية.. ففي النهار أتنقل بأروقة المحكمة متخبطًا بين قاعاتها.. وبالليل مقابلة العملاء والسهر على ملفات القضايا.. حتى إخوتي لا أراهم إلَّا في المناسبات؛ كخطبة أو زواج أحد الأبناء.. وطبعًا في زيارة قبر والدي بالأعياد، أما الولدان فمنذ زمن ألقيت مسؤوليتهما على زوجتي.
تأملت الورقة التي قدمها لي.. لا يوجد بها أي بيانات عنه.. اسمه فقط «شكري الدهشان» تساءلت ماذا يعمل؟!.. محامٍ.. محاسب.. مهندس.. طبيب؟ رقم التليفون والعنوان اللذين تركهما لي كتبهما بخط يده.. الرقم عادي وليس «موبايل» كما قال، وبجواره كلمة «القاهرة».. ولكن كيف عرف اسمي ولديَّ، فأنا لم أره من أيام الطفولة؟!
الأشكال تتغير بطبيعة الحال، ولكن الملامح تظل راسخة وإن طال الزمن، اجتررت ذكرياتي معه كأنها تخرج من سرداب معتم، شقاوته كانت مثيرة للدهشة، خفة ظله التي كانت تجعلنا نضحك من القلب طوال اليوم الدراسي... كم أشتاق لتلك الأيام، ما كنا نحمل في جعبتنا غير اللهو والمرح، أما الآن فالمسؤوليات لا تنتهي، تربطك بخيط ذهبي جميل، ولكنه ملتف حول رقبتك، إن حاولت الفكاك منه بأي صورة كانت تجده يحزّ عنقك ببطء قاتل.
جاء صباح يوم الخميس، كان لا بد من زيارة شكري بالمساء، شعرت أني مثقل بشيء ما، هلاوس وكوابيس مختلفة هاجمتني بلا رحمة طوال الليل، أرجعت كل هذا إلى العشاء الدسم الذي أعدَّته لي زوجتي ليلة أمس..
اعتذرت زوجتي لإصابتها بنزلة برد شديدة... ورفض الولدان أن يأتيا معي... فالخميس بالنسبة لهما هو يوم الانعتاق من المذاكرة والهموم الدراسية.. وهو يوم خروجهما مع الأصدقاء حيث اللهو البريء... لا يحق لي أن أقيدهما بهذا الموعد مع صديق قديم لا يعرفون عنه شيئًا، حتى أنا قررت الاعتذار..
جربت الرقم على كل الوجوه الممكنة، التليفون العادي وخطوط المحمول، ولكن دائمًا الرسالة نفسها.. «هذا الرقم غير موجود بالخدمة»!!.. ربَّما أخطأ بكتابة رقم ما.
وجدت نفسي أرتدي ملابسي وأركب سيارتي متوجهًا إلى العنوان الذي معي.. حدَّثت نفسي.. لا يجب الذهاب له دون إحضار هدية ما، يجب أن آخذ معي علبة حلوى على الأقل، فهي المرة الأولى التي أقوم فيها بزيارته، عرجت بطريقي على أحد المحلات الشهيرة بوسط البلد، الزحام والتدافع بهذا المحل جعلني أعيد التفكير في تلك الزيارة.. نظرت للساعة بتبرم وأنا ألقي بثقلي كله على أحد العاملين وأنفحه ورقة بعشرة جنيهات، في النهاية ظفرت بالعلبة وانطلقت بطريقي، لا أشك أنه ما زال يحتفظ بخفة ظله التي عهدتها به، منَّيتُ نفسي بقضاء أمسية لا تخلو من البهجة.
أتطلع لطفل صغير لصق وجهه بنافذة السيارة التي بجواري في إشارة المرور، أشير له فيبتسم بسعادة، أتساءل.. أي مستقبل ينتظره؟ الإشارة الخضراء تجعل السيارات تتسابق.
وضعت يدي على الجرس... وبعد هنيهة فتحت لي امرأة في عقدها الرابع.. ترتدي فستانًا أسود طويلًا.. مسحة حزن مرسومة فوق وجهها، نظرت لي بدهشة وهي تسألني:
- أي خدمة؟!
ابتسمت لها ابتسامة عريضة.. لا بُدَّ أنها زوجته.. ناظرًا إلى الأرض وعلى استحياء:
- شكري.. الأستاذ شكري.
لم أفهم بماذا تمتمت وهي تفتح الباب على مصراعيه، قدمت لها علبة «الجاتوه» فنظرت لي بذهول ولم تحاول أخذها مني، استدارت تتقدمني لغرفة الصالون وصوت ترتيل القرآن ينساب في أذني.. تبعتها للغرفة فوجدت بعض الأشخاص يجلسون والنساء يتَّشحن بالسواد.. وقفت مشدوهًا وجذبت يد المرأة متسائلًا:
- شكري؟!
نظرت لي باستنكار والدموع في عينيها وغمغمت:
- هو أنت من أصدقائه؟!
وقف أحد الحضور وقد شعر بالحرج الذي أواجهه فمد يده مصافحًا، وجذبني لأجلس وهو يهمس لي بحزن:
- تفضل يا أستاذ.. يبدو أنك لم تعرف بعد.. اليوم ذكرى أربعين المرحوم شكري.
سقطتُ على المقعد واجمًا، قلبت علبة الحلوى بين يدي ربَّما تحمل لي فهمًا لما يحدث، لم أعرف ماذا أصنع بها.. وضعتها على المنضدة بخزي غير مصدق ما أسمع، همهمت، الأربعين؟! كيف؟! أتذكر الحدث.. منذ ثلاثة أيام.. لم يمضِ على لقائنا غير ثلاثة أيام.
تطوع شخص قائلًا:
- تخيل العربة دهسته في عز النهار ولم يستطع أي شخص أخْذ نمرة السيارة التي هربت مسرعة.
ردد شخص آخر:
- من يصدق هذا؟ بوسط البلد وقدام «جروبي» والدنيا مزدحمة ومليئة بالناس، ورغم هذا استطاع الهروب بالسيارة، لم يفكر حتى في التوقف ليسعفه، أو يعرف ماذا حدث له.
- الظاهر لا أحد صار عنده ضمير.
أخرجت الورقة من جيبي والدنيا تدور بي.. نظرت للرقم المكتوب... رقم السيارة المجهول.. القاهرة... مددت يدي لزوجته بالورقة وجسدي كله يرتعد مرددًا بذهول:
- قدام «جروبي»!! قدام «جروبي»!! رقم السيارة.. من ثلاث أيام.. شكري!!