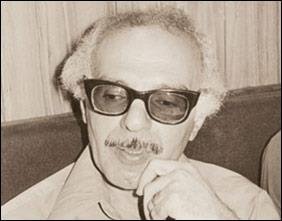يظل فهم منجز محمود البريكان (1931ـ 2002)، وتحديد موقعه في الشعرية العراقية غير مكتمل إذا لم يُنظر له بوصفه حالة شعرية، لها من الخصوصية ما يوطد صلتها بجوهر تجربة الإنجاز الشعري، مثلما يتعدى بدوره حدود الزمان والمكان منتقلاً بها إلى الأقاصي المضيئة للتجربة الإنسانية حيث سؤال الحرية يجدد الوجود ويمجد الإنسان.
كما سيظل فهم حالة محمود البريكان قاصراً إذا ما نُظر لمنجزه الشعري بوصفه مادة أولى وأخيرة في التعبير عن رؤيا الشاعر وإدراك موقفه بمواجهة رياح العالم، ووعي نزوعه إلى شيء أبعد من الراهن وأكبر من الموجود. للنثر في حالة محمود البريكان موقع حاسم يُغني الشعر ويغتني به، فليس النثر، بجملة البريكان، "نقيض الشعر. نقيضه الحق هو النظم الرديء"، وبقدر ما تعالج هذه المسكوكة قضية الثنائية المتضادة بين الشعر الجيد والشعر الرديء، تخلّص النثر من شبهة التقابل الضدي مع الشعر، وتُسقط فكرة التعارض والانفصال بينهما، فتقرّب مسافات وتمحو حدوداً، وذلك ما عمل البريكان على تمثله في تجربته الكتابية وقد حرص على النثر حرصه على الشعر في عالم تشكّله اللغة، لا يكون الشعر فيه " تظاهرة لفظية" بقدر ما يكون تجسيدا حياً لنزوع الإنسان بما يتجاوز حدود اللعب ليُعدّ " تجربة فريدة تتجسد عبر اللغة".
عمل البريكان عبر نصوص نثرية قليلة ـ أحكام الكم والمعيارية الشعرية تظل سارية في حالته على النثرـ على تلمّس فرادة هذه التجربة والوقوف على حدودها القصية، ليصح على إرثه النثري ما صح على إرثه الشعري، ومما يُدخله في حكمه توفره على أدوات الشعر التي يكتمل جماعها حال "اكتمال العقل الذي به تتميز الأضداد" كما ينصُّ صاحب عيار الشعر.
وإذا كان منجز محمود البريكان الشعري قد حقق حضوره ضمن حركية الحداثة العربية التي تجلت أول إرهاصاتها في أربعينيات القرن العشرين فإنه ظل لعقود طويلة محكوماً باشتراطاته الخاصة التي منحته فهماً شخصياً للشعر لم يتنازل عنه حتى نهاية حياته، مثلما ظل النثر محكوماً بهذه المعيارية التي لم تكن تتحدد، كما يبدو، بالشعر وحده إنما كانت تُضاء به جوهراً للإبداع الإنساني، لتسري الندرة على منجزه النثري سريانها على شعره.
إن فكرة (ليس ثمة نثر) التي تحدّث عنها أوكتافيو باث، تجد تحققها في منجز البريكان الذي لم يضع حداً بين نوعين كتابيين، كما لم ينظر لهما نظرة تراتبية تمنح الشعر درجة عالية في سلّم الإبداع فيما يأتي النثر تالياً في درجة أدنى. إن النثر الخاضع عادة إلى توجيه العقل ينزع كما ينصُّ باث " إلى إعطاء كل كلام، وكل جملة، دلالة واحدة. وبما أن الدلالة الواحدة مثال متعذر، وغير قابل للتحقيق، فليس هناك نثر في الواقع". إن النثر، بهذا التصوّر، نوع من صياغة شعرية قوامها تعدد الدلالات. صياغة لا ينجزها المجاز وحده، ولا تسمو في جناح من خيال. إن ثراءً دلالياً يُحرّك النثر باتجاه الشعر، يقرّبه إليه في صياغة تتعدى الراهن بقدر ما تتصدى له، تغور في أعماقه كي تنظر إليه، وهو ما تحقق في حالة محمود البريكان الذي أنتج مقولات نثرية تخضع لتوجيه العقل وتعمل على ترجمته ترجمة شعرية حددت قيمتها وأكدت فاعليتها في ضوء ما أحرزته من موقع في تجربته الإبداعية.
في الذكرى السادسة لرحيل بدر شاكر السياب في العام 1971، قدم محمود البريكان ورقة بعنوان (خواطر حول محنة الشعراء) حيث يطلّ الشعر، مع العنوان، محنة لا منحة، يستقطر الشاعر فيها حكمة الأجيال، ويسبر أغوار الحزن والفرح نازلاً إلى أعماق الشعور الإنساني، إلى جوهره الناصع، من أجل أن"يطلق جناحيه في أبعاد الكون". إن اللحظة العسيرة في محنة الشعراء، بتصور البريكان، هي اللحظة التي تتجسد " في أحلك الأزمنة، حينما يزحف الظلام على العالم، حيث تبقى لامعة عيون الأطفال، وأصوات الشعراء".
يتأمل البريكان غربة الشعراء أمام المنابر، التيه الذي يشعرونه بمواجهة الأضواء البرّاقة، حزنهم أمام التماثيل، مضيئاً المناسبة التي شُيّد فيها تمثال السياب في البصرة، موحداً بين حنين الشعراء وأحلامهم:
" إلام يحنُّ الشعراء؟ وفيم يحلمون؟
وهل لحلم الشاعر نسخة أخرى؟"
إنه يعبّر عن فهمه للشعر والشعراء، عن دور كل منهما في حركة العصور ودورة الزمان، فالشاعر الذي مثّل في تصوّره بشارة التاريخ، يظل بالنسبة له "شاهد العصور، ترجمان الطموح الأعمق في قلب الأرض"، وهو التصوّر الذي عبّر عنه البريكان قبل سنوات من كلمته تلك، فقد كتب في افتتاحية العدد الثاني من مجلة (الفكر الحي) البصرية التي شغل رئاسة تحريرها مع الدكتور محمد جواد الموسوي إن حب الحقيقة "يبلغ أن يكون نوعاً من الاستشهاد. هنا، لا في الضجيج الفاني، يكمن أمجد أمجاد الإنسان". تلك الكلمة التي استعار لها أمثولة نبوية بعد أن عدّ المفكرين ملح الأرض، مستعيداً سؤال السيد المسيح "إن فسد الملح فبماذا يُملّح؟"
كما سيظل فهم حالة محمود البريكان قاصراً إذا ما نُظر لمنجزه الشعري بوصفه مادة أولى وأخيرة في التعبير عن رؤيا الشاعر وإدراك موقفه بمواجهة رياح العالم، ووعي نزوعه إلى شيء أبعد من الراهن وأكبر من الموجود. للنثر في حالة محمود البريكان موقع حاسم يُغني الشعر ويغتني به، فليس النثر، بجملة البريكان، "نقيض الشعر. نقيضه الحق هو النظم الرديء"، وبقدر ما تعالج هذه المسكوكة قضية الثنائية المتضادة بين الشعر الجيد والشعر الرديء، تخلّص النثر من شبهة التقابل الضدي مع الشعر، وتُسقط فكرة التعارض والانفصال بينهما، فتقرّب مسافات وتمحو حدوداً، وذلك ما عمل البريكان على تمثله في تجربته الكتابية وقد حرص على النثر حرصه على الشعر في عالم تشكّله اللغة، لا يكون الشعر فيه " تظاهرة لفظية" بقدر ما يكون تجسيدا حياً لنزوع الإنسان بما يتجاوز حدود اللعب ليُعدّ " تجربة فريدة تتجسد عبر اللغة".
عمل البريكان عبر نصوص نثرية قليلة ـ أحكام الكم والمعيارية الشعرية تظل سارية في حالته على النثرـ على تلمّس فرادة هذه التجربة والوقوف على حدودها القصية، ليصح على إرثه النثري ما صح على إرثه الشعري، ومما يُدخله في حكمه توفره على أدوات الشعر التي يكتمل جماعها حال "اكتمال العقل الذي به تتميز الأضداد" كما ينصُّ صاحب عيار الشعر.
وإذا كان منجز محمود البريكان الشعري قد حقق حضوره ضمن حركية الحداثة العربية التي تجلت أول إرهاصاتها في أربعينيات القرن العشرين فإنه ظل لعقود طويلة محكوماً باشتراطاته الخاصة التي منحته فهماً شخصياً للشعر لم يتنازل عنه حتى نهاية حياته، مثلما ظل النثر محكوماً بهذه المعيارية التي لم تكن تتحدد، كما يبدو، بالشعر وحده إنما كانت تُضاء به جوهراً للإبداع الإنساني، لتسري الندرة على منجزه النثري سريانها على شعره.
إن فكرة (ليس ثمة نثر) التي تحدّث عنها أوكتافيو باث، تجد تحققها في منجز البريكان الذي لم يضع حداً بين نوعين كتابيين، كما لم ينظر لهما نظرة تراتبية تمنح الشعر درجة عالية في سلّم الإبداع فيما يأتي النثر تالياً في درجة أدنى. إن النثر الخاضع عادة إلى توجيه العقل ينزع كما ينصُّ باث " إلى إعطاء كل كلام، وكل جملة، دلالة واحدة. وبما أن الدلالة الواحدة مثال متعذر، وغير قابل للتحقيق، فليس هناك نثر في الواقع". إن النثر، بهذا التصوّر، نوع من صياغة شعرية قوامها تعدد الدلالات. صياغة لا ينجزها المجاز وحده، ولا تسمو في جناح من خيال. إن ثراءً دلالياً يُحرّك النثر باتجاه الشعر، يقرّبه إليه في صياغة تتعدى الراهن بقدر ما تتصدى له، تغور في أعماقه كي تنظر إليه، وهو ما تحقق في حالة محمود البريكان الذي أنتج مقولات نثرية تخضع لتوجيه العقل وتعمل على ترجمته ترجمة شعرية حددت قيمتها وأكدت فاعليتها في ضوء ما أحرزته من موقع في تجربته الإبداعية.
في الذكرى السادسة لرحيل بدر شاكر السياب في العام 1971، قدم محمود البريكان ورقة بعنوان (خواطر حول محنة الشعراء) حيث يطلّ الشعر، مع العنوان، محنة لا منحة، يستقطر الشاعر فيها حكمة الأجيال، ويسبر أغوار الحزن والفرح نازلاً إلى أعماق الشعور الإنساني، إلى جوهره الناصع، من أجل أن"يطلق جناحيه في أبعاد الكون". إن اللحظة العسيرة في محنة الشعراء، بتصور البريكان، هي اللحظة التي تتجسد " في أحلك الأزمنة، حينما يزحف الظلام على العالم، حيث تبقى لامعة عيون الأطفال، وأصوات الشعراء".
يتأمل البريكان غربة الشعراء أمام المنابر، التيه الذي يشعرونه بمواجهة الأضواء البرّاقة، حزنهم أمام التماثيل، مضيئاً المناسبة التي شُيّد فيها تمثال السياب في البصرة، موحداً بين حنين الشعراء وأحلامهم:
" إلام يحنُّ الشعراء؟ وفيم يحلمون؟
وهل لحلم الشاعر نسخة أخرى؟"
إنه يعبّر عن فهمه للشعر والشعراء، عن دور كل منهما في حركة العصور ودورة الزمان، فالشاعر الذي مثّل في تصوّره بشارة التاريخ، يظل بالنسبة له "شاهد العصور، ترجمان الطموح الأعمق في قلب الأرض"، وهو التصوّر الذي عبّر عنه البريكان قبل سنوات من كلمته تلك، فقد كتب في افتتاحية العدد الثاني من مجلة (الفكر الحي) البصرية التي شغل رئاسة تحريرها مع الدكتور محمد جواد الموسوي إن حب الحقيقة "يبلغ أن يكون نوعاً من الاستشهاد. هنا، لا في الضجيج الفاني، يكمن أمجد أمجاد الإنسان". تلك الكلمة التي استعار لها أمثولة نبوية بعد أن عدّ المفكرين ملح الأرض، مستعيداً سؤال السيد المسيح "إن فسد الملح فبماذا يُملّح؟"