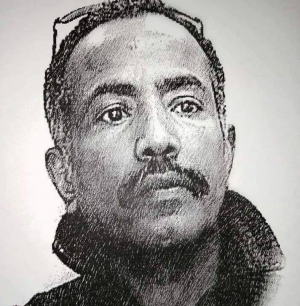من أقسى لحظات الصحو ، إلى أعنف حالات الجنون من الصمت المرتعش في الشفة السفلي حتى الغضب الفادح بنزق أزرق ، ينفر من عروق الجسد واختلاجات الحنجرة المعبأة بكلّ ما يمكن أن يعتلي الروح من صدأ ومن غضب ومن أرق وانفلات .. هكذا تأتي دائماً ، في نفثة الصباحات البغدادية ، مع فصول فيروز وضجيج الباعة ، مع رائحة دجلة واصطفاقات أمواجه غير بعيد عن ذؤابات أنوفنا ، تخترق المكتب المقفر إلآ من وجهي ، بسيماء الفاتحين ، لتقلب عالمي ب"صباح خير"ها المطعمة بابتسامة مألوفة ..
مع مطر الصباح لابدّ ستأتي .. وليرتجف قلبي مثل ملاءة ترفّ على ضفتيها الريح أمام دهشة حضورها .
في البدء ، أتظاهر بلا مبالاة عاجزة ، ثمّ أتطلّع إلى شعر أسود يسيل على الجانبين مخلياً الطريق إلى كوّتين تطلّ من خلالهما عينان خضراوان ، وشفتان تكوّرتا على هيئة حبّتي فستق ، سألقي عندهما ب"شوبنهاور" في قمامةٍ ما -أسفل جمجمتي - لأُقرّ ، مثله ، بأن الحياة تستحقّ أن تُعاش بأعذب تفاهاتها ..!
ما أن تدخل حتى تبدأ طقوس ضجيجها الصباحي الذي أدمنته : تُلقي حقيبتها على طرف الطاولة ، تُخرجُ أصابع زينتها ، تُخرج الميدالية التي تحمل إشراقة صورتها يوم كان لها شعر قصير وابتسامة أعنف براءة ، تجلس ، لتخلع حذاءها وتركن ركبتها على الطاولة ، وتأخذ بأرجحة قدميها وكأنها ترقص بكلاسيكيّة لذيذة .. وإذا ما بالغتُ بإطالة صبري ، بعدم التحدّث إليها لفترة أطول ، تتأوّه ودون أن تنتظر منّي ردّاً تشرع بسرد أخبارها الصغيرة التي سيكون عليّ الإصغاء لها بلذّة ناعسة ( ستحكي عن "الطاوة"التي شاطت ، وصراخ أمّها ، وطرق معالجة الباذنجان المحروق .. او ، في أحسن الأحوال ، عن مغامرة صغيرة في الطريق : لحقها أحدهم ، غمز لها أو ألقى تعليقاً حفظته لكثرة تردّده .. الخ ) . هكذا تهدر صاخبة متّخذة من فسحة أرض المكتب مساحة لها وهي تسدر في رواية تفاصيل يومها المملّة بعذوبة تتناغم وحركة حاجبيها واختلاجات صوتها وشفتيها ، بينما أصغي إليها ودوائر الدخان تشدّ الطوق حول رأسي ورقبتي أكثر فأكثر ..
( متناقض حدّ الصراخ .. أعلم ذلك ، وهو ما سيقودني إلى الجنون حتماً .. ) .
تذكرين يوم تنبّأنا بمستقبلنا هذا معاً ؟! .. "قرب السّكة " .. كنتِ تقولين ، وتشيرين ناحية أفقٍ ما قد يوصل إلى "ألشمّاعية" حيث مأوى المجانين .. وتضحكين :" مكان مضمون نكون فيه معاً .. بجنون رسمي موقّع ومختوم ..! "
(( نرتكب فيه أجمل ما توصّلت إليه عقولنا .. آه .. نعم عقولنا المريضة حدّ الصحو ، حدّ الإنطاق .. وبينما يصفنا جميع المتلصّصين هنا بأننا أجنّ اثنين ، سنصبح هناك أعقل اثنين ..! ))
تقولين "ربّما" ساهمة ، وأنت تضحكين ، أو ربّما مثلي تحلمين ، فأتوق لقظم تينكَ الشفتين اللتين تنعمان بإطلاق تلك ألكركرات من بينهما .
يوم قبّلتُكِ ، أوّل مرّة ، انتفضت بشدّة ، وكأنّكِ تحاولين تهشيم آخر قفص يترسّب فيكِ .. حدث ذلك قبل حوالي شهرين .. أتذكرين ؟! كان يوماً كهذا . ربّما أكثر دفئاً ، لأنّكِ كنتِ ترتدين "طقمك"ِ البنفسجي (أو البحري كما كان يلذّ لي أن أسمّيه ) : قميص بنفسجيّ بشفق أحمر ، تنّورة زرقاء ، والحذاء له نفس لون الأظافر المصطبغة بلون البنفسج ، وأقراط الزمرد المغشوش الذي لم يتمكن من سحل نظراتي المسلّطة على شفتيكِ الأكثر أوارا من نيران الغجر الملتهبة ، انتصبت واقفة ، حينها ، غير بعيد عن لهيب أصابعي ، بعدَ أن ملأتِ المكان بمشاعر منزليّة هادئة ، وانشغلت ، بعفويتكِ الخارقة الألفة ، بتعديل وضع حزامكِ الأسود ليقسّم خارطة جوعي إلى نصفين ، ثمّ مسحتِ تكويره صدركِ بباطن كفّيكِ دون أن تشهَدي شهقة التوق وهي تتسلّق شفتيّ ، وما أن تقدّمتُ نحوكِ حتى داهمني وجهكِ الذي طالما حاولت التعامل معه بحياديّة غبيّة : " ما رأيكَ ؟!" قلتِ لي ، وأنتِ تستعرضين قوامكِ إزائي : ارتبكت ، وجفت شرايين صوتي ، وبعدَ أن مرّت لحظات طويلة ، صرختُ فيكِ بهمسٍ مشروخ :
_ قوقعة بحريّة ..!
_ مَنْ ؟!
_ أنتِ ..
اقتربت منّي بوجهها :
_ لا تبالغ ..؟
_ ليجلدني أكثر الشياطين ساديّة إن كنت أكذب ..
وقبل أن أسترسل شعرتُ بروحي تنتفض ، وقلبي يشهق متداركاً أنفاسه .. ارتفعت حرارة المكان والتهبت أنفاسي وهي تعانق أنفاسها . كان دم الرمّان ، على شفتيها ، يناديني ، يصرخ بي ، وشفتاي عطشتان ولن يرويهما أنقى من هذا النبع ، والزمن اللاهث في جسدي ، على الحائط ، وبامتداد خطّ الاستواء ، توقّف للحظاتٍ شاسعة ، بينما .. دمي .. يلتهب بلظى شفتين افتقدتا حمّى شراستهما :" أما من هاويةٍ تطويني !" رفعت لها ذراعين مسيّرتين بقوى حنين مجهولة ، ضممتُ القوقعة البحرية إلى صدري ، تاه دمي في حمّى اللازورد ، احتويت مرتفعات الأرق ، ولامستُ ، بشفتيّ ، قاربيّ الدم المرتجفين . رُحنا نطوف أرجاء دوّامةٍ بعيدة ، تهدهدنا ريح غامضة ، ربما كانت ريح تلك الأعماق المنسية فينا .. إلا إنّها أجفلت فجأة ، رفعتْ سبّابتها لُتعيد رسمَ المسافة المخترقة بين الشفتين ، فأنفجر فينا الإحساس ب" الآخر " ، الآخر البعيد ، المتربص ، ذي المخالب الأكثر اقترابا من أغشية أرواحنا ..
نظرت إليّ بحدّة عينيها ، اللتين حاولتُ أن أستجلي فيهما شيء ، ردّة فعل ، قبول أو رفض أو صراخ ، إلا إنّها إشاحتهما عنّي بقوّة ، ولم تُبقِ ، في فضاء المكتب ، غير قوسٍ طيفيّ صغير له اخضرار عينيها .. لم أحتمل البقاء ، أنا الآخر ، لملتُ أطرافي وخرجت .
في الكافتيريا وجدت الزملاء أنفسهم ، تبادلنا التحايا والحكايات الصغيرة المُلفّقة وبعض الشائعات ذات الاستهلاك الأبدي ، لم أشأ التحدّث أو البقاء أو الضحك كثيراً . لم أتناول شيئاً ، ربما لأحتفظ بطعم شفتيها طريّاً في فمي . انتحيت ركناً منعزلاً ولذتُ وحيداً بأسئلتي .
حاولتُ أن اختزل استنتاجي بردّة فعلها ، أو شعورها المفاجئ ، بمفردةٍ واحدة ، فتقافزت الكلمات على سطح الطاولة بمواجهتي : الخوف / الخجل / الذنب / الغضب / الانسحاق .. أم هو الحب بشروطنا المعقّدة والشائكة ..؟!
وأنا : أتُراني أحبّها ؟
أيّ جيشان هذا الذي عصف بأعماقي ، وجعلني أغوص في لحظة انفلات مُرّة لأخترق أكثر عوالمها خصوصيّة بهذه السرعة ؟ ومن دون استئذان ؟! أيّ تناقض فاحش يّكمن في هذا الحيوان البليد الكامن فيّ ..؟ وفي أيّة حلباتٍ سودٍ أتيه ..؟! أم هي لم تكن أكثر من رغبة اجتياح عاتية فرضتها شحنات ملتهبة من مشاعر غامضة وسحيقة .. ما سرقنا منها غير لحظات ، لحظات كانت لنا ، لنا وحدنا ، أنا وأنتِ .. أنتِ وأنا ، جرفنا فيها الغموض فإنداحت أعماقنا عن نفسها في لحظة تدلّى فيها "الآخرون" على حبال مشانق سميكة ، لحظة أيقنت فيها بأن مركز الكون إنّما يُكمن فينا ، وينطلق من بين شفتينا ، ورغم ذلك يندر أن نعيه ، نستشفّه ، أو نتحسسّه ؟
لمَ كلّ هذا الغضب إذن ؟ .. ما الذي فعلناه ؟ .. وماذا في ذلك ؟! فمازال العالم مُنقلباً على ذاته ، ولا يدري إلى أين يمضي ، أو في أيّة دوّامةٍ يتيه ؟! وما زالت كرة الجنون هذه ترفل بأحلى موديلات الحروب ، وأعذب المجاعات ، وأرقى وأشهى الكوارث ، بينما لا نستشعر الإحساس بالكوارث إلا عندما تنطلق ذاتنا من إسارها .. عندها تشخص الدنيا كلّها لتقف حائلاً ما بيننا وبين بنفسجات أرواحنا الأكثر نقاء ..نعم سأقول لها ذلك ، وليكن ما يكون ..!
نهضت من مقعدي بحركات حادّة مُزمجرة ، خطوت نحو المكتب وكأنّي أقود جيشاً جرّاراً ورائي ، كاد باب المكتب المغلق أن يُثبّط شيئاً من عزيمتي ، إلا إني اتخذت منه تحدّ آخر ، فتحتُ الباب بحركة عاصفة ، وما أن ألقيت نظرتي الأولى عليها حتى شعرت بلا جدوى قول ما جال بخاطري .. أفردت قامتي وسط المكتب ، بينما أشاحت هي بوجهها عنّي ، وفي تلك اللحظة لمحت الدموع المُطعّمة بخطوط الكحل الخفيفة التي رُسمت أسفل جفنيها . قلت بنبرة جاهدت في إثبات لطفها :
_ هكذا تنتهي المعارك مع النساء دائماً : دموع ومناديل .. والحاجة الدائمة لمكياج جديد ..!!
واجهتني بالصمت ، فاستطردت بمرح يكاد أن يكون حقيقي :
_ أيتها المهرّجة ..!
سدّدت عينيها الخضراوين ناحيتي ، ثمّ التفتت لتُطلق نظراتها باتجاه النافذة ..
قلت ، وقد شحن صوتي بكامل طاقات جدّيته ومنطقه :
_ منى .. لنواجه الأمر .. الهروب لا ينفع ..
أومأت برأسها ، أو هكذا خُيّل إليّ ، فانطلقت أحدّثها عن الحب والموت والزنازين التي نختبئ خلف قضبانها ، حتّى أذكر بأني قلت لها ، وأنا أضجّ بهدير انفعال حقيقي " لماذا نقدّس الأوراق والأختام والمراسيم أكثر من أن نحترم مشاعرنا الحقيقية ؟ .. لنحترم أسماها ، على الأقل كي نحافظ على آدميتنا .. إننا نفكّر بموديلات الأحذية وقاذفات التلفزيون أكثر مما نفكر بصيانة نفوسنا .. ! "
كان صوتي يلتهب بحماس كبير . قلتُ ذلك وأنا أشعر بأني اهتديت إلى حقيقة علاقتي بها ، وهذا ما أراحني وشحن صوتي بنبرة صادقة ، متدفقة .. قلت لها صراحة بأن علاقتنا لا يمكن أن تكون حبّاً أو زمالة أو أبوة أو أخوّة أو صداقة .. إنها ليست أي واحدة من هذه لأنها تشملها جميعاً ، علاقة تتمرّد على أن تُصلَبْ في إطارٍ ما . قد تكون أسمى أو أدنى من أيّة واحدة منها ، قد تنمو أو تتحدّد فيما بعد ، وأنا متأكّد بأننا سنضعها في الإطار المناسب لها حينها ، وسنسمّيها ونتوّجها بصفتها لاحقاً .. عندما تنضج ، وتفرض نفسها ، ويكون لها طعمها ووجودها ونكهتها ..!
كانت الدوّامات العائمة في رأسي قد بدأت تتفصّد ، وتتخذ لها ملامح مميّزة أخيراً .. ولربما كان ذلك ما أثار اهتمامها ، وأعاد لعينيها الخضراوين شيئاً من بريقهما المألوف ، وأعاد الدم إلى وجهها ليغمره بحمرته الأصيلة الشفافة .
كان من حسن حظنا أن حدث ذلك ظهيرة الخميس ، حيث الهدوء يفترش المكان ، ويندر أن تجد مراجعاً ، يتأبّط معاملته ، بهذا الركن أو ذاك في دائرتنا .
وهو ما حدا بذلك الصمت لأن يستطيل بيننا ، أتذكرين : عندها أشعلتُ سيكارة أخرى ، فيما أخذتِ تزيلين أثر الدمع عن خدّيكِ وجفنيكِ ، اللذان زايلتهما تقاطيع التوتّر والانسحاق . توقّعت أن تبدين عتاباً ما أو أسفاً ، إلا إنّكِ تحصّنتِ بصمتٍ مُقلق ، صمت تبدعينه أحياناً فيظلّ يتهادى في أرجاء الغرفة مثل عاصفة من صمت .
ثمّ وكأنّ الوقت لم يتسع ، حينها ، لتحدثيني عمّّا ارتسم في عينيكِ ، من إنّكِ إنّما استطعمت ذاك الصمت ، حين بدوتُ في أقصى لحظات حيرتي وقلقي ، وأنا أتشوّق للتحدّث عن بياض الخبث المتواري خلف اخضرار عينيكِ.. ولمّا لم أجد ما أفعله دسستُ علبة السكائر في جيبي وخرجت .. وها أنذا أقف ، في اليوم الذي تلا ذلك تماما ، حيث أفتّش في خلاء المكتب ، باحثاً عن ذبذبات صوتكِ ، اختلاجة عينيكِ في لحظة اندهاش ، أتفقّد الأزهار التي جاهدت في الحفاظ على نظارة بقاءها ، أتطلع إلى الهواء الذي غادر بهجة أنفاسكِ ، وأرهف أذنيّ علّي أسمع خفق خطواتكِ في ممرّات المبنى .
* عن الف
مع مطر الصباح لابدّ ستأتي .. وليرتجف قلبي مثل ملاءة ترفّ على ضفتيها الريح أمام دهشة حضورها .
في البدء ، أتظاهر بلا مبالاة عاجزة ، ثمّ أتطلّع إلى شعر أسود يسيل على الجانبين مخلياً الطريق إلى كوّتين تطلّ من خلالهما عينان خضراوان ، وشفتان تكوّرتا على هيئة حبّتي فستق ، سألقي عندهما ب"شوبنهاور" في قمامةٍ ما -أسفل جمجمتي - لأُقرّ ، مثله ، بأن الحياة تستحقّ أن تُعاش بأعذب تفاهاتها ..!
ما أن تدخل حتى تبدأ طقوس ضجيجها الصباحي الذي أدمنته : تُلقي حقيبتها على طرف الطاولة ، تُخرجُ أصابع زينتها ، تُخرج الميدالية التي تحمل إشراقة صورتها يوم كان لها شعر قصير وابتسامة أعنف براءة ، تجلس ، لتخلع حذاءها وتركن ركبتها على الطاولة ، وتأخذ بأرجحة قدميها وكأنها ترقص بكلاسيكيّة لذيذة .. وإذا ما بالغتُ بإطالة صبري ، بعدم التحدّث إليها لفترة أطول ، تتأوّه ودون أن تنتظر منّي ردّاً تشرع بسرد أخبارها الصغيرة التي سيكون عليّ الإصغاء لها بلذّة ناعسة ( ستحكي عن "الطاوة"التي شاطت ، وصراخ أمّها ، وطرق معالجة الباذنجان المحروق .. او ، في أحسن الأحوال ، عن مغامرة صغيرة في الطريق : لحقها أحدهم ، غمز لها أو ألقى تعليقاً حفظته لكثرة تردّده .. الخ ) . هكذا تهدر صاخبة متّخذة من فسحة أرض المكتب مساحة لها وهي تسدر في رواية تفاصيل يومها المملّة بعذوبة تتناغم وحركة حاجبيها واختلاجات صوتها وشفتيها ، بينما أصغي إليها ودوائر الدخان تشدّ الطوق حول رأسي ورقبتي أكثر فأكثر ..
( متناقض حدّ الصراخ .. أعلم ذلك ، وهو ما سيقودني إلى الجنون حتماً .. ) .
تذكرين يوم تنبّأنا بمستقبلنا هذا معاً ؟! .. "قرب السّكة " .. كنتِ تقولين ، وتشيرين ناحية أفقٍ ما قد يوصل إلى "ألشمّاعية" حيث مأوى المجانين .. وتضحكين :" مكان مضمون نكون فيه معاً .. بجنون رسمي موقّع ومختوم ..! "
(( نرتكب فيه أجمل ما توصّلت إليه عقولنا .. آه .. نعم عقولنا المريضة حدّ الصحو ، حدّ الإنطاق .. وبينما يصفنا جميع المتلصّصين هنا بأننا أجنّ اثنين ، سنصبح هناك أعقل اثنين ..! ))
تقولين "ربّما" ساهمة ، وأنت تضحكين ، أو ربّما مثلي تحلمين ، فأتوق لقظم تينكَ الشفتين اللتين تنعمان بإطلاق تلك ألكركرات من بينهما .
يوم قبّلتُكِ ، أوّل مرّة ، انتفضت بشدّة ، وكأنّكِ تحاولين تهشيم آخر قفص يترسّب فيكِ .. حدث ذلك قبل حوالي شهرين .. أتذكرين ؟! كان يوماً كهذا . ربّما أكثر دفئاً ، لأنّكِ كنتِ ترتدين "طقمك"ِ البنفسجي (أو البحري كما كان يلذّ لي أن أسمّيه ) : قميص بنفسجيّ بشفق أحمر ، تنّورة زرقاء ، والحذاء له نفس لون الأظافر المصطبغة بلون البنفسج ، وأقراط الزمرد المغشوش الذي لم يتمكن من سحل نظراتي المسلّطة على شفتيكِ الأكثر أوارا من نيران الغجر الملتهبة ، انتصبت واقفة ، حينها ، غير بعيد عن لهيب أصابعي ، بعدَ أن ملأتِ المكان بمشاعر منزليّة هادئة ، وانشغلت ، بعفويتكِ الخارقة الألفة ، بتعديل وضع حزامكِ الأسود ليقسّم خارطة جوعي إلى نصفين ، ثمّ مسحتِ تكويره صدركِ بباطن كفّيكِ دون أن تشهَدي شهقة التوق وهي تتسلّق شفتيّ ، وما أن تقدّمتُ نحوكِ حتى داهمني وجهكِ الذي طالما حاولت التعامل معه بحياديّة غبيّة : " ما رأيكَ ؟!" قلتِ لي ، وأنتِ تستعرضين قوامكِ إزائي : ارتبكت ، وجفت شرايين صوتي ، وبعدَ أن مرّت لحظات طويلة ، صرختُ فيكِ بهمسٍ مشروخ :
_ قوقعة بحريّة ..!
_ مَنْ ؟!
_ أنتِ ..
اقتربت منّي بوجهها :
_ لا تبالغ ..؟
_ ليجلدني أكثر الشياطين ساديّة إن كنت أكذب ..
وقبل أن أسترسل شعرتُ بروحي تنتفض ، وقلبي يشهق متداركاً أنفاسه .. ارتفعت حرارة المكان والتهبت أنفاسي وهي تعانق أنفاسها . كان دم الرمّان ، على شفتيها ، يناديني ، يصرخ بي ، وشفتاي عطشتان ولن يرويهما أنقى من هذا النبع ، والزمن اللاهث في جسدي ، على الحائط ، وبامتداد خطّ الاستواء ، توقّف للحظاتٍ شاسعة ، بينما .. دمي .. يلتهب بلظى شفتين افتقدتا حمّى شراستهما :" أما من هاويةٍ تطويني !" رفعت لها ذراعين مسيّرتين بقوى حنين مجهولة ، ضممتُ القوقعة البحرية إلى صدري ، تاه دمي في حمّى اللازورد ، احتويت مرتفعات الأرق ، ولامستُ ، بشفتيّ ، قاربيّ الدم المرتجفين . رُحنا نطوف أرجاء دوّامةٍ بعيدة ، تهدهدنا ريح غامضة ، ربما كانت ريح تلك الأعماق المنسية فينا .. إلا إنّها أجفلت فجأة ، رفعتْ سبّابتها لُتعيد رسمَ المسافة المخترقة بين الشفتين ، فأنفجر فينا الإحساس ب" الآخر " ، الآخر البعيد ، المتربص ، ذي المخالب الأكثر اقترابا من أغشية أرواحنا ..
نظرت إليّ بحدّة عينيها ، اللتين حاولتُ أن أستجلي فيهما شيء ، ردّة فعل ، قبول أو رفض أو صراخ ، إلا إنّها إشاحتهما عنّي بقوّة ، ولم تُبقِ ، في فضاء المكتب ، غير قوسٍ طيفيّ صغير له اخضرار عينيها .. لم أحتمل البقاء ، أنا الآخر ، لملتُ أطرافي وخرجت .
في الكافتيريا وجدت الزملاء أنفسهم ، تبادلنا التحايا والحكايات الصغيرة المُلفّقة وبعض الشائعات ذات الاستهلاك الأبدي ، لم أشأ التحدّث أو البقاء أو الضحك كثيراً . لم أتناول شيئاً ، ربما لأحتفظ بطعم شفتيها طريّاً في فمي . انتحيت ركناً منعزلاً ولذتُ وحيداً بأسئلتي .
حاولتُ أن اختزل استنتاجي بردّة فعلها ، أو شعورها المفاجئ ، بمفردةٍ واحدة ، فتقافزت الكلمات على سطح الطاولة بمواجهتي : الخوف / الخجل / الذنب / الغضب / الانسحاق .. أم هو الحب بشروطنا المعقّدة والشائكة ..؟!
وأنا : أتُراني أحبّها ؟
أيّ جيشان هذا الذي عصف بأعماقي ، وجعلني أغوص في لحظة انفلات مُرّة لأخترق أكثر عوالمها خصوصيّة بهذه السرعة ؟ ومن دون استئذان ؟! أيّ تناقض فاحش يّكمن في هذا الحيوان البليد الكامن فيّ ..؟ وفي أيّة حلباتٍ سودٍ أتيه ..؟! أم هي لم تكن أكثر من رغبة اجتياح عاتية فرضتها شحنات ملتهبة من مشاعر غامضة وسحيقة .. ما سرقنا منها غير لحظات ، لحظات كانت لنا ، لنا وحدنا ، أنا وأنتِ .. أنتِ وأنا ، جرفنا فيها الغموض فإنداحت أعماقنا عن نفسها في لحظة تدلّى فيها "الآخرون" على حبال مشانق سميكة ، لحظة أيقنت فيها بأن مركز الكون إنّما يُكمن فينا ، وينطلق من بين شفتينا ، ورغم ذلك يندر أن نعيه ، نستشفّه ، أو نتحسسّه ؟
لمَ كلّ هذا الغضب إذن ؟ .. ما الذي فعلناه ؟ .. وماذا في ذلك ؟! فمازال العالم مُنقلباً على ذاته ، ولا يدري إلى أين يمضي ، أو في أيّة دوّامةٍ يتيه ؟! وما زالت كرة الجنون هذه ترفل بأحلى موديلات الحروب ، وأعذب المجاعات ، وأرقى وأشهى الكوارث ، بينما لا نستشعر الإحساس بالكوارث إلا عندما تنطلق ذاتنا من إسارها .. عندها تشخص الدنيا كلّها لتقف حائلاً ما بيننا وبين بنفسجات أرواحنا الأكثر نقاء ..نعم سأقول لها ذلك ، وليكن ما يكون ..!
نهضت من مقعدي بحركات حادّة مُزمجرة ، خطوت نحو المكتب وكأنّي أقود جيشاً جرّاراً ورائي ، كاد باب المكتب المغلق أن يُثبّط شيئاً من عزيمتي ، إلا إني اتخذت منه تحدّ آخر ، فتحتُ الباب بحركة عاصفة ، وما أن ألقيت نظرتي الأولى عليها حتى شعرت بلا جدوى قول ما جال بخاطري .. أفردت قامتي وسط المكتب ، بينما أشاحت هي بوجهها عنّي ، وفي تلك اللحظة لمحت الدموع المُطعّمة بخطوط الكحل الخفيفة التي رُسمت أسفل جفنيها . قلت بنبرة جاهدت في إثبات لطفها :
_ هكذا تنتهي المعارك مع النساء دائماً : دموع ومناديل .. والحاجة الدائمة لمكياج جديد ..!!
واجهتني بالصمت ، فاستطردت بمرح يكاد أن يكون حقيقي :
_ أيتها المهرّجة ..!
سدّدت عينيها الخضراوين ناحيتي ، ثمّ التفتت لتُطلق نظراتها باتجاه النافذة ..
قلت ، وقد شحن صوتي بكامل طاقات جدّيته ومنطقه :
_ منى .. لنواجه الأمر .. الهروب لا ينفع ..
أومأت برأسها ، أو هكذا خُيّل إليّ ، فانطلقت أحدّثها عن الحب والموت والزنازين التي نختبئ خلف قضبانها ، حتّى أذكر بأني قلت لها ، وأنا أضجّ بهدير انفعال حقيقي " لماذا نقدّس الأوراق والأختام والمراسيم أكثر من أن نحترم مشاعرنا الحقيقية ؟ .. لنحترم أسماها ، على الأقل كي نحافظ على آدميتنا .. إننا نفكّر بموديلات الأحذية وقاذفات التلفزيون أكثر مما نفكر بصيانة نفوسنا .. ! "
كان صوتي يلتهب بحماس كبير . قلتُ ذلك وأنا أشعر بأني اهتديت إلى حقيقة علاقتي بها ، وهذا ما أراحني وشحن صوتي بنبرة صادقة ، متدفقة .. قلت لها صراحة بأن علاقتنا لا يمكن أن تكون حبّاً أو زمالة أو أبوة أو أخوّة أو صداقة .. إنها ليست أي واحدة من هذه لأنها تشملها جميعاً ، علاقة تتمرّد على أن تُصلَبْ في إطارٍ ما . قد تكون أسمى أو أدنى من أيّة واحدة منها ، قد تنمو أو تتحدّد فيما بعد ، وأنا متأكّد بأننا سنضعها في الإطار المناسب لها حينها ، وسنسمّيها ونتوّجها بصفتها لاحقاً .. عندما تنضج ، وتفرض نفسها ، ويكون لها طعمها ووجودها ونكهتها ..!
كانت الدوّامات العائمة في رأسي قد بدأت تتفصّد ، وتتخذ لها ملامح مميّزة أخيراً .. ولربما كان ذلك ما أثار اهتمامها ، وأعاد لعينيها الخضراوين شيئاً من بريقهما المألوف ، وأعاد الدم إلى وجهها ليغمره بحمرته الأصيلة الشفافة .
كان من حسن حظنا أن حدث ذلك ظهيرة الخميس ، حيث الهدوء يفترش المكان ، ويندر أن تجد مراجعاً ، يتأبّط معاملته ، بهذا الركن أو ذاك في دائرتنا .
وهو ما حدا بذلك الصمت لأن يستطيل بيننا ، أتذكرين : عندها أشعلتُ سيكارة أخرى ، فيما أخذتِ تزيلين أثر الدمع عن خدّيكِ وجفنيكِ ، اللذان زايلتهما تقاطيع التوتّر والانسحاق . توقّعت أن تبدين عتاباً ما أو أسفاً ، إلا إنّكِ تحصّنتِ بصمتٍ مُقلق ، صمت تبدعينه أحياناً فيظلّ يتهادى في أرجاء الغرفة مثل عاصفة من صمت .
ثمّ وكأنّ الوقت لم يتسع ، حينها ، لتحدثيني عمّّا ارتسم في عينيكِ ، من إنّكِ إنّما استطعمت ذاك الصمت ، حين بدوتُ في أقصى لحظات حيرتي وقلقي ، وأنا أتشوّق للتحدّث عن بياض الخبث المتواري خلف اخضرار عينيكِ.. ولمّا لم أجد ما أفعله دسستُ علبة السكائر في جيبي وخرجت .. وها أنذا أقف ، في اليوم الذي تلا ذلك تماما ، حيث أفتّش في خلاء المكتب ، باحثاً عن ذبذبات صوتكِ ، اختلاجة عينيكِ في لحظة اندهاش ، أتفقّد الأزهار التي جاهدت في الحفاظ على نظارة بقاءها ، أتطلع إلى الهواء الذي غادر بهجة أنفاسكِ ، وأرهف أذنيّ علّي أسمع خفق خطواتكِ في ممرّات المبنى .
* عن الف