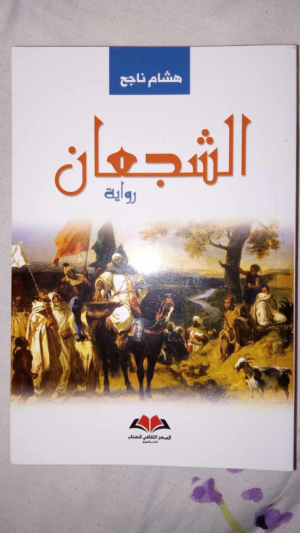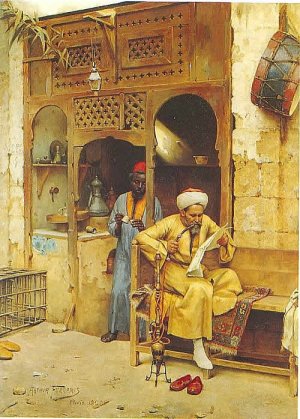عشت طفولتي في عالم مسكون بالخرافات والأساطير والجنّ والشّعوذة. فبلاد الجريد التي أنتمي إليها عالم بذاته. هي واحة في قلب الصّحراء التونسية ( الجنوب الغربي المتاخم للجزائر ) عاشت ازدهارا منذ الفتح العربي الإسلامي حتّى دخول جنود الغازي الفرنسي لهذه البلاد في نهاية القرن التاسع عشر.
كانت « بلاد الجريد » صرّة الصّحراء إذ فيها تتقاطع الطرق القادمة من المغربيين الأوسط والأقصى والأندلس والذّاهبة إلى مشارق الأرض. كما كانت المحطّة الأخيرة للتّجار القاصدين « أفريقيا » جنوب الصّحراء. ( مالي والنّيجر وتشاد ونيجيريا…) فامتزج في هذه الأرض التّاريخ بالجغرافيا: زنوج إفريقيا وبقايا الرّوم وبربر صنهاجة وكتامة وعرب العراق القادمين مع طلائع الفتح وبنو هلال وسليم ورياح وزغبة الّذين جاؤوا مصحوبين بكلابهم البيضاء الضّخمة وسيوفهم البتّارة وبناتهم الجميلات ( الجازية وأخواتها ) وفتوحاتهم وهزائمهم وخرافاتهم وسيرهم.
عشت في هذه الأجواء طفولتي داخل زوايا الدّراويش والمجذوبين وأصحاب الكرامات ومقرئي القرآن والأحاديث النّبوية ومردّدي قصص ” ألف ليلة وليلة ” وسير ” عنترة العبسي ” وسيف بن ذي يزن ” و ” ذات الهمة و ” ذياب الهلالي ” و ” خليفة الزناتي “. وصانعي البطولات ضدّ جنود فرنسا والشّعراء الشعبيين وآكلي العقارب والأفاعي…
وكان جدّي درويشا ادّعى – وصدّقه الأهالي – أنّه متزوّج من جنّية أنجبت له أبي وعمّي وانتقمت منه فطارت إلى السّماء بعد أن كشف سرّها لبني البشر. جنّية لبست صورة بني آدم ولكنّها ظلّت تحتزن في داخلها نار الجحيم التي أورثتني نصيبا منها فعاشرت الأبالسة الذين علّموني السّحر وما يخفى طيلة ردح من الزمن. ثمّ ضاع منّي كلّ هذا الزخم حين اكتشفت ” ماركس ” و ” إنجاز ” و” لينين ” و ” ستالين ” والمرتد ” كاوتسكي والتحريفي حروتشوف والمعلم جدانوف والقائد ” أنور خوجة ” والرّائع ” غيفارا “. فلعنت ” ربيع براغ ” ورفعت كتابي الأحمر الصّغير وأنشدت قصائد الثورة مع عمال ” تيرانا” وفلاّحي أرياف الصّين الشّاسعة وأنا أحلم بالجنة.
وتهشّم جدار ” برلين ” بصواريخ ” الجلاسْنوسْت ” وقذائف ” البيروسترويكا ” ففقدت اليقين. وظللت هائما على وجهي أخبط خبط عشواء في الليل البهيم إلى أن اكتشفت تجربة الكتابة الابداعية: قصّة ورواية. فدفنت نفسي وسط الكتب. قرأت الكثير ولم أكتب سوى القليل من المشاريع التي اقتربت من ذاكرتي المفجوعة بالويل والثّبور وعظائم الأمور.
المشروع الأوّل: التّراث والتّاريخ.
الرّواية التاريخية هي بنية زمنية متخيّلة خارجة من معطف التّاريخ. هي ما يتسرّب في مخيال المبدع من أحداث ووقائع وشخصيات وزمن تاريخي دون أن تكون التّاريخ كما هو واقع بالفعل حسب الرّواة والمؤرّخين سواء كانوا رواة السّلاطين والملوك والأمراء وأرباب الدّولة أو رواة المهمّشين والمعارضة. الرّواية التارخية هي قراءة المبدع للتّاريخ بعد أن صار من أخوات ” كان ” لذلك أحاول جاهدا في كلّ مرّة ألامس فيها التّاريخ أن أجعل ما هو مثبت في الموسوعات كحقيقة ثابتة لا يدخلها باطل، تجاور قراءتي الخاصة لهذا التاريخ في ضوء العلوم الحديثة. فأبطل في بعض الأحيان الثابت وأثبت في أحيان أخرى المتحوّل. وأتلاعب بالأزمنة والأمكنة فأستحضر شخصيات عاشت في العصور السّحيقة إلى القرن العشرين مثلا وأقرأ ردود أفعالها سلبا أو إيجابا. أو أستشرف المستقبل فأجعل شخصيات روايتي تعيش في أزمنة قادمة ( الثواب والعقاب في رواية القيامة… الآن ) انطلاقا من التّراث الديني كالقرآن والأحاديث والتّفاسير الصّحيحة أو الإسرائيليات. فأجعل نصّي « كوكتالا » تختلط فيه أقوال « الترمذي » و « البخاري » بتصريحات مذيعي « التلفزيون » وتتجاور فيه شطحات « الدّراويش » مع قراءة العلماء لهلوسات النفس البشرية الأمّارة بالسّوء.
إنّ التّراث جزء مكمل لحياتنا الآنية. فكلّ واحد منا مسكون بالتّراث بشكل من الأشكال فمنذ أن يخلق نطفة في رحم أمّه يبدأ التّراث في محاصرته. تلبس أمّه ” الوَدَعَ ” وتٌعلّق في صدرها ” حوته ” وتضع على غطاء رأسها ” خمسة ” وتبدأ في عدّ الأشهر إلى أن تحين ساعة الطّلق فتستعين القابلة بالأولياء الصّالحين والمشعوذين وبتراب مكّة وبدعوات العجائز المباركات لتكون الولادة سهلة وينزل الجنين سليما معافى.
بعد الولادة تبدأ النّذر والتّقرب إلى الرّب بالصّدقات والعطايا ليحفظ الطّفل من الموت. وهكذا دواليك إلى أن يضع الطّفل يديه على القلم ويفتح أوّل كتاب ويدخل مغارة ” علي بابا ” بعد أن يعرف السّر المكنون:
” افتح يا سمسم “.
شخصيا مررت بكلّ هذه المراحل وكلّ واحدة منها تركت في ذاكرتي ووجداني بقايا كبقايا سديم النّجوم المنفجرة منذ ملايين السّنين. ثمّ جاءت تجارب الحياة فأكملت ما أنجزه التكوين النفسي والاجتماعي لذاتي المبدعة.
إنّ للمحيط الأسري دورا كبيرا في اهتمامي بالتّراث ولكنّ الدّور الأهم كان لاطّلاعي الواسع على الذّاكرة المهملة لهذه الأمّة، فالمدوّنة التّراثية العربيّة التي اهتمّت بالسّرد منذ البدايات حتّى نهاية القرن التّاسع عشر تحوي في طيّاتها عالما عجيبا ومخزونا ثريا من القصص والحكايات والأمثولات والطرائف والأخبار، والنّكات والوقائع والمقامات وغيره ممّا تفتّقت عنه الذّهنية العربية قبل ظهور الإسلام وبعده. فقبل ظهور الإسلام أي فيما كان يسمّى بالعصر الجاهلي، أنتج العرب كمّا هائلا من القصص لم يصلنا منها سوى القليل وهي القصص التي لا تتعارض مع مفهوم الدّين الجديد للحياة والمجتمع. ثمّ بعد ظهور الإسلام، بداية بالمدوّنة الخاصّة بسيرة الرّسول وقصص الفتوحات والغزوات، مرورا بطرائف الجاحظ والمقامات التي لم يشتهر منها سوى ما كتبه « الهمذاني » و « الحريري » ( مع العلم أنّ أكثر من ستّين كاتبا أبدعوا في هذا الفن )، ورائعة ألف ليلة وليلة التي اشترك في تأليفها المخيال الجمعي لهذه الأمّة على مدى قرن من الزمن، وسير عنترة العبسي وسيف بن ذي يزن وذات الهمّة والزّير سالم والظّاهر ييبرس، وأخبار الملوك والأنبياء والرّسل، وغير هذا كثير ممّا تحفل به بطون المخطوطات الرّاقدة في الخزائن الخاصّة والعامّة والتي لم تجد من يحقّقها وينفض عنها غبار النّسيان إلى حدّ الآن.
إنّ هذه المدوّنة التّراثية التي أنتجها المخيال العربي ألهبت فكر قصّاصي أوربا. فقد ذكر بعض مؤرخي الأدب أنّ لقصص ” الدّي كاميرون ” الإيطالية التي تعتبر أم القصّ الأوروبي الحديث جذورا عربية وفدت عليها من خلال التّواجد العربي في جزيرة ” صقليّة ” كما أنّ « ثربانتس » صاحب « دون كيخوت » استلهم نصّه من خلال القصص الرّائجة في بلاد الأندلس قبل السّقوط النّهائي للعرب والمسلمين في تلك الأصقاع.
وقد حاول المبدعون العرب في عصر النّهضة ( أي في نهاية القرن التّاسع عشر ) الانفتاح على تلك المدوّنة التّراثية بالتّوازي مع الاستلهام من النصّ الوافد من الغرب. وكان من أبرزهم: محمد المويلحي في « حديث عيسى بن هشام » وأحمد فارس الشّدياق في « السّاق على الساق فيما هو الفارياق ». ولكن الغلبة في الأخير كانت لطريقة السّرد الغربية بدعوى أنّ النّص القصصي وافد من الغرب وأنّ تقنيات الكتابة القصصيّة غير موجودة في التّراث النّقدي العربي وغير ذلك من الحجج المتهافتة. فكأنّ لا تقنية للكتابة السّردية سوى تقنيات « موباسّان » و « بلزاك » و « دوستويفسكي » أو « تشيكوف » و«والترسكوت »…
إنّ قلّة من المبدعين العرب المعاصرين – وأنا واحد منهم – وبعد أن اطّلعوا على المخزون الثّري للمدوّنة الإبداعية العربية التي سبق وأن ذكرت بعضها، جرّبوا كتابة مغايرة للسّائد. كتابة لا تقطع مع الجذور ولا تتناسى العصر الحديث. وقد جرّب هذا الشكل الفنّي في تونس مبدعون مسكونون بهاجس التّغيير والخروج عن الطّرق السّالكة التي عبّدها كتّاب الغرب. وأهمهم على الإطلاق « محمود المسعدي » و « عز الدين المدني » من الجيل السّابق و « فرج الحوار » و « صلاح الدين بوجاه » من الجيل الجديد.
إنّ النّص الإبداعي الحديث نص مغامر بطبعه، لن تكتب له الحياة والدّوام إلاّ إذا خرج عن المألوف والمكرور وضرب بعيدا في أقاصي الإبداع باحثا عن دِنان خمر لم تطمث من عهد ساسان ليسكب روحها في كؤوس من البلوّر المصنوع في معامل القرون الحديثة.
إنّ التّراث العربي الإسلامي الشّفوي والمكتوب يحمل أشكالا مختلفة من السّرديات فالنكتة والطّرفة تحملان كثيرا من مواصفات القصّة القصيرة جدّا أو قصّة الدّقيقة الواحدة كالتكثيف الشّديد والخاتمة الصّادمة. والأخبار هي قصص تتفاوت في حجمها طولا وقصرا. أمّا المقامة أو الحديث فهي شكل راق جدّا شبيه بالرواية الغربية الحديثة. وقد بلغ السّرد العربي أوجه مع الملاحم والسّير وخاصة رائعة ” ألف ليلة وليلة ” التي خلبت الألباب وأذهلت الغرب قبل الشّرق. ولكن المؤسف هو أنّ المبدعين العرب لم يلتفتوا إلى هذا التّراث السّردي لاستلهامه و النّهل منه إلاّ فيما ندر – وإنّما ركبوا السّهل وادّعوا أنّ التراث العربي لا يحمل في خباياه القصّة والرّواية والملحمة. وزعمهم صحيح إذا قسنا السّرد المقصود بميزان النّقد الغربي. ولكنّه يجانب الصّواب إذا نظرنا إلى تراثنا السّردي بعيون عربيّة.
لكلّ هذا حاولت العودة إلى هذا التّراث لابتكار معان جديدة وأشكال طريفة من رحم هذا القديم دون الانقطاع عن فنون السّرد الحديثة. لقد حاولت تطوير شكل الرّواية الغربية وأعطيتها نكهة أخرى بأن أركبت على الفرس الأوربية حصانا عربيا أصيلا. فجاء نصّي يحمل الصّفات الحميدة لكلا الجنسين. فيه مقوّمات الرّواية الغربية ولكن فيه أيضا إضافات الشّكل العربي كالاستطراد والعنعنة والتّدوير والشّعر والاستشهادات. وتحضر فيه أيضا الطّرفة والخبر والشعر العامّي وهلوسات المتصوّفة وغير ذلك ممّا حوى السّرد العربي القديم.
هي على كلّ حال تجربة تهدف إلى إحياء ثقافة الأجداد والتّمرد على ثقافة الغرب التي تنظر باستعلاء إلى الثقافات الأخرى. ولي شرف القيام بها. فإن نجحت فلي أكثر من أجرين وإن فشلت فعلى غيري إثم الكافرين بالتّراث.
المشروع الثّاني: الحداثة والتّراث
الحداثة حركة فكريّة تقوم على الإعلاء من شأن العقل وتعتبره الرّكيزة الأساسية التي تقوم عليها حياة الفرد والمجتمع وتؤكّد على أنّ العقل هو مصدر كلّ تقدّم وأساس كلّ المعارف. ولكنّي شخصيا ومع إيماني العميق بهذه المقومات أرى أنّ هناك أنماطا معرفية أخرى يمكن للفكر الإنساني أن يستثمرها للتعبير عن مشاغله في الحياة كأن يلتفت إلى الخرافة أو الأسطورة أو الماورائيات بصفة عامّة. هذا التراث الإنساني الذي أرى فيه مصدر تحرير للفكر من قيود العقل وانفلات من جبروته وتسلّطه. فلم يعد مطلوبا من المبدع العربي الذي عاش ويعيش عجيب هذا القرن والقرن الذي سبقه أن يعكس الواقع كما هو، بل صار محتّما عليه أن يهرب من هذا الواقع من خلال شبابيك واسعة يفتحها على التراث الذي يعجّ بالأساطير والخرافات التي فسّر بها الإنسان البدائي ماهية هذا الكون والتي صارت في هذه الأيام المفتاح السّري الذي لا يمكننا بحال من الأحوال أن نغلقه لفهم عجائب هذه القرن الذي تحول فيه العلم إلى أسطورة فاقت في غرابتها ما لا يمكن لأي عاقل أن يتصور. فأنا مثلا لا يمكنني أن أفسّر دكّ مباني مركز التجارة العالمية في نيويورك بتلك الأجسام الجهنّمية الطّائرة إلاّ بسورة الطّير الأبابيل التي ترمي بحجارة من سجّيل فتجعل الإسمنت المسلّح والحديد والبلّور والبشر والودائع الذّهبية وذاكرة رأس المال العالمي والسّكرتيرات الجميلات وطاولات الإينوكس ومديري الشركات العابرة للقارات والمخبرين الواقفين أمام المصاعد في الطابق المائة من البناية التي تطلّ على نعيم ” مانهاتن ” وأجهزة الكمبيوتر الفائقة الجودة ورادارات الانترنات الفخمة و… عظمة أمريكا. تجعل كلّ ما ذكرت. وما سهوت عن ذكره. وما لم يخطر على بال، عصفا مأكولا. ولا حول ولا قوّة إلاّ بالله. ولله الأمر من قبل من بعد..
إنّنا نعيش حداثة زائفة فالماضي والحاضر يتداخلان في وعي الإنسان العربي تداخلا لا فكاك منه. إذ أنّنا نحمل في ذواتنا تراثنا الثقافي وإرثنا من الحضارات التي تعاقب على الأرض التي مازلنا نعيش على أديمها. فنحن نعيش حاضرنا بوعي زائف لأنه حاضر مسكون بأشباح الماضي. حاضر مريض بالإنفصام يتجاذبه قطبان:
القطب الأوّل: لحظة تالدة نريد أن نسترجعها ولو في شكل مهزلة.
القطب الثاني: لحظة آنية نحياها حياة الأيتام في مآدب اللّئا؟.
هذه العوامل السّوسيو – ثقافية قادتني إلى التراث العربي لاستقرائه والبحث من خلاله عن سبب تأزّم هذه المجتمعات العربيّة التي دخلت عصر « النّهضة » مع دول شرقية أخرى كاليابان مثلا. ولكن في حين عرفت اليابان كيف تستثمر إرثها الحضاري القديم وتطوّعه لبناء دولتها العصريّة. ظلّ المجتمع العربي يتأرجح بين العضّ بالنّواجذ على مفهوم للدّولة ولّى وانتهى أو عصرنة مجتمع بدويّ متخلّف، قسرا. وذلك بسنّ تشريعات تبقى في الغالب الأهم حبرا على ورق. لذلك حاولت توظيف هذا التّأزم روائيّا في نصوص انفلتت من عقالها فجاءت متأرجحة بين ماض ما انفكّ يتجدّد فينا كلّ يوم وحاضر يأبى الثّبات على حال من الأحوال.
المشروع الثالث: الواقع والعجيب
أوجب علينا معلمنا « جدانوف » لمّا كنّا تلامذة أوفياء للواقعية الاشتراكية أن يكون بطلنا إيجابيّا. وأن ننظر إلى الواقع بعين بصيرة. وأن نصنع أبطالا خارقين لا يهابون الرّدى. وأن نرى المستقبل جنّة للمحتاجين والبؤساء تحت راية ثورة العمّال والفلاّحين التي ستدكّ قلاع الرّأسمالية دكّا دكّا.
كنّا في تلك الأيّام نفكّر في تغيير العالم فجاءت قصصي التي كتبتها في ثمانينات القرن الماضي مرتبطة بالواقع كأحسن ما يكون الارتباط. تلامس أوجاع ناسه وتحتجّ صارخة في وجه قبضة البوليس وحذاء الجنديّ الخشن النازل للشوارع لقمع مظاهرات البؤساء والمطالبين بثمن عادل لرغيف الخبز ولقمة العيش. ثمّ فجأة، انهارت هذه الأحلام بانهيار « جدار برلين » وبسقوط علم « الأمميّة » تحت أقدام المحتجّين في شوارع « موسكو » ولينينغراد » وبالطلقة المكتومة من مسدّس في صدغ “تشاوسسكو” وبكتب الرفيق أنور خوجه المقدّسة تكدّس الزّبالة في شوارع « تيرانا » وبأمريكا تصرخ بأعلى مكبّرات صوتها بأنّ التّاريخ قد انتهى وبأنّ الرأسمالية في شكلها المعلوم ستسود في الدنيا والآخرة.
في تلك الضّروف العصيبة هرب كلّ واحذ منّا إلى ذاته المعذّبة ليختار لها مصيرا. فمنّا من اختار الموت تحت عجلات جرّار زبالة البلدية. والبعض الآخر أصابه مسّ من الجنّ فأهلكه. وآخرون اختاروا ” الخواء “. أفرغوا أبدانهم من أرواحها واشتروا الحياة الدّنيا بالآخرة. والآخرة خير وأبقى.
ونظرت حولي أختار لي واحدا من المصائر فعافتها نفسي جميعها. واختارت القلم وما يسطر. وغيّرني القلم. صارت رؤيتي للعالم مغايرة للمعتاد. صرت أرى البشر يمشون على رؤوسهم. وصارت الحيطان تتكلّم والهواء يطلّ علينا بألف وجه ووجه. والطّيور أصبحت لها وجوه بشرية بأنياب خنازير. ولبست أرجل تماسيح وطارت بأجنحة كأجنحة طائرات الأواكس. وامتلأ العالم براحة الجيف بعد أن أمسكت بخناق البشريد جبّارة يحرّكها دماغ إلكتروني قادر على الاستماع لدبيب النمل ورؤية بريق الدّرهم من فوق سبع سماوات. إنّ المطّلع على نصوصي القصصيّة الأولى يجد ظاهرة العجيب والسحري مبثوثة في ثناياها. أي أنّني – وأنا التلميذ النّجيب المفعم حدّا التخمة بالواقعية الاشتراكية – وجدت في لاوعيي مكانا لهذه الظاهرة. فقبل أن أقرأ لـ « ماركيز » و « أستورياس » و « أكتافيوباث » و « إيزابيل اللّندي »، قرأت ” القرآن ” وحفظت هذا الكتاب عن ظهر قلب. وقرأت في طفولتي الأولى قصص « ألف ليلة وليلة ». وعايشت الأهل وهم يحكون الخرافات القديمة المسكونة بالجنّ والملائكة والعفاريت والغيلان والموتى الذين يخرجون من قبورهم ليلا يهيمون في القرية ويزورون بساتينهم في الواحة يسقون نخيلها ويقلّمون أشجارها ويشربون الشاي مع الأصدقاء ويبطشون بالأعداء. يفقأون أعين المتلصّصين على أراملهم وينامون في أسرّة الحبيبات نوما خفيفا. ويغادرون فجرا إلى الأجداث قبل أن يفاجئهم آذان الصّبح. وتعلّمت قصّ ” السّيرة الهلالية “. وحفظت أجزاء كثيرة منها حتّى أنّني صرت أرى كلّ امرأة جميلة « عزيزة » وكلّ عاشق « يونس » .
وكبرت. وكبر معي هم القراءة والنّبش في الذّاكرة المنسية لهذه الأمّة. فاكتشفت العجب العجاب في رحلات ” ابن بطوطة “. و ” عجائب مخلوقات ” « القزويني » وغرائب قصص حيوان « الجاحظ ». هذا فضلا عن المعروف من القص العربي القديم في موسوعة « الأغاني » و « الكامل في التاريخ » والبداية واتلنهاية » وغيره… كـ « الإسراء والمعراج » وسيرة الرّسول المصطفى بصيغها المختلفة.
في هذه المدوّنات يحلّق المخيال العربي إلى آفاق لم يبلغها أحد بعد أن تفتّحت أمامه أسرار السّماوات والأرضين وجزائر البحار السبعة. إنّ « ماركيز » تلميذ متوسّط الموهبة إذا قارنّاه بـ « القزويني » أو بـ « ابن بطوطة » على سبيل المثال فقط. لذلك أعدّ ننفسي واحدا من تلاميذ هؤلاء السّاردين العرب الكبار. أتجسّس على حكاياتهم لآخرجها من غياهب التاريخ وأ ضعها عارية أمام قارئ القرن العشرين وما تلاه. أكتب بها ومن خلالها ما يعجز فن القول الحديث عن الإتيان بمثله هازئا تارة بالجغرافيا وضاحكا تارة أخرى على ذقن التّاريخ.
المشروع الرّابع: المقدّس والمدنّس:
إن الدّين والجنس والسياسة رغبات مكبوتة، دفينة في أعماقنا ودور الكاتب هو أن يفجر هذه الطاقات في نص أدبي يصدم ذائقه المتلقي. دوره أن يصنع الإنسان السليم خارج دوامة الأمراض المستثرية فينا منذ أن أكل آدم من تفاح الجنة.
لقد حوّل هذا الثالوث المحرم الإنسان العربي إلى رجل/ امرأة تعاني من الانفصام في شخصيتها. يتمارس العيب في الخفاء وينهي عن المنكر جهارا. ينتهك المقدّس الدّيني طيلة عمرها ويستغفر ربه عند الشدائد يسبّ الرّوس واليابانيين والإنجليز والأمريكيين واسرئيل والفرنسيين والناس أجمعين ولكن لا يتجرّأ على رفع إصبعها احتجاجا على الساسة من أبناء جلدتها. يكفر بكلّ الملل والنحل ويقف في الصّف ليصلّي في الجبّانة صلاة الجنازة ( هل لاحظتم كيف أنّني لم أنقط الياء من فوق هذه المرّة لأنّ المرأة لا تقف في الصفّ لتصلّي صلاة الجنازة في الجبّانة ) يبكي أمام صور القتلى من شهداء الانتفاضة في أرض فلسطين ولا تخرج للشارع محتجة على صمت الجهاز العربي من البحر إلى البحر. ( ولن أنتهي من عدّ أمراضنا الجنسية والدينية والسياسية لهذا أدعوك إلى ملئ الفراغ على هواك ) وسأكتفي بنقطة واحدة من هذا الفراغ هي المسألة الجنسية. فكثير من القراء يتهمون نصوصي بأنّها تسعى إلى تعنيف المتلقّي بصور خادشة للحياء والذّوق العام تشوّه الجسد وتقتل الرّوح وتبالغ في استحضار الرّغبات والشّهوات الكامنة في أعماق الغرائز الحيوانية للإنسان الأوّل !
إنّني أريد أوّلا أن اتفق مع متقبّل نصي على نقطة مهمّة قبل التّواصل معه هي: إنّ الابداع شيء والمنظومة الأخلاقية السائدة لدى شعب مع الشعوب في جزء من المعمورة وفي زمان معيّن شيء آخر. فالإبداع ثابت والأخلاق متحوّلة. وما هو مقبول لا يثير الشبهات لدى شعب ما يبدو مقرفا يثير التقزز لدى شعب آخر. لذا وجب الفصل نهائيا في نظري بين الأخلاق والإبداع. فمتى وضعنا حدودا للإبداع قتلناه. ومتى سلّطنا الأخلاق على النص الأدبي حكمنا عليه بالموت والبوار. من هذا المنطلق أتعامل في نصوصي مع المنظومة الأخلاقية السائدة الآن وهنا.أتحدّاها جهارا نهارا. وأقول كلمتي وأمضي. وأسعد حين تصلني تشكيات وتظلمات من « تعدياتي على الذوق العام » حينها أتأكد من فداحة المصيبة ومن أنّ البون مازال شاسعا بين الحقيقة والخيال. ففي عصر الصورة العابرة للقارات والصوت النابح داخل الأجهزة المحملة بهواتف الانترنات. مازال للكلمة نصيب. مازالت الكلمة قادرة على خدش الحياء. فأتمسك بحقي في « الإعتداء » على هذا الحياء الكاذب وعلى الجزء العائم فوق الماء من جبل النفاق والكذب. وأتمنى لو أنّ العرب أمة تقرأ كما هو الشأن لدى الأمم التي تعاصرها في بداية هذا القرن الجديد. وتذهب أمنياتي أدراج الرياح حين أتذكر أن نجيب محفوظ « المنوبل » منذ أكثر من عشر سنوات مازالت كتبه تطبع في أعداد محدودة لا تفوت خمسة آلاف نسخة تظل مركونة على الرفوف لسنوات عدة يتراكم فوقها الغبار ويتبرز على ألوان أغلافها الباهتة الذباب وهوام الأرض. في حين يطبع من كتب أمثاله من أصحاب جائزة « نوبل » ملايين النسخ توزع هدايا بمناسبة الأعياد وتقرأ على الشواطئ وفي المنتزهات والحفالات وفي الميترو وفي المخادع الفاخرة. وأتحسر لأن عنف كلماتي الفاحشة لن يخدش حياء سوى قلة من « المثقفين ». ولن يصل إلى جمهور الشعب الكريم الصائح في مدارج الملاعب الرياضية وعلى الهواء مباشرة بما لذّ وطاب من فواكه الكلم الطيب.
إن الجنس في نصي هم على القلب بالنهار وانفلات بلا حدود في الليل. وبما أن الإنسان حيوان جنسي. وبما أنّ الإنسان العربي متهم بأنه سيد هذه الحيوانات قاطبة فقد انشغلت في جزء من مشروعي الإبداعي بهذا المكبوت وافردت له رواية كاملة هي ” شبابيك منتصف الليل”. والغريب في الأمر أن القارئ العادي تقبلها بحماس أكبر من القارئ « المثقف » لآنه تعامل مع النص بدون خلفيات وبـ « قلب أبيض » بينما سعى الآخر إلى تأويلها تأويلات شتّى، أهونها خدش الحياء العام وأخطرها العمالة للغرب الأمبريالي والصهيونية العالمية.
إنّ مشاكل الإنسان العربي متعددة، متنوعة بتنوّع ألوان الطيف. ولكن الثالوث المحرم يمثل قلب الرّحى ضمن هذه المشاكل. فلئن صفى الغرب حساباته مع هذه المشاكل فإننا مازلنا إلى الآن نتجادل حول جنس الملائكة ونترقب المهدي الذي سيخلصنا من الظلم ويملأ الأرض عدلا بعد أن ملأت جوارا. ونجلد عميرة على وقع رقصة هز البطن أمام شاشات التلفزيون الملون.
إبراهيم درغوثي
كانت « بلاد الجريد » صرّة الصّحراء إذ فيها تتقاطع الطرق القادمة من المغربيين الأوسط والأقصى والأندلس والذّاهبة إلى مشارق الأرض. كما كانت المحطّة الأخيرة للتّجار القاصدين « أفريقيا » جنوب الصّحراء. ( مالي والنّيجر وتشاد ونيجيريا…) فامتزج في هذه الأرض التّاريخ بالجغرافيا: زنوج إفريقيا وبقايا الرّوم وبربر صنهاجة وكتامة وعرب العراق القادمين مع طلائع الفتح وبنو هلال وسليم ورياح وزغبة الّذين جاؤوا مصحوبين بكلابهم البيضاء الضّخمة وسيوفهم البتّارة وبناتهم الجميلات ( الجازية وأخواتها ) وفتوحاتهم وهزائمهم وخرافاتهم وسيرهم.
عشت في هذه الأجواء طفولتي داخل زوايا الدّراويش والمجذوبين وأصحاب الكرامات ومقرئي القرآن والأحاديث النّبوية ومردّدي قصص ” ألف ليلة وليلة ” وسير ” عنترة العبسي ” وسيف بن ذي يزن ” و ” ذات الهمة و ” ذياب الهلالي ” و ” خليفة الزناتي “. وصانعي البطولات ضدّ جنود فرنسا والشّعراء الشعبيين وآكلي العقارب والأفاعي…
وكان جدّي درويشا ادّعى – وصدّقه الأهالي – أنّه متزوّج من جنّية أنجبت له أبي وعمّي وانتقمت منه فطارت إلى السّماء بعد أن كشف سرّها لبني البشر. جنّية لبست صورة بني آدم ولكنّها ظلّت تحتزن في داخلها نار الجحيم التي أورثتني نصيبا منها فعاشرت الأبالسة الذين علّموني السّحر وما يخفى طيلة ردح من الزمن. ثمّ ضاع منّي كلّ هذا الزخم حين اكتشفت ” ماركس ” و ” إنجاز ” و” لينين ” و ” ستالين ” والمرتد ” كاوتسكي والتحريفي حروتشوف والمعلم جدانوف والقائد ” أنور خوجة ” والرّائع ” غيفارا “. فلعنت ” ربيع براغ ” ورفعت كتابي الأحمر الصّغير وأنشدت قصائد الثورة مع عمال ” تيرانا” وفلاّحي أرياف الصّين الشّاسعة وأنا أحلم بالجنة.
وتهشّم جدار ” برلين ” بصواريخ ” الجلاسْنوسْت ” وقذائف ” البيروسترويكا ” ففقدت اليقين. وظللت هائما على وجهي أخبط خبط عشواء في الليل البهيم إلى أن اكتشفت تجربة الكتابة الابداعية: قصّة ورواية. فدفنت نفسي وسط الكتب. قرأت الكثير ولم أكتب سوى القليل من المشاريع التي اقتربت من ذاكرتي المفجوعة بالويل والثّبور وعظائم الأمور.
المشروع الأوّل: التّراث والتّاريخ.
الرّواية التاريخية هي بنية زمنية متخيّلة خارجة من معطف التّاريخ. هي ما يتسرّب في مخيال المبدع من أحداث ووقائع وشخصيات وزمن تاريخي دون أن تكون التّاريخ كما هو واقع بالفعل حسب الرّواة والمؤرّخين سواء كانوا رواة السّلاطين والملوك والأمراء وأرباب الدّولة أو رواة المهمّشين والمعارضة. الرّواية التارخية هي قراءة المبدع للتّاريخ بعد أن صار من أخوات ” كان ” لذلك أحاول جاهدا في كلّ مرّة ألامس فيها التّاريخ أن أجعل ما هو مثبت في الموسوعات كحقيقة ثابتة لا يدخلها باطل، تجاور قراءتي الخاصة لهذا التاريخ في ضوء العلوم الحديثة. فأبطل في بعض الأحيان الثابت وأثبت في أحيان أخرى المتحوّل. وأتلاعب بالأزمنة والأمكنة فأستحضر شخصيات عاشت في العصور السّحيقة إلى القرن العشرين مثلا وأقرأ ردود أفعالها سلبا أو إيجابا. أو أستشرف المستقبل فأجعل شخصيات روايتي تعيش في أزمنة قادمة ( الثواب والعقاب في رواية القيامة… الآن ) انطلاقا من التّراث الديني كالقرآن والأحاديث والتّفاسير الصّحيحة أو الإسرائيليات. فأجعل نصّي « كوكتالا » تختلط فيه أقوال « الترمذي » و « البخاري » بتصريحات مذيعي « التلفزيون » وتتجاور فيه شطحات « الدّراويش » مع قراءة العلماء لهلوسات النفس البشرية الأمّارة بالسّوء.
إنّ التّراث جزء مكمل لحياتنا الآنية. فكلّ واحد منا مسكون بالتّراث بشكل من الأشكال فمنذ أن يخلق نطفة في رحم أمّه يبدأ التّراث في محاصرته. تلبس أمّه ” الوَدَعَ ” وتٌعلّق في صدرها ” حوته ” وتضع على غطاء رأسها ” خمسة ” وتبدأ في عدّ الأشهر إلى أن تحين ساعة الطّلق فتستعين القابلة بالأولياء الصّالحين والمشعوذين وبتراب مكّة وبدعوات العجائز المباركات لتكون الولادة سهلة وينزل الجنين سليما معافى.
بعد الولادة تبدأ النّذر والتّقرب إلى الرّب بالصّدقات والعطايا ليحفظ الطّفل من الموت. وهكذا دواليك إلى أن يضع الطّفل يديه على القلم ويفتح أوّل كتاب ويدخل مغارة ” علي بابا ” بعد أن يعرف السّر المكنون:
” افتح يا سمسم “.
شخصيا مررت بكلّ هذه المراحل وكلّ واحدة منها تركت في ذاكرتي ووجداني بقايا كبقايا سديم النّجوم المنفجرة منذ ملايين السّنين. ثمّ جاءت تجارب الحياة فأكملت ما أنجزه التكوين النفسي والاجتماعي لذاتي المبدعة.
إنّ للمحيط الأسري دورا كبيرا في اهتمامي بالتّراث ولكنّ الدّور الأهم كان لاطّلاعي الواسع على الذّاكرة المهملة لهذه الأمّة، فالمدوّنة التّراثية العربيّة التي اهتمّت بالسّرد منذ البدايات حتّى نهاية القرن التّاسع عشر تحوي في طيّاتها عالما عجيبا ومخزونا ثريا من القصص والحكايات والأمثولات والطرائف والأخبار، والنّكات والوقائع والمقامات وغيره ممّا تفتّقت عنه الذّهنية العربية قبل ظهور الإسلام وبعده. فقبل ظهور الإسلام أي فيما كان يسمّى بالعصر الجاهلي، أنتج العرب كمّا هائلا من القصص لم يصلنا منها سوى القليل وهي القصص التي لا تتعارض مع مفهوم الدّين الجديد للحياة والمجتمع. ثمّ بعد ظهور الإسلام، بداية بالمدوّنة الخاصّة بسيرة الرّسول وقصص الفتوحات والغزوات، مرورا بطرائف الجاحظ والمقامات التي لم يشتهر منها سوى ما كتبه « الهمذاني » و « الحريري » ( مع العلم أنّ أكثر من ستّين كاتبا أبدعوا في هذا الفن )، ورائعة ألف ليلة وليلة التي اشترك في تأليفها المخيال الجمعي لهذه الأمّة على مدى قرن من الزمن، وسير عنترة العبسي وسيف بن ذي يزن وذات الهمّة والزّير سالم والظّاهر ييبرس، وأخبار الملوك والأنبياء والرّسل، وغير هذا كثير ممّا تحفل به بطون المخطوطات الرّاقدة في الخزائن الخاصّة والعامّة والتي لم تجد من يحقّقها وينفض عنها غبار النّسيان إلى حدّ الآن.
إنّ هذه المدوّنة التّراثية التي أنتجها المخيال العربي ألهبت فكر قصّاصي أوربا. فقد ذكر بعض مؤرخي الأدب أنّ لقصص ” الدّي كاميرون ” الإيطالية التي تعتبر أم القصّ الأوروبي الحديث جذورا عربية وفدت عليها من خلال التّواجد العربي في جزيرة ” صقليّة ” كما أنّ « ثربانتس » صاحب « دون كيخوت » استلهم نصّه من خلال القصص الرّائجة في بلاد الأندلس قبل السّقوط النّهائي للعرب والمسلمين في تلك الأصقاع.
وقد حاول المبدعون العرب في عصر النّهضة ( أي في نهاية القرن التّاسع عشر ) الانفتاح على تلك المدوّنة التّراثية بالتّوازي مع الاستلهام من النصّ الوافد من الغرب. وكان من أبرزهم: محمد المويلحي في « حديث عيسى بن هشام » وأحمد فارس الشّدياق في « السّاق على الساق فيما هو الفارياق ». ولكن الغلبة في الأخير كانت لطريقة السّرد الغربية بدعوى أنّ النّص القصصي وافد من الغرب وأنّ تقنيات الكتابة القصصيّة غير موجودة في التّراث النّقدي العربي وغير ذلك من الحجج المتهافتة. فكأنّ لا تقنية للكتابة السّردية سوى تقنيات « موباسّان » و « بلزاك » و « دوستويفسكي » أو « تشيكوف » و«والترسكوت »…
إنّ قلّة من المبدعين العرب المعاصرين – وأنا واحد منهم – وبعد أن اطّلعوا على المخزون الثّري للمدوّنة الإبداعية العربية التي سبق وأن ذكرت بعضها، جرّبوا كتابة مغايرة للسّائد. كتابة لا تقطع مع الجذور ولا تتناسى العصر الحديث. وقد جرّب هذا الشكل الفنّي في تونس مبدعون مسكونون بهاجس التّغيير والخروج عن الطّرق السّالكة التي عبّدها كتّاب الغرب. وأهمهم على الإطلاق « محمود المسعدي » و « عز الدين المدني » من الجيل السّابق و « فرج الحوار » و « صلاح الدين بوجاه » من الجيل الجديد.
إنّ النّص الإبداعي الحديث نص مغامر بطبعه، لن تكتب له الحياة والدّوام إلاّ إذا خرج عن المألوف والمكرور وضرب بعيدا في أقاصي الإبداع باحثا عن دِنان خمر لم تطمث من عهد ساسان ليسكب روحها في كؤوس من البلوّر المصنوع في معامل القرون الحديثة.
إنّ التّراث العربي الإسلامي الشّفوي والمكتوب يحمل أشكالا مختلفة من السّرديات فالنكتة والطّرفة تحملان كثيرا من مواصفات القصّة القصيرة جدّا أو قصّة الدّقيقة الواحدة كالتكثيف الشّديد والخاتمة الصّادمة. والأخبار هي قصص تتفاوت في حجمها طولا وقصرا. أمّا المقامة أو الحديث فهي شكل راق جدّا شبيه بالرواية الغربية الحديثة. وقد بلغ السّرد العربي أوجه مع الملاحم والسّير وخاصة رائعة ” ألف ليلة وليلة ” التي خلبت الألباب وأذهلت الغرب قبل الشّرق. ولكن المؤسف هو أنّ المبدعين العرب لم يلتفتوا إلى هذا التّراث السّردي لاستلهامه و النّهل منه إلاّ فيما ندر – وإنّما ركبوا السّهل وادّعوا أنّ التراث العربي لا يحمل في خباياه القصّة والرّواية والملحمة. وزعمهم صحيح إذا قسنا السّرد المقصود بميزان النّقد الغربي. ولكنّه يجانب الصّواب إذا نظرنا إلى تراثنا السّردي بعيون عربيّة.
لكلّ هذا حاولت العودة إلى هذا التّراث لابتكار معان جديدة وأشكال طريفة من رحم هذا القديم دون الانقطاع عن فنون السّرد الحديثة. لقد حاولت تطوير شكل الرّواية الغربية وأعطيتها نكهة أخرى بأن أركبت على الفرس الأوربية حصانا عربيا أصيلا. فجاء نصّي يحمل الصّفات الحميدة لكلا الجنسين. فيه مقوّمات الرّواية الغربية ولكن فيه أيضا إضافات الشّكل العربي كالاستطراد والعنعنة والتّدوير والشّعر والاستشهادات. وتحضر فيه أيضا الطّرفة والخبر والشعر العامّي وهلوسات المتصوّفة وغير ذلك ممّا حوى السّرد العربي القديم.
هي على كلّ حال تجربة تهدف إلى إحياء ثقافة الأجداد والتّمرد على ثقافة الغرب التي تنظر باستعلاء إلى الثقافات الأخرى. ولي شرف القيام بها. فإن نجحت فلي أكثر من أجرين وإن فشلت فعلى غيري إثم الكافرين بالتّراث.
المشروع الثّاني: الحداثة والتّراث
الحداثة حركة فكريّة تقوم على الإعلاء من شأن العقل وتعتبره الرّكيزة الأساسية التي تقوم عليها حياة الفرد والمجتمع وتؤكّد على أنّ العقل هو مصدر كلّ تقدّم وأساس كلّ المعارف. ولكنّي شخصيا ومع إيماني العميق بهذه المقومات أرى أنّ هناك أنماطا معرفية أخرى يمكن للفكر الإنساني أن يستثمرها للتعبير عن مشاغله في الحياة كأن يلتفت إلى الخرافة أو الأسطورة أو الماورائيات بصفة عامّة. هذا التراث الإنساني الذي أرى فيه مصدر تحرير للفكر من قيود العقل وانفلات من جبروته وتسلّطه. فلم يعد مطلوبا من المبدع العربي الذي عاش ويعيش عجيب هذا القرن والقرن الذي سبقه أن يعكس الواقع كما هو، بل صار محتّما عليه أن يهرب من هذا الواقع من خلال شبابيك واسعة يفتحها على التراث الذي يعجّ بالأساطير والخرافات التي فسّر بها الإنسان البدائي ماهية هذا الكون والتي صارت في هذه الأيام المفتاح السّري الذي لا يمكننا بحال من الأحوال أن نغلقه لفهم عجائب هذه القرن الذي تحول فيه العلم إلى أسطورة فاقت في غرابتها ما لا يمكن لأي عاقل أن يتصور. فأنا مثلا لا يمكنني أن أفسّر دكّ مباني مركز التجارة العالمية في نيويورك بتلك الأجسام الجهنّمية الطّائرة إلاّ بسورة الطّير الأبابيل التي ترمي بحجارة من سجّيل فتجعل الإسمنت المسلّح والحديد والبلّور والبشر والودائع الذّهبية وذاكرة رأس المال العالمي والسّكرتيرات الجميلات وطاولات الإينوكس ومديري الشركات العابرة للقارات والمخبرين الواقفين أمام المصاعد في الطابق المائة من البناية التي تطلّ على نعيم ” مانهاتن ” وأجهزة الكمبيوتر الفائقة الجودة ورادارات الانترنات الفخمة و… عظمة أمريكا. تجعل كلّ ما ذكرت. وما سهوت عن ذكره. وما لم يخطر على بال، عصفا مأكولا. ولا حول ولا قوّة إلاّ بالله. ولله الأمر من قبل من بعد..
إنّنا نعيش حداثة زائفة فالماضي والحاضر يتداخلان في وعي الإنسان العربي تداخلا لا فكاك منه. إذ أنّنا نحمل في ذواتنا تراثنا الثقافي وإرثنا من الحضارات التي تعاقب على الأرض التي مازلنا نعيش على أديمها. فنحن نعيش حاضرنا بوعي زائف لأنه حاضر مسكون بأشباح الماضي. حاضر مريض بالإنفصام يتجاذبه قطبان:
القطب الأوّل: لحظة تالدة نريد أن نسترجعها ولو في شكل مهزلة.
القطب الثاني: لحظة آنية نحياها حياة الأيتام في مآدب اللّئا؟.
هذه العوامل السّوسيو – ثقافية قادتني إلى التراث العربي لاستقرائه والبحث من خلاله عن سبب تأزّم هذه المجتمعات العربيّة التي دخلت عصر « النّهضة » مع دول شرقية أخرى كاليابان مثلا. ولكن في حين عرفت اليابان كيف تستثمر إرثها الحضاري القديم وتطوّعه لبناء دولتها العصريّة. ظلّ المجتمع العربي يتأرجح بين العضّ بالنّواجذ على مفهوم للدّولة ولّى وانتهى أو عصرنة مجتمع بدويّ متخلّف، قسرا. وذلك بسنّ تشريعات تبقى في الغالب الأهم حبرا على ورق. لذلك حاولت توظيف هذا التّأزم روائيّا في نصوص انفلتت من عقالها فجاءت متأرجحة بين ماض ما انفكّ يتجدّد فينا كلّ يوم وحاضر يأبى الثّبات على حال من الأحوال.
المشروع الثالث: الواقع والعجيب
أوجب علينا معلمنا « جدانوف » لمّا كنّا تلامذة أوفياء للواقعية الاشتراكية أن يكون بطلنا إيجابيّا. وأن ننظر إلى الواقع بعين بصيرة. وأن نصنع أبطالا خارقين لا يهابون الرّدى. وأن نرى المستقبل جنّة للمحتاجين والبؤساء تحت راية ثورة العمّال والفلاّحين التي ستدكّ قلاع الرّأسمالية دكّا دكّا.
كنّا في تلك الأيّام نفكّر في تغيير العالم فجاءت قصصي التي كتبتها في ثمانينات القرن الماضي مرتبطة بالواقع كأحسن ما يكون الارتباط. تلامس أوجاع ناسه وتحتجّ صارخة في وجه قبضة البوليس وحذاء الجنديّ الخشن النازل للشوارع لقمع مظاهرات البؤساء والمطالبين بثمن عادل لرغيف الخبز ولقمة العيش. ثمّ فجأة، انهارت هذه الأحلام بانهيار « جدار برلين » وبسقوط علم « الأمميّة » تحت أقدام المحتجّين في شوارع « موسكو » ولينينغراد » وبالطلقة المكتومة من مسدّس في صدغ “تشاوسسكو” وبكتب الرفيق أنور خوجه المقدّسة تكدّس الزّبالة في شوارع « تيرانا » وبأمريكا تصرخ بأعلى مكبّرات صوتها بأنّ التّاريخ قد انتهى وبأنّ الرأسمالية في شكلها المعلوم ستسود في الدنيا والآخرة.
في تلك الضّروف العصيبة هرب كلّ واحذ منّا إلى ذاته المعذّبة ليختار لها مصيرا. فمنّا من اختار الموت تحت عجلات جرّار زبالة البلدية. والبعض الآخر أصابه مسّ من الجنّ فأهلكه. وآخرون اختاروا ” الخواء “. أفرغوا أبدانهم من أرواحها واشتروا الحياة الدّنيا بالآخرة. والآخرة خير وأبقى.
ونظرت حولي أختار لي واحدا من المصائر فعافتها نفسي جميعها. واختارت القلم وما يسطر. وغيّرني القلم. صارت رؤيتي للعالم مغايرة للمعتاد. صرت أرى البشر يمشون على رؤوسهم. وصارت الحيطان تتكلّم والهواء يطلّ علينا بألف وجه ووجه. والطّيور أصبحت لها وجوه بشرية بأنياب خنازير. ولبست أرجل تماسيح وطارت بأجنحة كأجنحة طائرات الأواكس. وامتلأ العالم براحة الجيف بعد أن أمسكت بخناق البشريد جبّارة يحرّكها دماغ إلكتروني قادر على الاستماع لدبيب النمل ورؤية بريق الدّرهم من فوق سبع سماوات. إنّ المطّلع على نصوصي القصصيّة الأولى يجد ظاهرة العجيب والسحري مبثوثة في ثناياها. أي أنّني – وأنا التلميذ النّجيب المفعم حدّا التخمة بالواقعية الاشتراكية – وجدت في لاوعيي مكانا لهذه الظاهرة. فقبل أن أقرأ لـ « ماركيز » و « أستورياس » و « أكتافيوباث » و « إيزابيل اللّندي »، قرأت ” القرآن ” وحفظت هذا الكتاب عن ظهر قلب. وقرأت في طفولتي الأولى قصص « ألف ليلة وليلة ». وعايشت الأهل وهم يحكون الخرافات القديمة المسكونة بالجنّ والملائكة والعفاريت والغيلان والموتى الذين يخرجون من قبورهم ليلا يهيمون في القرية ويزورون بساتينهم في الواحة يسقون نخيلها ويقلّمون أشجارها ويشربون الشاي مع الأصدقاء ويبطشون بالأعداء. يفقأون أعين المتلصّصين على أراملهم وينامون في أسرّة الحبيبات نوما خفيفا. ويغادرون فجرا إلى الأجداث قبل أن يفاجئهم آذان الصّبح. وتعلّمت قصّ ” السّيرة الهلالية “. وحفظت أجزاء كثيرة منها حتّى أنّني صرت أرى كلّ امرأة جميلة « عزيزة » وكلّ عاشق « يونس » .
وكبرت. وكبر معي هم القراءة والنّبش في الذّاكرة المنسية لهذه الأمّة. فاكتشفت العجب العجاب في رحلات ” ابن بطوطة “. و ” عجائب مخلوقات ” « القزويني » وغرائب قصص حيوان « الجاحظ ». هذا فضلا عن المعروف من القص العربي القديم في موسوعة « الأغاني » و « الكامل في التاريخ » والبداية واتلنهاية » وغيره… كـ « الإسراء والمعراج » وسيرة الرّسول المصطفى بصيغها المختلفة.
في هذه المدوّنات يحلّق المخيال العربي إلى آفاق لم يبلغها أحد بعد أن تفتّحت أمامه أسرار السّماوات والأرضين وجزائر البحار السبعة. إنّ « ماركيز » تلميذ متوسّط الموهبة إذا قارنّاه بـ « القزويني » أو بـ « ابن بطوطة » على سبيل المثال فقط. لذلك أعدّ ننفسي واحدا من تلاميذ هؤلاء السّاردين العرب الكبار. أتجسّس على حكاياتهم لآخرجها من غياهب التاريخ وأ ضعها عارية أمام قارئ القرن العشرين وما تلاه. أكتب بها ومن خلالها ما يعجز فن القول الحديث عن الإتيان بمثله هازئا تارة بالجغرافيا وضاحكا تارة أخرى على ذقن التّاريخ.
المشروع الرّابع: المقدّس والمدنّس:
إن الدّين والجنس والسياسة رغبات مكبوتة، دفينة في أعماقنا ودور الكاتب هو أن يفجر هذه الطاقات في نص أدبي يصدم ذائقه المتلقي. دوره أن يصنع الإنسان السليم خارج دوامة الأمراض المستثرية فينا منذ أن أكل آدم من تفاح الجنة.
لقد حوّل هذا الثالوث المحرم الإنسان العربي إلى رجل/ امرأة تعاني من الانفصام في شخصيتها. يتمارس العيب في الخفاء وينهي عن المنكر جهارا. ينتهك المقدّس الدّيني طيلة عمرها ويستغفر ربه عند الشدائد يسبّ الرّوس واليابانيين والإنجليز والأمريكيين واسرئيل والفرنسيين والناس أجمعين ولكن لا يتجرّأ على رفع إصبعها احتجاجا على الساسة من أبناء جلدتها. يكفر بكلّ الملل والنحل ويقف في الصّف ليصلّي في الجبّانة صلاة الجنازة ( هل لاحظتم كيف أنّني لم أنقط الياء من فوق هذه المرّة لأنّ المرأة لا تقف في الصفّ لتصلّي صلاة الجنازة في الجبّانة ) يبكي أمام صور القتلى من شهداء الانتفاضة في أرض فلسطين ولا تخرج للشارع محتجة على صمت الجهاز العربي من البحر إلى البحر. ( ولن أنتهي من عدّ أمراضنا الجنسية والدينية والسياسية لهذا أدعوك إلى ملئ الفراغ على هواك ) وسأكتفي بنقطة واحدة من هذا الفراغ هي المسألة الجنسية. فكثير من القراء يتهمون نصوصي بأنّها تسعى إلى تعنيف المتلقّي بصور خادشة للحياء والذّوق العام تشوّه الجسد وتقتل الرّوح وتبالغ في استحضار الرّغبات والشّهوات الكامنة في أعماق الغرائز الحيوانية للإنسان الأوّل !
إنّني أريد أوّلا أن اتفق مع متقبّل نصي على نقطة مهمّة قبل التّواصل معه هي: إنّ الابداع شيء والمنظومة الأخلاقية السائدة لدى شعب مع الشعوب في جزء من المعمورة وفي زمان معيّن شيء آخر. فالإبداع ثابت والأخلاق متحوّلة. وما هو مقبول لا يثير الشبهات لدى شعب ما يبدو مقرفا يثير التقزز لدى شعب آخر. لذا وجب الفصل نهائيا في نظري بين الأخلاق والإبداع. فمتى وضعنا حدودا للإبداع قتلناه. ومتى سلّطنا الأخلاق على النص الأدبي حكمنا عليه بالموت والبوار. من هذا المنطلق أتعامل في نصوصي مع المنظومة الأخلاقية السائدة الآن وهنا.أتحدّاها جهارا نهارا. وأقول كلمتي وأمضي. وأسعد حين تصلني تشكيات وتظلمات من « تعدياتي على الذوق العام » حينها أتأكد من فداحة المصيبة ومن أنّ البون مازال شاسعا بين الحقيقة والخيال. ففي عصر الصورة العابرة للقارات والصوت النابح داخل الأجهزة المحملة بهواتف الانترنات. مازال للكلمة نصيب. مازالت الكلمة قادرة على خدش الحياء. فأتمسك بحقي في « الإعتداء » على هذا الحياء الكاذب وعلى الجزء العائم فوق الماء من جبل النفاق والكذب. وأتمنى لو أنّ العرب أمة تقرأ كما هو الشأن لدى الأمم التي تعاصرها في بداية هذا القرن الجديد. وتذهب أمنياتي أدراج الرياح حين أتذكر أن نجيب محفوظ « المنوبل » منذ أكثر من عشر سنوات مازالت كتبه تطبع في أعداد محدودة لا تفوت خمسة آلاف نسخة تظل مركونة على الرفوف لسنوات عدة يتراكم فوقها الغبار ويتبرز على ألوان أغلافها الباهتة الذباب وهوام الأرض. في حين يطبع من كتب أمثاله من أصحاب جائزة « نوبل » ملايين النسخ توزع هدايا بمناسبة الأعياد وتقرأ على الشواطئ وفي المنتزهات والحفالات وفي الميترو وفي المخادع الفاخرة. وأتحسر لأن عنف كلماتي الفاحشة لن يخدش حياء سوى قلة من « المثقفين ». ولن يصل إلى جمهور الشعب الكريم الصائح في مدارج الملاعب الرياضية وعلى الهواء مباشرة بما لذّ وطاب من فواكه الكلم الطيب.
إن الجنس في نصي هم على القلب بالنهار وانفلات بلا حدود في الليل. وبما أن الإنسان حيوان جنسي. وبما أنّ الإنسان العربي متهم بأنه سيد هذه الحيوانات قاطبة فقد انشغلت في جزء من مشروعي الإبداعي بهذا المكبوت وافردت له رواية كاملة هي ” شبابيك منتصف الليل”. والغريب في الأمر أن القارئ العادي تقبلها بحماس أكبر من القارئ « المثقف » لآنه تعامل مع النص بدون خلفيات وبـ « قلب أبيض » بينما سعى الآخر إلى تأويلها تأويلات شتّى، أهونها خدش الحياء العام وأخطرها العمالة للغرب الأمبريالي والصهيونية العالمية.
إنّ مشاكل الإنسان العربي متعددة، متنوعة بتنوّع ألوان الطيف. ولكن الثالوث المحرم يمثل قلب الرّحى ضمن هذه المشاكل. فلئن صفى الغرب حساباته مع هذه المشاكل فإننا مازلنا إلى الآن نتجادل حول جنس الملائكة ونترقب المهدي الذي سيخلصنا من الظلم ويملأ الأرض عدلا بعد أن ملأت جوارا. ونجلد عميرة على وقع رقصة هز البطن أمام شاشات التلفزيون الملون.
إبراهيم درغوثي