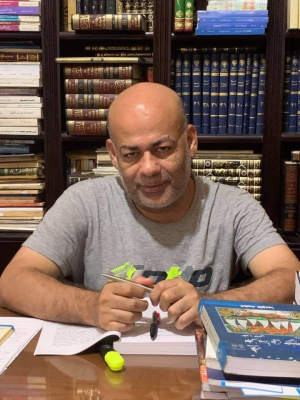لم اتعلّق بشيءٍ في حَيَاتي كتَعلُقي باِلمدرسةِ ، أحببتها ومَنيّت النّفسَ بِها قَبلَ أن اعرِفَ ما الدّرَس وما الطَلب ، كنت في صِغري أُفضِل الجُلُوسَ في مَدخَلِ قريتنا ؛ لأرى أبناءَ البلد من طُلابِها وهُم في طريقهم إليها ، لا أعرِفُ مِن دُنيا الطَّلَب وحياةَ المدرسة إلا تِلك الدقائقَ ، اعتِبُ فيِ مَراتٍ كَثيرةٍ على كُِّل مُتَكَاسِلٍ ، ساقه والده عُنوةً ، أوأجبَرته عصا أمه ونعلها لأن يهرول مُكرهًا ، اقولُ فِي نَفسي : ما لهؤلاءِ القوم وكأنّهم يُساقونَ إلى الموتِ وهم ينظرون ..؟!
قبلَ أن التحِق بالصَّفِ الأول الابتدائي ، طَلَب َ مني صديقٌ مُقرّب ، أن نَذهبَ سويًا في زِيارةٍ للمدرسةِ ، راودتني الفكِرة ووافقت هوىً في نفسي ، واعجبني أكثر جُرأة صاحبي ، أن اهتدى لهذا الرأي ، قُلتُ في نفسي : لِمَ لا ، وما المَانِعَ يا صاح..؟!
استَيقظتُ في الصَّباحِ البَاكِر كعادتي ، ففي مِثلِ هذا الموعد مِن كُلِّ شُرُوقٍ، أتناول طعامي واقصد طريقي للِحقلِ ، اركب حِماري وأجُرّ بقرتي ولا أعودُ إلا قُبَيلَ الظهيرة بدقائق ، ولكن في ذَاكَ الصَّباح تعللّتُ لأُمي وتظاهرت بالتَّعبِ ، فاعفتني من مَهمتي ، وتلكَ كانت أُمنيتي التي تحققت ، استبشرتُ خيرا فُكّل الأمور مؤاتية ولا مَانِعَ من الذَّهابِ وخوض هذه المغامرة .
بعدَ لحظاتٍ مرَّ صاحبي ، اختبأتُ خلفَ البَابِ على عَجَلٍ اصطحبته وسلكنا طريقنا ، فالمدرسة موجودة بقريةٍ تبُعد عن قريتنا مسافة بعيدة ، ولابُدّ أن نستعدَ ونتأهب للمَسيرِ ، وبالفعلِ سَلكَنا الجِسرَ التُّرابي المَار بَينَ البلدين ، ولكنّ السَّير عليهِ غير محببٍ للنّفسِ ، أكوام التراب الناعم ، وبقايا أشواك العاقول التي تُدمي الأقدام ، ناهيك عن حشرةٍ سوداء تفيضُ بها جنباته ، اَطلقَ عليها أبناء الريف ( خراب البيوت ) اعتقدنا لزمن ٍقريب ، أن من تلمسه ولو سهوا يخرب بيت أبيهِ ، ويحلّ بأهلِه النَّحس وسوء المصير.
كان الجو لا يزال هادئا ، فالطبيعة من حولنا لا تزال تَغِبُّ في ثباتها غبّا ، لم تفق الحقولِ الخضراء من سَكرةِ اللّيلِ، ولم تلق عنها رداء المساءِ الخامل .
ها هي الشمس أقبلت تُلقي تحية الصَّباح في رِقةٍ ، يشقُ جنودها العباب في تخفزٍ، وقد استسلمت لها الزُّروعَ التي ذاعبت أغصانها أكاليل النَّدى ، تراها العيون لامعة براقة تحتَ شعاع الشمس كحَباتِ الفِضة، والطيورُ على اختلافها تَحومُ في جَوِ السّماءِ الصافي ، في نشاطٍ ومَرحٍ ساعية لرِزقها المقسوم ، هنا وهناك تتصايح فتُلقي في أذانِ الوجود نَشيدَ الصَّباح ، تقول في ثقةٍ إن الله وحده مُقَسِم الأرزاق .
تلاحقت أسراب الغِربان وأبي فصاد ، وتناثرت جماعات اليمام ، وطافت عتاة الكواسر من الصقورِ والعِقابِ بريشها الزاهي وصراخها المتواصل َيرُجّ الفضاء ، وتراقصت عوائل أبو قِردان بلونها الأبيض ، معتلية أشجارَ السّنط والجميز العتيقة المحيطة بالجسرِ والتي احتضنت شاطىء التّرعة مُنذ عقودٍ طِوال ، يتردد صداها بين طيّاتِ الفَرَاغِ الممتد من حولنا .
حتى مياه الترعة تَسيرُ وكأنَّها هامدة ، لاتزال في نومها لم تستيقظ بعد مِن غفوة الظلام وأحلام الكَرى ، تحسبها جامدة وهي تَمرُّ مر ّالسّحاب ، بما يطفو فوق وجهها الأزرق من أكدارٍ وبقايا .
امتلأ صدري بالهواءِ المُنِعش ، اشمه بقوةٍ اُعبئ صدري وكأني أتَلمَّسه فاستشعرَ نقائه لأولِ وهلةٍ ، فلأول مرة اشعر بالجدية وأني ما خَرَجت إلا لأمرٍ جلل، وأن في حياتي مايستحق أن يُسعى إليه .
لم ينقطع صديقي عن حَديثهِ لحظة ، في الحقيقةِ لم اتنّبه لكَلِمٍة واحدة من كلَامهِ ، فقد شغلتني عوالمَ أخرى عن حديثهِ الفاتر ، وثرثرته التي لا تُغني عني شيئا .
لحظات وأطَلّت علينا أسوار المدرسة ، مبنى أصفر باهت قديم ، يُحِيطه سور يُوشِكُ أن يتداعى من فعلِ الرُّطوبة التي أكلت جوانبه ، يفصلهُ عن الطّريقِ بابٌ خشبي مُتهالِك تتأرجح ألواحه ، وفِي خَارجهِ فناءٌ ضيق يلف المبنى من واجهته الأمامية، وفِي جَانبهِ حوض إسمنتي كبير تتدلى منه ( حنفية ) عرَفتُ فيما بعد أنهّا مصدر المدرسة الوحيد من الماء .
مررّت يدي على ألواحِ الباب في نَشوةٍ بالغةٍ، أرمي ببصري للداخل ِ، سرت في جسدي قشعريرة غريبة لم اشعر بها من قبل ، وأنا الذي تَعوّدَ صبيا حياة حقول الذُّرة و مخاوفَ الظلام ، فللمكانِ هيبته وجلاله ، وإن أُغِرقَ في سكونهِ .
لم يعبأ رفيقي ولَم يُداخِله ما داخلني ، فقد وجَدَ تلهيته، عَثرَ مَصادفة على ما يشغله عن هدفنا السامي وسبب مجيئنا .
شَرَعَ صاحبنا في رمي شجرة ( النبق ) الكبيرة المُلاصقة للسُّورِ بالحصى والحجارة في بَهجةٍ لا تُوصَف ، ملأ جيبه وكبَسَ فمه بالثَّمرِ، نظرَ إليّ بعينِ الرِّضا وهو يُثني على فِكرةِ القُدُومِ ويُبَارِك مجيئنا، يَزِف إليّ بشاراتٍ تنتظرنا في أيامنا المقبلة ، فعلى ما يبدو أن البدايات تدل على الخواتيم.
أخيرا ودّعت المكان وانصرفنا ، ونفسي تتوق لهذهِ الحياة التي كُنت على أبوابها ، في الحَقيقةِ لم تغبْ عني صورة المدرسة ولا تفاصيلها التي حُفرت في رأسي وأغرقت خيالي ، أراها وهي ساكنة في جَلالٍ ووقار كمَعبدٍ من معَابدِ الحِكمةِ عندَ القُدماءِ ، وجدتني اغرقُ في أحلامِ يقظتي ، وأنا اتسابق مع الرِّفاقِ أجوب فصولها وأتحسس طرقاتها وممراتها ، وأُطَالِع المعلمين واستمع في أدبٍ لشروحهم، وأحيا أوقاتي في رِحابِ الدَّرسِ والمطالعة .
أما صاحبنا فقد اِنكَفأ على نفسهِ ينهش ما جمَعهُ من ثِمارِ ( النّبق) في غَبطةٍ لا تقُدر ، يعبث بالنوى فيقذفه في الماءِ فَرِحًا يتغنى بألحانِ الصّغارِ غير المفهومة .
عُدت أدراجي إلى المَنزلِ ، وهناك أصبحَ لا شُغل لي إلا أن تمرَ الأيام سريعا ، أن تنقضي المُدة وأَلحَق بالمَدرسةِ، استَغرِق في تفكيرٍ عميق لا أخرج منه .
لا زلت أتذكره ، لاحظه أصدقائي بعد أن انعزلت بنفسي ، فتنحيت جانبًا عن ألعابهم ، تَغيّر سلوكي بالمرة ، فَلم اعد ذَاكَ الفتى المُشَاكِس الذي لا يَمَلّ الحركةَ ولا النشاط .
كُنتُ اذهبُ للحَقلِ، واعودُ معَ المساءِ شَارِدَ الفكر مسلوب الذِّهن ، فمُنذ أن اعتلي ظهرَ حماري البني الصّغير ، اُسِلِم التَّفكِيَر للمدرسةِ وما ينتظرني فيها حتى أصِلَ البيت ، وعِندَ العَشَاء اجلس على ( الطبلية) اُمسِك اللُّقمةَ بين يديّ اُقَلِبها في زُهدٍ، فلم يعد يَغويني طعام ، ولا يُغريني حتى طبيخَ الباذنجان الذي تعودت أمي طهيه لأجلي ، على فُوهةِ ( فرن) الطِّين عِندَ الخَبيز .
ووسط هذا الجو المشحون بالفِكر والشُّرود ، لم يَتنّبه أحدٌ لحالي ، فَهُم في غَفلَةٍ عني ، كُنتُ صغيرًا اعتدت تَعقُب مجِالسَ الكِبَار ، التي امتلأت بحكاياتِ السنينِ المُلَهية، وتجارب الزَّمن المُسلية ، لكن في تِلَك الفترة لم تعد تستهويني في شيءٍ ، حتى حكايا القتل واللُّصوص وأبناء المَنّصر وقُطّاع الطُّرق وناقبي الجُدرَان ، فلقد وجدتُ ضَالَتي هذه المرة في رِحَابٍ أخرى .
عند شجرةِ الكَافور العتيقة التي تُلاصِقُ كوبري الترعة الصغيرة ، اتَخذَ بعض نَفرٍ من أبناءِ القريةِ ممن عرفوا طريقهم للمدرسةِ جِلستهم ، كان حديثهم ينصبّ في جملتهِ عن استعدادات المدرسة، اجلسُ إِلى جِوارهم في صَمتٍ وسكِينةٍ، الآن وجدت _ على ما يبدو _ ضالتي ، ففي كلامهم رُغم سَذاَجتهِ وسطحيته مَذَاقا آخر .
اعترف بأنّ الحماسَ قد تَملّكني أيمّا تملُّك ، جرّني معه مسلوبَ الإرادة لمنحى آخر ، لقد تعودت جمَعَ بَقايا ما خَلّفتهُ النِّيران من فحمٍ ورَماد ، لاخُطّ بيدي المرتعشة أولَ حُروفي على جُدرانِ بيوت الدّرب الطينية ، التي امتلأت بالمَسائلِ الحِسَابية البَسِيطة من ضَربٍ وطرحٍ وجمع ، إِضافةً لحُروفِ العربيةِ ارسمها بحرفيةٍ وفن، حتى وإن تَغبّرت ملابسي واسودّت أصابعي ، غير أني استطعت في أسبوعٍ كامل من امتلاكِ الشَّجاعةِ الكافية ؛ لأن تُذهِبَ من قلبي كُلّ رهبةٍ ، وهيأتني لأن أجِد لنفسي مكانا _ لاحقا_ يليقُ بأحلامي بين الطلابِ.
الكاتب المصري محمد فيض خالد
قبلَ أن التحِق بالصَّفِ الأول الابتدائي ، طَلَب َ مني صديقٌ مُقرّب ، أن نَذهبَ سويًا في زِيارةٍ للمدرسةِ ، راودتني الفكِرة ووافقت هوىً في نفسي ، واعجبني أكثر جُرأة صاحبي ، أن اهتدى لهذا الرأي ، قُلتُ في نفسي : لِمَ لا ، وما المَانِعَ يا صاح..؟!
استَيقظتُ في الصَّباحِ البَاكِر كعادتي ، ففي مِثلِ هذا الموعد مِن كُلِّ شُرُوقٍ، أتناول طعامي واقصد طريقي للِحقلِ ، اركب حِماري وأجُرّ بقرتي ولا أعودُ إلا قُبَيلَ الظهيرة بدقائق ، ولكن في ذَاكَ الصَّباح تعللّتُ لأُمي وتظاهرت بالتَّعبِ ، فاعفتني من مَهمتي ، وتلكَ كانت أُمنيتي التي تحققت ، استبشرتُ خيرا فُكّل الأمور مؤاتية ولا مَانِعَ من الذَّهابِ وخوض هذه المغامرة .
بعدَ لحظاتٍ مرَّ صاحبي ، اختبأتُ خلفَ البَابِ على عَجَلٍ اصطحبته وسلكنا طريقنا ، فالمدرسة موجودة بقريةٍ تبُعد عن قريتنا مسافة بعيدة ، ولابُدّ أن نستعدَ ونتأهب للمَسيرِ ، وبالفعلِ سَلكَنا الجِسرَ التُّرابي المَار بَينَ البلدين ، ولكنّ السَّير عليهِ غير محببٍ للنّفسِ ، أكوام التراب الناعم ، وبقايا أشواك العاقول التي تُدمي الأقدام ، ناهيك عن حشرةٍ سوداء تفيضُ بها جنباته ، اَطلقَ عليها أبناء الريف ( خراب البيوت ) اعتقدنا لزمن ٍقريب ، أن من تلمسه ولو سهوا يخرب بيت أبيهِ ، ويحلّ بأهلِه النَّحس وسوء المصير.
كان الجو لا يزال هادئا ، فالطبيعة من حولنا لا تزال تَغِبُّ في ثباتها غبّا ، لم تفق الحقولِ الخضراء من سَكرةِ اللّيلِ، ولم تلق عنها رداء المساءِ الخامل .
ها هي الشمس أقبلت تُلقي تحية الصَّباح في رِقةٍ ، يشقُ جنودها العباب في تخفزٍ، وقد استسلمت لها الزُّروعَ التي ذاعبت أغصانها أكاليل النَّدى ، تراها العيون لامعة براقة تحتَ شعاع الشمس كحَباتِ الفِضة، والطيورُ على اختلافها تَحومُ في جَوِ السّماءِ الصافي ، في نشاطٍ ومَرحٍ ساعية لرِزقها المقسوم ، هنا وهناك تتصايح فتُلقي في أذانِ الوجود نَشيدَ الصَّباح ، تقول في ثقةٍ إن الله وحده مُقَسِم الأرزاق .
تلاحقت أسراب الغِربان وأبي فصاد ، وتناثرت جماعات اليمام ، وطافت عتاة الكواسر من الصقورِ والعِقابِ بريشها الزاهي وصراخها المتواصل َيرُجّ الفضاء ، وتراقصت عوائل أبو قِردان بلونها الأبيض ، معتلية أشجارَ السّنط والجميز العتيقة المحيطة بالجسرِ والتي احتضنت شاطىء التّرعة مُنذ عقودٍ طِوال ، يتردد صداها بين طيّاتِ الفَرَاغِ الممتد من حولنا .
حتى مياه الترعة تَسيرُ وكأنَّها هامدة ، لاتزال في نومها لم تستيقظ بعد مِن غفوة الظلام وأحلام الكَرى ، تحسبها جامدة وهي تَمرُّ مر ّالسّحاب ، بما يطفو فوق وجهها الأزرق من أكدارٍ وبقايا .
امتلأ صدري بالهواءِ المُنِعش ، اشمه بقوةٍ اُعبئ صدري وكأني أتَلمَّسه فاستشعرَ نقائه لأولِ وهلةٍ ، فلأول مرة اشعر بالجدية وأني ما خَرَجت إلا لأمرٍ جلل، وأن في حياتي مايستحق أن يُسعى إليه .
لم ينقطع صديقي عن حَديثهِ لحظة ، في الحقيقةِ لم اتنّبه لكَلِمٍة واحدة من كلَامهِ ، فقد شغلتني عوالمَ أخرى عن حديثهِ الفاتر ، وثرثرته التي لا تُغني عني شيئا .
لحظات وأطَلّت علينا أسوار المدرسة ، مبنى أصفر باهت قديم ، يُحِيطه سور يُوشِكُ أن يتداعى من فعلِ الرُّطوبة التي أكلت جوانبه ، يفصلهُ عن الطّريقِ بابٌ خشبي مُتهالِك تتأرجح ألواحه ، وفِي خَارجهِ فناءٌ ضيق يلف المبنى من واجهته الأمامية، وفِي جَانبهِ حوض إسمنتي كبير تتدلى منه ( حنفية ) عرَفتُ فيما بعد أنهّا مصدر المدرسة الوحيد من الماء .
مررّت يدي على ألواحِ الباب في نَشوةٍ بالغةٍ، أرمي ببصري للداخل ِ، سرت في جسدي قشعريرة غريبة لم اشعر بها من قبل ، وأنا الذي تَعوّدَ صبيا حياة حقول الذُّرة و مخاوفَ الظلام ، فللمكانِ هيبته وجلاله ، وإن أُغِرقَ في سكونهِ .
لم يعبأ رفيقي ولَم يُداخِله ما داخلني ، فقد وجَدَ تلهيته، عَثرَ مَصادفة على ما يشغله عن هدفنا السامي وسبب مجيئنا .
شَرَعَ صاحبنا في رمي شجرة ( النبق ) الكبيرة المُلاصقة للسُّورِ بالحصى والحجارة في بَهجةٍ لا تُوصَف ، ملأ جيبه وكبَسَ فمه بالثَّمرِ، نظرَ إليّ بعينِ الرِّضا وهو يُثني على فِكرةِ القُدُومِ ويُبَارِك مجيئنا، يَزِف إليّ بشاراتٍ تنتظرنا في أيامنا المقبلة ، فعلى ما يبدو أن البدايات تدل على الخواتيم.
أخيرا ودّعت المكان وانصرفنا ، ونفسي تتوق لهذهِ الحياة التي كُنت على أبوابها ، في الحَقيقةِ لم تغبْ عني صورة المدرسة ولا تفاصيلها التي حُفرت في رأسي وأغرقت خيالي ، أراها وهي ساكنة في جَلالٍ ووقار كمَعبدٍ من معَابدِ الحِكمةِ عندَ القُدماءِ ، وجدتني اغرقُ في أحلامِ يقظتي ، وأنا اتسابق مع الرِّفاقِ أجوب فصولها وأتحسس طرقاتها وممراتها ، وأُطَالِع المعلمين واستمع في أدبٍ لشروحهم، وأحيا أوقاتي في رِحابِ الدَّرسِ والمطالعة .
أما صاحبنا فقد اِنكَفأ على نفسهِ ينهش ما جمَعهُ من ثِمارِ ( النّبق) في غَبطةٍ لا تقُدر ، يعبث بالنوى فيقذفه في الماءِ فَرِحًا يتغنى بألحانِ الصّغارِ غير المفهومة .
عُدت أدراجي إلى المَنزلِ ، وهناك أصبحَ لا شُغل لي إلا أن تمرَ الأيام سريعا ، أن تنقضي المُدة وأَلحَق بالمَدرسةِ، استَغرِق في تفكيرٍ عميق لا أخرج منه .
لا زلت أتذكره ، لاحظه أصدقائي بعد أن انعزلت بنفسي ، فتنحيت جانبًا عن ألعابهم ، تَغيّر سلوكي بالمرة ، فَلم اعد ذَاكَ الفتى المُشَاكِس الذي لا يَمَلّ الحركةَ ولا النشاط .
كُنتُ اذهبُ للحَقلِ، واعودُ معَ المساءِ شَارِدَ الفكر مسلوب الذِّهن ، فمُنذ أن اعتلي ظهرَ حماري البني الصّغير ، اُسِلِم التَّفكِيَر للمدرسةِ وما ينتظرني فيها حتى أصِلَ البيت ، وعِندَ العَشَاء اجلس على ( الطبلية) اُمسِك اللُّقمةَ بين يديّ اُقَلِبها في زُهدٍ، فلم يعد يَغويني طعام ، ولا يُغريني حتى طبيخَ الباذنجان الذي تعودت أمي طهيه لأجلي ، على فُوهةِ ( فرن) الطِّين عِندَ الخَبيز .
ووسط هذا الجو المشحون بالفِكر والشُّرود ، لم يَتنّبه أحدٌ لحالي ، فَهُم في غَفلَةٍ عني ، كُنتُ صغيرًا اعتدت تَعقُب مجِالسَ الكِبَار ، التي امتلأت بحكاياتِ السنينِ المُلَهية، وتجارب الزَّمن المُسلية ، لكن في تِلَك الفترة لم تعد تستهويني في شيءٍ ، حتى حكايا القتل واللُّصوص وأبناء المَنّصر وقُطّاع الطُّرق وناقبي الجُدرَان ، فلقد وجدتُ ضَالَتي هذه المرة في رِحَابٍ أخرى .
عند شجرةِ الكَافور العتيقة التي تُلاصِقُ كوبري الترعة الصغيرة ، اتَخذَ بعض نَفرٍ من أبناءِ القريةِ ممن عرفوا طريقهم للمدرسةِ جِلستهم ، كان حديثهم ينصبّ في جملتهِ عن استعدادات المدرسة، اجلسُ إِلى جِوارهم في صَمتٍ وسكِينةٍ، الآن وجدت _ على ما يبدو _ ضالتي ، ففي كلامهم رُغم سَذاَجتهِ وسطحيته مَذَاقا آخر .
اعترف بأنّ الحماسَ قد تَملّكني أيمّا تملُّك ، جرّني معه مسلوبَ الإرادة لمنحى آخر ، لقد تعودت جمَعَ بَقايا ما خَلّفتهُ النِّيران من فحمٍ ورَماد ، لاخُطّ بيدي المرتعشة أولَ حُروفي على جُدرانِ بيوت الدّرب الطينية ، التي امتلأت بالمَسائلِ الحِسَابية البَسِيطة من ضَربٍ وطرحٍ وجمع ، إِضافةً لحُروفِ العربيةِ ارسمها بحرفيةٍ وفن، حتى وإن تَغبّرت ملابسي واسودّت أصابعي ، غير أني استطعت في أسبوعٍ كامل من امتلاكِ الشَّجاعةِ الكافية ؛ لأن تُذهِبَ من قلبي كُلّ رهبةٍ ، وهيأتني لأن أجِد لنفسي مكانا _ لاحقا_ يليقُ بأحلامي بين الطلابِ.
الكاتب المصري محمد فيض خالد